هل كانت هناك علاقةٌ بين السيميائيات والتحليل النفسي؟ وبعبارةٍ أدقّ، كيف كانت علاقةُ غريماس (1917-1992م) بالتحليل النفسي، وبخاصّةٍ اسمانِ كبيرانِ في التحليل النفسي: المعلم الأول مؤسِّس التحليل النفسي سيغموند فرويد (1856- 1936م)، والمعلّم الثاني مجدّد التحليل النفسي جاك لاكان (1901- 1981م)؟
هناك ملحوظةٌ لا بدّ من تسجيلها في البداية: علاقةُ غريماس بالتحليل النفسي لم تكن إلى اليوم موضوعَ دراسةٍ نسقية. أيعني ذلك أنه لم تكن هناك أصلًا من علاقةٍ بين الاثنين؟ مؤشرات كثيرة تؤكد العكس. لأستحضرَ بعضًا من هذه المؤشرات: أولًا، منذ مؤلَّفه: «الدلاليات البنيوية» (1966م)، كان غريماس يؤسس نماذجه السيميائية الأولى (النموذج العاملي المشهور) في حوار مع مؤسس التحليل النفسي سيغموند فرويد، وبخاصة ما يتعلق بالبنيات العاملية. ويكون هذا الحوارُ سجاليًّا في بعض الأحيان: ولأذكرْ هنا النقد الصارم الذي وجهه غريماس إلى الناقد النفسي المشهور شارل مورون (1899-1966م)، وبخاصة حول موضوع الشبكات الدلالية الملحاحة. ولأسجل ثانيًا أن غريماس يحيل إلى جاك لاكان بخصوص مفهوم (assomption)، على سبيل التمثيل. وفوق ذلك، فإن غريماس قد عمل على تطوير نموذجِه السردي التوليدي، وذلك بتحليل حلقات سيكودرامية بمساعدة تلميذ جاك لاكان المحلل النفسي مصطفى صفوان (1921-2020م).
لكن هذه المؤشرات التي تؤشر على وجود علاقة بين غريماس والتحليل النفسي، لن تمنع من التقدم بافتراضات، من أهمها:
– هناك فضاء إشكالي مشترك بين السيميائيات والتحليل النفسي، وهذا الفضاء هو: المعنى وتأويله.
– التحليل النفسي والسيميائيات، كل واحد منهما، وبطريقته الخاصة، كان يتقرب من البنيات العاملية، ويسعى إلى بناء نماذج عاملية.
– حضورُ التحليل النفسي، والفرويدي خاصة، واضح في بدايات غريماس، لكن ذلك التأثير بدأ يقل شيئًا فشيئًا إلى أن اختفى تمامًا. وبلا شك أن معاصر غريماس، جاك لاكان، قد كان السبب في ذلك. ولذلك، اسمحوا لي أن أبدأ بهذا الثنائي: غريماس/ لاكان، قبل أن أعود إلى الثنائي الأول والأساس: غريماس/ فرويد؟
غريماس ولاكان
يمكنني أن أتساءل: لماذا كانت إحالات غريماس إلى لاكان قليلة جدًّا؟ وعلى سبيل التمثيل، قدَّمَ لاكان سنة 1956- 1957م محاضرةً مهمة جدًّا «La relation à l’objet» (العلاقة بالكائن)، لماذا لم يلتفت غريماس إلى هذه المحاضرة على الرغم من أنها تصب في قلب مشروعه السيميائي؟

غريماس
لأسجل من جهة أولى أن اللاوعي هو عنوان ميلاد التحليل النفسي، وأن المعنى هو نفسه هوية السيميائيات. ولأسجل من جهة ثانية أن السيميائيات، وبخاصة عند غريماس، تعد مفهوم اللاوعي، وبخاصة عند لاكان، «غير ملائم» في نماذجه الوصفية للمعنى. وبالفعل، فالتحليل النفسي اللاكاني يبدو أنه يتأسس على هذا الإبعاد للمعنى، على تجاهل للمعنى، على تهكم من المعنى، بصورة تجعل التحليل النفسي يبدو كأنه يوجد خارج المعنى.
وباختصار شديد، لقد حرصت العديد من الدراسات النفسانية على توضيح القاعدة الجوهرية في التحليل النفسي اللاكاني: «اللاوعي مبنًى كاللغة»، موضحة أن هذه القاعدة لا ينبغي لها أن تفهم كأنها إخضاع التحليل النفسي للسانيات، فلاكان كان يرفض عدّ اللاوعي «علامة» بالمعنى الدوسوسيري، أي علامة لها مدلول ثابت، فاللغة بالنسبة إليه ليست نسقًا من العلامات، بل هي نسق من الدوالّ، وإذا كانت نظرية دوسوسير نظرية للعلامة، فإن نظرية لاكان هي نظرية للدال، فلا تمييز في لغة اللاوعي بين الدال والمدلول، و«الشبكة اللاواعية يمكن أن تكون مفتوحة بامتياز على المعاني كلها: مفتوحة على دال خالص»(1).
وتعود أهمية هذه الأولوية التي أعطاها جاك لاكان للدال في الشبكة التي يَلِجُ المعنى من خلالها إلى أنها تؤدي إلى استنتاج مهم: تكشف بنية الشبكة الدالة عن الإمكانية التي للإنسان في استخدام هذه الشبكة للدلالة على شيء آخرَ غير ما يبدو أنها تقوله، لكن هذه الشبكة الدالة تكشف في المقابل أن للدال، بوصفه شبكة رمزية، قدرة كبيرة وسلطة واسعة واستقلالية كاملة في علاقتها بالإنسان، بحيث يمكنها أن تُقوِّلَ الإنسانَ ما لا يريد أن يقوله مثلًا.

سيغموند فرويد
هكذا يبدو أن المحلل النفسي جاك لاكان ينظر إلى الدال على أنه مستقل بشكل جذري عن المدلول. وهو بهذا يستبعد المعنى، ويستبعد كل نظرية للدلالة، ويستبعد كل حوار مع السيميائيات. وأغلب تلامذة لاكان، في حياته وبعد وفاته، قد كرسوا فكرة الدال الخالي من كل دلالة، وبعضهم يرفض إعادة قراءة لاكان أو تعديل نظريته أو تطويرها أو حتى تدقيقها. وهنا يمكن أن نقارن بين غريماس ولاكان، كيف تتطور النظرية السيميائية بفضل تلامذة غريماس وأقرانه وأتباعه، وكيف بقيت نظرية لاكان من دون تطوير.. فكيف السبيل إلى حوار بين التحليل النفسي والسيميائيات في هذه الحالة؟
في نظري، ومن أجل إعادة بناءِ هذا الحوار، لا بد من استعادةِ الحوار الذي كان بين غريماس وفرويد. ولكن قبل أن أتقرّب قليلًا من هذا الحوار، لا بد أن أشير إلى فالدير بايفيداس وهو لساني سيميائي ومحلل نفسي من البرازيل (من مواليد 1950م)، تقدّم سنة 2000م بأطروحة لنيل الدكتوراه، وكانت محاولته الأولى، تلتها محاولات أخرى، للدفاع عن حوار بين السيميائيات والتحليل النفسي قائم على فهم جديد للنظرية اللاكانية: يعودُ بايفيداس إلى محاضراتِ لاكان، ويوضّحُ أنّ «اللا-معنى» الذي يتّصف به الدالُّ عند لاكان لا ينبغي لنا فهمُه على أنّه «من دون دلالة»، بل لا بدّ من التقدّم بافتراضٍ أنّ الدالَّ عند لاكان قد تأسّسَ على مبدأ: «الأسبقية للمدلول». وينبغي لنا أن نفهمَ هذا المبدأَ عند لاكان من خلال تلك الصورة البلاغية التي من خلالها نلفت الانتباه إلى شيء ما مع أننا نعلن أننا لن نتحدث عنه. وجاك لاكان كان يصرح طول الوقت بأن الأمر لا يتعلق بالمدلول، مع أنه ضمنيًّا لا يتعلق الأمر إلا بذلك وطول الوقت.
غريماس وفرويد
أزعم أن إعادة بناء العلاقة بين غريماس وفرويد هي التي ستسمح بحوار مثمر بين السيميائيات والتحليل النفسي، وذلك انطلاقًا من العناصر الآتية:
– لا بد أن أتساءل: لماذا كان لمؤلَّف فرويد: «تفسير الأحلام» (1900م) حضورٌ لافتٌ في مؤلَّفات غريماس، منذ مؤلَّفه: «الدلاليات البنيوية» (1966م)؟ أفترض أنَّ سببَ هذا الحضورِ هو أن مسألةَ المعنى حاضرةٌ بقوةٍ في كتابات فرويد، وبخاصة في هذا المؤلَّف المؤسِّس: ففيه يسجّل فرويد أن الحلمَ مهمٌّ من الناحية العلمية؛ لأنه بالضبط «مليءٌ بالمعنى»، وتفسيرُ الحلم في التحليل النفسيِّ هو الكشفُ عن المعنى.
– يسجّل غريماس أنَّ التحليلَ النفسيَّ عند فرويد كان يستهدف بناءَ «بنيةٍ عاملية»، لننتبه إلى كلماتِ غريماس بهذا الخصوص: «… التحليل النفسي الذي كان صوغه للمفاهيم يستند، في جزئه الأكبر، إلى البحث عن نموذج عاملي قادر على إدراك السلوك الإنساني»(2).

جاك لاكان
– المكانة المركزية التي يحتلها مفهوم الرغبة في نظرية فرويد كما في نظرية غريماس هو ما يسمح لي بأن أتحدث عن وجود مسالك متناظرة، من الناحية المنهجية، بين السيميائيات والتحليل النفسي. وهنا يمكن أن نعيد النظر في مفهوم الرغبة عند فلادمير بروب (1895-1970م) وإتيان سوريو (1892-1972م)، وأن نعيد بناء مفهوم اللبيدو عند فرويد.
– يسجل فالدير بايفيداس(3) أن هناك فضاءً إشكاليًّا مشتركًا بين السيميائيات والتحليل النفسي، بين غريماس وفرويد، ويسميه: «فضاء الانفعال»، وهذا مفهوم مربك يتعلق بكل ما يؤثر في الذاتية الإنسانية: الغرائز والأهواء. وفرويد كان قد نظَّرَ لهذا الفضاء في صورة نظام غرائزي، يندرج في إطار نظام باثولوجي، ويسعى إلى وضع الذات داخل إطارات كلينيكية (الهستيريا، العصاب، الانحراف…) تأخذ في الحسبان تلك الوضعيات التي تؤثّر في الفرد في حياته الخاصة.
أما النظرية السيميائية، فقد طورت هذا النظام الفرويدي من خلال تأسيس «سيميائية الأهواء» من وجهة نظرٍ معجمية (غريماس 1983م)، ثم من خلال «مسار أهوائي»، وفي ضوء «مسار توليدي للدلالة»، وبدرجة أكثر سردية وخِطابية (غريماس وجاك فونتانيل (من مواليد 1948م) في دراسة صدرت سنة 1991م).
– لكن يمكن أن أسجّلَ أن غريماس لا يستحضرُ كلَّ الأنظمة التي وضعها فرويد، ولا يأخذ في الحسبان ذلك «المسارَ اللاواعيَ للذاتية الإنسانية»، ولا يأخذ في الحسبان «الدال» الذي يمنحه لاكان الأولوية. وأي حوار جديد اليوم بين السيميائيات والتحليل النفسي، لا بد أن يأخذ في الحسبان هذه الملحوظات.
وختامًا، أسجل أن التجاهل المتبادل كان السمة البارزة للعلاقة بين السيميائيات والتحليل النفسي، وبخاصة بين غريماس ولاكان، على نحو خلقَ توترًا بين اللاوعي والمعنى، وهو توتر يمكن أن يتحول إلى توتر خطير على «الصحة» النظرية لكل واحد من الاثنين: التحليل النفسي والسيميائيات.
هوامش:
(1) J. Le Galliot : Psychanalyse et langages littéraires, Nathan, 1979, p1977, p86.
(2) Greimas : Sémantique structurale, Larousse, 1966, p186.
(3) Waldir Beividas : Semiotique et psychanalyse, l’univers thymique comme enjeu, Langages, 2019, N213, Editions Armand Colin, pp 55-65.

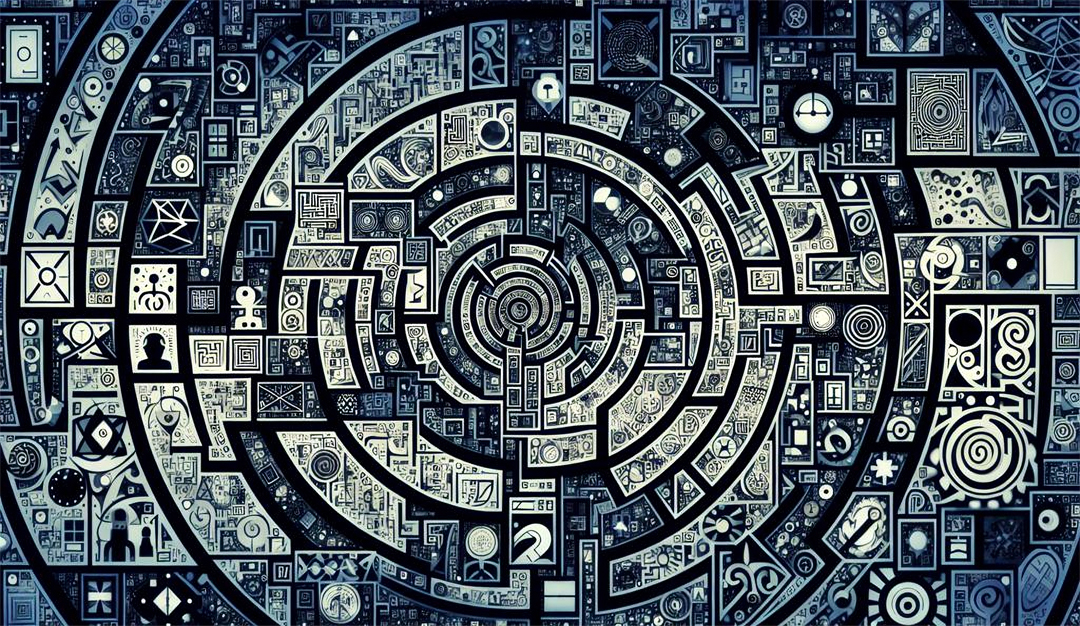











مقال السيمياىيات والتحليل النفسي للباحث الدكتور حسن المودن. يقدم رؤية نقدية جديدة ويكشف عن أسرار تعمق وعينا بالنظرية السمياىية