لكل فعل رد فعل، ولكل نظرية إثبات، نظرية نفي، ولكل ثقافة هنالك ثقافة مضادة. هذا يعني أن لكل شيء هنالك «اللاشيء» الذي يتبناه اللاشيئيون الجدد حول العالم. وهذا بدهي، ولكنه مخيف، ويهدم كثيرًا من الثقافات التي بَنتنا وعشنا عليها.
بعد كل ارتجاجٍ كبير يحدث في العالم، يتقشّر التاريخ عن ارتجاجاتٍ موازية تطول القيم والعادات والمنهج بمقدماته التي أدت إلى تلك النتائج الهزيلة. بعد تفكك الأوطان وتفسخ الاقتصاد، وبعد الحروب والأوبئة والأهوال، يحتج الجميع على الجميع، ويُحَطَّمُ المكرس والسائد. من هنا نقرأ الثقافة المضادة والهيبية والدادائية وجيل البيت والبانك وصحافة الجونزو والروك أند رول وغيرها من الحركات التفكيكية والرافضة.
ولكن اليوم وبعد انهيارات بالجملة والمفرّق، هل من حركة ثقافية تفكك أو تركّب ما يجري؟ لعلها ثقافة «اللاشيء». أستلهم المصطلح هنا من بحث كتبه جان مونتالتي بعنوان: «أولئك الذين هم لا شيء»، نعم نحن في عصر ثقافته اللاشيء، واللاشيء -من وجهة نظري- لا يعني العدم، فالعدم قد يقرأ ويُنظّر له، أما اللاشيء فلا، العدم مقابل الوجود، أما اللاشيء فلا نظير له.
عصر الاستبدال، فناء العالم القديم
في سنوات قليلة، استُبدلت مفاهيم العالم القديم برمتها، لقد اقتلع الماضي ولم يظل منه سوى أشباح بالكاد نقبض عليها في ذكرياتنا وأحاديثنا وكأنها من كوكب بعيد. نعم، من مرتكزات نظام العالم الجديد استبدال كل ما هو راسخ وعميق، يميز كل منّا عن الآخر، يجب أن نتخلى أيضًا عن الولاءات الضيقة، كل الولاءات، وألا نبالغ في إبراز هويتنا الثقافية والمجتمعية، محوها أفضل واستبدال ثقافة الأفراد الهلاميين بها، المتشابهين مثل كوكب الزومبي.
في الغالب، استُبدل بالحكومات الشركات الكبرى، ومُزّقت الهويات جميعها: الجندرية والوطنية والأيديولوجية، لم يعد هنالك مركزية لأي شيء، فباريس لم تعد تصنع العطور، وبوهيميا باتت تستورد الكريستال، كما اضمحلت السيارات الألمانية وتوارت وراء السيارات الرخيصة الجديدة، إن ختم الفرادة والتميز لم يعد بيد أحد. لقد سرقه الشيطان وطار به إلى الجحيم.
بعد انهيار أنظمة التكافل الاجتماعي والضمانات الصحية والمعونات الحكومية في الشرق والغرب، تغيّر العالم بشدة وبقسوة، وارتجّ العالم ارتجاجًا مرعبًا وأعاد تكتّله لمواجهة ما يحدث، فانتشرت الخيام بدلًا من وحدات الإسكان ومجمعات الإيواء، وتقدّمت الهجرات والنزوحات على الأوطان والاستقرار والإنتاج، وبكل قسوة؛ حلّت الآلة مكان البشر الذين أصبحوا عاطلين إلا عن الجرائم، وأكلت قروض الرهن العقاري أجناب أصحابها الذين تشرّدوا وناموا على الأرصفة، وبدأ سباق وتسارع مهول للتقنية والذكاء الاصطناعي وحروب الرقائق والحواسيب والأمن السيبراني، وقامت الفوضى وقعد الترتيب، وسُحقت العقول العادية وتعب التفكير وتراخى الطموح بعد أن كتب وقيل وأنتج كل شيء تقريبًا.
وفي خضم كل هذا، مات الأدب القديم بلا عودة، وحلّ محلّه أدبٌ جديدٌ مختلف كليًّا، وباتت الدعوة لقراءة دون كيشوت أو موبي ديك، ضربًا من العقاب والجنون. اختلفت السينما والدراما والمسرح والرسم والنحت والموسيقا. اختلف الإنسان بكلّيته، وتهاوت الفلسفة وتراجعت حتى قال المبرمج جوش بيرزو: «أي قيمة للفلسفة اليوم في عالم الديجتال؟ إنها جيدة كنموذج لرداءة المحتوى القديم وطوله وسفسطته، أي برنامج ذكاء اصطناعي اليوم أعمق من التاريخ كله».
نعم، دخلنا إلى فكرة نفي الكلام والاختزال والصمت المطبق، دخلنا إلى مرحلة انحطاط المعنى وفوضى المصطلحات وطبقية التعاطي. في هذا السياق يقول جون غاردنر: «إن المجتمع الذي يحتقر الفضائل في مهنة السباكة بوصفها نشاطًا متواضعًا ويتسامح مع الرذيلة في الفلسفة لأنها نشاطٌ رفيعٌ، لن يكون لديه سباكة جيدة ولا فلسفة جيدة! لا أنابيبه ولا نظرياته سوف تصمد».

الانحطاط، المزيد من الانحطاط
هل انحطّ الإنسان الحديث؟ هل كان ساميًا -أصلًا- وهوى؟ في عام 1946م قال جورج أورويل في مقال «السياسة واللغة الإنجليزية»: إنَّ ثمة ارتباطًا وثيقًا بين انحطاط اللغة وانحطاط الفكر، وشبّه الأمر بلجوء الإنسان الذي يشعر بالفشل إلى إدمان الخمر. الفشل سبب للإدمان، والإدمان سبب للمزيد من الفشل. علاقة تبادلية: سبب ونتيجة في آنٍ. تصبح اللغة قبيحة ومهلهلة بسبب حماقة الأفكار التي تعبر عنها، لكنَّ هذه الرثاثة اللغوية تجعل من السهل على صاحبها أن يصل إلى أفكار حمقاء.
يرى أورويل أن السياسة المتوحشة وخطاب السياسيين صارا دفاعًا عما لا يمكن الدفاع عنه. إنَّ بشاعات مثل إلقاء القنبلة النووية على اليابان، وحملات التطهير والترحيل الروسية، وغير ذلك من الفظائع يمكن الدفاع عنها، لكن بحجج شديدة الوحشية تعتمد على التحسينات اللفظية والغموض والإبهام. حيث إن قصف القرى المسالمة وقتل المواشي وإحراق البيوت بالقنابل الحارقة يسمى سياسة تهدئة. وحرمان ملايين الفلاحين من مزارعهم وتشريدهم يسمى نقلًا للسكان، أو تصحيحًا للحدود. أما سجن الناس لسنوات من دون محاكمة، أو اغتيالهم، أو إرسالهم لمعسكرات الاعتقال يسمى تخلصًا من العناصر غير الموثوق بها.
تقدم المؤثر، تراجع المثقف
ها نحن اليوم نرتهن للأقل ثقافة وبديهة وذكاءً، أولئك الذين ليس في أيديهم حساء قد يسكب على الأرض فيندمون، أولئك الذين لم يتعبوا ولم يسهروا الليالي من أجل قراءة كتابٍ واحد؛ القادمون من العدم والتفاهة والدعة والراحة والإحباطات النفسية واللاجدوى أيضًا، النرجسيون الذين يدعسون على كل شيء مقابل الظهور والمال.
ها نحن اليوم نشهد مشاهدات مليارية لمؤثر على وسائل التواصل، يجلس قبالة الشاشة ربع ساعة لا يقول شيئًا على الإطلاق، يجلس صامتًا واجمًا دون أي حركة تقريبًا. وفي كل مرة يظهر في بثّه «اللايف» نرى ملايين من المشاهدين يحضرون العرض الصامت نفسه من دون أدنى تغيير.
مؤثر آخر، يُحَطِّم السيارات الفارهة أمام المتابعين، يحرق الدولارات، ويرمي النقود من الطائرة والسطح والشرفة. ومثله مؤثر آخر، يصور لنا حفلاته الماجنة على اليخت وتحت الماء وفوق الفيل.. ومؤثر يلاحق قطط الشوارع ساعات بالكاميرا من دون أي كلمة أو خلفية موسيقية… هؤلاء لديهم متابعون يصعب عدّهم!
لا مشكلة لديَّ أنا المثقف الذي ضاع عمره بين الكتب، إنما المشكلة الحقيقية لديّ، أن هؤلاء أصبحوا واجهة «التأثير»! إن ملايين المتابعين يعني ملايين المشاهدات، ويعني إعلانات ومعلنين وملايين الدولارات. في حلقةٍ من المسلسل الكوميدي السعودي «طاش ما طاش»، يفقد ناصر القصبي وظيفته في الصحيفة، حيث يعمل محرر عمود أدبي رصين، ويجد نفسه بسبب انقطاع موارده بين يدي مؤثرة «فاشينيستا» تحتاج إلى مستشار إعلامي يبدع لها «شتائم» لائقة لمنافساتها، ثم تطرده ليقرر هو أن يتحول من الكتابة إلى البث «اللايف» ليقدم محتوى يليق بالعصر الجديد، ويصبح غنيًّا بشكل مضحك! إن تغوّل المؤثرين بدأ يقلق العالم؛ إذ أصبح ظاهرةً عجيبةً في وقت يزداد فيه العالم ضحالة بسبب قلة التفكير اليومي وأدواته. حيث نرى كثيرًا من المؤثرين المُتابعين بالملايين لا قيمة لمحتواهم سوى من خلال عدد متابعيهم الذين فضّلوا وركنوا إلى الراحة العقلية وعدم التفكير. وبحسب برنارد نويل في كتابه «موجز الإهانة»، فإنه «لا يمكن للمعدة أن تتحمل الإمساك عن الطعام، أما الذهن يتعود بسهولة عكس ذلك، وكلما ازداد ضموره قل إحساسه بالحاجة. المبالغة في منع الغذاء عن العقل لا يعطيه شهية، بل يجعله يشعر بالاشمئزاز والتعب من الغذاء».
في حادثة شاعت، طلبت فتاة مؤثرة من أحد الفنادق في دبلن غرفة لمدة أيام مقابل إعلان. أجابها الفندق برسالة تصلح لأن تكون قانونًا علينا الأخذ به في التعامل مع هؤلاء الضحلين الذين دفعهم جمهورهم إلى الواجهة دون أي مبرر سوى التفاهة. قال الفندق في رسالته: «شكرًا لك على الإيميل الذي يبحث عن إقامة مجانية مقابل الدعاية، يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لإرسال رسالة مثل هذه، ولكن ليس الكثير من احترام الذات والكرامة. إن تركتك تقيمين هنا مقابل فيديو عنا، من سيدفع المال للعمّال الذين يعتنون بك؟ من سيدفع لمن سيقوم بالنظافة بغرفتك؟ وهؤلاء الذين يقدمون لك وجبة الإفطار من سيدفع لهم؟ عامل الاستقبال الذي سيسجلك؟ من سيدفع للإضاءة والتدفئة التي ستستعملينها من أجل إقامتك؟ ربما يجب أن أخبر طاقمي أنك ستتحدثين عنهم أيضًا في الفيديو لكي تدفعي لهم مقابل العمل الذي تم خلال إقامتك. ملحوظة: الإجابة هي لا».
خرجت الفتاة باكية على بثّ «لايف» لجمهورها تستنصره وتستخدمه لمواجهة صلف الفندق، وهو ما عرضه لحملة تشويه كبيرة إلا أن الفندق لم يذعن لتلك الضغوطات وخرج ببيان رسمي جاء فيه: «بعد تلقي الكثير من الإهانات إثر قيام مدونة غير معروفة بطلب غرفة مجانية، اتخذنا قرارًا بمنع المدوّنين كافة من الدخول إلى فندقنا والمقهى كذلك. إن حسّ الاستحقاق والحصول على أشياء كأنها حق، وهي ليست كذلك، هو أمرٌ راسخ للغاية لدى مجتمع المدونين. وما حدث يضع الكثير من الأسئلة حول مصداقية مجتمع المؤثرين، علمًا أن تلك المؤثرة كانت ستتحدث بطريقة جيدة دون النظر إلى السلبيات لدينا إن وافق الفندق على إقامتها مجانًا».

من أين بدأ الأمر؟
أفكر كثيرًا من أين بدأ الأمر؟ لا أعرف! ولكنه وصل إلى مكان منفلت وغائم وضبابي… إلى اللاشيء. من ينظر في الكتب الأكثر مبيعًا اليوم، يعرف تمامًا أين نحن، كتب لا تقول شيئًا لعالم لا يريد أن يسمع شيئًا. قرأت أحد هذه الكتب الذي يتحدث عن فتاة عمرها 15 عامًا كانت تسجل يومياتها مع والديها وهما ينحازان لأخيها، هذا الصباح أخي أخذ بيضتين بينما أنا أخذت بيضة، قبل النوم، أمي طبعت قبلةً على جبين أخي بينما نظرت لي بعصبية وأغلقت وراءها الباب… هكذا، والطريف في الأمر أن هذا الكتاب عاد بمليون دولار للفتاة التي استمرأت اللعبة، فكتبت كتابًا آخر عن اختلاف تعامل أبويها بعد المليون دولار!
لقد غابت القضايا الكبرى من الفنون وحلت محلّها الفردية الضيقة التي غالبًا ليست ذات بال. إن فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب هو إشارة مباشرة لخروج العالم الجاد من اللعبة، ثمة خطاب جديد حلّ محل الخطاب القديم، هل فاز ديلان بشكل اعتباطي؟ لا أظنه كذلك بتاتًا، إن نص ديلان يقرأ المؤشرات الجديدة من حوله ويتصل مع المجتمع بلغة جديدة جريئة تخطو فوق المنهجية والنظريات النقدية، بل حتى لا تعرفها من أصله، لكن هل هو الأدب الذي نعرفه؟ لا أظن ذلك بتاتًا مرةً أخرى.
لعل أول الكتب التي أشارت إلى تدحرج القيم والحياة المجتمعية نحو الفردية المنغلقة، هو كتاب كريستوفر لاش: «ثقافة النرجسية: الحياة الأميركية في عصر التوقعات المتضائلة»، الصادر عام 1979م. يعد الكتاب رحلة أكاديمية ونفسية وثقافية وفنية واجتماعية، يحاول بها الكاتب الكشف عن جذور وتداعيات تطبيع النرجسية المرضية في الثقافة الأميركية في القرن العشرين. يقترح لاش أنه منذ الحرب العالمية الثانية، أنتجت أميركا نوعًا من الشخصية يتوافق مع التعريفات السريرية لـ«النرجسية المرضية». هذا المرض ليس مشابهًا للنرجسية اليومية، وأنانية اللذة، ولكنه يشبه التشخيص السريري لاضطراب الشخصية النرجسية. ويحدد أعراض اضطراب الشخصية هذا في الحركات السياسية الراديكالية في الستينيات مثل حركة (Weather Underground)، وكذلك في الطوائف والحركات الروحية التي راجت في السبعينيات. يرى لاش النرجسية كحالة من العظمة والفراغ الداخلي، حيث ينظر النرجسي إلى العالم على أنه مرآة له. وتكشف النرجسية عن الذات القهرية وأوهام الشهرة والسلطة والجمال. ويتمثل الجانب المظلم للنرجسية في الغضب المكبوت والحسد والميل إلى الانخراط في علاقات سطحية واستغلالية. ويتوقع لاش الأسوأ… نحن إذًا في الأسوأ الآن.
لقد جرى تفكيك كل الكتل بنجاح: الأسرة، والمجتمع، والأحزاب، والنخب، وباتت النجاة الفردية مطلبًا جماعيًّا. ها نحن اليوم نرى كيف يوظف النظام العالمي الجديد كل أدواته لتدمير «البطريركية» والسلطات بكل أشكالها. إن رواية لاش عن تأثيرات الثقافة النرجسية في العلاقات بين الجنسين متشائمة بالقدر نفسه. فهي تقلل من أهمية العلاقات الوثيقة وتقوض الزواج، حيث تهرب النساء والرجال من التشابكات العاطفية العميقة بحثًا عن أشكال أقل تطلبًا من الاتصال.

المهمة المستحيلة!
إذًا، ها نحن نقف على حطامنا بشكل أو بآخر، لم يعد هنالك جمهور للسيمفونيات الكلاسيكية ولا مؤلفون، الآداب والكتب بأغلفتها المذهبة باتت مخيفة ومضحكة، ربطات العنق هي الأخرى وضعها كوضع السيمفونيات والفرق النحاسية، المتشردون على الأرصفة، شكّلوا فرقًا مسرحية وأدبية بعدما طردهم المتن المتوحش، مثلما وجد فنانو الغرافيتي الكثير من الجدران المهترئة والقبيحة للرسم عليها.
يقول بيري جيستمان: «عندما كنا أطفالًا في مدينة نيويورك في سبعينيات القرن العشرين، وُلدنا في عالم مغطى بالطلاء. قد تكون الجدران والقواعد والقوالب حتى المشعات مغطاة بست أو سبع طبقات من الطلاء النظيف. حتى ظننا أنها تساهم في تماسك المبنى! كان هنالك كثير من الصرامة لأن يبدو كل شيء نظيفًا وغير قديم. إنما في مدة وجيزة لم يعد أحد يهتم! ربما الأزمات الاقتصادية عوقت الترميم، تقشرت الطبقات وتشققت. وحذرنا من تناولها. وهذا جعلنا نتساءل: هل كانت صالحة للأكل؟ انفجر الغرافيتي انفجارًا، وفي الثمانينيات كانت المدينة كلها مليئة برسوم الجدران حتى إن المترو طُلِيَتْ عرباته المتحركة بطلاء مقاوم للغرافيتي، أولًا باللون الأبيض الغامق، ثم باللون الأخضر الغابي والبورجوندي».
في مقال كتبه توم بينجام، حلل فيه أولمبياد باريس وانعكاسه على العالم وانعكاس العالم عليه، قال: «من بين كل هؤلاء الرياضيين العظام، أبطال الكوكب، يهبط علينا توم كروز لينقذ هذا التجمع الهزيل للعالم الحديث! هل كنت سأصدق حقًّا، بعد كل هذا، أن توم كروز سوف يأخذ العلم الأولمبي للمريخ وينقذ العالم فجأة مرة واحدة وإلى الأبد؟ بصراحة، لا أعتقد ذلك. ولكن لا بأس، على الأقل إنه وجه نعرفه، حتى وجهه المرسوم بأربع حقن بوتوكس، يبدو مألوفًا لنا كذكرى عابرة وحنين لمرحلة يمكن التعرف إليها بوضوح في صخب التناقص العالمي، عمومًا كان وجوده يشي بأن القضية ما هي إلا مهمة مستحيلة».
إننا نودع بالفعل حقبةً تبدو لنا رائعة، (لا نعرف ما رأي الجيل الجديد!) فإذا كان من يختتم ألعابنا الأولمبية الرصينة التي تطورت عن الفلسفة والأخلاق هو توم كروز، الرياضي المزيف، إلى جانب سنوب دوغ، النموذج السيئ السمعة، الذي يشير بيديه وأسنانه الذهبية لكل تنازلاتنا الثقافية وهو يقف بين آلاف الرياضيين أصحاب المثل والقيم العليا بمخدراته وتهتكه الأخلاقي، وإذا كانت تحديات التيك توك بين اثنين مجهولين يتشاتمان تحظى بملايين المشاهدات بينما لا يعرف أبناؤنا هيغل، وطوابير أجهزة شراء إصدار جديد من موبايل أطول من طوابير المسرح والسينما بعشرات الأضعاف، فلنستعد لعقد معقد أكثر من الذي نحن فيه ومرحلة قاسية من الاستبدال.

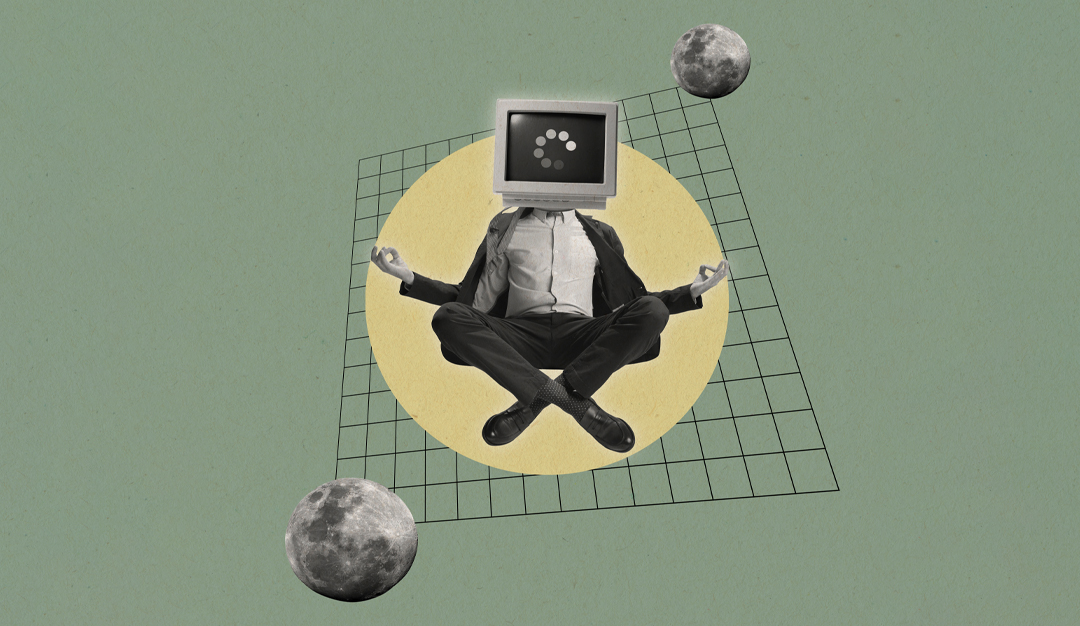











0 تعليق