ليست الأعمال الروائية اليمنية الجديدة نصوصًا صمّاء تفضي إلى أيديولوجيا محضة، كما أنها ليست رسالة تقتفي أثر الموعظة أو الإثارة أو السرد الدراماتيكي والتراجيدي للأحداث والوقائع الاجتماعية والتاريخية؛ بل هي مفهوم واسع يتجاوز مفهوم الواقعية بتشعباتها الاشتراكية والسحرية والفانتازية مفضيه إلى ما بعد الحداثة بحساسيتها الجديدة. ما يهمني هنا أن رواية «عقلان» لمحمد عبده الشجاع (صدرت في القاهرة عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر – بما يقارب 500 صفحة) تعد رواية إبستمولوجية تنحو باتجاه طرح الأسئلة المعرفية والفلسفية على ألسنة الشخصيات التي تعيش في منطقة رمادية، وقعت تحت تجاذبات الاشتراكيين في جنوب اليمن، والرأسماليين في شماله.
الواقع أن الرواية أثارت جدلًا متنوعًا؛ لما تحمله من قدرة على التشعب والاختزال في الوقت نفسه. تندرج رواية «عقلان» ضمن ما يمكن أن أسميه رواية ما بعد الحداثة التي لا تلتزم بالمعايير الجامدة، وتحتفي بلغة جزلة وعوالم مفتوحة وأبطال كثيرين متمردين على الواقع، يتحركون في مكان معلوم وزمان مفتوح على العديد من الأزمنة المقيدة بخيوط أعدها السارد مسبقًا؛ فثمة نسق ثقافي معتاد يقابله نسق يتوق إلى أفق جديد.
عتبة النص
تعد عتبة النص من أهم الركائز التي تتوازى مع المتن، معبرة عن كينونته المتماسكة. فالعتبة الروائية ليست ملحقًا بالنص، ولكنها باب وفضاء ومفتاح ومرآة لكل الاعتمالات التي يحملها الخطاب، وكثيرًا ما عدت مرآة جاذبة وبوابة فضائية في سماء النص، وكلما كانت رمزية العنوان أكثر حضورًا وثراءً جذبت القارئ وتركته مشدودًا إلى معرفة كلية النص. إن مشروعية النص في اكتماله تأخذ في الحسبان مشروعية أن تكون العتبة في وظيفتها ليست إشهارية، وإنما نسق دال يؤدي إلى تداولية الفكرة وعمقها. ومن العتبات أيضًا- توزع الرواية في فصلين هما: «عكاز في الظل، وأشتات فصول» إضافة إلى عديد من العناوين.
وقد أثار فضولي في النص ظهور شخصية عمر عقلان الذي يترك اسمُه عددًا من الإيحاءات، إضافة إلى أنه دخل إلى النص من أولى العتبات، ثم تلاشى في كل الانتقالات؛ ليظهر في نهايات الرواية كمن يغلق الباب، وفي تصوري أنه يشبه صاحب المنزل.
جاء عمر عقلان إلى القرية قادمًا من مدينة عدن، المستعمرة البريطانية التي تحررت حديثًا في الزمن السردي. جاء مكتنزًا خبرة نضالية عميقة اكتسبها من مقارعة الاستعمار، وفي القرية حدثته نفسه عن القيام بفعل ثوري -ضد السلطة التقليدية في شمال اليمن- شبيه بالذي صنعته المقاومة في عدن؛ «وحده عمر من تنبه دون غيره للفارق بين رعوي ومواطن محاولًا رفع الوعي لدى الجميع» ص14. وكاد عمر ينجح في أسر قلوب الناس وألبابهم بحكمته ومعارفه وصبره، ولكن العيون اتسعت من حوله وكادت تقتله لولا عودته إلى عدن؛ في إشارة إلى أن فعل التنوير يتلاشى دائمًا في بلادنا. وفي تجلٍّ محوري لرمزية العنوان، عقلان: يشير السارد إلى أن «الصراع بين عبدالفتاح ويوسف، صراع العقل والعقل الآخر» ص103.
حقبة غامضة عنيفة
يمكننا ببساطة وصف الجو العام في الرواية بأنه ملحمة شعبية بأدوات سردية جديدة، وهي ملحمة حقًّا إذ تدور أحداثها في المناطق الوسطى من اليمن لتغطية مرحلة ما بعد استقلال الجنوب، تلك الحقبة الغامضة العنيفة العاطفية من تاريخ اليمن، المرحلة التي ابتعدت منها الأقلام إلا ما ندر. وكما هيمنت أجواء الصدام الدامي على الحياة، فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك في سطور الرواية، من خلال الصراع بين الشخوص. وأهم الديناميات التي رفعت منسوب السرد في الرواية، الأحداث الدرامية والتراجيدية التي يبثها إعلام النظامين المتنافسين، وما رافق ذلك من نشوء شخصيات متناقضة تمجد النظريات والفلسفات والحوارات. يمكننا القول: إن الرواية وسط هذا الجو المضغوط قدمت شخصيات استثنائية، مستوحاة من إشكاليات الواقع المطروحة حتى اليوم. فشخصية عزيز مثلًا استخدمت السؤال والفلسفة، فيما ذهب الفقيه إلى إثارة الجدل وتعميقه، والأعمى الرائي رفع من شأن التجليات، أما الشيخ الشاب عماد الذي كان حضوره لافتًا في العملية السردية، الذي ورث والده كحلقة وصل بين الضحايا والبسطاء من جهة، وبين رموز النظام من جهة أخرى، قرر الرحيل حين «شعر بانفلات الهيبة وتقويض الأحلام وتتابع النوازل، والملمات، وتعالي همهمات الرعية». بهذا الوصف يمكننا فهم طبيعة الحياة يومها، ولكن ذلك قاد الشاب إلى مقاومة ما يحدث عبر الاصطفاف مع النظام.
يطفو على سطح الرواية كثير من الشخصيات الرفيعة في حضورها، ومن ذلك الطبيبة السويدية مارغريت التي تحاول الاقتراب من الناس وإصلاح ما يمكن بتكريس العلم والمعرفة، بعد أن كانت الوسائل التقليدية هي السائدة. من خلال العملية السردية سنرى أن ثمة شخصيات كثيرة ساهمت في تنامي الأحداث، وهي شخصيات ثرية تشير إلى أن العمل السردي لا يتحدث عن شخوص بعينهم، وإنما يقدم ملحمة شعبية.
شعرية اللغة
إن أهم ما يميز رواية «عقلان» تموضعها بين مقولة الفن مفيد بذاته، والفن من أجل الانسان، فهي رواية معبأة بكمية كبيرة من الشاعرية اللغوية. وهناك جانب ساحر في اختيار الشخصيات المتناقضة، وما تثيره من شاعرية في حواراتها وتنافسها وأحلامها وآمالها الرومانسية. وكل ذلك يشبه الواقع اليمني بحرفية إبداعية. فهذا عمر عقلان يظهر ويختفي بسرعة، مع أن وجوده، وفق الكيفية التي حددها تنامي العملية السردية، يضفي على الاستعارة اللغوية نمطًا خاصًّا في الحكي. وفي تصوري أن اختفاء صوته أفقد المفارقة السردية حيويتها القاموسية، «صوت يساري يقابل أصواتًا يمينية»، لكني أعود فأقول: إن ذلك يعكس تناقضات واقع الحال؛ لأن طبيعة الواقع لا تتحمل شخصية متمردة بأفق حداثي، كما هي متجسدة في عمر عقلان.
الرواية تصور ما حدث بالأمس، وتحذر من تكراره اليوم. وتبقى غاية الرواية تقديم رؤية جمالية مكتملة الأركان، مترفعة عن التقريرية والمباشرة، بملحمية جديدة بالغة الدقة. وهي لا تحتفي بالبطل الإشكالي الواحد؛ لأن المجتمع بتعدد أصواته وثقافته ومعارفه يقفز إلى السطح، فهناك مخزون بشري ضخم يريد التعبير عن وضعه الهوياتي والتاريخي. فعودة عمر عقلان في نهاية الرواية، يشير إلى أن الصدام السياسي والفكري والثقافي غير ثابت، وأن العلاقات الإنسانية تتعرض للنكوص والتقهقر، ولكنها تتشكل وفق منظور جديد.

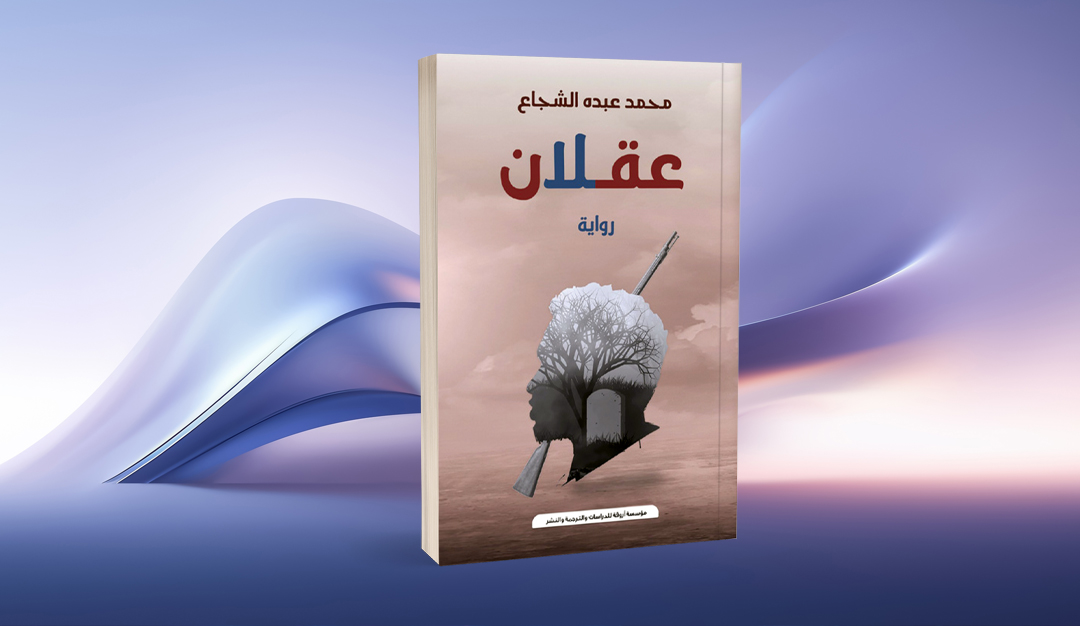








0 تعليق