للأمكنة، كلّ الأمكنة، روائح. وليس جديدًا، لا في الحياة ولا في الأدب، أن نستذكر وجوهًا وحالات تمتّ إلى ماضينا البعيد، من خلال روائح نبّهتنا صدفٌ عابرة إلى أنّنا لا نزال نحملها فينا. لكنْ إذا كانت القرى والأرياف تزخر بروائح طبيعيّة يقول الأطبّاء: إنّها مفيدة للصدر وللتنفّس، وربّما لأعضاء أخرى في الجسد ولوظائف أخرى، فإنّ المدن تطالعنا بنوع آخر من الروائح. فهنا، تتجاور النفايات الملوّثة والتلويث الصناعيّ، بما فيه ذاك الصادر عن اهتلاك الآلات القديمة، لتضعنا أمام نتائج يصعب وصفها بالصحّيّة أو بالنفع.
مع ذلك، وعلى رغم هذه المنغّصات جميعًا، فأنا منحاز بقوّة إلى العيش في المدن. فالروائح الطيّبة في القرى لا تستطيع أن تحلّ محلّ البشر الذين يندر وجودهم هناك. أمّا الروائح السيّئة في المدن فلا تحجب عنّا حيويّة تلك المدن وحركة البشر والأفكار التي تضجّ بها. وانحيازي هذا إلى المدينة هو ما جعل صديقي حسن يتّهمني بأنّني أسعى إلى «خراب بيته»: فهو يملك منزلًا جميلًا في الريف، إلّا أنّ إلحاحي على ضرورة أن يتخلّص منه ويشتري بيتًا في المدينة، وحرصه على استمرار صداقتنا، جعلاه يبحث عن أيّ مُشترٍ، حتّى لو دفع له ما يقلّ عن سعر البيت العادل.
على أيّة حال، بالغتْ بيروت في امتحان قدرتي على التحمّل، كما لو أنّني «العاشق الوحيد» الذي رثتْ حالَه أغنية محمّد عبدالوهاب الشهيرة.
فأنا أقمت في شطري بيروت، الغربيّ والشرقيّ، اللذين اكتسبا تسميتهما هاتين إبّان «حرب السنتين» في أواسط السبعينات، فانطوى كلّ منهما على معنى طائفيّ ودلالة سياسيّة معيّنين. والإقامة في الشطرين معًا لا تنمّ فحسب عن حبّ صاحبها لبيروت، بل هي في نظر كثيرين تعبير عن وطنيّة متعالية على الهوى الطائفيّ الضيّق.
لكنّ ما حصل لي لا يشجّع مُحبّي المدن كما لا يشجّع مُحبّي الأوطان. ففي الأشرفيّة، الواقعة في الشرق، اخترت شقّة في الطابق الأوّل من البناية. ولسوء الحظّ اكتشفت بعد الانتقال إليها أنّ هناك مصبغة تقيم تحتها في الطابق الأرضيّ. وحين تقال كلمة «مصبغة»، في هذا السياق، لا يكون المقصود فعل التنظيف بل فعل التوسيخ. ذاك أنّ الروائح الكيماويّة التي كانت تنبعث منها كانت تتجاوز توسيخ بيتنا إلى توسيخ صدورنا. وهي معضلة دائمة لا يخفّفها تحوّل الطقس وتغيّراته: فإذا هبّ علينا الهواء هبّت هذه الروائح معه قويّةً عاصفةً، وإذا انحبس الهواء واضطررنا إلى فتح الأبواب كنّا كمن يفتح ذراعيه لملاقاة هذه الرائحة اللئيمة.
وكنت أقول: إنّ الروائح الكيماويّة أسوأ من الروائح الطبيعيّة، ليس فقط لأنّها أكثر إضرارًا بالصحّة، بل أيضًا لأنّها أصعب على التعقّل والفهم، فضلًا عن كونها غير مألوفة نهائيًّا. وأذكر ذات مرّة أنّني قرأت مقالًا لواحد من عتاة البيئويّين بهذا المعنى، مستخلصًا أنّ الرأسماليّة الصناعيّة لن يهدأ لها بال قبل أن تودي بنا جميعًا إلى التهلكة. وأحيانًا، وفي محاولة منّي للتحايل على مأساتي، كنت أقول لنفسي: هذا طبيعيّ، وأولئك البيئويّون المتطرّفون هم كمن يطالبنا بألّا نأكل كي لا نُضطرّ إلى دخول بيت الخلاء. لكنّني لا ألبث أن أتذكّر أنّ الأمور عندنا ليست على هذا النحو بتاتًا. فنحن في بلد كلبنان، إنّما نحصد التلوّث من دون أن نجني أفضال الصناعة، بحيث يقتصر أمر «تقدّمنا» على تنظيف بعض القمصان والسترات لزبائن المصبغة!
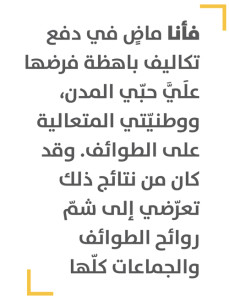 بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.
بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.
لكن المشكلة تكمن بالضبط هنا. فالطبيعة لا تمنحنا الشمس فحسب، بل تمنحنا أيضًا رائحة المجارير التي تهبّ علينا بين فينة وأخرى هبوبًا ساحقًا ماحقًا، وإن كان لا يدوم طويلًا. ولا بدّ أنّ الأمر الكريه هذا ناشىء عن فساد البنى التحتيّة التي لم تُجدّد بما يجعلها تواكب التحوّلات السكّانيّة وحاجاتها المتعاظمة. ولربّما زاد في تفاقم المشكلة ما عُرف به لبنان مؤخّرًا لجهة عجزه عن جمع نفاياته وتصريفها، أو إعادة تدويرها بشكل مفيد.
وكائنًا ما كان الدور الذي اضطلعت به المعالجات السياسيّة والاقتصاديّة السيّئة، يبقى أنّ روائح المجارير طبيعيّة جدًّا، وأكاد أقول: إنّها جزء لا يتجزأ من ثقافة شعب بعينه ومن تعاطيه مع مألوفاته وما هو حميم فيه. ولست هنا بحاجة إلى الاستشهاد بعلم النفس، خصوصًا علم نفس الأطفال ممّن لا يكتمون تعلّقهم بأسوأ ما تفرزه أجسادهم.
لكنْ لا هذا يحلّ المشكلة ولا ذاك. فأنا ماضٍ في دفع الأكلاف الباهظة التي رتّبها عليّ حبّي للمدن، ومعه وطنيّتي المتعالية على الطوائف. وقد كان من نتائج ذلك تعرّضي لشمّ روائح الطوائف والجماعات كلّها التي تقيم في المدينة، بالصناعيّ منها وما قبل الصناعيّ.
لهذا، ومن دون أن أقرّ علنًا بذلك، أضبط نفسي أحيانًا مُوافقًا صديقي الشابّ ماهرًا أفكاره. فماهر قرّر، قبل سنوات عدّة، أن يلوذ بالقرية، وأن يعتبرها حصنًا يعتصم به أمام زحف المدينة المتعاظم. فإذا ما اضطرّه ظرف بالغ الاستثنائيّة أن يفد إلى بيروت، عامل نفسه كأنّه أسير حرب لا يحظى بحرّيّته إلّا حين يقفل راجعًا إلى القرية.
والمؤكّد أنّ رئتي ماهر أنظف ألف مرّة من رئتيّ. لكنّني مُصرّ على ألّا أقول هذا الكلام، لا لحسن ولا لماهر، وأن أمضي متنقّلًا بين طوائف مدينتي وروائحها.







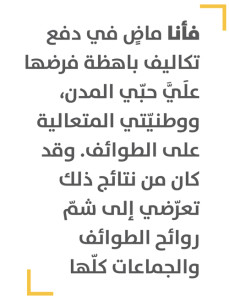 بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.
بيد أنّني حين انتقلت إلى منطقة الحمرا، في الشطر الغربيّ من العاصمة، بدأت، لسبب آخر، أعيد النظر بتلك الأفكار البالغة العداء للروائح الكيماويّة. فهنا وقعت على شقّة لطيفة في حيّ بالغ الحيويّة لا تبارحه الحركة ليلًا ولا نهارًا. فوق هذا، تحتلّ الشقّة الجديدة الطابق الخامس من البناية، نائيةً بنفسها عن الموبقات التي قد تأتي من الطريق العامّ وجلبته. وهي أيضًا شديدة التعرّض للضوء الذي يكاد ينفجر فيها انفجارًا؛ لأنّ فجوات عمرانيّة واسعة تحيط بها، وهذا ما تزداد ندرته في بيروت التي نكاد لا نرى سماءها؛ بسبب المباني الشاهقة المتكاثرة.


0 تعليق