 تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.
تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.
وهي علاقة تحفزنا إلى أنْ نسأل سؤاليْنِ: أوّلهما سؤالُنا عن إمكانية تخلِّي هاتيْنِ الفعاليتيْن الإنسانيتيْنِ عمّا كان ينتظم تاريخَهما من مواجهات ظلَّت خلالها كلُّ واحدة منهما تُناقض الأُخرى، وتمكر بها مكرًا؟ وثانيهما سؤالُنا عن وجاهة البحث عن شكلٍ من الوجود جديدٍ لكلِّ من الثقافيّ والسياسيّ مما يسمح للواحد منهما بأن يعضد جهدَ الآخر، ويحرسه مِن غُلَوائه، ويحميه من حالات ركوده وضعفه؟ وفي محاولة منا للإجابة عن هذيْنِ السؤاليْنِ سنلوذ بالحالة التونسية بعد انتفاضة يناير 2011م عيِّنةً نبحث من خلالها عن ملامح التدبير الثقافيّ والسياسيّ الذي حدّ من تزايد الفوضى الاجتماعية من جهة، وساهم من جهة ثانية في سِلْمية التجربة الثورية التونسية، وفي حصول البلاد على جائزة نوبل في السلام.
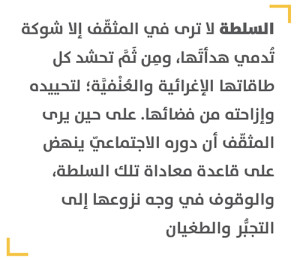 لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها.
لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها.
وما ينبئ به تاريخ الدولة الوطنية العربية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الآن هو استمرار تلك العلاقة بين الثقافة والسياسة، واتّكاء أنظمة الحُكم فيها على مقولات «محاربة الفتنة الداخلية» و«مشروع بناء الدولة الفتيَّة» و«مصلحة الحزب فوق مصلحة الجميع»، واعتمادُها بُعبُعًا تُخيف به كلَّ مَن يَروم معارضَتها أو نقدَها من المثقّفين.
وقد نستفيد في فهم ذلك مِن رأي ابن خلدون القائل: «السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة، يستعين بهما على أمره، إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم، أشد من الحاجة إلى صاحب القلم؛ لأن القلم في تلك الحال خادم فقط منفّذ للحكم السلطانيّ».
ومتى فاق احتياج الدولة إلى السيف احتياجَها إلى القلم أثَّر ذلك في طبيعة علاقة السلطة بالثقافة؛ وتفصيل ذلك أن السلطة لا ترى في المثقّف إلا شوكة تُدمي هدأتَها، ومن ثمة تراها لا تني تحشد كلّ طاقاتها الإغرائية والعُنْفيَّة لتحييده وإزاحته من فضائها، على حين يرى المثقّف أن دوره الاجتماعيّ ينهض على قاعدة معاداة تلك السلطة والوقوف في وجه نزوعها إلى التجبُّر والطغيان، فإذا هو يحشد كل طاقاته الإبداعية لتكون سبيله إلى كشف حقيقتها الاستبدادية أمام مجموعته الاجتماعية.

المثقفون والجنون والتشرُّد
على مدار هذه العلاقة الصدامية سالت دماءُ كثيرٍ من المثقّفين، ودُفع بعضُهم الآخرُ إلى الجنون أو التشرُّد أو الهجرة أو المكوث في ظلمة السجون. وعلى مدار هذه العلاقة -أيضًا- اقتنعت السلطة بمدى تأثير المثقّف في الجمهور، فحرصت على تدجينه بجميع الوسائل المتاحة لها، سواء أكان من خلال استقطابه إلى صفّها وإفراغه من جذوة قول الحقيقة، أم عبر التنكيل به متى رفض الانصياع لها، متمثِّلة في ذلك تاريخَ علاقة أنظمة الحكم العربية مع مبدعيها ومثقّفيها الذين خالفوا سياساتها في تدبير شؤون الرعايا، ورفضوا تحكّمها في آرائهم ومعتقداتهم؛ إذ جرى الإجهاز على الجهم بن صفوان، والجعد بن درهم، والحلَّاج، وغيلان القدري، ومحمد بن سعيد المصلوب، والسهرورديّ، وبشار بن بُرد الذي «وشى به بعض من يُبغضه إلى المهديِّ بأنه يدين بدين الخوارج، فقتله المهديُّ. وقيل: بل قيل للمهديّ: إنه يهجوك. فقتله»، وغير هؤلاء كُثُر.
ولعلّ في مقتل هؤلاء المبدعين ما يعني أن كثرة من الأنظمة الحاكمة واعيةٌ بقُدرة المثقّف على الدفاع عن الحقّ، وكشف الباطل السياسيّ؛ لما لديه من قدرة على الغوص في أعماق الوقائع الحياتية، وتعرية تفاصيلِها، والتعبير عن قضايا المضطهَدين، وحفزهم إلى أن يتخلّصوا من الجور والظلم والاستبداد، وبِنَاءً عليه فإنه عندما استتبّ الأمن للدولة الوطنية سَعَتْ إلى استقطاب المثقّفين، وصار «أرباب القلم في هذه الحالة أوسع جاهًا، وأعلى مرتبةً، وأكثر نعمةً وثروةً، وأقرب إلى السلطان مجلسًا، وأكثر إليه ترددًا؛ لأنهم حينئذ آلته التي بها يستظهر على تحصيل ملكه، والنظر إلى أعطافه، وتثقيف أصرافه، والمباهاة بأحواله» وفق ما يرى ابن خلدون، ونجد له تمثيلًا في الوضع الثقافيّ التونسيّ قبل عام 2011م؛ إذ يجوز لنا القول: إن الثقافة في تونس لم تتصف بصفة «الرأسمال الجماعيّ» على حدّ تعبير بيير بورديو على طول المدة الممتدَّة من بداية الاستقلال إلى نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة، بل إنها لم تمثّل للفردِ الاجتماعيّ خلفيةً جماليةً وقِيَمية يتَّكئ عليها في تواصله مع ماضيه وحاضره، ويَمْتح منها رَواءَ إبداعاته، إنما ظلَّت فعلًا تُهيمِن عليه السُّلطة السياسية، وتلوّنه بألوانها، وتتحكّم في مُخْرَجاته جميعها بتوجيهها وجهاتٍ خادمةً لمصالحها؛ مديحًا لها وهجاءً لمعارضيها.
.
اختراق المثقفين وتأليب بعضهم على بعض
نجحت السلطة التونسية في عَهْدَيْ بورقيبة وبن علي في اختراق مثقّفي البلاد، وفرض «ثقافتها» عليهم؛ عبر تأليب بعضهم على بعضٍ، ضمن لُعبةٍ أجادت رسمَ قوانينها، فجعلت كلّ واحد من الفريقيْنِ يستنفد طاقته في التشهير بالفريق الآخر وإقصائه، بل في أكْل لَحمِه نيئًا؛ ومن ثَمَّ أغرقتهم في عداوات مجَّانية، وأَلْهَتْهم بمعارك بَيْنيَّة واهية عن القيام بأدوارهم التاريخية، فارتاحت هي من (وجع الرأس)، وخسر الفعل الثقافيّ التونسيّ كلَّ جَدْواه: صفاء أهدافه ووجاهة مضامينه. غير أنّ تلك الحال الثقافية التونسية ستشهد تحوُّلًا في علاقتها بالسياسة بُعَيْدَ انتفاضة يناير 2011م؛ لأنَّ النار التي أشعلها البوعزيزي لم تكتفِ بحرق جسده فحسب، إنّما أحرقت كلّ منظومات السلطة وأعوانها، ومثّلت حدثًا تطهُّريًّا صفّى العقل الجَمْعيّ من كلِّ شوائب مألوف تصوُّره عن الدولة والوطن والإنسان والقيم؛ إذ تكشّف للناس ولنخبهم المثقّفة والسياسية أنهم مقبلون على زمن جديد هم مسؤولون مباشرة عن رسم ملامحه، وبناء صروح نهوضه الحضاريّ.
.
مكر سياسيّ
ولا نرى في الشعارات الثقافية التي رفعتها السلطة التونسية على غرار شعار «لا لتهميش الثقافة ولا لثقافة التهميش» إلَّا مكرًا سياسيًّا يُخفي طيَّه نقيضَ ما يدعو إليه. وصورة ذلك حرصها على السيطرة على الفعل الثقافيّ، وجعله آلةً من آلات الحكم من خلال تصنيع «مثقّفيها»، ومنحهم امتيازاتٍ ماديةً ومعنويةً كثيرةً؛ كي يصيروا شوكتها لمحاربة ما شذّ عن قطيعها من مثقّفين مُعارِضين.


بن علي
ومن ثَمَّ تَوَزَّع المثقّفون فئتيْنِ: أمَّا الفئة الأولى فكثيرة، وتضمّ كُتَّابًا وإعلاميّين وجامعيّين وفنّانين لاذ أغلبهم –وهم من ضعيفي المنجَز الإبداعيّ- بمهاراتهم في فنون الانتهازية والتمسُّح على الأعتاب والدّوس على الضمير، وركبوا مركب السلطة؛ ليكونوا عيونَها التي لا تنام، وأقلامَها التي تكتب ما يُخفي صمتُ الناسِ من أحلام، وألسنتَها التي تُجمِّل لها أخطاءَها داخليًّا وخارجيًّا، وتسوغ لها عنفَها، وتُثني عليها بجميل الكلام، وأغلب هؤلاء صحافيون تونسيّون وأجانب، ومنتسبون إلى اتحاد الكُتَّاب في أثناء رئاسة كلّ من العروسي المطوي والميداني بن صالح، ومنهم مُهرِّجون مسرحيون، ومُغنُّون بلا أصوات طربية، وفئة «أبناء فرنسا» من المثقّفين البراغماتيّين. وأما الفئة الثانية فقليلة، وتضمّ مثقّفين يعيشون على الهامش، لا يلتفت إليهم الإعلام الرسميّ، ولا مؤسّسات الثقافة الحاكمة، ولهم طاقة على تحمّل أذى السلطة لهم، وتنامي تحرّشها بهم، ولا يملكون إلا إبداعاتهم ينافحون بها عن مطالب العامّة في الحرية والعدل والكرامة، ومن هؤلاء نذكر الشعراء أولاد أحمد وبلقاسم اليعقوبي والطاهر الهمامي، ونفر من الكتّاب والإعلاميّين التحرُّريّين؛ أمثال: ابن بريك والهاشمي الطرودي ونزيهة رجيبة.
وعلى كثرة ما قيل حول عدم مشاركة المثقّف التونسيّ في الانتفاضة الشعبية، فإنه لا يمكن الإقرار به توصيفًا صادقًا لمدى حضور هذا الأخير في أحداث تلك الانتفاضة؛ إذ لا نعدمُ هبّةَ كثرة كثيرة من المثقّفين وجاهزيتهم لنصرة حَراكِ المواطنين سواء بالمشاركة الفعلية في المظاهرات أم الاعتصامات أم بالاتكاء عليها خلفيّة إبداعية لنصوص شعرية وروائية، أم بالكتابة الحماسية عنها في الصحف المحلية والعالمية.

نزيهة رجيبة
والرأي عندنا أنّ رحيل (بن علي) وسيطرة الشعب على الشارع أمران جعلَا مثقّفي تونس وسياسيّيها يقفون على حقيقة أن تونس لم تعد تحتمل وجود حزب واحد، وزعيم واحد، ورأي واحد، وأنّها عادت إلى كلِّ أبنائها سواء منهم مَن كانوا مع السلطة المنهارة أم مَن كانوا ضدّها، وأنها دخلت مرحلة تاريخية جديدة تتطلّب تعاضد كلّ الجهود لتتجاوز ما ظهر فيها من صعوبات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية. وهو أمر عجّل بتوفير أسباب التقارب بين الفعل السياسيّ والفعل الثقافيّ واشتراكهما في أداء مهمّة واحدة تنعقد حول كيفية حماية البلاد من الفوضى التي راحت تعمّ كلّ مناحي الحياة فيها.
وتحت ضغط الخوف من انجرار البلاد إلى أزمة كبرى نَسِي المثقّفون والسياسيّون صراعاتهم القديمة؛ حتى حينٍ، وانتظموا داخل جمعيات ثقافية مدنية انصبّ اهتمامها على الخروج بفعلها التثويريّ من دائرة المركز والذهاب إلى المواطن، حيث يوجد في الشارع أو في الأرياف أو في المدارس، والتعبير عن هواجسه بجرأة رافضة كلّ وصاية فنية، وكلّ خضوع للمثال والنموذج، ومن أبرز تلك الجمعيات المدنية: اتحاد الشغل، وعمادة المحامين، واتحاد الأعراف، ورابطة الكتاب الأحرار، وحركة نصّ، وجمعية الصحافيين، وبعض الفرق الموسيقية الملتزمة على غرار «مجموعة البحث الموسيقي»، إضافة إلى فن الغرافيتيّ مع مجموعة «أهل الكهف»، وفن المسرح مع حركة «فنّي رغمًا عنّي».

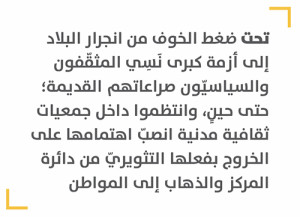 من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة
من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة
لقد تكفّلت هذه الجمعيات بتنبيه الجماهير إلى صعوبة المرحلة وضرورة نحت مستقبلها بأيديها، والتحوّل من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة، ومن سياسة فوقية الفرد إلى سياسة عُلوية الجماعة، وراحت تشحن الناس بكلّ قيم الحرية والعدل والكرامة والتسامح والمصالحة الوطنية والعيش معًا. وهي قيم كانت للمجتمع التونسيّ معالمَ طريقه إلى الوجود الجماعيّ الحرّ، وسبيله السالكة إلى تحيين تصوّراته الثقافية والسياسية تحيينًا يضمن الاختلاف فيها، ولا يبلغ الخلاف حولها، فتحوّلت الثقافة من فعل تخييليّ إلى فعل واقعيّ، واستأنست السياسة بالفعل التخييليّ في تصريف شؤون الواقع، ومن ثَمَّ لم يَعُد وجيهًا الفصلُ التقليديُّ بين «الثقافة» و«السياسة»، بل تحوَّلَتا معًا إلى حاضنة مخصبة لشروط العيش معًا، ويبدو أن اصطفاف الثقافة والسياسة في خطّ وطنيّ واحد، وتكفّل الواحدة منهما بنقد الأخرى، ومساعدتها في عدم النكوص على عقبيها، والعودة إلى زمن الإقصاء، وتمجيد الرأي الواحد هو ما مثّل حالة تونسية لم نَرَ لها شبيهًا في بعض الأقطار العربية، التي شهدت انتفاضات وطنية في السنوات الماضية.







 تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.
تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار. 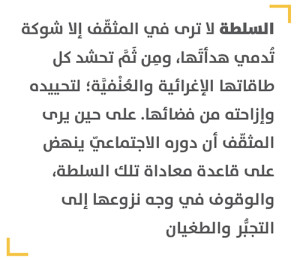 لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها
لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها




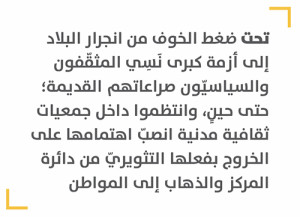 من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة
من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة 


0 تعليق