
زمزي بعلبكي
هذا الكتاب هو مجموع مقالاتٍ كتبها الدكتور رمزي البعلبكي خلال مسيرته العلمية الحافلة بالإنتاج. كل مقالةٍ تُعالج موضوعًا مستقلًّا، ونُشرت في مكان وزمان منفصلين، وكان الدكتور بلال الأرفه لي رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الأميركية ببيروت، قد جمعها في سفر واحد، وتعاهدها بالتحرير والتنقيح، ثم نشرها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ومن خلال عنوان الكتاب ومطالعته يتبين أنها مقالات متنوعة بين اللغة والمعجم والنظرية النحوية والساميات. تشهد هذه المقالات بغزارة معرفة الباحث، وعلو كعبه، وطول باعه فيما كتب.
ولعل عنوان الكتاب الذي أُدرجت تحته هذه المقالات وهو «العربية هذه اللغة الشريفة» يستحق أن نقف عنده هنيهة، وخصوصًا عند الصفة التي ألبسها الباحثُ هذه اللغةَ وهي «الشريفة». يذكر الباحث في مقالته عن نظرية الشدياق أنّ ابن جني هو من أطلق هذه الصفة على العربية، ثم أخذها الباحث عن استلهام من عبارة ابن جني؛ يقول ابن جني: «وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة، الكريمة اللطيفة، وجدت فيها من الحكمة والدقة، والإرهاف والرقة، ما يملك عليَّ جانب الفكر…». ومن الواضح أنّ ابن جني خلع على هذه اللغة صفات كثيرة، بيد أن الباحث وقع اختياره على هذه الصفة، التي جاءت في «حاقّ موضعها» كما يقول عبدالقاهر الجرجاني، ولو أنك أخذت صفة الكريمة مثلًا أو اللطيفة، لما وقعت موقع «الشريفة» ولبقيت قَلِقة مضطربة، وغير متمكِّنة في موضعها. ولنا أن نتساءل بعد ذلك: ماذا يقصدان -ابن جني ومِن ورائِه الباحثُ- بهذه الصفة؟ أهو التشريف الديني؟ بحيث أنّ الله شرَّفها وأنزل كلامه بها، وجعلها لغة الدين الخاتم، ثم تحدَّى بها العرب أولي الفصاحة والبيان واللَّسَن، أم أنها تتميز بخصائص لغوية، ومزايا صرفية، حافظت عليها من دون أخواتها الساميات، ثم نزل بها كلام الله، فازدادت شرفًا على شرف؟!
أقول: لعل الاحتمال الثاني هو الأقرب لمقصد الرجلين؛ لأنّ كليهما ألمح إلى نظرته حول هذه القضية؛ أما ابن جني فقد أوضح في المقالة نفسها أنّ مميز العربية هو النظام اللغوي الدقيق، والحكمة الكامنة في استعمال كل تركيب بعينه، وأما الدكتور البعلبكي فيذكر في مقالته التي يتحدث فيها عن منزلة العربية بين الساميات، أنّ المنهج المرتضى في الحكم على تميز لغة في أي جانب إنما هو المنهج اللغوي الذي يستند إلى ثوابت من صُلب اللغة، لا من شيء خارج عنها، ثم يذكر بعد ذلك أنّ العربية تفرَّدت بين أخواتها الساميات بكثير من المزايا التي تُنسب للغة السامية الأم.
يسلط الباحث الضوء على الواقع المتعثِّر لتعليم العربية في المؤسسات الأكاديمية، وإعراض الطلاب عن تعلُّم لغتهم الأم، وإتقانها على مستوى جيد، ولا سيما علم النحو، فهو أكثر علوم العربية تجريدًا، فلذا كانت الجفوة بينه وبين متعلمي العربية كبيرة. ويعزو الباحث هذه الجفوة إلى تركيز النحويين على مسألة التعليل في إطلاق أحكامهم النحوية، في حين أنّ التعليل يغير المنهج من الوصفية إلى المعيارية، الذي كان على النحاة أن يتجنبوه، ويكتفوا بوصف الظواهر. وفي ختام المقالة يذكر توصياتٍ للتحسين من واقع العربية المتردي في أوساط المتعلمين، فيدعو إلى تخليص النحو من شائبة «التعليل»؛ لأنها تنفِّر الطلبة من لغتهم، والتوجه نحو اعتماد المعنى بديلًا عن التعليل، كما فعل البلاغيون؛ لأن الغرض الذي وضع من أجله علم النحو هو دراسة المعنى من جوانبه كافة، هذا بالإضافة إلى التخفف من وطأة القيود التي وضعها النحاة، كـ«عصور الاستشهاد» أو «الوجه الضعيف». ومما يُستحسن لدارس العربية أيضًا أن يتعلم لغة سامية إلى جانب العربية؛ لإدراك الظواهر اللغوية بشكل أعمق وفي إطار تاريخي مقارن.
العربية في جمعية الأمم
ويُعالج الباحث أهم الاعتراضات التي وُجِّهت إلى اللغة العربية إبّان الجدال الدائر في جمعية الأمم المتحدة حول قبول اللغة العربية في الجمعية وجعلها لغة رسمية، وكان الاعتراض آنذاك هو أن العربية تنتمي إلى القرون الوسطى، ولا تصلح أن تكون لغة حداثة، أو تواصل في المنتديات الدولية. فرأى أن العربية فيها من المرونة ما يسمح أن يُطوع أساليب جديدة تستجيب لمقتضيات التخاطب السياسي والدبلوماسي، ففي معظم الوثائق الدبلوماسية العربية قد لا يعرف القارئ إن كان النص كُتب بالعربية من أصله أو تُرجم إليها، بل إن العربية قد استخدمت من المصطلحات الدبلوماسية ما يصعب ترجمته بكامل دلالته إلى لغة أجنبية؛ مثل: جلالة ودولة ورفعة وغبطة وسعادة وسمو ومعالي وعزة وعصمة. ولقد كان الباحث موضوعيًّا عندما رأى في ختام مقالته أنه لا بد من نقد ذواتنا العربية، علاوة عن الذَّبِّ عن لغتنا، فهل ذلَّلنا سُبُل الانطلاق للغتنا حتى في مجتمعاتنا، وهل وفَّرنا لها وسائل التصدي لخطر اللغات الأجنبية؟ فنحن نقدم للعالم ومنظماته صورة غير موحدة عن لغتنا. وهل لدينا واقع مصطلحي موحَّد؟
يجزم الباحث في مقالته عن التقعيد النحوي بأنّ نشأة النحو العربي كانت نشأة عربيةً خالصة، وهو ابن بيئته، وذلك لسببين:
أولهما- أنَّ المصطلحات في كتاب سيبويه كانت في طور الولادة، فقد يُعبِّر سيبويه عن المصطلح بجملة كاملة، وهذا دليل على أنها محلية النشأة، وليستُ مقتبسةً من نحو أمة أخرى.
ثانيهما- أنّ المُتأمل كتاب سيبويه يرى ترابطًا منهجيًّا، يجعله يُسلِّم بوجود خطة في ذهن سيبويه تقوم على تحليل التراكيب النحوية العربية بشكل دقيق، ولا يستقيم في المنطق أن يكون ذلك كله لنظام مُقترض من لغة أخرى، وطبقه على العربية. ولا ينكر الباحث ظهور الأثر اليوناني في دراسة النحو العربي وغيره من العلوم العربية، من حيث تناول الأشياء وتحليلها، وهذا أمر مستقلّ تمامًا عن مرحلة النشأة.
القسم الثالث من الكتاب يضم مقالات في التأليف المعجمي، يستهلّه الباحث بمقالة عن نظرية الشدياق الاشتقاقية، وهي نظرية جديدة، تقوم على الثنائية اللغوية، مُغايرة للنظرية المعجمية الثلاثية السابقة، التي بنى عليها المعجميون العرب معجماتهم. لقد كان الباحث موضوعيًّا حين سرد في البداية إطراء مارون عبود على نظرية الشدياق الذي جعل كفة معاجم اللغة كلها تشول إذا ما وُزنت بسر الليال للشدياق. ثم بعد ذلك وضعها على ميزان النقد ليرى هل يمكن عدها نظرية ثابتة، وخطوة جديدة في مجال المعجم، ليتبيَّن له في نهاية المطاف «أن نظرية الشدياق الاشتقاقية قائمة في جوهرها على الافتراض، وفي تطبيقها على التعسف، وإن كان فيها ومضات خلَّاقة، وملاحظ صائبة، وجهد دائب في التقصي والمقارنة والنفاذ من الجزئيات إلى الخطوط العامة الكبيرة» ومما يوجهه إلى تلك النظرية من سهام النقد هي أن المعاني التي يُرجع إليها الأصول الثنائية قليلة جدًّا، ولا يمكن أن تقوم عليها لغة متكاملة، وأن معظم التأويلات التي يذكرها الشدياق لا تخلو من التكلف أو التمحل. ثم إن الباحث في نقده لنظرية الشدياق لا يبخسه حقًّا، ولا يغمطه فضلًا، بل يُشيد بجهده، ويُقرّ بنصيبها من الصحة في بعض الجوانب، بيد أنه يرى أنها لا يمكن أن تكون نظرية راسخة ثابتة.

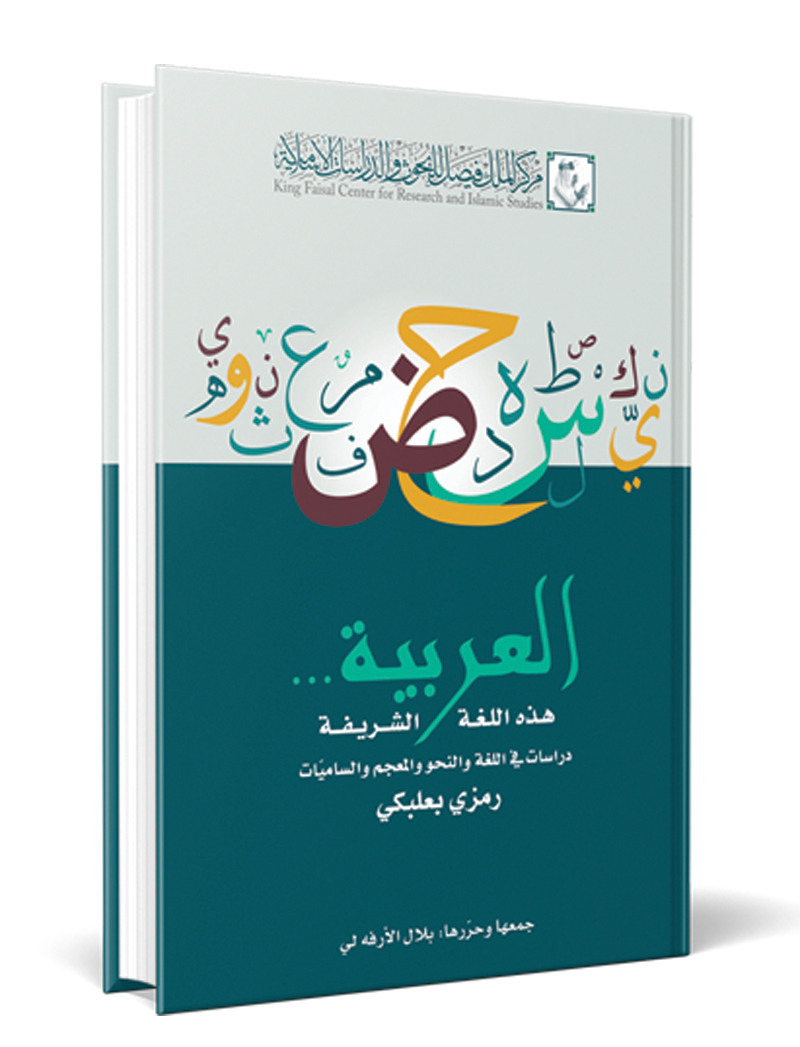









0 تعليق