أدباء في الظل.. هل لعبت الميديا دورًا في تكريس كتّاب وتهميش آخرين؟
الفيصل | مايو 2, 2017 | تحقيقات, قضايا
يقال إن أبا نواس التقى ذات يوم شاعرًا نظم بيتًا جيدًا في الخمر، فلما سمعه منه أبو نواس استحسنه، وبعد أيام التقاه في مجلس الأمير، وكان أبو نواس مقدَّمًا على جميع الشعراء، فأنشأ قصيدة تضمنت بيت صاحبه، فلما استنكر الرجل ذلك، نظر إليه الأخير قائلًا: أيعقل أن يقال بيت جيد في الخمر ولا يكون لي؟ يقال أيضًا: إن المنافسة بين عميد الأدب العربي طه حسين وخصمه الدائم الدكاترة زكي مبارك دفعت العميد إلى استخدام سلطاته لمنع غريمه من التدريس في الجامعة، مما دفع الأخير لأن يطبع كروت تعارف كتب عليها: «الدكاترة زكي مبارك، حاصل على عالِميَّة الأزهر، ولم يحصل عليها طه حسين».
ربما تجيء هذه الطُّرَف في إطار الفكاهة التي تنسب إلى الخصوم، لكنها توضح أن تاريخ الأدب العربي عُرِف من مظلومي الأدب أكثر من مشاهيره، فلكل عصر عبقريّ حسبما قال رجاء النقاش في إحدى مقالاته في الستينيات عن نجيب محفوظ، لكن هذا العبقري كي تتحقق عبقريته وحده فإنه بوعي أولًا وعي منه يحجب الضوء عن الكثيرين، ويفقد الأدب كثيرًا من كُتَّابه المهمين، لا لشيء سوى أنهم ولدوا في عصر كاتب أو شاعر شهير، أو لأنهم لم يفطنوا إلى دولاب الألعاب السحرية للميديا في زمانهم، فلم يستطيعوا الترويج لكتاباتهم، ولم يتمكنوا من التواصل مع الجماهير الغفيرة، وربما مات بعضهم مغبونًا بمظلوميته دون أن ينال اعتراف النقاد بكتاباته، مما يجعلنا نقول: «ياما في الأدب مظاليم»، تلك المقولة التي عبَّر عنها العرب قديمًا بقولهم: «وأدركته حرفة الأدب»، بما تعنيه من تعب وكدّ لأجل مجدٍ لا يجيء.
«الفيصل» تساءلت: مَن هؤلاء الأدباء الذين عاشوا في الظل، ولماذا؟ وهل ما زال الظلم مستمرًّا رغم ما أتاحته ثورة الميديا الجديدة من تقنيات وقدرات للجميع، أم أنه لا مظلومين في الأدب، وكلٌّ يأخذ نصيبه من المجد والشهرة حسب قدر موهبته؟
رؤوف مسعد: التاريخ غبن لويس عوض وسلامة موسى
 أعتقد أن الإحساس بالمظلومية عند المبدعين المصريين هو إحساس صادق وصائب لعدة أسباب تتعلق بحالة الفساد المتفشية «كطريقة حياة» في المجتمع المصري بكل طبقاته، وهو فساد موروث من عصر الفراعنة (ارجع إلى شكاوى الفلاح الفصيح) والسؤال هو: لماذا لم ينتبه الناس إلى عدد لا بأس به من الكُتَّاب المهمين الذين ظهروا في عصر الأقمار الساطعة والشموس المضيئة مثل محفوظ وإدريس..إلخ؟ السبب الأول هو أن المسيطرين على الميديا والموجهين لها ثقافتهم في الأصل بسيطة ومحدودة.. لنرجع إلى ذلك الزمن.. زمن محفوظ وإدريس، من المسؤولون الأساسيون عن الميديا في ذلك الوقت؟ هم ضباط جيش حصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة، ووجدوا أنفسهم في قمة الهرم الإداري، ويسيطرون على مُقَدَّرات عشرات ومئات من المثقفين المصريين، أما عن عصر طه حسين وما يحيط به، فكان من العصور المضطربة في تاريخ مصر الحديث.. فهو عصر كان يسمح لقرويٍّ أعمى أن يذهب إلى السوربون بعد أن كان كل مراد أهله أن يحفظ القرآن، ويتّخذ منه صنعة تغنيه عن سؤال اللئيم، بوصفه كان معوقًا جسديًّا. ذلك هو العصر الذهبي للنهضة الثقافية برعاية دولة الباشوات الإقطاعيين… وها هو طه حسين والعقاد وسلامة موسى والرافعي والطهطاوي ومن سبقهم ومن التحق بهم من أجيال يحرسون الأرض تمهيدًا لظهور لويس عوض «كمفكر» مع زملائه الآخرين، ثم ظهور نجيب محفوظ ويوسف إدريس.
أعتقد أن الإحساس بالمظلومية عند المبدعين المصريين هو إحساس صادق وصائب لعدة أسباب تتعلق بحالة الفساد المتفشية «كطريقة حياة» في المجتمع المصري بكل طبقاته، وهو فساد موروث من عصر الفراعنة (ارجع إلى شكاوى الفلاح الفصيح) والسؤال هو: لماذا لم ينتبه الناس إلى عدد لا بأس به من الكُتَّاب المهمين الذين ظهروا في عصر الأقمار الساطعة والشموس المضيئة مثل محفوظ وإدريس..إلخ؟ السبب الأول هو أن المسيطرين على الميديا والموجهين لها ثقافتهم في الأصل بسيطة ومحدودة.. لنرجع إلى ذلك الزمن.. زمن محفوظ وإدريس، من المسؤولون الأساسيون عن الميديا في ذلك الوقت؟ هم ضباط جيش حصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة، ووجدوا أنفسهم في قمة الهرم الإداري، ويسيطرون على مُقَدَّرات عشرات ومئات من المثقفين المصريين، أما عن عصر طه حسين وما يحيط به، فكان من العصور المضطربة في تاريخ مصر الحديث.. فهو عصر كان يسمح لقرويٍّ أعمى أن يذهب إلى السوربون بعد أن كان كل مراد أهله أن يحفظ القرآن، ويتّخذ منه صنعة تغنيه عن سؤال اللئيم، بوصفه كان معوقًا جسديًّا. ذلك هو العصر الذهبي للنهضة الثقافية برعاية دولة الباشوات الإقطاعيين… وها هو طه حسين والعقاد وسلامة موسى والرافعي والطهطاوي ومن سبقهم ومن التحق بهم من أجيال يحرسون الأرض تمهيدًا لظهور لويس عوض «كمفكر» مع زملائه الآخرين، ثم ظهور نجيب محفوظ ويوسف إدريس.
بالطبع يستحق العميد ومحفوظ وإدريس ما نالوه من شهرة، فطه حسين كان أول من فكر في اختراق التابوهات الدينية المسلَّم بها في دراساته التي أشهرها «في الشعر الجاهلي»، ثم محفوظ الذي استطاع بدأبه، رغم موهبته المحدودة، أن يتسلّق السلم الأكبر، سلم الصحافة، فموهبة محفوظ محدودة في الخيال الأدبي والإبداعي لكنها غير محدودة في التأمل واقتناص الأفكار والقدرة على صياغتها بأسلوب بسيط وروائي؛ لذا تجد أكثر أعماله تأثيرًا في القُرَّاء (النخبة) هي التي تناقش فكرة القدر والسماوات والوجود وموضع الإنسان في النظام الكوني وبالتالي الظلم المجتمعي.
أما يوسف إدريس فكان أكثر جموحًا وقوة وانطلاقًا؛ لذا أبدع لنا قصصه القصار النادّة في روعتها، ومسرحياته الغريبة المتأملة لحال البشر، ورواياته القادرة على الأخذ بتلابيبنا وأنفاسنا، وشخصياته الجامحة نفسيًّا وقدريًّا وبشريًّا، على عكس محفوظ (الموظف) المدجن المطيع الدؤوب الباحث عن رزق شريف وعلاوة يستحقها. غبن التاريخ لويس عوض كما غبن سلامة موسى مع أن تأثيرهما في الإبداع والفكر المصري يوازي بقوة تأثير طه حسين الأريب الذي ارتبط بالوفد -حزب الأغلبية- فأصبح وزيرًا، بينما ارتبط إدريس باليسار المغضوب عليه من كل أنظمة الحكم في مصر، وكذا ارتبط به لويس عوض وسلامة موسى ومعظم كتاب الستينيات الأصلاء الذين غيَّبهم نظام ناصر في السجون بتُهَم متنوعة، ولم ينجُ منهم سوى عدد محدود مثل بهاء طاهر، وجميل عطية إبراهيم، وإدوار الخراط.
روائي مصري.
خليل النعيمي : ضجيج العاديين يعتم على حضور الكبار
 الإعلام لا يمكنه أن يصنع كاتبًا كبيرًا، والعُملة الرديئة لا تطرد إلّا العملة الأردأ منها من السوق، فالضجيج الإعلامي لكُتاب «عاديين»، حتى لا نقول مبتذلين، أو غير مهمّين، يُعَتِّم على حضور كُتاب «كبار». فالكاتب واحد. وليس هناك كاتب كبير وآخر صغير، إلّا بالحجم. والموهبة لا تُقاس بالضجيج، ولا بالإشهار. الموهبة ليست سلعة. إنها موقف تاريخي من العالَم، وتصوّر معقَّد وعميق للحياة، فضاؤها هو العلاقة الجدلية مع الكائنات، ومجالها هو البحث المستمر عن جوهر الوجود. ولكن ما هذا الجوهر؟ وكيف تتجلّى صُوَره؟ وما علامة الاقتراب منه؟ في هذا المثلث تكمن طاقة الموهبة وخطورتها. الفكر العربي المعاصر ما زال بدائيًّا، ومتخلِّفًا. والإعلام الذي تتكلم عنه كأنه طاقة حقيقية، ما هو إلا «فقاعة معرفية» مثل فكر «السلطة العربية الواحدة» الذي يتحكَّم فيه. إنه إعلام مغرض. لا يستند على إستراتيجية معرفية لها بُعد تاريخيّ، ولا يتمتّع بمصداقية حازمة. لذا فهو لا يستطيع أن يخلق موهبة حتى لو تجيّش من أجلها، ولا يُلْغي أخرى، إذا كانت موجودة، حتى لو أراد ذلك.
الإعلام لا يمكنه أن يصنع كاتبًا كبيرًا، والعُملة الرديئة لا تطرد إلّا العملة الأردأ منها من السوق، فالضجيج الإعلامي لكُتاب «عاديين»، حتى لا نقول مبتذلين، أو غير مهمّين، يُعَتِّم على حضور كُتاب «كبار». فالكاتب واحد. وليس هناك كاتب كبير وآخر صغير، إلّا بالحجم. والموهبة لا تُقاس بالضجيج، ولا بالإشهار. الموهبة ليست سلعة. إنها موقف تاريخي من العالَم، وتصوّر معقَّد وعميق للحياة، فضاؤها هو العلاقة الجدلية مع الكائنات، ومجالها هو البحث المستمر عن جوهر الوجود. ولكن ما هذا الجوهر؟ وكيف تتجلّى صُوَره؟ وما علامة الاقتراب منه؟ في هذا المثلث تكمن طاقة الموهبة وخطورتها. الفكر العربي المعاصر ما زال بدائيًّا، ومتخلِّفًا. والإعلام الذي تتكلم عنه كأنه طاقة حقيقية، ما هو إلا «فقاعة معرفية» مثل فكر «السلطة العربية الواحدة» الذي يتحكَّم فيه. إنه إعلام مغرض. لا يستند على إستراتيجية معرفية لها بُعد تاريخيّ، ولا يتمتّع بمصداقية حازمة. لذا فهو لا يستطيع أن يخلق موهبة حتى لو تجيّش من أجلها، ولا يُلْغي أخرى، إذا كانت موجودة، حتى لو أراد ذلك.
مَنْ قال: إن الأدب الحقيقي يحب الأضواء؟ ما هذه المهزلة التاريخية؟ كيف يمكن لمبدع حقيقي (لأن المزيفين كُثُر) أن يمسك بخيوط «لعبة الكريات الزجاجية» وهو تحت الأضواء «العامِيَة»؟ المبدع ضمير، وسلاحه اللغة. الضمير لا يقبل المساوَمة، واللغة لا تقبل التنازل. فــ«مَنْ يقبَلْ أي تنازل في اللغة، يقبَلْ أي تنازل في الحياة».
روائي سوري مقيم في باريس.
ليلى الأطرش: عالم تسيطر عليه الشللية
 لم تعد مسألة الترويج الإعلامي قصرًا على أحد، فالعالم يعيش عصر صناعة النجم؛ السياسي والاجتماعي والفنّي والأدبي، ومن لا يجيد هذه اللعبة أو يجد من يروّج له فيها، فهو بالتأكيد سيُظلَم كثيرًا، ولا ينال المكانة التي يستحق، ويترك الواجهة لمن هم أقل قيمة ممن يجيدون الظهور الدائم، أو يعتمدون العلاقات الخاصة والشللية والمحسوبية بل المناطقية التي تسود الوسط الثقافي العربي للأسف. كثير من النجوم صنعهم الإعلام وكسبوا من ذلك الشهرة والمال رغم ضعف القيمة الفنية والفكرية لمنجزهم الإبداعي، وهناك أسماء تكرّست منتصف القرن العشرين كقامات أدبية استفادت من مواقعها الصحفية أو قربها من السلطة أو الحركات الثورية أو بسطوة مادية أو وظيفية يفرضونها، تلمّعت عربيًّا ودوليًّا، وحين زال الوهج بانت قيمتها الفكرية والإبداعية الحقيقية.
لم تعد مسألة الترويج الإعلامي قصرًا على أحد، فالعالم يعيش عصر صناعة النجم؛ السياسي والاجتماعي والفنّي والأدبي، ومن لا يجيد هذه اللعبة أو يجد من يروّج له فيها، فهو بالتأكيد سيُظلَم كثيرًا، ولا ينال المكانة التي يستحق، ويترك الواجهة لمن هم أقل قيمة ممن يجيدون الظهور الدائم، أو يعتمدون العلاقات الخاصة والشللية والمحسوبية بل المناطقية التي تسود الوسط الثقافي العربي للأسف. كثير من النجوم صنعهم الإعلام وكسبوا من ذلك الشهرة والمال رغم ضعف القيمة الفنية والفكرية لمنجزهم الإبداعي، وهناك أسماء تكرّست منتصف القرن العشرين كقامات أدبية استفادت من مواقعها الصحفية أو قربها من السلطة أو الحركات الثورية أو بسطوة مادية أو وظيفية يفرضونها، تلمّعت عربيًّا ودوليًّا، وحين زال الوهج بانت قيمتها الفكرية والإبداعية الحقيقية.
وليس الإعلام وحده المسؤول عن هذا، بل انحسار دور النقد العربي، وآليات الجوائز العربية، فنحن نشهد نزعة شللية فيما يعرف بالصحافة الأدبية، وغياب المنابر الثقافية والمجلات المتخصصة التي تحتفل بالغث أكثر من السمين، ويؤخذ على بعض النقاد أنهم لا يتابعون الجديد، مع أن مسؤوليتهم كبيرة لغربلة الأدب والإبداع الحقيقي. وتلعب الجوائز العربية دورًا كبيرًا في تلميع أسماء من منطلق الجيوسياسية والأيديولوجية التي تحدد الفائزين. وبات مألوفًا أن نسمع القارئ العادي يظهر خيبته من روايات نالت هذه الجوائز، وكان يمكن للجوائز أن تصحح الوضع القائم، لولا أن بعض لجان التحكيم مصابة بأمراض الساحة الثقافية. ومعظمهم لا يقرؤون ما يرسل إليهم ويكرّسون أسماء بعينها.
روائية أردنية.
شعبان يوسف: لكل زمن مظاليمه
 يرى الشاعر والناشط الثقافي المصري شعبان يوسف صاحب كتاب (ضحايا يوسف إدريس) أن «إدريس» بسلطاته وامتداداته حرم الكثيرين من الظهور إلى جانبه، كانت له سلطة في العديد من المجالات، وكان من الصعوبة أن يقام مؤتمر أو ندوة في القصة أو المسرح أو الترجمة ولا تجده متصدّرًا المشهد، وبخاصة أنه ابن تيار اليسار الذي وقف بقوة داعمًا له، فضلًا عن علاقته بالسادات، فقد كتب له كتابيه: «الاتحاد القومي» و«قناة السويس». وذهب شعبان إلى أن هذا الأمر لم يتوقف على إدريس وحده، فقد شمل جميع المجالات والفنون، فعقب موقعة الشعر الحديث بين العقاد وكل من صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي تحوَّل الأخيران إلى سلطة واضحة في مصر، فهمَّشا كثيرًا من الشعراء كعبدالحليم القباني وفتحي سعيد وكامل أمين، ولعل أبرز من هُمِّش لصالح حجازي وعبدالصبور هو الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر، الذي لم يأخذ المكانة التي يستحقها، فقد رفض عبدالصبور نشر ديوانه الأول، كما رفض حجازي أن يمنحه جائزة ملتقى الشعر العربي. وفي المسرح الشعري هُمِّش عبدالرحمن الشرقاوي ومعين بسيسو لصالح صلاح عبدالصبور، وفي الرواية هُمِّش كتاب كبار كسعد مكاوي وعبدالرحمن فهمي وعادل كامل لصالح نجيب محفوظ، لكن «محفوظ» لم يمارس سلطاته في تهميش الآخرين، وحدها الميديا هي التي فعلت ذلك، فرجاء النقاش في الستينيات كتب قائلًا: إن لكل عصر عبقريًّا، وعبقريّ هذا العصر هو نجيب محفوظ، وقد تكرست هذه النظرة إليه بعد فوزه بنوبل.
يرى الشاعر والناشط الثقافي المصري شعبان يوسف صاحب كتاب (ضحايا يوسف إدريس) أن «إدريس» بسلطاته وامتداداته حرم الكثيرين من الظهور إلى جانبه، كانت له سلطة في العديد من المجالات، وكان من الصعوبة أن يقام مؤتمر أو ندوة في القصة أو المسرح أو الترجمة ولا تجده متصدّرًا المشهد، وبخاصة أنه ابن تيار اليسار الذي وقف بقوة داعمًا له، فضلًا عن علاقته بالسادات، فقد كتب له كتابيه: «الاتحاد القومي» و«قناة السويس». وذهب شعبان إلى أن هذا الأمر لم يتوقف على إدريس وحده، فقد شمل جميع المجالات والفنون، فعقب موقعة الشعر الحديث بين العقاد وكل من صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي تحوَّل الأخيران إلى سلطة واضحة في مصر، فهمَّشا كثيرًا من الشعراء كعبدالحليم القباني وفتحي سعيد وكامل أمين، ولعل أبرز من هُمِّش لصالح حجازي وعبدالصبور هو الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر، الذي لم يأخذ المكانة التي يستحقها، فقد رفض عبدالصبور نشر ديوانه الأول، كما رفض حجازي أن يمنحه جائزة ملتقى الشعر العربي. وفي المسرح الشعري هُمِّش عبدالرحمن الشرقاوي ومعين بسيسو لصالح صلاح عبدالصبور، وفي الرواية هُمِّش كتاب كبار كسعد مكاوي وعبدالرحمن فهمي وعادل كامل لصالح نجيب محفوظ، لكن «محفوظ» لم يمارس سلطاته في تهميش الآخرين، وحدها الميديا هي التي فعلت ذلك، فرجاء النقاش في الستينيات كتب قائلًا: إن لكل عصر عبقريًّا، وعبقريّ هذا العصر هو نجيب محفوظ، وقد تكرست هذه النظرة إليه بعد فوزه بنوبل.
أما في النقد فقد هُمِّش عبدالقادر القط وغيره لصالح محمد مندور، وفي شعر العامية المصرية هُمِّش مجدي نجيب وفؤاد قاعود وغيرهما لصالح الأبنودي وسيد حجاب، وما زال التهميش مستمرًّا، المتغير الوحيد أن السلطة لم تعد رضا جماعات اليسار أو المؤسسة الرسمية، بقدر ما أصبحت علاقات وصداقات ورسائل ماجستير ودكتوراه، ودور نشر ومراكز ثقافية، ورحلات ومؤتمرات وندوات وترجمات وأسفار وحفلات توقيع، وجوائز محلية وعربية، وعدد طبعات وقوائم أكثر مبيعًا، وطنطنة دائمة في كل مكان بأسماء مبدعين بعينهم، مما يقتل مواهب كبيرة لصالح أناس في كثير من الأحيان لا علاقة لهم بالأدب.
عِذاب الركابي: الرموز لا تحجب
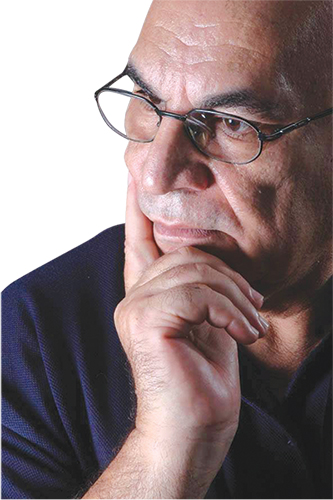 نحن –ككتّاب ومبدعين– لا ننكر أبدًا أنّ لنا آباء.. وأننا لم نُولَدْ من رحم الفراغ..! والكتابة هي كلّ ما بقيَ لنا من ذاكرة.. والإبداع والثقافة فعل حضاري، أبجديته أنين الروح وصلاتها التي لا تكون قضاءً هي المعاناة.. والثقافة والإبداع تواصل دائم.. ورموز إبداعنا وأدبنا وثقافتنا، هم أيقونة تراثنا الإنسانيّ الفاعل.. ونحن امتداد طبيعي لهم.. ومن خلال قراءتنا لواقعنا الثقافي الذي بات يُشبه كثيرًا (البورصة) في الارتفاع والهبوط، والازدهار والانتكاس نرى أنّ هؤلاء الرموز لا ذنب لهم في حجب الضوء عن غيرهم، فمَن قام بحجب الأضواء هم مَن يتولون زمام المنابر الإعلامية، سواء في الصحافة الثقافية التي تشبه مرآة مهشمة، أو في المؤسسات الراعية للإبداع والثقافة بمؤتمراتها الأدبية والفكرية (الديكورية) التي ما زالت تعاني عُقدة (الأسماء الكبيرة)، وترسّخ لنجومية بعض الأسماء التي لم تعُدْ تأتي بجديد، فما تمارسه بعض المنابر والمؤسسات الثقافية يجيء ضمن هندسة «التلميع» و«الترميم» والمصالح المتبادلة، وهذه المنابر أو (الدكاكين) التي تتاجر بدماء المبدعين، هي التي تهمّش إبداعاتهم وتحاول حجب الضوء عن الكلمة الهادفة، لكن تلك المحاولات كثيرًا ما تكلل بالفشل أمام الإبداع الجاد.
نحن –ككتّاب ومبدعين– لا ننكر أبدًا أنّ لنا آباء.. وأننا لم نُولَدْ من رحم الفراغ..! والكتابة هي كلّ ما بقيَ لنا من ذاكرة.. والإبداع والثقافة فعل حضاري، أبجديته أنين الروح وصلاتها التي لا تكون قضاءً هي المعاناة.. والثقافة والإبداع تواصل دائم.. ورموز إبداعنا وأدبنا وثقافتنا، هم أيقونة تراثنا الإنسانيّ الفاعل.. ونحن امتداد طبيعي لهم.. ومن خلال قراءتنا لواقعنا الثقافي الذي بات يُشبه كثيرًا (البورصة) في الارتفاع والهبوط، والازدهار والانتكاس نرى أنّ هؤلاء الرموز لا ذنب لهم في حجب الضوء عن غيرهم، فمَن قام بحجب الأضواء هم مَن يتولون زمام المنابر الإعلامية، سواء في الصحافة الثقافية التي تشبه مرآة مهشمة، أو في المؤسسات الراعية للإبداع والثقافة بمؤتمراتها الأدبية والفكرية (الديكورية) التي ما زالت تعاني عُقدة (الأسماء الكبيرة)، وترسّخ لنجومية بعض الأسماء التي لم تعُدْ تأتي بجديد، فما تمارسه بعض المنابر والمؤسسات الثقافية يجيء ضمن هندسة «التلميع» و«الترميم» والمصالح المتبادلة، وهذه المنابر أو (الدكاكين) التي تتاجر بدماء المبدعين، هي التي تهمّش إبداعاتهم وتحاول حجب الضوء عن الكلمة الهادفة، لكن تلك المحاولات كثيرًا ما تكلل بالفشل أمام الإبداع الجاد.
ورموزنا لم يكونوا أنانيين أو دكتاتوريين، ومن عرفناهم والتقيناهم كانوا شديدي التواضع والمسؤولية، أذكر عبقري الرواية نجيب محفوظ حين استقبلني في لقائه الأسبوعي بـ«فرح بوت» بكل ودّ وبهجة واهتمام.. وصديقي شاعر الحداثة الكبير عبدالوهاب البياتي الذي أحتفظ برسائله الحميمة لي بخط يده وأعماله الممهمورة بتوقيعه، وأذكر أنه خصّص ثمن إحدى جوائزه لطباعة أعمال الشباب الشعراء الواعدين، ومن المبدعين الكبار الأحياء الصديقان الروائيان: غادة السمان، وعبدالرحمن مجيد الربيعي اللذان ما زلتُ أسعد بصحبتهما واتصالاتهما المستمرة ورسائلهما الحميمة جدًّا، وغيرهم ممن يضيئون في فضائنا الثقافي كما الكواكب.
كاتب وشاعر عراقي.
إبراهيم فرغلي: المظاليم هم أنصاف الكتاب
 بشكل شخصي لا أُومِن بفكرة وجود مظاليم في عالم الأدب، بمعنى أن أيّ كاتب حقيقي صاحب موهبة لا يمكن عدّه من مظاليم الأدب حتى لو تأخرت شهرته، فالمظاليم هم أنصاف الكتاب وأعداء العمق الفكري والموهبة حتى لو مكنتهم الأسباب من الشهرة أو المقروئية الواسعة والانتشار. هناك نماذج من الكتاب الذين حققوا المعادلة الصعبة أي بامتلاكهم الموهبة والعمق والشهرة والانتشار مثل: العقاد، وطه حسين، ومحفوظ، أو الجواهري في العراق، وبدر شاكر السياب وسواهم لظروف تخص الآلة الإعلامية التي كانت تهتم بإبراز القوة الناعمة لمجتمعاتها، ولكن لاحظ أن أي اسم من هذه الأسماء كان مسلحًا بترسانة من المعرفة والموهبة والإقبال على الإعلام أيضًا.
بشكل شخصي لا أُومِن بفكرة وجود مظاليم في عالم الأدب، بمعنى أن أيّ كاتب حقيقي صاحب موهبة لا يمكن عدّه من مظاليم الأدب حتى لو تأخرت شهرته، فالمظاليم هم أنصاف الكتاب وأعداء العمق الفكري والموهبة حتى لو مكنتهم الأسباب من الشهرة أو المقروئية الواسعة والانتشار. هناك نماذج من الكتاب الذين حققوا المعادلة الصعبة أي بامتلاكهم الموهبة والعمق والشهرة والانتشار مثل: العقاد، وطه حسين، ومحفوظ، أو الجواهري في العراق، وبدر شاكر السياب وسواهم لظروف تخص الآلة الإعلامية التي كانت تهتم بإبراز القوة الناعمة لمجتمعاتها، ولكن لاحظ أن أي اسم من هذه الأسماء كان مسلحًا بترسانة من المعرفة والموهبة والإقبال على الإعلام أيضًا.
لكن مع انخفاض مستوى التعليم الذي أدى إلى انحدار الكفاءات في المواقع القيادية في الإعلام والسياسة وغيرهما بدأت الآلة الإعلامية تسير في درب المصلحة والمجاملة، وكان حظ الكتاب المنتمين لليسار أفضل؛ بسبب انتباه الأحزاب اليسارية في مصر لقوتها الناعمة، وتنجيم كل الكتاب الذين ينتمون لأحزابهم أو مبادئهم، لكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والميديا الجديدة اختلف الأمر كثيرًا، وأصبحت فكرة المظاليم معدومة أساسًا إلا لمن لا يمتلك أبجديات استخدام الميديا الجديدة. وهي ربما الأخطر اليوم لقدرتها على تنجيم حتى صبيان ومراهقات الكتابة لمجرد أن لديهم جمهورًا افتراضيًّا، وهو ما يقلب المعادلة الآن تمامًا، مع ذلك فتاريخ الأدب والكتابة غالبًا ما ينصف النصوص الحقيقية ولو بعد حين، مهما تعرض كُتابها للتجاهل أو عدم الإنصاف.
قاص مصري.
خليل صويلح: تسليع الأدب
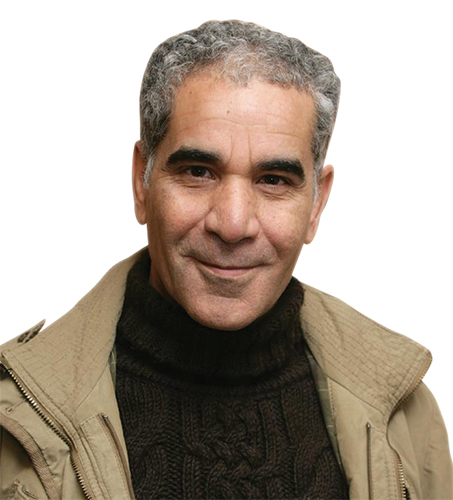 هناك موجة إعلامية شرسة لتسليع الأدب وتحويله إلى «ماركتينغ»، على غرار ما يحصل في الغناء، ومسابقات الشعر، وجوائز الرواية. قارئ اليوم يتبع الموضة في المقام الأول، بصرف النظر عن القيمة الإبداعية للعمل. هكذا تُلفظ خارج القائمة أسماء مهمة، وتُكرّس أسماء أخرى أقل قيمة بقوة الميديا والشلليّة، وصور السيلفي -للكاتبات على نحو خاص- وقبل كل ذلك الاختفاء المريب للنقّاد الكبار، هؤلاء الذين كانوا يضيئون بكتاباتهم التجارب الإبداعية النافرة، بعيدًا عن ولائم الجوائز التي فرضت سطوتها على الذائقة، فيما يتعلّق بالرواية خصوصًا. لهذه الأسباب تندحر أسماء وتبرز أخرى، فيكتفي القرّاء بنحو عشر روايات في كل موسم قراءة، تحمل دمغة هذه الجائزة أو تلك، كما لا يمكننا تجاهل «التشبيك» بين بعض الكتّاب ودور النشر وأعضاء لجان تحكيم الجوائز.
هناك موجة إعلامية شرسة لتسليع الأدب وتحويله إلى «ماركتينغ»، على غرار ما يحصل في الغناء، ومسابقات الشعر، وجوائز الرواية. قارئ اليوم يتبع الموضة في المقام الأول، بصرف النظر عن القيمة الإبداعية للعمل. هكذا تُلفظ خارج القائمة أسماء مهمة، وتُكرّس أسماء أخرى أقل قيمة بقوة الميديا والشلليّة، وصور السيلفي -للكاتبات على نحو خاص- وقبل كل ذلك الاختفاء المريب للنقّاد الكبار، هؤلاء الذين كانوا يضيئون بكتاباتهم التجارب الإبداعية النافرة، بعيدًا عن ولائم الجوائز التي فرضت سطوتها على الذائقة، فيما يتعلّق بالرواية خصوصًا. لهذه الأسباب تندحر أسماء وتبرز أخرى، فيكتفي القرّاء بنحو عشر روايات في كل موسم قراءة، تحمل دمغة هذه الجائزة أو تلك، كما لا يمكننا تجاهل «التشبيك» بين بعض الكتّاب ودور النشر وأعضاء لجان تحكيم الجوائز.
ربما سنعيد اكتشاف أسماء ظُلمت في زمننا الراهن؛ بسبب عشوائية الخرائط الإعلامية من جهة، وعدم إدراك أصحابها لأهمية التسويق من جهةٍ ثانية. التسويق هنا ليس إعلاميًّا صرفًا، فقد يتعلّق بأيديولوجيا صاحبه، أو معجم صاحبته. وكأن المعادلة الآن هي «ناقد عجوز»، و«كاتبة شابة»، وإذا بالنص العادي أو الركيك يقفز إلى الواجهة، وتاليًا، فإن الأمر يتعلّق بالنزاهة النقدية، وهي سلعة منبوذة تقريبًا، عدا إشراقات نادرة وسط غيبوبة عمومية. اليوم عليك أن تكون جزءًا من السيرك كي تجيد اللعب على الحبال من دون أن تقع في النسيان، أو العزل، أو الظلم. لا أعلم ماذا سيفعل اليوم مبدع ما، خارج الماكينة الإعلامية، أو أنه لا يمتلك صفحة شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي؟
كاتب سوري.
لنا عبدالرحمن: شبكات التواصل تدفع بكُتاب وتظلم آخرين
 قطار الضحايا والمظاليم في الأدب يتعلق بعدة عوامل، بعضها يخص الجانب الإبداعي للكاتب، وبعضها إعلامي وترويجي بحت، ليس له علاقة بالكتابة، لكن المدهش وجود حالات إبداعية في الثقافة العربية لديها نصوص إبداعية جيدة جدًّا وليس لها حضور إعلامي؛ مما يؤدي إلى تغييب هذه النصوص أو اكتشافها بالصدفة من قبل قارئ أو ناقد حذق يسلط الضوء عليها. هذا يستدعي التساؤل: هل بإمكان الكاتب أن يقوم بالكتابة والترويج لأعماله، وبالوجود الصحافي الذي يحقق له الانتشار، إلى جانب إدارة شؤون حياته الخاصة؟ في تقديري يحتاج ذلك لقدرات خاصة، وهذه القدرات لا تتوافر للجميع.
قطار الضحايا والمظاليم في الأدب يتعلق بعدة عوامل، بعضها يخص الجانب الإبداعي للكاتب، وبعضها إعلامي وترويجي بحت، ليس له علاقة بالكتابة، لكن المدهش وجود حالات إبداعية في الثقافة العربية لديها نصوص إبداعية جيدة جدًّا وليس لها حضور إعلامي؛ مما يؤدي إلى تغييب هذه النصوص أو اكتشافها بالصدفة من قبل قارئ أو ناقد حذق يسلط الضوء عليها. هذا يستدعي التساؤل: هل بإمكان الكاتب أن يقوم بالكتابة والترويج لأعماله، وبالوجود الصحافي الذي يحقق له الانتشار، إلى جانب إدارة شؤون حياته الخاصة؟ في تقديري يحتاج ذلك لقدرات خاصة، وهذه القدرات لا تتوافر للجميع.
من المؤكد أن الإعلام في المرحلة الحالية عبر سائر وسائل التواصل الإلكترونية ساهم في صعود أعمال إبداعية إلى الواجهة، وغياب أعمال أخرى، يكفي أن تتطلع إلى كتائب الجيوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على تصدير خمسة أو ستة أعمال يُتَحدَّث عنها على أنها الأفضل أدبيًّا، وفي حقيقة الأمر أن القيمة الأدبية للأعمال المذكورة متوسطة أو ضعيفة، لكن هذا ما يحدث فعلًا.. أضف إلى ذلك كله موضوع الجوائز الذي نقل العمل الإبداعي سواء في الرواية أو القصة القصيرة، من خانة الامتداد الزمني إلى خانة «الآنية» أو بعبارة أكثر تبسيطًا أصبحت حال الروايات تشبه حال المسلسل الرمضاني، فكما أن هناك في كل عام مجموعة من الأعمال الدرامية التي تطلقها الفضائيات مع قدوم شهر رمضان، فإن هذا يحدث إبداعيًّا مع إعلان الجوائز، والقوائم الطويلة والقصيرة، لنفترض أن هناك عملًا إبداعيًّا جيدًا أو أكثر من جيد، ولم يحصل على جائزة، ولم يصل لأي قائمة، لن يكون له أي حضور خارج دائرة المثقفين، إلى جانب هذا، حتى الأعمال التي تنال جائزة أيضًا، أو تصل للقائمة القصيرة، سيكون حضورها مرهونًا بالوقت الراهن، وينتهي بعد إعلان الجائزة التالية، وهكذا، كما لو أن العمل الإبداعي صار مرهونًا لفكرة الموضة.
كاتبة وناقدة لبنانية.







 أعتقد أن الإحساس بالمظلومية عند المبدعين المصريين هو إحساس صادق وصائب لعدة أسباب تتعلق بحالة الفساد المتفشية «كطريقة حياة» في المجتمع المصري بكل طبقاته، وهو فساد موروث من عصر الفراعنة (ارجع إلى شكاوى الفلاح الفصيح) والسؤال هو: لماذا لم ينتبه الناس إلى عدد لا بأس به من الكُتَّاب المهمين الذين ظهروا في عصر الأقمار الساطعة والشموس المضيئة مثل محفوظ وإدريس..إلخ؟ السبب الأول هو أن المسيطرين على الميديا والموجهين لها ثقافتهم في الأصل بسيطة ومحدودة.. لنرجع إلى ذلك الزمن.. زمن محفوظ وإدريس، من المسؤولون الأساسيون عن الميديا في ذلك الوقت؟ هم ضباط جيش حصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة، ووجدوا أنفسهم في قمة الهرم الإداري، ويسيطرون على مُقَدَّرات عشرات ومئات من المثقفين المصريين، أما عن عصر طه حسين وما يحيط به، فكان من العصور المضطربة في تاريخ مصر الحديث.. فهو عصر كان يسمح لقرويٍّ أعمى أن يذهب إلى السوربون بعد أن كان كل مراد أهله أن يحفظ القرآن، ويتّخذ منه صنعة تغنيه عن سؤال اللئيم، بوصفه كان معوقًا جسديًّا. ذلك هو العصر الذهبي للنهضة الثقافية برعاية دولة الباشوات الإقطاعيين… وها هو طه حسين والعقاد وسلامة موسى والرافعي والطهطاوي ومن سبقهم ومن التحق بهم من أجيال يحرسون الأرض تمهيدًا لظهور لويس عوض «كمفكر» مع زملائه الآخرين، ثم ظهور نجيب محفوظ ويوسف إدريس.
أعتقد أن الإحساس بالمظلومية عند المبدعين المصريين هو إحساس صادق وصائب لعدة أسباب تتعلق بحالة الفساد المتفشية «كطريقة حياة» في المجتمع المصري بكل طبقاته، وهو فساد موروث من عصر الفراعنة (ارجع إلى شكاوى الفلاح الفصيح) والسؤال هو: لماذا لم ينتبه الناس إلى عدد لا بأس به من الكُتَّاب المهمين الذين ظهروا في عصر الأقمار الساطعة والشموس المضيئة مثل محفوظ وإدريس..إلخ؟ السبب الأول هو أن المسيطرين على الميديا والموجهين لها ثقافتهم في الأصل بسيطة ومحدودة.. لنرجع إلى ذلك الزمن.. زمن محفوظ وإدريس، من المسؤولون الأساسيون عن الميديا في ذلك الوقت؟ هم ضباط جيش حصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة، ووجدوا أنفسهم في قمة الهرم الإداري، ويسيطرون على مُقَدَّرات عشرات ومئات من المثقفين المصريين، أما عن عصر طه حسين وما يحيط به، فكان من العصور المضطربة في تاريخ مصر الحديث.. فهو عصر كان يسمح لقرويٍّ أعمى أن يذهب إلى السوربون بعد أن كان كل مراد أهله أن يحفظ القرآن، ويتّخذ منه صنعة تغنيه عن سؤال اللئيم، بوصفه كان معوقًا جسديًّا. ذلك هو العصر الذهبي للنهضة الثقافية برعاية دولة الباشوات الإقطاعيين… وها هو طه حسين والعقاد وسلامة موسى والرافعي والطهطاوي ومن سبقهم ومن التحق بهم من أجيال يحرسون الأرض تمهيدًا لظهور لويس عوض «كمفكر» مع زملائه الآخرين، ثم ظهور نجيب محفوظ ويوسف إدريس.  الإعلام لا يمكنه أن يصنع كاتبًا كبيرًا، والعُملة الرديئة لا تطرد إلّا العملة الأردأ منها من السوق، فالضجيج الإعلامي لكُتاب «عاديين»، حتى لا نقول مبتذلين، أو غير مهمّين، يُعَتِّم على حضور كُتاب «كبار». فالكاتب واحد. وليس هناك كاتب كبير وآخر صغير، إلّا بالحجم. والموهبة لا تُقاس بالضجيج، ولا بالإشهار. الموهبة ليست سلعة. إنها موقف تاريخي من العالَم، وتصوّر معقَّد وعميق للحياة، فضاؤها هو العلاقة الجدلية مع الكائنات، ومجالها هو البحث المستمر عن جوهر الوجود. ولكن ما هذا الجوهر؟ وكيف تتجلّى صُوَره؟ وما علامة الاقتراب منه؟ في هذا المثلث تكمن طاقة الموهبة وخطورتها. الفكر العربي المعاصر ما زال بدائيًّا، ومتخلِّفًا. والإعلام الذي تتكلم عنه كأنه طاقة حقيقية، ما هو إلا «فقاعة معرفية» مثل فكر «السلطة العربية الواحدة» الذي يتحكَّم فيه. إنه إعلام مغرض. لا يستند على إستراتيجية معرفية لها بُعد تاريخيّ، ولا يتمتّع بمصداقية حازمة. لذا فهو لا يستطيع أن يخلق موهبة حتى لو تجيّش من أجلها، ولا يُلْغي أخرى، إذا كانت موجودة، حتى لو أراد ذلك.
الإعلام لا يمكنه أن يصنع كاتبًا كبيرًا، والعُملة الرديئة لا تطرد إلّا العملة الأردأ منها من السوق، فالضجيج الإعلامي لكُتاب «عاديين»، حتى لا نقول مبتذلين، أو غير مهمّين، يُعَتِّم على حضور كُتاب «كبار». فالكاتب واحد. وليس هناك كاتب كبير وآخر صغير، إلّا بالحجم. والموهبة لا تُقاس بالضجيج، ولا بالإشهار. الموهبة ليست سلعة. إنها موقف تاريخي من العالَم، وتصوّر معقَّد وعميق للحياة، فضاؤها هو العلاقة الجدلية مع الكائنات، ومجالها هو البحث المستمر عن جوهر الوجود. ولكن ما هذا الجوهر؟ وكيف تتجلّى صُوَره؟ وما علامة الاقتراب منه؟ في هذا المثلث تكمن طاقة الموهبة وخطورتها. الفكر العربي المعاصر ما زال بدائيًّا، ومتخلِّفًا. والإعلام الذي تتكلم عنه كأنه طاقة حقيقية، ما هو إلا «فقاعة معرفية» مثل فكر «السلطة العربية الواحدة» الذي يتحكَّم فيه. إنه إعلام مغرض. لا يستند على إستراتيجية معرفية لها بُعد تاريخيّ، ولا يتمتّع بمصداقية حازمة. لذا فهو لا يستطيع أن يخلق موهبة حتى لو تجيّش من أجلها، ولا يُلْغي أخرى، إذا كانت موجودة، حتى لو أراد ذلك. لم تعد مسألة الترويج الإعلامي قصرًا على أحد، فالعالم يعيش عصر صناعة النجم؛ السياسي والاجتماعي والفنّي والأدبي، ومن لا يجيد هذه اللعبة أو يجد من يروّج له فيها، فهو بالتأكيد سيُظلَم كثيرًا، ولا ينال المكانة التي يستحق، ويترك الواجهة لمن هم أقل قيمة ممن يجيدون الظهور الدائم، أو يعتمدون العلاقات الخاصة والشللية والمحسوبية بل المناطقية التي تسود الوسط الثقافي العربي للأسف. كثير من النجوم صنعهم الإعلام وكسبوا من ذلك الشهرة والمال رغم ضعف القيمة الفنية والفكرية لمنجزهم الإبداعي، وهناك أسماء تكرّست منتصف القرن العشرين كقامات أدبية استفادت من مواقعها الصحفية أو قربها من السلطة أو الحركات الثورية أو بسطوة مادية أو وظيفية يفرضونها، تلمّعت عربيًّا ودوليًّا، وحين زال الوهج بانت قيمتها الفكرية والإبداعية الحقيقية.
لم تعد مسألة الترويج الإعلامي قصرًا على أحد، فالعالم يعيش عصر صناعة النجم؛ السياسي والاجتماعي والفنّي والأدبي، ومن لا يجيد هذه اللعبة أو يجد من يروّج له فيها، فهو بالتأكيد سيُظلَم كثيرًا، ولا ينال المكانة التي يستحق، ويترك الواجهة لمن هم أقل قيمة ممن يجيدون الظهور الدائم، أو يعتمدون العلاقات الخاصة والشللية والمحسوبية بل المناطقية التي تسود الوسط الثقافي العربي للأسف. كثير من النجوم صنعهم الإعلام وكسبوا من ذلك الشهرة والمال رغم ضعف القيمة الفنية والفكرية لمنجزهم الإبداعي، وهناك أسماء تكرّست منتصف القرن العشرين كقامات أدبية استفادت من مواقعها الصحفية أو قربها من السلطة أو الحركات الثورية أو بسطوة مادية أو وظيفية يفرضونها، تلمّعت عربيًّا ودوليًّا، وحين زال الوهج بانت قيمتها الفكرية والإبداعية الحقيقية. يرى الشاعر والناشط الثقافي المصري شعبان يوسف صاحب كتاب (ضحايا يوسف إدريس) أن «إدريس» بسلطاته وامتداداته حرم الكثيرين من الظهور إلى جانبه، كانت له سلطة في العديد من المجالات، وكان من الصعوبة أن يقام مؤتمر أو ندوة في القصة أو المسرح أو الترجمة ولا تجده متصدّرًا المشهد، وبخاصة أنه ابن تيار اليسار الذي وقف بقوة داعمًا له، فضلًا عن علاقته بالسادات، فقد كتب له كتابيه: «الاتحاد القومي» و«قناة السويس». وذهب شعبان إلى أن هذا الأمر لم يتوقف على إدريس وحده، فقد شمل جميع المجالات والفنون، فعقب موقعة الشعر الحديث بين العقاد وكل من صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي تحوَّل الأخيران إلى سلطة واضحة في مصر، فهمَّشا كثيرًا من الشعراء كعبدالحليم القباني وفتحي سعيد وكامل أمين، ولعل أبرز من هُمِّش لصالح حجازي وعبدالصبور هو الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر، الذي لم يأخذ المكانة التي يستحقها، فقد رفض عبدالصبور نشر ديوانه الأول، كما رفض حجازي أن يمنحه جائزة ملتقى الشعر العربي. وفي المسرح الشعري هُمِّش عبدالرحمن الشرقاوي ومعين بسيسو لصالح صلاح عبدالصبور، وفي الرواية هُمِّش كتاب كبار كسعد مكاوي وعبدالرحمن فهمي وعادل كامل لصالح نجيب محفوظ، لكن «محفوظ» لم يمارس سلطاته في تهميش الآخرين، وحدها الميديا هي التي فعلت ذلك، فرجاء النقاش في الستينيات كتب قائلًا: إن لكل عصر عبقريًّا، وعبقريّ هذا العصر هو نجيب محفوظ، وقد تكرست هذه النظرة إليه بعد فوزه بنوبل.
يرى الشاعر والناشط الثقافي المصري شعبان يوسف صاحب كتاب (ضحايا يوسف إدريس) أن «إدريس» بسلطاته وامتداداته حرم الكثيرين من الظهور إلى جانبه، كانت له سلطة في العديد من المجالات، وكان من الصعوبة أن يقام مؤتمر أو ندوة في القصة أو المسرح أو الترجمة ولا تجده متصدّرًا المشهد، وبخاصة أنه ابن تيار اليسار الذي وقف بقوة داعمًا له، فضلًا عن علاقته بالسادات، فقد كتب له كتابيه: «الاتحاد القومي» و«قناة السويس». وذهب شعبان إلى أن هذا الأمر لم يتوقف على إدريس وحده، فقد شمل جميع المجالات والفنون، فعقب موقعة الشعر الحديث بين العقاد وكل من صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي تحوَّل الأخيران إلى سلطة واضحة في مصر، فهمَّشا كثيرًا من الشعراء كعبدالحليم القباني وفتحي سعيد وكامل أمين، ولعل أبرز من هُمِّش لصالح حجازي وعبدالصبور هو الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر، الذي لم يأخذ المكانة التي يستحقها، فقد رفض عبدالصبور نشر ديوانه الأول، كما رفض حجازي أن يمنحه جائزة ملتقى الشعر العربي. وفي المسرح الشعري هُمِّش عبدالرحمن الشرقاوي ومعين بسيسو لصالح صلاح عبدالصبور، وفي الرواية هُمِّش كتاب كبار كسعد مكاوي وعبدالرحمن فهمي وعادل كامل لصالح نجيب محفوظ، لكن «محفوظ» لم يمارس سلطاته في تهميش الآخرين، وحدها الميديا هي التي فعلت ذلك، فرجاء النقاش في الستينيات كتب قائلًا: إن لكل عصر عبقريًّا، وعبقريّ هذا العصر هو نجيب محفوظ، وقد تكرست هذه النظرة إليه بعد فوزه بنوبل.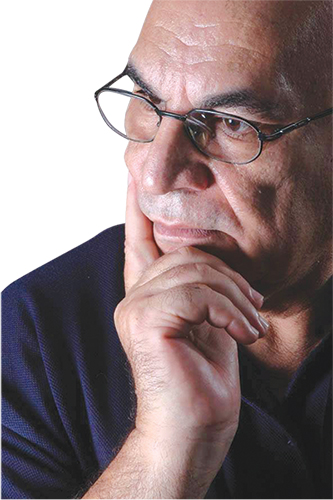 نحن –ككتّاب ومبدعين– لا ننكر أبدًا أنّ لنا آباء.. وأننا لم نُولَدْ من رحم الفراغ..! والكتابة هي كلّ ما بقيَ لنا من ذاكرة.. والإبداع والثقافة فعل حضاري، أبجديته أنين الروح وصلاتها التي لا تكون قضاءً هي المعاناة.. والثقافة والإبداع تواصل دائم.. ورموز إبداعنا وأدبنا وثقافتنا، هم أيقونة تراثنا الإنسانيّ الفاعل.. ونحن امتداد طبيعي لهم.. ومن خلال قراءتنا لواقعنا الثقافي الذي بات يُشبه كثيرًا (البورصة) في الارتفاع والهبوط، والازدهار والانتكاس نرى أنّ هؤلاء الرموز لا ذنب لهم في حجب الضوء عن غيرهم، فمَن قام بحجب الأضواء هم مَن يتولون زمام المنابر الإعلامية، سواء في الصحافة الثقافية التي تشبه مرآة مهشمة، أو في المؤسسات الراعية للإبداع والثقافة بمؤتمراتها الأدبية والفكرية (الديكورية) التي ما زالت تعاني عُقدة (الأسماء الكبيرة)، وترسّخ لنجومية بعض الأسماء التي لم تعُدْ تأتي بجديد، فما تمارسه بعض المنابر والمؤسسات الثقافية يجيء ضمن هندسة «التلميع» و«الترميم» والمصالح المتبادلة، وهذه المنابر أو (الدكاكين) التي تتاجر بدماء المبدعين، هي التي تهمّش إبداعاتهم وتحاول حجب الضوء عن الكلمة الهادفة، لكن تلك المحاولات كثيرًا ما تكلل بالفشل أمام الإبداع الجاد.
نحن –ككتّاب ومبدعين– لا ننكر أبدًا أنّ لنا آباء.. وأننا لم نُولَدْ من رحم الفراغ..! والكتابة هي كلّ ما بقيَ لنا من ذاكرة.. والإبداع والثقافة فعل حضاري، أبجديته أنين الروح وصلاتها التي لا تكون قضاءً هي المعاناة.. والثقافة والإبداع تواصل دائم.. ورموز إبداعنا وأدبنا وثقافتنا، هم أيقونة تراثنا الإنسانيّ الفاعل.. ونحن امتداد طبيعي لهم.. ومن خلال قراءتنا لواقعنا الثقافي الذي بات يُشبه كثيرًا (البورصة) في الارتفاع والهبوط، والازدهار والانتكاس نرى أنّ هؤلاء الرموز لا ذنب لهم في حجب الضوء عن غيرهم، فمَن قام بحجب الأضواء هم مَن يتولون زمام المنابر الإعلامية، سواء في الصحافة الثقافية التي تشبه مرآة مهشمة، أو في المؤسسات الراعية للإبداع والثقافة بمؤتمراتها الأدبية والفكرية (الديكورية) التي ما زالت تعاني عُقدة (الأسماء الكبيرة)، وترسّخ لنجومية بعض الأسماء التي لم تعُدْ تأتي بجديد، فما تمارسه بعض المنابر والمؤسسات الثقافية يجيء ضمن هندسة «التلميع» و«الترميم» والمصالح المتبادلة، وهذه المنابر أو (الدكاكين) التي تتاجر بدماء المبدعين، هي التي تهمّش إبداعاتهم وتحاول حجب الضوء عن الكلمة الهادفة، لكن تلك المحاولات كثيرًا ما تكلل بالفشل أمام الإبداع الجاد. بشكل شخصي لا أُومِن بفكرة وجود مظاليم في عالم الأدب، بمعنى أن أيّ كاتب حقيقي صاحب موهبة لا يمكن عدّه من مظاليم الأدب حتى لو تأخرت شهرته، فالمظاليم هم أنصاف الكتاب وأعداء العمق الفكري والموهبة حتى لو مكنتهم الأسباب من الشهرة أو المقروئية الواسعة والانتشار. هناك نماذج من الكتاب الذين حققوا المعادلة الصعبة أي بامتلاكهم الموهبة والعمق والشهرة والانتشار مثل: العقاد، وطه حسين، ومحفوظ، أو الجواهري في العراق، وبدر شاكر السياب وسواهم لظروف تخص الآلة الإعلامية التي كانت تهتم بإبراز القوة الناعمة لمجتمعاتها، ولكن لاحظ أن أي اسم من هذه الأسماء كان مسلحًا بترسانة من المعرفة والموهبة والإقبال على الإعلام أيضًا.
بشكل شخصي لا أُومِن بفكرة وجود مظاليم في عالم الأدب، بمعنى أن أيّ كاتب حقيقي صاحب موهبة لا يمكن عدّه من مظاليم الأدب حتى لو تأخرت شهرته، فالمظاليم هم أنصاف الكتاب وأعداء العمق الفكري والموهبة حتى لو مكنتهم الأسباب من الشهرة أو المقروئية الواسعة والانتشار. هناك نماذج من الكتاب الذين حققوا المعادلة الصعبة أي بامتلاكهم الموهبة والعمق والشهرة والانتشار مثل: العقاد، وطه حسين، ومحفوظ، أو الجواهري في العراق، وبدر شاكر السياب وسواهم لظروف تخص الآلة الإعلامية التي كانت تهتم بإبراز القوة الناعمة لمجتمعاتها، ولكن لاحظ أن أي اسم من هذه الأسماء كان مسلحًا بترسانة من المعرفة والموهبة والإقبال على الإعلام أيضًا. 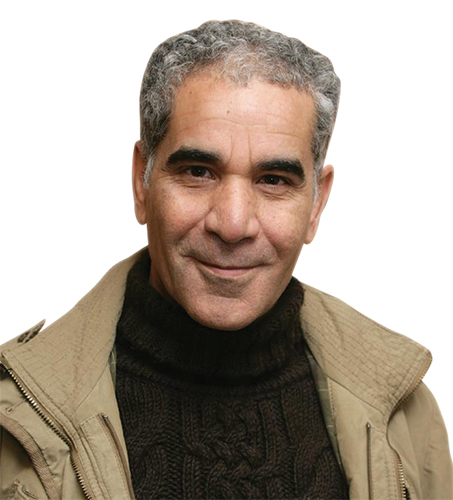 هناك موجة إعلامية شرسة لتسليع الأدب وتحويله إلى «ماركتينغ»، على غرار ما يحصل في الغناء، ومسابقات الشعر، وجوائز الرواية. قارئ اليوم يتبع الموضة في المقام الأول، بصرف النظر عن القيمة الإبداعية للعمل. هكذا تُلفظ خارج القائمة أسماء مهمة، وتُكرّس أسماء أخرى أقل قيمة بقوة الميديا والشلليّة، وصور السيلفي -للكاتبات على نحو خاص- وقبل كل ذلك الاختفاء المريب للنقّاد الكبار، هؤلاء الذين كانوا يضيئون بكتاباتهم التجارب الإبداعية النافرة، بعيدًا عن ولائم الجوائز التي فرضت سطوتها على الذائقة، فيما يتعلّق بالرواية خصوصًا. لهذه الأسباب تندحر أسماء وتبرز أخرى، فيكتفي القرّاء بنحو عشر روايات في كل موسم قراءة، تحمل دمغة هذه الجائزة أو تلك، كما لا يمكننا تجاهل «التشبيك» بين بعض الكتّاب ودور النشر وأعضاء لجان تحكيم الجوائز.
هناك موجة إعلامية شرسة لتسليع الأدب وتحويله إلى «ماركتينغ»، على غرار ما يحصل في الغناء، ومسابقات الشعر، وجوائز الرواية. قارئ اليوم يتبع الموضة في المقام الأول، بصرف النظر عن القيمة الإبداعية للعمل. هكذا تُلفظ خارج القائمة أسماء مهمة، وتُكرّس أسماء أخرى أقل قيمة بقوة الميديا والشلليّة، وصور السيلفي -للكاتبات على نحو خاص- وقبل كل ذلك الاختفاء المريب للنقّاد الكبار، هؤلاء الذين كانوا يضيئون بكتاباتهم التجارب الإبداعية النافرة، بعيدًا عن ولائم الجوائز التي فرضت سطوتها على الذائقة، فيما يتعلّق بالرواية خصوصًا. لهذه الأسباب تندحر أسماء وتبرز أخرى، فيكتفي القرّاء بنحو عشر روايات في كل موسم قراءة، تحمل دمغة هذه الجائزة أو تلك، كما لا يمكننا تجاهل «التشبيك» بين بعض الكتّاب ودور النشر وأعضاء لجان تحكيم الجوائز.  قطار الضحايا والمظاليم في الأدب يتعلق بعدة عوامل، بعضها يخص الجانب الإبداعي للكاتب، وبعضها إعلامي وترويجي بحت، ليس له علاقة بالكتابة، لكن المدهش وجود حالات إبداعية في الثقافة العربية لديها نصوص إبداعية جيدة جدًّا وليس لها حضور إعلامي؛ مما يؤدي إلى تغييب هذه النصوص أو اكتشافها بالصدفة من قبل قارئ أو ناقد حذق يسلط الضوء عليها. هذا يستدعي التساؤل: هل بإمكان الكاتب أن يقوم بالكتابة والترويج لأعماله، وبالوجود الصحافي الذي يحقق له الانتشار، إلى جانب إدارة شؤون حياته الخاصة؟ في تقديري يحتاج ذلك لقدرات خاصة، وهذه القدرات لا تتوافر للجميع.
قطار الضحايا والمظاليم في الأدب يتعلق بعدة عوامل، بعضها يخص الجانب الإبداعي للكاتب، وبعضها إعلامي وترويجي بحت، ليس له علاقة بالكتابة، لكن المدهش وجود حالات إبداعية في الثقافة العربية لديها نصوص إبداعية جيدة جدًّا وليس لها حضور إعلامي؛ مما يؤدي إلى تغييب هذه النصوص أو اكتشافها بالصدفة من قبل قارئ أو ناقد حذق يسلط الضوء عليها. هذا يستدعي التساؤل: هل بإمكان الكاتب أن يقوم بالكتابة والترويج لأعماله، وبالوجود الصحافي الذي يحقق له الانتشار، إلى جانب إدارة شؤون حياته الخاصة؟ في تقديري يحتاج ذلك لقدرات خاصة، وهذه القدرات لا تتوافر للجميع.


0 تعليق