يوضح الدكتور عزمي خليفة المستشار الأكاديمي بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في مصر أن الشكل الجديد للدولة القومية قد غيَّر من نمط علاقات السلطة بالكامل؛ بحيث فقدت الدولة احتكار السلطة نتيجة اكتساب المجتمع جزءًا من السلطة من خلال ما يطلق عليه «سلطة الشبكات» وهذا سبب مقاومة الدولة في العديد من دول العالم -ومنها منطقتنا العربية- التحول للشكل الشبكي والعولمة؛ حفاظًا على كامل سلطتها. وهذا هو مأزق الدولة العربية اليوم، وهي محاولة ميؤوس منها؛ لأنها ضد طبيعة العصر القائم على العولمة.
ويرى في كتابه الصادر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، سلسلة «أوراق»، بعنوان: «تحولات الدولة القومية والسلطة: دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة» أن حل مأزق الدولة العربية متاح، ويمكن بناؤه على حلول تعيد التوازن بين الدولة والمجتمع؛ وهي حلول سياسية وتنظيمية وفنية مع وجود آليات تضمن للدولة دورها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في عصر لم يعد يقبل المنكفئ على ذاته، وبخاصة أن ضغوط العولمة أقوى من هذا الانكفاء. كما أن تغييرات الدولة شملت إعلاء شأن الشرعية التي تغير محتواها ومضمونها مقابل السيادة التي لم تعد تعني الانفراد بالقرار حتى لو كان يخص شعب هذه الدولة. فالدول لا تعيش في فراغ، بل تعيش في عالم من الشبكات، تتحول فيه الدولة -أي دولة مهما عظمت- إلى مجرد عقدة.
وسعى المؤلف إلى الإجابة عن تساؤلات مثل ماهية العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع مع التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات بداية، ثم تعرف التغيير الذي أدخلته هذه التكنولوجيا على الدولة القومية وسلوكها، وانعكاسات هذه الثورة الرقمية على المجتمع، ونمط العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومستقبل شكل الحكم في القرن الحادي والعشرين.
ويرصد أهم التغييرات الثقافية والاجتماعية التي عبرت عن هذه الثورة العلمية الرقمية في ثماني نقاط؛ منها: أولًا- الاهتمام بالقيم الفكرية غير المادية المتعلقة أساسًا بالتعبير عن الذات التي تعكس وعيًا بالجوهر الواحد للإنسان بغض النظر عن موقعه الجغرافي وانتمائه الجنسي أو العرقي أو الإثني. ثانيًا- الاهتمام بعلاقة الإنسان بالبيئة التي تحيط به، ومن هنا يمكن أن نفهم حركة الخضر التي انتشرت في العالم في ذلك الحين. ثالثًا- هذا الوعي بالبيئة وبالإنسانية أدى في تفاعلهما إلى وعي كوني بأن المشكلات الناتجة عن العولمة هي مشكلات كونية (عالمية) تحتاج لحلول عالمية على أساس من التشاركية. رابعًا- سقوط جميع الحواجز الجغرافية والزمنية والسياسية مما يزيد من عمق التفاعل الإنساني على مستوى العالم وعلى مدار 24 ساعة يومية. خامسًا- سقوط هذه الحواجز وزيادة التفاعل الإنساني أدَّيَا إلى ظهور المجتمع الشبكي وانعكاساته على ممارسة السلطة.
وعرف المؤلف الشبكة بأنها عبارة عن مجموعة فاعِلِين، كلٌّ منهم يسمى عقدة، متصل بعضهم ببعض، وهذا الاتصال يتم بروابط متعددة ومتداخلة، ويؤمَّن بأدوات تكنولوجية. وقد يطلق على هذا الشكل التنظيمي الشبكية أو المصفوفة أو الويب. وتتحدد أهمية العقد بقدرتها على المساهمة في فاعلية الشبكة لتحقيق أهدافها؛ أي أنها تتحدد بمدى استيعابها لأكبر تدفق ممكن للمعلومات، ومدى قدرتها على إصدار معلومات لأعضاء الشبكة. ويلحظ خليفة أنه عندما تتخذ الشبكة الشكل العنقودي فإن سلوكها يكون مشابهًا لسلوك تنظيم متماسك أو مجتمع صغير، وذلك لأن العقد يمكن اتصال بعضها ببعض، بالشبكة كلها وبالشبكات ذات الصلة، من أي عقدة في الشبكة، من خلال عدد محدود من الخطوات. وعادةً ما يضاف في هذه الحال شرط المشاركة في البروتوكول، وتسمى شبكة مغلقة. ومن ثم فالخلاصة أن الشبكات بإيجاز هي هياكل معقدة للاتصال القائم على مجموعة أهداف تضمن وحدة الهدف، ومرونة التنفيذ أو من خلال قدرتها على التكيف مع بيئة التشغيل وقدرتها على إعادة التشكل ذاتيًّا.
ويقول: يمكن النظر إلى المجتمع الشبكي على أنه مجتمع الشبكات المكون من أنماط مختلفة من الشبكات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال عام افتراضي متعدد المستويات للتفاعل الاجتماعي. وهذه الشبكات تحدد حدود المجتمع الجديد مع التأكيد على أن هذه الحدود مرنة ومتغيرة جدًّا. وللتأكد من ذلك لا بد أن نحدد خصائص المجتمع الشبكي المستمدة من خصائص الشبكات. ومن ثم يمكن الفصل بين المجتمع الشبكي بوصفه شبكات تنشّطها تكنولوجيا الاتصال التي تعالج المعلومات رقميًّا والهياكل الاجتماعية التي تعد ترتيبات تنظيمية للبشر في علاقات الإنتاج والاستهلاك وإعادة الإنتاج والخبرة والسلطة.
ويتساءل المؤلف: «أين تكمن السلطة في المجتمع الشبكي؟». ويذكر أنه في المجتمع الدولي في ظل الدولة القومية «تكمن السلطة في يد الدولة الأقوى، أو الدول الأقوى، ففي ظل النظام الثنائي القطبية كانت السلطة متمركزة في الاتحاد السوفييتي الذي ورثته روسيا دوليًّا والولايات المتحدة الأميركية. أما في المجتمع الشبكي فالسلطة أكثر انتشارًا ولها مصدران؛ مصدر يرتبط بالشبكة نفسها، ومصدر يرتبط بالتحويل أي التفاعل بين الشبكات وبعضها.
ويخلص المؤلف إلى عدد من النتائج أبرزها أن هذه الثورة الرقمية أدت إلى سقوط جميع النظم الثقافية ذات الأنساق المغلقة التي تدعي معرفة الحقيقة؛ ما أدى إلى سيادة الأنساق المفتوحة وقيم التشاركية، وهذا أدى إلى ظهور الحكومة المنفتحة؛ حيث يشارك المجتمع المدني فيها الحكومة في الحكم من خلال الرقابة على الميزانية العامة، والقيام بمشروعات في مناطق قد لا تصل إليها الحكومة لأسباب مختلفة. كما أنها تشكل دعمًا لتحولات سرعة تبادل المعلومات من خلال استخدام الإنترنت؛ ما أدى إلى ظهور نوعين من التحولات على الدولة القومية التي ورثناها بعد الحرب العالمية الثانية، أولهما تغييرات على المستوى الماكرو للدولة تمثلت في تحولها إلى الشكل الشبكي بضغط من المجتمع الذي كان أسرع في التحول للشكل الشبكي. والنوع الثاني من التحولات ترتب على مستوى التحليل الجزئي للدولة؛ نتيجة استخدام بعض التطبيقات الشبكية؛ مثل مواقع التواصل الاجتماعي إجمالًا، وكلا التغييرين دعم التغييرات الشبكية للدولة، وأكد الواقع المعاصر هذه التغييرات.

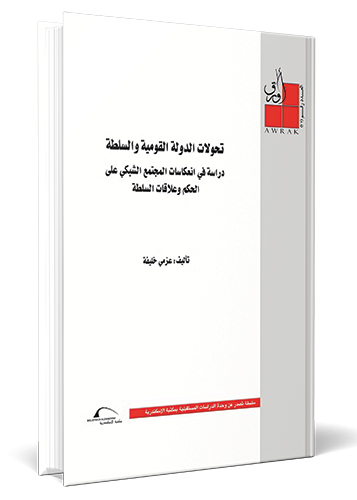








0 تعليق