لقاء
انتظرتُ ليلى ساعتين.
فتّشني الجنود عند باب الخليل بحثًا عن سلاح ناريّ أو سكّين. دخلت ميدان عمر بن الخطّاب الذي يعجّ بالسيّاح وبأعداد من المستوطنين. كان المساء ينشر ظلّه على الأمكنة، والقدس تتسربل بغموض ما. انتظرتها في المقهى الذي يتردّد عليه السيّاح. هنا لن ترانا عيون المتلصّصين. تشاغلتُ، وأنا أنتظرها، في تأمّل حيطان المقهى، حيطان قديمة جرى ترميمها لتقاوم وطأة الزمن. على صدر الحائط صورة للأب الكبير، صاحب المقهى الأوّل، والد إميل. وثمّة صورة للميدان يعود تاريخها إلى عام 1920م، يظهر فيها عدد من الجنود البريطانيين الذين احتلّوا فلسطين. جاءت ليلى واعتذرت لأنّها تأخّرت في الوصول. قالت: طوّق الجنود الإسرائيليّون حيّنا، فتّشوا البيوت بحثًا عن شباب مطلوبين. ولم يسمحوا لنا بالخروج إلا بعد انتهاء التفتيش. كان في عينيها فزعٌ ما.
اقترب منّا إميل. طلبنا فنجانين من القهوة. خلعت ليلى المنديل، فانسرح شعرها مثل طيور خرجت من قفص. فكّت أزرار الجلباب، فاندلع اللون الورديّ البهيج لفستانها الخفيف.
أمضينا ساعة ونحن نخرج من حديث شهيّ لندخل في حديث آخرَ شهي.
دفتر سميك
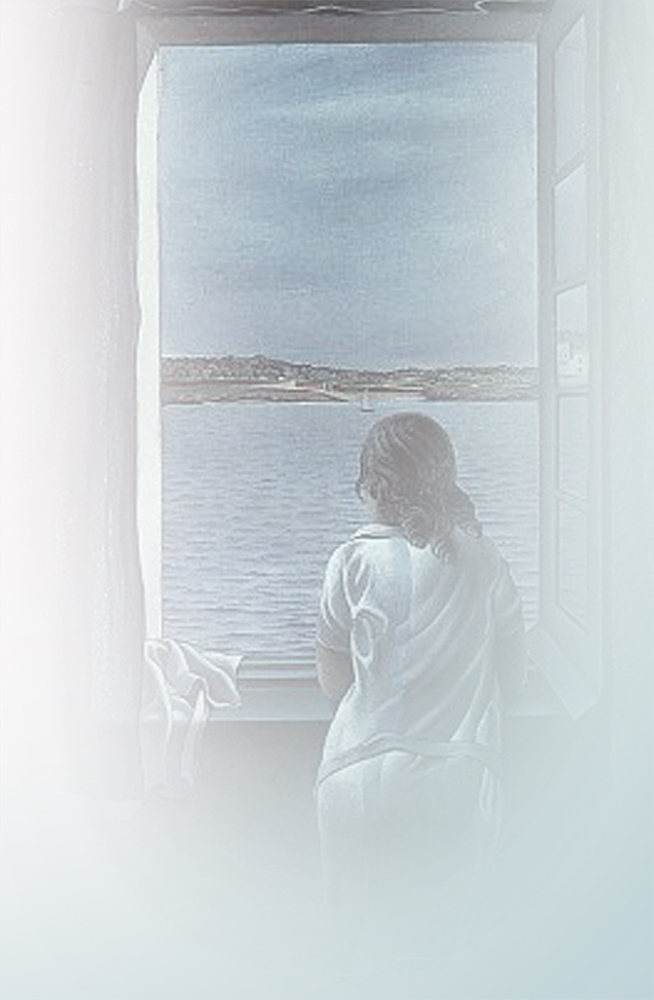 رأيناهما معًا، هو والمرأة. في يده دفتر سميك، وهي تسير إلى جواره بخطوات واثقة.
رأيناهما معًا، هو والمرأة. في يده دفتر سميك، وهي تسير إلى جواره بخطوات واثقة.
قلت: أظنّ أنّني أعرفهما، لكنّني لست متأكّدًا من ذلك الآن.
وقلت: دفتره مثير للفضول.
قالت ليلى: نعم، صحيح.
دخلا المقهى الذي اعتدنا الجلوس فيه. فتح الدفتر وراح يكتب والمرأة ترمقه بإعجاب.
واصلنا، أنا وليلى، حلمنا، وكان دفتره السميك على مسافة حلم منّا أو حلمين. غافلتها، وانفردت بنفسي في حلم خاص، ورحت أتذكّر أين قابلت هذا الرجل وهذه المرأة! ولم تسعفني الذاكرة. غضبت من حلمي الذي يجعلني غير قادر على تحديد الأسماء وتمييز الأشخاص. وكنت معنيًّا بألا تعرف ليلى ما أحلم به. لكنّها فاجأتني وقالت: حين تتذكّرهما أخبرني من هما على وجه التحديد. أومأت لها بالإيجاب، وكانت السماء تنذر بمطر غزير.
صباح الشغل
نهضتُ في الصباح المبكّر، تذكّرت نتفًا من أحلامي الليليّة ثمّ اتجهت إلى الحمّام. اغتسلت كعادتي كلّ صباح، ارتديت ملابسي، شربت القهوة وغادرت البيت. فتحت باب السيّارة وجلست خلف عجلة القيادة، وذهبت من رأس النبع إلى باب العمود. هناك انتظرت الركّاب، وكنت بين الحين والآخر أتبادل أحاديث عابرة مع زميلي رهوان وزملاء آخرين، وأتأمّل في الوقت نفسه المدينة التي تعجّ بالخلق، ولا يعكّر صفوها سوى الجنود، في أيديهم معادن صقيلة لسفك الدماء. وثمّة على الأرصفة والأدراج رجال حذرون، أو هكذا خُيّل لي. وثمّة بنات وأولاد ذاهبون إلى مدارسهم، ونساء متّجهات إلى داخل البلدة القديمة للتسوّق أو للالتحاق بوظائفهن. ولا يحلو لي الصباح إلا حين أرى ليلى وهي قادمة بمشيتها الرشيقة فوق الرصيف، ثمّ وهي تضع قدمها على أوّل الدرج النازل إلى باب العمود، في طريقها إلى المدرسة التي تُمضي فيها نهارها وهي تعلّم البنات والأولاد.
هذا الصباح رأيتها. نظرت نحوها بحذر، وهي نظرت نحوي بحذر، وكنّا كما لو أنّنا نتبادل بطريقتنا الخاصّة تحيّة الصباح. قلت لنفسي: حين أرى ليلى وتراني يكون صباحي وصباحها أبهى وأجمل.
الدفتر
دخل الرجل حلمنا، فلم نُظهر أيّ استياء. وكانت المرأة ملازمة له مثل ظلّه. فتح دفتره السميك وانكبّ عليه يكتب فيه. تسللتُ مثل قطّ رشيق حتّى اقتربت منه، ورحت أسترق النظر إلى ما يكتبه. كانت المرأة تجلس إلى جواره وهي تقرأ في كتاب. دقّقت النظر في صفحة الدفتر، ولم أتمكّن من قراءة ما تخطّه يده. كانت الكلمات تنداح من قلمه مثل ماء جدول. فركت عينيّ لعلّني أستطيع القراءة ولكن من دون جدوى. اقتربت منه ليلى، وراحت تحدّق في صفحة الدفتر، ولم تستطع القراءة. لُمنا حلمنا ولم نستطع تبديله بحلم آخر مطواع. بعد وقت، نهض الرجل ونهضت المرأة، وضع يدها في يده وسارا معًا، ربّما إلى البيت، أو إلى مطعم، أو إلى نزهة في شوارع المدينة. أقلعت عن النظر إليهما، وقدت ليلى من يدها ودخلنا مدينة ينام أهلها في النهار ويقضون ليلهم ساهرين.
نهار ٌبهيج
جلستُ خلف عجلة القيادة، قريبًا من باب العمود، في انتظار راكب أو راكبة. أخرجت كتابًا كنت وضعته في جيب السيّارة لكي أقرأ فيه كلّما وجدت وقتًا لذلك، لم يكن زملائي معجبين بقراءتي للكتب، ولم آبه لهم. انهمكت في القراءة، ثمّ رفعت عينيّ عن الكتاب، وكانت حركة الناس فوق الأرصفة على أشدّها. أعدت الكتاب إلى مكانه، وتأمّلت ما حولي بانتباه.
فجأة، ظهرت ليلى وهي تسير نحوي على الرصيف، ولم أصدّق عينيّ للوهلة الأولى. كانت ترتدي جلبابها، وتغطّي كعادتها شعر رأسها بمنديل. فتحت الباب الخلفي للسيّارة وجلست وقالت: خذني إلى البيت إنْ سمحت. شغّلت المحرّك وانطلقت السيّارة في الشارع الرئيس نحو بيتها. في الطريق، تمازحنا كما لو أنّنا في حلم، مددت يدي إلى الخلف لتلمس يدها. تعانقت يدانا. نظرتْ ليلى نحو الخارج ثم ارتدّ بصرها نحوي وقالت: الخوف يتربّص بي في كلّ مكان.
تأمّلت وجهها عبر المرآة وقلت: أرجوك، لا تذكري الخوف الآن. ثمّ أوقفت السيّارة قريبًا من البيت.
من بين الأسطر
فرحتُ حين التقيتها، ولم يكن هناك رقيب. اقتربت منّي ووقفنا أمام الشبّاك. بياض جسدها يتلامح من تحت قميص النوم، وشعرها منعوف على وجهها وعلى صدرها من دون ارتباك. قالت بخيلاء: أنا لا أخاف. قلت: وأنا أيضًا لا أخاف. خيّم علينا صمت، وفي الأثناء، رأيناه يفتح دفتره السميك، يكتب فيه بضعة أسطر، تندلع من بين الأسطر صيحة ممطوطة لرجل يتألّم مثل حيوان جريح. تملأ صيحاته فضاء حلمنا. ارتعش جسدي، وبدا جسد ليلى كما لو أنّه تعرّض لانتهاك. حين انتهى من الكتابة، أغلق دفتره وتأمّل وجه المرأة الجالسة إلى جواره وهي تقرأ في كتاب.
قالت ليلى: كأنّه يكتب عن مأساة.
قلت: ربّما.
وقلت: كأنّني سمعت هذه الصيحات من قبل.
رحتُ أتذكّر أين سمعتها، ولم أتمكّن من تذكّر أيّ شيء.







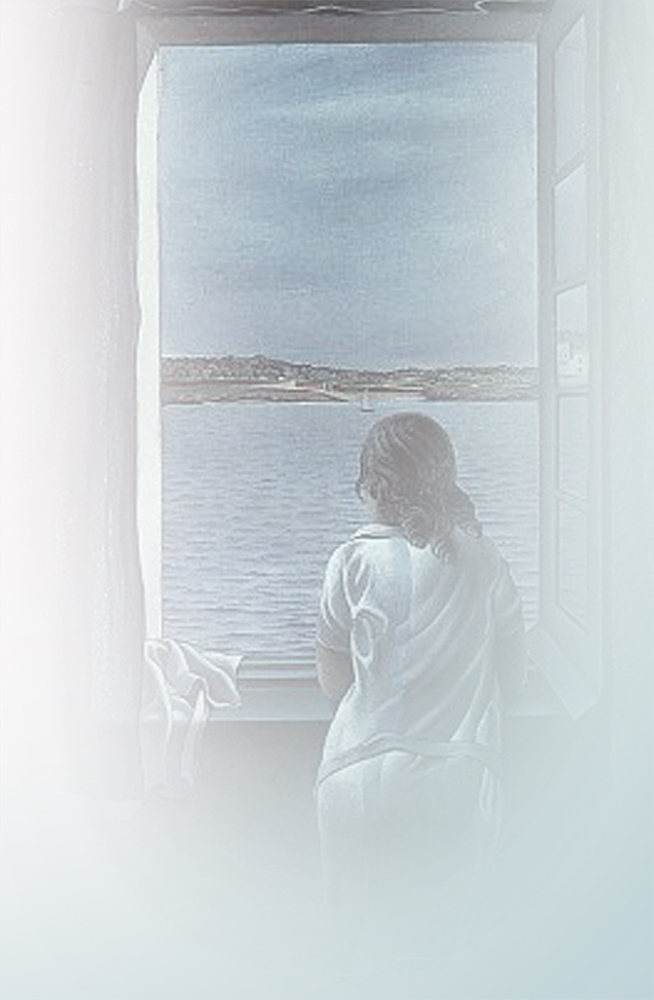 رأيناهما معًا، هو والمرأة. في يده دفتر سميك، وهي تسير إلى جواره بخطوات واثقة.
رأيناهما معًا، هو والمرأة. في يده دفتر سميك، وهي تسير إلى جواره بخطوات واثقة.


0 تعليق