اطلعت على كتاب (باريس) الذي جمعه الصحافي المصري الراحل أحمد الصاوي محمد، وصدرت طبعته الأولى عام 1933م، ثم أعادت نشره هذا العام دار إصدارات في الرياض مع دار آفاق في القاهرة، وفي الكتاب اللطيف يحشد الصاوي عشرات المقالات والمقولات التي كتبت في باريس، وبعضها أعده المشاركون لأجل مشروع الكتاب أوائل القرن الماضي. والواقع أن الكتاب يمثل رحلة ثقافية ووجدانية خاصة في طُرقات باريس وميادينها ومقاهيها، ولفتني أكثر ما لفتني محاولات المثقفين على اختلاف مشاربهم الإجابة عن سؤال كبير حول ما سمّوه لغز باريس.. سر باريس.. سحر باريس.. من دون أن تخرج بإجابة واحدة تصمد أمام سرّها المزعوم. هل يكمن في تاريخها، طقسها، حدائقها، حاناتها، معمارها…؟ بل إن الصاوي نفسه وفي مقدمته الموجزة لم يعلِّل اختياره باريس ليجمع فيها هذه المقولات، واكتفى بوصف عمله هذا بأنه «طاقة من الزهر لباريس» التي هي «دنيا منيفة يصعب حصرها بين غلافي كتاب».
ولطالما شغلني سؤال حول المدن وأسرارها. ما الذي يجعل مدينة ما حميمة ومؤنسنة، ومدينة أخرى موحشة لا يقرّ لك فيها قرار. فباريس مثلًا التي يقول الصاوي إنه كُتب فيها أكثر من مئتي ألف وصف حتى مطلع القرن الماضي؛ انفردت بين المدن الأوربية الأخرى بهذا الهيام الذي يبديه المثقفون والروائيون والسيّاح والعشاق من ساحة الكونكورد إلى غابة بولونيا، والقارئ في تاريخ «باريس الجديدة» يعرف أن من هدمها وأعاد بناءها هو جورج أوجين هوسمان الموظف المدني البسيط الذي حوّلها من برك وبيوت للفقراء على هامش نهر السين إلى ما نعرفه اليوم بعاصمة النور، واستمرت باريس تحافظ على بنيان هوسمان ومشروعه المعماري مهما توسعت على مر العقود الماضية، فيما نعرف أن القاهرة الخديوية التي بناها هوسمان نفسه بطلب من الخديو إسماعيل لا يكاد يبقى منها اليوم شيء وكانت أجمل ما في القاهرة، ربما لا يعرف سر المدن إلا بُناتها العظام ومهندسوها الأوائل. إنه الفارق الذي لا تخطئه العين بين لطف ميونخ على بساطتها وقسوة فرانكفورت على فخامتها، بل إنه الفارق في جدار من بضعة سنتيمترات فصل بين برلين الغربية والشرقية، مدينة تعامل النهر بوصفه شريان حياتها وتزينه بالورد وتنمو على ضفافه كل بهجاتها، ومدينة ترى النهر وسيلة نقل ومستوعبًا لنفايات المصانع، بين مدينة تحشر الناس في صناديق صفراء هائلة تسميها مساكن شعبية، ومدينة تفتح نوافذها على الحدائق والساحات والمهرجانات الملونة، إنه الفارق بين ثقافة الحياة وثقافة الحزب.
ولعله من الوهم أن يُظَن أن بناء المدن وتخطيطها هو شأن هندسي معماري لا علاقة له بالثقافة والسياسة، الأحزاب الشمولية التي جثمت على بعض المدن الأوربية حوّلتها لغرف للعمال وساحات للشعارات الحزبية وصور الزعماء وتماثيلهم، ومخطئ من يظن أن البناء الحديث والأبراج الزجاجية العالية والإسمنت المسلح يصنع مدينة، فبعض أجمل مدن العالم يخلو من برج أو عمارة بأكثر من خمسة طوابق، لكنها جميلة وعملية ونابضة، فيما تبدو المدن الكوزموبوليتية المصنوعة مكتظّة لكن فارغة، مهولة لكن موحشة، كأنما بنيت لتعيش فيها القاطرات والشاحنات. زائر الحي اللاتيني في باريس لن يفطن إلى العمارات المتهالكة والحديد الصدئ والألوان غير المتجانسة والممرات الضيقة، لكنه سيرتاح إلى المكتبات العتيقة والمقاهي التاريخية، وهذا المزيج البشري الحيّ الذي يعشق الحياة ويتنفس الفنون ويعبر عن نفسه بلا تزييف وتنميق.
بناة المدن العظام كانوا مشغولين بالبشر قبل الحجر، وأكثر ما يشد انتباهي وأنا أزور بعض العواصم العربية التي ما زالت مزدهرة هو مزارع الناطحات التي لا تنفك تتزايد ويعلو بعضها على بعض، وتحت عنوان التحديث والتنمية تنسى هذه الأبراج الشاهقة أن هناك إنسانًا تحت كعبها يريد أن يمر بينها ويدخل إليها ويخرج منها، معظم هذه الأبراج بنيت للسيارات تصل إلى بابها وليست مشغولة أبدًا بمن يدب على الأرض من المشاة، ووسط هذا التطاول يضيع كثير من المعنى الإنساني وراء العمران ليحل محله شيء من التحدي والتنافس المحموم.
لم يكن انتعاش الثقافة وتفاعل الأفكار وانصهارها مرتبطًا ببناء ضخم تحت عنوان مكتبة أو مركز أو متحف أو منتدى لا يفتح أبوابه إلا في المناسبات الرسمية، فعلى ضفاف التايمز في لندن تطل ثلاثة مراكز ثقافية كبرى تفتح أبوابها للمبدعين أيًّا كان لونهم وجنسهم وسنهم ليمارسوا فنونهم، وتظل المراكز مفتوحة حتى ساعة متأخرة من ليل العاصمة البريطانية، وقد تنشأ التيارات الثقافية الكبرى، وتؤلف الكتب وتعقد المناظرات والحوارات في أماكن لا يتوقعها أحد؛ مقهى صغير أو ميدان على جوانبه تباع الصحف والكتب والورد ويفترشه الرسامون والموسيقيون.
لقد غابت النشاطات الثقافية العفوية التي كانت تبعث الحياة في المدن العربية، وكثيرًا ما يبرز سؤال عن المدن المغلقة وتلك التي لا تتيح للأفراد والمجموعات فرصة التعبير عن الذات في الهواء الطلق، ومثل حقيقة فيزيائية سيجيء اليوم الذي تعبر فيه هذه الذوات عن رأيها بشكل عنيف، بدلًا من طرحها أفكارًا قد لا تصمد طويلًا وتنتهي.
هناك سر ما يميز المدن قديمها وحديثها، يطبعها بخصوصية أهلها، يؤنسنها ولا يحولها إلى مكان ضخم للعمل ووسائل النقل، يجيء هذا الحديث ونحن نتابع أخبار الحواضر العربية الكبرى تهدم وتدمر كل يوم، وبأقصى قدر من التفاؤل الممتنع عقلًا يتمنى الواحد منا أن يكون كل ما يراه مخاضًا لشيء جديد.





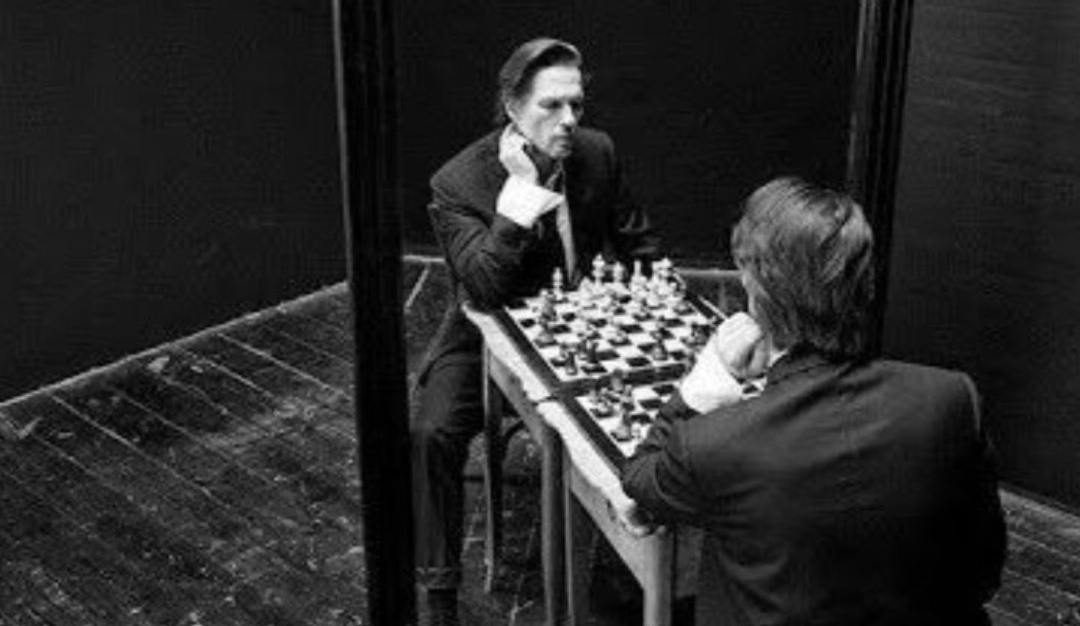

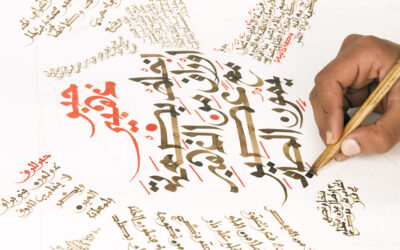

0 تعليق