لماذا بدأت الرواية العربية الأولى باسم امرأة؟ وما الذي أعطاها حضورًا متوالدًا في روايات لاحقة؟ وهل كانت فكرة «فاضلة» مجردة أم كيانًا مشخصًا واضح الحركة والفعل؟
جاءت شرعية السؤال من «زينب»، التي كتبها محمد حسين هيكل في نهايات العقد الأول من القرن العشرين واعتبرها بعضٌ الرواية العربية الأولى، ولحقت بها أنثى تشبهها في رواية توفيق الحكيم «عودة الروح»، في انتظار أخرى أوسع حضورًا وغموضًا في «دعاء الكروان» لطه حسين… أخذت «زينب» ملامح الأصل، بالمعنى النظري: فهي بداية ما لحق بها من روايات، وامتداد للريف المصري، أصل الشخصية المصرية الموزعة على النيل والأهرامات، ومرآة «لعبقرية المكان» بلغة الجغرافي النبيه جمال حمدان. وهي روح غامضة مشبعة بالجمال وسريعة الرحيل… ولأنها أصل فهي تنفتح على الماضي والمستقبل وتحرض في ديمومتها على التأويل، وهي في الحالات جميعًا «رمز» وطبقة من الرموز المتعددة الدلالات.
أنثى هيكل
ما يميّز زينب، كما رسمها هيكل الشاب، أمران: جمال هادئ وروح مستقرة، ورحيل عن الحياة في زمن الشباب واضح وغامض في آن. الأصل، نظريًّا، لا يموت، له ماضٍ أثيل، تمتد فيه «طبيعة مصر» سرمدية الوجود. زينب من خضرة الأرض وأريج الظلال، لصيقة بأرضها، بها تبدأ وإليها تنتهي، بعيدة من أنثى توفيق الحكيم القريبة من المدينة وعالم الطلبة والمظاهرات الوطنية، لكنها كالأولى تقاسمها جمالها وأنس حضورها ولها روحها الجماعية، تعشق الكل ويعشقها الكل، تجسّد «الواحد في الكل والكلّ في واحد»، يتساند فيها الحاضر والماضي معًا. كأن وجودها «لا زمني»، تعبره جميع الأزمنة ويظل شابًّا.
يلفّ التساؤلات السابقة سؤال «صغير»: لماذا دفع هيكل زينب إلى موت مبكِّر واستبقى الحكيم أنثاه المشرقة صامدة منتصرة؟ لماذا اختلف مآل «مصريتين» مرتبطتين «بالأرض» في منظورين روائيين يذكران بجمال الريف و«بجيوش الشمس» الفرعونية؟ يصدر الجواب عن منظور أول عامر بالارتباك، يعشق الريف المصري وسماءه، و«يعطف على فلاحين طيبين»، ويستنكر استبداد العادة الذي يحكم حياتهم، يختصر الفرد في خضوعه والفلاح إلى جوعه. ولهذا تحضر زينب كموضوع وإشارة، فهي عاشقة مضطهدة، تكون كما أرادت لها العادات المستبدة أن تكون، وهي «روح مصر القديمة الخالدة»، صورة عن «جمال فرعوني» وآية له، تفتقر إلى حرية تدعها طليقة الرغبات. وإذا كانت صورة زينب في جمالها الباذخ من صورة مصر الأصلية، فإن مآلها الحزين أثرٌ لمجتمع متخلّف، الجمال العميم رحمة لكنه لا يرحم. تفتقر الصورة الأولى إلى «العقد الاجتماعي»، المأخوذة عن جان جاك روسو التي تدع البشر متساويين أحرارًا، بينما يترجم المآل الحزين أحوال مجتمع يسوسه «بشر بلا مدارس» وعقول لا تُحسن القياس.
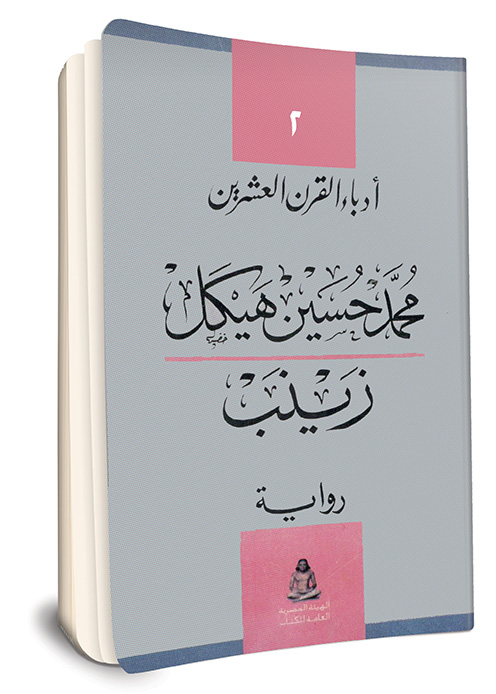 الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
تتعيّن رواية زينب خطابًا حداثيًّا، آيته أنثى لها طبيعة مصر، عشقها تصادره الأعراف، وصبيها الواعد يتأمل الجمال ويقف عاجزًا. ولهذا يكون السارد المتمرد قناعًا فكريًّا، يشهد على بيئة «جميلة مستبدة»، تعارض قواعدها الحاجات الطبيعية، وعلى تفاؤل كسيح، ينظر إلى مجد قديم لن يعود، وإلى مجتمع يعترف بالحرية والمساواة، يشفق على فلاحين يعتاشون بآفات يظنونها فضائل، يقدسون ذكورة فارغة ويرجمون أنوثة جديرة بالحياة.
يتجلّى البعد التبشيري في نظر الصبي المفتون بجمال زينب، الذي يقنعه بأنها لا تموت، فإن ماتت بعثت من جديد. يأخذ عندها المثقف الشاب دور «المبشّر»، يقتات برغباته ويحملها ويسير إلى لا مكان. كما لو كان مصيره شكلًا آخر من المصير الذي انتهت إليه زينب.
أنثى الحكيم
ارتاح هيكل إلى رومانسية فلسفية متأثرة بأفكار فرنسية، واطمأن الحكيم في «عودة الروح» 1923م، إلى رومانسية صوفية، تضع الكلّ في واحد وتضع ذاته فوق الجميع. نسب الحكيم فلسفته إلى موروث مصري قديم، يساوي بين العقل والقلب والزمن والروح. قاسم هيكل مجاز «الصبي الواعد»، والقول بأصل فرعوني عظيم، مجلاه الفلاح المصري الذي يجتمع فيه الصبر والتضامن والتسامح، وتقاسم معه صورة الأنثى الفاتنة، التي هي من روح مصر وآية لها، وغالى في تجميلها حتى تفرّدت. أراد هيكل أن يواجه التخلّف بثقافة حديثة، تحرّر الفرد من استبداد الجماعة، لا فرق إن كان ذكرًا أو أنثى. رأى الحكيم في الجماعة كيانًا فاضلًا، عبقري القلب، يحايثه الكمال في جميع الأزمنة. وبسبب عمومية سمتها الخلود، تتساوى فيها الأنثى والذكر، ويرشدان إلى المستقبل بلا خطأ.
شاء الحكيم مصر مبدعة متجددة، اشتقها من ميتافيزيقا ساذجة؛ إذ المصري من جوهر فلاحي، مفعم بالنقاء كالأرض التي يمشي فوقها، يعيش بإحساسه و«الإحساس هو علم الملائكة»، لا يحتاج إلى «لغة العقل» الغريبة عن مصري مندمج بالكون، يأتلف مع جميع المخلوقات: «إن مصر الملائكية القلب ذات القلب الطاهر ما برحت مصر، وقد ورثت -على مرّ الأجيال- عاطفة الاتحاد مع الوجود دون أن تعلم…».
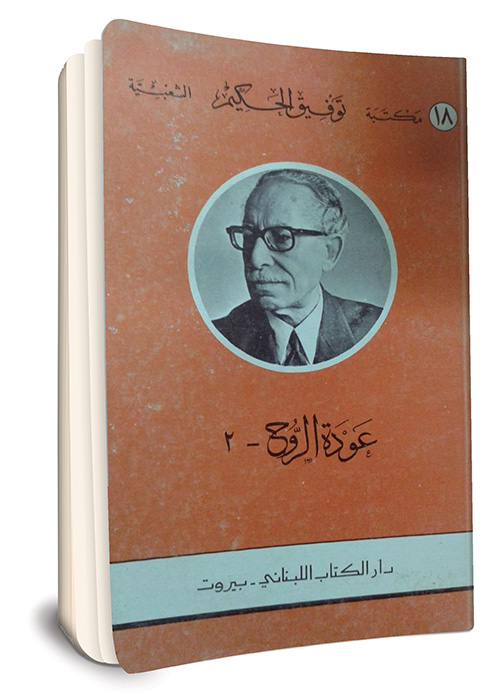 لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
تجسّر «سنيّة» المسافة بين ما مضى وما سياتي، بين الفلَّاح القديم وثورة 1919م، وبين مصر فرعونية: «عنقها غابة من البياض»، وفضاء روائي حديث يقتات بالواقع ولا يتعامل مع المعجزات. تجتمع المتناقضات في نص مجرد موحّد الزمن، يحتفي بثورة 1919م ويعد إلى الوراء إلى زمن أخناتون، كأن الرواية جنس أدبي تقبل به جميع الأزمنة.
أنثى طه حسين
استُهلت الرواية العربية بأقلام غير روائية، فرنسية الثقافة، وتتصرف بالرواية كما تشاء. عُني هيكل بالفلسفة والرواية ووقف إلى جانب الحرية، وكتب الحكيم عن ذاته وميوله وكتب الرواية في «أوقات الفراغ». انشغل طه حسين بقضايا التخلّف والتقدم وحاول الرواية في مجتمع مسكون «بثقافة الأدعية»، وأنجز رواية أولى عام 1934م عنوانها: «دعاء الكروان»، سردت رغباته الفكرية الذاتية واقتفت مسار «حب مشؤوم» يثير السخرية، يجب أن ينتصر.
ما حديث التخلّف والتقدم في عقل نقدي عنيد كعقل طه حسين إلا الحديث الصعب عن قيم جميلة منتصرة في مجتمع يسكنه الكراهية. ذلك أن طه حسين لا يرضى بأنصاف الحلول ويؤمن بقوة المعرفة إيمانًا مطلقًا. والأرجح أنه حين كان يكتب «دعاء الكروان» كان يهجس بمسيرته الذاتية، كما ساقها في «الأيام»؛ إذ الإرادة تروّض الوجود والأرجح أيضًا أنه انتصر للحب المثالي مثلما انتصرت إرادته على «عماه»، وانتقل من وضع إنسان يُرفع كالمتاع إلى وضع آخر مستقل، مرفوع الرأس، ينصاع إلى إرادته ولا يخضع لأحد.
أقام حسين روايته «دعاء الكروان» على مجاز الانتقال الوهمي: انتقال مكاني، اجتماعي، نقل فتاة من البادية إلى الريف، من حياة خشنة بائسة الحاجات إلى حياة في بيئة ميسورة من الريف، وانتقال على مستوى الوعي صدر عن اختلاف البيئة، فعرفت الفرق بين القراءة والأميّة واستمعت إلى صوت البيانو الذي لم تراه من قبل، وتبدلت كلامًا وملبسًا، كأنها حظيت بأكثر من ولادة. وانتقال الثالث على مستوى العاطفة، جاءت كارهة مملوءة بروح الانتقام وانتهت متسامحة، قلقة، عاشقة.
طرح المؤلف في روايته موضوعه الأثير والمحدّث عن التعلم والتعليم، وغالى فيه واستحضر ثقافته المدنية- الفرنسية، فنقل الفتاة من الريف إلى المدينة. ومن تعلّم القراءة والكتابة إلى تهجّي «الثقافة الفرنسية»، فكأنها انتقلت من فضاء الرمال إلى ضفاف نهر النيل. ونقلت معها «المعشوق» من لا مبالاة مؤذية إلى قلب رقيق هذّبته العاطفة المتبادلة والحوار بين عقلين متساويين في التساؤل والمحاججة.
تساوي شروط الحضارة بين فتاة من البادية وأخرى من المدينة، فإن كان لها حظ من الاجتهاد تفوقت على الأخيرة، تفوقًا «يمكن» أن يجعلها من «النخبة المتعلمة». اختصر حسين إيمانه بقوة المعرفة في حكاية متعددة الأبعاد.. الإيمان بالمساواة بين البشر، إمكانية التحضر وتوليد شروطه، وحق الأنثى في التعلّم «الراقي»، ليكون لها حقٌّ في الحب والاختيار الحر والمساهمة في تطوير المجتمع. ليست صعبة المقارنة بين الصبي الضرير في «الأيام» والبدوية النجيبة في «دعاء الكروان»: سيرتان لإنسانين نبيهين، لهما شروطهما الصعبة، يقتحمان الصعاب ويبلغان السلامة.
اللجوء إلى الرواية
سؤال يثير الفضول: لماذا لجأ المثقفون الثلاثة (هيكل والحكيم وحسين) إلى الرواية وهم الذين انشغلوا بصياغة «الأفكار الاجتماعية»؟ محاكاة الثقافة الفرنسية «ربما»، فجان جاك روسو، الذي أخلص الشاب لأفكاره، كتب رواية عن الحب -هولويز الجديدة- والحكيم انشغل بالمرأة والحب في «عصفور من الشرق»، روايته الأولى التي كتبها في باريس، وعرف حسين بدوره «قيمة المرأة»، عاشها حسين حين كان بدوره طالبًا في باريس. اعتنق الثلاثة معًا، بأشكال متفاوتة: فكرة التقدم واعتبروا الرواية، كما الدفاع عن المرأة، وجهًا من وجوهها. حرّض على ذلك «المتخيل الروائي»، الذي يقبض على وجوه من الحياة المعيشة، ويضيف إليه «أوهامًا جميلة»؛ ذلك أن «فكرة التقدم» اتكأت على فكر «رَغَبي» عريض قوامه «المستقبل المنتصر» والكمال الاجتماعي ومصر الخالدة.
مازج الفكر الرغبي تجريدًا واسعًا أدمن عليه «المحرومون» الذين يفصلهم عن نقائضهم مسافة واسعة، كما لو كان لا يستوي إلا بإضافة -ضرورة- تعترف بالمعيش وتعيد خلقه كما يجب أن يكون. لهذا تأتي المرأة في الروايات الثلاث، رحيبة الجمال والنباهة، سبقها زمن مغترب وعقبها زمن منتصر آخر.
كان فرح أنطون، المثقف السياسي التنويري المنفتح على الثقافة الأوربية يقول: «الرواية فن تأخذ به الشعوب الراقية»، والرواية عندنا «كتابة تدعى الرواية على سبيل التساهل». سيطرت الرغبة المضمرة، أو الصريحة، بمحاكاة «الآخر المتقدم» على الروايات الثلاث، ما يسمح بالقول: كان هيكل والحكيم وطه حسين روائيين على سبيل التساهل ويتصرّفون بالأفكار تصرّفًا مريحًا: الفلاحون عند هيكل يعيشون «الاشتراكية» بشكل عفوي، وأنثى الحكيم تقارب الشمس ضياءً، توحّد بين الجامعة الحديثة والأفكار الفرعونية القديمة، والأنثى في «دعاء الكروان» أقرب إلى المعجزة. أدرج الحكيم في نصه «صبيًّا ملائكيًّا»، وساوقت الملائكة «المرأة الروائية» في الروايات الثلاثة؟
جاءت الرواية العربية؛ في بداياتها، معوّقة، صاحبتها أفكار تقدمية لا تنقصها الإعاقة، منّت النفس بامرأة مصرية من حرية وذهب، يضيق به الواقع المعيش وتحتفي بها الكتابة المجردة.







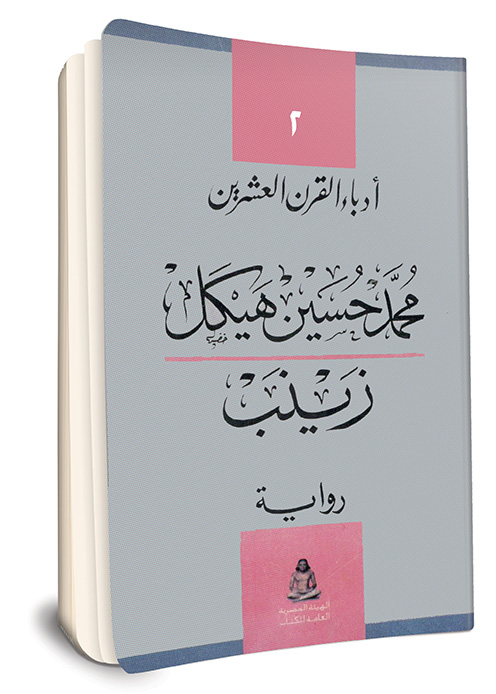 الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.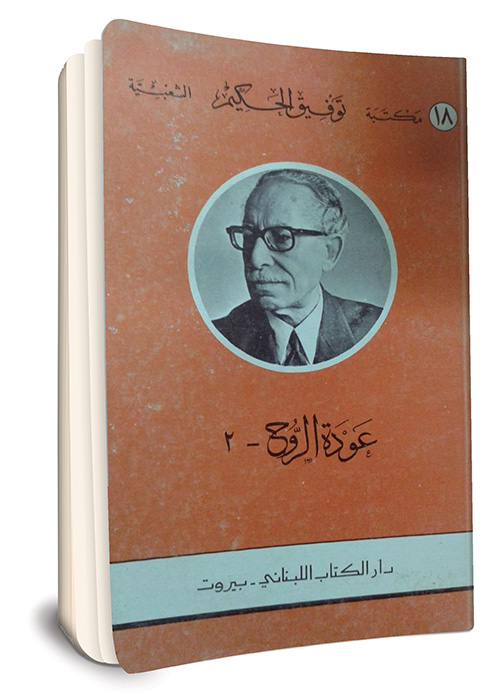 لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.


0 تعليق