ارتأيْتُ، هذه المرَّة، أن أكتفِيَ بقراءة الأعمال الشعرية، من دون ربطها بأي سياق، سوى ما تفرضه، هي نفسها، من سياقات فكرية جمالية، أو ما تقترحه من أفق شعري لكتابتها، إذا نحن اعتبرنا الأعمال الثلاثة، تدخل في سياق مفهوم الكتابة، أو أنَّ الشفاهةَ فيها تخِفُّ وتَلِين، ولم تَعُد. كما في «القصيدة» أو في الشعر الغنائي، هي المُهَيْمِنَة.
ليس سهلًا أن تقرأ كتاباتٍ لِشُعراء من جيل التسعينيات، ومن اليمن تحديدًا، لكون هذه الكتابات، تقتضي أن يستعيد القارئ، أو الناقد ما مَرَّ لِفَهْم ما تعنيه بعض كتابات شُعراء هذا الجيل، في علاقتها بما كان قبلها. وليس سهلًا أن تكتفي بقراءة عدد محدود من هؤلاء الشعراء، وفي عمل واحد لكل واحد منهما. لكن اختيارنا المنهجي، يقوم في هذه القراءة، وفي هذا الاختيار، على الاكتفاء بالعمل، ولا شيء غير العمل، ففيه ما يكفي من آثار أو ملامح التجربة، أو بعض آثار وملامح تجربة، إما تكون في طَوْر البناء والتَّشَكُّل، أو تكون شرعَتْ ملامِحُها تبدو بما يجعلها تجربة بالفعل. وهنا، لا بُدّ أن أوضح ما أعنيه بالتجربة، حتى لا نأخذها بالمفهوم العامّ الذي نطلقه هكذا، دون تحديده.
التجربة، هي تراكم كَمِّيّ، يفضي، إذا ما كان مَبْنيًّا على رؤية، وعلى وعي فكري جمالِيّ، إلى ما هو نوعيّ في هذه التجربة، ما يخُصُّ الذات الشاعرة، ما تكون هو، أو ما أعتبره دَمَ الشاعِر الشخصيّ، يجري، أو ينبض في نَصِّه، وفيما يكتبه وينشره من أعمال تكون لها صفات، وخِصال، وملامح، أو خَواصّ بنيوية، حالما نقرؤها نتبيَّن لمن تكون، لكن، ليس بمعنى الاستقرار والتكرار، بل بمعنى الصيرورة والاستمرار، أو بمعنى الخلق والإضافة والإبداع.
 إذن، نحن لن نُسائِل هذه الأعمال بغيرها، بل بذاتها، ولن نقيس الحاضر على الغائب، أو نُسْقِط الماضي على الراهن، فما نذهب إليه، هو الحديث عن الأعمال التي بين أيدينا، (عبدالوهاب المقالح، مقطع آخر من تنهيدة طويلة. محمد اللوزي، بيدق أسود في يد الجنرال. أحمد السلامي، قديس خارج اللوحة. وكلها صادرة في 2023م وعن دار نشر واحدة: منشورات مواعيد، صنعاء) بما تقوله هي عن نفسِها، وما يمكن أن يكون جرى فيها من إحداث وابْتِداع، أو مِنْ مُفارقات، هي إضافات في المشهد الشعرِيّ، لا اليمني فقط، بل العربيّ، حتى نُوسِّع الدائرة أكثر، ونخرج من التصنيفات الجغرافية، إلى التصنيفات الشعرية التي تحكمها السِّياقات الفكرية الجمالية.
إذن، نحن لن نُسائِل هذه الأعمال بغيرها، بل بذاتها، ولن نقيس الحاضر على الغائب، أو نُسْقِط الماضي على الراهن، فما نذهب إليه، هو الحديث عن الأعمال التي بين أيدينا، (عبدالوهاب المقالح، مقطع آخر من تنهيدة طويلة. محمد اللوزي، بيدق أسود في يد الجنرال. أحمد السلامي، قديس خارج اللوحة. وكلها صادرة في 2023م وعن دار نشر واحدة: منشورات مواعيد، صنعاء) بما تقوله هي عن نفسِها، وما يمكن أن يكون جرى فيها من إحداث وابْتِداع، أو مِنْ مُفارقات، هي إضافات في المشهد الشعرِيّ، لا اليمني فقط، بل العربيّ، حتى نُوسِّع الدائرة أكثر، ونخرج من التصنيفات الجغرافية، إلى التصنيفات الشعرية التي تحكمها السِّياقات الفكرية الجمالية.
سياق مأساوي تراجيدي
فكريًّا، حين نتأمَّل هذه الأعمال التي صدرت عن الدار نفسها، وفي السنة نفسها، سنجدها تلتقي في أشياء، يغلب فيها السياق المأساوي التراجيديّ، وكأنَّنا إزاء مَراثٍ معاصرة، ليس فقط لما حدث أو يحدث في اليمن، بل ما يتجاوز اليمن نفسَه، ويمسّ الإنسان في عمومه، أو غير اليمن من جغرافيات أخرى، ربما تعيش الوضع نفسه، أو ما هو قريب منه، من حيث طبيعةُ هذه المأساة، وما يعتريها من خُدوش وجراح أو مآسٍ. وأودّ، هنا، أن أفْصِل تجربة أحمد السلامي، في عمله «قديس خارج اللوحة» عن الكتابات الأخرى؛ لما تتميَّز به خواصّ شعرية، يمكن اعتبارها سمات، أو ملامح تجربة، تدخل في إطار شعريةٍ المُغايرة والاختلاف، شعرية تقوم على المفارقة، وعلى نوع من الباروديا التي تجعل اللغة تمتلئ بمجازات، هي، في جوهرها، تعبير عن المأساة نفسها، لكن من نافذة أخرى، ذات رؤية شعرية الواقع فيها تابع للشِّعْر، يسير خلفَه، وليس الشعر ما يتبع الواقع، فقط، ليقوله، بما يمليه هذا الواقع، وهذه هي مشكلة بعض زملائه من الشعراء، بل ما صِرْنا نقرؤه من كتابات في العالم العربيّ اليوم، أغلبها، الواقعُ ما يكتبها، وليست هي ما يكتب الواقع، أو يُعيد كتابته.
وبما أنَّ الشعر، عكس غيره من أجناس أو أنواع الكتابات الإبداعية الأخرى، هو مُحايَثةُ الفكر للشِّعْر، أو هُما جوهر واحد لِنَصّ واحِد، لا يمكن عَزْلُ الواحِد منهما عن الآخر، إلا إجرائيًّا، فقط، فما تَطْرَحُه بعض هذه الأعمال الأربعة من مشكلاتٍ، ترتبط بهذا العَزْل بالذات، وهو عَزْل سَببُه رؤية الشاعِر وفهمُه للشِّعْر، أو طبيعة المِساحَة الشعرية التي اقْتَطَعَها لنفسه، وصارت هي زاوية نظره للشِّعْر.
مقطع آخر من تنهيدة طويلة
يمكن أن أقف، مثلًا عند تجربة عبدالوهاب المُقالِح، في «مقطع آخر من تنهيدة طويلة». هذا العمل، لم يخرج من النَّفَس التقليدي للشِّعْر، أو لم يتحرَّر كُلِّيًّا من «القصيدة» بمعناها التاريخِيّ، بما هي دَوالّ، أو بناء، بالأحرى، بما يستغرق هذا البناء من وَعْي شفاهي إنشاديّ، لا تظهر فيه ملامح أو سِمات الوعي الكِتابِيّ، الذي هو وعي لا تبقى فيه سلطه للشَّفاهة، باعتبارها ما يهيمن على الخِطاب، أو هي الخِطاب ذاته، لا النَّص الذي هو كتابة، ووعي بطبيعة الكتابة، وما تمليه من لغة وتركيب، يتَّسِم بالهُدوء والتَّروِّي، وبالتعثُّر في القراءة ذاتها، وبالتَّخفُّف من الغِنائية والصوت الواحد، وكذلك من النُّزوع النَّظْمِيّ، الذي هو صدًى للوزن أو التأثير العَروضي على الأذن، بالانتقال إلى الإيقاع الذي يُعْتَبَر الوزن عنصرًا من عناصره، لا هو الوزن وحده، كما توهَّمَت نازك الملائكة ذلك في الشعر المُعاصِر، واعتبرت الوزن، أو الشعر «ظاهرة عروضية»، لتختزل الشعر في الموسيقا، دون الخيال، ودون ما يمكن أن يحفل به الشعر من دَوالّ شعرية هي ما يُوسِّع مفهومه، يخرج به من ماضيه إلى مستقبله، ومن البُعْد الغنائيّ، إلى البُعْد الملحميّ، الذي يتناغم أكثر مع الرُّؤية التراجيدية، أو المأساوية.
 حتى اللغة في هذا العمل، هي لُغَة لا تعرف هل تذهب إلى المستقبل، بما يظهر فيها من نزوع نحو لغة الراهن الشعرِيّ كما يبدو في أكثر من مثال في الديوان، أم تبقى في الماضي، بنوع من المُراوَحَة بين الزَّمَنيـْن، أو المسافتَيْن، وهُما ليسا الشيء نفسه. وإذا كان مثال «الحديث يطول»، وهو أوَّل ما يبدأ به الديوان، هو تعبير عن ماضوية البناء واللغة والإيقاع والرؤية، أيضًا، وما يستعمله الشاعِر من مفردات تعود بنا إلى قديم شِعْر اليمن، أو نـَجْد والحجاز، أو بيئات الشعر العربيّ الأولى، بما فيها ما ظهر من شعر بعد الإسلام. يقول الشاعر:
حتى اللغة في هذا العمل، هي لُغَة لا تعرف هل تذهب إلى المستقبل، بما يظهر فيها من نزوع نحو لغة الراهن الشعرِيّ كما يبدو في أكثر من مثال في الديوان، أم تبقى في الماضي، بنوع من المُراوَحَة بين الزَّمَنيـْن، أو المسافتَيْن، وهُما ليسا الشيء نفسه. وإذا كان مثال «الحديث يطول»، وهو أوَّل ما يبدأ به الديوان، هو تعبير عن ماضوية البناء واللغة والإيقاع والرؤية، أيضًا، وما يستعمله الشاعِر من مفردات تعود بنا إلى قديم شِعْر اليمن، أو نـَجْد والحجاز، أو بيئات الشعر العربيّ الأولى، بما فيها ما ظهر من شعر بعد الإسلام. يقول الشاعر:
«الحديث يطول/ والمفاجآت تفضي إلى شرف القول/ تفضي إلى سدرة المنتهى وتؤول/ وحنين الفؤاد يحمحم مثل البراكين/ يدمدم مثل السيول. / شهقة وطبول/ وسيول تليها سيول». والقافية متوالية، لا مسافة فيها بين رَوِيّ وآخر، بل هي نفسها تتكرَّر بنفس الصيغة الصَّرْفِية [فعول]، وكذلك بالتكرار والاستعادة، وهذه من تداعيات التَّدْوِين، لا الكتابة، أي تدوين اللسان، ما نلفظه على الورق، لا ما نكتبه فيه وعليه، ويكون بغير وعي الشفاهة والإنشاد. والمُثير في هذا الديوان، هو عدم استقراره على تجربة واضحة المعالم تَخُصُّ الشاعر وتُميِّزُه. ما يلي هذه «القصيدة»، هكذا نُسَمِّيها لأنها اختارت لنفسها هذا المفهوم بما اسْتَدْعَتْه من دوالّ قديمة، يختلف تمامًا، من حيث البناء، واللغة، والإيقاع، ومن حيث الفكرة نفسها، وكأن لا شيء يجمع بين القصيدتين، وهو ما اعتبرناه مُراوَحة، هي في الحقيقة، بحث عن الذات، وعن مُسْتَقَرّ شعريّ، وكأنَّ الشاعر، بقدر مَيْلِه إلى الحاضر، فهو لا يفتأ يلتفت خلفه بحنين جارِفٍ إلى ماضٍ، ربما هو أساس تكوينه الشعريّ. نقرأ في الصفحة الموالية، بنوع من الانتقال المفاجئ، أو غير المُبرَّر فنِّيًّا وشعريًّا: «هل أنذا أراك، أيها العائد/ وأنت تطل على قريتك التي امَّحَت إلا من ذاكرتك/ أراك تبتسم ابتسامة حزينة/ مخضلّة بالدمع وقد استيقظت ذكريات».
أولئك الذين أوجعوك/ وذكريات أولئك الذين كانوا لطيفين معك.
من نَفَس الشعر، بما هو نَسَق، وبما هو بناء يحُثُّ على «القصيدة» ويستدعي دوالَّها المُبَنْيِنَة لها، إلى النَّفَس النثري، أو ما يبدو بهذا المعنى، تحرُّرًا من نسقية «القصيدة»، ورغبة في الدُّخول إلى الشعر بما فيه من رحابة واتِّساع. وهنا، لا بد أن نوضح الفرق بين «القصيدة» والشعر، فالشعر نوع جامع، و«القصيدة» هي شكل من أشكاله، تتسمَّى به ولا يتسمَّى بها بالإطلاق، كما حدث في زمن التدوين، حين اختُزل الشعر العربي كاملًا في المثال الجاهلي، أي في «القصيدة» التي أصبحت هي كل الشعر، دون غيرها من الأشكال التي سُكِتَ عنها أو تُجُوهِلَت. ثم إنَّ الشعر ليس جمع قصيدة، وهي ليست مفرده؛ لذلك فمفهوم شعر في العربية، يدُلّ على الكثرة والتَّنوُّع والتعدُّد، وهذا ما عبَّرت عنه الحداثة الشعرية في وضعها المُعاصر، على الرغم من أنها لم تستطع أن تخرج من هيمنة «القصيدة»، بما هي بناء شفاهي إنشاديّ، وببنيتها الغنائية ذات الصوت الواحد، وهذا ما حدث حتى في تجارب شعراء جماعة شعر، مع استثناءات قليلة، بينها تجربة أنسي الحاج، وشوقي أبي شقرا.
المُفارقاتُ التي نلمَسُها، كقُراء، عند هذا الشاعِر، هي هذا التَّناوُس بين السِّياقات، أو الخُروج من سياق فنِّيّ جمالِيّ إلى آخر، دون مُبرِّرات شعرية، أو فنية، يمكن الْتِماسُها من «القصيدة» ذاتها، أو من الديوان كاملًا؛ لأنَّ الديوان ليس تجربة واحدة، بل هو قصائد، بعضها يمسك برقاب بعض، وبعضها لا علاقة بما يليه، أو يأتي تالِيًا عليه، أو حتى ابْتِعاده بمسافات زمنية معينة.
فبقدر ما نظنُّ أنَّ الشاعِر، في لحظات من الديوان، خرج من دوالّ الشعر التقليدي، التي لا تخطئها العين، الأحرى بالأذن، بما يعتريه من رتابَةٍ في التعبير، ومن خلُوِّ القصيدة من الصُّوَر الشعرية، التي هي دالّ من الدَّوال البانية لشعرية النَّص الحداثي، أو الشعريّة المُعاصرة بكل تجلياتها الفنية والفكرية الجمالية، نجد الشاعر يعود بنا إلى «القصيدة»، هذا الماضي الشعرِيّ المستولي، فيما يبدو، على ثقافة ووعي الشاعِر، وعلى تكوينه ربما.
المعنى المباشر
يبقى المعنى المباشر من نتائج هذا الاختيار الشعرِيّ الجماليّ، ومن تبِعاته، وهو معنى خَطابِيّ لا يتوارى خلف مجازاتٍ تُبْقِي الشعر في سياقه الخاص به، لا أن يتحوَّل إلى لغة القَصْد فيها هو ما تقوله، لا كيف تقول. وقصيدة «موعظة العرش»، هي مثال، من بين أمثلة أخرى لهذا الخطاب المُباشر، الذي يمكن، مثلًا، أن نجد مُعادله في قصيدة درويش «خطبة الدكتاتور»، التي حاول فيما بعد أن يتخلَّص منها، وهو ما نجده في هذا القصيدة، التي هي نوع من الصَّدَى، صاحب العرش، والحاكم المطلق هو المتكلم، عن عرشه، وعن الثروات التي احتكرها لنفسه، وما أشْعَلَه من فِتَن وحروب، أو ما تركه وراءَه من دَمارٍ. فقط، الدكتاتور، هُنا، كأنَّه أمام مرآة نفسه، بنوع من المراجعة لهذه الذات التي طَفَتْ على نفسها، بما بلغته من تضخُّم وغطرسة واستفراد بالسلطة والقرار.
فديوان المقالح، كما أراه، هو تجميع لقصائد ليست من التجربة نفسها، أو ليس تجربة واحدة، فهو كتابات، هكذا جُزافًا جُمِعَت ضمن كتاب واحد، في حين أنَّ جَمْعَها، في ذاتها، تعبير عن ارتباكها، وعن التَّشوُّش الذي تخلقه عند القارئ، الذي لا يستطيع معرفة الاتجاه، أو المنحى الذي يرغب الشاعِر أن يسير فيه، هل بالنظر إلى الخلف، أم باستشراف المستقبل، لا شيء واضح، وهذه من معضلات الحداثة حين تكون ملتبسة، ليس في الرؤية، فقط، بل في المفهوم والتصوُّر أيضًا، فالشاعِر، بهذا المعنى، إذا اسْتَعَرْنا تعبيرًا لجاك دريدا، فيه تحدَّث عن الحدود الممكنة لتجربة أنطونان آرْطُو المسرحية، فهو «يُبْقي نفسَه عند حَدٍّ ما… ونحن حاولنا أن نقرأه عند هذا الحدّ».( عن روبن كريسويل، مدينة البدايات (الحداثة الشعرية في بيروت)، ترجمة وتقديم د.عابد إسماعيل، دار التكوين، دمشق سوريا، 2022م (ص 318).
قديس خارج اللوحة
النقيض لعبدالوهاب المقالح، أحمد السلامي، في ديوانه «قدِّيس خارج اللوحة»، رغم ما يلتقيان فيه من أفكار، أو مَراثٍ، بما يتجاوز المرثية بمعناها الشَّخْصِيّ، إلى المعنى المأساوي الوجوديّ، خصوصًا ما جرى في اليمن من أحداث مُتتالية، ضاعَفَت وضع اللامدينة، بما يعنيه مفهوم المدينة من عمران بالمعنى الخلدونيّ، بل أدخلت أيضًا الشَّك في نفس الإنسان الذي صار يتساءل، عمن يكون الإنسان، وكيف هو الإنسان، وما معنى أن يكون الإنسان إنسانًا، في وضع ملتبس، لا ينفكّ غموضه يزداد كثافةً واضطرابًا.

عبدالوهاب المقالح
هذا المعنى، بما يحتمله من سُخرية، ومن باروديا، ومن لعب بالمجازات، هو ما يتبدَّى بوضوح في تجربة أحمد السلامي، الذي يبدو أن ديوانَه، هو عمل واحد، ينتظمُه خيط به يَشُدُّ عُرَى الثوب، ويحبك زمامه، بما امْتازَ به هذا الدِّيوان من نُزوع حداثيّ لا غُبار عليه، في سياقاته التعبيرية الكتابية، التي تصير معها الشفاهةُ، عنصرًا من عناصر البناء، وليست عنصرًا مهيمنًا، كما في تجربة زميله عبدالوهاب المقالح. لستُ بصدد المقارنة بين الشاعرين، بل، طبيعة المفترق الذي يتقاطعان فيه، هو ما يُلِحّ عليَّ كقارئ أن أتساءل، فقط، بشأن العلاقة التي تجمعهما، لأميِّز ما يُجافِي به كل واحد منها الآخر، وينأى بذاته عن غيره، خصوصًا أنهما من الجيل نفسه، ومن المكان نفسه، كما أنَّ ناشرَهُما واحد، وفي السنة نفسها، وهي السنة الحالية (2023).
وحدة تصور شعري
تتميَّز تجربة أحمد السلامي، إذن، بتناغمها ووحدة تصوُّرها الشعرِيَيْن. لا يبدو الخروج من نصٍّ، وهنا نُؤكِّد مفهومَ النص لا الخِطاب؛ لأنَّنا إزاء بناء شِعْرِيّ كِتابِيّ، يقوم على كثافة في الرؤية، ما أفضى إلى كثافة المجاز والصُّوَر الشعرية، وذهاب النَّص نحو الإيقاع، باعتباره أكبر من الوزن نفسه، فهو يشتمل عليه، أو على بعض ظلاله دون أن يذوب فيه، أو يكون مُجرَّد تفاعيل هي ما يفرض الصُّورَة أو بناء الجملة وتركيبها.
في ندوة حول محمود درويش، كُنْتُ، بحضور محمود، أثَرْتُ الانتباه إلى بناء النَّص الشعرِيّ عنده في «لماذا تركْتَ الحصان وحيدًا»، إلى أنَّ القارئ ما لم ينتبه إلى الوزن في الديوان، فهو سيظنُّ أنَّك كتَبْتَ «قصيدة النثر» التي كُنْتَ انْتَقَدْتَها، فكان جواب محمود بالمُوافقة على هذه الملاحظة، وقد أشار إلى أنَّ ناقِدًا عربيًّا معروفًا كتب عن الديوان، يعتبره أوَّل تجربة في النثر لمحمود درويش، في حين أن محمودًا، كما أكَّد هو نفسُه ذلك، سعى إلى الكتابة بلغة تخَفَّفَت من ثقل الوزن من جهة، ومن البناء البلاغي الذي يكون عبئًا على الشعر.
بهذا المعنى يمكن أن نقرأ ديوان «قِدِّيس اللوحة»، الذي فيه ما يمكن اعتباره خِفَّة الشعر الذي يُحْتَمَل، دون أداة نفي ميلان كونديرا، في عنوان روايته المعروفة. ما يُواجهنا به هذا العمل الشعرِيّ، هو كثافة الصُّور، بما فيها من مجازات طارئة، هي من طباعة النَّصّ المكتوب الذي تكون فيها الجمل خاطِفَةً، لكنها مُفْعَمَة بالدهشة والغرابة، وهذا لا يحدث على مستوى الجملة أو الصورة وحدها، بل قد يكون النص بكامله مجازًا. نقرأ في «مُغْلَق للتَّوْبَة»:
أُرافِقُ اليَأسَ كُلَّ يَوْمٍ/ نُمارِسُ معًا رِيَاضَة الصَّمْتِ/ ونتسَلَّى بِجَمْعِ القَلَقِ/ نَلْتَقِطُ الخَطَوَاتِ الَّتِي تَشِي بِهِ/ نَحْشُرُهَا فِي عُلَبِ صَمْغٍ/ لَعلَّها تَبْقَى حَبِيسَةً/ لَكِنَّنَا نَتَعَثَّرُ بِهَا مِنْ جَدِيدْ. / أرَافِقُ اليَأسَ/ فَأَكْتَشِفُ أنَّه يَسْبِقُنِي نَحْوَ الأمَل بِخطْوَةٍ/ أحْسدُه على أصْدِقَاء السُّوءِ الجَيِّدِينَ/ أخْبِرُهُ بِذَلِكَ عَقِبَ الانْتِهاء من جَوْلَتِنَا/ ثُمَّ نَفْتَرِقُ/ يَـمْضِي مُثْقَلًا بِرَغَبَاتِهِ/ يَهْرُبُ إلَيْهَا لِيَدْفِنَ الفَائِضَ مِنَ القُنُوطِ/ وأمْضِي إلى عَالَمِي المُتَشائِلِ/ أهَدْهِدُ أيامِي بِرِفْقٍ/ وأحْرُسُ فِي رأسِ مَصْنَعَ نَبِيذٍ/ مُغْلَقٍ للتَّوْبَة!».
هنا تتجلَّى شعرية المُفارقَة والباروديا بشكل واضح، وهو ما يفرض على النَّصّ أن يكون مجازًا واحِدًا يُوَزَّع بالتَّقْسِيط على لحظات النَّص، أو في المواقع التي تكون هذه الباروديا اسْتَوْفَت ظهُورَها، لِتَهَبَ النَّص تأثيره، وما يحدث في بنائه من تَصَاعُد، من البَسيط إلى المُركَّب، أو من المُسْتَقِرّ إلى المُتوتِّر. فلا أحَد سيتوقَّع في هذا البناء التصاعُدِي، أو التصعيديّ، بالأحرى، أن تصل هذه الباروديا إلى «مصنع نبيذ» في الرأس، «مُغْلَق للتَّوْبة»، رغم وجود علامة التعجّب [!] التي لا داعِيَ لها في مثل هذا الموقف؛ لأنها موجودة في المعنى ذاته.
الديوان نسيج واحِدٌ، بهذا البناء، وبهذه اللغة، وبهذا الإيقاع، وبهذه المفارقات، أو الصُّوَر التي تصدم القارئ، وتُـحْبِط توقعَه، وهذا ما تُؤكِّده نظرية التلقي، التي تعتبر العمل الجيد، هو ما أخذ القارئ إلى ما لم يتوقعه من حالات ومواقف، فما ينتظره من حلّ يصير مشكلةً أو مأزقًا.
صورة مَرَاثٍ

أحمد السلامي
أما ما يتعلَّق بالمعنى، حتْمًا سيدرك القارئ أنَّ مثل هذا النَّوْع من الشعر، لا يمنح نفسَه أو نَصَّه للقارئ، كما يمكن أن يجده في وضع «القصيدة» التي هي خِطابٌ، وشفاهَة، وتدوين للملفوظ، لا لما هو كِتابِيّ أو مكتوب. ولعلَّ نفس المعاني التي الْتَمَسَها عبدالوهاب المقالِح، نجدها في صورة مَرَاثٍ، أو موت فجائعِيّ، مأساته تتضاعف بما يجري في البلاد من مآسٍ، عند أحمد السلامي، لكنها عنده، تلبس لبوسًا شعريًّا، في بناء نَصِّيّ، بلوغ ما يقوله، يحتاج إلى وعي الشَّرْط الشعرِيّ الكتابِيّ في العمل، أو في النص، لا بإفراغ النَّص من سياقه الشعرِيّ الكتابِيّ، أو من طريقة القَوْل، والذَّهاب رأسًا ما يُقال.
فأحمد السلامي كأنه، بهذا النوع من الكتابة، يطلب من قارئه أن يأتيه «بريشة من جناح الذُّل من الرحمة»، إذا أراد أن يملأ له قِنِّينَتَه بـ«بِماء المُلام»، وفق حكاية أبي تمام، مع من جاء يطلب منه هذا الماء الذي تكلَّم عنه في شعره، وهو غير موجود في الواقع.
بيدق أسود في يد الجنرال
بين أهم ما أفْرَزَتْه حالات الإحباط، وما يجري من انقلابات وحروب، واستفراد بالسلطة، أو تنازع عليها، وما تعرفه بعض البلاد العربية، من أوضاع مُضْطَرِبَة، بما تتركُهُ من انعكاسات على الإنسان، لجوء الشعر، بصورة خاصة، إلى السُّخرية، وإلى قلب الوقائع والأحداث، بالنظر إليها من زاوية مقلوبة، ربما، لفهم ما يجري بشكل أفضل، لكون الشيء المقلوب أو المُنْقَلِب، لا يُرى، ولا يُقْرأَ إلا مقلوبًا أو مُنْقَلِبًا. هذا ما تُعبِّر عنه تجربة محمد اللوزي في عمله «بيدق أسود في يد الجنرال».

محمد اللوزي
فالباروديا، هي ثِيمَةٌ تجمع عددًا من شُعراء اليمن، من جيل التسعينيات، وهذا لا يعني أنها لم توجد من قبل في الشعر اليمني، بل يمكن أن نعود بها إلى بعض قصائد الشاعر عبدالله البردوني، وقصيدتُه عن اليمن، تكفي لنقرأ هذه الباروديا، أو السخرية الهجائية، التي مسَّ بها ما أصاب البلاد من يأس وبؤس و«جَرَب»، بنوع من النقد اللاذع القاسي، من دون أن نكتفي بالتجارب الحداثية، أو ما ينتسب منها إلى الشعر المُعاصِر.
محمد اللوزي، عمله كاملًا، هو، من جهة، نسيج كتابِيّ واحد، الرؤية فيه هي نفسُها، بنفس اللغة، وبنفس طريقة النظر إلى الواقع والأشياء التي تُحيط به، كما أنَّ العمل يميل إلى ما يُسَمِّيه ميرلو بونتي بـ«نثر العالَم»، أو النظر إلى العالم نثريًّا، والنثر هنا، لا يعني الكتابة نثرًا، بل النظر إلى الأشياء وكتابتها بما هي عليه من تفكُّك، وتَشَتُّت، وانفراط، وتَشَظٍّ، باستثناء عبدالوهاب المُقالِح الذي لن يُغادر بشكل كُلِّيّ بلاغة «القصيدة»، وما تشترطه من دَوَال شعرية، تهيمن فيها بنية الشفاهة والإنشاد، فباقي الشعراء، عرفوا كيف يستثمرون النثر لصالح الشعر، على الرغم من أن هذا التقسيم بين لغة للنثر وأخرى للشِّعْر، لا ينبغي قبوله، فالشعرية، إما أن تتحقَّق في النص وفي العمل وفق بناء ووعي شعريين كتابيين، أو لا تكون.
النظر إلى العالم بالقلب
النظر إلى العالم بالقَلْبِ، هو الوسيلة الوحيدة التي أتاحت لمحمد اللوزي أن يقول ما يرغب فيه، من دون استعمال الأقنعة، فالجنرال هو الجنرال، والبيدق الأسود هو البيدق الأسود، وتركيب الصورة كاملةً، هو ما يجعل اليَد، وهي تكتُب، تعبث بها، بإعادة صناعتها، أو تخيُّلِها بنوع من الباروديا التي يمكن أن نعتبرها هنا سوداء، والسواد، هو ما يُجلِّل العمل، وما يحكم صباغة القُماش، أو يغلب على بياضه. نقرأ في مقطع من «الملك والشجرة»:
«الملك الذي كان يرى الفلاحون صورته في القمر/ وفي عظمة الضان المشوية نهار العيد/ الملك الذي اتَّهم شجرةً بسرقة الجنود/ وقيَّدها بالسلاسل ذات خوف/ ملك بلدتنا/ الذي بمجرد أن عزله الشعب/ اختفت صورته من القمر ومن عظمة لحم الضان/ وهرولت الشجرة في شوارع المدينة تُغنِّي».
الطريف في هذا العمل، وفي النصوص التي على نفس وتيرة هذا النص، اللغة، إذا نحن لم نحذر فِخاخَها، قد تبدو مُباشِرةً، لكن إقحام تعبيرات معينة على الصورة، أو الجملة، تَقلِب المُباشر إلى مجازٍ، فالعنوان «الملك والشجرة»، يمكن أن نقرأه برؤية الملك التي كانت لا ترى إلا الشجرة، لا الغابة، ما أخفى عنه حقيقة الفلاحين الذين كانوا يرون صورتَه في كُلّ شيء؛ لأنه هو موجود في كل شيء، لا بفعل الواقع، بل بفعل الاستيهام، وما كانت له من سلطة على الفلاحين، بل على الطبيعة نفسها، سقوط جنود الملك، هو سقوط الملك، أو سقوط الشجرة، هو ظهور للغابة، فهو لم يقيد الشجرة، بل قيَّد رؤيته للأشياء، التي كانت كلها مُتوهَّمة. فالسلطة هي سلطة الشعب، والقرار هو قراره، والقمر هو نفسه القمر، لكن هذه المرة قد يكون بصورة ملك، أو زعيم آخر يحُلّ مَحلَّه.
أوسع من النظر إلى الشجرة
السلطة، إذن، هي لعبة شطرنج، والملك فيها، غالبًا ما يلعب بالبيدق الأسود، وهو بيدق، مهما تحرَّك بحرية في مساحة اللعبة، فهو لا محالة خاسِر، ما لم تكن رؤيته أوسع من النظر إلى الشجرة.
حتى حين يرثي الشاعِر بعض القريبين منه، من الشعراء، أو من غيرهم، فهو يصدر عن نفس الرؤية، وعن نفس الموقف، فالبلاد، دائمًا، هي إطار الصورة، وهي الصورة، إذا شئنا، وهي بلاد الضحية فيها قد يتحوَّل إلى جلّاد، بحكم ما في البلاد من عبثية، ومواقف سوريالية، فيها تتداخل المواقف والمواقع، وتختلط الأصباغ والألوان والأوراق، والصورة تصبح مثل قطعة البازِل التي مهما ركَّبْناها، فهي تبقى ناقصة، أو مقلوبة لا وُضُوح في تركيبها. ويمكن اختزال لغة، وبناء الصُّوَر، وطبيعة الباروديا المُرَّة السوداء، في هذا المقطع من نص «سجان»:
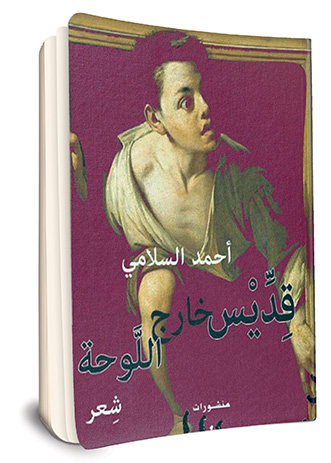 «حبَس دموعَه في عينيه،/ حبس ضحكاته وآهاته،/ حبس شُرودَه،/ هكذا صار السجينُ القابع في الزنزانة سَجانًا/ وفي يده تُجلجلُ الهروات».
«حبَس دموعَه في عينيه،/ حبس ضحكاته وآهاته،/ حبس شُرودَه،/ هكذا صار السجينُ القابع في الزنزانة سَجانًا/ وفي يده تُجلجلُ الهروات».
في أغلب هذه الدواوين، يستغني الشعراء عن الترقيم، النقط، والفواصل في النَّص، لكن هذا النص، فيه فواصل، فهل نقرؤها بما يثوي في دلالات النص، وما يُوحِي به من سجن وسجان، وهذا ممكن، لكون ما سبق هذا النص، وما جاء بعده، كان خاليًا من الترقيم. وهو ما يعني أنَّ اللغة وحدها لا تكفي في قول المعنى، فثمَّة دوالّ أخرى في الشعر، لا ننتبه لأهميتها في نسيج العمل أو النص، كما يحدث في هذا النَّص بالذات.
وإذن، فنحن، كما سَلَفَت الإشارة، أمام متن شعريّ، لجيل واحد، يكتب في نفس السياق، بنفس اللغة، وبنفس المجاز، وبنفس الرؤية، الوطن، لكن، وطن المُفارقات، ووطن الانقلابات، والوطن السجن، الضحية فيه قد يصير جلادًا، الوطن الذي لا يعرف الاستقرار والاستمرار، الوطن الذي تحجب الرؤية عنه ما يجري فيه من حكم مفرد، حكم تبقى فيه الأحلام مُؤجَّلَة، كون السجين، يقبل فيه أن يصير سجانًا.
مرارة الإخفاق
يكشف لنا، هذا، في حدود هذه الدواوين التي قرأناها هنا، أنَّ التجربة اليمنية، عند هذا الجيل، هي تجربة لم تُفْرِز بنيات مشتركة، اللهم إلّا في السياق الفكري، أو في سياق المعنى، حيث نجد البنية الجنائزية المأساوية، التي يغلب فيها الموت والرثاء والغياب، كما تغلب فيها مرارة الإخفاق والفجيعة التي لا تقتصر على الأشخاص، بل تمسُّ وطنًا أو بلدًا بكامله، ما زال لم يستطع الخُروج من المِصْيَدَة الكبيرة التي حاقَت به، أو أطبقت عليه، فمن إخفاق إلى إخفاق، ومن سقوط إلى آخر، وكأنَّ قَدَر هذا الوطن، أو هذا الواقع، هو هذا السقوط والانْفِطَار.
إنَّنا، إذن، في هذه الأعمال على رغم نسبيتها، أمام تجارب شعرية فردية، يبدو أنَّ بعضها لا يشكل تجربة ذاتية، أو أنَّ ما يكتبه الشاعر نابع من رغبة في التجريب، وفي إحداث الاختراق والاختلاق… ثمَّة من هذه التَّجارب، إذن، ما هو ناضِج، فيه حضور للذات الشاعرة، وما تميَّزت به من خصوصية في الكتابة، وفي التَّصوُّر، بل في طبيعة الرؤية، وما تحقَّق فيها من سخرية ومفارقة، أو باروديا، لقول الأشياء، وكذلك في طريقة القول التي هي ما جعل شعريتها تكون متماسكة، ذات منحى رؤيويّ فريد وواعِد.







 إذن، نحن لن نُسائِل هذه الأعمال بغيرها، بل بذاتها، ولن نقيس الحاضر على الغائب، أو نُسْقِط الماضي على الراهن، فما نذهب إليه، هو الحديث عن الأعمال التي بين أيدينا، (عبدالوهاب المقالح، مقطع آخر من تنهيدة طويلة. محمد اللوزي، بيدق أسود في يد الجنرال. أحمد السلامي، قديس خارج اللوحة. وكلها صادرة في 2023م وعن دار نشر واحدة: منشورات مواعيد، صنعاء) بما تقوله هي عن نفسِها، وما يمكن أن يكون جرى فيها من إحداث وابْتِداع، أو مِنْ مُفارقات، هي إضافات في المشهد الشعرِيّ، لا اليمني فقط، بل العربيّ، حتى نُوسِّع الدائرة أكثر، ونخرج من التصنيفات الجغرافية، إلى التصنيفات الشعرية التي تحكمها السِّياقات الفكرية الجمالية.
إذن، نحن لن نُسائِل هذه الأعمال بغيرها، بل بذاتها، ولن نقيس الحاضر على الغائب، أو نُسْقِط الماضي على الراهن، فما نذهب إليه، هو الحديث عن الأعمال التي بين أيدينا، (عبدالوهاب المقالح، مقطع آخر من تنهيدة طويلة. محمد اللوزي، بيدق أسود في يد الجنرال. أحمد السلامي، قديس خارج اللوحة. وكلها صادرة في 2023م وعن دار نشر واحدة: منشورات مواعيد، صنعاء) بما تقوله هي عن نفسِها، وما يمكن أن يكون جرى فيها من إحداث وابْتِداع، أو مِنْ مُفارقات، هي إضافات في المشهد الشعرِيّ، لا اليمني فقط، بل العربيّ، حتى نُوسِّع الدائرة أكثر، ونخرج من التصنيفات الجغرافية، إلى التصنيفات الشعرية التي تحكمها السِّياقات الفكرية الجمالية. حتى اللغة في هذا العمل، هي لُغَة لا تعرف هل تذهب إلى المستقبل، بما يظهر فيها من نزوع نحو لغة الراهن الشعرِيّ كما يبدو في أكثر من مثال في الديوان، أم تبقى في الماضي، بنوع من المُراوَحَة بين الزَّمَنيـْن، أو المسافتَيْن، وهُما ليسا الشيء نفسه. وإذا كان مثال «الحديث يطول»، وهو أوَّل ما يبدأ به الديوان، هو تعبير عن ماضوية البناء واللغة والإيقاع والرؤية، أيضًا، وما يستعمله الشاعِر من مفردات تعود بنا إلى قديم شِعْر اليمن، أو نـَجْد والحجاز، أو بيئات الشعر العربيّ الأولى، بما فيها ما ظهر من شعر بعد الإسلام. يقول الشاعر:
حتى اللغة في هذا العمل، هي لُغَة لا تعرف هل تذهب إلى المستقبل، بما يظهر فيها من نزوع نحو لغة الراهن الشعرِيّ كما يبدو في أكثر من مثال في الديوان، أم تبقى في الماضي، بنوع من المُراوَحَة بين الزَّمَنيـْن، أو المسافتَيْن، وهُما ليسا الشيء نفسه. وإذا كان مثال «الحديث يطول»، وهو أوَّل ما يبدأ به الديوان، هو تعبير عن ماضوية البناء واللغة والإيقاع والرؤية، أيضًا، وما يستعمله الشاعِر من مفردات تعود بنا إلى قديم شِعْر اليمن، أو نـَجْد والحجاز، أو بيئات الشعر العربيّ الأولى، بما فيها ما ظهر من شعر بعد الإسلام. يقول الشاعر:


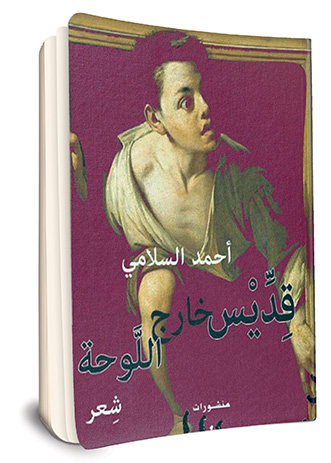 «حبَس دموعَه في عينيه،/
«حبَس دموعَه في عينيه،/


0 تعليق