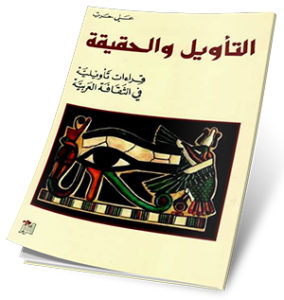 لا شك أن الإرهاب الجهادي هو عنف فاحش لا سابق له، كما تشهد نماذجه كحرق الناس أحياء، أو قتلهم في المقاهي والملاعب، أو دهسهم بشاحنة في الساحات والميادين. ولا يفوق هذه الأعمال البربرية سوى ما قام به ذلك الإسلامي الذي فقأ عيني زوجته؛ لأنها لم تمتثل لأمره بالذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية انتحارية. مثل هذا العنف الأعمى يحتاج إلى قراءة تتقصّى جذوره. وتحلّل الأسباب التي تقف وراءه. والقراءة الجذرية تتناول المسائل على مستواها الفكري، أي من جهة العقليات وأنماط التفكير وأساليب التعامل، ما دامت ميزة الإنسان هي أنه كائن يفكر ويتفكّر فيما يحدث له أو يصنعه من حيث لا يحتسب. قد تكون هناك عوامل مساعدة لانتشار الظاهرة، منها ما هو خارجي كتدخل القوى الكبرى والدول اللاعبة على المسرح. ومنها ما هو داخلي؛ سياسي أو معيشي، حضاري أو نفسي، كما هي مفاعيل الأزمات الناجمة عن الفقر والجور والاستبداد أو عن الاستلاب والإحباط. لكن الأساس في نشوء الظاهرة هو أيديولوجي ثقافي، كما تجسّد في الأطروحة الأصولية السلفية الرامية إلى أسلمة الحياة، بإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة.
لا شك أن الإرهاب الجهادي هو عنف فاحش لا سابق له، كما تشهد نماذجه كحرق الناس أحياء، أو قتلهم في المقاهي والملاعب، أو دهسهم بشاحنة في الساحات والميادين. ولا يفوق هذه الأعمال البربرية سوى ما قام به ذلك الإسلامي الذي فقأ عيني زوجته؛ لأنها لم تمتثل لأمره بالذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية انتحارية. مثل هذا العنف الأعمى يحتاج إلى قراءة تتقصّى جذوره. وتحلّل الأسباب التي تقف وراءه. والقراءة الجذرية تتناول المسائل على مستواها الفكري، أي من جهة العقليات وأنماط التفكير وأساليب التعامل، ما دامت ميزة الإنسان هي أنه كائن يفكر ويتفكّر فيما يحدث له أو يصنعه من حيث لا يحتسب. قد تكون هناك عوامل مساعدة لانتشار الظاهرة، منها ما هو خارجي كتدخل القوى الكبرى والدول اللاعبة على المسرح. ومنها ما هو داخلي؛ سياسي أو معيشي، حضاري أو نفسي، كما هي مفاعيل الأزمات الناجمة عن الفقر والجور والاستبداد أو عن الاستلاب والإحباط. لكن الأساس في نشوء الظاهرة هو أيديولوجي ثقافي، كما تجسّد في الأطروحة الأصولية السلفية الرامية إلى أسلمة الحياة، بإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة.
هكذا نظّر وشرّع الآباء المؤسسون لمشروع الإسلام السياسي، من علماء ومرشدين ودعاة؛ من رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب إلى الخميني وعلي خامنئي، ومن حسن الترابي إلى راشد الغنوشي، وصولًا إلى طارق رمضان. هذه الأطروحة هي ما تعمل على ترجمتها على أرض الواقع المنظمات الإرهابية؛ مثل: القاعدة، وداعش، والنصرة، ومثيلاتها في المعسكر السُّني، أو أضدادها في المعسكر الشيعي.
أين هو دور القرآن الداعي إلى الوسطية والاعتدال والتسامح؟!
حشر القرآن لا يفيد في المساجلة حول تفسير الظاهرة الإرهابية، أولًا- لأن الخطاب القرآني هو كلام يحتمل القول ونقيضه، بقدر ما هو كلام مفتوح على التأويلات المتعددة والمتعارضة؛ ثانيًا- لأن تاريخ الإسلام لم يتشكّل وفقًا لمنطق التعارف ولا بحسب فضيلة التقوى.
ما الذي شكله إذن؟
 إنها المنظومات العقائدية والأنساق الفقهية التي تضيِّق ما اتسع وتقطع ما اتصل. فهي التي أسّست للانشقاق والعداوة، سواء داخل الإسلام أم بين المسلمين وسواهم، بقدر ما اشتغل أئمّتها بلغة التكفير والردّة، أو بعقلية الكره والحقد، أو بمنطق الإقصاء والنفي المتبادل. والحصيلة هي كل هذه البحار من الدماء، وكل هذا الخراب المادي والمعنوي، كما تصنعه الحروب الأهلية الطاحنة أو الأعمال الإرهابية الوحشية على يد الجهاديين من أهل الخلافة أو المجاهدين من أتباع الولاية. لنحسن التشخيص. إذا أردنا معالجة المشكلة، للإرهاب هويته الإسلامية، بوجهيها الدعوي والجهادي، بما هي نمط فكري أصولي اصطفائي، مغلق، وبما هي إستراتيجية جذرية، راديكالية، عدائية، لا تنتج سوى التعصّب والتطرّف والعنف. من هنا تبدأ المعالجة: تفكيك هذا النمط من التفكير وكسر نماذجه وصوره، أو قوالبه وأختامه. وهذا يقتضي ثورة في برامج التعليم الديني، بقدر ما يتطلب الصدق مع النفس وشجاعة فائقة وعقلًا خلاقًا، قادرًا على إيجاد المخارج واستنباط الحلول. لا سيما أن الإرهابيين إنما يكتبون، ببربريتهم، التي لا نظير لها، نهاية المشروع الديني.
إنها المنظومات العقائدية والأنساق الفقهية التي تضيِّق ما اتسع وتقطع ما اتصل. فهي التي أسّست للانشقاق والعداوة، سواء داخل الإسلام أم بين المسلمين وسواهم، بقدر ما اشتغل أئمّتها بلغة التكفير والردّة، أو بعقلية الكره والحقد، أو بمنطق الإقصاء والنفي المتبادل. والحصيلة هي كل هذه البحار من الدماء، وكل هذا الخراب المادي والمعنوي، كما تصنعه الحروب الأهلية الطاحنة أو الأعمال الإرهابية الوحشية على يد الجهاديين من أهل الخلافة أو المجاهدين من أتباع الولاية. لنحسن التشخيص. إذا أردنا معالجة المشكلة، للإرهاب هويته الإسلامية، بوجهيها الدعوي والجهادي، بما هي نمط فكري أصولي اصطفائي، مغلق، وبما هي إستراتيجية جذرية، راديكالية، عدائية، لا تنتج سوى التعصّب والتطرّف والعنف. من هنا تبدأ المعالجة: تفكيك هذا النمط من التفكير وكسر نماذجه وصوره، أو قوالبه وأختامه. وهذا يقتضي ثورة في برامج التعليم الديني، بقدر ما يتطلب الصدق مع النفس وشجاعة فائقة وعقلًا خلاقًا، قادرًا على إيجاد المخارج واستنباط الحلول. لا سيما أن الإرهابيين إنما يكتبون، ببربريتهم، التي لا نظير لها، نهاية المشروع الديني.
كيف ذلك؟
لكل ظاهرةٍ وجهها الآخر. من هنا قولي: إن الجهاد الإرهابي هو آخر مراحل الإسلام السياسي. وهذه هي حصيلة كل سعي للتطابق مع الأصل: انتهاكه باستئصال كل مخالف ولو كان قريبًا أو حليفًا، كما هي العلاقة، مثلًا، بين داعش والنصرة. هذا هو مآل العودة إلى نماذج مستهلكة أو بائدة لتطبيقها في هذا العصر: الإطاحة بمكتسبات الحضارة القديمة والحديثة، وانتهاك كل المقدسات والقيم والأعراف: أي البربرية والعدمية في آنٍ واحد.
عنصرية البلدان الأوربية
كيف تفسر صعود اليمين المتطرف في أوربا وأميركا وشخصيات؛ مثل: نوربرت هوفر النمساوي، ودونالد ترامب الأميركي، ومارين لوبين الفرنسية، وبوريس جونسون البريطاني؛ إضافة إلى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي، هل هو إخفاق لليسار أم ردة فعل تجاه اللاجئين والأجانب؟
لا شك أن العنصرية «تزدهر» اليوم في البلدان الأوربية، وبخاصة بعد تدفق اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب الأهلية، وبالأخص بعد تصاعد الإرهاب الذي ولّد نماذج ترد على التطرف بمثله. هذا ما يحدث الآن بعد صعود لوبن في فرنسا أو ترامب في أميركا أو جونسون في بريطانيا، وسواهم من النماذج العنصرية الفاضحة. ومع أن بريطانيا أثبتت انفتاحها بانتخاب عمدة للندن، المسلم البريطاني صادق خان، فإن التيار اليميني، المحافظ والعنصري، صار أقوى من ذي قبل، ومن فضائحه أن إحدى الشخصيات السياسية البريطانية التي كانت مرشّحة لمنصب رئيس الوزراء، إنما تتهم الرئيس الأميركي أوباما، بأنه نصف كيني ونصف أميركي. تفسيري للظاهرة أن الإنسان هو كائن جيولوجي تتداخل فيه الأطوار وتتراكب المراحل المختلفة والمتعارضة. وما نحسبه ماضيًا قد يعود، إذا تهيّأت له الأسباب، عودة مرعبة، كما هي عودة الدين بعقول وحوشه الإرهابية، أو كما يشهد صعود التيارات العنصرية والفاشية من أحشاء المجتمعات الغربية، وعلى نحو مفاجئ وصادم.
والدرس المستخلص هو أن الماضي يتوارى ولا يمحى، إذا لم يجرِ العمل عليه وصرفه، تعرية وتصفية أو تفكيكًا، لسراديب الذاكرة ومعسكرات العقيدة، أو لأفخاخ الهوية ومنازع العنصرية. ومع ذلك لا ينبغي أن نثق ثقة مفرطة بالإنسان. وإلا كيف نفسر تحول الضحية إلى جلاد، والمظلوم إلى قاهر ظالم! مما يعني أن القيم المتعلقة بالمساواة والعدالة أو الحقوق والحريات ليست مكتسبات نهائية، بل هي محتاجة على الدوام إلى تعزيزها وتوسيعها وتفعيلها، بابتكار مساحات أو أطر وسياق للتداول والتبادل والعمل المشترك.
هناك إشكالية دائمة، يختلف المهتمون بالفلسفة في البلدان العربية بشأنها، وهي هل يوجد نص فلسفي في العالم العربي؟
 هناك جهد فلسفي عربي قد انبثق وانتظم، شرحًا أو ترجمة وتأليفًا، منذ الاحتكاك بالعالم الحديث. وهذا الجهد الذي امتدّ على مراحل مختلفة، بدءًا من عصر النهضة حتى المعاصرين، تجلى في تعدد المذاهب والاتجاهات الفكرية التي هي، في معظمها، استعادة للمنتج في أوربا وأميركا من الحركات الفكرية؛ مثل: الوجودية والوضعية والذرائعية والبنيوية، أو من فروع المعرفة؛ مثل: الظاهراتية والأناسة وأصول المعرفة أو أثريات المعرفة. ولا شك أن المرحلة الأخيرة المتعلقة بالنقد (نقد العقل)، هي من أخصب المراحل، كما مثلها أعلام مثل: أركون والجابري وحنفي والعروي وصفدي.. ومع ذلك لم ينجح الفلاسفة العرب، على أهمية ما أنجزوه، في إنتاج نصوص (نظرية. حقل. منهج. تيار)، تخرق السقف المحلي، وتحتلّ مكانتها في ساحة الفكر العالمي.
هناك جهد فلسفي عربي قد انبثق وانتظم، شرحًا أو ترجمة وتأليفًا، منذ الاحتكاك بالعالم الحديث. وهذا الجهد الذي امتدّ على مراحل مختلفة، بدءًا من عصر النهضة حتى المعاصرين، تجلى في تعدد المذاهب والاتجاهات الفكرية التي هي، في معظمها، استعادة للمنتج في أوربا وأميركا من الحركات الفكرية؛ مثل: الوجودية والوضعية والذرائعية والبنيوية، أو من فروع المعرفة؛ مثل: الظاهراتية والأناسة وأصول المعرفة أو أثريات المعرفة. ولا شك أن المرحلة الأخيرة المتعلقة بالنقد (نقد العقل)، هي من أخصب المراحل، كما مثلها أعلام مثل: أركون والجابري وحنفي والعروي وصفدي.. ومع ذلك لم ينجح الفلاسفة العرب، على أهمية ما أنجزوه، في إنتاج نصوص (نظرية. حقل. منهج. تيار)، تخرق السقف المحلي، وتحتلّ مكانتها في ساحة الفكر العالمي.
كيف تفسّر ذلك؟
أشير إلى خلل متعدد الوجوه: الأول هو غَلَبة هواجس التحرّر السياسي والنضال الوطني على مهام التنوير العقلي، بوصفه تحرّر الفكر من كل أشكال الوصاية على العقل. والثاني هو غلبة الاعتبارات الأيديولوجية، القومية أو الدينية، على مشاغل المعرفة ولغة الفهم، على حين أن الفلسفة هي خطاب عقلاني عابر لحواجز اللغات والثقافات والانتماءات. أشير إلى عائق ثالث هو الأهم ومضمونه أن مشكلة العقل العربي فُهمت بوصفها آتية من خارجه؛ من السلطات السياسية أو الدينية أو من اجتياح الخرافة له من جانب ثقافة أخرى. على حين أن مشكلة العقل عامة، هي بنيوية، داخلية. وأساس ذلك أن العقل لا ينفك عن أوهامه وخرافاته وممارساته المعتمة، فيما هو ينتج أدواته المنهجية وأنساقه المعرفية وصيغه العقلانية. وهكذا فالوهم حاكم على العقل. من هنا جاءت حاجته الدائمة إلى النقد. لعلّي أشير إلى عامل رابع هو أن الفلاسفة العرب لم يتصرفوا بصفتهم العالمية، بل وقعوا في فخ تجنيس العقول بحديثهم عن عقل عربي أو إسلامي أو غربي، على حين خطاب العقل لا هوية له؛ لأنه يخاطب جميع العقول، بصرف النظر عن جنسيات أصحابها، أو عن المعطيات التي يشتغلون عليها.
من هنا نجد أن بعض الفلاسفة والمفكرين الذين يقيمون في هذا البلد الأوربي أو ذاك ويحملون جنسيته، كما هو شأن المقيمين في فرنسا، مثالًا، وبخاصة من كان منهم من أصول مسلمة، قد وقعوا في قوقعة الهوية. لذا فقد كتبوا وألفوا وعقولهم مشدودة إلى العالم العربي. لم ينخرطوا في قراءة المجريات وتشخيص الواقع العالمي بمشكلاته وتحدياته؛ لكي ينتجوا أفكارًا تستأثر باهتمام الإنسان المعاصر أيًّا كان انتماؤه. هذا ما حاولت تجنبه منذ البداية، بحيث تصرفت بوصفي عاملًا في حقل معرفي، هو الفلسفة، همّي الأول تجديد العُدّة الفكرية عبر تشخيص الواقع. هذا ما تشير إليه عناوين كتبي: (التأويل والحقيقة- نقد النص- أوهام النخبة- حديث النهايات- هكذا أقرأ- العالم ومأزقه…) وانطلاقًا من ذلك فأنا أكتب عن أرسطو والفارابي وابن رشد وابن عربي، كما أكتب عن ديكارت وكانط وهيغل وهيدغر وفوكو… كذلك فأنا أتناول الأزمة المالية العالمية، وأفكك الظاهرة الأصولية المعولمة، وأكتب عن الأزمة في فرنسا، وأكتب عن الأزمات في العالم العربي. والأزمة في العالم العربي، في هذا العصر حيث تتشابك المصالح، لا تنفصل عن أزمة العالم، بل هي وجه من وجوهها تتأثر بها، كما تغذيها، بعد أن اعتُبر العرب مصدرًا لتصنيع الإرهاب وتصديره.
من هنا تشخيصي للواقع العالمي بقولي: ثلاث كلمات تلخص اليوم الأزمة الكونية، هي أولًا التخبّط؛ إذ اللاعب على المسرح من القوى الكبرى والدول الفاعلة، إنما يتردد بين النقيض والنقيض في مواقفه وسياساته. وثانيًا التورط؛ إذ هو لا يصنع سوى مآزقه، بمعنى أن حلوله للمشكلات يجعلها تزداد تعقيدًا. وثالثًا التواطؤ، بمعنى أنه لا يخدم إلا عدوّه، بقدر ما يصنع النماذج التي يدّعي محاربتها.
في رأيك هل انتهت الفلسفة في زمن التحولات، وهل بقي من دور للفلسفة؟
للفلسفة جذرها الراسخ في حياة البشر، ما دام الإنسان، كما مرّ ذكره، هو كائن ميزته أنه يفكر ويتفكّر، بالعودة النقدية الارتدادية، على ذاته وأفكاره وأعماله، بالنظر والتأمل، أو بالمراجعة والمحاسبة؛ لتقصي أسباب الأشياء أو تحليل الظواهر أو قراءة التجارب أو تشخيص المشكلات..
لذا لا يعرى إنسان من منزع فلسفي. كل واحد يمكن أن يتفلسف، عندما يتفكر ويتساءل؛ لكي يعرف أسباب ما يحدث، أو لكي يحسن تدبير شؤونه، بتغيير أسلوبه في التفكير أو طريقته في المعالجة، عندما تواجهه صعوبة أو مشكلة، تمامًا كما أن هناك أناسًا ليسوا بشعراء لكنهم يتحدثون أحيانًا بصورة شاعرية.
أما الفيلسوف المحترف فهو الذي يشتغل على الأفكار لتجديد العدة الفكرية، فيضع نظرية في الأسباب، أو يجترح طريقة في التفكير، أو يصوغ معادلة وجودية فيما يخص العلاقة بين الذات والفكر والواقع، كقول ديكارت: انا أفكر إذًا أنا موجود.
لذا لن تموت الفلسفة، لكنها تتطور بموضوعاتها ونظرياتها ومناهجها. ولو حكمنا على ما يُكتب اليوم، بمقاييس أرسطو أو ابن رشد أو كانط، فلن نجد فلسفة؛ لأن الفلسفة تكتب الآن بأشكال وأنماط وأساليب مختلفة، كما تنفتح على مجالات جديدة للحياة، أو تقتحم صُعُدًا جديدة للوجود غير مسبوقة ولا متوقعة.
تفكك العرب واضطرابهم
بعد موجة الحركات والتظاهرات والحروب والنزوح والهجرات؛ العرب إلى أين؟
العالم العربي هو اليوم في أسوأ أحواله تفككًا وترديًا واضطرابًا، باستثناء دول الخليج التي تشكل المساحة الحضارية المتبقية. ولعلّ المجتمعات العربية تدفع الآن ثمن عجزها أو ممانعتها فيما يخصّ إصلاح أحوالها وتطوير حياتها، بالطرائق السلمية والديمقراطية، كما فعلت شعوب أخرى، وكانت الحصيلة هي هدر الموارد، وشلّ الطاقات الحية، والوصول إلى هذه النهايات الكارثية، كما تتمثل في الانفجارات والحروب الأهلية والتدخلات الخارجية؛ إذ أصبحت دول مثل: سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان، ساحات مفتوحة لكل داعية مشعوذ أو جنرال متغطرس أو لاعب متدخّل من الخارج. والخارج لا يعتمد عليه، أي لا يحلّ لك مشكلتك، بل يجعلها تزداد تعقيدًا، بانتظار حلّ مشكلته أو ضمان مصالحه. والإنسان، فردًا كان أم جماعة، إنما يحصد ما يزرع. وهذا مآل ما لا يحسن طيّ صفحة وفتح أخرى في سجل الحقيقة؛ لكي يتدبر حاضره ويهيئ لمستقبله، بما يبتكره في مجال من المجالات، وعلى النحو الذي يتيح له المشاركة في صناعة الحضارة. وإذا كانت أجيالنا قد أخفقت أو عجزت أو حتى تواطأت، فالأمل في الأجيال الجديدة من القوى الحيّة والمدنية، وقد شهدنا نماذج منها في الانتفاضات والثورات العربية، التي تألب ضدها ثالوث الاستبداد والإرهاب في الداخل والغزو من الخارج.
لكن لا عودة إلى الوراء. لا مخرج من هذا المأزق الحضاري، إلا بتغيير العقليات والمفاهيم وأنماط التفكير. من غير ذلك سنحصد المزيد من الخراب والكوارث. والتغيير لم يعد صنيعة زعيم أوحد أو قائد متألّه أو بطل منقذ؛ لأن أعمال النهوض والإصلاح أو التطوير والتحسين، هي مسؤولية المجتمع بكل دوائره وقطاعاته وفاعلياته. ودور الحكام والساسة، هو المساعدة على فتح الآفاق والأبواب والفرص، على نحوٍ يتيح للمجتمع أن يتحوّل إلى ورشة دائمة من التفكير الحيّ والخلاق، بقدر ما يترجم إلى عمل تنموي مثمر وبناء. وهذا هو الرهان أمام البلدان العربية: أن تتقن لعبة الخلق والفتح؛ لكي تمارس وجودها وحضورها على سبيل الجدارة والاستحقاق. فهي تملك موارد هائلة طبيعية وبشرية، رمزية وتراثية. ولكن ما ينقصها هو الرؤى المستقبلية والسياسات الرشيدة أو الإدارات العقلانية والإستراتيجيات الفعالة.
كيف تقرأ هويتك وأنت القائل في كتابك «خطاب الهوية، سيرة فكرية»: أنا بدوي وجاهلي وقبليّ وعربي ومسلم ولبناني شيعي عاملي ويوناني وغربي وفرنسي بمعنى من المعاني، ومسيحي ويهودي ووثني وإثنينيّ وبوذيّ وزنديق.. من هنا كان السؤال عن ماهيّته: أين أنا من كلّ هذه الهُويّات؟
أنا عبرت عن مفهومي لهويتي على هذا النحو المفتوح على التنوع والاختلاف، إبان الحرب الأهلية التي لم تنته بعد؛ بسبب التعامل مع الهويات بمنطق الاصطفاء والنقاء والثبات. وهكذا، فإن التجارب المريرة والإخفاقات المتلاحقة والمعايشات اليومية، بمعاناتها ومكابداتها، حملتني على وضع هويتي، كلبناني وعربي ومسلم، على طاولة النقد والتشريح؛ للكشف عمّا يقف وراءها من الأوهام الخادعة والقوالب الجامدة أو الصور النمطية والتهويمات النرجسية. وكانت حصيلة ذلك أن تشكّلت عندي قناعة جديدة مضمونها أن الهوية هي نِسَبها وعلاقاتها مع الآخر، بقدر ما هي شبكة تأثيراتها المتبادلة وسيرورة تحوّلاتها المستمرّة. وهذا شأن الهوية الغنية والقوية أو المزدهرة. إنها قدرتها على التواصل والتفاعل مع الآخر، بقدر ما هي طاقتها على التجدّد في ضوء التحولات وعلى وقع الأزمات. فكيف ونحن في عصر التواصل والتداول والاعتماد المتبادل، حيث تشابك المصالح والمصاير.
ولكن أليس هناك محطات ثابتة لهويتك؟
بالتأكيد. هناك ثلاث ركائز. بلدي لبنان حيث أقيم وأعمل، ثمّ مهنتي ككاتب، ثمّ هويتي العربية لكوني أنطق وأكتب بالعربية. لا تعنيني كثيرًا الأصول الدينية أو الأطر الطائفية الضيقة، بل لا أعترف بها وأحاول التحرّر من تصنيفاتها الخانقة التي تحشر الفرد تحت خانة لتحيله إلى رقم في حشد لخدمة مشروع شمولي، أو إلى فرد في قطيع تسيره الغرائز العمياء والفالتة من كل معيار، كما نعاني في البلدان العربية ذات التركيب الطائفي المتعدّد.
فأنا لا يعنيني أن يكون الواحد مسيحيًّا أو مسلمًا على هذا المذهب أو ذاك. ما يعنيني بالدرجة الأولى عمله وما يتقنه، سواء أكان رئيسًا أم عاملًا، أم كاتبًا أم فلاحًا، أم صاحب شركة أم موظفًا بسيطًا… إن امرءًا يحترم قانون السير أو يحرص على نظافة البيئة، هو في نظري أفضل من داعية مشعوذ أو مثقف متطرّف يحدثنا، من على الشاشة، عن مشاريعه وحروبه التي تقود إلى هلاك العباد وخراب البلاد.
ألهذا الحدّ تكتسب مسألة البيئة أهميتها في نظرك؟
يكاد الإنسان يدمّر الطبيعة بجشعه وتكالبه وجهله بما يفعل. لذا فالحفاظ عليها هو أولى من جميع العقائد والأيديولوجيات التي تدمر من جهتها جسور التواصل بين البشر. من هنا كان نقدي لهويتي الثقافية، مدخلًا لنقد هويتي كإنسان وهو الأهم، على ما هو شأن المقاربة الوجودية والتحليل الفلسفي. وكان المنطلق إلى ذلك هو أزمة المشروع الحداثي. فبعد كل هذه العهود والمواثيق حول حقوق الإنسان، نجد أن أكثر من يسيء إليها هم دعاتها وحراسها. وبعد كل هذه العصور والأطوار من التنوير العقلي والتطور الهائل في العلوم والمعارف، تنتهي المجتمعات البشرية إلى مثل هذه المآلات البائسة أو الكارثية، من تلويث البيئة إلى الانهيارات المالية، ومن أزمة الديمقراطية إلى صعود الأصوليات الدينية والعنصرية. وكل ذلك يشهد على عجز الإنسان عن التدبير وفقدانه السيادة على نفسه.
هذا ما دعاني إلى إعادة النظر في مفهوم الإنسان، بتفكيك العدّة التي صنعنا بها إنسانيتنا أو صنعتنا، من حيث لا نعقل، كما هي مفاعيل مفردات كالألوهة والقداسة والعظمة والعصمة والبطولة والنخبة والنجومية، وسواها من الصور والنماذج والقيم. وهكذا فما ندافع عنه هو ما نشكو منه. بهذا المعنى يتجاوز النقد الصراعات الأيديولوجية والصدامات الثقافية. والرهان للخروج من المأزق، هو اشتغال الإنسان على نفسه لصوغ مفاهيم ونماذج أو قيم وقواعد جديدة لإدارة شؤونه وشؤون الكوكب. من هنا لا مخرج إذا لم ننجح في إدارة العالم وفقًا لإستراتيجية جديدة تنبع من رؤية جديدة، بل من إنسان جديد. هذا ما يجعلني أعود دومًا إلى مانديلا الذي قضى في السجن 27 عامًا. وعندما تحرَّر بلده وتولى سدة الرئاسة لم يشأ التجديد، خلافًا للقانون، وهو الرمز المقاوم والمحرر والمؤسس. نحن نفتقر، وبخاصة في العالم العربي، إلى مثل هذا النموذج الذي اتسم صاحبه بالتعقل ضد التعصب، وبالتواضع ضد التأله، وبالخضوع للقانون ضد الاستبداد والانفراد بالحكم؛ لذا، لا نبحثنّ عن العلة في العولمة، ولا في التقنية، ولا في السوق المفتوحة أو في الرأسمالية المتوحشة. بل في الإنسان، فهو مصدر كل هذا التوحش الذي هو حصيلة الأنا النرجسية والعقلية المفخخة، والذاكرة الجريحة، والهوية الموتورة، والنفس الأمَّارة.
الشخصية الثقافية
بعد عقود من الانغماس في الكتابة والمقاربات الفلسفية والفكرية إلى جانب أنك عشت تحولات الثقافة العالمية والأضداد والتناقضات والفتوحات والصدامات؛ كيف تقرأ شخصيتك الثقافية باختصار وموقعك في حقل الفلسفة، وما الذي لم تكتبه بعد؟
فيما يخصّ شخصيتي، أشعر بأن هناك فجوة بين موقعي ككاتب، وبين مكانتي الاجتماعية أو السياسية. على هذا الصعيد أشعر أحيانًا، بأنني أضعف خلق الله؛ لكوني لا أرتبط أو ألوذ بجهة أو مؤسسة أو جماعة أو حزب أو حتى صحيفة. أما من حيث موقعي الفكري، فأنا، على العكس، أُمارس حضوري وأثري في المشهد الثقافي اللبناني والعربي، وربما خارجه، بالطبع ليس عبر علاقاتي أو منصبي، لكوني عاريًا من أي منصب ثقافي أو سواه، بل عبر أعمالي ونصوصي لا غير. وبات من النرجسية أن أعاود الحديث عن الأثر الذي تركته أعمالي. بدءًا من كتابي «التأويل والحقيقة» (1985م). ثم كتاب «النص والحقيقة» بأجزائه الثلاثة، وبالأخص «نقد النص» الذي اعتُمِد مقررًا دراسيًّا في جامعة باريس منذ عقدين، وما أعقب ذلك من كتب استُقبلت بوصفها طريقة جديدة في التفكير، أو أسلوبًا جديدًا في الكتابة الفلسفية، أو رؤية مختلفة إلى الأشياء والعالم. فالفلاسفة مشهورون بأنهم من عشاق الحقيقة وشهدائها. ثم أتى من يكتب عن «نقد الحقيقة»، فكان ذلك بمنزلة فتح أفق جديدة للتفكير والتنوير. وهكذا، فإن أعمالي شكلت إمكانًا للتفكير فُتحت معه أبواب جديدة بالمقاربة والمعالجة أمام النقاد والكتّاب والدارسين، فاعتمدوها مراجع في تحصيلهم، أو نسجوا على منوالها في كتاباتهم الفلسفية، أو استخدموا تقنياتها المنهجية في الدرس والتحليل، أو اقتبسوا منها أو نقلوا عنها أفكارًا وصيغًا استخدموها في مؤلفاتهم ومقالاتهم.
كيف تتعاطى الآن مع كتابك «أوهام النخبة» الذي كانت له أصداؤه الواسعة في الساحة الثقافية؟
أما كتاب «أوهام النخبة» الذي رسخ لنقد المثقف، فيكفي أن أذكر هنا أنه بعد صدوره قال لي أحد المثقفين الذي أصبح صديقي: بعد قراءتي الكتاب خرجت على حزبي السياسي الفاشي.
كيف تقرأ في هذا السياق كتابات الفيلسوف سلافوي جيجك؟
مؤخرًا سئل جيجك: ماذا نفعل في مواجهة الرأسمالية التي لا تتوقف عن التوسع والانتشار؟ أجاب: لست أدري، ثم أضاف علينا أن نقلب نظرية ماركس؛ لأن المطلوب ليس فهم العالم كما يفعل الفلاسفة، بل تغييره؛ أي العودة إلى موقف الفلاسفة. وعندما كان أحدنا يقول قبل عشرين عامًا، على وقع انهيار المشاريع الأيديولوجية للنخب الثقافية: إن النظريات والإستراتيجيات السائدة في فهم العالم وتغييره، قد فقدت مصداقيتها، وباتت بحاجة إلى التغيير، كان يُتهم صاحب الرأي بأنه بورجوازي ومعادٍ للتقدم. والآن يأتي جيجك ليتبنى هذا الرأي ويتخلى عن رأي ماركس بوصفه تعبيرًا عن موقف بورجوازي سابق. وهكذا فإن جيجك، عوضًا من أن يعيد النظر في أساس مشروعه، يعدّ كل ما هو رأسمالي خاطئًا، وكل ما هو اشتراكي صحيحًا، مثله في ذلك مثل الأصوليين الإسلاميين الذين يسطون على النظريات العلمية لنسبتها للقرآن الكريم.
يقول إدغار موران تعليقًا على مجزرة صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، إنه يدين هذا الاعتداء، لكنه ليس مع مسّ المقدسات…
أنا أخالفه الرأي، فيما يخص العالم العربي؛ لأن الممارسات التقديسية هي علة العلل وأم المشاكل، كما تتجلى في عبادة الكتب والأشخاص والأسماء أو الأمكنة والأحجار. وللقداسة مفاعيلها السلبية، المدمرة والقاتلة أحيانًا، بقدر ما تقوم على حجب قوامه خلع صفات الألوهة والتعالي أو العظمة والإطلاق على ما هو عادي ونسبي ويومي ومتغير، وربما غير مقبول أو مشروع…. وهكذا من يُقدس شيئًا، إنما يسدل الستار على عقله بقدر ما يتعلق به تعلقًا أعمى. والحصيلة أن يقع ضحيته، أو أن يضحي بغيره، كما تشهد علاقة الناس بمطلقاتهم ومقدساتهم وطوطماتهم الدينية أو السياسية أو الثقافية.
ما رأيك في المقولات التي تتكرر في بعض الأفكار؟
أعترف بأن هناك شيئًا من التكرار فيما أكتبه، أما فيما يخصّ ما لم أكتبه بعد، فأنا منذ سنوات أفكر في أن أكتب كتابًا يكون بمنزلة الجزء الثاني لكتابي «خطاب الهوية»، وبالطبع سوف يختلف الأمر، بعد أكثر من ثلاثين عامًا، بالأسلوب والمقاربة. المهم أن يكون منطلق الكتاب عن حياتي وسيرتي أو مسيرتي. ولكن مشاغل الدراسة والصحافة وقراءة المجريات والأحداث العاصفة، قد صرفتني عن ذلك. وأخشى ألّا يكون أمامي متّسع من العمر؛ لكي أنجز قصتي مع الحقيقة، من خلال التطرق إلى هويتي ومهنتي ومهمتي.
دائمًا تحاول أن تكون سجاليًّا انتقاديًّا، نجحت بقوة في كتابك «أوهام النخبة/ نقد المثقف»، وتابعت في مجالات أخرى، خصوصًا الأصوليات والأصنام الفكرية والأيديولوجية والداعشية؟
ثمة كلام يتكرّر منذ زمن، بأنه لا وجود لسجالات خصبة على ساحات الفكر في العالم العربي. وكي لا أقول بأن هذا الكلام لا معنى له أو لا طائل من ورائه، أقول بأن ما يعنيني من المعارك الأدبية والسجالات الفكرية، التي تكون أحيانًا علنية وأحيانًا أخرى صامتة، هو أن أُحْسِن قراءة المجريات، وأن تفتح مقارباتي إمكانًا لتشخيص ما أتناوله من القضايا والمشكلات.
كيف تقيّم ما كتبته في السنوات الأخيرة؟
ما كتبته في السنوات الأخيرة، حول مشكلات الساعة وحول التحديات المصيرية التي تواجه العرب، والعالم، أعطى مصداقية لما قدمته من الآراء والتحليلات. صحيح أن ما قلته لاقى معارضة شديدة من جانب المتشبثين بأطروحاتهم ومواقفهم، من أصحاب التيارات الأصولية، الدينية والعلمانية، القومية واليسارية، ممن يتعاملون مع شعاراتهم بعقل أمني، عسكري، شمولي. لكن ما كتبته أكّد صحة رهاناتي، سواء في تفسيري للظاهرة الأصولية بالعودة إلى جذورها الدينية، أو بقولي: إن أنظمة الاستبداد، شأنها شأن المشاريع الدينية، غير قابلة للإصلاح أو للمفاوضة والتسوية، وهذا ما كتبته عن المحادثات حول اليمن قبل شهور: إنها مضيعة للوقت. وهذا ما حصل؛ لأنه لا مساومة مع من يفكر بعقل طائفي، عنصري، فاشي. كذلك الأمر فيما يخصّ قراءتي لحرب تموز من خلال مقولتي عن النصر الخادع والمستحيل، بعد أن انخرط أهل التحرير في خوض حروب تفضي إلى تدمير غير بلد عربي، بدعم من إيران. هنا أيضًا، صحّ رهاني، حول طبيعة المشروع الإيراني الرامي إلى تفكيك دول المشرق العربي؛ لإعادة ترتيب أوضاعه السياسية والطائفية، كما كتبت منذ سنوات.
أَصِلُ من هذه المرافعة، غير المحمودة، إلى قضية الساعة، بعد المذابح التي تعرضت لها فرنسا. فأنا من القائلين، منذ زمن، بأن فرنسا قد تراخت وتأخرت بمعالجتها للظاهرة الجهادية. وما حصل شاهد؛ إذ تحولت الجالية الإسلامية إلى حاضنة اجتماعية وثقافية لولادة الوحوش الإرهابية.
مقولات نيتشه
اشتغلت كثيرًا على مصطلحات «المنطق التحويلي»، و«العقل التداولي» إضافة إلى ترجمات لمصطلحات أخرى؛ هل بات لديك قاموسك الخاص في الحقل الفلسفي؟
أنا حصيلة كل ما قرأته وتأثرت به من الأعمال الفكرية والنصوص الفلسفية. ويأتي نيتشه في الطليعة، شأنه شأن فوكو ودولوز أو ابن عربي وابن خلدون. لكني لم أكن مجرد شارح. بل أعدت إنتاج ما قرأته وتمرّست به من الأعمال. ولا أوثر هنا كلمة «تخريج» القاصرة عن الوصف والفهم. فالأمر يتعدى ذلك إلى إعادة الخلق، شرحًا وتأويلًا، أو صرفًا وتحويلًا، أو تركيبًا وتجاوزًا، انطلاقًا من لغتي وبيئتي الثقافية، أو أسئلتي ومشاغلي المعرفية، وبالطبع في ضوء تجاربي وخبراتي. وهذه النصوص باتت تعبر عن فرادتي، وتحمل بصْمتي وختمي. والشاهد أن كثيرين قد اطلعوا على فكر نيتشه وفلاسفة ما بعد الحداثة من خلال أعمالي. هناك من يكتب عن نيتشه، على حين أن كتابته آتية من نصوصي أكثر مما هي آتية من نصوص نيتشه.
كتب عبدالرزاق بلعقروز مقارنة معرفية ومنهجية بينك وبين نيتشه، كاشفًا عن فضاءات التشارك والحوار بينكما، ويستنتج أنك من أشد الناقدين للفيلسوف الألماني، لا سيما دعوته إلى الإنسان «السوبرمان». ومع ذلك يجد بلعقروز أن في نصك استثمارًا لمقولات نيتشه وإشكاليته الفكرية، أعدت تخريجها ومقاربتها والتعاطي معها، بما يتلاءم مع تصورك لمقولة نقد الحقيقة بمعناها الكلياني الشمولي، وحسبانها إشكالية تتعلق بوجودنا، على نحو تكون فيه الحقيقة ممارسة تنتجها الخطابات والروايات والتأويلات؛ ما رأيك بهذه المقاربة؟
لا شك أنني أفدت من نيتشه فوائد جليلة. لكني لست نسخة عنه، ولا مجرد شارح له. لقد تجاوزته بقدر ما جددت وأضفت. مثال ذلك مقولتي حول «المنطق التحويلي»، حيث شعاري ليس «أن أكون ذاتي»، كما هو شعار نيتشه وكثيرين. وبحسب المنطق التحويلي يجري تجاوز منطق المماهاة ومنطق هيغل الجدلي معًا، حيث الفكرة الحيّة والخصبة، تتغير هي نفسها بقدر ما تسهم في تغيير الواقع، وتغير صاحبها أو من يتداولها بقدر ما تسهم في تغيير علاقته بالآخر. نحن إزاء تحويل مربع الوجه. بهذا نتجاوز مقولة الثابت والمتحول؛ لأن علاقتنا بالثوابت ليست ثابتة، بل متحولة. وآية ذلك أن الفكر هو توتره الدائم، والواقع هو حراكه المستمر، سلبًا أو إيجابًا، تخلّفًا أو ازدهارًا. ولكن التغير قد يحصل بصورة صامتة أو بطيئة، ثم ينفجر، كما هي الأزمات والثورات.
مثال آخر، أنا لست مع مفهوم «الإنسان الأعلى» الذي أورث نيتشه محنته وجنونه، وهذا شأن كلّ من يتعلّق بمبدأ مثالي: أن يُحبَط ويُجَنّ، أو أن يتحول إلى إرهابي. ومفهوم الإنسان الأعلى هو الذي يصنع أزمة الإنسان عمومًا. من هنا مقولتي حول «الإنسان الأدنى»، بمعنى أن الفاعل البشري هو أدنى بكثير مما يدعيه أو يدعو إليه، من حيث علاقته بشعاراته ومشاريعه. وإلا كيف نفسّر كل هذا التراجع أو الانهيار على مستوى القيم والمبادئ؟ والرهان هو كسر منطق التعالي والأعلى والأقصى؛ للاشتغال بمفردات الوسط والمساحة والفضاء والأفق، أي ما يتيح للبشر إقامة علاقات تبادلية مثمرة، وذلك يقتضي التفكير في عقل تداولي والتحلّي بالتقى الفكري والتواضع الوجودي. وأخيرًا هناك قضية الحقيقة. وأنا أفدت من نيتشه بفتحه مفهوم الحقيقة على اللغة والمجاز واللغة والجسد والقوة. ولكن بقيت لديه أوهام ما ورائية حول الحقيقة عبر عنها بوصفه أحد كتبه بأنه «الإنجيل الخامس للبشرية». أنا أفهم الحقيقة من خلال مفردات الخلق والفتح، أو الصناعة والتحويل، أو التجاوز والتركيب، بل أفهمها من خلال مفردات الإستراتيجية واللعبة والرهان. ولعلّنا نحتاج إلى مثل هذه المفاهيم لمقاومة موجات التأله والتعصب والتطرف التي تنفجر حروبًا أهلية، أو بربرية إرهابية.
أنا تحررت من المفهوم الأيقوني للحقيقة، بوصفها ماهية ثابتة أو هوية تامة أو بنية سحيقة وغائرة، بقدر ما تجاوزت منطق التيقن والقبض والتحكم. أين هو التحكم فيما الإنسان عاجز الآن عن معالجة نفاياته؟ من كان يحسب أن بيروت التي كانت مدينة نظيفة، أنيقة، في زمن الفرنسيين وما بعده، تكاد تطمرها النفايات؟!
التعليقات على مقالاتك على الإنترنت كثيرة، وكثير منها يصب في خانة الهجوم عليك؛ لمجرد أنك تقترب من «التابو الديني» أو حتى الاجتماعي، هذا من دون أن ننسى ما حصل في إحدى الندوات في القاهرة، انطلاقًا من هذا؛ هل تعرّضت للتهديد؟ هل شعرت بخطر على حياتك؟
 _ مثل هذه التعليقات ليست غريبة، بل هي طبيعية عندما تصدر عمن خُتم على عقولهم، ممن يتقنون تقديس الكتب وعبادة السلف. نحن إزاء ردات فعل غريزية تشهد على ممانعة أصحابها تشخيص المشكلة التي يعترف الجميع بوطأتها. ومثل هؤلاء كمثل المريض النفسي الذي يقاوم محاولات تفكيك عقدته. وإلا كيف نفسر أن نتصوّر حلولًا للمشكلات، فإذا بها تزداد تعقيدًا أو استعصاء! مما يعني أن ما نحسبه الحلّ هو المشكلة. وبالعكس ما نرفضه وندينه قد يكون بداية الحل. وهكذا فهم يهربون من مقاربة المشكلة، على نحو جذري، للكشف عن مكامن الخلل والعجز والقصور. والحصيلة هي الاستبداد السياسي والإرهاب الديني، أو التخلف المجتمعي والتقهقر الحضاري.
_ مثل هذه التعليقات ليست غريبة، بل هي طبيعية عندما تصدر عمن خُتم على عقولهم، ممن يتقنون تقديس الكتب وعبادة السلف. نحن إزاء ردات فعل غريزية تشهد على ممانعة أصحابها تشخيص المشكلة التي يعترف الجميع بوطأتها. ومثل هؤلاء كمثل المريض النفسي الذي يقاوم محاولات تفكيك عقدته. وإلا كيف نفسر أن نتصوّر حلولًا للمشكلات، فإذا بها تزداد تعقيدًا أو استعصاء! مما يعني أن ما نحسبه الحلّ هو المشكلة. وبالعكس ما نرفضه وندينه قد يكون بداية الحل. وهكذا فهم يهربون من مقاربة المشكلة، على نحو جذري، للكشف عن مكامن الخلل والعجز والقصور. والحصيلة هي الاستبداد السياسي والإرهاب الديني، أو التخلف المجتمعي والتقهقر الحضاري.
الحب والفناء
قلتَ بعض المفاهيم عن المرأة في كتابك «الحب والفناء» بعضهم اعتبرها سلبية وتقليدية على غير عادتك في الكتابة وتحطيم الأصنام، هل ما زلت متمسّكًا بتلك الأفكار أو تعدها ابنة مرحلة وانتهت أو تبدّلت؟ وكيف تفسر كتاباتك عن الحركة النسوية؟
كتابتي عن حرية المرأة، هي وجه لكتابتي النقدية عن حركات التحرّر الوطني، بمعنى أنها ترمي إلى كشف ما تنطوي عليه المنظومة الأيديولوجية حول مفاهيم المساواة والاختلاف والتحرر، من الوهم والادعاء أو الزيف والخداع؛ لذا كان المآل الفشل والإخفاق. وكما أن حركات التحرّر الوطني والسياسي، ترجمت مزيدًا من الاستبداد، فإن الحركات النسوية لم تمنع أعمال التمييز ضد النساء، والتعامل معهنّ بلغة العنف تضييقًا وقمعًا أو اغتصابًا أو قتلًا. ثمة تبسيط تتّسم به الحركة النسوية، بنسائها ومن يقف معهنّ من الرجال، يقوم على اختزال علاقة المرأة والرجل، إلى مجرّد قوانين وقواعد أو إلى أدوار ووظائف. وذلك يطمس الكينونة الجنسية لكل منهما، أي ما هو محلّ جذب أو إغراء أو افتتان. لذا فإن الرجل حين يلتقي المرأة إنما تلفته بالدرجة الأولى صفاتها الأنثوية، أي كونها امرأة بالدرجة الأولى، أيًّا كانت صفاتها الأخرى العارضة؛ زميلة أو رفيقة، خادمة أو رئيسة، عالمة أو كاتبة… إلا في الحالات الاستثنائية التي يدجّن فيها الرجل أو يغلب على أمره. وبالعكس إلا إذا كانت المرأة تسحق رغبتها بحكم التقاليد أو لأي سبب آخر.
هنا أيضًا يمكن القول بأن ما يختزل لا يمحى، بل يتوارى ويعود بصورة مخاتلة؛ مفاجئة أو صادمة. لنحسن التشخيص؛ كي نعالج المشكلة. فالإنسان هو ذات راغبة بالدرجة الأولى. وإلا كيف نفسر أعمال التحرّش والاغتصاب، بعد هذه العهود التنويرية والتحررية؟ وأين؟ في البلدان الأوربية؛ ففي فرنسا، مثلًا، كان يكفي أن تأتي إحدى النائبات إلى البرلمان بالفستان لأول مرة، حتى يخرج النواب الذكور، الذين يشرّعون للأمة، عن طورهم، هياجًا وصراخًا وصفيرًا. ناهيك بحالات الطلاق وأعمال التحرش التي تضاعفت عما كانت عليه قبل عقود. والدرس ألّا نلتفّ على المشكلة. فالرغبة حاكمة على الذات؛ إذ هي الأصل تمامًا كما أن الوهم هو الأصل في مسألة العقل. لذا لا تكفي القوانين والتشريعات التي تساوي بين المرأة والرجل، كما لا تكفي العقوبات لردع الرجال عن الخروج على المسلك الحضاري.
هل يعني ذلك أننا أمام مشكلة تستعصي على الحل؟
السؤال يطرح إشكالية العلاقة بين الطبيعة والثقافة، بين الرغبة والواقع، بين الغريزة والقانون. والصعوبة الفائقة هنا، إن لم أقل الاستحالة، تتأتى من كون الهوى عند الإنسان هو الأصل وليس العقل. فالمرء لكي يصبح عاقلًا أو متعقلًا في علاقته مع الآخر، يحتاج إلى كثير من الاشتغال على الذات بالجهد والمراس أو التدرب والتحول. لذا لا أخشى القول بأن مفردات الوفاء والاستقامة والانضباط قاصرة عن إيجاد الحل؛ لأن العلاقة بين الرجل والمرأة، كما بين أي شريكين، قد تستهلك ولو كانت في البداية ودًّا أو حبًّا وعشقًا. وعندها تشتغل المخيلة الخائنة، تحت وطأة الرغبات المتقلبة أو الأهواء الجامحة التي تجنح بصاحبها، نحو انتهاك القيم والقوانين. ولكي لا تتحول الشراكة إلى حياة رتيبة أو إلى حرب باردة، أو تؤول إلى الهجر والانفصال، فإنها تحتاج إلى من يحسن إدارتها بالمصارحة والمكاشفة كما بالمرونة والمواربة والترويض الدائم، والأهم أنها تحتاج إلى التجديد؛ كي لا تستنفد العلاقة بين الزوجين، بل يبقى بينهما رابط جامع من سر جاذب أو لغز غامض. والأساس ألّا يفكر الواحد بامتلاك شريكه؛ إذ إنه بذلك يخدع نفسه أو يظلم شريكه.
كتب المفكر الجزائري محمد شوقي الزين «هناك فلاسفة في تاريخ الفكر البشري هجروا الأنساق المعرفية؛ لتتحوّل الفلسفة عندهم إلى كتابة أو فن أو متعة، أي إلى ذوق جمالي يحيونه بقوة النظر أو ببلاغة الأسلوب. هذا حال علي حرب الذي ابتكر مفردات أصيلة تعبر عن نفوره من التصنيفات أو التنميطات، وهي مفردات حُبلى بالمجاز، ولا تنفك عن نمط استعاري في الدلالة والأداء…
 أنا محظوظ مع الجزائر؛ لأن كتبي تقرأ فيها أكثر من أي بلد آخر، ولأن أعمالي شكّلت مادة لكثير من الدراسات والأطروحات الجامعية من جانب كثيرين. حقًّا كان الدكتور محمد شوقي الزين، الذي هو اليوم أحد أعلام الجيل الجديد من الفلاسفة العرب الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفلسفية، هو أول من اهتمّ بأعمالي وكتب عنها. ثم ترجم كتاب «حديث النهايات» إلى الفرنسية. ولا شكّ أن ما قاله الصديق محمد شوقي هو في مكانه. فأنا لم أكتب وفقًا لقواعد المنهج الصارم أو لقوالب النسق المغلق، كما أنني لست من أصحاب المشاريع الفكرية العريضة والشاملة. إنما أكتب بصورة حرّة ومفتوحة على الأحداث والمعايشات. فأتناول بالدرس والتحليل قضية أو تجربة أو ظاهرة أو نصًّا.
أنا محظوظ مع الجزائر؛ لأن كتبي تقرأ فيها أكثر من أي بلد آخر، ولأن أعمالي شكّلت مادة لكثير من الدراسات والأطروحات الجامعية من جانب كثيرين. حقًّا كان الدكتور محمد شوقي الزين، الذي هو اليوم أحد أعلام الجيل الجديد من الفلاسفة العرب الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفلسفية، هو أول من اهتمّ بأعمالي وكتب عنها. ثم ترجم كتاب «حديث النهايات» إلى الفرنسية. ولا شكّ أن ما قاله الصديق محمد شوقي هو في مكانه. فأنا لم أكتب وفقًا لقواعد المنهج الصارم أو لقوالب النسق المغلق، كما أنني لست من أصحاب المشاريع الفكرية العريضة والشاملة. إنما أكتب بصورة حرّة ومفتوحة على الأحداث والمعايشات. فأتناول بالدرس والتحليل قضية أو تجربة أو ظاهرة أو نصًّا.
من هنا لست مضطرًّا إلى تغيير بعض ما كتبته بصورة جوهرية. يكفي أن أحذف فصلًا أو أضيف فصلًا آخر. وقد أغير عنوانًا. وهذا ما أنوي فعله، فيما لو أعيد طبع كتابي: الأختام الأصولية والشعائر التقدمية، ثم أصنام النظرية وأطياف الحرية، بحيث أقوم باختصار كل منهما على النحو الآتي: الأختام والشعائر، ثم الأصنام والأطياف، فيكون ذلك أبلغ وأجمل. أما من حيث طريقة الكتابة، فأنا منذ أن شرعت في التأليف، أَوْليت أهمية للأسلوب. وقد أفادني في ذلك تدريسي للفلسفة العربية طوال ربع قرن، وأكثر الفلاسفة العرب هم كتّاب. أضف إلى ذلك أن التمرّس بالنص الفلسفي العربي، قد زوّدني بإمكانيات فيما يخصّ ترجمة المصطلحات الأجنبية. ولا أنسى مداومتي على قراءتي الآثار والأعمال الأدبية، شعرًا ورواية. وهكذا فقد حرصت على أن أكتب بأسلوب ذوقي بياني، يجمع بين جمال العبارة وجدّة المفهوم أو قوة الفكر. وأذكر أنني في أول زيارة لي إلى تونس عام 1993م، سُئلت عما إذا كنت أتعاطى الشعر، فنفيت، لكني لم أستغرب السؤال؛ ذلك لأن الكتابة ذات المنحى الذوقي، بإشاراتها والتماعاتها، شكلت رافدًا من روافد القصيدة العربية الحديثة؛ أعني قصيدة النثر. وأنا كانت لي تجربة في هذا الخصوص، على صفحات جريدة «النهار»، منذ ثلاثة عقود تحت العنوان الآتي: «إشارات». من مثالاتها هذه العبارة: كلما قتل امرؤ نظيره فزعت من نفسي. وقد قرأت مؤخرًا كلامًا جميلًا في هذا الخصوص للشاعر محمد علي شمس الدين: أخشى أن يكون قاتلي في داخلي.
هل يربكك المديح والثناء؟
أعتقد، بالاستناد إلى تجربتي، أن من يكتشف شيئًا، هو أول من يعرف ما كشفه أو ما أنجزه، أي قبل النقاد وأهل الحقل أو الاختصاص. ومع ذلك فالإنسان، ككائن اجتماعي محتاج إلى الاعتراف بما ينجزه. ومن سعادة المرء أن ينجح في عمله، وأن يكون مقدرًا في وسطه وعالمه. أما إذا كان محبوبًا فتلك غاية السعادة. لكن لكل شيء وجه آخر. فالنجاح والشهرة أو الصيت، قد تكون لآخرين، مصدرًا لمشاعر الحسد والكره والغل. ثمة من يظن أنك بنجاحك حجبت ذكره أو سرقت دوره، كما يظن أصحاب الأقلام الرديئة والنفوس المريضة.







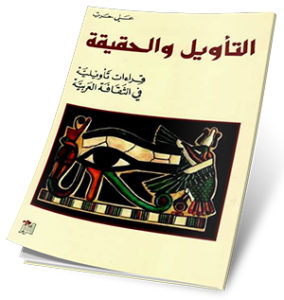 لا شك أن الإرهاب الجهادي هو عنف فاحش لا سابق له، كما تشهد نماذجه كحرق الناس أحياء، أو قتلهم في المقاهي والملاعب، أو دهسهم بشاحنة في الساحات والميادين. ولا يفوق هذه الأعمال البربرية سوى ما قام به ذلك الإسلامي الذي فقأ عيني زوجته؛ لأنها لم تمتثل لأمره بالذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية انتحارية. مثل هذا العنف الأعمى يحتاج إلى قراءة تتقصّى جذوره. وتحلّل الأسباب التي تقف وراءه. والقراءة الجذرية تتناول المسائل على مستواها الفكري، أي من جهة العقليات وأنماط التفكير وأساليب التعامل، ما دامت ميزة الإنسان هي أنه كائن يفكر ويتفكّر فيما يحدث له أو يصنعه من حيث لا يحتسب. قد تكون هناك عوامل مساعدة لانتشار الظاهرة، منها ما هو خارجي كتدخل القوى الكبرى والدول اللاعبة على المسرح. ومنها ما هو داخلي؛ سياسي أو معيشي، حضاري أو نفسي، كما هي مفاعيل الأزمات الناجمة عن الفقر والجور والاستبداد أو عن الاستلاب والإحباط. لكن الأساس في نشوء الظاهرة هو أيديولوجي ثقافي، كما تجسّد في الأطروحة الأصولية السلفية الرامية إلى أسلمة الحياة، بإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة.
لا شك أن الإرهاب الجهادي هو عنف فاحش لا سابق له، كما تشهد نماذجه كحرق الناس أحياء، أو قتلهم في المقاهي والملاعب، أو دهسهم بشاحنة في الساحات والميادين. ولا يفوق هذه الأعمال البربرية سوى ما قام به ذلك الإسلامي الذي فقأ عيني زوجته؛ لأنها لم تمتثل لأمره بالذهاب إلى سوريا لتنفيذ عملية انتحارية. مثل هذا العنف الأعمى يحتاج إلى قراءة تتقصّى جذوره. وتحلّل الأسباب التي تقف وراءه. والقراءة الجذرية تتناول المسائل على مستواها الفكري، أي من جهة العقليات وأنماط التفكير وأساليب التعامل، ما دامت ميزة الإنسان هي أنه كائن يفكر ويتفكّر فيما يحدث له أو يصنعه من حيث لا يحتسب. قد تكون هناك عوامل مساعدة لانتشار الظاهرة، منها ما هو خارجي كتدخل القوى الكبرى والدول اللاعبة على المسرح. ومنها ما هو داخلي؛ سياسي أو معيشي، حضاري أو نفسي، كما هي مفاعيل الأزمات الناجمة عن الفقر والجور والاستبداد أو عن الاستلاب والإحباط. لكن الأساس في نشوء الظاهرة هو أيديولوجي ثقافي، كما تجسّد في الأطروحة الأصولية السلفية الرامية إلى أسلمة الحياة، بإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة. إنها المنظومات العقائدية والأنساق الفقهية التي تضيِّق ما اتسع وتقطع ما اتصل. فهي التي أسّست للانشقاق والعداوة، سواء داخل الإسلام أم بين المسلمين وسواهم، بقدر ما اشتغل أئمّتها بلغة التكفير والردّة، أو بعقلية الكره والحقد، أو بمنطق الإقصاء والنفي المتبادل. والحصيلة هي كل هذه البحار من الدماء، وكل هذا الخراب المادي والمعنوي، كما تصنعه الحروب الأهلية الطاحنة أو الأعمال الإرهابية الوحشية على يد الجهاديين من أهل الخلافة أو المجاهدين من أتباع الولاية. لنحسن التشخيص. إذا أردنا معالجة المشكلة، للإرهاب هويته الإسلامية، بوجهيها الدعوي والجهادي، بما هي نمط فكري أصولي اصطفائي، مغلق، وبما هي إستراتيجية جذرية، راديكالية، عدائية، لا تنتج سوى التعصّب والتطرّف والعنف. من هنا تبدأ المعالجة: تفكيك هذا النمط من التفكير وكسر نماذجه وصوره، أو قوالبه وأختامه. وهذا يقتضي ثورة في برامج التعليم الديني، بقدر ما يتطلب الصدق مع النفس وشجاعة فائقة وعقلًا خلاقًا، قادرًا على إيجاد المخارج واستنباط الحلول. لا سيما أن الإرهابيين إنما يكتبون، ببربريتهم، التي لا نظير لها، نهاية المشروع الديني.
إنها المنظومات العقائدية والأنساق الفقهية التي تضيِّق ما اتسع وتقطع ما اتصل. فهي التي أسّست للانشقاق والعداوة، سواء داخل الإسلام أم بين المسلمين وسواهم، بقدر ما اشتغل أئمّتها بلغة التكفير والردّة، أو بعقلية الكره والحقد، أو بمنطق الإقصاء والنفي المتبادل. والحصيلة هي كل هذه البحار من الدماء، وكل هذا الخراب المادي والمعنوي، كما تصنعه الحروب الأهلية الطاحنة أو الأعمال الإرهابية الوحشية على يد الجهاديين من أهل الخلافة أو المجاهدين من أتباع الولاية. لنحسن التشخيص. إذا أردنا معالجة المشكلة، للإرهاب هويته الإسلامية، بوجهيها الدعوي والجهادي، بما هي نمط فكري أصولي اصطفائي، مغلق، وبما هي إستراتيجية جذرية، راديكالية، عدائية، لا تنتج سوى التعصّب والتطرّف والعنف. من هنا تبدأ المعالجة: تفكيك هذا النمط من التفكير وكسر نماذجه وصوره، أو قوالبه وأختامه. وهذا يقتضي ثورة في برامج التعليم الديني، بقدر ما يتطلب الصدق مع النفس وشجاعة فائقة وعقلًا خلاقًا، قادرًا على إيجاد المخارج واستنباط الحلول. لا سيما أن الإرهابيين إنما يكتبون، ببربريتهم، التي لا نظير لها، نهاية المشروع الديني. هناك جهد فلسفي عربي قد انبثق وانتظم، شرحًا أو ترجمة وتأليفًا، منذ الاحتكاك بالعالم الحديث. وهذا الجهد الذي امتدّ على مراحل مختلفة، بدءًا من عصر النهضة حتى المعاصرين، تجلى في تعدد المذاهب والاتجاهات الفكرية التي هي، في معظمها، استعادة للمنتج في أوربا وأميركا من الحركات الفكرية؛ مثل: الوجودية والوضعية والذرائعية والبنيوية، أو من فروع المعرفة؛ مثل: الظاهراتية والأناسة وأصول المعرفة أو أثريات المعرفة. ولا شك أن المرحلة الأخيرة المتعلقة بالنقد (نقد العقل)، هي من أخصب المراحل، كما مثلها أعلام مثل: أركون والجابري وحنفي والعروي وصفدي.. ومع ذلك لم ينجح الفلاسفة العرب، على أهمية ما أنجزوه، في إنتاج نصوص (نظرية. حقل. منهج. تيار)، تخرق السقف المحلي، وتحتلّ مكانتها في ساحة الفكر العالمي.
هناك جهد فلسفي عربي قد انبثق وانتظم، شرحًا أو ترجمة وتأليفًا، منذ الاحتكاك بالعالم الحديث. وهذا الجهد الذي امتدّ على مراحل مختلفة، بدءًا من عصر النهضة حتى المعاصرين، تجلى في تعدد المذاهب والاتجاهات الفكرية التي هي، في معظمها، استعادة للمنتج في أوربا وأميركا من الحركات الفكرية؛ مثل: الوجودية والوضعية والذرائعية والبنيوية، أو من فروع المعرفة؛ مثل: الظاهراتية والأناسة وأصول المعرفة أو أثريات المعرفة. ولا شك أن المرحلة الأخيرة المتعلقة بالنقد (نقد العقل)، هي من أخصب المراحل، كما مثلها أعلام مثل: أركون والجابري وحنفي والعروي وصفدي.. ومع ذلك لم ينجح الفلاسفة العرب، على أهمية ما أنجزوه، في إنتاج نصوص (نظرية. حقل. منهج. تيار)، تخرق السقف المحلي، وتحتلّ مكانتها في ساحة الفكر العالمي. _ مثل هذه التعليقات ليست غريبة، بل هي طبيعية عندما تصدر عمن خُتم على عقولهم، ممن يتقنون تقديس الكتب وعبادة السلف. نحن إزاء ردات فعل غريزية تشهد على ممانعة أصحابها تشخيص المشكلة التي يعترف الجميع بوطأتها. ومثل هؤلاء كمثل المريض النفسي الذي يقاوم محاولات تفكيك عقدته. وإلا كيف نفسر أن نتصوّر حلولًا للمشكلات، فإذا بها تزداد تعقيدًا أو استعصاء! مما يعني أن ما نحسبه الحلّ هو المشكلة. وبالعكس ما نرفضه وندينه قد يكون بداية الحل. وهكذا فهم يهربون من مقاربة المشكلة، على نحو جذري، للكشف عن مكامن الخلل والعجز والقصور. والحصيلة هي الاستبداد السياسي والإرهاب الديني، أو التخلف المجتمعي والتقهقر الحضاري.
_ مثل هذه التعليقات ليست غريبة، بل هي طبيعية عندما تصدر عمن خُتم على عقولهم، ممن يتقنون تقديس الكتب وعبادة السلف. نحن إزاء ردات فعل غريزية تشهد على ممانعة أصحابها تشخيص المشكلة التي يعترف الجميع بوطأتها. ومثل هؤلاء كمثل المريض النفسي الذي يقاوم محاولات تفكيك عقدته. وإلا كيف نفسر أن نتصوّر حلولًا للمشكلات، فإذا بها تزداد تعقيدًا أو استعصاء! مما يعني أن ما نحسبه الحلّ هو المشكلة. وبالعكس ما نرفضه وندينه قد يكون بداية الحل. وهكذا فهم يهربون من مقاربة المشكلة، على نحو جذري، للكشف عن مكامن الخلل والعجز والقصور. والحصيلة هي الاستبداد السياسي والإرهاب الديني، أو التخلف المجتمعي والتقهقر الحضاري. أنا محظوظ مع الجزائر؛ لأن كتبي تقرأ فيها أكثر من أي بلد آخر، ولأن أعمالي شكّلت مادة لكثير من الدراسات والأطروحات الجامعية من جانب كثيرين. حقًّا كان الدكتور محمد شوقي الزين، الذي هو اليوم أحد أعلام الجيل الجديد من الفلاسفة العرب الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفلسفية، هو أول من اهتمّ بأعمالي وكتب عنها. ثم ترجم كتاب «حديث النهايات» إلى الفرنسية. ولا شكّ أن ما قاله الصديق محمد شوقي هو في مكانه. فأنا لم أكتب وفقًا لقواعد المنهج الصارم أو لقوالب النسق المغلق، كما أنني لست من أصحاب المشاريع الفكرية العريضة والشاملة. إنما أكتب بصورة حرّة ومفتوحة على الأحداث والمعايشات. فأتناول بالدرس والتحليل قضية أو تجربة أو ظاهرة أو نصًّا.
أنا محظوظ مع الجزائر؛ لأن كتبي تقرأ فيها أكثر من أي بلد آخر، ولأن أعمالي شكّلت مادة لكثير من الدراسات والأطروحات الجامعية من جانب كثيرين. حقًّا كان الدكتور محمد شوقي الزين، الذي هو اليوم أحد أعلام الجيل الجديد من الفلاسفة العرب الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفلسفية، هو أول من اهتمّ بأعمالي وكتب عنها. ثم ترجم كتاب «حديث النهايات» إلى الفرنسية. ولا شكّ أن ما قاله الصديق محمد شوقي هو في مكانه. فأنا لم أكتب وفقًا لقواعد المنهج الصارم أو لقوالب النسق المغلق، كما أنني لست من أصحاب المشاريع الفكرية العريضة والشاملة. إنما أكتب بصورة حرّة ومفتوحة على الأحداث والمعايشات. فأتناول بالدرس والتحليل قضية أو تجربة أو ظاهرة أو نصًّا. لم تقل رأيك في قضية أمين معلوف الذي تحدث إلى قناة إسرائيلية، وما أثاره ذلك من الجدل والانقسام؟
لم تقل رأيك في قضية أمين معلوف الذي تحدث إلى قناة إسرائيلية، وما أثاره ذلك من الجدل والانقسام؟


0 تعليق