ريتشارد كابوشنسكي صحفي بولندي، صُوِّتَ له كأعظم صحفي في القرن العشرين بعد حياة مهنية لا مثيل لها. حوَّل البرقيات والتقارير الصحفية إلى فن أدبي، مؤرخًا للحروب والانقلابات والثورات الدموية التي هزت إفريقيا وأميركا اللاتينية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. بدأ حياته المهنية بعد الجامعة وأصبح المراسل الأجنبي الوحيد لوكالة الأنباء البولندية. وعلى مدى السنوات التالية كان «مسؤولًا» عن 50 دولة وشهد 27 ثورة وانقلابًا.
احتفظ دومًا بدفتري ملاحظات؛ أحدهما لتسجيل الحقائق المستخدمة في التقارير المرسلة، والآخر لملحوظاته وانطباعاته. شكل هذا الأساس لكتبه المشهود لها، من بينها «حرب كرة القدم»، صراع هندوراس والسلفادور على مباراتين لكرة القدم. و«الإمبراطور»، عن هيلا سيلاسي من إثيوبيا. كما نشر كتاب «إمبريوم: سلطة القيادة» الذي يمكن القول: إنه أفضل دراسة كُتبت على الإطلاق عن سقوط الاتحاد السوفييتي.
في هذا الحوار يتحدث مع الصحفي الأميركي بيل بوفورد عن الأسباب التي جعلته كاتبًا، وكيف أصبح كاتبًا، ورؤيته لما يكتب وصبغته الخاصة ما بين الصحافة والأدب.
● في عمر الثالثة والعشرين، كتبت مقالًا، سياسيًّا للغاية من حيث تداعياته، وكان له تأثير كبير لدرجة أنه غيّر بالفعل سياسة الحكومة في بولندا. وبعد ذلك كتبتَ سلسلة من أكثر القصص التي كتبتَها أناقةً، عن الحياة في ريف بولندا «الأدغال البولندية» وأصبحت من الأكثر مبيعًا. لكن يبدو أنك قضيت بقية مسيرتك في الكتابة تتجنب بولندا. لماذا؟
■ ليس الأمر أنني تجنبت بولندا، كل ما في الأمر أن هناك آخرين يكتبون ببراعة عن بولندا. موضوعي مختلف لأنني كنت مفتونًا بشيء آخر. بعد مدة وجيزة من إعادتي إلى منصبي فزت بجائزة، واتصلت بمحرر الصحيفة، وسألت إذا كان بإمكاني السفر إلى الخارج. أردت الخروج من وارسو، أردت أن أرى العالم. سألني أين تريد الذهاب؟ وقلت: إنني أريد رؤية شيء مختلف، شيء عجيب.
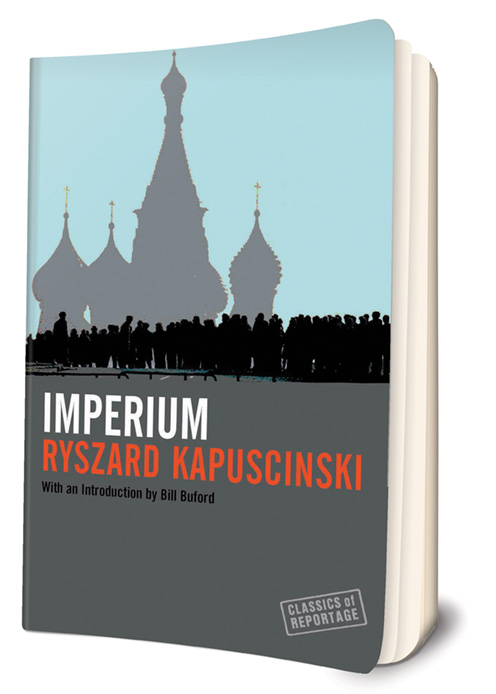 ● مثل؟
● مثل؟
■ مثل تشيكوسلوفاكيا.
● تشيكوسلوفاكيا؟
■ نعم، لأنها كانت غريبة وبعيدة، العالم الكبير بالنسبة لي. بدلًا من ذلك، أرسلني المحرر إلى الهند.
● هل سبق للجريدة أن أرسلت مراسلها إلى الخارج؟
■ لا، كنت الأول. يجب ألا تنسى أنه بالنسبة لجيلي لم يكن العالم الخارجي موجودًا، وإذا كان هناك، فنحن نعرف القليل عنه. مكان مثل الهند لم يكن دولة. لم تكن إفريقيا قارة. كانوا حكايات خرافية، وما أردته ليس أكثر من فرصة لرؤية العالم.
● وبعد الهند؟
■ بعد الهند، كانت باكستان وأفغانستان. حظيت تقاريري بالإعجاب، وأُرسلت إلى الشرق الأقصى، اليابان والصين، حيث عملت لبعض الوقت مراسلًا أجنبيًّا مقيمًا للصحيفة، وفي النهاية إفريقيا. كان الأمر مثيرًا لأنني كنت أكتشف العالم، ولهذا بعد سنوات، في 1968م، في أثناء تجميع المقالات التي ستُنشر في النهاية باسم «حرب كرة القدم»، أصررت على ترتيبها وفقًا لتاريخ كتابتها. كان من المهم بالنسبة لي أن أوضح التجارب التي من خلالها يدخل الأجنبي إلى عالم جديد وبخاصة عالم إفريقيا، يكون خائفًا في البداية، ثم يتفاجأ، ثم يكتشف المتعة والبهجة. أتذكر أيضًا في أثناء تجميع هذا الكتاب، أنه خلال مدة وجودي في أميركا اللاتينية كنت دائمًا أفتقد إفريقيا.
● لماذا؟
■ لست متأكدًا. بصورة ما إفريقيا كانت شبابي، وربما بقولي إنني أفتقد إفريقيا، فأنا في الواقع أقول أفتقد شبابي. في إفريقيا، بدأت فعلًا في تولي مسؤولياتي مراسلًا، كان لدي مسؤوليات مختلفة جدًّا عن تلك التي يتحملها المراسل التقليدي. في البداية، عملت في ذلك الوقت في وكالة الأنباء البولندية PAP. واخترت العمل في وكالة صحفية لأسباب محددة؛ لأنه من النواحي الأخرى، فالعمل في وكالة هو محض عبودية.
المهمة المستحيلة
● «المتهكمون المُتَيَبّسون»، كما وصفتهم في «الإمبراطور»، «من رأوا كل شيء وعاشوا كل شيء، من اعتادوا على محاربة ألف عقبة لا يتخيلها معظم الناس أبدًا لمجرد القيام بوظائفهم»؟
■ لا يتعين على أي صحفي آخر يعمل في صحيفة أو مجلة أو تلفزيون أن يتحمل أهوال أن يكون صحفيًّا في وكالة أنباء. ذات يوم سوف أكتب عنهم، أصدقائي هؤلاء، العلامات المجهولة للأحداث، والضحايا الرهيبون للمعلومات، يعملون ليل نهار في أسوأ الظروف الممكنة. لكنني توليت هذه الوظيفة طواعيةً؛ لأنني كنت أعرف أن العمل في وكالة صحفية سيريني المزيد من الأشياء، وأقابل المزيد من الناس. لن يضيع مرتزق أو ثوري أو جنرال وقته على صحفي من صحيفة مغمورة في بولندا لم يسمع بها من قبل، حتى لو كان من الممكن لتلك الصحيفة الغامضة أن ترسل مراسلًا لرؤيته. لكنه قد يمنح مقابلة مع صحفي يقدم تقارير إلى البلد بأكمله.
وأنا أعلم أيضًا أنه، من خلال العمل في الوكالة، يمكنني السفر أكثر مما لو كنت أعمل لدى شخص آخر. بولندا بلد فقير، لا تستطيع تحمل العديد من المراسلين الأجانب. لرويترز أو أسوشيتد برس أو برس فرانس مراسل في كل دولة إفريقية تقريبًا. في أثناء العمل في بولندا، طُلب مني أن أكون مراسلًا للقارة بأكملها. لم يكن بإمكاني الذهاب إلى أي مكان أريده فحسب، بل كان من واجبي الذهاب إلى أي مكان أريده: إذا كانت هناك مشكلة، فقد كان من المفترض أن أكون هناك لرؤيتها. كثيرًا ما يسألونني كيف كان من الممكن أن أرى الكثير صحفيًّا. لقد شهدت شخصيًّا سبعًا وعشرين ثورة. تبدو المسألة مستحيلة، لكن هذا هو بالضبط ما تطلبه وظيفتي: كنت مسؤولًا عن خمسين دولة؛ كان لا بد لي من العثور على شيء ما مرة واحدة على الأقل في الشهر، في واحدة على الأقل من تلك البلدان. كنت مفعمًا بالحكايات.
● لدي شعور بأنه لا بد أنك كنت داهيةً.
■ لا بد. كان عليك أن تكون هكذا لأن الوظيفة تتطلب ذلك، ولأن العمل في وكالة فقيرة، فالمال لم يكن أبدًا أعظم مورد لك، كانت المعلومات: جهات الاتصال، من كنت تعرفه، وماذا تعرف. يمكن للصحفي الذي يعمل في وكالة ثرية استئجار سيارة أو طائرة في أي لحظة، لكنني لم أستطع ذلك مطلقًا. لذلك، على سبيل المثال، عندما اندلعت الاضطرابات في زنجبار، كان عليَّ الوصول إلى هناك، لكن لم يكن لدي وسيلة نقل. على عكس الصحفيين من الوكالات الكبرى، كنت أعرف بعض الأشخاص المشاركين في الثورة. كانوا أصدقائي. طلب أحد الصحفيين من الوكالة مساعدتي: كان لديه الطائرة، ولكن لم يكن لديه إذن بالهبوط. لذلك عقدت صفقة: «حسنًا، فيليكس، ليس لديَّ نقود لاستئجار طائرة. ولكن إذا اصطحبتني معك، فسأقوم بترتيب التخليص الذي تحتاجه لتتمكن من الهبوط».

● أعلم أنك لا تريد التحدث عن عيدي أمين الآن؛ لأنه موضوع الكتاب الذي تكتبه، لكني أتساءل كيف كان الأمر عندما ذهبت لمقابلته؟
■ كان ذلك في عام 1962م. كنت في كمبالا ومرضي شديد بعد إصابتي بالملاريا الدماغية، فقدت الوعي لمدة ثلاثة أسابيع، وفي يوم، لما بدأت أتعافى، وجدته بجانب سريري.
● لقد كنت، كما أفهم، الصحفي في فِلْم «المعاملة الوحشية» لأندريه فايدا. ويصفك فايدا بأنك رجل لا يستطيع الجلوس. تغادر ثم تعود، تروي بعض الحكايات ثم تختفي مرة أخرى. إلى أي مدى كنت تستخدم رحلاتك لجمع مواد لكتابة كنت ستنجزها لاحقًا؟
■ لا، أنت لا تفهم. كنت هناك في إفريقيا لأنني وجدتها مقنعة جدًّا. كنت أدرك أنني أرى شيئًا فريدًا؛ لأنني كنت هناك في لحظة تاريخية مهمة: تحرير إفريقيا، عندما كانت الدول الإفريقية في كل مكان تعلن استقلالها.
أتمنى أن أنقل كيف كانت إفريقيا. شيء لم أرَ مثله. إفريقيا لها شخصيتها الخاصة، أحيانًا تكون حزينة، وأحيانًا عصية، ولكنها دائمًا لا تتكرر. كانت إفريقيا ديناميكية، عدوانية في الهجوم، وقد أحببت ذلك. بعدها، أجد نفسي الآن في محيط هادئ، وسط الاستقرار في أوربا، وأشعر بالملل. وإلا لم أكن في إفريقيا لأراكم الخبرات، وكنت مجرد صحفي أعمل في وكالة. صحيح أنني كنت أرى نفسي كاتبًا، لكنني كنت دائمًا شاعرًا؛ إذ نشرت الشعر لسنوات.
الصحفي وراوي القصص
● أنت تعيش في بلد يبدو، بشكل عام، أنه يعتقد أن لديه حكومة ماركسية مفروضة عليه ضد إرادته؛ من ناحية أخرى، فأنت شهدت عددًا من الثورات أبديت معها كثيرًا من التعاطف باسم الماركسية. هل تشعر أن الثورة الحقيقية ممكنة؟ ألم تر الكثير لتؤمن بالأمل الذي تقدمه الثورة؟
■ في القرن التاسع عشر دعا الإيمان بالعلم إلى إيمان مماثل بالتاريخ: كان للتاريخ قوانين، ويمكن إدراكه لأنه يتبع نمطًا ما. ما نؤمن به الآن -بالتأكيد ما أُومِنُ به- مختلف تمامًا، وهو أنه من المستحيل استيعاب التاريخ وهذا هو ثراؤه الكبير.
يمكن أن تكون هناك ثورات وثورات تبدأ باسم العدالة وتحقق نسخة من الإصلاح العادل. سالازار في البرتغال مثلًا. وهناك آخرون لم ينجحوا. لكني مهتم أكثر بكثير بسر التاريخ، لماذا تحدث الثورة في المقام الأول. بدأت الثورة في إثيوبيا بسبب ارتفاع أسعار البترول، لكن سعر البترول كان يرتفع منذ سنوات، لماذا فجأة ثورة؟
● يسهل الإشارة إلى أوجه الشبه بين المواقف السياسية الموصوفة في كتبك والوضع السياسي في بولندا: تشير محكمة هيلا سيلاسي الفاسدة إلى البيروقراطية الفاسدة في وارسو. يذكر التجديد غير العقلاني للشاه بـإدوارد جيريك والإنفاق الأهوج في السبعينيات. في رحلاتك عبر إفريقيا، هل كنت واعيًا بالتشابه مع بولندا؟
■ في إفريقيا، تجد شعبًا يقاتل من أجل استقلاله، ويحاول الحفاظ على تقاليده لترسيخ هويته الوطنية. لكني لم أكن أبحث عن أوجه تشابه.
● تعلم أن القُرّاء هنا في بولندا يرون أوجه التشابه؟ ويقرؤون كتبك على أنها قصص رمزية تقريبًا؟
■ لا، ليست قصصًا رمزية. لكن لا بد أن يكون هناك تشابه بالطبع.
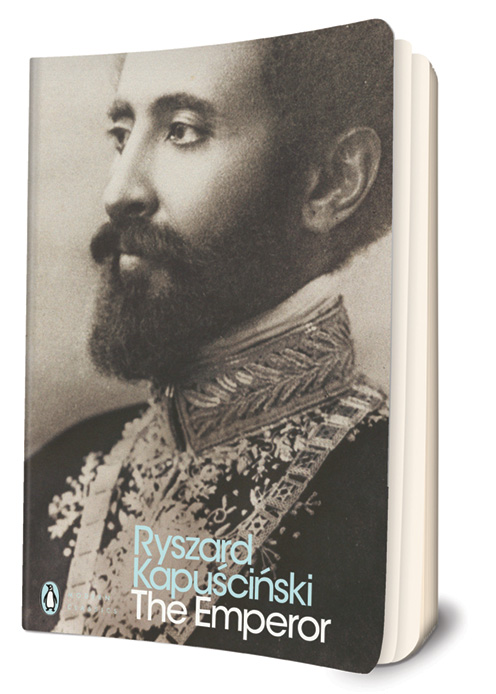 ● من المفارقات أن الكتاب الغربيين، وبخاصة الأميركيون، يحسدون دائمًا الكاتب الذي يعيش في ظل نظام قمعي سياسي، والذي يتمتع بما وصفه جورج شتاينر بـ«إلهام الرقابة». لا يفترض عملك وجود مصدر إلهام من هذا النوع على الإطلاق. ومع ذلك، لديك ما يمكن أن يأمل القليل من الكتاب الغربيين في الاستمتاع به: قصص ترويها، وقراء متلهفون لسماعها. يمكن وصفك تقريبًا بأنك راوي قصص من النوع الأكثر تقليدية: مسافر يعود بقصص رحلته. لدي فضول لمعرفة كيف انتقلت من كونك صحفيًّا في وكالة صحافة إلى كاتب. ما الذي جعلك تريد كتابة الكتب؟
● من المفارقات أن الكتاب الغربيين، وبخاصة الأميركيون، يحسدون دائمًا الكاتب الذي يعيش في ظل نظام قمعي سياسي، والذي يتمتع بما وصفه جورج شتاينر بـ«إلهام الرقابة». لا يفترض عملك وجود مصدر إلهام من هذا النوع على الإطلاق. ومع ذلك، لديك ما يمكن أن يأمل القليل من الكتاب الغربيين في الاستمتاع به: قصص ترويها، وقراء متلهفون لسماعها. يمكن وصفك تقريبًا بأنك راوي قصص من النوع الأكثر تقليدية: مسافر يعود بقصص رحلته. لدي فضول لمعرفة كيف انتقلت من كونك صحفيًّا في وكالة صحافة إلى كاتب. ما الذي جعلك تريد كتابة الكتب؟
■ مرة أخرى، عملي صحفيًّا في وكالة مهم؛ لأن جميع كتبي تطورت من التجارب التي مررت بها. كانت مسؤوليتي دائمًا تغطية حدث ما: تحديد موقع القصة الجيوسياسي، وبأسرع وقت ممكن، أرسل برقية على طول الخط بتفاصيلها. كانت صحافة مباشرة، لا أكثر ولا أقل. لكن بمجرد إرسالي البرقية، كنت أشعر دائمًا بالنقص، لقد غطيت الحدث السياسي فقط، ولم أنقل فعلًا الطبيعة الأعمق، وشعوري بصدق لما كان يجري. وكان هذا الشعور بعدم الرضا يراودني في كل مرة أعود فيها إلى بولندا.
ويمكنك دائمًا العثور على نسختين من عملي. النسخة الأولى هي ما أفعله عندما أكون في الميدان: كل شيء في البرقيات، وتُحفظ القصص. النسخة الثانية هي ما أكتبه لاحقًا، وهذا يعبر عما شعرت به بالفعل، وما عشته، والانعكاسات المحيطة بالقصة الإخبارية البسيطة.
كما تعلم، البرقيات الصحفية هي وسيلة متحفظة للغاية لنقل الأخبار. لكن الحقائق التي نواجهها، ولا سيما في العالم الثالث، أكثر ثراءً وتعقيدًا مما تسمح لنا أي صحيفة بتقديمه.
الحدود بين الحقيقة والخيال
● إحساس المراسل بالنقص مشابه لشعور العديد من الروائيين الحداثيين بعدم الكفاية عندما قالوا: إن متطلبات الحبكة أو القصة التقليدية تمنع التعبير عن القصة الحقيقية- الأشياء المحيطة بالقصة.
■ نعم هذا ما أريد التعبير عنه.
● كيف تختلف إذن عن الروائي؟
■ آه، لقد تطرقت للتو إلى نقطة مهمة في تفكيري. منذ عشرين عامًا، كنت في إفريقيا، وهذا ما رأيته: انتقلت من ثورة إلى انقلاب، من حرب إلى أخرى؛ لقد شاهدت، في الواقع، التاريخ في أثناء صنعه. التاريخ الحقيقي والتاريخ المعاصر، وتاريخنا. لكنني فوجئت أيضًا: لم أرَ كاتبًا مطلقًا، لم أقابل قط شاعرًا أو فيلسوفًا- حتى عالم اجتماع. أين كانوا؟ كل هذه الأحداث المهمة، ولا كاتب واحد في أي مكان؟ ثم أعود إلى أوربا وأجدهم. يكونون في المنزل، يكتبون قصصهم المحلية: الصبي، الفتاة، الضحك، العلاقة الحميمة، الزواج، الطلاق، باختصار، القصة نفسها التي كنا نقرؤها مرارًا وتكرارًا منذ ألف عام. منذ أيام كنت أقرأ عن الروايات التي فازت بالجوائز الفرنسية السنوية. كان شيئًا لا يصدق. لم يكن لأي من هذه الكتب أي علاقة بعالمنا، بواقعنا.
● إذن، هل تجد الأدب المعاصر مرجعيًّا للذات أكثر من اللازم، ومهوس جدًّا بأعماله الشكلية الخاصة؟
■ لا، ببساطة كثير من أدبنا تقليدي للغاية، حتى عندما يُنظر إليه على أنه طليعي. وإذا كان رائدًا فبسبب أسلوبه فقط، كما لو جُمع في ورشة عمل. لم يكن أبدًا طليعيًّا لموضوعه؛ لم يُكتشف فعليًّا وهو ينظر إلى العالم، فالكاتب دائمًا ينظر من فوق كتفه ملاحظًا موقف سلفه. الأدب المعاصر مسألة خاصة جدًّا.

● أتذكر مقال جوزيف برودسكي عن الرواية الروسية الذي يقول فيه: إن القرن العشرين لن ينتج أبدًا رواية «روسية» حقيقية؛ لأن كثيرًا من الخيال الأدبي تسيطر عليه الدولة، سواء في انصياعه، أو حتى في المقاومة اللازمة لذلك. ربما يكون عملك أقرب ما يكون إلى التحرر من قيود الدولة.
■ أنا لا أعرف. أنا لا أضع مانيفستو وبالتأكيد لا أريد أن أبدو كأن لدي دوجما. لكني أشعر أننا نَصِفُ نوعًا جديدًا من الأدب. أشعر أحيانًا أنني أعمل في مجال أدبي جديد تمامًا، في منطقة غير مطروقة أو مستكشفة.
● أدب التجربة السياسية؟
■ الأدب الشخصي… لا، هذا ليس صحيحًا. تعرف، أحيانًا، في وصف ما أفعله، ألجأ إلى العبارة اللاتينية silva rerum: غابة الأشياء. هذا هو موضوعي: غابة الأشياء، كما رأيتها، العيش والسفر فيها. لاستيعاب العالم، عليك التغلغل فيه بأكمل صورة ممكنة.
● لكن استخدام القصة لفهم هذه الغابة من الأشياء، لإضفاء الشكل والترابط؟ لأن كتابتك تعتمد بالتأكيد على السرد.
■ نعم، القصة هي البداية. نصف الإنجاز. لكنها لا تكتمل حتى يصبح الكاتب، جزءًا منها. عايشت هذا الحدث فوق جلدي كاتبًا، وتجربتك هذا الشعور، هو ما يمنح قصتك تماسكها: ما يقع في قلب غابة الأشياء. الحيلة التقليدية للأدب هي حجب الكاتب، والتعبير عن القصة من خلال راوي ملفق يصف حقيقة ملفقة. لكن بالنسبة لي، فما يجب قوله تؤكده حقيقة أنني كنت هناك، وشاهدت الحدث. أعترف أن هناك أنانية معينة فيما أكتبه، أشكو دائمًا من الحرارة أو الجوع أو الألم الذي أشعر به، لكن من المهم للغاية أن يكون ما أكتبه موثقًا بعيشه. يمكن أن تسميه، على ما أعتقد، ريبورتاج شخصي؛ لأن المؤلف حاضر دائمًا.
● كيف يختلف هذا عن الصحافة الجديدة؟ عمل هانتر إس تومبسون أو جوان ديديون أو توم وولف، الذين أضافوا امتيازات حكاية المتكلم* إلى المراسل؟
■ هذا سؤال مهم. بينما لم أكن أعرف شيئًا عن الصحافة الجديدة عندما كنت في إفريقيا، يمكنني الآن رؤية أن الصحافة الجديدة كانت البداية في إذابة الحدود بين الحقيقة والخيال. لكن الصحافة الجديدة كانت في النهاية مجرد صحافة تصف غرابة أميركا. أعتقد أننا تجاوزنا كل ذلك، إنها ليست صحافة جديدة، بل هي أدب جديد. لماذا أنا كاتب؟ لماذا جازفت بحياتي مرات عدة، وأوشكت على الموت؟ هل لحكي الغرائب؟ لكسب راتبي؟ عملي ليس مهنة، إنها مهمة. لن أعرض نفسي لهذه المخاطر إذا لم أشعر أن هناك شيئًا مهمًّا للغاية -حول التاريخ، عن أنفسنا- شعرت بأنني مجبر على عبوره. هذا أكثر من مجرد صحافة.
* حكاية المتكلم هو نمط من رواية القصص، فيه يسرد الراوي الأحداثَ من وجهة نظره مستعملًا ضمير المتكلم المفرد أو الجمع.
المصدر: Granta Magazine







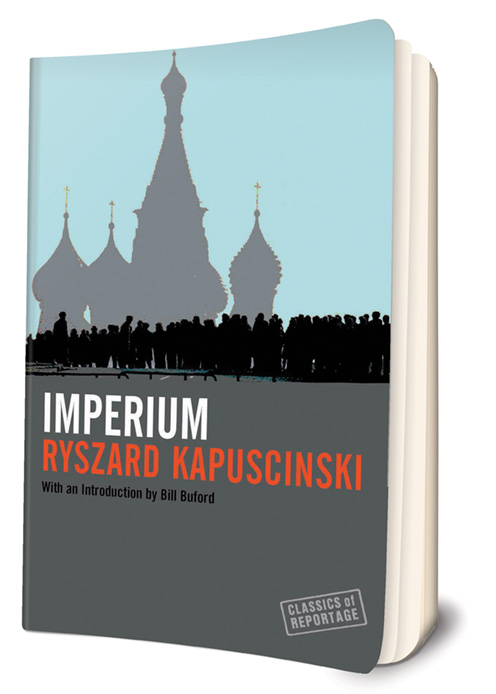 ●
●
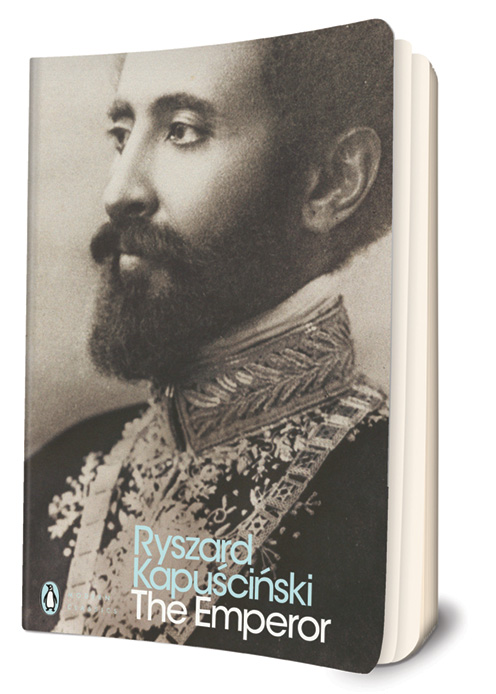 ●
●



0 تعليق