في الثاني من شهر يونيو من العام الحالي، فقدت الثقافة التونسية والعربية واحدًا من أعلامها، أعني بذلك المفكر والمؤرخ الكبير الدكتور هشام جعيط، الذي توفي عن سنّ تناهز 86 عامًا، أمضى الشطر الأكبر منها في التأليف في مجالات تتصل بالتاريخ الإسلامي، وبالحضارة العربية الإسلامية، وبماضي العرب وحاضرهم فكريًّا وثقافيًّا وسياسيًّا…
كان الدكتور هشام جعيط على فراش مرضه الأخير لما أصدر كتابًا بالفرنسية عن دار «سيراس» التونسية حمل عنوان: «معنى التفكير في التاريخ وفي الدين». وهو يحتوي على قسمين: حمل الأول عنوان: «قضايا التاريخ». أما القسم الثاني فحمل عنوان: «معنى التفكير في الدين». كما تضمن الكتاب مُلحقًا عن الديانات السماوية وتأثيراتها في الحضارات الإنسانية. ويهدف هذا الكتاب، بحسب مقدمة مؤلفه، إلى دراسة بعض الأسس المهمة للحضارات البشرية عبر التاريخ. ويركّز على قوتين فاعلتين هما، الهجرات البشرية والدين. كما يتطرق الكتاب إلى أسس أخرى مثل الدولة، والاقتصاد، والبنى الاجتماعية اعتمادًا على فلاسفة كبار عالجوا هذه القضايا، واهتموا بها اهتمامًا كبيرًا مثل: ابن خلدون، وهيغل، ودوركهايم، وبروديل، وماكس فايبر…
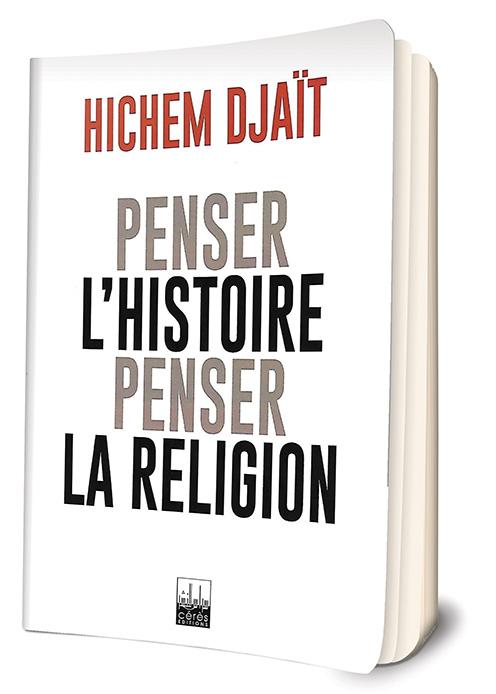 وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.
وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.
ويعتقد الدكتور هشام جعيط أن الهجرات لعبت دورًا مُهمًّا عبر التاريخ البشري؛ فقد كانت الجموع البشرية تنتقل من فضاء جغرافي إلى آخر حاملة معها لغات، وعادات وتقاليد وأديانًا ومعتقدات وأساطير وخرافات. وهذا ما حدث في منطقة الشرق الأوسط. كما أن الهجرات ساهمت في تكون ما أصبح يسمى بـ«الثقافة الهندو-أوروبية». كما ساهمت الغزوات الحربية في تأسيس ثقافات، ونشر لغات ومعتقدات. حدث ذلك خلال المدة التي خاض فيها ألكسندر المقدوني حروبًا من أجل ضم بلاد الشرق إلى اليونان ليكون هذا البلد مركز العالم الحضاري والثقافي والسياسي. كما حدث مع الغزو الإسباني لأميركا الجنوبية حيث فُرضت الديانة المسيحية ونُشرت اللغة الإسبانية بقوة السلاح. وبسبب ذلك ارتُكبت مجازر فظيعة مثل تلك التي حدثت في أميركا الشمالية بعد أن اكتشفها كريستوف كولومبس. كما تمكن العرب القادمون من الجزيرة العربية من نشر الإسلام واللغة العربية في العديد من المناطق البعيدة جدًّا من فضائهم الجغرافي.
ويرى الدكتور هشام جعيط أن العرب تمكنوا، بفضل الإسلام، من التحرر من التقاليد القبلية والعشائرية التي كانت سائدة ليؤسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف على أنقاض إمبراطوريتين كبيرتين، هما الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. وفي البداية كانت الحروب هي الوسيلة لاكتساح فضاءات جغرافية جديدة، لكن شيئًا فشيئًا أصبحت اللغة العربية، التي هي لغة القرآن الكريم، الفاعلَ الأساسيّ في توسع رُقْعَة الحضارة العربية-الإسلامية.
وفي القسم الخاص بالدين، يُشيرُ الدكتور هشام جعيط إلى أن تجاربه وقراءاته لكبار الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين أفضت به إلى أن الإنسان «مُتديّن بطبعة». ويعود ذلك إلى أن العالم الخارجي يُرْبكُه، ويُخيفه، ويثير فيه الحيرة والشك؛ لذا هو يجد في الدين ما يخفف عنه وطأة الحياة، ومتاعبها.
العلاقة بين الدين والحداثة
وبعد أن يستعرض الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي بسطت بها الديانات الكبيرة الثلاث؛ أي اليهودية، والمسيحية، والإسلام سلطتها على مساحات جغرافية شاسعة في القارات الخمس، يقدم لنا هشام جعيط قراءته الخاصة للعلاقة الملتبسة بين الدين والحداثة. وهو يرى أن الحداثة كانت أدبية في بداياتها؛ إذ ظهر شعراء وكتاب أرادوا القطيعة مع الكلاسيكية التي كانت في جلها محاكاةً وتقليدًا للآداب اليونانية والرومانية شعرًا ونثرًا. غير أن أولئك الشعراء والكتاب لم يكونوا يعلمون أن تلك القطيعة لم تكن تخصّ فقط أنماطًا من الكتابة، بل كانت تخصّ أيضًا أنماطًا من التفكير والحياة.
كما أنها تمثل أيضًا فاتحة لعصر جديد كانت فيه أوربا قد بدأت تخرج من العصر الوسيط، وأيضًا من عصر النهضة، لتدخل عصرًا جديدًا سيتميز بظهور الرأسمالية، وبرغبة بعض الدول الغربية في التمدّد والتوسع في إفريقيا وآسيا تحديدًا. وقد تميزت هذا الحقبة بظهور فلاسفة ومفكرين لم يترددوا في التصدي للكنيسة، وطُرق استعمالها للدين لقمع واضطهاد أهل القلم والفكر، ونصب المشانق لهم في الشوارع والساحات، وحرقهم وحرق كتبهم، مثلما حدث خلال المدة التي استفحلت فيها محاكم التفتيش.

إيمانويل كانط
ويرى هشام جعيط أن فلاسفة تلك الحقبة أمثال ديكارت، وسبينوزا، ولوك، وهيوم، وهوبز لم ينتقدوا الدين في مضامينه وأصوله، بل هم ركزوا على توجيه سهام نقدهم، العنيف أحيانًا، للكنيسة التي تلجأ إلى الدين لتشريع الاستبداد الديني والسياسي، وقمع الحريات الخاصة والعامة. ومع فلاسفة الأنوار الفرنسيين الكبار فولتير، وروسو، وديدرو، احتدّ النقد ضد الكنيسة، وضد أنظمة الحكم الملكية المتحالفة معها. وعلى الرغم من المضايقات المُجحفة التي تعرضوا لها، فإن أولئك الفلاسفة واصلوا معركتهم الفكرية بجرأة كبيرة لتكون أفكارهم وأطروحاتهم فتيلًا للثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789م.
ويشير الدكتور هشام جعيط إلى أن فلاسفة الأنوار في ألمانيا يختلفون عن نظرائهم في فرنسا، وبريطانيا؛ إذ إنهم لم يحشروا أنفسهم في المعارك السياسية، بل ركزوا على بلورة أطروحات فلسفية وفكرية جديدة تقطع مع الماضي، وتساعد النخب على مواجهة ما سوف تفرزه العصور الحديثة على جميع المستويات. وهذا ما فعله كانط (1727-1804م) في جميع مؤلفاته الفلسفية التي تزامن ظهروها مع الاكتشافات العلميّة الكبيرة خلال القرن الثامن عشر. وتقوم تلك المؤلفات على إعطاء القيمة العليا للإنسان الذي يتحتم عليه، بحسب الإمكانيات المتاحة له، منح معنى للعالم من وجهة نظر المعرفة، والأخلاق، والمصالح السياسية.
ويعتقد الدكتور هشام جعيط أن هيغل (1770-1831م) وسّع مجال الفلسفة، وفتح أبوابًا جديدة لم تُطرَق من قبل. وقد أتاحت له معارفه الموسوعية أن يُلقَّب بـ«أرسطو» عصره. فقد اهتم بالكيمياء وبعلم التنجيم، وبعلم النفس، وبالاقتصاد، وبالسياسة وبالفنون بجميع أنواعها. كما اهتم بالتاريخ اهتمامًا كبيرًا؛ لذا يمكن أن نقول: إن جميع الفلاسفة الذين اشتهروا في القرنين التاسع عشر والعشرين مثل ماركس، ونيتشه، وكيركوغارد، وكوجيف، وهايدغر، وغيرهم، استندوا إلى فلسفته، ومن وحيها بلوروا مفاهيم وأطروحات جديدة.
ويرى الدكتور هشام جعيط أن هيغل بلور أطروحاته الفلسفية من خلال ما تمليه عليه روح العالم. ويشير الدكتور جعيط إلى أن هيغل اهتم في سنوات شبابه بـ«العقيدة»، وبما سماه بـ«الدين الإيجابي» الذي يكون عمادًا للدولة التي تحكم «مجتمعًا واعيًا بوجوده التاريخي».
واضح أن الراحل الدكتور هشام جعيط أراد من كتابه الأخير هذا أن يجيب عن أسئلة كثيرة تشغل النخب العربية حول الحداثة، والدين وعلاقته بالسياسة، محاولًا أن يقدم تصوره لمجتمع جديد تتصالح فيه الحداثة مع الأصالة، ويتحول فيه الدين إلى «قوة إيجابية» دافعة للتقدم والرقي، ومحرضة على الحرية والديمقراطية، وكل القيم السياسية والفكرية والإنسانية التي تحتاجها المجتمعات العربية للخروج من المآزق والأزمات التي تتخبط فيها راهنًا.







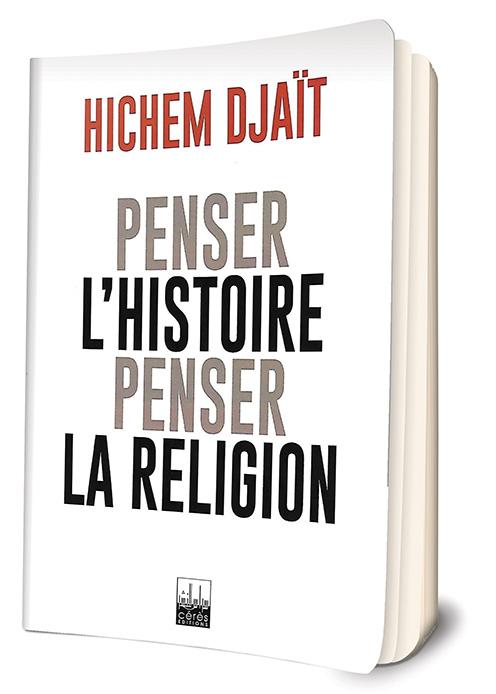 وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.
وفي المقدمة، يُضيف الدكتور هشام جعيط قائلًا: «مؤرخًا، اهتممت بالفلسفة في جميع تجلياتها، خصوصًا حين يكون لها ارتباط بالتاريخ. وبما أنني أنتمي إلى ثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، فإنني سمحت لنفسي بالسباحة بينهما، مُخْتارًا أمثلتي من هنا ومن هناك». ويرى هشام جعيط أن الثقافتين المذكورتين لهما قواسم مشتركة، وصلات قوية عبر مختلف مراحل التاريخ، وهما تختلفان عن ثقافة الشرق الأدنى. مع ذلك هو سمح لنفسه بالبحث في مسائل تتصل بالثقافة في الهند، وفي الصين، ودراسة بعض جوانب الديانات الشائعة في هذين البلدين.



0 تعليق