ليس بالأمر الجديد استحضار الشاعر لمكانه الأثير في شعره لدرجة تجعله يفرد كتابًا كاملًا له، أكان موضع طفولته ونشأته أو حتى موضع إقامته، وهذا ما رأيناه في «باريس» بودلير، أو «جيكور» السيّاب، أو حتى في «صور» عباس بيضون و«نيويورك» لوركا، وما هذا الاستحضار الذي يأتي بلغة البراءة الطفولية لدرجة تُظهره للقارئ مركبًا لدرجة التعقيد، إلا نوعًا من الفرار من وجه العالم وقسوته ومشاقه، ليغدو هذا المكان بمنزلة الحديقة الخلفية التي يستريح فيها الشاعر ويحاولُ استذكار ماضيه فيه.

علي محمود خضيّر
من هذه النقطة ينطلق على محمود خضيّر في عمله الشعري الرابع «كتاب باذبين» (دار الرافدين- بيروت 2021م)، فهو يبدأ من باذبين وينتهي بها (أو المنصورة- علي الغربي- تل البيادر حسبما ترد في النصوص)، فتتكامل النصوص لتشكّل ما يشبه بالدائرة السيَرية للشاعر وعالمه معًا، هذا العالم الذي لا ينزاح عن الطفولة والبراءة المفقودين لصاحب «سليل الغيمة»، وكأنه يود لو يمسح الغبار عنهما ويعيد إنتاجهما في مخيلته، متّخذًا من مفردات محكيّته العراقية الدارجة (الأمّاية، الطابوق، الطرطيع، الطارمة، …) حقلًا معجميًّا غنيًّا لعالمه، وركيزةً جميلةً في إضفاء الحيوية على النص العربي الفصيح.
وباذبين هذه هي التسمية القديمة لبلدة «علي الغربي» الحالية، وقد ورد ذكرها في مصنّف ياقوت الحموي «معجم البلدان» كالآتي: «باذبين بكسر الباء الموحدة، وياءٌ ساكنةٌ ونون، قرية كبيرة كالبلدة تحت واسط على ضفّة دجلة، منها جماعة من التجار المثرين، ومنها جماعة من رواة العلم، منهم: أبو الرضا أحمد بن مسعود بن الزقطرّ الباذبيني…». وقد سمّيت بالمنصورة في العصور الإسلامية الأولى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، أما تسميتها بعلي الغربي فتعود لقائد ثورة الزنج أيام المتوكل العباسي الذي عرف أيضًا بالغرابي.
عالم غني بالاختلاط
ولعل العالم الغني لهذه البلدة، الذي عرف تخالطًا عظيمًا لساكنيها على مر العصور من يهود ومندائيين وأكراد وعرب، هو عالم الشاعر وسرّ سيرته الشعرية هذه، وما استحضاره لاسمها السومري القديم (باذبين هي عبارة سومرية مركّبة من كلمتين «باذ» و«بين» وتعني تل البيادر) إلا شيئًا من البحث عن هوية المكان والزمان الفائت لإعادة الطفلِ إلى نفس الشاعر، هذا المكان الذي يعترف الشاعر في نص «كتاب أبي» أنه مفتاح هذا الكتاب الذي لم يكن ليأتي لولا استقرار والده فيه، فيقول: «فلولا مجيئه لباذبين وقراره الزواج والإقامة فيها ما كنتُ لأقطع هذا الطريق، وما كان للكتاب أن يجمع علاماته».
هذا ويكرّس خضيّر تفكيره الطفولي من خلال كوننة بلدته، لدرجة نكاد نشعر أن نهاية هذا العالم مسدودةٌ بجدرانٍ عاليةٍ، وهنا أمام هذا المسار يلجُ في عوالم البلدة المتعددة ليجعلها خاصة به وحده، فيبدأ بمنزله والحياة الهادئة داخله في قصيدة «بيتٌ تحرسه سدرتان»، مارًّا بغرفة والده المظلمة، أو مخزن ورشته الذي كان جزءًا محرّمًا عليه، وكذلك أحلام طفولته البريئة التي ربما يخالها الآن نقمةً بعد أن كبر، وأيضًا عن الإيمان الفطري لأهل البلدة في ذكره المعتقدات الخاصة بمرقد علي الغرابي في قصيدة «الطريقُ إلى علي الغرابي» حين يقول: «الأكفّ المحنّاة تركت على الجدران في الخارج حزامًا عقيقيًّا يسوّر المرقد بشهيق الناذرين ونار انتظارهم. تعضّده، بين ركوعٍ وسجودٍ، أذكار المصلّين وهمهمات المسبّحين ورجاء الداعين في الأركان والأروقة…».
بورتريه موحد
أو حتى ذكره لخرافة «عبد الشط» التي تزرعها الأمهات في رؤوس أطفالهم العصاة قائلًا: «طويلٌ، بأصابع ناحلة/ بابتسامةٍ نصف ميّتةٍ وشعرٍ أشقر/ عارٍ، أو يكاد/ يسحبُ الأطفال العصاة إلى النهر ويغيب». غير أن الشاعر يحاولُ في بعض الأحيان أن يصنع من عالمه الفريد بورتريهًا موحّدًا للبلدات والقرى العراقية من خلال العديد من القواسم المشتركة، فيبدأ بتطرّقه لحصار العراق الذي كان له آثاره النفسيّة في الشاعر والشعب على حدّ سواء في نص «سوقٌ في التسعينيات»، وكذلك الأجواء العاشورائيّة الكربلائيّة في بلدات العراق، متحدّثًا عن عادات وتقاليد أهلها في نص «المهباشة»، بل يتخذ موقفًا واضحًا تجاه المعاملة التي يلقاها الغجر أو «الكولية» كما يسمّون بالدارجة العراقية ويعنون نصّه عنهم، فيعمل على تجميل صورتهم التي قبّحتها تيارات الإسلام السياسي جراء عملهم في الرقص.
تتوزّع قصائد المجموعة الممتدّة على 103 صفحات من القطع المتوسط بين شقين شعريين، وإن لم يأتِ ترتيبٌ واضح لهذين الشقين، وهما الشعر الحرّ الذي عدَّه شقًّا مأزومًا ومتوتّرًا، والنثر الذي عدَّه تأويليًّا ومنبسطًا. ولعل جنوحه نحو النثر من شأنه أن يفسّر مقدرة شكل الشعر الحر على رصد التصويرات المختلفة في نصه، فكان النص أقرب إلى ما يمكن لقصيدة النثر بشكلها الفرنسي الخالص.
وهذا النثر بدوره مفرطٌ في السرد حتى يكاد يشبه السرد القصصي، غير أنه يعطي تداخلًا معقّدًا بين مقدرة خضيّر على السرد وقدرة هذا السرد على إعطاء النص شاعريته، كما في «أحزان باريس» لبودلير، و«جنّي الليل» لبرتران. غير أنّه حتى في قصائده التي تحاكي شكل الشعر الحر قد بدت ملامح السردية واضحة معطية للنصوص نفسًا نثريًّا طريًّا. وهنا نستذكر مقولة أبي حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» حين يقول: «أحسنُ الكلام ما… قامت صورته بين نظمٍ كأنه نثر، ونثرٍ كأنه نظم»، ولعل خضيّر عن غير قصدٍ قد جعل من مجموعته الشعرية هذه مثالًا دقيقًا لمقولة التوحيدي هذه.
يمكن القول: إن تجربة علي محمود خضيّر هذه هي الحديث التاريخي الخفيّ عن الحواضر الصغرى شعرًا، فلعل إغراق المكتبات بالمؤلفات التاريخية المكرّسة للحديث عن مدن وبلداتِ الأطراف في أيّ بلدٍ من شأنه أن ينفض الغبار عن بعض ما يختزله المكان من الزمن من دون أن يفصح عما تقوله سريرته، ليكون الشعر هو الحيّز الذي يفرّغ فيه ما لا يرغب في قوله على الدوام، ويكون الشاعر هو لسان هذا المكان وجسده، كضربٍ من التناسخ الذي من الممكن أن يتجسّد بعد أعوامٍ طويلةٍ بشاعرٍ آخر يقول ما لم يدركه سابقوه.

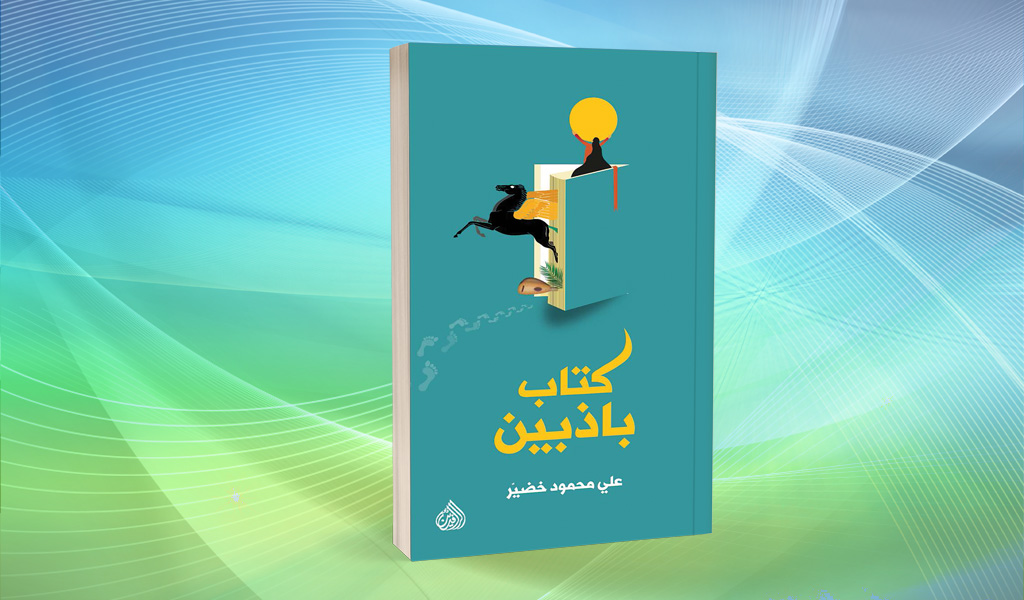









0 تعليق