لم يبالغ الأديب الكويتي محمد الشارخ عندما وصف مواطنه الروائي والقاص طالب الرفاعي بـ«المؤسسة»، ذات لقاء في منزله ضم عددًا من المثقفين والأدباء العرب. المؤسسة بما تعنيه من جهود لا يقوم بها عادة فرد أو حتى مجموعة أفراد، جهود على مقدار كبير من دقة التنظيم ووضوح الرؤية ونبل الأهداف. ذلك هو طالب الرفاعي، كاتب الرواية والقاص الذي ربما لا يمضي يوم من دون أن يكتب قصة قصيرة، طالب ينشر مقالًا أسبوعيًّا، ويُدَرِّس تقنياتِ الكتابة للطلاب في أكثر من جامعة أهلية مرموقة في بلده، طالب الذي ينظم ملتقًى ثقافيًّا في منزله، الذي أول من سيستقبل الزائر فيه زوجة وبنات تميزهم رحابة صدر نادرة، كما يدير ويشرف على جائزة الملتقى للقصة العربية، التي أسسها بالشراكة مع الجامعة الأميركية، ثم جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت، وأضحت واحدة من أهم الجوائز التي تحتفي بنوع أدبي يكاد يندثر، فأعادت له الاعتبار، وأصبح كتابه يسعون إلى نيلها.
في رواياته وقصصه لن يخفى على القارئ، انحياز صاحب «سمر كلمات» إلى العمال، بسبب مهنة الهندسة المعمارية التي كان يزاولها، وجعلته قريبًا من هذه الشريحة من العمالة العربية، التي عملت ولا تزال تعمل في دول الخليج، تحت ظروف صعبة. أيضًا تعكس أعماله الأدبية في شكل أوسع التصاقه بقضايا مجتمعه، تلك التي تطرأ على السطح، أو تبقى متخفية في انتظار كاتب يتحلى بجسارة وجرأة غير مسبوقة ليسلط الضوء عليها ويخرجها إلى العلن، تمثل أعماله الحالات القصوى في تشريح المجتمع.
قارَبَ طالب الرفاعي، الذي تحتفي «الفيصل» بتجربته، قضايا إشكاليةً وموضوعاتٍ مسكوتًا عنها، مثل تفكك الأسرة وتداعي المجتمع في الكويت، بفعل ضربات عدة قاسية؛ منها «الاحتلال»، ومنها التشدد الديني، والطائفية، وسيادة قيم الاستهلاك. يفعل صاحب «النجدي» كل ذلك، من دون أن يبارح جمالية الرواية وتقنيات القص، ومن دون أن يتخلى عن نزعة التجريب في هذا العمل أو تلك القصة. متنقلًا، داخل سياقٍ تَحكمُه رؤيةٌ عميقة لماهية العمل الأدبي، من التخييل الذاتي إلى التوثيق الروائي والسِّيَر الروائية.
يمارس صاحب «حاجي» فِعْل الكتابة بانتظام، ففي كل ثلاث سنوات تقريبًا يصدر رواية أو مجموعة قصصية، تمثل علامة بارزة في تجربته الممتدة، وجعلته هذه الأعمال أحد الأسماء العربية البارزة، التي تراكم مشروعًا ينطوي على تنوع وتفرد لافتيْنِ. حاز صاحب «الكراسي» و«رمادي داكن» أكثر من جائزة مرموقة في بلده، وتناول النقاد العرب منجزه الأدبي في دراسات مطولة، واحتفت بتجربته ملتقيات السرد وندوات الرواية التي تُنظَّم في أكثر من بلد عربي، كما تُرجِمتْ بعض أعماله إلى عدد من اللغات. وفي الآونة الأخيرة تَحوَّل طالب الرفاعي إلى وجهة، لا بد من المرور بها، لكل مثقف عربي يزور الكويت.
لا أعرف عيشًا آخر!
طالب الرفاعي
هو عيش البشر، يسعون فيختارون دربًا، وتقتنصهم دروب كثيرة ترتع في أيام أعمارهم القصيرة. الآن وقد تجاوزت الستين بقليل، يبدو لي واضحًا أن محطات كثيرة في حياتي لم تكن كما بدا على وجهها لحظة التقيتها للمرة الأولى! بينما محطات أخرى جاهدتُ وحلمتُ بالوصول إليها، وتكشفت لي حين وطئت عتبتها عن أذى مسَّ ومضَّ في قلبي وروحي. ومحطات ثالثة قد تكون مرّت ببالي، لكن ما إن دخلت دربها حتى انفتحت لي آفاق كثيرة مُلوّنة ومتشعّبة، لم تكن بأي شكل من الأشكال قد وردت بذهني.
 ومحطات خيرٍ لا جاهدتُ ولا سعيتُ ولا مرت ببالي، جاءتني بمحض قدرية الحياة، تقصدني لتأخذني لحضنها، وكم ارتاحت روحي في فيء ظلالها الوارفة! لذا إذا كان لي من وقوف أمام أهم المحطات الأدبية في حياتي، فسأقول:
ومحطات خيرٍ لا جاهدتُ ولا سعيتُ ولا مرت ببالي، جاءتني بمحض قدرية الحياة، تقصدني لتأخذني لحضنها، وكم ارتاحت روحي في فيء ظلالها الوارفة! لذا إذا كان لي من وقوف أمام أهم المحطات الأدبية في حياتي، فسأقول:
قراءة أول رواية في حياتي: «الأم» للكاتب الروسي مكسيم غوركي، بترجمة سامي الدروبي، وكنتُ وقتها في الصف السادس الابتدائي، كانت بمنزلة فتح نافذة عريضة على لوحة حياة ملوّنة، ومتحركة، وآسرة. نافذة ما زلتُ أقف خلفها بدهشتي الأولى لأعاين آلاف الحيوات التي تدور في كل مكان، وما زالتْ تسحرني بألوانها وإبداع أصحابها المفكرين والكتّاب والفنانين!
المحطة الثانية جاءت يوم نشرتُ أول قصة قصيرة لي بعنوان «إن شاء الله سليمة» في جريدة الوطن الكويتية صباح يوم الأربعاء 17 يناير 1978م، ولحظتها وقفتُ لأخطو خطوتي الأولى على درب الكتابة والنشر. مؤمنًا بأن الكتابة مسؤولية كبيرة؛ لأنه يراد لها أن تكون إضاءة وسؤالًا وعونًا لقارئ على فهمِ واقعه وبيئته. وقبل هذا وذاك تسلية رفيعة تساعده على احتمال مرارة ولا عدالة واقعه! بدأتُ المشوار منذ قرابة ثلاثة وأربعين عامًا، حتى اللحظة تحيّرني وتحتويني كتابة القصة، وكطفل أدندن بلحن راقص لحظة أنتهي من كتابة قصة جديدة!
بَدْءُ عملي كمهندس مدني في مواقع المشاريع الإنشائية عام 1982م، الذي استمر لمدة خمسة عشر عامًا، مع آلاف العمال والفنيين ومئات المهندسين، وبسبب من طبيعة سوق العمل في الكويت، بوجود ومخالطة قرابة مئة جنسية عربية وأجنبية، كان مدرسة وجامعة إنسانية شاسعة ومؤلمة، تعلمتُ فيها، تحت شمس حارقة، قراءة ومعايشة وجع الإنسان، ومشاهدته وهو يبادل عرق جبينه بلقمة عيش مرّة، على وقع لحظة قاسية، تدور حتى يُقصف عمره، ويموت! الموقع والعمال والفنيين والمهندسين كانوا حياةً كتابًا قرأت فيه ما كوّن وعيًا مختلفًا لديّ تجاه الإنسان وقضاياه وعيشه، وأثّر وما زال يؤثر فيما أكتب، وقد سجلت تلك الحَيَوَات في عشرات القصص القصيرة، وكذلك في أول رواية لي بعنوان «ظل الشمس».
نَشْرُ رواية «ظل الشمس، عام 1998م، كان انعطافًا لي في درب مختلفٍ تمامًا عن درب القصة القصيرة، وكان مغامرة متجددة ومشوّقة ما زلت أخوض غمارها؛ لكونها تشكّل حياة أخرى توازي حياة الواقع الذي أعيش. لكنها حياة تمنحني القدرة على قول وفعل ما أعجز عنه على أرض الواقع، وبذا تمكنني من عيش لحظة كنتُ أتمنى عيشها في الواقع ولم أستطع!
انطلاقًا من قناعتي بأن الفعل الثقافي لا يقف عند الكتابة والنشر، وفي عام 2011م، أسستُ ومجموعة من الأصدقاء، وعلى رأسهم الروائي إسماعيل فهد إسماعيل والكاتبة ليلى العثمان، صالونًا أدبيًّا بعنوان «الملتقى الثقافي»، تنعقد جلساته في بيتي، ويستضيف مفكرين ومبدعين ومثقفين من الكويت والوطن العربي والعالم، وتغطي الصحافة الثقافية أمسياته، ويُصدر في نهاية كل موسم كتابًا توثيقيًّا لأنشطته.
سفري إلى الولايات المتحدة الأميركية، واشتراكي في برنامج «الكتابة الإبداعية العالمي-International Writing Program» في جامعة «آيوا-University of Iowa» أخذني لفهم جديد لماهية الكتابة الإبداعية، سواء في القصة القصيرة أو الرواية. هناك، وفي واحد من أقدم البرامج الثقافية في أميركا، عاينت كيف أنهم يتعاملون مع الإبداع بوصفه مادة دراسية كالرياضيات والفيزياء والفلسفة، وأن على منْ يريد ارتياد طريق الكتابة الإبداعية أن يتوافر على موهبة ورصيد قراءات متجدد ومستمر، وأن يتبحّر في معرفة أصول الجنس الأدبي الذي سيشتغل عليه. وهذا ما قادني لاحقًا للدراسة في «جامعة كنغستون لندن-Kingston University London» والحصول على شهادة ماجستير احترافية في الكتابة الإبداعية «Master of Fine Art Writing»
عشقًا وإخلاصًا لفن القصة القصيرة، وبالتعاون ما بين «الملتقى الثقافي»، والجامعة الأميركية في الكويت (AUK)، أطلقتُ عام 2015م، جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية؛ لتكون بذلك مساهمة الكويت الأهم في مشهد الجوائز العربية، في ظل مجلس أمناء عربي، ولائحة جائزة ولجنة تحكيم محترفة، وبما ضمن ويضمن للجائزة مكانة مرموقة، وقد انتقلت الجائزة بعد دورتها الثالثة لتحط في حرم جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت (AUM) ولم تزل.
إن عملي في الجامعة الأميركية في الكويت، محاضرًا لمادة الكتابة الإبداعية، أخذني لعالم جديد عليَّ حيث التدريس وفق منهج «الورشة الإبداعية الأميركية»، واجتماع الأستاذ والطالب حول نصٍّ يتخلق، وبما يجعل من عملية التدريس درسًا عمليًّا للطالب والمدرس.
الآن، وبعد نشر تسع مجاميع قصصية، وسبع روايات، وستة كتب بحثية، وقرابة 700 مقال صحافي ومئات الدراسات الثقافية، وبعد أن تُرجمت أعمالي إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والتركية والصينية، إضافة إلى رصيد من الأعمال الروائية والقصصية غير المنشورة، فإنني أحيا يومي بين القراءة والكتابة بأنواعها، وتدريس مادة الكتابة الإبداعية، وأشعر أنني أنتمي للحظة الواقع بقدر انتمائي للحظة الفن. وأنني أعيش تفاصيل لحظات يومي وشيءٌ مني يختلس مراقبتها رغبة في الكتابة عنها، وأنني أكتب عنها لأجعل منها واقعًا فنيًّا إنسانيًّا يبزّ واقع الحياة ويتفوّق عليه!
بتُّ أعيش يومي بين حرف وحرف، أستلذ وأتعب، لكني لا أعرف عيشًا آخر!
شراع بأعلى الوجد السردي
محمد خضير – كاتب عراقي

يملك طالب الرفاعيّ بقبضته إقليميْنِ، بل شرفتيْنِ، يطلّ منهما على عالميْنِ: عالم السرد القصصي، ومجازاة هذا العالم بجائزة الوفاء الأوفى. هو الإنسان المخلص لعائلته وأصدقائه. عرفتُ هاتين المُلْكيتيْنِ يومَ لم تكن في مملكة طالب الرفاعيّ غير «الثوب» و«الكرسيّ» مع حفنة من «حكايات رملية» وأسمارٍ من «كلمات». ومن هذه الممتلكات/ الكلمات اتسعت معرفتي بعوالم روائيّة تُراوِح بين التقليد المحلّي والتخطّي الجريء نحو عالميةٍ عزَّت على أدباء الخليج، ولم تتمنّع على ثلاثة أدباء مهمّين من الكويت: ليلى العثمان وإسماعيل فهد إسماعيل وطالب الرفاعيّ. أمّا حين نصّبَ الرفاعيُّ «كرسيًّا» لملتقى ثقافيّ، أردفَه بمنصّة لجائزة القصة القصيرة، فقد أراد من هذين المنجزيْنِ الوطنيّينِ، فتح الأبواب لرياح التغيير في بنية الثقافة الكويتيّة، وتأسيس روابط اتصالٍ تفاعليّة، عبر الحوض الأزرق والصحراء، مع ما يجاورهما من عمارة التجديد والمغايرة الثقافية والحضارية.
كانت رحلتي الأولى لدولة الكويت، عبر طريقٍ بريّة متّصلة ببوابتيْنِ رمليتيْنِ، متقابلتيْنِ، قد تأخّرتْ كثيرًا. كان لي أصهار وأنسباء وراء بوابة «العبدلي» وأصدقاء أحبّاء، غير أنّي لم أزُر بيتَ واحدٍ منهم حتى دعتْني مؤسسة عبدالعزيز البابطين، مع مجموعة كبيرة من الأدباء العراقيين المغتربين، لحضور الملتقى الشعري العراقي الأول في الكويت (مايو ٢٠٠٥م). إلا أنّ التعرّف الحقيقي إلى مناخ الكويت الثقافي وشخصياته الفاعلة، كان بدعوةٍ من طالب الرفاعيّ لإلقاء محاضرة في «الملتقى الثقافيّ» في مايو ٢٠١٤م، على هامش «ملتقى السرد الخليجيّ».
وقتذاك التقيتُ الروائيَّ إسماعيل فهد إسماعيل وجهًا لوجه، بعد أن افتقدتُ وجودَه في البصرة مذْ هجرَها إلى الكويت عام ١٩٦٩م. كانت هذه الدعوة باب الصلة بأدباء شاءت الأقدار الظالمة أن تُبعدني من ثلّة منهم، أثْرَوْا كويتَ الإبداع الجديد بنصوصهم وحضورهم الإنسانيّ الخصيب. ومن ساحل هذا المكان المفتوح على البحر كتبتُ أفضل مقالاتي عن فنّ القصة القصيرة، وبخاصة أنّ طالب الرفاعيّ وضعَني على جدول «جائزة القصة القصيرة» مستشارًا ومحاضرًا ومديرًا لجلساتها، خلال أربع دوراتٍ متتالية.
وإنْ أغفُلْ لا أغفُلْ لقائي بأدباء من مشرق الوطن العربي ومغربه، فضلًا عن أدباء عراقيّين وخليجيّين جمعتني بهم جلساتُ الجائزة أمثال: سعيد يقطين، وسعيد بنكراد، ومحمد الداهي، وخليل مردم بك، وإلياس فركوح، وسعيد الكفراوي، وسلوى بكر، وأحمد زين، ومحمد العباس، وفهد حسين، وريم الكمالي، ومحمود الرحبي، وسليمان المعمري، وناصر الظاهري، وعالية ممدوح، وسالمة صالح… وغيرهم من أصحاب القلم والرأي البارزين.
ستكون لطالب الرفاعي، فيما بعد، وقفاتٌ أعلى مقامًا في تشريع بروتوكولات الإجازة والوفادة لضيوف الكويت، حين كلّف في الدورة الرابعة لملتقى الجائزة مَن يُنجز كتابًا شاملًا عن القصة العربية القصيرة، جمعَ بين غلافيه نماذج قصصيّة وآراء جوهريّة في هذا الفنّ الانفراديّ، المستقلّ بقواعده وأجوائه وشخصياته «المغمورة» حسب وصف فرانك أوكونور.
كانت المكتبة العربية تفتقر لكتابٍ تعريفيّ، مفصّل، يغطّي عقودَ القصة الأولى والمتأخّرة، ويستذكر فضلَ روادها وكتّابها العرب من محمود تيمور إلى إبراهيم أصلان. ولعلّ هذا الإنجاز، وغيره من التعريفات المهمّة، سيُنجِب من الوجود المتلاشي لقصّة الأسلاف أعقابًا متجدِّدة، بتقاناتٍ وثيماتٍ وأجواءِ «لون الغد» حسب استشراف طالب الرفاعيّ لمستقبل المجتمع العربي/ ما بعد الكورونيّ. كان مقدّرًا لهذا الفنّ «الاحتياطيّ، أن ينتقل هو بذاته إلى مراحل جديدة لينجو من مَحجِر العزلة والإهمال؛ وشاء حظّ الأدب العربيّ أن تكون هذه الانتقالة الحاسمة من أرض الكويت، بإرادة فردية، غيور، من الممارس القصصيّ، طالب الرفاعي.
وفي غمرة هذه الأعمال والمخاضات العسيرة، التي تكتنف حياةَ أديبٍ مجاهد، ظلّ طالب الرفاعيّ يبعث برسائل خاصة من إقليمه/ شُرفته المطلّة على البحر، يضمنها رواياته الأخيرة «النجديّ» و«حابي» و«البَرحيّة». والرواية الأخيرة تضمينٌ لهجرة العائلات العراقية الأولى للكويت، واستدخالٌ للتقاليد الاجتماعية المشتركة في منطقة الخليج وعملُها في نشأة الوعي الاجتماعي الكويتي المبكر. ولا يزال الرفاعيّ صوتًا متردِّدًا بقوة بين منابع تلك النشأة ومصبّاتها في ثقافة العصر الأخير، في منطقة النهوض الأدبيّ الجديد. إنّه الشراع المبحِر إلى أعالي الوجْد السَّرديّ؛ حيث تتوحّد الذاتُ الرائدة بصاريها الشامخ، وتتوضأ بجوهرها الحكائيّ الأصيل.
المجتمعات الأبوية ودوائر النفي والإقصاء
سعاد العنزي – ناقدة كويتية

إن المنجز السردي للأديب طالب الرفاعي يحفل بالرؤية الاجتماعية والرؤية الإنسانية شأنه شأن أي خطاب أدبي رصين. يعكس عالم المكان في رواياته المتعددة البعد الاجتماعي بما فيه من توقف عند العادات والتقاليد الاجتماعية وطغيانها على المكان مثل رواية «سمر كلمات» التي يظهر فيها الدور التكويني الذي يلعبه حيز المكان في بلورة تصور المتلقي، حول عمق معاناة الشخصيات من جانب، ويرسم من ناحية أخرى معالم الكويت الحديثة مقارنة بالقديمة بعفوية سارد يتجول في الأحياء الكويتية والطرق والمباني الشامخة مما يضفي على المكان بعدًا حضاريًّا وإنسانيًّا يتجاوز فكرته كفضاء تدور فيه الأحداث.
إن المكان انقسم في الرواية إلى ثلاثة أنماط:
أولًا– المكان كفضاء عام للأحداث، وحيز يحتوي على شخوص الرواية.
ثانيًا– المكان كعنصر مفجر لمعاضل سيسولوجية وسيكولوجية تعانيها الشخوص؛ بسبب ضيق الحيز الاجتماعي وخنق الأفق الاجتماعي.
ثالثًا– المكان بوصفه ذاكرة جمعية لأبطال الرواية: ويقصد بهذا المكان الأماكن العامة، من طرق ومبانٍ ومدن ومؤسسات دولة، حرص الرواة على رصدها أولًا، ورصد انطباعاتهم حولها ثانيًا، وتعقب التحولات التي طالتها تلك الأماكن ثالثًا.
ومن ثم توثيق خريطة المكان الكويتي التي جاء تفعيلها إيجابيًّا في الرواية وبذكاء من المؤلف، جعلها تتكشف وتتبدى تلقائيًّا مع رحلة السرد حيث التجول في السيارة إلى مكان مقصود أو غير مقصود، تجولًا سرديًّا عائمًا في فضاء الحيرة والقلق والانتظار، أو حتى التمرد على الأوضاع، ومتداعيًا ذلك التداعي الحر الذي يمتزج وذاكرة المكان، فتتشكل الحكاية ممزوجة بين أحداث الماضي وتفاعل السارد مع المكان.
فطالب أحد شخصيات الرواية يقول في أحد الفصول السردية التي يسردها: ««سوق شرق» يحتل شاطئ البحر على الجهة اليسرى… في السبعينات لم يكن من مبانٍ على شاطئ البحر سوى ملاعب كرة القدم وحدها: ملعب الشملان، وملعب فريق الصباح، وملعب المهاري. ابتداءً من العصر، تعجّ الساحات باللاعبين والمشجعين واللعب الحماسي والفرحة، وقتها كان شاطئ البحر صديقًا مضيافًا لكل الناس».
يلحظ من الاقتباس السابق أن السارد هنا قام بكتابة خارطة للمكان وبعث التفاصيل القديمة التي كادت أن تردم من الذاكرة الشفهية والشعبية فأحياها، وحوَّل الشفاهي إلى الكتابي. ومن جانب آخر عمق فكرة الحنين إلى الماضي كزمن معيش ومكان يحتوي أحداث الماضي بكل ما فيها من حميمية أو عفوية وتلقائية.
كما ساهمت التقنية السردية في «سمر كلمات» المتمثلة في تعدد وتنوع الرواة، في الكشف عن الصراع الاجتماعي بين الأفراد وعرض وجهات النظر المتعددة. هذه الوفرة في الأصوات الروائية، وتناوب السارِدِين بالتعليق على حدثين رئيسين في الرواية شكلا نواة السرد، هما طلاق سمر من زوجها وليد، وطلاق عبير من زوجها جاسم الذي أرادت سمر لاحقًا الزواج منه. فكان الحدث الرئيس هو طرد سمر من البيت بسبب رغبتها في الزواج من طليق أختها، وقرارها ترك سليمان إلى أن حدث الزواج في نهاية الرواية كحلّ وخلاص للأزمة التي كان بالإمكان أن تتسبب في قطيعة بين أفراد العائلة.
وأحداث تابعة تفرعت من الأحداث الرئيسة وهي عودة الدكتورة عبير إلى بيت أبيها، وخروج سمر ليلًا من منزل أبيها، وغيرها من الأحداث القصيرة التي توزعت على المتن الحكائي للسرد وتناولها بالسرد الرواة المتعددون. حقيقة، ما كان مميزًا هنا في عنصر السرد هو أن الرواة قاموا بفعل حكائي ووظيفي في الرواية، وهو إغناء عنصر السرد بالتحليل والتعليق المتغاير في بعض الأحيان لما قاله أحد السارِدِين، وهذا أعطى السرد نوعًا من المصداقية، ومشابهة
للحياة الواقعية.
وتفكيك بنى المسلمات والمعطيات التقليدية التي اعتدنا كقراء أخذها وتلقيها من دون تفكيك، فاليوم كيف لنا أن نصدق كلامًا مقدمًا من جهة واحدة، كيف نقتنع بوجهة نظر عبير تجاه طليقها جاسم وهي مشحونة تجاهه بسبب صدمتها في إقدامه على الطلاق، وكيف نتقبل صورة سمر في مرآة عبير وهي الغاضبة والحانقة على سمر بسبب إقدامها على الارتباط بطليقها، فكل ما يخرج من طرفها من سرد هو كلام مشكوك فيه بناءً على الظرف النفسي التي تمر به عبير. وهذه الفكرة دعمتها كذلك دلال ابنة عبير إذ تحدثت عن تصورها لأبيها وما دار أيضًا في المنزل من مهاترات بين أبويها. فالحدث سرد عبر السارِدِينَ الثلاثة «عبير، جاسم، ابنتهما دلال»، تُنُووِلَ بطريقة مختلفة، من كل سارد على حِدَة.
الصراع الطائفي في رواية «في الهنا»
في خطوة لاحقة، وتحديدًا في رواية «في الهنا» انتقل طالب الرفاعي من نقد ثيمات القهر الاجتماعي الأسري، وتحديد حريات الأفراد، إلى قضية الصراع السني الشيعي المتمثلة في قضية الزواج والمصاهرة.
اتضح الصراع الطائفي من خلال بطلته كوثر الشيعية، التي تنتمي إلى الأقليات الطائفية في الكويت، وهي تحب مشاري المسؤول السني الكبير في الدولة، ليكون اختلافه الطائفي واحدًا من أسباب رفضه من عائلتها، إضافة إلى كونه متزوجًا ولديه أطفال. الزواج هو أحد الأمور الكاشفة للصراع الحقيقي الخفي بين الهويات السنية والشيعية. ثقافة القبول المجتمعي بين أفراد المجتمع، أهم بالنسبة لي من ثقافة قبول الزواج بين السني والشيعي.
الهوية والاعتراف الاجتماعي في «حابي»
كما هو معروف أن أدب «ما بعد الحداثة» هو أدب موضوعه هويات الأقليات العرقية والدينية، التي لم تأخذ حقها في التمثيل الكافي، وأيضًا هو أدب الهوية الفردية وتحقق الذات، الهوية التي تريد شق طريق الاعتراف بها والتعايش معها بقبول وسلام وتوافق في المجتمع. وعند النظر إلى المجال المعرفي الذي ترتبط به الرواية، يتضح أنه ضمن ما يسمى بأدب المهمشين والمنفيين في المجتمع.
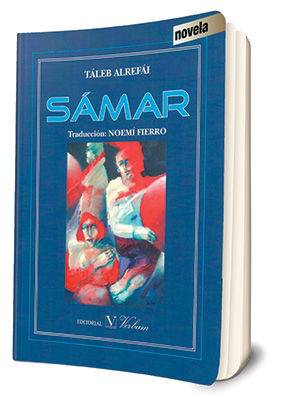 هناك في النقد الأدبي نظريات مثل «Lesbian Theory» و«Queer Theory» وهما النظريتان اللتان تقاربان موضوعًا مشابهًا ومختلفًا في الوقت عينه، لشخصية بطل رواية «حابي». تشتغل كل من النظريتين سابقتي الذكر على هوية الرجل والمرأة، التي شكلت بناءً على الفهم الاجتماعي، وتراجعان بعض المسلمات والانطباعات المغلوطة التي حددت هوية المرأة والرجل من منظور اجتماعي. يقارب النقد الأدبي النصوص الأدبية، بناءً على التوجهات العاطفية تجاه الجنس المماثل، والنفور من الجنس الآخر، مدافعين عن حق كل من الطرفين في الاختلاف.
هناك في النقد الأدبي نظريات مثل «Lesbian Theory» و«Queer Theory» وهما النظريتان اللتان تقاربان موضوعًا مشابهًا ومختلفًا في الوقت عينه، لشخصية بطل رواية «حابي». تشتغل كل من النظريتين سابقتي الذكر على هوية الرجل والمرأة، التي شكلت بناءً على الفهم الاجتماعي، وتراجعان بعض المسلمات والانطباعات المغلوطة التي حددت هوية المرأة والرجل من منظور اجتماعي. يقارب النقد الأدبي النصوص الأدبية، بناءً على التوجهات العاطفية تجاه الجنس المماثل، والنفور من الجنس الآخر، مدافعين عن حق كل من الطرفين في الاختلاف.
لا بد من القول: إن الرواية العربية التي تنحو هذا المنحى من الأدب الذي يؤسس للاعتراف بالآخر، تقوم بدور لافت ومهم جدًّا في تاريخ الرواية العربية، بل إنها تستبق وتواكب المنظمات الحقوقية، في تمثيل معاناة الشرائح الإنسانية المقموعة والمحرومة من حقوقها الإنسانية، التي ابتليت بالاختلاف في فضاء لا يعترف بالمختلفين من أبنائه. إن هذا الاتجاه الروائي يعطي صوتًا وحضورًا لشخصيات جرى تغييبها عن الفضاء الثقافي العام، مع سبق الإصرار والترصد من القوى الاجتماعية المتصلبة والمتمسكة بالعادات والتقاليد البالية، التي للأسف لم تحظَ بأي رياح تغيير وفكر إنساني يلهمها ضرورة الاختلاف وتقبل الآخر.
نحن اليوم لا نتحدث عن تقبل الآخر المختلف؛ لأن الاختلاف مزية في حد ذاته، ولكن لأن هناك ذاتًا محرومةً من حقها في أن تحقق ذاتها ووجودها، وأخرى تعاني التهميشَ وضياعَ حقوقها الإنسانية، وثالثة تعاني العزلَ الاجتماعيَّ؛ لأن الخطاب العام لم يعترف بوجودها بشكل مسبق. لذلك نجد أن الرواية اليوم تقوم بدورها الإنساني والتنويري تجاه هذه القضايا الإنسانية المستحقة، والفئات البشرية التي بدأت بكتابة وتحرير تاريخها الخاص، ولا أقول إعادة كتابته؛ لأنه لم يكتب بالأساس أو كتب من وجهة نظر السيد والمنتصر.
تنطلق هذه الرواية من معضلة حقيقية تواجه البطل/ة التي وُلدت بعيبٍ خلقيّ اتضحت مظاهره عليها في مرحلة مراهقتها، وبدأت بمشوار طويل من عمل الفحوصات اللازمة والتأكد من هويتها الجنسية. ولكن بطل رواية «حابي» (ريان) يعاني حالةً مختلفة ناتجة عن خلل بيولوجي؛ وهذا ما جعله طموحًا في الاعتراف بهويته الجديدة مثلما يوضح البطل: «أنا وأفكاري وذكرياتي. لم أستمتع بأيام عمري كباقي البنات، منذ طفولتي وأنا أحيا بشخصيتين؛ الأولى ريان الطفلة، والثانية هاجس لا ينفك يلاحقني يهمس بي في كل لحظة: أنت لست أنت. كنت طفلة ولا أدري ماذا يعني هذا الهاجس، لكنني كنت أشعر أن جزءًا مني يلبي نداءً خفيًّا في روحي؛ لذا انسقت وراءه، تقربت من عالم الأولاد ودون أن أعرف تفسيرًا لذلك».
واجهت ريان تيارًا عنيفًا من الرفض والإقصاء والتهميش من المقربين من أسرتها: والدها وشقيقاتها، ولم يتبقَّ معها أحد سوى والدتها وصديقتها المقربة جوي. تكمل ريان مسيرة كفاحها من أجل التحول إلى هويتها الحقيقية، وتصبح ولدًا بعد إجراء مجموعة من العمليات الجراحية. هنا، لا بد أن نذكر أن ريان ليست من النوع الأول ولا النوع الثاني في النظريات الغربية سابقة الذكر، بل هي حال مرضية تستوجب التحول لأن هذا ناتج عن عيب خلقي وُجِدَ مع الولادة.
وهذا ما يجعل ريان يحس بالمرارة لأنه رُفِضَ مع أنه أمر مستحق ومتفق عليه قضائيًّا وشرعيًّا؛ لذلك استطاع الحصول على حقه الرسمي في التحول إلى رجل، بينما بقي الرفض الشعبي في المجتمع الكويتي يلاحقه في كل مكان، حتى قرر الانقياد خلف قرار المنفى القسري الذي زج به مجبرًا على الرحيل إلى أميركا ليبتعد من المجتمع الذي لفظه بكل أعرافه وعاداته وتقاليده. هذا الرفض الذي رَكّزتْ الرواية عليه بشكل موسع، تنقصه حقيقة توسيع دائرة الرفض؛ إذ اكتفت الرواية بسرد تفاصيل رفض المقربين منه: والده، وشقيقاته، وعماته، وزوج أخته. لو سُلِّطَ الضوء على شرائح المجتمع الأخرى لكان قدم لنا رؤية مجتمع بجميع أطيافها لهذا الموضوع أكثر عمقًا ووضوحًا.
من الملحوظ على شخصية ريان أن هويتها لم تتكون فقط في السنوات الأخيرة من مرحلة مراهقتها، بل من الواضح أنه كان لديها كثير من الميول الذكورية منذ طفولتها وبداية مراهقتها، فكانت تميل إلى اللعب مع الأولاد، ولبس زي الأولاد أكثر من ميلها لبنات جنسها، وهو ما يعني أن لديها النزعة الطبيعية نحو أبناء الجنس المماثل له. وتغوص ريان في التفاصيل التي تحاول ترسيخ شرعية وجودها وهويتها الذكورية، من خلال الحديث عن تاريخ حمل أمها بها إذ كانت تتصور أنها ذكر، واستعدت لإنجاب ذكر.
فكأن كل هذه الملابسات توثّق إحساس ريان بأنها ولد، وكأن الأدلة العلمية الطبية لم تكن كافية بالنسبة له ولأمه فيذهبان معًا إلى دائرة المشاعر والأحاسيس والتفاصيل العاطفية التي تقوي آراء الطب بدلًا من العكس.
إذا كانت الرواية تحفر بموضوع جديد، وهو التحول من الأنوثة إلى الذكورة وتحديد هوية الجسد، فإنها أيضًا تنطلق من السياق الثقافي العام، الذي يعارض أي جديد أو تغيير نحو الأفضل، بحيث تكون سطوة العادات والتقاليد قوية ومهيمنة جدًّا، فجميع الشخصيات كانت تعاني خوفًا شديدًا من نظرة المجتمع الإقصائية لأي تحولات جديدة تخدش بعض مفاهيم الشرف، التي يؤمن بها أفراد المجتمع التقليدي.
الملحوظ هنا في هذه الرواية كما في روايات أخرى كثيرة تشتغل على مناقشة وطأة العادات والتقاليد، تقوم بفضح لا عقلانية المجتمع الذي يقاوم المنطق من أجل اجترار عادات وتقاليد بالية، ولأنه لا يملك القدرة والجرأة الكافية لتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه الشخصيات التي تتعرض لإقصاء وتهميش وظلم اجتماعي. لنأخذ على سبيل المثال شخصية والد ريان، يعري بطل الرواية سلوكياته وخياناته المتكررة لوالدته، أي قيامه بانحرافات أخلاقية يرفضها المجتمع ويدينها الدين، ويعضد هذا السلوك المشين بإهمال تام لدوره في الأسرة؛ إذ تقوم الأم بدورَيِ الأب والأم، ولكنه لا يلبث أن يتشدد في ممارسة دوره الصوري أمام المجتمع، ويعارض توجهات ريان في التحول إلى جنسه الطبيعي.
كما تتأكد فكرة لا عقلانية المجتمع من خلال موقف أخته نورة وزوجها «المطوع» اللذين يعالجان ابنهما من عيب خلقي، وفي الوقت نفسه يطلبان من ريان الرحيل والعيش خارج البلاد درءًا للفضيحة. يا له من مجتمع يقسو على أبنائه لكي يحافظ على صورته الشخصية، أمام ناس لا يمتّون له بِصِلة. مجتمع يكرر ويؤكد الصورةَ النمطيةَ التقليدية نفسها، على الرغم من لا عقلانيتها وتناقضاتها الحادة؛ لأنه لا يريد أن يتجرأ على التغيير ومواجهة المجتمع بقناعاته الجديدة والمعدلة. وهنا تصبح الأوطان كفضاء طارد للمختلفين والمهمشين.
المركزية اللغوية ونفي الآخر
يقول شوبفلين (Schopflin) في مقالته «بناء الهوية» إن: «الهويات راسية حول مجموعة من الأخلاقيات التي تنظم القيم والسلوك؛ لذا بناء الهوية بالضرورة يتضمن أفكارًا حول الصواب والخطأ، مرغوب به، وغير مرغوب به، نقي وشائب».
الإقصاء اللغوي في الخطاب الاجتماعي: من أكثر الأمور اللافتة في رواية «حابي» هي الاشتغالات اللغوية وارتباطها بهوية البطل ريان، فبدءًا من العنوان حتى نهاية الرواية، ونحن نجد اللغة تصاحب تطور وعي الشخصية حول ذاتها، وتبدأ تتعرف إلى نفسها، وتعلن وجودها من خلال أناها الخاص المتحول من الأنا الأنثوية إلى الأنا الذكورية. لقد كان/ت البطل/ة تعاني ازدواجًا واضحًا في الهوية يتلاءم واسمه (حابي). عندما تأكد ريان من جنسه الذكوري، رغب في أن يحظى باعتراف عام من المقربين منه بمخاطبته، على أنه رجل من خلال الضمير المخاطب أنتَ، بينما المجتمع الأبوي الإقصائي يعمل على حرمان ريان من هذه الفتحة فوق التاء؛ لأنهم أولًا: لا يعترفون بتحوله إلى رجل، وثانيًا: لأنهم يريدون تصحيح الفكرة الخاطئة عن نفسه بأنه ولد. أنتِ/ أنتَ لم تكن مجرد ضمائر خطاب عادية، بل استُخدِمتْ من منظور اجتماعي أبوي إقصائي لتشكيك ريان في هويته الحقيقية، وحرمانه من لذة الانتصار في آخر الرواية.
تجربة طالب الرفاعي بين «النجدي» و«حابي»
سعيد بنكراد – ناقد مغربي

أصدر طالب الرفاعي في السنوات الأخيرة روايتين شق بهما مسارًا جديدًا في التجربة السردية في الكويت، وقد تكونان هما آخر ما كتب: «النجدي» و«حابي». أعادت الرواية الأولى كتابة وقائع «تاريخ فعلي» ضمن تجربة تخييلية موازية استطاعت من خلالها الشخصية الرئيسة، النجدي، استعادة ما ضيعته وهي تدخل تاريخ الكويت من خلال حولياته. يتعلق الأمر في هذه الرواية بكتابة تاريخ جديد يحتفي بــ«الحياة الفعلية»، كما يمكن أن تُستعاد من لحظات أهملها المؤرخون، وهي تلك التي تُصنف عادة ضمن الأوهام والإحباطات والصغائر والكبائر، وضمن ما تحقق من الأحلام وما ظل مجرد استيهامات لن ترى النور أبدًا.
سيعود هذا البحار مرة أخرى إلى الحياة لكي يموت بـــ«المباشر» في تفاصيل البحر، ضمن إستراتيجية سردية تضع القول على لسان «الأنا» «المتوفاة»؛ لكي تكون شاهدًا «عيانيًّا» على حقيقة موتها. إنها استعادة لتفاصيل لم يكشف عنها التاريخ نفسه. وبذلك سيُصبح حضوره في هذا التاريخ أوسع وأكثر إقناعًا مما يمكن أن تقوله حياته كما عاشها فعلًا. وهذا ما جعل لغة الرواية وتقنياتها في السرد والوصف وفي طريقة إعادة بناء حقائق الواقع ضمن عوالم التخييل حدثًا فنيًّا مميزًا.
لقد تخلص الرفاعي من «واقعية» لازمت تجربته الطويلة، وتخلص أيضًا من «أناه»، كما كانت تحضر بالاسم والحالة المدنية والمهنية في نصوصه؛ لكي يستعيض عن ذلك كله بواقعية مستوحاة من التاريخ، ولكنها بُنيت ضمن مضافات التخييل، فحقائق هذا الفضاء أطول عمرًا وأشد تأثيرًا من حقائق الحياة الفعلية.
لم تكن الرمزية الفنية في هذا النص تتجاوز حدود رسم معالم «هوية جديدة» مصدرها محكيات تُشخص الشرط الإنساني، كما يتجسد في سعي الناس إلى ضمان لقمة العيش وفي تدبير كل أشكال القلق. ولكنها كانت، مع ذلك، تنخرط في «لحظة إبداعية» يستطيع من خلالها الفعل الأدبي الإسهام في بناء شخصية كويتية هي جماع ما يقوله التاريخ، وما تُفَصل المحكيات المختلفة القول فيه. وذاك ما يشكل في نهاية الأمر ما يُطلق عليه «الهوية السردية»، وهي مقولة مركزية في أدبيات الهرموسية المعاصرة، فمن خلالها تتم المصالحة بين ما يكون مصدره وقائع التاريخ بكل إكراهاته، وبين ما يمكن أن يُبنى في ملكوت التخييل بكل
مساحاته المضافة.
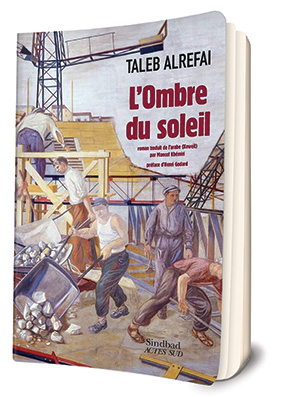 ومع ذلك لم يكن هذا النص رواية تاريخية، بالمفهوم التقليدي للنوع، بل كان «تخييلًا تاريخيًّا»، أي سردية جامحة مكتوبة خارج إكراهات الواقع، ولكنها لا يمكن أن تتحرك خارج ما يجيزه التاريخ ويقبل به المؤرخون. وذاك ما مكن الروائي من التخلص من «الأشباح» (وهي في النهاية مفاهيم تستوطن الذهن) لكي يحتفي بشخصيات «من لحم ودم» (أليكساندر دوما). وبذلك شكلت هذه الرواية نقلة نوعية في تجربته الشخصية، وشكلت أيضًا تجربة مميزة في تاريخ الرواية الكويتية، بل في الرواية العربية أيضًا.
ومع ذلك لم يكن هذا النص رواية تاريخية، بالمفهوم التقليدي للنوع، بل كان «تخييلًا تاريخيًّا»، أي سردية جامحة مكتوبة خارج إكراهات الواقع، ولكنها لا يمكن أن تتحرك خارج ما يجيزه التاريخ ويقبل به المؤرخون. وذاك ما مكن الروائي من التخلص من «الأشباح» (وهي في النهاية مفاهيم تستوطن الذهن) لكي يحتفي بشخصيات «من لحم ودم» (أليكساندر دوما). وبذلك شكلت هذه الرواية نقلة نوعية في تجربته الشخصية، وشكلت أيضًا تجربة مميزة في تاريخ الرواية الكويتية، بل في الرواية العربية أيضًا.
مسار سردي من طبيعة جديدة
وكانت روايته الثانية «حابي» تدشينًا لمسار سردي من طبيعة جديدة. يتعلق الأمر بتجربة سردية تواجه فيها «الذات» نفسها ضمن حوار داخلي يركز على علاقة المرأة (أو الرجل) بجسدها، في وظيفته وشكله، وفي نتوءاته وتضاريسه. ليست هناك قصة «مشوقة»، بالمفهوم الحدوثي للكلمة، بل هناك تفاصيل وجزئيات تروي لحظات تحول داخل الذات نفسها. وليس غريبًا أن يكون جزء من رمزيتها معطى من خلال «التعالي» في السماء (رحلة الطائرة)، إنها لحظات تتحقق خارج الانتماء إلى طبيعة الجسد، وإلى قوانين المجتمع في الوقت ذاته. وهي تعبير عن الرغبة في التركيز على فضاء «البين بين»، بين السماء والأرض، إنه فضاء يقع في برزخ «اللاتحدد الهوياتي»، بين التذكير والتأنيث: لم تعد ريان امرأة، ولكنها لم تصبح رجلًا بعد.
وقد كان اختيار ضمير المتكلم صوتًا للسرد اختيارًا لموقف من «الحقيقة» وطريقة في صياغتها أيضًا. فعلى الرغم من محدودية مردوده السردي، فإنه يُعد بوابة مثلى يمكن من خلالها التسلل إلى وجدان الكائن والكشف عن كل خباياه. إنه صوت الضياع والتمزق بين ما هو كائن وبين ما كان يجب أن يكون. لا يتعلق الأمر فقط بحالات العيش في ثوب المذكر أو في ثوب الأنثى، بل هو تمزق بين العيش في عالم يحيط به الإسمنت من كل الجهات (التحديث)، وبين الانتماء إلى ثقافة القديم في تدبير القلق الوجودي (التقليد).
تحكي الرواية قصة فتاة كويتية اسمها ريان، وستُلقَّب بعد ذلك بـــ«حابي»، إشارة إلى الازدواجية الجنسية في التراث الفرعوني المصري. لقد أحست هذه «الذات» بوجود خلل في جسدها بعد أن تأخرت عنها العادة الشهرية؛ لتكتشف في النهاية أنها وُلدت بتشوه خلقي يقتضي القيام بعملية «تحول»، هي وحدها يمكن أن تُعيدها إلى حالتها السوية. عليها أن تستعيد هويتها الجنسية الحقيقية، أي تصبح ذكرًا بكل التبعات التي يقتضيها هذا التحول على مستوى العلاقات الأسرية المباشرة وامتداداتها في الأحكام الاجتماعية والإدارية. ومن أجل ذلك ستخوض معركة ضد نفسها وضد عائلتها وضد المجتمع كله من أجل
تحقيق هذا التحول.
تلك هي الوقائع المباشرة للبناء التقريري للنص الروائي. إنها حكاية الآلاف من «المتحولين والمتحولات» في كل ربوع الدنيا. لذلك لا قيمة لكل الحقائق العلمية التي تعرضها الرواية، أو لا تشكل سوى خطاب وصفي عابر يمنح الفعل السردي نَفَسًا يُسقطه خارج مداره التخييلي الصرف. إنها بذلك مجرد غطاء من أجل إضفاء نوع من الواقعية على أحداث تُدرك في رمزيتها لا في إحالاتها التقريرية. فهذه الحقائق تصبح منتجة حقًّا عندما تندرج ضمن السلوك الرمزي العام. ذلك أن «التحول الجنسي» أمر وارد في كل مكان، فتلك حاجة يقتضيها بناء جسدي أخطأ هويته، وكان ضروريًّا «تصحيح» التشوهات الخلقية أو الخلل الهرموني الذي يؤثر في شكل الأعضاء ووظيفتها. إلا أن التعاطي معه من الموقع الاجتماعي يختلف باختلاف البيئات الثقافية الاجتماعية. وهذا مصدر الرمزية. فما هو مثير ليس التحول في ذاته، بل المحيط الثقافي الذي يتم داخله. وهذا ما يمنح الرواية أبعادًا رمزية تشمل كل التقابلات بين الرجل والمرأة.
انزياح عن تمثلات الذات
بعبارة أخرى، هناك انزياح حقيقي عن تمثلات الذات كما تحضر ضمن ممكنات الصراع الاجتماعي والسياسي، أي ما يعود لتضارب المصالح المرتبطة بالمواقع والوظائف (من جملة أسباب الاعتراض على التحول هو نصيب الذكر من الإرث)، إلى ما يمكن أن تقوله هذه الذات لنفسها استنادًا إلى ما يمليه البعد البيولوجي فيها. يتعلق الأمر بخروج عن المألوف الحياتي الذي يصادر الرغبات التي تتم في النفس، لكي يستحضرها في صوت «اللحم» وحده. والحال أن «اللحم» لا يحضر في العين خارج ممكنات الهوى وقدرتها على توجيه استعمالاته الجنسية والتحكم في صبيب سلوكه الاجتماعي.
وتلك هي حالة الجسد عندما يتخلص من مضافاته الثقافية ليعود إلى نفسه، كما هو ناطقًا في «خارطة الحنان» فيه، أي ما يمكن أن تقوله «خطوط الحساسية»، فهي بوابة «الرغبات» الحسية ومهدها. إنه يتحول إلى طاقة غريزية لا شيء بعدها سوى اللذة، إنه يشير إلى حالة العري المفترضة.
وبذلك يصبح الجسد العاري «هو الشيء ذاته، فهو موجود في ذاته، إنه الجوهر». ذلك، «أن العري حين يُجرد الجسد من المضاف اللباسي يمزج بين الإنسان والطبيعة، إنه يعيده إليها» (فرانسوا جوليان): تدخل ريان للبيت وتتعرى وتتملى جسدها بكل النقصان فيه، إنها لحظة اكتشاف الذات في لحمها. ولكنها تكتشف، في الوقت ذاته، محيطها العائلي والكم العاطفي الذي يقاس بالمصالح لا بقرابة الدم وحدها. وتلك هي الحالة الموصوفة في رواية «حابي» أو بعض منها: قد يكون الأمر متعلقًا حقًّا بقضية تحول واجهت الكثيرات والكثيرين في الكويت وغيرها، ولكن لا شيء يمنع، بل كل شيء يدفع إلى اعتبار «التحول» هنا في هذا السياق نفسه، حالة رمزية شاملة تهم السياسة والاجتماع والأخلاق الخاصة والعامة.
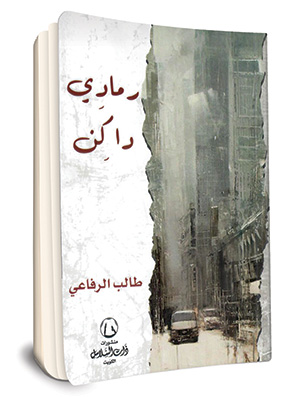 فالرواية لا تحكي تفاصيل عملية جراحية، وهي موجودة ولكنها عابرة، بل تنصب على الكشف عن «التحول» الذي يحاصر الناس من كل الجوانب داخل مجتمع يعيش حالة من «السكيزوفرينيا الحضارية»، حيث مظاهر التحديث في كل مكان وفي كل شيء، إنها في تفاصيل الحياة اليومية وفي المحيط واللباس، ولكن الناس ما زالوا يتحركون خارج مدارات «حداثة» هي الوجه الثقافي لكل حالات التحديث. إنهم ينظمون فضاءاتهم المخيالية وفق قيم مستوحاة من تقاليد تأبى الزوال.
فالرواية لا تحكي تفاصيل عملية جراحية، وهي موجودة ولكنها عابرة، بل تنصب على الكشف عن «التحول» الذي يحاصر الناس من كل الجوانب داخل مجتمع يعيش حالة من «السكيزوفرينيا الحضارية»، حيث مظاهر التحديث في كل مكان وفي كل شيء، إنها في تفاصيل الحياة اليومية وفي المحيط واللباس، ولكن الناس ما زالوا يتحركون خارج مدارات «حداثة» هي الوجه الثقافي لكل حالات التحديث. إنهم ينظمون فضاءاتهم المخيالية وفق قيم مستوحاة من تقاليد تأبى الزوال.
وهي صيغة أخرى للقول: إن الذات المتعالية تحضر في الجسد ببعديه الفردي (حالة العري التي تكشف عنها الرغبة في التحول)، والاجتماعي («الجسم» الاجتماعي: لم يعد التحول مسألة تخص الفرد، بل أصبح قضية اجتماعية أيضًا). وبذلك يتحقق حضور الذات المسرَّدة خارج كل الوسائط وخارج كل الأحكام الاجتماعية أو التقديرات الثقافية، عدا الكم الانفعالي الحاضر في النص بوصفه طاقة استهوائية تدشن لِحِس أصلي موجود في ذاته: وحدها الأم قبلت الانخراط في التحول لأنها تستعيد جزءًا منها. إنها الرحم مصدر الحياة والرحمة والفردوس الذي نسيه العقل، ولكن الوجدان تعلق به إلى حد الهوس. إن الذات تكتشف نفسها في لحمها، فيما يشكل الأساس الذي يقوم عليه وجودها في العالم. وهو وجود لاحق، لأنه يتجسد في انفصال عن عالم مادي.
لا يتعلق الأمر هنا بتحول يمس الأعضاء وحدها، بل دالّ على خروج من عالم ثقافي له سماته وإكراهاته، إلى آخر يتمتع هو الآخر بخصوصيات تجعله مميزًا في طريقة حضوره في الفضاء العمومي. ولم يكن وجود الفتاة «جوى»، صديقة ريان، اعتباطيًّا في تفاصيل الرواية: إنه التجسيد الأمثل لهذا التفاوت بين التحديث والحداثة. إنها تفصيل من تفاصيل التقابل بين الحداثة والتحديث (أبوها كويتي وأمها أميركية)؛ لذلك رفضها الناس في الشارع ورفضها أترابها في القسم الدراسي.
وتلك هي البوابة المركزية التي تتسلل من خلالها كل الرمزيات الممكنة. فــ«التحول» ليس عملية جراحية، إنها في المفهوم العام ثورة تصيب الجسد الاجتماعي وتصيب الأحكام والعوالم الثقافية. فعلى عكس ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن، فإن الذكورة والأنوثة ليستا خاصيتين بيولوجيتين فقط، فهما فعلًا أصل التلاقح والتناسل والتكاثر، أي جزء من وظيفة في الجسد سابقة على التمدن والتحضر، إلا أنهما يحددان أيضًا موقعًا داخل نظام رمزي يُذكر ويُؤنث استنادًا إلى سند لغوي يتميز بتقطيع خاص للمدرك الخارجي لا يراعي في الكثير من الحالات حقيقة الجنس فيما يتم تقطيعه.
وهذا مصدر اختلاف اللغات في الكشف عن الجنس والعدد وتسمية أشياء الكون وظواهره. وهو أيضًا الحاضن لعوالم ثقافية تُبنى في التذكير والتأنيث وفق ما يمكن أن تحيل عليه الحمولة الرمزية فيهما. إنها تُصنف كائنات العالم وفق إكراهات ثقافية تختلف باختلاف معتقدات الناس وتصوراتهم للحياة والموت. وذاك هو الفاصل المركزي بين الحس في الطبيعة وبين التمثيل الرمزي في الثقافة. لذلك لا تقابل الرواية بين ذكر وأنثى، بل تقابل بين عوالم الذكورة والأنوثة في الثقافة لا في الأجساد.
لذلك تذهب الرمزية بالأمور إلى حدودها القصوى: نحن في حاجة إلى ثورة داخلية لا تغيرنا فحسب، بل تنقلنا من إبدال حضاري إلى آخر يغير من نظرتنا لكل شيء في الحياة، كما هو التحول من ذكر إلى أنثى، أي من عالم ثقافي إلى آخر.
لا أريد أن أذهب أبعد من ذلك، وأرى في رمزية الرواية إحالة على دول الخليج ومواقعهم داخل تجمعهم السياسي والاقتصادي، كما أوَّلَها بعضٌ. فهذا النوع من الرمزية لا يغريني، وهو بالإضافة إلى ذلك غير منتج على مستوى غنى العوالم التي تبنيها الرواية في التخييل.
قصص تعكس الهموم الكبيرة للإنسان العربي
كاتيا الطويل – كاتبة لبنانيّة وطالبة دكتوراه في جامعة السوربون

يرى الفيلسوف والناقد لوسيان غولدمان (1913- 1970م) أنّ العمل الأدبيّ الجيّد هو العمل الذي يحمل رؤية للعالم، فيجسّد صاحب النصّ في عمله نظرته للعالم والإنسان والمجتمع. وغولدمان المتخصّص في الحقوق والسياسة الاقتصاديّة والفلسفة والأدب ونظريّات الإستطيقا، يبني نظريّته في سوسيولوجيا الأدب على منهج يبحث في العلاقة بين النصّ الأدبيّ ومحيطه الاجتماعيّ. وبحسب هذا المنهج لا يمكن عزل النصّ عن محيطه وعن سياقه التاريخيّ والفكريّ والثقافيّ، فيرى غولدمان، ورأيه في هذا الشأن لا يخلو من صواب، أنّ النصّ يُفهم عبر النظر إلى الإطار العامّ المحيط به، فهو يرتبط بمجموع التصرّفات والقيم الاجتماعيّة التي تسود بيئته، ومن ثم يتحوّل إلى انعكاس لمجتمع كاتبه وإلى رغبته في التأثير فيه.
ويمكن لقارئ نصوص الكاتب الكويتيّ طالب الرفاعي، وعلى وجه الخصوص قصصه القصيرة، أن يرى تطبيقًا ملموسًا لهذه النظريّة ولهذا المنهج السوسيولوجيّ في قراءة الأدب. فالرفاعي نفسه يحدّد في بداية مجموعته القصصيّة «رماديّ داكن» أنّ الإنسان والمجتمع والإبداع هي همومه، وهو ما يجعل قصصه القصيرة منتمية إلى أدب الوعي الاجتماعيّ والسياسيّ والعائليّ إن أمكن تسمية هذا النوع من الكتابة بأدب الوعي.
وتوسيعًا لفكرة وعي طالب الرفاعي بمسائل الإنسان والواقع والإبداع، ارتأينا العمل على ثلاث مجموعات قصصيّة نشرها الرفاعي ابتداءً من بداية القرن الحالي، وبثّ فيها أزمات الإنسان العربيّ وزلاته، وهذه المجموعات الثلاث هي: «سرقات صغير» (دار الشروق، 2010م)؛ و«الكرسي» (دار الشروق، 2012م)؛ و«رمادي داكن» (منشورات ذات السلاسل، 2018م). خمسة وخمسون قصّة قصيرة تشكّل مجموع قصص هذه المؤلّفات وستكوّن أساس التحليل الآتي.
ويخطئ من يجد في قصص الرفاعي انعكاسًا للمجتمع الكويتيّ وحده. على العكس، ففي هذه القصص، يمكن استشفاف عودة إلى المجتمع السوريّ، وأخرى إلى المجتمع المصريّ وغيرهما، إضافة إلى عودة إلى المجتمعات الخليجيّة عمومًا بأنماط حياة أهلها، لتتحوّل هذه القصص إلى مرآة هموم الإنسان الكويتيّ والخليجيّ والعربيّ، مرآة أرادها الرفاعي فاضحة للعيوب والشوائب.
يستعيد الرفاعي في قصصه الدور الذي مُنح في زمن مضى إلى الكاتب والمثقّف في العالم العربيّ، دور المنارة والمرشد والمانح للحكمة. إنّما بعيدًا من أسلوب الوعظ الواضح والنصح الذي ينهر ويأمر، يتمكّن الرفاعي من الإشارة بالإصبع إلى ما يدور في مجتمعاتنا بمهارة سرديّة واقعيّة، ويوظّف الأشياء المحسوسة المحيطة بالإنسان لخدمة الدلالات المعنويّة.
في تقنية القصة القصيرة
يرى الأميركيّ إدغار آلان بو (1809- 1849م)، رائد القصّة القصيرة في أميركا، أنّ القصّة القصيرة يجب أن تكون مسبوكة في روح واحدة وفضاء واحد، كما أنّه يجب أن تُوظَّف كلّ جملة فيها لخدمة النصّ ووحدته. ووفق هذا التعريف الأوّليّ والبسيط ظاهريًّا، يمكن الدخول تقنيًّا إلى نصوص الرفاعي في مجموعاته الثلاث المذكورة. فيلحظ القارئ أنّ الأحداث تسير دومًا في اتّجاه واحد ونحو حبكة واحدة بهدف تأدية معنى معيّن. وعلى الرغم من أنّ الموضوع المطروق قد يكون في أحيان كثيرة موضوعًا عميقًا متعدّد الأبعاد، إلا أنّ طريقة معالجته وكتابته تأتي مسبوكة وفق خطّ سرديّ واحد.
ولم يعقّد الرفاعي كتابته النثريّة ولم يحمّل أسلوبه المعقّد من التعابير، بل شحن قصصه بالأبعاد والدلالات. وبينما اختلفت الموضوعات بين أزمات العمل وأزمات العائلة والعلاقات بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين الأهل وأولادهم، استطاع الرفاعي أن يطوّع اللغة، وأن يحرص على استعمال الواقعيّ والسهل منها. تحوّل الحوار نفسه إلى تقنيّة تخدم السرد وتساهم في تحويل القصص القصيرة إلى مشاهد من الواقع تبتعد من ابتذال البلاغة أو تصنّع الصور البديعيّة.
وحيث إنّ القصّة القصيرة تقوم على خمسة عناصر أساسيّة، هي: الشخصيّة والإطار الزمانيّ- المكانيّ والحبكة والصراع والموضوع، فقد تمكّن الرفاعي من إثبات هذه العناصر الخمسة في خدمة نصوصه على اختلاف موضوعاته. فلنأخذ مثالًا على ذلك القصّة الحادية عشرة من مجموعة «سرقات صغيرة» وعنوانها «خاتم». تتجلّى في هذه القصّة العناصر الخمسة للقصّة القصيرة على نحو واضح. فيبدأ السرد بشخصيّة الراوي ووالدته، ووجود إطار زمانيّ ومكانيّ ملائم للأحداث الدائرة، ثمّ ينتقل مسار الأحداث إلى حبكة أو عقدة، ألا وهي اختفاء خاتم الأم وسخطها لاختفائه المفاجئ والغامض. ثمّ تتوالى الأحداث وتتأزّم المسألة مع اتّهام الخادمة بسرقة الخاتم، وصولًا إلى الحلّ النهائيّ باعتراف الأخ بأنّه سرق الخاتم ليخلق ما يلهي الأمّ عن أوجاعها وتبرّمها الدائم من أمراضها وشيخوختها.
وفيما تبدو عناصر القصّة القصيرة واضحة في هذه القصّة المحدّدة، إلّا أنّها ليست كذلك في مختلف المواضع. فغالبًا ما يمنح الرفاعي كلّ قصّة قصيرة نكهتها ويغيّر في البنية الكلاسيكيّة لنمط السرد ليخلق عنصر التشويق والإثارة. ففي القصّة السادسة عشرة من مجموعة «رماديّ داكن» وعنوانها «الثالث»، ينقل الرفاعي وجهة نظر زوجةٍ في حياتها الزوجيّة، ثمّ ينتقل في القصّة نفسها لينقل وجهة نظر زوجٍ إنّما ليس زوجَ المرأة الأولى. فلا يستطيع القارئ الامتناع عن التعاطف مع كليهما هو الذي تمكّن من رؤية الواقع من زاويتين اثنتين.
وكذلك يتنبّه القارئ إلى وجود قصص ذات نهايات مفتوحة، فبعدما تحتدم الأمور ويصل السرد إلى أوج التشويق في قصّة «لكن لا يتحرّك» في مجموعة «سرقات قصيرة» مثلًا، يُسقط الرفاعي خاتمته على قارئه كالماء البارد من دون توضيح أو توسيع، فلا يعرف القارئ تمامًا كيف انتهت المسألة. يمكن أن يتكهّن، إنّما لا يمكن أن يتأكّد.
الأشياء تفضح تهافت الإنسان
يقول الكاتب الأميركيّ ستيفن كينغ في إحدى المقابلات التي أُجرِيتْ معه: «إنّ القصّة القصيرة ومن دون مبالغة، هي لأمر مختلف، فهي تشبه قُبلة من غريب في العتمة».
وبينما لا يمكن تشبيه مشكلات المجتمعات العربيّة بالقُبَلِ، يجب التوقّف عند هذا التشبيه وعند قيمته. إنّ القصّة القصيرة الجيّدة تترك أثرًا خلفها، تترك إحساسًا أو نقمة أو انتفاضة أو تعاطفًا، تترك شيئًا، وهذا تمامًا ما يحصل عند الانتهاء من قصص الرفاعي.
تتحوّل الأشياء المحيطة بالشخصيّات في هذه القصص، إلى أدوات تجسّد مشاعرها ونزاعاتها وصراعاتها الداخليّة. ويمرّ منهج الرفاعي اللغويّ الرمزيّ في نقل الواقع العربيّ بسلاسة وهدوء؛ لأنّه طريقة رمزيّة إيحائيّة مدوّرة الزوايا. يشيّئ الرفاعي المعانيَ ويحوّل قضايا المجتمع العربيّ من موضوعات معنويّة إلى أشياء مجرّدة ترمز إلى حقائق لا يريد قولها مباشرة، فيراوغ في قصصه، ويعتمد الأشياء، ويختبئ خلفها بحنكة سرديّة ممتعة؛ لأنّه لو قال الأمور كما هي مباشرة لأثارت حفيظة كثيرين.
ولا يمكن عَدّ طالب الرفاعي في قصصه القصيرة أنه شخّص الأشياء، بل هو شيّأ القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة لينقل رؤيته لمحيطه. فهنا النيّة لم تكن جماليّة بلاغيّة بقدر ما كان الهدف منها نقل مثالب المجتمع وأهله بمهارة. لقد نقل الكاتب الكويتيّ هموم المجتمعات العربيّة: تلك الخليجيّة، وتلك التي هي خارج الخليج، نقل التسلّط والفساد والخبث والنفاق، نقل الرغبة في الترقية من دون اجتهاد، والاستغلال والتكبّر والتعنّت والطعن في الآخر. نقل هموم الإنسان الصادق وعلاقته بزوجته ووالديه وأبنائه. نقل هموم المرأة العاملة، هموم المرأة التي تضحّي من أجل زوجها، المرأة التي تعمل خادمة لتجني ما يقوم به أودها.
ولا يمكن أوّلًا ألّا يلتفت القارئ إلى خيارات العناوين التي تجسّد رغبة الرفاعي في إلباس الأشياء معانيَ. فقد مال الكاتب بوضوح إلى تشييء المشكلات الاجتماعيّة ليتناولها بحرّيّة أكثر من خلف قناع الأشياء. ويظهر هذا الأمر قبل أن يغوص القارئ في عمق النصوص أي عبر العناوين. فمن أصل خمسة وخمسين عنوانًا، يقع القارئ على اثنين وأربعين عنوانًا تدلّ على أشياء، بينما خمسة عناوين فقط تدلّ على حيوان، وثلاثة على إنسان، وخمسة تحمل اسم علم.
لقد حوّل الكاتب الأشياء في قصصه إلى أدوات تعبّر عن المعاني المُرادة، بذلك لم يصدم قارئه لكنّه لم يتركه مستلقيًا على أمجاده. اختار طالب الرفاعي أن يشير بالإصبع إلى تهافت الإنسان وإلى المشكلات الكثيرة التي يعانيها المجتمع العربيّ، لكنّه لم يفضح بقسوة وشراسة وعنف، بل ساوى بين الفرد وأشيائه لينقل زلّات المجتمع.
شيّأ الرفاعي المشكلات والطِّباع والقضايا، فألبس الحذاء هموم صاحبته المجتهدة، وجسّدت البالونة المرتفعة نفاق صديقٍ متسلّقٍ انتهازيٍّ، وأصبح الجناح الملكيّ مرآة طِباع المدّعين السطحيّين من المجتمع. جعل الرفاعي الصورة رمز الفنّ المتحرّر، واللوحة دليلًا على خيبة الزوج من طباع زوجته، واللحية رمز الذكورة المستبدّة، والحقيبة رمز المرأة التي تلتفت إلى المظاهر وحدها، والسيجارة رمز الغريزة والمغامرة، وورقة المال رمز حياة الرأسماليّة السريعة التي نعيشها في عصرنا اليوم.
لم يشخّص الرفاعي الأشياء بل حمّلها هموم البشر، شيّأ الأزمات والمشكلات بحنكة وبداهة مميّزتين. حتّى فعل الانتفاخ تحوّل لديه إلى فكرة التهافت البشريّ خلف المناصب والترقيات والوساطات والمال والنفوذ. إنّ الانتفاخ الذي يصيب شخصيّات القصّة التاسعة من مجموعة «سرقات صغيرة» مثلًا، والانتفاخ الموجود في القصّة الثالثة من المجموعة نفسها يتحوّل إلى مرادف لغرور الناس وتعنّتهم وجريانهم خلف المظاهر والمناصب. ففي هذه القصّة الثالثة مثلًا، وهي بعنوان «فووووووق» يقدّم الرفاعي بمهارة لغويّة رائعة، مطابقة بين البالونة التي ترتفع في الهواء وصديق الراوي الذي يروح يرتفع على سلّم الدرجات الاجتماعيّة من دون أن يكون مستحقًّا لذلك، فيقول: «ترتفع البالونة إلى السماء،… بعد فترة صرت أشاهد صور العُبُد في الجرائد والمجلات». تتحوّل البالونة التي ترتفع إلى أعلى إلى الصديق «العبد» الذي ارتقى فجأة على سلّم المراتب والمراكز.
حتّى التقنية كانت لها حصّتها في نصوص المجموعات، ففي القصّة العاشرة من مجموعة «رمادي داكن» تتحوّل الإيميلات إلى جلّ حياة الراوي الذي ينسى واجباته الاجتماعيّة وأصدقاءه وابنته نفسها التي لم يعد يراها ولا يتّصل بها. وكأنّ هذه الإيميلات هي الحياة العصريّة السريعة الزاخرة بمتطلّباتها وشروطها التي تُنسي الإنسان عائلته وما كان ضمن أولويّته سابقًا. وتتجلّى مسألة التقنية أيضًا في قصّة «كرسي (9)» التي تتحدّث فيها طفلة صغيرة عن علاقتها بأمّها القاسية، فتقول في نفسها في أحد المواضع بينما تكون هي معاقبة وأمّها مأخوذة بهاتفها: «تودّين لو تكسرين تليفونها».
الأشياء تفضح تسلّط الحاكم
لا يكتفي الرفاعي في مجموعاته القصصيّة الثلاث بفضح المشكلات الاجتماعيّة، بل ينتقل أيضًا إلى شؤون سياسيّة تحمل قضايا الوطن العربيّ بأسره. فمثلًا نراه اختار أن يعتمد اسم «الكرسي» لمجموعة قصصيّة بأسرها تحتوي على أربع عشرة قصّة تحمل كلّ منها اسم «كرسيّ» مع الرقم العائد للقصّة، وهو أمر مغرق في الرمزيّة. فالكرسيّ هو في الواقع صاحبه، هو تكبّر الحاكم الجالس عليه وفساده، هو زيفه الاجتماعيّ وتعاليه وغروره. ولا يتوانى الرفاعي في وصف الكرسيّ بأنّه غبيّ، قاصدًا صاحبه طبعًا، وذلك في القصّة رقم خمسة: «الكرسيّ المنتصب بضخامته الغبيّة». ليتحوّل الكرسيّ الضخم إلى رمز للجالس عليه، وليتحوّل الغباء من صفة تطول الذكاء عمومًا إلى واقع غياب الوجود الإنساني والعقل الإنسانيّ والعاطفة الإنسانيّة على الكرسيّ.
وكأنّ هذه الصفة لم تكفِ، فطوّر الرفاعي صورة كرسيّ السلطة والاستبداد بأن أظهر كيف أنّ قدمي الجالس عليها هما بمستوى رؤوس الناس. يتجسّد استبداد الحاكم المتسلّط بجلوسه على الكرسيّ طبعًا، إنّما أيضًا بقدميه «المعلّقتين في الهواء» («كرسي (5)»، ص: 41). إنّ رؤوس الناس هي بمستوى قدمي الحاكم الجالس على الكرسي الضخم العالي، فهل من يوم يأتي ويصبح كرسي الحاكم بمستوى شعبه وتصبح قدماه على الأرض؟
والجميع يرغب في الوصول إلى الكرسي، بأيّ طريقة ممكنة، فنجد الشخصيّات في قصّة «كرسي (13)» راكضة في الطرقات وفي الأزقّة خلف الكراسي. كلّ فرد يركض خلف الكرسي وخلف المنصب الذي يريده متناسيًا المحيطين به، متناسيًا أيّ أمر آخر دون الكرسيّ.
لكنّ الكرسي العالي والضخم يملك مساوئه أيضًا، فالكرسي يبتلع الجالس عليه ويحوّله إلى صرصار كافكا من الرواية القصيرة «التحوّل» (1915م). إنّ هاجس السلطة يتحوّل إلى مرض، يحوّل المرء إلى حشرة، فتروح إنسانيّة الحاكم تختفي ويروح الحاكم نفسه يتضاءل ويتلاشى لتحلّ محلّه الهالة والسلطة… والكرسيّ.
إضافة إلى ذلك، يتجلّى للقارئ أنّ الإنسان القويّ الجالس على الكرسي يخسر كلّ شيء ما إن يتقاعد أو ما إن يجلس آخر مكانه. وكأنّ النزول عن الكرسي يعني الموت والاضمحلال. ففي القصّة العاشرة من مجموعة «الكرسي» يجد الوزير نفسه وحيدًا عندما يحلّ آخر مكانه، فيقول في نفسه: «لماذا أنت متضايق لا تستطيع سحب أنفاسك؟ أحد لن يأتي الليلة! الروّاد، أو سمّهم ما شئت، كانوا يأتون إليك تودّدًا للكرسيّ، وحين غادر محطّتك، تشبّثوا بأرجله، ومعه ابتعدوا إلى محطّة أخرى». تحلّ الأشياء مكان الناس ويصبح نفوذ الحاكم ووجوده مرتبطًا بالكرسي الجالس عليه، ليتحوّل المجتمع إلى مجرّد أفراد يتهافتون خلف السلطة والنفوذ والأشياء.
يبقى الفنّ…
في خمس وخمسين قصّة، حاول طالب الرفاعي سبر أغوار المجتمعات العربيّة المعاصرة لينقل أعباءها وأعباء أهلها، فالإنسان العربيّ اليوم رازح تحت فساد السلطات واستبداد الحكّام ونفاق المحيطين به ومتطلّبات حياته العائليّة. الإنسان العربيّ اليوم، رجلًا أو امرأة، يدخل على ألفيّة جديدة محاولًا تحديد موقفه من أمور كثيرة: من الحاكم ومن التقنية ومن المجتمع.
وعلى الرغم من قسوة الواقع الذي ينقله الرفاعي في قصصه إلاّ أنّه يترك متنفّسًا للقارئ، يترك له الفنّ. يتحوّل الفنّ إلى المخرج، يصبح مرادفًا للتحدّي والتحرّر والتفوّق. يرى الرفاعي عبر قصصه القصيرة أنّ الحلّ هو الثورة، والثورة تكون عبر الفنّ. فالسينما ثورة تخيف الدكتاتور، والصورة ثورة تهزّ الكرسي، والكلمة ثورة لن يخفت وهجها. إنّ الصورة والكلمة والألوان هي الطلقة التي ستحرّر الشعوب وتُنزل الفاسد والمستبدّ عن كرسيه. إنّ الفنّ هو الشعلة التي ستحرّر وتُسقط من يجب أن يسقط، فيرد في قصّة «كرسيّ (5)» بقوّة وعمق وتوهّج: «صوّر، لا تدع شيئًا يفلت منك.. الصورة طلقة […] صوّر.. الكرسي يهتزّ».
فهل يهتزّ الكرسي يومًا؟
عالم سردي يتجاوز حدود الجغرافيا البشرية الضيقة
أمير تاج السر – كاتب سوداني

على الرغم من أن الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، نشر أول أعماله القصصية في سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه أقرب إلى جيل الثمانينيات في الكتابة الإبداعية، حيث ازدهرت أعماله القصصية في تلك الحقبة، حتى انطلق إلى كتابة الرواية في بداية الألفية الجديدة، مع الاحتفاظ برونقه ككاتب قصة متفرد، عبرت قصصه عن أفكارها بصورة جيدة، بالرغم من التكثيف والاختصار المعروفيْنِ في كتابة القصة.
والمتابع لأعمال طالب الرفاعي، سواء في قصصه القصيرة، أو رواياته، ينتبه إلى أنه ألمَّ بكل أدوات الكتابة الحديثة باكرًا، كما أنه عثر على صيغته المعتمدة للكتابة، فخرج إبداعه جديدًا ومختلفًا، ولا تستطيع إلا أن تعجب به حتى لو لم تكن تتفق معه. ولطالما نادينا بضرورة القراءة المتأنية، والالتفات لما قد يورده الكاتب من ابتكارات سواء على مستوى الأفكار أو اللغة المستخدمة، وذلك من أجل قراءة نزيهة وذات فائدة.
ألاحظ أيضًا أن طالب الرفاعي على الرغم من تنوع الأفكار التي يستخدمها في الكتابة، مثل الغوص في التاريخ، والغوص في المجتمع المعاصر، أراه التزم إلى حد ما بكتابة واقع مواز للواقع، ويوهمك أنه الواقع. هذا النمط من الكتابة يبدو صعبًا لكنه ممكن إن كُتب بأيد خبيرة، وقد تفاجأ حين تجد أسماء واقعية، وأحداثًا تبدو واقعية، أي تعثر على اسم زوجة الكاتب أو أحد أصدقائه، وتجدهم شخوصًا في الأعمال وتتوهم أن ما حدث في النص، حدث في الواقع أيضًا. وما زلت أذكر بداية رواية «الثوب»، حين نجد استدعاء شخص مسؤول الراويَ، ونتابع بتشوق شديد مسار الراوي للقاء ذلك المسؤول تمامًا كما نتابع شريطًا سينمائيًّا مشوقًا.
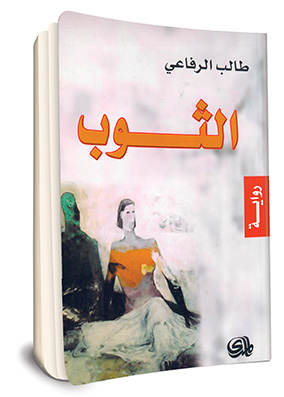 هذا الذي ذكرته يقودني للحديث عن تقنية السينما التي استفاد منها طالب أيضًا، أي تقنية تقطيع المشاهد وجعل بعضها يكمل بعضًا، واستخدام كاميرا سردية إن جاز القول، تتجول بعينيك في المكان النصيّ، مُتابِعةً حركة الشخوص فيه. وبالطبع لن ننسى استخدام المونولوج الداخلي، وحديث الشخوص مع ذواتها، في محولات للكشف عما يحدث.
هذا الذي ذكرته يقودني للحديث عن تقنية السينما التي استفاد منها طالب أيضًا، أي تقنية تقطيع المشاهد وجعل بعضها يكمل بعضًا، واستخدام كاميرا سردية إن جاز القول، تتجول بعينيك في المكان النصيّ، مُتابِعةً حركة الشخوص فيه. وبالطبع لن ننسى استخدام المونولوج الداخلي، وحديث الشخوص مع ذواتها، في محولات للكشف عما يحدث.
«الثوب» وغيرها من روايات طالب، في معظمها وقصصه القصيرة، عَدَّها مرايا مجتمعية، نقلت لنا وبصدق إبداعي، خفايا مجتمع نعرفه، ولا نعرفه حقيقة، ولطالما نوهت أن الحكاء الحقيقي، هو القادر على صناعة الدهشة عند المتلقي، بتعريفه بتفاصيل يظن أنه يعرفها، وهو في الحقيقة لا يعرفها، ربما تكون التفاصيل موجودة في ذهن المتلقي، فقط هناك من يكشف عنها الغطاء، أيضًا تأتي البراعة لدى الحكاء في مجتمع ما، أن يصوغ مجتمعه إبداعيًّا من دون أن يسيء إلى أحد، أو يفضح أحدًا. بالطبع ما كتبه طالب في هذا الصدد، ليس سيرًا ذاتية رغم الوهم الذي قد يثيب للمتلقي كما ذكرت، ولكن سردًا بنكهة لها معانٍ عدة، وفي الكتابة تظل المعاني العدة التي يمكن استنباطها من نص ما، هي جمال هذا النص، وأظن أن السيرة الذاتية أو لنقل شذرات منها يمكن أن تتسرب إلى كتاباتنا كلنا، باعتبار أن الكاتب حين يكتب، لا بد أن يكتب أشياء يخبرها جيدًا، وكلنا خبراء في بيوتنا وشوارعنا، والمدن التي وُلدنا أو نشأنا فيها.
أود أن أذكر بكثير من الافتتان رواية «النجدي» لطالب الرفاعي، وهذه رواية تاريخية، تتحدث عن أحد صناع المجد القديم في منطقة الخليج، وهنا تبدو الكتابة صعبة بالفعل؛ لأن استعادة شخصية تاريخية، بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات، في نص حداثي، يُعَدّ مغامرة، ولذلك أنا أميل شخصيًّا لتخيل التاريخ، بوصفه أكثر أمنًا وبعدًا من المشكلات، ولكن أيضًا هناك من يكتب الشخصيات التاريخية الإنسانية بكثير من الرشاقة، والإضافات التي لن تكون عورات بقدر ما هي نشاطات إنسانية مشروعة. وأعتقد أن «النجدي» كُتِبتْ باحترافية، ولم تغفل أي تفاصيل يمكن أن تزرع القارئ في قلب النص، أيضًا حفلت بما ذكرته عن تقنيات الكتابة التي يستخدمها طالب عادةً؛ من سرد وحوار، واستفادة من الموروث الشفاهي، وتلك القصص الصغيرة التي تكمل اللوحة في النهاية، وتبدو مسألة رسم لوحة بالكلمات ملائمة جدًّا، إذا عرفنا عشق طالب الرفاعي للوحات الفنية، والسعي لاقتناء لوحات فريدة ومميزة.
في العام الماضي نشر طالب روايته الأخيرة «حابي»، وهنا دخل في مسألة المسكوت عنه، مسألة التحول الجنسي، الذي يبدو موضوعًا مؤثرًا في مجتمعاتنا لكن قليلًا ما تطرق إليه الأدب العربي، وأذكر أن الصديقة الكاتبة الراحلة ثريا علام، نشرت مرة رواية مهمة في هذا الصدد، لكن لم يتناولها النقاد؛ لكون الكاتبة رحلت باكرًا، وأيضًا للفتور الذي أصاب الحركة النقدية في السنوات الأخيرة. ورواية طالب مثل رواية ثريا تتحدث عن تلك الشخصيات التي هي شخصيات إنسانية، يَعُدّها المجتمع شخصيات غير سوية، ولا أعدّ الكتابة هنا تحيزًا لتلك الشخصيات بقدر ما هي كشف عن إنسانيتها، وأحقيتها في الحياة كغيرها.
عمومًا طالب الرفاعي قدم ولا يزال يقدم تجارب ثرية في الكتابة الإبداعية، وأيضًا في تبني الكتابة الإبداعية، واستخدم إمكانياته ككاتب أولًا، وكمعلم للكتابة الإبداعية ثانيًا، في إثراء الثقافة العربية.
عين زرقاء اليمامة
سلوى بكر – كاتبة مصرية

تعرّفت إلى الأديب الكويتي طالب الرفاعي من قرب ربيعَ عام 2013م خلال أحد المنتديات الأدبية في بلدة أنشون الكورية الجنوبية، ومن خلال ذلك ترسّخ لديّ انطباع بأنه شخصية ودودة مفعمة بالإنسانية، مع عمق ثقافي واتساع في الرؤية. ولم أكن حتى ذلك الوقت قد قرأت للرفاعي إلا بعض القصص القصيرة، فقد كانت كتابات إسماعيل فهد إسماعيل وليلى العثمان، هي الكتابات الأكثر شيوعًا من الأدب الكويتي لدى المثقفين المصريين، ولكن عند عودتي من كوريا إلى موطني بالقاهرة مرة أخرى أخذت أتعرف شيئًا فشيئًا إلى كتابات طالب الرفاعي، وكم شعرت بأنني محقة في انطباعاتي عنه، فقد اكتشفت أن أعماله بالفعل مهمومة إنسانيًّا بالمعنى العميق للكلمة، وتسعى للبحث في معاناة الناس التي لا تلحظ ولا ترى بسبب التكرار والاعتياد.
وعالمه السردي يتجاوز حدود الجغرافيا البشرية الضيقة والمحدودة، كما أن ما يطرحه عن مجتمعه الكويتي، يجذر الفهم والتعرف إلى هذا المجتمع الذي يصعب رؤيته من الخارج، ولا أظن أن الأجيال اللاحقة لإسماعيل فهد إسماعيل وليلى العثمان وطالب الرفاعي، ما كان لها أن تنجز ما أنجزته من تراث أدبي لولا كتابة هؤلاء، فهذه الكتابات المؤسسة هي التي فتحت الأبواب لتدلف منه روايات جيل سعود السنعوسي المدهشة، وما تلاه من أجيال.
ولعل مسألة الهجرة لأجل العمل والتكسب في مواقع جغرافية أخرى غير الوطن الأم باتت ظاهرة عالمية منذ عدة عقود تعود إلى القرن الماضي، فحالة العولمة والتطورات الاقتصادية المذهلة التي واكبتها دفعت بكتل بشرية مختلفة الإثنيات والهويات للتنقل والعمل في مناطق جغرافية أخرى غير تلك المناطق التي نشأت فيها، وهو ما شكل ما يمكن تسميته في النهاية عبودية العصر الحديث، وقد تناول الإبداع عامةً والأدب خاصةً مسألة الهجرة والعمالة المرتحلة من أجل حياة أفضل، منذ مدة تعود إلى القرن الماضي، بدءًا من غسان كنفاني ورائعته «رجال تحت الشمس»، حتى كتابات فتحي إمبابي ومحمد غزلان ونعمات البحيري وإبراهيم عبدالمجيد صاحب «البلدة الأخرى» وغيرهم، غير أن ما قدمه الرفاعي في روايته «ظل الشمس» الصادرة لأول مرة عام 1998م يظل له خصوصيته ضمن السرد الأدبي المتمحور حول موضوع هجرة العمالة وارتحالها، فلقد تناول الرفاعي في «ظل الشمس» العمال المصريين الفقراء في دولة الكويت بعين المواطن الكويتي، ليقدم صورة قاتمة عن معاناة هؤلاء العمال وخيبات آمالهم في الوصول إلى حياة أفضل، من خلال ابتعادهم من وطنهم المصري.
 إن النزعة الإنسانية التي تشكل المحور الأساسي لكتابات طالب الرفاعي تتبدى أكثر ما تتبدى في رواية «ظل الشمس»، فتعاطف الكاتب مع أولئك الفقراء القادمين من أعماق الخريطة المصرية سواء من الشمال أو الجنوب، وتصوير معاناتهم التي تجبرهم على ترك أوطانهم تظهر مع بدايات العمل، وتستمر حتى نهايته، ضمن رؤية موضوعية انتقادية لما يتعرضون له من مهانة وخداع ونهب لقوتهم وطاقاتهم البشرية.
إن النزعة الإنسانية التي تشكل المحور الأساسي لكتابات طالب الرفاعي تتبدى أكثر ما تتبدى في رواية «ظل الشمس»، فتعاطف الكاتب مع أولئك الفقراء القادمين من أعماق الخريطة المصرية سواء من الشمال أو الجنوب، وتصوير معاناتهم التي تجبرهم على ترك أوطانهم تظهر مع بدايات العمل، وتستمر حتى نهايته، ضمن رؤية موضوعية انتقادية لما يتعرضون له من مهانة وخداع ونهب لقوتهم وطاقاتهم البشرية.
وعبر مفارقات إنسانية متباينة، تتبدى في هذه الرواية، وفي معظم كتابات طالب الرفاعي القصصية الأخرى، مثلما هو الحال في مجموعة «الكراسي»، أو «رمادي داكن» على سبيل المثال، ينتج السرد جملة من الأسئلة الإنسانية المتعلقة بالقيم والمفاهيم، سواء داخل المجتمع الكويتي ذاته أو داخل المجتمع العربي عمومًا، بما في ذلك القيم الخاصة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، أو بين الآباء والأبناء. فالمرأة التي تجبر على ارتداء النقاب، تجد نفسها مضطرة للمساومة مع زوجها حتى يقبل بأن ترتدي الحجاب فقط، مقابل أن تقرضه من مالها الخاص. والمدرس المسافر للعمل في الكويت مرتضيًا أي مهنة، حتى لو كانت حقيرة، يبحث عن وسيلة للهروب من سطوة أبيه وتسلطه وقبضته الحاكمة.
وأعمال طالب الرفاعي سواء القصصية أو الروائية تقود القارئ عبر خطاباتها إلى جملة من الأسئلة المتعلقة بوجوده وقيمته ومفاهيمه ورؤيته لذاته والعالم، وكيفية إدارته للحياة.
عمومًا ترتكز كتابات طالب الرفاعي إلى الفهم الأصيل لدور الأدب، بوصفه عين زرقاء اليمامة التي ترى ما لا يراه الآخرون داخل المجتمع، بفعل التكرار والاعتياد، ولتكون هذه العين في النهاية مؤشرًا، عبر رؤيتها الثاقبة، إلى تغيير إنساني لا بد أن يكون.
الاختزال الجماليّ الناقد
شهلا العجيلي – كاتبة وناقدة سورية
بدأ طالب الرفاعي بنشر نتاجه الأدبيّ منذ سبعينيّات القرن العشرين، وظهرت قصصه مُنَجَّمةً في الدوريّات العربيّة، حتى أصدر مجموعته الأولى «أبو عجاج طال عمرك» عن دار الآداب في عام 1992م، وبينها وبين مجموعته الأخيرة «رمادي داكن»، الصادرة عن منشورات ذات السلاسل في عام 2018م، ما يقرب من ستّ مجموعات قصصيّة.
تحمل القصّة القصيرة بوصفها شكلًا فنيًّا، إمكانيّة التعرّف إلى موضوعات معقّدة ومتشعّبة، وليست موحّدة بالضرورة، من خلال المجموعة الواحدة، التي لا تكتفي بقدرتها على نقل معنى ما، بل بإحداث معنى، وتوليد دلالات. تنتمي تلك الموضوعات المعقّدة والمتشعّبة التي يتضمّنها النصّ القصصيّ إلى «الثقافيّ»، الذي تنتمي إليه الدلالات المتوالدة أيضًا، والمتعلّقة بالمتلقّي؛ لذا تحمل القصّة القصيرة بوصفها نوعًا فنيًّا تمثّلات الثقافة بوجهيها الأنثروبولوجيّ والجماليّ، وهذا لا يعني اقتصار هذه التمثّلات على القصّة القصيرة من دون الأنواع الأدبيّة التي تنتمي إلى الجنس السرديّ، كالرواية، أو من دون الأجناس الأخرى غير السرديّة كالشعر، لكن تكتسب دراستها في القصّة أهميّة مخصوصة؛ لأنّه يُنظر إلى القصّة على أنّها شكل بمساحة تعبيريّة صغيرة، وقد نعتت بفنّ الرجل الصغير، وعُرّفت على أنها تناول لقطة أو زاوية من زوايا الحياة، وأنّها شكل مغلق… لذلك تُشعر مقارباتها بالضآلة، مع أنّها فنّ له تقاليده الكتابيّة، ودلالاته الثقافيّة المميزة.
لعلّ ذلك «الثقافيّ الذي أشرنا إليه، هو ما تمثّله طالب الرفاعي في قصصه تمثّلًا لافتًا، فقدّم لنا صورًا فنيّة متنوّعة للحياة زاخرة بالخصوصية الثقافيّة للكويت، ففي مجموعته «أبو عجاج طال عمرك» تواجهنا الرؤية الهجائيّة الساخرة، بوصفها أداة للمعرفة، كما يواجهنا الاختزال الجماليّ الذي يحول العالم الخاصّ إلى صورة ديناميكيّة، وليست قناعًا ثقافيًّا يعلّق على الحائط، كما يشير بيكاسو.
 تناقش قصّة «أشياء صغيرة» مطبّات العلاقات الاجتماعيّة الناشئة عن قيم تقليديّة في مجتمع ينحو نحو الحداثة، لعلّها أشياء صغيرة كما أشار العنوان، لكنّها تهدّ العلاقة الأسرية. ونتقرّى في «الإنسان لا يموت» تركيبة المجتمع الكويتيّ، ومفهومي الوطن والعمل، وعلاقتهما بكلّ من الحداثة والرأسمالية، عبر شخصيّة الوافد (أبو شاكر) مستخدم المدرسة، الذي يمثّل نموذجًا لملايين المهاجرين من أجل لقمة عيشهم في العالم كلّه، من حيث همّهم اليوميّ ومصيرهم، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه القصّة كتبت في عام 1986م. أمّا متوالية «أبو عجاج طال عمرك» فهي فريدة في سخريتها الناقدة للعلاقة بين المواطنين والوافدين والحكومات، في إطار مجتمع يتحوّل بسرعة إلى عالم التوحّش الرأسماليّ، سنجد في هذه القصّة المفارقات الطباقيّة حسب إدوارد سعيد، فأنت لا يمكن أن تقدّم في هذه البنية الاجتماعيّة الثقافيّة، حكاية النسق المسيطر (المواطنون) من غير أن تقدّم حكاية النسق المهمّش (الوافدون).
تناقش قصّة «أشياء صغيرة» مطبّات العلاقات الاجتماعيّة الناشئة عن قيم تقليديّة في مجتمع ينحو نحو الحداثة، لعلّها أشياء صغيرة كما أشار العنوان، لكنّها تهدّ العلاقة الأسرية. ونتقرّى في «الإنسان لا يموت» تركيبة المجتمع الكويتيّ، ومفهومي الوطن والعمل، وعلاقتهما بكلّ من الحداثة والرأسمالية، عبر شخصيّة الوافد (أبو شاكر) مستخدم المدرسة، الذي يمثّل نموذجًا لملايين المهاجرين من أجل لقمة عيشهم في العالم كلّه، من حيث همّهم اليوميّ ومصيرهم، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه القصّة كتبت في عام 1986م. أمّا متوالية «أبو عجاج طال عمرك» فهي فريدة في سخريتها الناقدة للعلاقة بين المواطنين والوافدين والحكومات، في إطار مجتمع يتحوّل بسرعة إلى عالم التوحّش الرأسماليّ، سنجد في هذه القصّة المفارقات الطباقيّة حسب إدوارد سعيد، فأنت لا يمكن أن تقدّم في هذه البنية الاجتماعيّة الثقافيّة، حكاية النسق المسيطر (المواطنون) من غير أن تقدّم حكاية النسق المهمّش (الوافدون).
تحوّل قصص طالب الرفاعي المرأة من فضاء الهامش إلى المركز، عبر رؤيته النقديّة التي تهتمّ بالأقليّة سواء أكانت اجتماعيّة إثنيّة أم طبقيّة أم جندريّة، وقد استمرّ ذلك الاهتمام عبر مجموعاته كلّها، لنصل إلى مجموعته الأخيرة «رمادي داكن»، ففي قصّة «لحية وشارب»، سنجد تحولات الوضع الثقافيّ الاجتماعيّ للمرأة الكويتيّة، بين بيت الأب وبيت الزوج، وهذا يشير إلى تحول زمنيّ وليس مكانيًّا، وينتقد موقع الرجل ومقايضاته في المجتمع من خلال (القرض)، و(الحجاب)، و(النقاب)، و(التعليم الجامعيّ)، و(الراتب)، فيعرّفنا إلى الحداثة الناقصة أو المجزوءة، التي يعوزها أساسان وهما الحرية، والمسؤوليّة، حيث إنّ المرأة ليست ضحيّة دائمًا بل قد تغيّب ذاتها، وتستسلم لنزعة المجتمع الاستهلاكيّة وحداثته المزيفة، كما نجد في قصّتي «وضحى»، و«حذاء أسود».
سنجد الكاتب في قصص هذه المجموعة يُبَئِّر العلاقات في المجتمع الرأسماليّ الذي يسعى بشراسة لإزاحة القيم التقليديّة المفعمة بالمعنى الإنسانيّ، ليحلّ بشراسة قيم السوق، التي يمكن أن نسمها بغير الإنسانيّة من جهة، كما أنّها تشكّل نظامًا ناقصًا وانتقائيًّا في المجتمعات العربيّة، فتبدي أسوأ ما في الهجنة من جهة أخرى، وذلك نجده في قصص من مثل: «قرب المدخل»، وهي مبنيّة على المفارقة المؤلمة، وكذلك «قط صغير»، و«العم خليفة»، و«جيش نمل»، وغيرها من القصص التي تُشعر بحرارة الحياة، وديناميكيّتها، وهمومها الصغيرة منها والكبيرة، وأفراحها، مميزة بواقعيّة التصوير، والحوارات البسيطة التي يقتضها فنّ القصّ، والشخصيّات الكنائيّة التي لا تفقد خصوصيّتها وهي تمثّل معظمنا؛ إذ لا يهمّ إن كانت بأسماء أو بصفات، أو بالاثنتين معًا، كما لا يهم إن كانت الكويت بارزة بأسماء أحيائها، وأسواقها، ومرافقها، أو حاضرة بتمثل أليغوريّ.
في محراب الأدب والثقافة
محمد رفيع – كاتب مصري
يعد الكاتب الكويتي طالب الرفاعي مثالًا على الدور العضوي الذي يمثله المبدع والمثقف داخل مجتمعه، فهو بجانب إسهاماته الأدبية في القصة القصيرة والرواية له أدوار ثقافية متعددة، لعل أبرزها إنشاء جائزة مخصصة للقصة القصيرة العربية في دولة الكويت، بالتعاون مع الجامعة الأميركية هناك، وكانت هذه الجائزة وفي توقيت ظهورها بمنزلة قبلة الحياة التي أعادت الاهتمام بهذا الفن المغدور، وقد رأيت الدكتور طالب الرفاعي بنفسي وهو حريص كل الحرص على هدفين مهمين له؛ أولهما إنشاء جائزة كويتية تعيد المد الثقافي الكويتي إلى الساحة، وثانيهما إعادة الاعتبار للقصة القصيرة العربية.
وعلى ذلك كان طالب في 2016م في أثناء التجهيز للدورة الأولى لجائزة الملتقى للقصة القصيرة كالعصب العاري، يريد أن تخرج هذه الجائزة في حلة مشرفة، ورغم ذلك كان يتوارى عن أعين الكاميرات مقدمًا الحدث نفسه والمتسابقين إلى الساحة الثقافية العربية، وربما بدأ بحثي من هذه النقطة عن أدب طالب الرفاعي للتعرف إلى عوالم هذا المبدع، وكذلك لسبب شخصي وهو وجه الشبه الكبير في طريقة الحياة والكلام حتى التفكير بين طالب الرفاعي ورعيل كبير من أقاربي المنحدرين بالطبع من الأصول البدوية.
وهنا اكتشفت أواصر أخرى في البنية الفكرية والإبداعية عند طالب، فهو مهتم بالأسطورة وبالهوية وبالقصة القصيرة رغم إجادته فن الرواية. وهناك ميزة أخرى لسرد طالب الرفاعي وهو البحث، فالرواية بالنسبة له كما بالنسبة لكثيرين لم تعد حقلًا للمتخيل فقط بل حقلًا معرفيًّا في الأساس يتطلب كثيرًا من البحث في التاريخ وربما في العلوم الأخرى لكي يلم الروائي بمكونات عالمه. فنجده في رواية «حابي» متبحرًا في فكرة الهوية والذكورة والأنوثة وتأثيرها في الهوية النفسية والجسدية للفرد، مع اطلاعه على علوم الجينات، ليس لجعل الرواية درسًا بحثيًّا بقدر جعلها مزيجًا معرفيًّا نفسيًّا أدبيًّا ممتعًا، يقول بطل الرواية الذي راوَحَ بين الثنائيات المكانية بين الشرق والغرب والنوعية بين الذكر والأنثى: «أنا ولد، أشعر كأن طعمًا مرًّا بفمي قدري أن أبقى حابي»، ليلخص لنا أزمته.
ونجده في رواية «نجدي» التي تروي سيرة غيرية لنوخذة أو قبطان مركب وهو علي ناصر النجدي. والرواية على حجمها تروي آخر يوم في حياة علي النجدي. ولعل اختيار طريقة السرد هذه تعد تحديًا، فعليك أن تروي سبعين عامًا، وهي حياة النجدي في هذا النهار الأخير من حياته، ولذلك يجب أن يكون الروائي حذرًا هنا، فالرواية ستبنى على تقنية الاسترجاع، وليس الاسترجاع أو الفلاش باك فقط، ولكن تأخذ أيضًا من تيار الوعي فكرة التذكر العرضي أو أن الشيء بالشيء يذكر. ولعل طالب الرفاعي في هذه الرواية كان لا بد أن يتمثل شخصيًّا حياة الرجل الذي قرأ عنه في مصادر أجنبية وعربية حتى كاد يراه رؤية العين، جسدًا وروحًا.
درب مميز وبصمة خاصة
مفلح العدوان – كاتب أردني
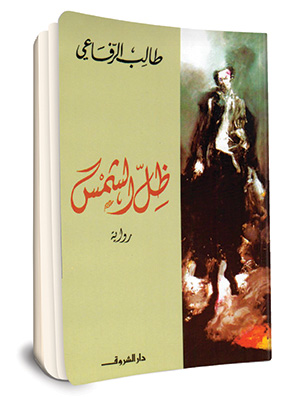 يبدع طالب الرفاعي في مجمل ما يكتبه من سرد، وهو في كتابته للرواية والقصة يخط دربه الذي يميزه، وله بصمته الخاصة، هذا المبدع الذي بدأ كتابة القصة في منتصف السبعينيات، وكانت أولى مجموعاته القصصية المنشورة «أبو عجاج طال عمرك»، واستمر في إصداراته القصصية وكتابته وعشقه لفن القصة إلى أن بدأ كتابة الرواية في منتصف التسعينيات، حيث كانت أولى رواياته «ظل الشمس».
يبدع طالب الرفاعي في مجمل ما يكتبه من سرد، وهو في كتابته للرواية والقصة يخط دربه الذي يميزه، وله بصمته الخاصة، هذا المبدع الذي بدأ كتابة القصة في منتصف السبعينيات، وكانت أولى مجموعاته القصصية المنشورة «أبو عجاج طال عمرك»، واستمر في إصداراته القصصية وكتابته وعشقه لفن القصة إلى أن بدأ كتابة الرواية في منتصف التسعينيات، حيث كانت أولى رواياته «ظل الشمس».
لكن طالب الرفاعي وعلى الرغم من كتابته للرواية فإنه بقي ينحاز وينتصر كثيرًا للقصة القصيرة التي ينشغل فيها بموضوعات إنسانية مهمة، وخطيرة، وحساسة، هي بحسب ما تابعت من كتاباته قضايا المرأة وقضايا المهمشين وعلى وجه الخصوص العمالة الوافدة، إنه يلتقط الفكرة، والقصة فن التكثيف، فهو يقدمها بتوظيف ذكي لتقنيات القصة القصيرة، ويوجه الحوار باتجاه جوهر الفكرة التي يبني عليها قصته، مع استثمار للترميز والمونولوج الداخلي والتداعيات. طالب الرفاعي في قصصه معنيّ بالإنسان وقضاياه، معنيّ بتعرية زيف المجتمع، ويطرح نماذج مختلفة في قصصه، وهو فيما يكتب لديه موقف يقدمه بطريقة فنية عالية تحمل الفكرة، وتؤدي الرسالة على محمل الإبداع.
قبل سنوات، في عام 2017م، حين كنت رئيسًا لمختبر السرديات الأردني نظمت وأدرت ندوة حول إبداع وكتابة طالب الرفاعي ضمن برنامج «سيرة سارد»، وتحدث طالب الرفاعي خلال اللقاء بحميمية عن كتابته للقصة القصيرة وتعلقه بالكتابة منذ بداياته حيث كان حديثه بأنه «في الكتابة فسحة تمكنه من الهروب إلى الحرية والحلم والأمل، وتقدم له السلوى والعزاء والأمان في لحظة إنسانية عاصفة يخيم عليها العنف واللاعدالة». فهو يضع أولوية في موضوعاته في القصة وفي معالجتها للجوانب الإنسانية الكبرى، ولعلني هنا يمكن أن أشير إلى رأي للمرحوم الروائي إلياس فركوح، وكان حاضرًا في الندوة على المنصة، حيث قال: إن «تجربة طالب الرفاعي الممتدة نحو ربع قرن تُعنَى بنقل مناخات الواقع المعيش إلى الورق، الشخصيات وحكاياتهم، بتلوينات خاصة اعتمدت التجربة الذاتية لكاتبها ومساءلته لها».
بقي أن أشير إلى أن كتابة القصة القصيرة عند طالب الرفاعي هي جزء من مشروعه السردي الموزع بين القصة والرواية، ولكنه يفيد في كلا الجنسين الإبداعيين من تجربته الشخصية ومعاينته لكثير من القضايا الإنسانية، وهو يوائم بين تخصصه العلمي في الهندسة، وبين الأبعاد المعنوية والمجتمعية في كتابته للقصة والرواية، ولكن هذا الحنين إلى القصة عبر عنه بعودته إلى الدراسة الأكاديمية ودراسته لمادة الكتابة الإبداعية، مع التركيز على القصة القصيرة وتنظيره فيها، يضاف إلى هذا العشق للقصة القصيرة مشروعه الذي أبدع في تأسيسه وإدارته وهو جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، فهو عاشق لهذا الفن، وصاحب مشروع طموح لديمومته وإعطائه زخم الحضور في زمن صعود الرواية لإيمانه بفن القصة ولعشقه له.
جغرافيا السرد
فهد الهندال – كاتب كويتي
يميز أدب الأديب طالب الرفاعي، تلمسه لقضايا المجتمع على اختلاف مستوياته، فتجد في أعماله القصصية والروائية حكايات البيت، الشارع، العمل، الجامعة وغيرها. فجغرافيا القص لدى طالب الرفاعي لا تتوقف عند السرد الآني، وإنما يستعيد ذاكرة المكان عبر شخصيات يستعيدها من الماضي، أو شخصيات واقعية تعاني إشكالية معينة، حيّدها المجتمع تحت إطار نظرة واحدة. إن المطلع على أدب الرفاعي، لن يستوحش اللغة الروائية، ولن يحتاج إلى قراءة مقعرة مجهدة، وإنما إلى منظار للأفكار التي تختبئ بين ظلال الكلمات.
في رواية «حابي»، نجد سردًا مزدوجًا، كما هي حالة السرد المتداخل فنيًّا، يتناول تحولًا جنسيًّا من أنثى إلى ذكر، ولكن يبقيان «ريان الفتاة» و«ريان الفتى» في سجن الجسد الواحد سيكولوجيًّا، رغم تحوله الفسيولوجي، وكأن المفارقة هنا تأتي على لسان ريّان الفتاة سابقًا: «ريان تلك الفتاة الغافية في بئر روحي ستبقى تلاحقني طوال عمري لتشاركني وتفسد عليّ لحظتي، وستبقى في نظر أسرتي وأقربائي هي صورتي وهويتي التي يصعب عليهم نسيانها وتجاوزها. ريان الفتاة لعنة تمسك بي! أجريت أكثر من عمليتين جراحيتين وعانيت ما عانيت وما زالت تمسك بي».
وكأننا أمام مصير آخر لم يفكر فيه العلم، رغم تطوره الطبي والجراحي، ونعني الجانب النفسيَّ في مواجهة النفس قبل المجتمع، وهو ما ختم به ريان الفتى الآن: «أشعر أن طعمًا مرًّا بفمي، قدري أن أبقى حابي».
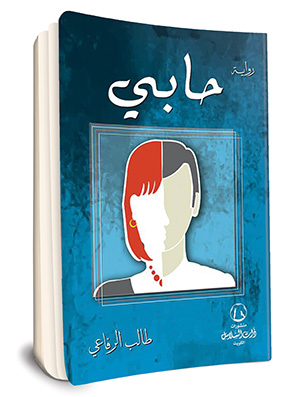 في رواية «الثوب»، جاء السرد وفق علاقة التخييل الذاتي بالواقع الذي انطلق منه الكاتب في حضوره كسارد باسمه الحقيقي كما هو المكتوب على غلاف الرواية، وهي التجربة الثالثة لطالب الرفاعي التي يحضر في رواياته كأحد الشخصيات. ولمزيد من التقارب مع الواقع، استخدم الكاتب الزمن كأداة لتخيّل سردي لأحداثها. فقد اتكأ على زمن داخلي من خلال التواريخ التي جعلها عتبة فصوله المرقمة. والملحوظ أن الكاتب اهتم بأن يورد التاريخ مفصلًا مشتملًا على اليوم الموافق له، الشهر، السنة. هذا بالنسبة لزمن القص الذي اعتمده عتبة دخول كل فصل، أما زمن السرد فجاء في ثنايا متن كل فصل، من خلال الإشارة إلى التوقيت الزمني لساعات اليوم، نهارًا أو ليلًا، أو الإيحاء بوقت من أوقات اليوم.
في رواية «الثوب»، جاء السرد وفق علاقة التخييل الذاتي بالواقع الذي انطلق منه الكاتب في حضوره كسارد باسمه الحقيقي كما هو المكتوب على غلاف الرواية، وهي التجربة الثالثة لطالب الرفاعي التي يحضر في رواياته كأحد الشخصيات. ولمزيد من التقارب مع الواقع، استخدم الكاتب الزمن كأداة لتخيّل سردي لأحداثها. فقد اتكأ على زمن داخلي من خلال التواريخ التي جعلها عتبة فصوله المرقمة. والملحوظ أن الكاتب اهتم بأن يورد التاريخ مفصلًا مشتملًا على اليوم الموافق له، الشهر، السنة. هذا بالنسبة لزمن القص الذي اعتمده عتبة دخول كل فصل، أما زمن السرد فجاء في ثنايا متن كل فصل، من خلال الإشارة إلى التوقيت الزمني لساعات اليوم، نهارًا أو ليلًا، أو الإيحاء بوقت من أوقات اليوم.
اعتمد الكاتب على النسق الزمني المتقطع في عملية السرد الذي جاء زمنه متناثرًا بحسب السارد/ طالب المنظّم لمجريات أحداث الرواية. ليكون الزمن السردي منقسمًا بين نوعين من الاسترجاع، الأول خارجي والآخر داخلي. لأقف هنا عند نهاية الرواية التي ختمها بعبارة على لسان السارد طالب الرفاعي «مادة الرواية محفوظة لدي، ولن أتركها تموت وحيدة بصمتها. لن تخيفني تهديدات أم وليد وأخيها، ولن تثنيني توسلات شروق. الكتابة مخاطرة بدءًا ومنتهى. سأكتب الرواية ولن ألتفت لأحد»، وهو ما يمكن الإجابة عنه، بأن الرواية كتبت أصلًا قبل تاريخها المدون، الذي بدأت به زمن القص الخاص بها في الفصل الأول (28 مارس 2007م).
إضافة إلى زمن آخر مهم نشير إليه هنا عن الرواية، وهو زمن النص المؤرخ للطبعة الأولى للرواية عام 2009م، وزمن الكاتب الخاص بالمدة التي استغرقها في كتابة الرواية التي ختم بها الرواية (الكويت يونيو/ حزيران 2006م – فبراير/ شباط 2009م). لنجد أن الكتابة سبقت في زمنها زمن القصة والسرد معًا. وهو ما يحيل إلى زمن المتلقي لاحقًا لاستقبال هذا النص، وزمن القراءة التي ستختلف من مُتلقٍّ لآخر، بحسب قراءته لأحداثها الواقعية والمتخيلة معًا، وهو ما يتضح من خلال بعض الإشارات الزمنية في حياة خالد خليفة، مثلًا عن معيشته السابقة قبل الغنى «خلال طفولتي كنت أراه واسعًا، لكن قبل هدم البيت في منتصف السبعينات، حين زرته للمرة الأخيرة، استغربت مساحته، فلقد بدا لي صغيرًا، والغرف كانت ضيقة جدًّا، ولا أدري كيف كنا نعيش فيها، وكيف كانت تسعنا؟».
ثم عن مرحلة دراسته الجامعية، وكيف ربطها زمنيًّا بمرحلة معيّنة في تاريخ الكويت «جامعة الكويت وقتها كانت تعيش واحدة من أهم وأجمل فترات تطورها وانفتاحها، قائمة «الوسط الديمقراطي» ممسكة بزمام الاتحاد الوطني للطلبة: محاضرات، وعلاقات جميلة بين الطلاب والطالبات، وصداقات، ورحلات شبابية، وحفلات.. المجتمع الكويتي بأسره في تلك الفترة كان يعيش واحدة من أجمل فترات ازدهاره وحضوره الاجتماعي والاقتصادي والفني والرياضي في الداخل والخارج. كانت الكويت وقتها درة الخليج، وما كان هناك من ينافسها». ليعود الزمن إلى زمن السرد نفسه «أحزن عندما أنظر إلى وضع الكويت اليوم».
كانا نموذجين من أعمال طالب الرفاعي الروائية، حيث تكتنز بقية الأعمال بما خطه طالب من سرد ورؤى حول الإنسان، بمختلف زمانه.







 ومحطات خيرٍ لا جاهدتُ ولا سعيتُ ولا مرت ببالي، جاءتني بمحض قدرية الحياة، تقصدني لتأخذني لحضنها، وكم ارتاحت روحي في فيء ظلالها الوارفة! لذا إذا كان لي من وقوف أمام أهم المحطات الأدبية في حياتي، فسأقول:
ومحطات خيرٍ لا جاهدتُ ولا سعيتُ ولا مرت ببالي، جاءتني بمحض قدرية الحياة، تقصدني لتأخذني لحضنها، وكم ارتاحت روحي في فيء ظلالها الوارفة! لذا إذا كان لي من وقوف أمام أهم المحطات الأدبية في حياتي، فسأقول:

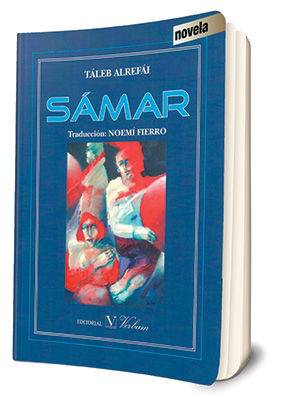 هناك في النقد الأدبي نظريات مثل «Lesbian Theory» و«Queer Theory» وهما النظريتان اللتان تقاربان موضوعًا مشابهًا ومختلفًا في الوقت عينه، لشخصية بطل رواية «حابي». تشتغل كل من النظريتين سابقتي الذكر على هوية الرجل والمرأة، التي شكلت بناءً على الفهم الاجتماعي، وتراجعان بعض المسلمات والانطباعات المغلوطة التي حددت هوية المرأة والرجل من منظور اجتماعي. يقارب النقد الأدبي النصوص الأدبية، بناءً على التوجهات العاطفية تجاه الجنس المماثل، والنفور من الجنس الآخر، مدافعين عن حق كل من الطرفين في الاختلاف.
هناك في النقد الأدبي نظريات مثل «Lesbian Theory» و«Queer Theory» وهما النظريتان اللتان تقاربان موضوعًا مشابهًا ومختلفًا في الوقت عينه، لشخصية بطل رواية «حابي». تشتغل كل من النظريتين سابقتي الذكر على هوية الرجل والمرأة، التي شكلت بناءً على الفهم الاجتماعي، وتراجعان بعض المسلمات والانطباعات المغلوطة التي حددت هوية المرأة والرجل من منظور اجتماعي. يقارب النقد الأدبي النصوص الأدبية، بناءً على التوجهات العاطفية تجاه الجنس المماثل، والنفور من الجنس الآخر، مدافعين عن حق كل من الطرفين في الاختلاف.
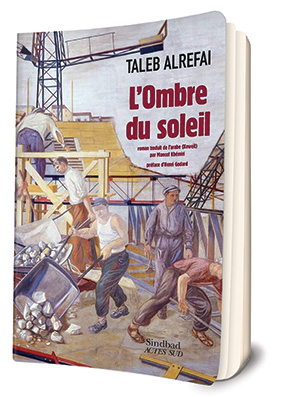 ومع ذلك لم يكن هذا النص رواية تاريخية، بالمفهوم التقليدي للنوع، بل كان «تخييلًا تاريخيًّا»، أي سردية جامحة مكتوبة خارج إكراهات الواقع، ولكنها لا يمكن أن تتحرك خارج ما يجيزه التاريخ ويقبل به المؤرخون. وذاك ما مكن الروائي من التخلص من «الأشباح» (وهي في النهاية مفاهيم تستوطن الذهن) لكي يحتفي بشخصيات «من لحم ودم» (أليكساندر دوما). وبذلك شكلت هذه الرواية نقلة نوعية في تجربته الشخصية، وشكلت أيضًا تجربة مميزة في تاريخ الرواية الكويتية، بل في الرواية العربية أيضًا.
ومع ذلك لم يكن هذا النص رواية تاريخية، بالمفهوم التقليدي للنوع، بل كان «تخييلًا تاريخيًّا»، أي سردية جامحة مكتوبة خارج إكراهات الواقع، ولكنها لا يمكن أن تتحرك خارج ما يجيزه التاريخ ويقبل به المؤرخون. وذاك ما مكن الروائي من التخلص من «الأشباح» (وهي في النهاية مفاهيم تستوطن الذهن) لكي يحتفي بشخصيات «من لحم ودم» (أليكساندر دوما). وبذلك شكلت هذه الرواية نقلة نوعية في تجربته الشخصية، وشكلت أيضًا تجربة مميزة في تاريخ الرواية الكويتية، بل في الرواية العربية أيضًا.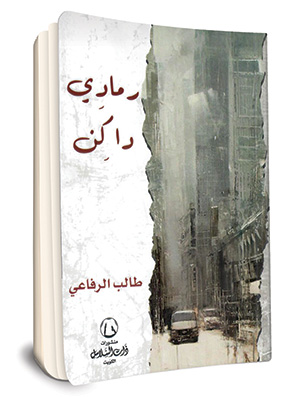 فالرواية لا تحكي تفاصيل عملية جراحية، وهي موجودة ولكنها عابرة، بل تنصب على الكشف عن «التحول» الذي يحاصر الناس من كل الجوانب داخل مجتمع يعيش حالة من «السكيزوفرينيا الحضارية»، حيث مظاهر التحديث في كل مكان وفي كل شيء، إنها في تفاصيل الحياة اليومية وفي المحيط واللباس، ولكن الناس ما زالوا يتحركون خارج مدارات «حداثة» هي الوجه الثقافي لكل حالات التحديث. إنهم ينظمون فضاءاتهم المخيالية وفق قيم مستوحاة من تقاليد تأبى الزوال.
فالرواية لا تحكي تفاصيل عملية جراحية، وهي موجودة ولكنها عابرة، بل تنصب على الكشف عن «التحول» الذي يحاصر الناس من كل الجوانب داخل مجتمع يعيش حالة من «السكيزوفرينيا الحضارية»، حيث مظاهر التحديث في كل مكان وفي كل شيء، إنها في تفاصيل الحياة اليومية وفي المحيط واللباس، ولكن الناس ما زالوا يتحركون خارج مدارات «حداثة» هي الوجه الثقافي لكل حالات التحديث. إنهم ينظمون فضاءاتهم المخيالية وفق قيم مستوحاة من تقاليد تأبى الزوال.

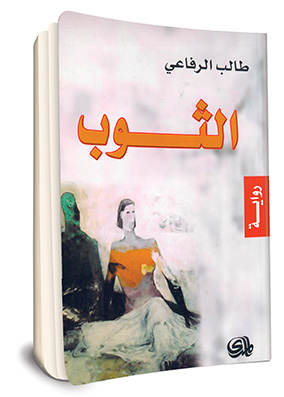 هذا الذي ذكرته يقودني للحديث عن تقنية السينما التي استفاد منها طالب أيضًا، أي تقنية تقطيع المشاهد وجعل بعضها يكمل بعضًا، واستخدام كاميرا سردية إن جاز القول، تتجول بعينيك في المكان النصيّ، مُتابِعةً حركة الشخوص فيه. وبالطبع لن ننسى استخدام المونولوج الداخلي، وحديث الشخوص مع ذواتها، في محولات للكشف عما يحدث.
هذا الذي ذكرته يقودني للحديث عن تقنية السينما التي استفاد منها طالب أيضًا، أي تقنية تقطيع المشاهد وجعل بعضها يكمل بعضًا، واستخدام كاميرا سردية إن جاز القول، تتجول بعينيك في المكان النصيّ، مُتابِعةً حركة الشخوص فيه. وبالطبع لن ننسى استخدام المونولوج الداخلي، وحديث الشخوص مع ذواتها، في محولات للكشف عما يحدث.
 إن النزعة الإنسانية التي تشكل المحور الأساسي لكتابات طالب الرفاعي تتبدى أكثر ما تتبدى في رواية «ظل الشمس»، فتعاطف الكاتب مع أولئك الفقراء القادمين من أعماق الخريطة المصرية سواء من الشمال أو الجنوب، وتصوير معاناتهم التي تجبرهم على ترك أوطانهم تظهر مع بدايات العمل، وتستمر حتى نهايته، ضمن رؤية موضوعية انتقادية لما يتعرضون له من مهانة وخداع ونهب لقوتهم وطاقاتهم البشرية.
إن النزعة الإنسانية التي تشكل المحور الأساسي لكتابات طالب الرفاعي تتبدى أكثر ما تتبدى في رواية «ظل الشمس»، فتعاطف الكاتب مع أولئك الفقراء القادمين من أعماق الخريطة المصرية سواء من الشمال أو الجنوب، وتصوير معاناتهم التي تجبرهم على ترك أوطانهم تظهر مع بدايات العمل، وتستمر حتى نهايته، ضمن رؤية موضوعية انتقادية لما يتعرضون له من مهانة وخداع ونهب لقوتهم وطاقاتهم البشرية. تناقش قصّة «أشياء صغيرة» مطبّات العلاقات الاجتماعيّة الناشئة عن قيم تقليديّة في مجتمع ينحو نحو الحداثة، لعلّها أشياء صغيرة كما أشار العنوان، لكنّها تهدّ العلاقة الأسرية. ونتقرّى في «الإنسان لا يموت» تركيبة المجتمع الكويتيّ، ومفهومي الوطن والعمل، وعلاقتهما بكلّ من الحداثة والرأسمالية، عبر شخصيّة الوافد (أبو شاكر) مستخدم المدرسة، الذي يمثّل نموذجًا لملايين المهاجرين من أجل لقمة عيشهم في العالم كلّه، من حيث همّهم اليوميّ ومصيرهم، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه القصّة كتبت في عام 1986م. أمّا متوالية «أبو عجاج طال عمرك» فهي فريدة في سخريتها الناقدة للعلاقة بين المواطنين والوافدين والحكومات، في إطار مجتمع يتحوّل بسرعة إلى عالم التوحّش الرأسماليّ، سنجد في هذه القصّة المفارقات الطباقيّة حسب إدوارد سعيد، فأنت لا يمكن أن تقدّم في هذه البنية الاجتماعيّة الثقافيّة، حكاية النسق المسيطر (المواطنون) من غير أن تقدّم حكاية النسق المهمّش (الوافدون).
تناقش قصّة «أشياء صغيرة» مطبّات العلاقات الاجتماعيّة الناشئة عن قيم تقليديّة في مجتمع ينحو نحو الحداثة، لعلّها أشياء صغيرة كما أشار العنوان، لكنّها تهدّ العلاقة الأسرية. ونتقرّى في «الإنسان لا يموت» تركيبة المجتمع الكويتيّ، ومفهومي الوطن والعمل، وعلاقتهما بكلّ من الحداثة والرأسمالية، عبر شخصيّة الوافد (أبو شاكر) مستخدم المدرسة، الذي يمثّل نموذجًا لملايين المهاجرين من أجل لقمة عيشهم في العالم كلّه، من حيث همّهم اليوميّ ومصيرهم، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه القصّة كتبت في عام 1986م. أمّا متوالية «أبو عجاج طال عمرك» فهي فريدة في سخريتها الناقدة للعلاقة بين المواطنين والوافدين والحكومات، في إطار مجتمع يتحوّل بسرعة إلى عالم التوحّش الرأسماليّ، سنجد في هذه القصّة المفارقات الطباقيّة حسب إدوارد سعيد، فأنت لا يمكن أن تقدّم في هذه البنية الاجتماعيّة الثقافيّة، حكاية النسق المسيطر (المواطنون) من غير أن تقدّم حكاية النسق المهمّش (الوافدون).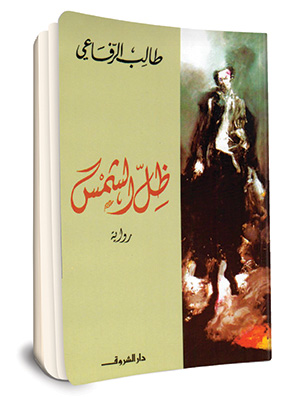 يبدع طالب الرفاعي في مجمل ما يكتبه من سرد، وهو في كتابته للرواية والقصة يخط دربه الذي يميزه، وله بصمته الخاصة، هذا المبدع الذي بدأ كتابة القصة في منتصف السبعينيات، وكانت أولى مجموعاته القصصية المنشورة «أبو عجاج طال عمرك»، واستمر في إصداراته القصصية وكتابته وعشقه لفن القصة إلى أن بدأ كتابة الرواية في منتصف التسعينيات، حيث كانت أولى رواياته «ظل الشمس».
يبدع طالب الرفاعي في مجمل ما يكتبه من سرد، وهو في كتابته للرواية والقصة يخط دربه الذي يميزه، وله بصمته الخاصة، هذا المبدع الذي بدأ كتابة القصة في منتصف السبعينيات، وكانت أولى مجموعاته القصصية المنشورة «أبو عجاج طال عمرك»، واستمر في إصداراته القصصية وكتابته وعشقه لفن القصة إلى أن بدأ كتابة الرواية في منتصف التسعينيات، حيث كانت أولى رواياته «ظل الشمس».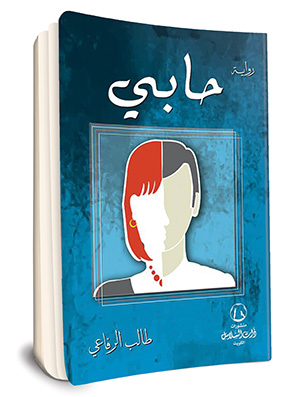 في رواية «الثوب»، جاء السرد وفق علاقة التخييل الذاتي بالواقع الذي انطلق منه الكاتب في حضوره كسارد باسمه الحقيقي كما هو المكتوب على غلاف الرواية، وهي التجربة الثالثة لطالب الرفاعي التي يحضر في رواياته كأحد الشخصيات. ولمزيد من التقارب مع الواقع، استخدم الكاتب الزمن كأداة لتخيّل سردي لأحداثها. فقد اتكأ على زمن داخلي من خلال التواريخ التي جعلها عتبة فصوله المرقمة. والملحوظ أن الكاتب اهتم بأن يورد التاريخ مفصلًا مشتملًا على اليوم الموافق له، الشهر، السنة. هذا بالنسبة لزمن القص الذي اعتمده عتبة دخول كل فصل، أما زمن السرد فجاء في ثنايا متن كل فصل، من خلال الإشارة إلى التوقيت الزمني لساعات اليوم، نهارًا أو ليلًا، أو الإيحاء بوقت من أوقات اليوم.
في رواية «الثوب»، جاء السرد وفق علاقة التخييل الذاتي بالواقع الذي انطلق منه الكاتب في حضوره كسارد باسمه الحقيقي كما هو المكتوب على غلاف الرواية، وهي التجربة الثالثة لطالب الرفاعي التي يحضر في رواياته كأحد الشخصيات. ولمزيد من التقارب مع الواقع، استخدم الكاتب الزمن كأداة لتخيّل سردي لأحداثها. فقد اتكأ على زمن داخلي من خلال التواريخ التي جعلها عتبة فصوله المرقمة. والملحوظ أن الكاتب اهتم بأن يورد التاريخ مفصلًا مشتملًا على اليوم الموافق له، الشهر، السنة. هذا بالنسبة لزمن القص الذي اعتمده عتبة دخول كل فصل، أما زمن السرد فجاء في ثنايا متن كل فصل، من خلال الإشارة إلى التوقيت الزمني لساعات اليوم، نهارًا أو ليلًا، أو الإيحاء بوقت من أوقات اليوم.


0 تعليق
Trackbacks/Pingbacks