يبدو أحمد الملا (1961م-) من أكثر شعراء قصيدة النثر العرب إخلاصًا لهذه القصيدة، متماهيًا مع متطلباتها، إنْ على مستوى نزعتها التمردية على المواضعات الفنية والاجتماعية، أو في استدراجها لعناصر وأجواء من خارجها، فتتحول مكونًا أساسيًّا ضمن مكوناتها الدقيقة، وتنفتح بها على أقاليم جديدة.
هذا التماهي لا يقوله نصه فقط، نصه المتكاثر والمتعدد الوجوه والحالات، وهو ما يغري دومًا النقاد والباحثين ويدفعهم إلى إنجاز المقاربة تلو الأخرى، إنما يعكسه ما يفعله هو بحياته، تعكسه هيئته الشخصية، وينم عنه سلوكه وإيقاع عيشه، فهو بشعره الطويل ولحيته الكثة، بلا غطاء للرأس في معظم الأوقات، وهو حين يختار أن يلبس غطاء للرأس، فسيكون «شماغًا» بلا لون، أو لونًا لم تَعتَدْه الأنظار، بنأيه عن “الوظيفة” الرسمية وإكراهاتها، كأنما هو يمقت أن يزاول إدارة ينقصها الخيال، بكل هذه الخصال، يذهب صاحب «خفيف ومائل كنسيان» في مغايرة صريحة، لا تتقصد الإعلان السافر عن «أنا» متهورة، تصدم الآخر في ذوقه، وتجابه الشعراء فيما ألفوه في الكتابة وطرائق العيش، إنما تتوالى بعفوية شديدة، وببساطة مترفعة، مغايرة لا يصحبها ضجيج، بل هي ضد الضجيج.
إذن، يتحقق أحمد الملا، الذي تفصله خطوة عن ولوج عقده السابع، شعريًّا وأنطولوجيًّا عبر تمظهرات متنوعة، تصبّ جميعها في وحدة، ليست سوى كائن معنيّ بسؤال وجوده، في الشعر والحياة. في معنى ما، هو كينونة متمردة تفتش عن صورتها في الشعر ومراياه، من فنون وأشكال إبداعية مختلفة. ولا يظهر صاحب «فهرس الخراب» معنيًّا بحساب العمر، وقد يروق له مثل طفل شقيّ، تحويل أعوامه الستين إلى مجرد كرة يتلهى بها ويدحرجها بين قدميه.
خاض الملا وجرب أنماطًا تعبيرية شتى، كتب في المسرح، واستهوته الفوتوغرافيا، ومثّل في أفلام قصيرة، وانشغل بالسينما كمتفرغ، وحين أسس وأدار مهرجان أفلام السعودية، فرش السجاد الأحمر لصناعها اليافعين لكن الكبار في أحلامهم… وهو يواصل مغايرته للسائد، واستقلاله عن الشائع من السلوك والتجارب، حتى في شكل الخاتمة أو الميتة التي يقترحها لنفسه، ويرى أنها قد تكون امتدادًا طبيعيًّا لحياة هذه صورتها، في ذهاب صريح إلى رفض التنميط حتى بعد فناء الجسد، فهو يقول في أحد نصوصه: سأموتُ بشَعْرٍ طويلٍ/ ولحيةٍ كَثَّةٍ بيضاء/ في مغارةٍ عالية،/ فلا حاجة إلى كَفَن/ أو قبر».
لا يسع المرء أن يعرف، إذا ما كان الشعر، بصوره المتنوعة، يأتي امتدادًا لحياة الملا، أم إن حياة صاحب «كتبتنا البنات» تواصل تدفقها في هذا الشعر وفي تلك الانشغالات وفي طريقة عيشه. على مستوى الكتابة، مرت قصيدة الملا باختبارات عدة، وكانت موضوعًا لاشتغال يطور نفسه باستمرار، حتى أضحت، بعد مراودة عسيرة، كما أرادها، «مدبّبةً مُحكمَة ومحشوّةً بالبارود»، تقرأ في كل وقت، ولا يحتاج إلى كتابة غيرها.
فصاحب «تمارين الوحش» يأخذ نصّه مأخذ مسؤولية، معرفيّة ووجوديّة، بحسب ما يذهب الناقد بنعيسى بوحمالة. وقصيدته تبدأ، كما يقول الشاعر عبدالقادر الجنابي، حين تتجاور الكلمات «وكأنها كائنات تتواصل بينها، تشتغل معًا وتتبادل عزلاتها الكبرى». في تجربة صاحب «الهواء طويل وقصيرة هي الأرض» تتجول عين الكاميرا بالقارئ بين المشاهد، وفقًا لما تقوله الناقدة ميساء الخواجا. يمثل أحمد الملا، في تصور الناقد أيمن بكر، شريحة مهمة متمردة حيوية بصورة كبيرة من شعراء التجديد الشعري العربي. وعلى ما يذهب الشاعر السوري أكرم قطريب، فإن صاحب «سهم يهمس باسمي» يؤكد لقارئه أنّه ليس من الصعوبة تقدير مكانة دقته الشديدة في صياغة قصائده. يكتب أحمد الملا شعرًا واسع الرؤية عميق البصيرة، كما يرى الكاتب السوداني طارق الطيب.
هنا تحية، من نقاد وشعراء، لتجربة تميزها هذه الخصال.

قراءة لا على التعيين في شعر أحمد الملا
عبدالقادر الجنابي – شاعر وناقد عراقي
I
الشعر، كالحب، يتجلى سحرُه حين يكون فعلًا لا إراديًّا: فراش الشاعر ورقته البيضاء. هنا شاعر يوظف اللغة بأسلوب جديد ترتسم فيه حالات البشر وجدانيًّا. فهو يكتب من وراء نافذة تطل على منظر البشر في حالات من التساؤل. ففي كل قصيدة نراه يحاول التسلل إلى العبارة بغنائية مضادة في ذاتها، بعاطفته المكمونة لرصد ما يهوّم في مخلفات اللغة من دلالات مكسورة تصلح أن تتآخى في مجاز جديد متاح للمشاركة في لعبة الشعر الأصلية التي تحافظ على انسيابية هارمونية بأسلوب -متخلص من مبالغة ميلودية غالبًا ما يقع تحت أسرها عدد من الشعراء المحدثين- يأخذنا إلى فجر الأمم حين كانت أممًا من الشعراء، كما يتصور الفيلسوف جيوفاني باتيستا فيكو.
وهذا يوجب الشاعر أن يُفرغ الكلمة من ذكرياتها، مزودًا إياها بذاكرة جديدة؛ لكي تتمكن من أن تحتل مكانها في البيت لا «بثياب البارحة» وإنما بـ«جسد عار يَطمئنُّ في حضن العري». فالقصيدة تبدأ حين تتجاور الكلمات وكأنها كائنات تتواصل بينها، تشتغل معًا وتتبادل عزلاتها الكبرى: أبّهتُها.
II
بين الشعر والشاعر علاقة جدلية تصبح مهمة الشاعر فيها لا تأويل الحلم، بشتيت الإنشاء؛ بنتيجة يتوقعها القارئ، وإنما تأهيل هذا الحلم المرافق بمتفجرات ذهنية تتشظّى عن لَوْحِهِ صُوَرٌ غالبًا ما تجسُر هُوّة القراءة، صور واقعية لا تسقط في الغرابة، لا تأكلُ الكلمات بنهم، وإنما تكتفي بما يشطبُ اللوغوس (الخطاب) بحثًا عن إرجاءٍ، تأجيلٍ حيث يَجِدُ النفَسُ الشعري أرجاءَه المفتوحة؛ أرضَ معناه الموعودة. إنها صور على عكس الأشجار، لا «تختبئ في التكرار» وإنما «تترك سرّها خفيًّا» في نهار الكون، في حنايا كل ما هو واضح ورائق وجلي. الشعر، هنا، وطنُ صُوَر.
III
هناك دوما «فكرة غارقة» على الشعراء «إنعاش رئتيها» لكي تقف القصيدة بمفردها، لا تركض وإنما تتأنى، لا تغرز وإنما تشمُّ؛ لا تقتنص، وإنما تتلقى، لا تُحيل إلى شيء ما وإنما أن تكون ذاتها، لا مظهر طقوسيًّا لها سوى مظهرها هي. لا أقصد أن قصيدته بلا غاية، أي لا تنطلق من تاريخ يبرر وجودها. على العكس من ذلك، قصيدة الملا رواقية المنزع، تؤمن بحرية الحياة الحاضرة كجزء من تاريخ معركة الكلام الدائمة في ميتافيزيقا مفتوح. من هنا يحق لنا أن نشارك الشاعر في إثارة السؤال وتبادله: «أيُّ جدوى في تمام المعنى؟». إنه عدو القصيدة بمجرد أن يهدي القارئ. المعنى سراب. كلما يتقدّم، يتزايد اللبس.
IV
تعج قصائد أحمد الملا بأشياء صغيرة تلفت نظره: «لحاء الشجر، المَنْوَر الذي «يمتد ضوؤه في الغرف»، «الجدرانُ المهترئة/ ذات الغيران السوداء»، الشجرة التي «تشتاق للمطر وترفع المظلّة كلما أقبل»… أشياء، بل مشاهد عابرة تتلاحق لقفلة مطلوبة… هي، هنا، عين هواجسه، أحلام يقظة تفتح قلقًا عميقًا يجعل من الشاعر خيميائيًّا يقلّب «ألبوم غيابه» بعيدًا من رومانسيات الصحراء وبداوة التأثير والإقناع.
V
كل شاعر، من وقت إلى آخر، يشكّ، شرعيًّا، في الكلمات، ليس لأنها «انقلبت» عليه و«لم تعد ألیفةً مثلما التقاها في كتاب المطالعة» فحسب، بل لأنها باتت أيضًا عشبًا ضارًّا في رمل البيت. من هنا ينحو الشاعر إلى تبطين قصائده بغنائية مضادة لازمة لاكتشاف اللغة؛ لتجديد الإدراك المندحر بهزة تركيبية عَلَّ «مفتاح ينزلق من تحت الباب»، وينفتح الكون.
VI
بصفتها «قطعة من مشقة الطريق»، قصيدة أحمد الملا
«محفورة في نَفَس بطيء
لا اليأس فأسها
ولا مثقابُها الألم»
بل صدفة اللغة بَوصلتُها في رحلتها إلى المركز.
VII
المتنافر متزامن كما في نظرية الحلم الفرويدية حيث القصيدة رغبة مقنعة. الشاعر يمشي في الليل، يخاطب كائنه الداخلي، «يرفع الموسيقا فوق كتفيه» فـ«يأتي الكون مقشعرًّا». شعر أحمد الملا فعلٌ مُستغرِقٌ.
باريس/ ديسمبر 2020م

تحويل القصيدة إلى وسيط مرئي
ميساء الخواجا – ناقدة سعودية
غالبًا ما يتوجه الحديث عن وجود علاقة مفترضة بين الأدب والسينما إلى الرواية من حيث وجود ملامح يمكن أن تشكل نقاط التقاء بين هذين الخطابين، فكلاهما يسرد حكاية بطريقة ما، وكلاهما يروي أحداثًا في الزمان والمكان. ولعل ما يبرر الحديث عن مثل هذه العلاقة ما مر به تاريخ السينما من تحويل عدد من الأعمال الروائية إلى أفلام سينمائية لاقت رواجًا ونجاحًا ملحوظًا، غير أن مثل هذه الثقة قد تتزعزع إذا ما انتقلنا إلى خطاب أدبي آخر هو «الشعر»، فقلة هم الذين تحدثوا عن ذلك حيث تظل العلاقة بين الشعر والسينما علاقة ملتبسة نظرًا لاختلاف المرجعيات، واختلاف آليات التصوير والمكونات الفنية التي يعتمد عليها كل منهما.
وينطلق الباحثون في هذه العلاقة من رؤية دارسي السينما لطبيعة هذا الفن، فالسينما لها مدى تعبيري غير اعتيادي؛ إذ تشترك مع الفن التشكيلي في حقيقة كونها تشكيلًا مرئيًّا يسقط على سطح ذي بعدين، ومع الرقص في قدرتها على معالجة الحركة المنسقة، ومع المسرح في قدرتها على خلق كثافة درامية لأحداث، ومع الموسيقا في قدرتها على التأليف في إطار الإيقاع والجمل الزمنية، ومع الشعر في قدرتها على وضع الصور بعضها إلى جانب بعض، ومع الأدب –في أشكاله كافة– في قدرتها على الإحاطة بالتجريد المعروف في اللغة عمومًا(١).
إن الحديث هنا عن العلاقة بين الشعر والسينما لا يعني الحديث عن السينما الشعرية كما ظهرت في تجربة المخرج الإيطالي باولو بازوليني، أو في أعمال السينمائي الفرنسي جاك كوكتو وغيرهما. ولا يعني أيضًا الحديث عن القصائد التي اتخذت السينما موضوعًا لها، فتلك مسألة قديمة كما أشار إلى ذلك بعض الدارسين، فهي تمتد إلى عصر الفِلْم الصامت (1918-1930م) حيث كثرت القصائد الغربية التي تناولت ذلك الموضوع، كما كثر الشعراء الذين عبروا عن إعجابهم بهذا الفن، وظهرت في الشعر الفرنسي «القصيدة السينمائية» التي تؤمن أن السينما والشعر فنّانِ لا انفصامَ بينهما(٢).
ذلك كله يشير إلى وجود علاقة ما بين هذين الخطابين، لكن الحديث هنا سينطلق من وجود تأثير للسينما في الشعر قد يرتبط بوجود وعي لدى الشاعر بالسينما، وبأنه يحتكّ بأفقها الجمالي، ويستعير أدواتها التعبيرية الفنية. هذا الوعي الذي ارتبط بتغير جوهري في مفهوم «الشعرية» بدأ مع تيار الحداثة ورواد شعر التفعيلة في الشعر العربي، لكنه أخذ شكلًا أكثر عمقًا مع قصيدة النثر وروادها الأول، حيث تجاوزت القصيدة التصنيف الأجناسي الصارم، واتجه الشعراء صوب الانفتاح على الخطابات الأخرى –الأدبية وغير الأدبية– ليتسع فضاء الكتابة ويتفاعل اليومي بالذهني، والعادي بالمجرد، ويتفاعل البصري مع السمعي، وتدخل السردية والمشهدية وسمات الدراما إلى القصيدة في حوارية جدلية تفاعلية تعيد تأسيس مفهوم القصيدة والخطاب الشعري من جديد.
وكانت السينما أحد الخطابات التي تفاعلت معها القصيدة، ويرى محمد آيت ميهوب أن الأمر قد اتخذ في البداية مضمونًا أيديولوجيًّا عدّ فيه استحضار السينما عنوانًا للحداثة والتجديد، وقد راوَحَ ذلك بين الكتابة عن السينما والتغني بفضائلها، واستخدام تقنياتها في متن القصيدة، ومزج الخطاب الشعري بالخطاب السينمائي، ثم بلغ الحوار ذروته حين صار حوارًا أجناسيًّا، حين تُنشأ القصيدة بوصفها إعادة كتابة لفِلْم من الأفلام(٣). ومع تنامي تجربة الحداثة صار يمكننا ملاحظة المزيد من التعالق بين الشعر والسينما بحيث يحس المتلقي وهو يقرأ القصيدة أنه يشاهد فِلْمًا سينمائيًّا، حيث تستعير القصيدة عددًا من تقنيات السينما، فوظف الشعراء الأبعاد والأحجام في القصيدة، واهتموا بالديكور، وعملوا على رسم المشاهد في قصائدهم مستعملين التنويع في اللقطات بين سريعة وبطيئة، والمشاهد بين كبيرة وصغيرة، ومارسوا التقطيع الذي تستند إليه كتابة السيناريو، فصارت المقاطع الشعرية أقرب إلى مشاهد أو لقطات تبدو منفصلة في ظاهرها، لكنها تخدم رؤيا الشاعر عند إعادة تركيبها في مشهد أو صورة كلية كبرى(٤).
يكتب أحمد الملا قصائده بوعي سينمائي واضح، ويُظهِر في عدد من نصوصه تعالقًا مع السينما بتقنياتها المختلفة، فنرى المشهدية وتقطيع القصيدة إلى مشاهد متفرقة، كما نرى تتابع اللقطات البصرية وتنويع اللقطات، إضافة إلى القطع والتقسيم وتوظيف المونتاج. ونرى أيضًا عين الكاميرا وهي تجول بالقارئ بين المشاهد، فتلتقط التفاصيل والصور البصرية، تتجول في الفضاء وتصوره من زوايا مختلفة، في حين تبدو قصائد أخرى أشبه بفِلْم قصير مكتمل العناصر. هذا الحوار السينمائي الشعري يمتد على مدى تجربة أحمد الملا، وسنقف هنا على نماذج منها وعلى بعض ملامح هذا الحوار من خلال سمة عامة كبرى هي «المشهدية» التي تتجلى في ملامح منها:
التقطيع والمونتاج
لعل من أهم السمات التي يمكن ملاحظتها في عدد من قصائد أحمد الملا تبنيها لأسلوب المونتاج، حيث تتركب القصيدة من مجموعة من المقاطع التي تبدو منفصلة ظاهريًّا لكنّ خيطًا ما يجمعها لِتُشكّل في النهاية مشهدًا أو فِلْمًا متكاملًا إن صح التعبير. ومن المعروف أن المونتاج يقوم أساسًا على لصق اللقطات الفِلْمية وعناصر الترتيب الصوتي حسب الترتيب الذي يريده المخرج، حيث يُقطَّع المشهدُ -في البداية- لقطاتٍ من مختلف وجهات النظر، وهو ما يقيم علاقات سيميائية وشكلية بين تلك اللقطات، وتغيُّر تلك اللقطات يوجّه فهمَنا للمشاهد كما يشدّ بنية العمل ويجمع بين أجزائه(٥).
وتبدو هذه التقنية واضحة في كثير من قصائد الملا، ومن ذلك «تمثال الشاعر» حيث يتكون النص من مجموعة من المشاهد التي ترصد من خلال عيني التمثال التي تتجول في المكان وتلتقط تفاصيله. ويبدأ المشهد الأول بلقطة عامة للحديقة، فتتحرك الكاميرا من الخارج إلى الداخل «حظي قليل/ مع الناس/…/ لي حديقة أفكار/ مهجورة/ يتراقص فيها جن وأبالسة/ هكذا يخيف الجيران أطفالهم/…/ وفي الليل يهمسون قبسًا من ناري/ في جوف عشيقاتهم)(٦). يطرح المشهد الأول العلاقة الملتبسة بين الشاعر والناس، علاقة خوف وحب تبرر إحساسه بقلة حظه كما تبرر وحدته، والمشهد داخلي يحضر فيه الآخرون عن بعد، وتحضر رؤيتهم التي لا تستطيع تفسير عبقرية الشاعر وعبقرية الخيال، فيتحول تمثال الشاعر إلى فزاعة يخيف بها الجيران أطفالهم، لكنّ نوعًا آخر من البشر يعترف بتفرده فتصير كلماته قبس نار يضيء لحظات العشق.
 يأتي المشهد الثاني استمرارًا لتلك العلاقة الملتبسة وللحركة الداخلية نفسها، فيبتدئ باللقطة الافتتاحية نفسها «حظي قليل» لكن تلك العلاقة تنفتح زمنيًّا إلى ولادة الشاعر في غير زمنه، وتقدم إضاءة أخرى حول رفضه وجحود عمله «فكلما أعلنت ولادة شجرة/ رجمتُ بأحجار مقلوعة من سوري/ يتشهون وردي/ ويوغرون صدر النهر…»(٧).
يأتي المشهد الثاني استمرارًا لتلك العلاقة الملتبسة وللحركة الداخلية نفسها، فيبتدئ باللقطة الافتتاحية نفسها «حظي قليل» لكن تلك العلاقة تنفتح زمنيًّا إلى ولادة الشاعر في غير زمنه، وتقدم إضاءة أخرى حول رفضه وجحود عمله «فكلما أعلنت ولادة شجرة/ رجمتُ بأحجار مقلوعة من سوري/ يتشهون وردي/ ويوغرون صدر النهر…»(٧).
لكن المشهد يوسع اللقطة فيتحول إلى مشهد خارجي تتحرك فيه عين الكاميرا ملتقطة تفاصيل المكان عبر عيني التمثال، وتجعلنا نرى ما تراه، وتتفق التفاصيل مع المقدمات الواردة في المشاهد الافتتاحية، فهي مليئة بالوحشة وغياب الآخرين وغياب أية فاعلية بشرية «أبواب حديقتي سبعة مشرعة على العشب/ شجر مصطف/ ورود مائلة من قلة القاطفين/ كرسي طويل قوسه غيابهم/ وها أنا في آخر الحديقة/ واقف/ بخطوة متقدمة عن صف الشجيرات العتيقة/…/ عيناي على الأبواب المخلعة/ ويداي يبستا في الهواء من شدة الشوق/ أعشاب هوجاء تطاولت/ ريش على كتفي/ ودرف طيور مهاجرة/ لطخت معدني»(٨)، تتحرك الكاميرا من الخارج إلى الداخل تدريجيًّا، من الأبواب إلى الشجر، ثم الورد والكرسي، لنصل إلى آخر الحديقة في لقطة مقربة، تركز على تفاصيل التمثال: وقفته، خطوته، العينان، اليدان، ثم لقطة عامة له وقد غطاه الريش ومخلفات الطيور.
ومع اقتراب الكاميرا يطرح النص الانفعالات الداخلية للتمثال، فيتواءم الداخل مع الخارج ليعمق معاني الوحشة والإحساس بالهجر والتخلي. ثم ترتبط المشاهد كلها في المشهد الختامي فينتهي النص كما ابتدأ بصوت الشاعر، ليعلن عن سر الوحشة وعن خيانة الأصدقاء والمقربين.
التفاصيل وعين الكاميرا
تقوم تقنية عين الكاميرا على مرافقة آلة التصوير لعيني الممثل فينتقل معه المتفرج وينفعل لانفعالاته(٩)، وهي من التقنيات الحاضرة بقوة في النصوص الشعرية، حيث يمكن أن نرى ما يشبه الكاميرا التي يقوم فيها الشاعر بدور المخرج، فيجعلنا نرى ما نراه متحكمًا في حجم اللقطات وزواياها.
ومن ذلك ما نراه في نص «أرداني بسهمه» حيث تتشكل التفاصيل من خلال عيني الفريسة والصياد «شد قوسه/ وصوب عينيه إلى قلبي/ مال برأس تقيس المسافة/…/ تلاقت نظرتانا/ وحزنت مثل بغتة الغزال»(١٠)، يبدأ النص/ المشهد بالفعل الحاسم/ الاستعداد للصيد «شد قوسه» وتتابع الكاميرا التفاصيل الدقيقة حيث يعتمد النص على صور بصرية، وعلى توالي الأفعال التي تعطي حركية واستمرارية في الفعل (صوب، مال، حط)، ثم يتوقف الزمن للحظات، هي لحظة المواجهة لتنتقل منها إلى رصد رد فعل الراوي/ الفريسة من دون أن تنقل لنا ملامح الصياد «حزنت مثل بغتة الغزال»، وفي هذا الحزن تمهيد لما سيأتي «فعل القتل».
يستثمر الشاعر بياض الورق وكأنه أشبه بعملية قطع زمني وتركيب لمشهد آخر، حيث تنتقل الكاميرا إلى اللحظة الثانية في لقطة مقربة تركز على ملامح الصياد «جسده مشدود/ أصابعه مفتولة/ رعشة مؤجلة/ تحين اللحظة/ وبغمضة عينه الأخرى/ أطلق كمانه/ وأرداني»(١١). يركز النص من خلال عيني الراوي/ الفريسة على ملامح الجسد الخارجية ليؤكد تأهُّبَ الصيادِ، ثم تقترب الكاميرا في لقطة مقربة جدًّا «أصابعه مفتولة» لتبرر لنا رد فعل الفريسة وخوفها.
وعبْر الجمل القصيرة المتلاحقة التي تكاد تقترب من لقطات سينمائية قصيرة متتابعة؛ نَصِلُ إلى اللقطة الختامية والصياد قد أردى فريسته. لكن النص يحمل انحرافًا لفظيًّا يفتح الدلالة «أطلق كمانه» فيحل الكمان محل القوس، ويُربط بين وتر الكمان ووتر القوس، لتنفتح الدلالة وتتغير دلالة القتل ليصير قتلًا مجازيًّا مرتبطًا بالموسيقا وتأثيرها في الراوي، فالصياد هو العازف والفريسة هي المستمع الذي يقع تحت هيمنة العازف وفتنة الموسيقا، وكأنّ السماع والوجد شكلانِ من أشكال الموت.
تتابع اللقطات بأنواعها
يقوم الفِلْم السينمائي على وضع سيناريو تَتتابَعُ فيه عدد من اللقطات وتتنوع ما بين لقطات داخلية وأخرى خارجية؛ لقطات مكبرة وأخرى مصغرة، وما إلى ذلك من تهيئة المشهد والديكور تبعًا للهدف الذي يرمي إليه الكاتب/ المخرج(١٢). يكتب أحمد الملا النص أحيانًا وكأنه فِلْم قصير أشبه بلقطة واحدة كما في نص «حقيبة»(١٣)، الذي يقدم مشهدًا بصريًّا تجول فيه عين الكاميرا في رؤية مسحية تلتقط ملامح الحقيبة وتفاصيلها.
أو في نص «حراس النوم» الذي يلتقط تفاصيل الأب/ الشجرة الذي يحرس نوم بنيه «ألمحه جالسًا/ في صحن البيت/ غارسًا كوعه في فخذين تحرث كعبهما الأرض/ رأسه بين كفيه/ وعيناه مصوبتان إلى نقطة لا تجف من الخوف/ الغرف تغط في سبات يوشك أن ينفض/ والليل يكاد أن ينجلي»(١٤)، يقدم النص مشهدًا بصريًّا بلُغة محسوسة، تلتقط تفاصيل جلسة الأب، ويبدأ بلقطة عامة موسعة تحدد المكان والجلسة، ثم تقترب أكثر لتلتقط هيئة الجلسة، ثم تقترب أكثر لنرى رأس الرجل بين كفيه، وفي لقطة مقربة جدًّا إلى العينين، بعدها تبتعد الكاميرا تدريجيًّا لتعطي لقطة موسعة عن المكان والزمان. يلتقط الشاعر التفاصيل في مشهد أقرب إلى فِلْم صامت نتابع فيه تعب الأب وعلاقته بأبنائه وخوفه عليهم، فهو الأب الشجرة؛ ثابت وراسخ في الأرض كما هو في حياة أبنائه.
يقوم الشاعر في نص «بوسطن طفل تائه» بدور المخرج الذي يبتكر أماكن الصور، ويركب اللقطات ويصنع لكل مشهد بطلًا، فهذا النص عبارة عن لقطات قصيرة، سريعة ومتلاحقة لملامح وأماكن مختلفة تشكل في مجملها صورة عامة للمدينة، وكأن كل لقطة تستقل بذاتها، ومن هنا هيمنت الجمل الاسمية على النص، حيث تبتدئ الجمل غالبًا بأشخاص يحددون منذ البداية محور المشهد ومركزه (الطائرة، عامل النظافة، سائق الباص، الفتاة، حامل الحقائب، العجوز، الممثلة، الأطفال، الجنازة، القطار، النهر…) «عامل النظافة الذي جرف ما تبقى من ثلج البارحة وكومه جانبًا/ سائق الباص بتحية كفه السمراء للغريب على الرصيف المقابل/…/ حامل الحقائب الذي قدم نفسه مرتين بلا ضرورة بأنه من النيبال/ عازف الناي تحت الأرض»(١٥)، ويستمر النص في مثل هذه اللقطات المتتابعة التي تنتقل في الزمان والمكان، فتتفكك الصورة إلى قطعة موزاييك فيما يعرف بالمونتاج القصير(١٦)، الذي يقوم فيه القارئ بتجميعها في النهاية ليصل إلى المشهد الكلي الأكبر الذي يشكل المدينة.
هكذا تطرح نصوص أحمد الملا مسألة العلاقة بين الشعر والسينما بوضوح، حيث يتحول الشاعر إلى مخرج وكاتب سيناريو يُقطِّع اللقطات ويُركِّب المشاهد ويلتقط التفاصيل لتقترب مجموعة من نصوصه من نظام التكوين السينمائي، فتتحول القصيدة إلى وسيط مرئي ينقل لنا حركة الكاميرا وهي تتبع المشاهد وتلاحقها، ليجمعها القارئ في صورة كلية ومشهد نهائي كبير يرتبط برؤيا الشاعر وموقفه من الحياة والوجود.
هوامش:
(١) انظر، بشرى البستاني، جماليات السينما في الشعر، سيناريو كاظم الحجاج أنموذجًا، مجلة رسائل الشعر، ع 2، إبريل 2015م، ص 61-71 www.poetryletters.com/mag
(٢) انظر، محمد آيت ميهوب، التداخل بين الخطاب الشعري والخطاب السينمائي في نماذج من الشعر العربي، أفكار (الشعر والسينما)، ص 21، 22 www.culture.gov.jo
(٣) انظر، محمد آيت ميهوب، التداخل بين الخطاب الشعري والخطاب السينمائي في نماذج من الشعر العربي، ص 26، 29، 30
(٤) حول هذا الأمر، انظر، المصدر السابق، ص 23، بشرى البستاني، جماليات السينما في الشعر، زينب دريانورد، رسول بلاوي، علي خضري، البنية السينمائية في شعر عدنان الصائغ، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، ع 43، نيسان 2019م، 791 وائل عيسى، التكوين السينمائي للصورة الشعرية، أفكار (الشعر والسينما)، ص 31 www.culture.gov.jo ، محمد طه العثمان، سينمائية اللقطة الشعرية، أفكار (الشعر والسينما)، ص 39، 40 www.culture.gov.jo
(٥) حول المونتاج ودوره انظر، ماري تيريز جورنو، معجم المصطلحات السينمائية، إدارة ميشيل ماري، ترجمة فائز بشور، ص 68، 69، محمد آيت ميهوب، التداخل بين الخطاب الشعري والخطاب السينمائي في نماذج من الشعر العربي، ص 27.
(٦) أحمد الملا، إياك أن يموت قبلك، منشورات المتوسط، ميلانو، 2018، ص 3.
(٧) أحمد الملا، إياك أن يموت قبلك، ص 3.
(٨) المصدر السابق، ص 3، 4.
(٩) انظر، محمد آيت ميهوب، التداخل بين الخطاب الشعري والخطاب السينمائي، ص 28، 29، وائل عيسى، التكوين السينمائي للصورة الشعرية، ص 33، 34.
(١٠) أحمد الملا، يوشك أن يحدث يليه مرآة النائم، مسكلياني، تونس، ط1، 2020م، ص 47.
(١١) أحمد الملا، يوشك أن يحدث يليه مرآة النائم، ص 47، ويمكن أن نرى مثل هذا أيضًا في (أتلو أسماءهم) الذي يبدو أشبه بفِلْم قصير متكامل، ص 35.
(١٢) انظر، ماري تيريز جورنو، معجم المصطلحات السينمائية، ص 34، 35، زينب دريانود وآخرون، البنية السينمائية في شعر عدنان الصائغ، ص 749.
(١٣) أحمد الملا، إياك أن يموت قبلك، ص 24، وانظر أيضًا «قهوة مرة»، ص 45، 46.
(١٤) أحمد الملا، علامة فارقة، مسعى للنشر والتوزيع، البحرين، ط 1، 2014م، ص 20.
(١٥) المصدر السابق، ص 42، 43 ويمكن ملاحظة مثل هذه اللقطات السريعة في نص «يوشك أن يحدث»، يوشك أن يحدث ص 125.
(١٦) حول هذا المصطلح وأنواع المونتاج، انظر، ماري تيريز جورنو، معجم المصطلحات السينمائية، ص 70.

معترك الكتابة.. برية الوجود
بنعيسى بوحمالة – ناقد مغربي
– 1 –
بمنأى عن المتطلّب الإبستيمولوجي، الذي لا فكاك منه، عند أية مطارحة فكرية لماهية الحداثة، مثلما تبلورت في السياق التاريخي والمجتمعي والثقافي الغربي، الحداثة التي تخلقت في ثناياها خبرة شعرية، تكاد تكون نسيج وحدها، كتلك التي أبان عنها الشاعر الفرنسي آرثر رامبو، الذي سيطلق، من فرط عقيدته الحداثية الوثنية أو تكاد، صيحته المزلزلة: «يلزم أن نكون حداثيين عن الآخر». الشاعر الذي ستبلغ معه قصيدة النثر مرقى لا يضاهى مجنحًا، هكذا، بمسعى كتابيّ كان قد دشنه في الشعر الأنغلو – أميركي، والت ويتمان، تحت مسمى الشعر الحر، بديوانه «أوراق العشب» (1855م)، وفي الشعر الفرنسي كل من ألويزيوس برتران، بديوانه «جرذ السفائن الليلي» (1842م)، وشارل بودلير بديوانه «قصائد نثر قصيرة» (1869م).
إذن بمنأى عن هذه الحيثيات، وأيضًا خارج المعادلة الملتبسة: حداثة/ تحديث لربما يستقيم، في تفكيرنا وتحليلنا، الحديث عن قصيدة النثر العربية، المستجلبة، على الغرار من أشكال تعبيرية أخرى لم تنتجها الثقافة العربية، كالرواية والقصة القصيرة والمسرح والسينما والفيديو آرت…؛ شأنها شأن ثقافات المحيط الحضاري، بتعبير الاقتصادي المصري سمير أمين، المحكومة باستجلاب ابتكارات العقل والمخيلة الغربيين.
توطدت قيم الاستنارة والتقدم والحرية في الواقع الغربي، فكان على القصيدة الغربية أن تجعل من النثر قاعدتها الأدائية تناغمًا منها مع ما طال الواقع المذكور من متغيرات هائلة ستمس الأفكار والأشكال، من تشظيات، إن لم نقل انتثارات، لا عهد لأزمنة العتاقة بها. على أن رحابة صدر الحداثة الغربية إزاء النزوعات التجديدية، مقارنة مع الوضع الثقافي العربي، لم تزح، بالمرة، بقايا النزوعات التقليدية المترسبة في اللاوعي الجمعي، ومن ثم لا غرابة في أن تعد الأدبيات الأميركية والت ويتمان مفكرًا وفيلسوفًا، بل مهرطقًا، أكثر منه شاعرًا، دليلًا على جسامة الإرباك الذي يمكن أن يستثيره شكل شعريّ يتمرد على نواظم التقليد الشعري، بحيث لم يلتقط أهمية تجديده سوى الناقد الأميركي والدو إمرسون، وأن يصبح شارل بودلير محط تحرش قضائي كنوع من رد فعل للمتخيل الثقافي الجمعي تجاه إبدال كتابي جذري يحطم الحدود بين الشعري والنثري، نحو جمالية تخييلية تحط، في الحالة البودليرية تخصيصًا، من مهابة القيم والأخلاقيات المتواطأ عليها.
إن المأزق المؤرق الذي سيواجهه بودلير لهو مأزق اللغة الشعرية المستوجبة في كنف الزمن الحديث والقادرة على اقتطاف ثمرات ما عدَّه خطيئة الرقي الغربي العارم. فاللغة بقدر ما هي امتياز للشعر تلوح، في العمق، بمنزلة عائق تعبيري، بَلْهَ مانع لتحقيق منسوب عالٍ من الأيقونية التي تنتفي معها ثنائية الشكل والمضمون، أصلًا، وهي الأيقونية التي وفقت إليها مخيلات الرسامين، توسطًا باللون، والموسيقيين، توسلًا بالصوت، ومن هنا دعوته، كما هو معروف، إلى التلمذة المواظبة على منجزات الرسامين والموسيقيين.
إن حرب الشاعر، شبه المقدسة، تكون ضد منظومة السلط المختلفة، ولأن أيّما سلطة كانت إلا تمرّر، على نحو ما يقول الناقد البنيوي الفرنسي الذائع الصيت، رولان بارت، خطابها الذي يتنفذ في الذهنيات والنفسيات، أو، بالأصح، طاغوتها عبر اللغة، فإن هذه الحرب تجري، أساسًا، في فضاء اللغة بما هي موئل التواريخ والإرغامات والاستيهامات والرمزيات، وبالتالي، ليس الأدب، ومنه الشعر، أكثر من لعب راقص، ماكر، بالعبارة النيتشوية الشهيرة، لكنه لعب خلّاق غايته بلبلة اللغة السلطوية، إرباك طمأنينتها والتشكيك في وثوقيتها.
من هذا الضوء يمكننا التأشير على ولادة قصيدة النثر في الثقافة الغربية بوصفها ممكنًا لتعبير شعري تجريبي(١) عماده الكثافة والمجانية والإيجاز والحكي والمفارقة والإيقاع الداخلي، وفقًا لرأي المُنظّرة الفرنسية الرائدة سوزان برنار، تعبير ستنضوي إلى مداره أجيال من الشعراء الغربيين الذين سيكرسونه مردفين إليه، عبر الحِقَب، قيمًا مضافة على مستوى الشكل والموضوع كليهما. فمن شارل بودلير، آرثر رامبو، إيزودور دوكاس لوتريامون، ستيفان مالارميه… إلى الدادائيين والسرياليين وما بعد الحداثيين، مثل: فرانسيس بونج، ويوجين غيلليفيك، وجاك آنصي… في الشعر الفرنسي… من والت ويتمان، عزرا باوند، ويستان أودن، شيموس هيني، سيلفيا بلاث، تيد هيوز، وجيل البيتنيك.. في الشعر الأنغلو- أميركي.. إلى شعراء آخرين من جغرافيات شعرية مختلفة، وذلك من مثال الروسي فيليمير خليبنيكوف، والألماني- الروماني بول سيلان، والإغريقي يانيس ريتسوس، والتشيكي ياروسلاف سيفرت، والسويدي توماس ترانسترومر، والصيني بي ضاو.. على يد هؤلاء وغيرهم ما كان لقصيدة النثر سوى أن تهيمن على نشاطية الكتابة الشعرية في الآداب الوطنية كافة منحية جانبًا بقية الطرائق الصياغية المعتادة.
قصيدة النثر والتزيد النقدي
على أن السيرورة المديدة التي ستستغرقها ولادة قصيدة النثر في الثقافة الغربية، أي ما يقارب القرنين، لن تقتضي في الثقافة العربية سوى قرابة ستة عقود، وذلك بين استتباب نموذج الإحياء وظهور الموجة الرومانتيكية وصولًا إلى قصيدة التفعيلة فقصيدة النثر، وهي وتيرة مفهومة لسائر الثقافات الواقعة موقع تأثير. هكذا سيتسع، عند نهاية خمسينيات ومطلع ستينيات القرن العشرين، المشهد الشعري العربي المعاصر لهذا الوليد الجديد لتبدأ في التواتر قصائد ودواوين ومتون تصب، إجمالًا، في رصيد كتابي لَمّا يزل قيد التنامي وتتناوب على إنضاجه وتصليبه أجيال من الشعراء في مختلف الأقطار العربية.
وعليه فليس أكثر من تزيد نقدي الارتجاع، مثلًا، بإرهاصات قصيدة النثر العربية إلى مظانّ تراثية، كنصوص المتصوفة وكتابات أبي حيان التوحيدي، أو إلى التماعاتها القريبة، على شاكلة ما تغري به كتابات اللبنانيون؛ أمين الريحاني وجبران خليل جبران ومي زيادة، والعراقيون، روفائيل بطي وحسين مردان، والمغربي محمد الصباغ، والسعودي محمد حسن عواد، ما دمنا قد نتنصّل جهارًا، والحالة هذه، من مجمل الاشتراطات التاريخية والثقافية التي اقتضت ولادتها في التوقيت المومأ إليه بما يضفي على هذه السوابق صفة الماقبلية أو الجنينية، وهو ما لا نعدم له نظائر في سائر الثقافات، وحسبنا ألا نأخذ في الحسبان، في هذا المقام، ما عدا محاولات معدودة، تمتلك نزرًا من الصدقية المعيارية، كتلك التي تُعرِب عنها القصائد المدورة لكل من أدونيس وخليل الخوري، مسبوقين بالشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر، وحيث يجري تدبر النسغ النثري في سياج التفعيلي، تدبر تدعمه تربية عروضية مكينة مع انفتاح إيقاعي مرن.
منذ ستة عقود، إذن، التأمت، إن شئنا، خارطة طريق قصيدة النثر العربية وطوال هذه الطريق أمكن لأسماء وتجارب أن تشكل محطات بارزة أثمرت منها هذه القصيدة إضافات واجتراحات لسوف تثبت مشروعيتها وتوسع من نطاق تلقيها، وكذا اقتحامها للمحافل الأكاديمية والإعلامية، كما أمكنها دحض الفكرة القائلة بأنه «… لئن سلم المرء بأن الوزن شرط أساسي من شروط الشعر فإن قصيدة النثر بفقدانها الوزن تفقد ذلك الشرط فقط، أي تفقد شرطًا واحدًا، ولكنها لا تفقد كل الشروط، والعمل يقيم بما توافر فيه من شروط لا بما غاب عنه، بل قد يعوض عن فقدان شرط بتحقيق شروط أخرى، وخير مثال على ذلك الكفيف، فهو لا يفقد شرط وجوده، ولا يفقد حقه في الحياة والعطاء والإبداع، ولا يقيم بما فقد، بل بما عوض عن ذلك الفقد، وكثيرًا ما يقدر ببصيرته أكثر مما يقدر به المبصرون»(٢).
فلقد كانت المحطة الأولى مدخلية، أو استهلالية، بقوة الأشياء، تتغيا إرساء الأسس والدعائم البنائية الأولية أكثر من انشغالها برفاه تجريبي ما خصوصًا في واقع ثقافي عربي مُجافٍ لقصيدة التفعيلة فما بالنا بقصيدة النثر، لكن حالما نجح الرعيل الأول(٣) في استنباتها في التربة الشعرية العربية، سواء من والى من شعرائه النموذج الأنغلو- أميركي، كتوفيق صايغ وجبرا إبراهيم جبرا…؛ (فلسطين)، وسعدي يوسف…؛ (العراق)، أو انحاز إلى النموذج الفرنسي، كأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا…؛ (لبنان)، ومحمد الماغوط وأدونيس…؛ (سوريا)، لن يحجم الرعيل الثاني، ومن شعرائه صلاح فائق وسركون بولص وفاضل العزاوي ومؤيد الراوي وجليل حيدر وعبدالقادر الجنابي…؛ (العراق)، عن ركوب رهان التجريب، إن شكليًّا وتخييليًّا أو موضوعاتيًّا ورؤياويًّا، مفسحًا، على هذا المنوال، المجال لما يمكن احتسابه رعيلًا ثالثًا، تأتلف في دائرته أسماء من بينها حلمي سالم وعبدالمنعم رمضان ورفعت سلام وفريد أبو سعدة…؛ (مصر)، وبسام حجار وعباس بيضون ووديع سعادة وعقل العويط وبول شاوول وعيسى مخلوف وعبده وازن…؛ (لبنان)، وسليم بركات ونوري الجراح ومرام المصري…؛ (سوريا)، وأمجد ناصر…؛ (الأردن)، وقاسم حداد…؛ (البحرين)، ودنيا ميخائيل…؛ (العراق)، وظبية خميس…؛ (الإمارات)، وسيف الرحبي وزاهر الغافري…؛ (عمان)، ورعيلا راهنا هو من يأخذ بزمام هذا المشروع الإبداعي حافرًا، بدوره، بصمته النوعية الممهورة بتصوراته الإبداعية والمحكومة بأسباب مَعِيشِهِ المتوتر بأثر من ضغط وضع عربي مأزوم ومعاد للحرية، وكذلك بإغواءات زمن معولم عن الآخر انمسخت فيه الكرة الأرضية إلى مجرد قرية صغيرة، بتعبير السوسيولوجي الكندي مارشال ماكلوهان، بما يتصاعد معه هاجس الحداثة، لا الحضارية ولا الشعرية، «… وهذا يعني أن الحداثة انخراط في التاريخ، وأنها كتابة تضع هذا التاريخ موضع تساؤل، وذلك ضمن حركة دائمة من استكشاف طاقات اللغة، واستقصاء أبعاد التجربة»(٤)، ومن شعرائه لنا أن نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، كلًّا من مبارك وساط ومحمد الصالحي وفاطمة الزهراء بنيس…؛ (المغرب)، ونصيرة محمدي…؛ (الجزائر)، وآمال موسى وعبدالفتاح بنحمودة…؛ (تونس)، ومحمود قرني وسمير درويش وجرجس شكري وإيهاب خليفة وغادة نبيل وإيمان مرسال…؛ (مصر)، وعبدالزهرة زكي وباسم المرعبي…؛ (العراق)، ولينا الطيبي وحسين حبش وخلات أحمد…؛ (سوريا)، وزكريا محمد وغسان زقطان…؛ (فلسطين)، وميسون صقر…؛ (الإمارات)، وفوزية أبي خالد ومحمد الدميني وغسان الخنيزي وإبراهيم الحسين وهدى الدغفق وأحمد الملا…؛ (السعودية).
ومما لا شك فيه أن انضواء الحركة الشعرية، في منطقة الخليج عامة، والسعودية خاصة، إلى الدينامية الحداثية الشاملة التي يعيشها الشعر العربي لشيء خليق بالانتباه، بل الاعتناء، ما دام الأمر يتعلق بإقليم عربي ما برحت فيه سلطة الاتباع الشعري نافذة، لاعتبارات تاريخية وثقافية وقيمية، تكيف الذائقة الجمعية التي تجد نفسها في النموذج الشعري العمودي، المجلجل، والمستثير للمشاعر والانفعالات. هذا وإذا ما كانت قد تهيأت عوامل متراكبة، محلية وعالمية، لانفتاح التفكير الشعري في هذا الإقليم على هبات التجديد القادمة، سيان من الشعريات العربية المجاورة الرائدة، وتحديدًا من مراكزها التاريخية كالقاهرة وبيروت ودمشق وبغداد، أو من الشعريات العالمية التي تتوزعها مختلف القارات، فلا مناص من الإقرار، فيما يمس الحركة الشعرية في السعودية، بالدور الفعال الذي سيلعبه شاعر لم تنقصه الجرأة على خلخلة بنيان النص الشعري الناجز ومراهنته، بالتالي، على أفق حداثي يجدر بهذا النص استشرافه والكتابة والتخيل صدورًا عنه وليس عن غيره. نقصد، بطبيعة الحال، الشاعر محمد الثبيتي الذي لا مبالغة في قولنا بأن الشعراء الجدد الطليعيين لسوف يخرجون من معطفه، تشبهًا بانسلال الرواية الروسية من معطف نيكولاي غوغول كما يرد في التخريج المأثور، وحالما تموقعوا، عن استحقاق، في المشهد الشعري السعودي حتى انخرطوا في جهد جمعي حثيث يمس بنية القصيدة كما يمس محمولها، وبتعبير آخر فقد جعلوا من «… التحولات على المستوى الجمالي تتواشج مع تحولات على المستوى الرؤيوي الذي يستقطب التجارب الشعرية الجديدة في مسارات تفاعلها مع الحياة؛ إذ برزت رؤى جديدة تتصل بعلاقة الإنسان بذاته وأسئلته (…) رؤى تتعلق بتشظي الأنا، وشعوره بالغياب في اللحظة المعاصرة»(٥)، وهي المشاغل الإبداعية- الأنطولوجية التي تهجس بها أيّما عقيدة حداثية مترسخة.
ولعل وقفتنا على تجربة الشاعر أحمد الملا لا تشكل فقط استنصاتًا، من نوع ما، لصوت أحد ألمع شعراء جيله في الشعرية السعودية، الذي يكتب قصيدته انطلاقًا من وعي إبداعي- أنطولوجي حادّ ومنتج، بل وجسا، في الآن عينه، لنبض أو ذبذبة مشروع شعري جمعي تتآزر في مربعه أصوات أخرى ساعية إلى الاستعاضة عن الصورة النمطية التي استقرت عن القصيدة السعودية من حيث كونها، موقوتة، وبالمطلق، على التراث الشعري العربي بنكهة أخرى لحساسية شعرية لا تقل فطنة ومثابرة عما هو قائم في أقاليم عربية أخرى، حساسية منخرطة في راهنها ولا تني مكبة على اجتراح تخييل شعري من الثراء بمكان.
ومنه فنحن، في حالة أحمد الملا، بإزاء شاعر يأخذ نصه مأخذ مسؤولية، معرفية ووجودية، ولا يتورع عن تغذية مخيلته بقطوف من اهتماماته الشعرية والسينمائية والتشكيلية والموسيقية…؛ بما يماثل صنيع قامات شعرية غربية ارتسمت وضعيتها الاعتبارية بناءً على تعدد اهتماماتها، وهو ما ينعكس، ما في ذلك ريب، في منتسج نصه هذا ويراكب، كنتيجة، أصعدته ومراقيه فاتحًا إياه على تأولات متشابكة ولا نهائية. هكذا، وبالموازاة من إصداراته الشعرية، التي تتعدى عشرة عناوين، والتي تواترت لما يناهز العقدين، ومن بينها «ظل يتقصف»، «سهم يهمس باسمي»، «تمارين الوحش»، «ما أجمل أخطائي»، «فهرس الخراب»….؛ سيقوده شغفه بما هو بصري إلى السينما ليس كمحض متفرج أو هاوٍ، وإنما كفاعل في المجال.
– 2 –
لنقل، بادئ ذي بدء، بأن اختيارنا لديوان «تمارين الوحش»(٦) ليمليه اعتبار إجرائي يأخذ في الحسبان القيمة الشعرية المتحصلة في هذه المحطة من مسار الشاعر وأيضًا ما كان من مردوده البنائي والتخييلي والرؤياوي في هذا المسار وذلك اقتناعًا منا بكون مجموع دواوين أيما شاعر إلا تقوم، أصلًا، مقام جملة شعرية واحدة، كما يذهب إلى ذلك الناقد الأميركي مايكل ريفاتير، تتنفذ في نشوئها وتدرجها، عبر دواوين- خبرات متعاقبة، نواة صلبة واحدة، مخصوصة ومتفردة، مستضمرة في لا وعي التجربة، وتنفتح، قوة وفعلًا، طوال سيرة الشاعر الكتابية، على متغيرات شكلية وجمالية وموضوعاتية محسوسة قد تأخذ ملمح قيم مضافة للنواة إياها أو، على العكس، شكل انحباسات أدائية، مردها إلى حيثيات لحظة الكتابة وأيضًا إلى طبيعة اللحظة التاريخية والثقافية، تمس، بهذه الدرجة أو تلك، فاعليتها وإشعاعها.
فالديوان، الذي يعنينا هنا يمثل زمنيًّا، إن وددنا، واسطة العقد في المتن الكتابي للشاعر، ولعل مقاربته، هو بالذات، قد تسعفنا على مقايسة منسوب ارتقاء مشروعه الشعري سواء بالنظر إلى منجزه السالف أو عند استحضارنا للأفق الذي سينتظم دواوينه اللاحقة حرصًا منه، كمطمح إبداعي، على تدريج جملته الشعرية ومدها، على التتالي، بلوازم نضوجها وتماسكها على أكثر من صعيد.
ولأن معترك الشاعر، الشاق، والمستلذ في آنٍ واحد، لهو، أساسًا، مع اللغة، وأيضًا لكون إبدال قصيدة النثر يشكل أحد انجلاءات هذا المعترك، في منحاه التصعيدي، تحرِّيًا عن عبارة لرؤيا شعرية لا تسعها اللغة المعجمية المقولبة والمبذولة، وذلك استئناسًا بغصة الصوفي محمد بن عبدالجبار النفري المريرة وهو يشكو شسوع رؤياه وضيق عبارته، لنا أن ندرك أن هذا الاحتراب الرمزي لا يرمي إلى الإعفاء القطعي من القاعدية اللغوية المسنونة، بحيث، وببساطة، «…لا تتم تنحيتها وإنما تفنيدها بقاعدة مستجدة بالأحرى»(٧)، وكيف ذلك وهي وسيلة الكتابة الشعرية التي لا مفر منها، بل إنه يرمي إلى إعادة تشييدها، إلى امتصاص ذرائعيتها الدلالية، وتلغيم خطيتها عن طريق الإعمال الاستعاري والمجازي والترميزي انتشالًا لها من حضيضها التعبيري.
في هذا المضمار، وإن نحن وضعنا طبوغرافيا الديوان الكلية موضع توصيف أو نمذجة، فسنلاحظ توزع قصائده بين نمط كتابي شذري يعتمد جملة شعرية وجيزة ومبرقة، وإلى هذا النمط تنتمي أغلبية القصائد، وآخر يوائم بين القصر والطول، مثال هذا قصيدتا «مهجة» و«بنت هواي»، وثالث أميل إلى الطول النصي قوامه جملة استغراقية على قدر من الامتداد مع استدعائه لحجوم أرحب، وتندرج في خطه قصائد: «الدون – لويس قونزاليس»، و«سر الخيزران»، و«النائم»، و«المنزل»، و«ليلتها»، و«ترفق بحجارتي أيها الجبل»، و«أكتب حكايتي»، و«أمحو الموت»، مردوفة بقصيدة «سبع حركات إحداهن مرتجلة»، ذات البناء المقطعي، سبعة مقاطع مرقمة، لنكون، هكذا، قبالة ثلاث هندسات نصية أو، بالأدق، ثلاثة أنفاس متضافرة، لا متنافرة، يستحكم فيها وازع التعبير الشعري محددًا المسافة التي قد تغطيها القصيدة وقد استنفدت موضوعها.
وبالداخل من هذه المسافة تنهض مدونة مفرداتية تستند عليها الوظيفة النصية(٨)؛ إذ تعتاش عليها القصائد، ومن خلالها يتأتى لها اصطناع طرزها الأسلوبية المعطاة، وكذا مساقاتها الدلالية والإيقاعية والاستعارية والحكائية الآيلة، رأسًا، إلى رؤيا تبثها، في الفضاء العام للديوان، أنا شعرية تنوب مناب الذات الشاعرة وتأخذ على عاتقها تسريب اختلاجاتها وابتلاءاتها في رحاب محفل وجوديّ شرس ومعاد، أقرب إلى برية رمزية منه إلى مهاد يبعث على الإيناس والألفة.
وبتقرينا لمكونات هذه المدونة نلاحظ مدى هيمنة مفردات بعينها على المنتسج النصي، بحيث يتكرر حضورها في أكثر من قصيدة، الشيء الذي يلزم القراءة بالتساؤل عن مغزى هذا الحضور وكذلك عن حدود تكييفه للاقتصاد الدلالي، من ناحية المبدأ، والإيقاعي والاستعاري والحكائي، ضمنيًّا. كذا تحضر، وبقوة، المفردات التالية: «الليل»، كقرينة لزمن تخومي، مضاد لنهارية العالم المتبلدة، وحيث يتاح، في تضاعيفه، للمخيلة أن تستبصر ما لا تقتدر على استبصاره الأعين المبحلقة للحشود الرضية، الغارقة في دركها الوجودي.
كما تحضر فضاءات تدخل في خانة الأمكنة المكبرة، من قبيل «الصحراء»، برمزيتها إلى المتاه، اللانهائية، والوحشة… ومعها بعض من لواحقها، كـ«الرمل»، رمز التفتت والهشاشة، و«النخل»، المحيل على الوحدة والتحمل ومطاولة الأعالي…، و«الماء»، بمطلقيته الهيراكليطية، أي كواحد من رباعية العناصر الأرضية، كنسغ للحياة تزكيه مفردات «المطر» و«الغيم» و«الضباب» و«النهر»… و«البحر» الموصول، بِازْرِقَاقِهِ الطافح بمعاني الماوراء، المجهولية، والعدمية…؛ وفضلًا عن هذا بفيضه المائي الأسطوري، و«الجبل»، في تأشيره على الجبروت، الغطرسة، والرفعة…؛ وأخرى تؤول إلى مفهوم الأمكنة المصغرة، من مثال «المدينة»، «الحي»، «الأرصفة»، «المطاعم»، «المقاهي»، «البارات»، «المنزل»، «الغرفة»…؛ التي هي أفضية ميكروسكوبية، ماديًّا، تُراوِح بين الأصغر والأصغر منه، لكنها لا تتوانى عن التعملق، شعريًّا، وفي مساحتها تنبثق مواجد الأنا الشعرية بصدد الوحشة، والاغتراب، والحنين، والألم، والموت، مستسعفة انفعالات الاستذكار، والحلم، والغناء، والحب، وهي تغالب قدرها الوجودي المُقِضّ والمبرح.
زوايا مستهامة ترتكن إليها الأنا
وإذا كانت هذه الأمكنة المصغرة بمنزلة زوايا مستهامة ترتكن إليها الأنا، بمعية ذوات حميمة تَمُتُّ بوشيجة روحية إليها، فإن الأرصفة والجادّات المفتوحة تبقى مأوى الذوات العرضية التي تتقاطع معها في مهبات وجودها القلق والمتكدر، لكن في كلتا الحالتين لطالما يسفر التوضع الشعري عن مفاقمة عين القلق وذات التكدر بالنسبة لذات شعرية مصوبة بوصلتها الروحية نحو الأبهى والأكمل، ذات منذورة لتغريبتها الشقية في برية الوجود هذه. وعلاوة على ما ذكرنا نشير إلى الحافزية الجلية التي تفسر الحضور المكثف لمفردة «المرآة»؛ إذ تتلامح بوصفها أداة تستمرئ، في نصوعها، هذه الذات اختلاجاتها وابتلاءاتها المذكورة، تتحرى فيها عن صميم كُنْهها الروحي وترمم، في نصوعها دائمًا، انشراخات كينونتها، ومفردة «الجسد»، كموئل للرغائب والاشتهاءات، الرضوض والأتراح، الالتياعات والاحتدامات.
وضمن هذا وذاك، استدرجت، إلى الآلية التخييلية، أمكنة بهُويّتها الإطلاقية أو بأسامي علميتها المتعينة، على شاكلة ما يلقانا به «جبل قاسيون»، أو «نهر بردى»… مدائن «الأحساء»، و«دمشق»، و«هيوستن»… حارة «باب توما» الدمشقية أو مطعم «الدون – لويس قونزاليس»… فإنها لا تلبث أن ترضخ لتعميد جديد يؤهلها لعاملية ترميزية، جديدة بدورها، وذلك في مرمى ابتناء عالم شعري طازج، مستهام، تختطّ له المخيلة معماره وقسماته، مثلما تقتني له مادته ومؤثثاته، أو لم يعتبر بول سيلان مهمة الشاعر هي إعادة تسمية الأشياء، منحها خلقة أخرى ولسانًا آخر؟
هذا ولكون المكون الإيقاعي سيصير، في كافة الشعريات العالمية ومنذ القدم، إلى ما يضاهي التابو الجسيم، إلى حد أنه لا يمكن تصور أيما كتابة شعرية في تنصل بالغ من القواعد العروضية الصارمة، فسيكون رهان شعراء قصيدة النثر على إبدال ما يمكن وسمه بالتغليف الوزني الفوقي، المعمول به في الشعر التقليدي، بفهم متفتح للإيقاع جاعلًا منه مكونًا ناظمًا تتشربه الكتابة الشعرية على أكثر من وجه، من ناحية كلياتها أو مستدقاتها البنائية، ويقوم، في تمظهره الأبرز، على كيفيات الأسلبة والتوضيب، بل ناقلًا إياه من خارجيته المتمحلة إلى صنف من عاملية أدائية مستدمجة في أوصال هذه الكتابة اندماجها في أديمها، وبتعبير آخر «… فالإيقاع هو مجموع المكونات الصغرى والكبرى داخل الخطاب: من الكلمة والجملة حتى المقاطع السردية»(٩). من هنا فإن استثمار حروف صائتة أو مهموسة، أفعال (الحركية) وأسماء (الثبات)، جمل شذرية (الإلماع) وأخرى استغراقية (الإسهاب)، أضف إلى هذا ما ترهص به الدلالات المتبلورة من تفاعلات، تأخذ منحى التعاضد أو التنابذ، لَمِمّا يخول للقصيدة زخمًا إيقاعيًّا لا تخطئه القراءة الحصيفة، زخمًا عضويًّا متماديًا وليس مجرد فَضْلةٍ شكلية مفتعلة، نموذج هذا ما نلفيه في هذا المجتزأ به من القصيدة التالية:
«رمى الجميلة في الماء/ قالت له: أكرهك/ فانهال نهر./ أسماكه تتقافز/ نحو النبع./ تخفق أجنحتها ثابتة أو بطيئة/ كي لا يعبر الوقت./ رغبة مُلحّة في إبقاء الدهشة مكانها/ لإرغام الزمن على الانتظار قليلًا،/ شهقة واحدة/ غرق بطيء/ قفزة تجبر الموج على الانتباه،/ وبخطفة سريعة تنغرز الأنياب». – «سبع حركات إحداهن مرتجلة»، ص 85.
إذ تنثال نغمية المقطع توافقًا مع ارتفاع النبرة الإيصاتية مرة وخفوتها مرة أخرى، أي الجهر والمكتومية، ولكن أيضًا توافقًا مع إيقاع المعنى مصبوبًا في ضرب من الطباقية، أي جدل المعاني وتصادمها، من مثال الإلقاء العمودي في لجة الماء والجريان الأفقي للنهر، التقافز نحو النبع وليس نحو المصب، أي نحو البداءة أو الأصل لا نحو المنتهى أو الهيولى، الثبات والبطء، سكونية الوقت ودفقانه اللامنقطع، سيولة الزمن في مقابل انحباسية الانتظار، شهقة واحدة وغرق بالمطلق، القفزة في إحالتها على العاقل وانتباه الموج غير العاقل، انختامًا بالتضامّ الدلالي لاسم «خطفة» ونعت «سريعة» وفعل «تنغرز» مبتعثة، أي هذه الوحدات اللفظية، نوعًا من اندغام دلاليّ أقصى يؤشّر إلى جدل سافر مع التجافيات السابقة.
وتوازيا مع هذه الوجهة في التفعيل الإيقاعي، وهو ما تسلكه قصائد عدة في الديوان، تلجأ قصائد أخرى إلى تقنية التكرار، مثلما هو قائم في قصيدة «المنزل» (ص 125)، حيث يستعاد، في معظم مقاطعها، السطر الشعري- اللازمة «أنت الغريب» كصنف من التبئير الدلالي، ما في ذلك ريب، لكنّ استهدافًا أيضًا لتوليد إيقاعي ترشح به التشاكلات أو التصاديات المتباعدة، نسبيًّا، بفضل العودوية المتقصدة للسطر الشعري- اللازمة على امتداد القصيدة.
ومن ثم فإن نحن راعينا البناء المقطعي، أصلًا، مضيفين إليه هذه التقنية، كصيغتين اثنتين لتوليد إيقاعي لا غبار عليه، فما من حاجة، والحالة هذه، إلى التنصيص، من باب الإيضاح، على أن «… هذا التقسيم إلى مقاطع -في قصائد النثر- كثيرًا ما تصحبه بنية دائرية للقصيدة، وتنظيم إيقاعي مبنيّ على العودة والتكرار. وأشكال التكرار متنوعة للغاية: عودة إحدى اللازمات على مسافات منتظمة (لازمة متشابهة دائمًا عندما يراد تأكيد الشعور بالثبات، والوقوف -عن قصد- في مستوى الأبدية الثابتة)، أو اللازمة المتنوعة عندما يراد ضم المتشابه والمتخالف، التكرار والتنوع، واسترجاع جملة البداية في موقع النهاية، وهو ما يمكن الفكرة الشعرية من الالتفاف حول نفسها وإغلاق القصيدة لتؤكد -بذلك- على انطباع «الدورة» و«الدائرة» المغلقة»(١٠).
والآلية الشعرية في الديوان لا تتراخى عن تدبر عالم مستهام قيد الانبجاس، وكيما يتملك أوفى لوازمه التخييلية، لسوف تعمد إلى تسخير تقنيات إيهامية ترقى بالمتلفظ الشعري إلى صُعُد انزياحية، إن عبر الكناية أو الاستعارة أو المجاز، لا يقنع معها هذا العالم بنديته للعالم العياني القائم، بل يسمو عليه مستميلًا القراءة إلى الوثوق فيه والتماهي معه، ولنا أن نلاحظ كيف يتضافر الكنائي والاستعاري والمجازي في اصطناع توليفات خيالية، منها هذه التوليفة الماتعة بين الجسدي والطبيعي، بين إشاريات الجسد وبين تلاوين الماء، أو، بالأدق، بين الاندياح الشهواني وبين الانهراق المائي:
غمازتك/ قطرة مطر على الماء/ ابتسمي/ كي أذوب/ واضحكي لأجرب/ المنحدرات/ كما السيل/ ألاحق رائحتك في الغرف والممرات/ كي أستعيد قدك/ أعجن طينته/ وأصب قالبًا لتمرين الحواس. – «تمثالك يركض في الحديقة»، ص 17.
قلنا توليفة، أي تركيبًا، ما دام «… التركيب ليس مستقلًّا عن الدلالة. إن منطق لغة ما يرتكز على الانسجامات الحاصلة بين شكل اللغة بوصفه فضاءً وبين النسق التصوري، وخصوصًا المظاهر الاستعارية في هذا النسق التصوري»(١١).
النحت في توسله بالمادة
وتماديًا في السمو بالعالم المستهام إياه تلوذ المخيلة بطرز الإيهام التي تقوم عليها الجماليات الفنية الأخرى، كالرسم في اعتماده اللون والمساحة، الضوء والظل، الكتلة والبقعة، التشخيص والتجريد…؛ وابتداع، بالتالي، لوحات مجنحة في استعاريتها، والنحت في توسله بالمادة، معدن أو حجر أو رخام أو خشب، والإزميل، الوفاء للمقاسات أو الإخلال بها أحيانًا، واصطناع تماثيل ونصب وأشكال هندسية لا تقل عن هذه اللوحات تجنيحًا. ولكون الفن التشكيلي لهو أحد مجالات الأيقنة التعبيرية جماليًّا، وأيضًا لكون الحداثة الشعرية ستطوح بمبدأ نقاء جنس الشعر واكتفائه بذاته، لن تتحرج ثلة من الشعراء في استدعاء بعض الماهيات والتوسلات من حقل التشكيل بهدف استحصال صور شعرية تقرب أكثر عوالمهم المستهامة، وها الشاعر يفعل ذلك رغمًا من تمويهه بأنه ليس رسامًا ولا نحاتًا، بل ليس حتى بشاعر: «لمس المراد،/ فيما انغلقت الرؤوس/ في عمامة الاعتياد،/ ربما سيضع، الآن،/ قماشة أمام المشهد،/ ويرسم الخالص منه،/ ربما يفتح صفحته/ ويخيط قصيدة،/ ربما يطرق بإزميله الرخامة/ ليستيقظ التمثال النائم./ لكنه/ ليس رسامًا/ ولا شاعرًا/ ولا نحاتًا،/ وليس له من مراد الأشياء/ إلا مهجة صغيرة». – «مهجة»، ص 43- 44.
لكننا نجده هو نفسه، أي الشاعر، المتنكر لكونه رسامًا، مثلًا، لا يتورع عن استسعاف مفردات من القاموس التشكيلي القح وهو يتخيل موقفًا عشقيًّا ساخنًا تحياه الأنا الشعرية وتتصادى فيه لزوجة الماء مع لزوجة الجسد: «تبتكر ألوانا/ وتلطخ الجدران،/ شفاهًا حمراء،/ بحرًا عميقًا،/ وأسماكًا تقفز/ من صدرك وتغوص». – «هلوسات الساعة الأخيرة»، ص 96.
على أن الحقل السينمائي يبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشاعر الذي يواظب، كما أسلفنا، على انشغاله بالسينما مواظبته على الكتابة الشعرية، ومن ثم لا غرابة في أن ينفتح الديوان، وبنصيب من الأريحية التخييلية، على الفن السينمائي مستدعيًا جمالياته ووسائطه التي نسجل محايثتها في أكثر من صورة شعرية مفسحة، على هذا النحو، المجال لمواظفة تقنيات من قبيل السيناريو والمونتاج والإكسسوارات (اللواحق)، الكلام والصمت، الترهين المشهدي أو الارتجاع إلى الوراء أو استباق الآتي، التبئير المشهدي من خلال تكبير الصورة وتثبيتها Gros plan…؛ والظاهر أن الشاغل السينمائي، في حالة الشاعر، وفضلًا عن كونه سبيلًا، فيما نخمن، إلى الرفع من درجة الأداء التعبيري، في تجربته الإبداعية، بحثًا منه عن دراية- متعة عالية، يقوم مقامًا موازيًّا نصيًّا Paratexte، الذي وضعه الناقد البنيوي الفرنسي جيرار جنيت، جائز تسخيره كعنصر إضاءة لعمله الشعري، أداة مسعفة على استغوار بواطنه الإبداعية وكذا مقاصده المنتواة، وهو ما ينطبق كذلك على شعراء عرب آخرين معاصرين، كبلند الحيدري، وسعدي يوسف، وحسب الشيخ جعفر، وصلاح فائق، ومحمود درويش…؛ في بعض قصائدهم، نعني أن القراءة الفِلْمية(١٢) لبعض قصائده قد تشكل مدخلًا ناجعًا إلى صميم التخييل والدلالة كليهما و، بالتبعية، إلى اللب من الرؤيا المستحكمة في فضائها، ناهينا، عمومًا، عن أن البناء المشهدي في قصيدة النثر يتم بـ«… الاعتماد على حاسة البصر في تكوين المشهد والذي يستطيع، في الحالات الجيدة، أن ينتقل من مكونات الواقع اليومي المعتاد إلى مكونات واقع الحلم أو الخلط بينهما وهو ما يحقق ما يمكن تسميته بالمفارقة المدهشة»(١٣). ويكفي أن قصيدتين اثنتين، في الديوان، تحملان عنوانيْنِ دالين هما:«فيلم طويل من لقطة واحدة» و«فيلم بطئ لحياة مستعملة»، ولنمثل بمقطع من هذه الأخيرة عسى أن نضع اليد على واحدة من الصيغ لتجاذب ما هو لفظي وما هو بصري في نطاق شعري بالأساس:
«وهربت بالطبع/ ألم نتفق على أن المشهد الأجمل/ سريع وخاطف./ أين دوري الأخير، خاتم الرواية:/ خنجر مسموم في زقاق معتم،/ أو عثرة قدم على هاوية/ وعلى الأرجح/
رصاصة طائشة في بار مزدحم…./… أيها المخرج الغر:/ الفيلم بطيء،/ لن أمثل أمام عدستك،/ سأرتجل نهايتي،/ فلست حريًّا بالذكريات/ وتبًّا للحنين/
لا أشتهي صورة ذابلة/ لحياة اهترأت/ من شدة الاستعمال». – «فيلم بطيء لحياة مستعملة»، ص 21 – 22.
إذن ففي الصميم من إوالية شعرية، كهذه التي أتينا على تشخيصها، تأخذ الأنا الشعرية على عاتقها شأن الحكي الشعري عن تغريبتها الشقية في برية الوجود، مثلما ذكرنا، مبلورة، هكذا، محكيات شعرية تغلف الدلالات أو الموضوعات المركزية التي تنفرز عنها، إنْ جزئيًّا أو كليًّا، ومن قصيدة إلى أخرى، هذه الإوالية.
وقبل هذا وذاك فإن الحكي ليعد أحد مقومات قصيدة النثر التي ييسر عليها معجمها المنثور، في الأصل، سردنة ما هو شعري وذلك باستدخال عناصر الزمن والمكان والشخوص والراوي والمحكي… وتأهيلها، لفظيًّا وتركيبيًّا وتخييليًّا، لحساب ما هو شعري والانصياع لإملاءاته النوعية واقتضاءاته المقننة. بعبارة أخرى، وبخصوص «… السرد المستعاض به عن غنائية محلقة أو مهومة، والمجتلب للنص لإكسابه ملموسية وتعيينًا، فقد كان ممكنًا في قصيدة النثر بشكل كبير نظرًا إلى الإفادة من طاقة النثر المنصهر في بنيتها.
حكي يقول الأزمنة والأمكنة
ولا يعني ذلك جلب آليات القص حرفيًّا -كما هو حاصل في البناء القصصي مثلًا- ولكن منح قصيدة النثر أبعادًا تسهم في تشكيل نسيجها البنيوي، وتدعم جانبها الدلالي، وتخفف من كثافة اللغة والصور فيها، ما يبعدها من الغنائية الساذجة والتهويم الصوري المجاني»(١٤). بهذا نجدنا، في الديوان، إزاء طاقة حكائية لافتة، بيد أنه حكي مضاد للحكي الجمعي الذي لطالما تشربته شغاف الأنا الشعرية في غضون الطفولة، حكي يضع في الصدارة تصاريف تغريبتها الوجودية الممضة، يصفي الذاكرة من أدرانها ويقول الأزمنة والأمكنة ما لم تفلح في قوله قط، معيدًا ابتكار سير الصعاليك والهائمين على وجوههم والعشاق الأصفياء، متعكزة، ما في ذلك شك، على روح الكتاب الأم «ألف ليلة وليلة» وتخصيصًا على ديباجته الاستهلالية المسكوكة، لكن في قلب سافر، متعمد، للأدوار تصبح معه هذه الأنا هي من يباشر الحكي- الكتابة، مثلما يجسده عنوان القصيدة التي نستشهد بها هنا، «أكتب حكايتي»، ويمسي شهريار هو الراوي في حين تكتفي شهرزاد بالإنصات:
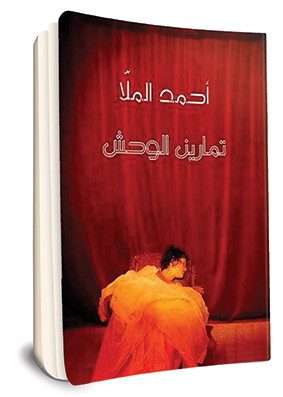 «كان يا ما كان/ يندفع المجنون خلف دمه/ ملتاثًا بليلاه/ يصرعه الهوى بين المنازل والهضاب/ فريدًا، لا خيل له ولا خلان». – «أكتب حكايتي»، ص 146.
«كان يا ما كان/ يندفع المجنون خلف دمه/ ملتاثًا بليلاه/ يصرعه الهوى بين المنازل والهضاب/ فريدًا، لا خيل له ولا خلان». – «أكتب حكايتي»، ص 146.
إن المحكي الشعري إياه لسوف تجري أطواره، وتتبلور معها ترتيباته وكذا تمفصلاته، في مكان يتخذ، عند القراءة المباشرة، هيئة صحراء ملموسة، يرين عليها ليل مدلهم قد يتبدى بدوره، لأول وهلة، أليفًا، زائلًا، غير أن استحضارنا للرؤيا الممسكة بتلابيب تجربة الديوان لا تلبث أن تقتادنا إلى صحراء كونية متراحبة من محتد، على سبيل الإلماع، الصحراء المصرية التي ابتدعتها من جديد مخيلة الشاعر الإيطالي جويسيبي أونغاريتي أو أرومة صحراء تونس كما تستنهضها قصائد الشاعر الفرنسي لوران غاسبار.
صحراء تلوح فضاء لا نهائيًّا، ملغزًا، ولا قبل لقحولتها، ليباسها، أو، بالحري، لشدتها، بجماع التداعيات التي قد ترخيها صحاري الأرض المأنوسة على هذه المعاني، صحراء موحشة عن الآخر، يدثرها ليل من عتيق الأزمنة، لكنه مضيء رؤياويًّا، تلوي بمصاير الذوات ويتربص محقها الميثولوجي، فتكها اللايوصف، بالكينونات واضعة كل حلم، تمامًا كما كل شيء، موضع صغار، بَلْهَ امّحاء، بحيث لا يقين يعلو على يقينها ولا مشيئة قد تبز مزاجها رغم ما قد يغري به ظاهر الأشياء من تكافؤ، بَلْهَ ندية:
لا تتيقن من أي شيء يخطر لك أو ينتصب أمامك. الصحراء/ فاجرة ولذيذة، لك وعليك، لا تدركك ولا تداريك، كل ما يتبدى قناع/ تلو قناع. اللحظة رجراجة، والحياة ليست ساكنة، يقينك الوحيد أن/ تداري عشقك مثل «الوشم في ظاهر اليد». – «ورقة الصحراء»، ص 138.
وعليه، إن كان الأمر كذلك والأنا الشعرية منذورة، كسائر الكائنات، لموت جائر يبقى امتدادًا، ليس إلا، لموت رمزي ضار، مقسط، تتلقفه، عبر اليومي، ذوات وأحلام، قيم وأفكار، مباهج ولذاذات، فما من خيار أمامها، لتلافي حتفها المباغت أو المتقطع، هي من تدمن التملي في سيماها المرتعبة وشقائها الكياني عبر مرآتها المستعارة، سوى أن تقبس من مائها، المستعار أيضًا، هديره وبأسه، ومن جبلها، المستعار هو الآخر، سموقه ونخوته، وتضع قناع وحش رمزي منذور لأن يعارك القبح والانحطاط، الضحالة والتكلس، كتمظهرات للموت المقسط، ويرجئ، ليس إلا، موت الأنا المتقنعة، تسلحًا بالاستذكار والحلم والغناء والحب.
ولأن المعترك لمن الضراوة بمكان فما من مانع أمام استنفارها، رمزيًّا، لزمرة من أصدقاء مبدعين، كالرسام النمساوي غوستاف كليمت، والنحات الفرنسي أوغست رودان، والممثل والمخرج السينمائي وفنان الإيهام الهنغاري هاري هوديني، أو متخيلين، كدافيد كوبرفيلد بطل رواية الكاتب البريطاني تشارلز ديكنز، أو فعليين، كجبر علوان المهداة إليه قصيدة «النائم» وعصام السعدي الذي أهديت إليه قصيدة «ورقة الصحراء»، ثم ريم التي حظيت بإهداء قصيدة «ترفق بحجارتي أيها الجبل»، أيضًا لرفقاء طريق قصيدة النثر، ممن تسميهم إحدى قصائد الديوان، أي طريق الكتابة والألم، وقبل هؤلاء واحد من أسلاف الشعراء الجاهليين النيرين، المأساويين، طرفة بن العبد، الذي لَشَدَّ ما أقضَّ مخيلتَه البحث عن «خولة» مستحيلة، وعن «برقة تهمد» مندثرة لم ترأف بها، البتة، فلاة الشاعرين المشتركة، التجلي الأرضي للصحراء الكونية في بطشها الأعمى بأيما سكينة وجودية رواقية، وهذا الاستنفار يجد مسوغه، حتمًا، في انضواء أساميهم، عتبانيًّا، أو أعمالهم، تناصِّيًّا، إلى مدار التجربة الشعرية وانصهارها، كنتيجة، في جوفها، الشيء الذي يلزم الزمرة المذكورة بخفرها، أي الأنا، في ممشاها الرمزي، الوعر والمكلف، صوب عقر دار الوحشية، بمعاضدتها في معتركها الكالح هذا، كتمرين من بين تمارين، أو تربصات، مترادفة للوحش المستعار، مع التوحش الأصلي وهو يفاقم وحشتها، اغترابها، حنينها، ألمها، ويستعجل، بالتالي، موتها. ليكن، إذن، توحش يطاول آخر… أفلم يقل أبو عبادة البحتريُّ في وصف ذئبه، ممجدًا إياه ومستلفًا منه صولته: «كلانا بها ذئب…»(١٥):
«كل نهار أصحو/ وبخفة أسحب جسدي المنهك من فراشه وأغتسل… أكشط الدم قبل/
بزوغ الأعين، أعدّ الإفطار من غير لحم، أترفق بالقهوة… أسمر/ الخبز… أضع العسل في زجاجة وأزين مزهرية بيضاء بابتسامة بلا/ أنياب./ بعد أن يطمئن البيت، وتنطفئ رائحة الليل الحريفة من هوائه أتسلل/ بطمأنينة الغدر، أحصي فرائس البارحة، وأدفن جثثًا ممزقة، أواسي/ المصابين وأعالج الجرحى، وأحصي الطرائد وأشم مكان صيدها
المعتاد قبل جهامة الليل». – «تمارين الوحش»، ص 28.
أنا شعرية تخوض معتركها المتخيل
على أن هذا لا يحول بين الأنا الشعرية، وهي تخوض معتركها المتخيل، وبين نزع قناع توحش الضواري السائبة في البراري وارتداء قناع التهريج، بمعنى انتقالها إلى توحش آخر، ناعم هذه المرة، لا تقل مفاعيله عن آثار التوحش البهيمي. توحش فانتازي يوخز فرائسه ويلدغها، بدل نهشها، يباشره امرؤ ببذلة متهدلة وحذاء سريالي وزينة فاقعة، ممجوجة، مفطور، ظاهريًّا، على الخفة والوداعة وإبهاج الآخرين، لكنه يستضمر، رغمًا من حقارته البادية، قريحة حكيم يقوم بترميم أرواحهم المشروخة، سلاحه الهزء، أو، في الواقع، الباروديا السوداء، وألاعيبه البهلوانية التي تسفه الأباطيل والأوهام، تزري بالسفاسف والترهات، وتضع الإصبع، بتوقح الحكماء وعدم خشيتهم من لوم اللائمين، على الوضاعات والمسوخات. من هنا انتصاب شخصية المهرج في تجربة الديوان، وفي أكثر من قصيدة، وذلك بقسمات دالة تستثير في الذاكرة كبار المهرجين في الثقافة الغربية، من معدن البريطاني شارلي شابلن، والإيطالي داريو فو، والفرنسي ميشيل كولوشي، مثلًا:
«دعوني أعود لألون وجهي،/ وأقفز من أعلى الحلبة،/ أمشي على الحبل،/ وليكن قريني/
قردًا وبالونة صفراء،/ وجمهرة من السابلة/ يملؤون الخيمة،/ يشيرون بسخرية إليَّ،/ وبأعلى أصواتهم يضحكون/ على مشيتي المتكررة،/ مقلدًا القرد وهو يفكر،/ ويحك بوقاحة/ ما بين فخذيه». – «بدل الاكتئاب»، ص 15.
والتفافًا منها على شرطها الوجودي المؤرق، ومداراة منها لانعواقها الروحي في صحرائها المستهامة تلجأ الأنا الشعرية إلى ارتحالات رمزية، في الزمن والمكان… تستعيض عن خواء مسقط الرأس بنعماء دمشق أو تخمة هيوستن… تأخذ بنواصي البوح في هدأة المطاعم أو جلبة المقاصف… تمتلئ بالبهاء الأنثوي الصارخ في هذه البرهة أو تلك… وتكرع، حد الثمالة، من مدامة بابلية معتقة في مخيلة أحد رفقاء الطريق، الحسن بن هانئ… لكن سائر هذه الانفراجات لا تفلح في أن تصادر منها اغترابها المريع، المزدوج في الجوهر، كما تخفق في اجتثات اشتياقها إلى لذاذة الرحم الأولى، ومن يدري ففي أفيائها البكر، العدنية، قد تعثر على ملاذ رحيم يرقّ لحالها ويقيها من خطوب بريتها الوجودية ودواهيها، ففي البدء كانت «الأحساء» ومنها انطلقت أبجدية الكينونة تمامًا مثلما أينعت بذرة الخشية الأولى: «كنت البدوي/ في الصمان،/ والذئب الجريح في الربع الخالي،/ بيني وبين النجوم نسب ورفقة حداء/…/ في الأحساء/ تكلمت نخلة مثابرة في أحلامي/ سدرة خبأتني في كهرمانها،/ وأغوتني في الظهيرة/ فلقة رمان». -«هيوستن: شهوات مصفدة»، ص 29 – 30.
لكن حالما حطت الرحال في سكينة الرحم الأولى سرعان ما استيقظ في وجدانها توحش عالمها، فإذا بها تتساءل عما يمكن أن يجديه الحلم، مثلًا، في مغالبة هذا التوحش والحد من صلفه وغلوائه خصوصًا أن الجسد متهالك بأثر من ضربات سوط زمن ومكان معاندين، ليس من قامة كبريات الأحلام وأعتاها من جنس تلك التي تختلج في حناياها، بل لعله، أضيق من استضافة حياة فوارة، بل شعرية: «جسدي ليس طوع أحلامي/ أو ربما أكثر مما يحتمل،/ رغباتي طويلة وصلبة،/ الحياة فيه/ فكرة ناقصة،/ أمد يدي ولا تطالها». – «أقل مما ينبغي أو أكثر مما يحتمل»، ص 109.
وها هي ذي تستجدي الغناء، كقرينة جمال وتفتح، امتلاء وتسام، كمنفلت من ورطتها الوجودية الجاثمة، ترويضًا منها لليل الصحراء، ربما، على عكس ليل هيوستن الممانع الذي لا تروضه موسيقا الجاز، لا بحة المغني الجريحة ولا الأنة الجهيرة، الشجية، لعزف مضمخ ببرحاء العبودية، بمواجعها، ومكابداتها: «عندما تبعث الريح خلفنا سنحتمي من الطرق وقطاعها بالغناء،/ نعصب بأسنا برفقة الدم الأول، ولا نهمل الوحش فينا». – «ورقة الصحراء»، ص 137.
وتصعيدًا منها لمعتركها الصعب ذاك، ولأن الحلم والغناء يستجلبان رقة الأحاسيس واشتعال المواجد، يبقى الحب، بوصفه طاقة روحية هائلة، ممكنًا رمزيًّا للفتّ من عضد صحراء الوجود الطاعنة في تغولها والمطوحة، من فرط شراستها، بأيّما معيش أو، بالأحرى، تجوهر كياني، مصفى وملهم. ومنه ندرك المحايثة المِلْحاحة لضمير المخاطب الأنثوي في عرض الديوان واستئثاره بأكثر من محاورة مع الأنا الشعرية في هذه القصيدة أو تلك.
فقد تلوح الأنوثة في مقصف، على منوال ما نلفيه في قصيدة «وحش البار»، أو تتخلق في فضاء غرفة، في الحالة الأولى تستوي موضوعًا للتأمل، للدردشة، والمناوشة الجميلة، بينما تنهض، في العتمات الحميمة، كطرف في برهة عشقية فادحة، وحيث الشغف، التجسد… التضرع والتعنيف، الشطح الجذلان – الأليم… تنهض كألفباء للبرهة… منة أو سلوى روحية في غمار يباب وجودي مطبق ومعها الحب كحد مضاد لاجتفاف روحي أزلي… كحد مضاد، بالأدق، للتبدد، للموت: «أتأمل ذراعيها وأقف مبتهلًا/ عند كل شامة وانحناءة،/ وقبيل إدمان رائحة أشجارها/ أعتصر رمانة الكتف/ وأقترح أسمائي عند كل استدارة». – «بنت هواي»، ص 69.
لكن أيهما سيفوز بالمعترك؛ الأنا الشعرية أم الموت؟ من سيفتك بمن؟ من سيجهز على من في تجربة الديوان؟ ما من شك في أن الغلبة ستكون للموت، ليس فقط استنادًا إلى ما تنتصر له، دلاليًّا، قصائد، من مثال «مراوغة الموت»… «أمحو الموت»… «قبر عائشة»، التي تجعل يده هي العليا و، بالتالي، لا مفر للكينونة من سطوته، وهي تحيا موتها المتقطع أو تتلقف حتفها المباغت. لذا حتى وهي، نقصد الأنا، تأخذ بأطراف مشاغبتها الميتالغوية(١٦) الرائقة، أو وهي تؤثت اللحظة، ضمن تلوين تغريبي، بـ«الكيبود»، «الياهو»، «الجي ميل»، «الإيميل»، و«البلوتوب»،.؛ كثمرات للعصر الرقمي و، جوهريًّا، كوسائط سحرية لمراوغة الغياب لن تكون بمنجاة من معانقة موتها المسطور: «اسمعي، في إحدى تلك الليالي توصلت بمقدرة ما، إلى طريقة مبتكرة/ لتصلك رسائلي بعد الموت، ربما لأني أمين في مناكفة قصيدة/ النثر، أو لأني توصلت صدفة إلى معرفة الخليط السري لشعر، يرى/ ويفهم بلغات ولهجات، خليط انبثق المارد من دخانه شاخصًا أمامي/ وكان طلبي الوحيد بعد توسله أن أراسلك بعد الموت». – «أمحو الموت»، ص 157.
– 3 –
والكتابة توالي أشواط معتركها الجمالي والتخييلي مع صنوف الإغاضة التي تزخر بها بريتها الوجودية المستهامة، من وحشة واغتراب وألم، انتهاء إلى الموت، سيحصل، لمقصد رؤياوي بين، أن تستدرج الأنا الشعرية من لدن أنثى ما إلى حدود المأزق اللاهب، الذي يا ما واجهه مبدعون أصيلون في مختلف الآداب الإنسانية، وبموجبه يستعاد ذلك الموقف الهاملتي الفارق: «أكون أو لا أكون، تلك هي المشكلة»، وبتعبير موازٍ كيف يمكن للمبدع أن يحسم موجوديته الفريدة، هل بعيشها خياليًّا داخل المكتوب أم بالانخراط المسالم في المهبّ الحياتي الشامل الذي يؤوي الكينونات الرهيفة ويتسع، دفعة واحدة، للغوغاء أو الحشود العارمة، القنوعة بمعيشها الأرضي الخامل والرتيب، وها الشاعر يرمي بشباكه، عبر أناه المنتدبة، في شائكية هذا المأزق مؤطرًا بالمحاورة الدالة الآتية:
«يوم تعارفنا، بسبب قرش رن سهوًا/ قلت: لا وصف لك./ قلت: أيها الشاعر، عش حياتك، لا تصفها/…/ يقرب القرش، يلمع عند شفته السفلى/ ويتمم:/
أيها المغفل/ عشها/ لا تصفها/ خاطفة هي الحياة». – «قرش»، ص 79 – 81.
وعليه نقول: هل للشاعر، ما دامت الحياة قصيرة لا تتسع للعيش والكتابة كليهما، في مداراته لهذا المأزق، أن يحيا حياته حد الإشباع وبعدها يطرق بوابة الكتابة طافحًا بمآتيها بما يشبه موقف القائد الروماني يوليوس قيصر لما وطئت قدماه بر بريطانيا وهو يرفل في سؤدده الإمبراطوري، الذي لا سؤدد بعده، لينطق بعبارته المخلدة: «جئت، رأيت، انتصرت»! أم تراه يستأنس بفحوى السيرتين الفاتنتين: «أشهد أني عشت» للشاعر الشيلي بابلو نيرودا، و«عشتها لأرويها» للروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، اللتين، على الرغم مما قد توحي به العنونة من سابق العيش على الكتابة، فإن منطق الأمور يؤكد مزاوجةً ما، على انشطار بين الأفقين، غالبًا ما يستحكمان في هذه المعادلة المؤرقة(١٧).
ولا مراء في أن هذا المأزق لا يخلو من استشكال، بحيث تتفاوت أقدار المبدعين وتختلف، بناءً عليه، سبل تعاطيهم مع الثنائية(١٨) القاسية في هويتهم. لذا، وسيان ما له علاقة بتدرجات سيرة الشاعر أو متواليات إصداراته الشعرية، يظهر أن قدره المتاح هو أن يزاوج، كشاعر ممسوس وواع، بين تدبير أسطورته الشخصية الناجزة التي تشف عنها بوهيميته الوجودية الجسورة، واستنكافه المقدام عن الطقسية الحياتية للجموع متحصنًا، هكذا، بفردانيته المنيعة من الغبار المجتمعي الكاسح، شأوه شأو الشعراء الحداثيين الأصلاء كافة، هذا مع الأخذ بزمام إستراتيجية كتابية قائمة على تذويت الأفكار والتمثلات تستأثر فيها السريرة بالأولوية، أي العناية بما تعج به دخيلته من أسئلة وهواجس، اصطخابات واعتنافات، ذلك أن «… أي نص لا يتأتى له أن يوجد إلا بفضل حتمية لا نصية: يوجد بوصفه نتاج كائن إنساني»(١٩) مميز ومخصوص. ولعل قدره المتاح هذا هو أن يغور في نفق الكتابة متسائلًا عـ«من ينتقي عروق الصخرة» من بين رفقاء الطريق، أولئك الأشقاء الخلص الذين ينحدرون من نفس شجرة النسب الشعرية:
«من ينتقي عروق الصخرة؟/ وديع سعادة ترك حاشية قرب تخطيطات سليم بركات/ قاسم حداد دون نصوصه على مدخل العمارة/ سعدي يوسف، محمد الثبيتي، أدونيس، زكريا محمد، عباس بيضون،/ أمجد ناصر/ الحروف التي يشحذون أسنتها ليلًا/ في كل فاصلة/
وما يضمرون بين الأقواس/ والحواشي». – «حصتي من النفق»، ص 154.
منقبًا عن نفسه في معمعان الكتابة، ومتحملًا، كعاقبة محتومة، أهوال مسير لا يعود سوى بالخسران، بالاستحالة، تمامًا كما خسران أورفيوس، الشاعر والموسيقيّ الكونيّ الأول، لحبيبته – قصيدته يوريديس على مرمى حجر من ضوء العالم، إثر تلك اللفتة منه، الرؤوم لكن اللعينة والمدمرة، لتعود القهقرى إلى حلكة العالم السفلي:
«أبحث عن أحمد الملا/ عله بينهم/ بأظافر ملثمة/ بكتب حصته من النفق». – نفسه، ص 155.
هوامش:
(١) بما يحاكي نفس التجريبية التي ستقود روائيين غربيين وغيرهم، بدءًا من القرن التاسع عشر، إلى توسل تقنيات شعرية بعينها، كالتكثيف والمجاز والتداعي الحر…؛ في كتابة أعمالهم السردية. مثال هذا رواية «الأبله» للروسي فيدور دوستويفسكي، ورواية «عوليس» للأيرلندي جيمس جويس، و«الصخب والعنف» للأميركي ويليام فولكنر، ورواية «أنشودة ناراياما» للياباني شينشيرو فوكازاوا، ورواية «مئة عام من العزلة» للكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز..؛ الشيء الذي سيقتدي به بعض الروائيين العرب، في أكثر من عمل روائي، كالمصري إدوار الخراط، والسوريين، حيدر حيدر وسليم بركات، والمغربي أحمد المديني،…
(٢) د. أحمد زياد محبك: مشكلة الحداثة في القصة القصيرة جدًّا وقصيدة النثر… رؤية تنظيرية، مجلة «الشعر» (المصرية)، ع 142، صيف 2011م، ص 91.
(٣) نستعمل الرعيل كرديف لمفهوم الجيل وذلك رغم إدراكنا لضيق المسافة الزمنية التي قطعتها قصيدة النثر في الشعرية العربية المعاصرة، وكذا تفهمنا لتحفظ واحتراز، بعض من الشعراء بخاصة، على مفهوم الجيل وتفضيل التعاطي مع الظاهرة الشعرية في إطلاقيتها. فالمفهوم إياه، رغما من أيما تحفظ واحتراز، والمستجلب إلى الدراسات الأدبية من حقل علم الاجتماع، لسوف يبين عن نجاعة إجرائية فائقة في استيعاب علاقة الظاهرة الشعرية بمقتضاها الزمني، بحيث تُنزَع من كتلويتها العائمة واسترسالها المبهم وإخضاعها لتقسيط زمني يراعي عنصر العمر والانتماء إلى حقبة تاريخية وثقافية مخصوصة مما نكون معه حيال وجدان جمعي ما، أو لنقل حساسية أو مزاج، لا يصح تناول الكتابة الشعرية بمعزل عنه. ويكفينا، هنا، الاستئناس بما درجت عليه الأدبيات النقدية الغربية في هذا الباب، بحيث تُصَنَّفُ مجموعة من الأسماء والتجارب الشعرية المائزة ضمن خانات جيلية، كجيل المستقبليين الروس، وجبل التعبيريين الألمان، والجيلين الإسبانيين، جيل 1898 وجيل 27، والجيلين الأميركيين: الجيل الضائع وجيل البيتنيك..؛ على أن هذا لا يلغي، بأي حال من الأحوال وأساسًا بمراعاة البعد اللازمني للحداثة، تعاملنا مع أسماء شعرية استثنائية بوصفها عابرة للأجيال والأزمنة، كامرئ القيس، وأبي الطيب المتنبي، والشاعر الإيطالي أليغيري دانتي، والشاعر المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير، والشاعر الألماني فريدريش هولدرلين، والشاعر الفرنسي آرثر رامبو…؛ أو لم يعنون الشاعر العراقي المعاصر، سعدي يوسف، مثلًا، أحد دواوينه بـ«حفيد امرئ القيس»، مؤكدًا، هكذا، قرابتَه الرمزية من شاعر جاهلي أكثر من قرابته المفترضة مع شاعر حديث، من زمنه نفسه، كمواطنه الشاعر العراقي معروف الرصافي.
(٤) أدونيس: الشعرية العربية، دار الآداب، ط 2، بيروت 1989م، ص 191.
(٥) عبدالحميد الحسامي: كلمات عن فضاء المشهد الإبداعي السعودي، ضمن ملف (راهن المشهد الشعري في السعودية)، مجلة «البيت»، التي يصدرها «بيت الشعر في المغرب»، ع 31، ربيع 2018م، ص 160.
(٦) دار الغاوون، بيروت، 2010م.
(٧) Tzevetan Todorov : Les genres du discours, Coll. Poétique , Ed . Seuil, Paris, 1978, p. 24.
(٨) إمعانًا من الشاعر في مراكبة التلفظ الشعري في الديوان، إن لم نقل تهجينه وتعنيفه، سيستثمر، مثلًا، مفردات من المعجم الإنجليزي كما فعل في قصيدة «وحش البار».
(٩) محمد الصالحي: شيخوخة الخليل، بحثًا عن شكل لقصيدة النثر العربية، منشورات «اتحاد كتاب المغرب»، الرباط 2003م، ص 95.
(١٠) سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن، ترجمة: راوية صادق، مراجعة وتقديم: رفعت سلام، ج 2، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة 2000م، ص 162 – 163.
(١١) جورج لايكوف، مارك جونسن: الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، دار توبقال للنشر، ط 2، الدار البيضاء، 2009م، ص 143.
(١٢) وبالمثل يحفل الحقل السينمائي بزمرة من الأقلام الراقية التي لا تخلو، إن من حيث السيناريو أو الإخراج، من لمسة شعرية تستوجب، والحالة هذه، من المتفرج المرهف والمزود بمعرفة شعرية سديدة التعاطي مع الشخوص والحوارات، المشاهد والديكورات، بوصفها قرائن مجازية من الكثافة والانزياح أكثر منها عناصر توضيبية منذورة، آليًّا، لخدمة الحبكة الفِلْمية. ومن الأمثلة القوية في هذا المضمار: «الكلب الأندلسي» للمخرج الإسباني لويس بونويل (1928م)، «كازابلانكا» للمخرج الأميركي مايكل كورتيس (1942م)، «بسمات ليلة صيف» للمخرج السويدي إنغمار بيرغمان (1955م)، «عندما تمر اللقالق» للمخرج الروسي ميخائيل كالاتوزوف (1957م)، «قصة الحي الغربي» للمخرج الأميركي روبير وايز (1961م)، «كاتش 22» للمخرج الأميركي مايك نيكولس (1970م)، «لكم عشقنا بعضنا» للمخرج الإيطالي إيتوري سكولا (1974م)، «ديرسو أوزالا» للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا (1975م)، «هير» للمخرج الأميركي ميلوش فورمان (1979م)، «حلقة الشعراء المفقودين» للمخرج الأميركي بيتر وير (1989م)، «فوريست غامب» للمخرج الأميركي روبير زيميكس (1994م)، «التحت» للمخرج البوسني – الصربي إمير كوستوريكا (1995م)، «الأرض من حيث هي لغة» – وثائقي عن سيرة الشاعر محمود درويش – للمخرجة المغربية – الفرنسية سيمون بيتون (1998م)، «كل شيء عن أمي» للمخرج الإسباني بيدرو ألدوموفار (1999م)، «يد إلهية» للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان (2002م)، «موسيقانا» للمخرج السويسري – الفرنسي جان لوك غودار (2004م)، «شعر» للمخرج الكوري لي شانغ دونغ (2010م)..
(١٣) د. صلاح السروي: قصيدة النثر، دراسة نظرية وتطبيقات، دار نفرو للنشر والتوزيع، القاهرة 2009م، ص 67.
(١٤) د. حاتم الصكر: الثمرة المحرمة، مقدمات نظرية وتطبيقات في قراءة قصيدة النثر، إصدارات مجلة «نصوص من خارج اللغة»، سلسلة النقد 1، شبكة أطياف الثقافية، الرباط 2019م، ص 11.
(١٥) ولنا أن نستحضر، بالمناسبة، المواءمة الرفيعة بين طباع التوحش والافتراس وبين خصال النبالة والأنفة، مما تشف عنه رمزية بعض الحيوانات والطيور الكاسرة، التي خلدها الأدب العالمي، ولنذكر منها: «حوت» الروائي الأميركي هرمان ملفيل، و«ذئب» فلوات الروائي الألماني هرمان هسه، و«غراب» الشاعر الأميركي إدغار ألان بو، و«قطرس» الشاعر الفرنسي شارل بودلير، و«ثور» الشاعر الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا…
(١٦) التي سيجعلها الناقد البنيوي الروسي، رومان ياكوبسون، ضمن الوظائف الست للغة، وتهم أنماط اللغة البعدية، التحليلية، كالنحو والعروض والبلاغة والنقد..؛ التي تنكب بالوصف على لغة إبداعية مسبقة. على أن هذا لم يمنع شعراء عربًا بعينهم، على قلتهم، من استغلال قصائدهم في تمرير أفكارهم الشخصية حول الشعر، وذلك بما يماثل أيما ميتالغة، أو لغة ما ورائية Métalangage، ومنهم أدونيس، سعدي يوسف، ومحمود درويش…
(١٧) كمثال مغاير سينحاز الكاتب الأرجنتيني المرموق، خورخي لويس بورخيس، في قصته الباذخة «المرآة والقناع»، إلى تخييل سردي ينتهي بمآل الملك البريطاني، الذي أعياه انتظار القصيدة الموعودة، الأيقونية، الممجدة لانتصاره المدوي على النرويجيين، والشاعر الذي سيعتقد أنه عاش فصولها الملحمية من خلال حولياته المدحية المتواترة، قبل أن يصعقه إخفاقه المريع في جعل الشعري مضارعًا للحياتي، لينتهي الاثنان، جرّاء خيبتهما، إلى مخرج عدمي تراجيدي، بحيث سيطفئ أولهما نور عينيه ويسيح متشردًا في مناكب الأرض، بينما فضّل الثاني إزهاق مهجته ونفض اليد من الشعر والحياة سواء بسواء.
(١٨) لعل مرد هذه المعضلة إلى ما يستشعره المبدعون، عادة، من شرخ أو انفصام بين عوالمهم الإبداعية وبين معيشهم الأرضي؛ لذلك سيكون أحد شعارات الحداثة الشعرية في الغرب، كمسعى لردم هذه الفجوة، جعل السيرة الحياتية امتدادًا أو صدًى لمتخيلهم الإبداعي. ومن بين أبرز الأمثلة على هذا تلك المزاوجة اللافتة التي عمل بها شارل بودلير وهو يمضي سحابة الكثير من أيامه متسكعًا في الجادّات الباريسية، ينام أحيانًا في المقابر بدعوى استنصاته لوشوشات الموتى، ثم ما كان من اقترانه بالخلاسية جان دوفال تمردًا منه على المركزية الذوقية الغربية التي تربط الجمال ببياض البشرة وزرقة العينين والشعر الأصهب.. أيضًا آرثر رامبو حين سيرفق سيرته الكتابية، التي سوف تسفر عن عمليه الشعريين الأساسيين والفريدين، «فصل في الجحيم» و«إشراقات»، بما كان لهما من آثار غائرة ليس فيما يخص الحداثة الشعرية الغربية وإنما على بنية اللغة الفرنسية بنفسها، قلنا: سيرفق هذا بسيرة بوهيمية تقتات على رذائل التشرد والشذوذ وتناول المخدرات، هذا ريثما يشد الرحال إلى نورانية الشرق (عدن) والغرابة الإفريقية (هرر، في الهضبة الإثيوبية) متنصلًا، بالمرة، من الشعر، بل مستجيرًا بصمت مذهل، على مدى سنوات اغترابه، عسى أن يعثر فيه على ما توخاه من شعر خالص سيبحث عنه حتى في الصميم من مسلكياته اللاشعرية، كمتاجر في البن أو السلاح، بل حتى البشر. ولنا أن نختم بسيرة الشاعر الروسي المرموق، فلاديمير ماياكوفسكي، الذي لن يتردد في عيش حياته شعريًّا بالتمام، وذلك بالداخل من الجهنمية البيروقراطية السوفييتية، ودليل هذا ما كان من أناقة ملبسه، هو الوسيم أصلًا، وارتداؤه لرابطة عنق منضودة على شكل فراشة، بل ارتياده، في عز حياة الكفاف التي كانت من نصيب الملايين من مواطنيه، في ظل القبضة الحديدية الستالينية، لشوارع موسكو بسيارته الرياضية الفارهة، الشيء الذي كان يحتسب، ساعتها، كميوعة برجوازية مقيتة، أضف إلى هذا حلمه الجنوني بتجوال طويل في ربوع العالم سيكتفي منه، ضدًّا على أمنيته، بزيارة فرنسا والمكسيك في انتظار أن يؤوب إلى موسكو ويطلق رصاصة الرحمة على رأسه كتتويج شعري متطرف لحياته التي لم تَسَعْها الرداءة الاشتراكية واكفهِرار مزاجها.. أو لم يكن حلمه الجارف، مثلما صور في إحدى قصائده، هو أن تقوم مدينة المستقبل ستنشأ من تجاويف دماغ ألبرت أينشتاين، تعرقات سواعد المزارعين والعمال، ثم ائتلاقات خياله الشعري هو…
(١٩) Jean – Marie Schaeffer : Qu’est – ce qu’un genre littéraire ? Coll . Poétique, Ed. Seuil, Paris, 1989, p. 71.

قصيدة أحمد الملا حين تتمرد على رقابة ثقافة تعشق موتها
أيمن بكر – ناقد مصري
في عام ١٩٥٦م نشر ألن غينسبرغ قصيدته الصادمة «العويل» ليصبح واحدًا من أهم مؤسسي جيل البيت في الشعر الأميركي. ليس مهمًّا لهذه الورقة ما أثارته قصيدة «العويل» -وجيل البيت كله- من ردود أفعال اجتماعية عنيفة قادها اليمين الأميركي، وهو ما وصل إلى محاولة تجريم هذه الكتابة، ورفع قضايا على الناشر الذي سمح لهذا الشعر -الذي لا يعدو أن يكون «بذاءات» من وجهة نظر التيار المحافظ- أن يرى النور. المهم هنا هو تعبير المدرسة الشعرية السابقة عن وعي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أميركا، لقد كانت هذه المدرسة الشعرية جزءًا من صرخة شبابية حادة، بعد الحربين العالميتين اللتين أشعلهما الكبار الناضجون سدنة التقاليد والقيم.
 حاول هذا الجيل من الشعراء والسينمائيين وكُتّاب السرد نَفْضَ القُبح الإنساني الذي أغرقه، وشكّل ميراثه الدموي القريب، كأنما يقول صارخًا: أنتم أيها الكبار الناضجون مسؤولون عن عشرات الملايين من القتلى بحكمتكم الكاذبة. لقد أورثتمونا الدم، وأطلقتم أعمق ما فينا من ألم وإحباط ويأس؛ لذا سنريكم -في الطريق نحو الحرية- أقبح ما في الإنسان وأكثره جنونًا.
حاول هذا الجيل من الشعراء والسينمائيين وكُتّاب السرد نَفْضَ القُبح الإنساني الذي أغرقه، وشكّل ميراثه الدموي القريب، كأنما يقول صارخًا: أنتم أيها الكبار الناضجون مسؤولون عن عشرات الملايين من القتلى بحكمتكم الكاذبة. لقد أورثتمونا الدم، وأطلقتم أعمق ما فينا من ألم وإحباط ويأس؛ لذا سنريكم -في الطريق نحو الحرية- أقبح ما في الإنسان وأكثره جنونًا.
استخدمت تلك المدرسة الشعرية تقنيات التشظي، ومجافاة المنطق، والصور الفانتازية، والتعابير العامية الصادمة، وأصوات النواح والتأوُّه التي تبدو خالية من المعنى، إلا ما تثيره في النفس من لوعة وفزع. لكن المهم لنا هو تحول قصيدة العويل السابقة إلى مادة للسينما؛ حيث سعى صُنّاع الفِلْم الذي يحمل اسم القصيدة «Howl» إلى تجسيد تخييلات القصيدة وعوالمها الفانتازية الغرائبية في مشاهد مرئية.
هنا يثور سؤال ربما يمثل مدخلًا لتجربة أحمد الملا الشعرية: كيف أثرت السينما والفن التشكيلي في حركات التجديد في الشعر العربي؟ وكيف عبرت قصيدة النثر العربية تحديدًا عن هذا التفاعل النشط الذي يؤدي إهماله إلى استغلاق النص الشعري لدى قطاع كبير من كتابها العرب؟
* * *
يناقش سيد عبدالله السيسي في كتابه المهم «ما بعد قصيدة النثر» ضعف المرجعية الفلسفية لتيارات التجديد في الشعر العربي، وكذلك غياب العلاقة بين تلك التيارات وبين تيارات الفن التشكيلي التي واكبتها، على العكس من ارتباط قصيدة النثر الغربية بمدارس الفن التشكيلي المعاصرة لها سواء في أوربا أو أميركا. وهو رأي يمكن الاتفاق معه عامة، دونما إغفالٍ لإمكانية تفاعل بعض الشعراء مع الفن التشكيلي بصورة فردية، وطبقًا لظروف استثنائية.
وهو ما يتبدى في أعمال أحمد الملا؛ إذ تدخل لوحات الفن التشكيلي أحيانًا كجزء من جسد النص، أي كجزء من تجربة الإنتاج والتلقّي. نجد ذلك في إصداره الذي يضم عملين؛ «يوشك أن يحدث» يليه «مرآة النائم» ٢٠٢٠م، حيث تشترك لوحات الفنانة ريم البيات في صلب النص الشعري، وهو ما جعل اسمها يوضع على غلاف الكتاب مع اسم الشاعر وبحجم الخط نفسه، إشارة إلى الحضور المشترك الذي يجب علينا ألّا ننظر إليه كتجاور بين نوعين من الفنون يقوم أحدهما بترجمة الآخر أو تأويله، بل كنوع من التأليف المشترك، وهو أمر مربك على الأقل حين يحاول الباحث كتابة بيانات المرجع في الهامش.
في قصيدة «عليكما أن تجدا الشعر معًا» يهدي المؤلفان عملهما إلى شاعر وقاص من أصول لاتينية بهذه الطريقة:
To Alejandro Murguia- San Francisco.
لقد ولد أليخاندرو مورجويا في كاليفورنيا ثم تنقل بين الأميركتين ليستقر به المقام في سان فرانسيسكو مهد حركة البيت، ثم فاز بلقب شاعر سان فرانسيسكو عام ٢٠١٢م. المهم أن أشهر كتبه صدر عن دار النشر نفسها التي أصدرت قصائد ألن غينسبرغ «العويل وقصائد أخرى» للمرة الأولي وهي دار City Lights Books، التي كان صاحبها شاعرًا ضمن تيار «البيت» وهو من خضع للمحاكمة ساعتها بسبب قصيدة غينسبرغ، فهل هي مصادفة أن يهدي الملا والبيات إحدى قصائدهما إليه؟
يكشف العمل الشعري الذي أُهدِيَ لأليخاندرو مورجويا عن تضافر قدرات فنية مختلفة بحثًا عن جوهر الشعر، وهو ما يتجلى في عنوان العمل: «عليكما أن تجدا الشعر معًا». لكن يجب علينا ملاحظة اللوحة التشكيلية التي تأتي في الصفحة السابقة لبداية القصيدة. يبدأ النص هكذا: «على هذه الكلمات/ أن تصل/ دون كلفةِ المعنى/ أن تراها تتحرك في الظلام/ مغمض العينين».
 الكلمات (مادة الشعر) تبدو هي الطرف الثاني في البحث المشترك عن الشعر، بحيث يكون البحث قائمًا بين الشاعر واللغة، لكنها في هذا الكتاب كله كلمات/ لغة ذات مواصفات خاصة؛ إنها تخلع عن نفسها كلفة المعنى، وتتحرك في فضاء المخيلة بما يعني أنها تشكل وسيطَ تعبير مختلفًا ذا سمات مغايرة، تُراوِح بين التصوير اللغوي والفن التشكيلي، وتقترب تشكيلاتها دومًا من سمات المشهد السينمائي الفجائي.
الكلمات (مادة الشعر) تبدو هي الطرف الثاني في البحث المشترك عن الشعر، بحيث يكون البحث قائمًا بين الشاعر واللغة، لكنها في هذا الكتاب كله كلمات/ لغة ذات مواصفات خاصة؛ إنها تخلع عن نفسها كلفة المعنى، وتتحرك في فضاء المخيلة بما يعني أنها تشكل وسيطَ تعبير مختلفًا ذا سمات مغايرة، تُراوِح بين التصوير اللغوي والفن التشكيلي، وتقترب تشكيلاتها دومًا من سمات المشهد السينمائي الفجائي.
تأتي اللوحات التشكيلية لتبدو متوافقة مع هذا الانفتاح لدلالة التشكيل أيضًا؛ فاللوحة السابقة لهذه القصيدة على سبيل المثال تكسر الإطار وتسيل باتجاه فضاء الصفحة، كأنما تشير إلى إمكان التلاقي مع النص اللغوي كأنما هي تتصاعد منه كما يتصاعد الدخان من مصباح علاء الدين متشكلًا في صورة جِنّيّ هو الشعر، أو ربما تسيل اللوحة لتتحول هي نفسها إلى حروف/ كلمات/ القصيدة التالية.
تكتمل القصيدة في الإطار نفسه الذي يجعل من الشعر حضورًا مربكًا مزعجًا ومجاوزًا للأحرف المعتادة، وما يتشكل عنها من كلمات وجمل دالة، لكنه حضور هو ملاذ المبدع من الخوف. فتلك الكلمات/ اللغة الخاصة التي تشكل حلمًا شعريًّا تتصف بأنها تسمع بالعين ويمكن أن تُقرأَ حركاتها، إنها كلمات/ لوحات/ مشاهد تتوحد مع الذات الإنسانية التي ابتدعتها، لتصطفي هي تلك الذات بدورها كي تمنحها الأمان:
كلماتٌ تسمع رنينَها / عندما تفتح عينيك/ وتقرأ حركاتها اللا إرادية/ عليها أن تمضي بك/ وحدك من بين الجموع/ لائذًا بها من الخوف/ والرهبة».
لطالما تَشَكَّى الشعراء من ضيق اللغة الألفبائية، فهل تمثل تجربة «يوشك أن يحدث…» محاولة لاستكشاف آفاق أكثر رحابة للشعر تتضافر فيها وسائط من فنون مختلفة؟
* * *
لا يعني ضعف أثر الفن التشكيلي في مدارس الشعر العربي الحديثة، انتفاء التفاعل النشط بين تيارات التجديد الشعري العربي، وبين ثورة الصورة في السينما تحديدًا؛ وهو ما يبلوره سيد عبدالله السيسي بقوله:
…مع الثورة التي رافقت تطور تقنيات كاميرات السينما، بدأ حضور السينما في الشعر الحديث يفرض نفسه رويدًا رويدًا… وقد انعكس هذا التحول للوعي بالصورة السينمائية، التي قلنا: إنها صارت تشكل المرجعية البصرية المركزية في الوعي بالصورة وفي عمل الخيال، على تشكيلات الصورة في قصائد النثر.
لكن كيف ترتبط تجربة أحمد الملا بشعر ما بعد الحرب كما قدمه جيل البيت؟ أية حرب؟ وكيف تأثرت تجربته بالسينما تحديدًا؟ وهل يمكن أن تتحول خيالات النص الشعري لديه بدورها إلى فِلْم سينمائيّ كما حدث مع ألن غينسبرغ؟
في افتتاح القصيدة التي يحمل الديوان اسمها «تمارين الوحش» يقول الشاعر:
لم أعد متيقنًا مما رأيت/ شككت طويلًا في براعة النوم/ شككت في الليل/ أَنْهَرُ الحُلمَ بيدين عاريتين/ فزعي ملطخ / بدم لزج حار».
يحيلنا عنوان القصيدة والمشهد الافتتاحي، وما يمكن أن تمنحه القصيدة من ثمار تأويلٍ، إلى الحالة الفَزِعَة التي عاشها بطل فِلْم الذئب (جاك نيكلسون/ ١٩٩٤م)، صبيحة أن استيقظ وملأه الشك بأنه قد تحول ليلًا إلى ذئب يطارد الكائنات الحية، ويتغذى على لحمها النِّيءِ. ليست القصيدة إعادة إنتاج للفِلْم، الذي ربما لم يكن حاضرًا في وعي الشاعر، لكن الصورة التي يقدمها النص الشعري تبدو متفاعلة -شاء أم أبى- مع الحالة التي قدمها فِلْم نيكلسون.

ريم البيات
الأمر أكثر تعقدًا من ذلك؛ فالأهم من أن السينما قد منحت الشاعر المجدد مشاهد وصورًا اكتنزتها ذاكرته، أنها مددت أدوات التخييل لديه، لتشمل المشاهد المتحركة ذات الطبيعة الغرائبية التي يندر وجودها في الشعر العربي التقليدي. ألا يبدو ذلك جليًّا في قصيدة «عليكما أن تجدا الشعر معا؟».
يحدث الفارق في الرؤية والتوجه عندما نتقدم في قراء «تمارين الوحش» الذي لن يتخلى مع ذلك عن سينمائية المشهد الفانتازي. فِلْم جاك نيكلسون يضم حبكة، وصراعًا خارجيًّا لازميْنِ لطبيعة النص المرئي، الموجه لجمهور متفاوت من حيث الثقافة والقدرة على الفهم والتأويل، في حين تستخدم قصيدة الملا الصراع الداخلي وحده مادة لها، دونما نظر للقارئ الذي يتشكل لدى الشاعر بصورة لا واعية لكنها انتقائية نخبوية.
* * *
هل يمكن أن تعد القصيدة السابقة وغيرها من إنتاج الملا إعلانًا صاخبًا عما فعله بنا الكبار التقليديون؟ لقد وضعنا أصحاب الخبرات الرتيبة الرافضة لحركة الزمن في مأزق وجودي مرعب: يجب علينا ألّا نقلد الغرب، وفي الوقت نفسه نحن نرزح تحت ثقل عادات وتقاليد أدبية واجتماعية تعوق وتلوث، بتهم جاهزة وبسوء نية عبقري، كلَّ محاولات التحرر الإنساني والعقلي والفني. تبدو تمارين الوحش التي يقدمها الملا إعلانًا ذكيًّا عن الازدواج الحضاري الذي ارتاحت إليه الثقافات العربية، وقررت أن تستنزف فيه أعمار مبدعيها بالتحديد، دونما محاولة حقيقية لمواجهته. يقول أدونيس معبرًا عن الأزمة السابقة: …الشاعر العربي الحديث يرى نفسه في تعارض أساسي مع ثقافة النظام العربي، التي تستعيد الأصول تقليديًّا، ومع الثقافة الغربية كما يتبناها هذا النظام العربي ويعممها. إنه نظام يفصلنا عن الحداثة العربية، أي عن أعمق وأغنى ما في تراثنا، متواطئًا في ذلك مع الاتجاهات التقليدية المهيمنة، ومع بنى ثقافية نشأت في المناخ الاستعماري… وتتمثل المشكلة بجانبها الحاد في كون الشاعر العربي الحديث حقًّا يعيش في حصار مزدوج، تضربه عليه ثقافة التبعية للآخر، من جهة، وثقافة الارتباط الجنيني بالماضي التقليدي من جهة أخرى.
الفانتازيا التي تتحدى بها الصورة الشعرية عند أحمد الملا عقل القارئ؛ هي اقتراح لتجاوز الازدواج المفروض على الشاعر، إنها ميدان انتصار وحيد لا يمكن لبليدي الحس والمخيلة أن يقتحموه، أو أن يقفوا على شفراته التي تنتج المعنى. تنتج الصورة في قصيدة الملا مساحة تحررٍ تخلو من رقابة ثقافات تعشق موتها، وتكره أن ترى الحياة تتفتح. الصورة الشعرية، لدى هذا التوجه في قصيدة النثر العربية، موجعة ومؤلمة للخيال العاجز عن التمدد الحر لملاحقتها.
بعبارة أخرى؛ يمثل التخييل الشعري الذي يقدمه الملا إشكالية مربكة للمتلقي التقليدي، الباحث عن التشبيه المريح والاستعارات الساكنة. إنه تخييل يسهل -ولعله يقصد- أن نصفه بالغلو المزعج. يقول أحمد مطلوب في وصف الغلو البلاغي: «والغلو أحد أنواع المبالغة وقد سماه ابن طباطبا التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحابها فيها، ولم يخرج كلامهم في العبارة عنها سلسًا عذبًا». هذا تحديدًا ما يتعمده كثير من كُتّاب قصيدة النثر العربية، تمامًا كما تعمده شعراء البيت. لقد أصبحت التخييلات الخشنة المغرقة في فانتازيتها ولا معقوليتها طريقًا عبّدها شعراء قصيدة النثر، كمن يعبِّر من خلالها عن تمرده ورفضه، أو كأنما هم يتبعون كلام ابن طباطبا السابق، معلنين كفرهم بالعذوبة المكرورة والسلاسة الخاملة.
يمثل أحمد الملا شريحة مهمة متمردة حيوية بصورة كبيرة من شعراء التجديد الشعري العربي، الذين اختاروا قصيدة النثر مضمارًا لتجاربهم؛ إذ سنجد حالة العنف التصويري الفانتازي الصادم، القادر على تشكيل مشاهد حركية مربكة وجريئة، عند مجايليه في الثقافات العربية على تنوع تفاصيلها، ولنتأمل تجارب زكي الصدير (السعودية)، فتحي أبو النصر (اليمن)، مؤمن سمير (مصر) على سبيل المثال؛ لذا يبدو أن تجارب الملا ومجايليه قابلة لأن تتحول إلى مادة سينمائية، بالمنطق نفسه الذي تحولت به قصيدة ألن غينسبرغ «العويل»، ليصبح التفاعل في الاتجاهين بين قصيدة النثر والسينما.
لكن ماذا عن حضور الحرب؟ سيشعر من يتأمل الشعر العربي الحديث، قصيدة النثر خاصة، بأننا ثقافات لم تزل عالقة في أزمة ما بعد الحرب، وليس المقصود هنا الحرب العالمية الثانية التي لم نكن أكثر المتضررين منها، لكن الحرب بالمعنى الوجودي الشامل، حرب لا تنتهي ولا تسمح بإعلان فائزٍ. نحن عالقون فيما بعد حرب الاستقلال الوطني، وما بعد حروب التحديث الشائه غير المنجز، وحروب تشكيل الهوية الملتبسة غير القادرة على الانسلاخ من الماضي أو الوفاء بمتطلباته المستحيلة.
جميع الداعين إلى حرية الفكر والإبداع هم ضحايا حرب شرسة لا تتوقف مع الفكر الرجعي المتزمت، الحالم بعودة موهومة إلى أزمان انقضت؛ فهل يمكن أن تكون قصيدة النثر العربية هي المعادل الإبداعي لحركات الشعر والفن التي تلت الحرب العالمية في أميركا وأوربا، في تعبيرها عن حروب مكرورة نخوضها بمنطق دون كيخوته؟ تساؤل مفتوح للمناقشة.
هوامش:
(١) Allen Ginsberg, Howl and other Poems (San Francisco, City Lights Books, 1956).
(٢) لا توجد ترجمة عربية لاسم مدرسة شعر البيت Beat Poetry ولا لجيل البيت Beat Generation؛ إذ تتضمن التسمية ظلالًا كثيفة ومتداخلة من معانٍ مختلفة، مثل: الإرهاق، والإحباط، والفوز، ومجافاة الواقع، والروح الجميلة، والإيقاع. لقد مثل جيل البيت حركة شبابية في الموسيقا والشعر والسينما غيّرت بصورة كبيرة من الثقافة الأميركية في وقتها بتمردها على عالم الكبار الممل وادعاءاته الأخلاقية الزائفة، وطرائقه في العيش وإدارة الثروة… إلخ. يراجع حول جيل البيت:
Jamie Russell, The Beat Generation (Great Britain, Pocket Essentials, 2002), 7.
(٣) ظهر الفِلْم الذي يحمل اسم القصيدة Howl عام ٢٠١٠م، من سيناريو وإخراج: روب إبستين، وجيفري فريدمان.
(٤) سيد عبدالله السيسي، ما بعد قصيدة النثر: نحو خطاب جديد للشعرية العربية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠١٦م.
(٥) شعر أحمد الملا، رسوم ريم البيات، «يوشك أن يحدث» يليه «مرآة النائم»، تونس، مسكيلاني للنشر والتوزيع، ٢٠٢٠م.
(٦) لاحظت أن الثيمة الأساسية للوحات ريم البيات في هذا الديوان هي كسر الإطار أو التخلي عنه تمامًا، لينفتح التشكيل التصويري على بياض الصفحة بالطريقة نفسها التي توحي بأن أحد التشكيليْنِ يسيل صانعًا الآخر: التشكيل اللغوي والتشكيل التصويري. يراجع العمل السابق صفحات: ٢٢، ٣٨، ٤٨، ٥٦، ٧٢، ٩٤، ١٠٢، ١٠٦، ١١٤، ١٢٨، ١٤٠، ١٥٤، ١٥٨، ١٦٤، ١٧٨، ١٨٢، ١٨٨.
(٧) سيد السيسي، المرجع السابق، ١٥٠- ١٥١.
(٨) أحمد الملا، تمارين الوحش، بيروت، منشورات الغاوون، ٢٠١٠م، ٢٢.
(٩) أدونيس، الشعرية العربية، بيروت، دار الآداب، ط٢/ ١٩٨٩، ٨٧.
(١٠) أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٧، ج٣، ٩٧.

عندما يكون الشعر آخر المرايا
عبود الجابري
«الوصفة التي خطَّها الطبيب، لم أجرؤ على صرفِها، وضعتُها إلى جانبِ قصائدَ خرِبة، حينها عرفتُ لماذا يصرُّ الأطباء على خطِّ ما لا يُقرأ، كما الشعراء عندما يفسُدُ الشعر في أيديهم ولا ينفع معه علاج». يكتب أحمد الملّا القصيدة كمن يكتب عن صديقٍ بعيد، وهذا النوع من الكتابة يحمل تفاصيل الوقت المفقود، فهو مفضوحٌ بشقيه الريفي والمدني، يتنقل بينهما بخطى مترددة وعين تلتقط الصور، تحملها في حقائب اللغة لتعقد بينهما مقارنات شعرية موجعة: «شدّتني شجرة من كتفي؛ أخّرتني لحظة عن دهسي بشاحنةٍ متهوّرة… طوال النهار تخيلت دمي ذاهلًا على الشارع، صرخات تبقّع الرصيف. ورأيت فزعًا يتنبّه قليلًا ويكمل غفلته».
تلك المقارنات التي أفضت به إلى وضع سيناريوهات مطوّلة لحياته وحيوات أصدقائه والمدن والقرى التي مرّ بها عابرًا أو مقيمًا، ويبدو ذلك واضحًا في تحوّله من كتابة النص الذي يومض بقصره وحدّة لمعانه والتكثيف الذي يسكن مفاصله كما يرد ذلك في مجموعته «تمارين الوحش» نحو النص الأطول، النص المحمّل بإضاءة المكان، وحركة الكاميرات، وزحام الشخوص، وكلاكيت العناوين الجارحة، فيما يتولّى الملّا مهمّة أن يلصق مقطعًا من النص على صدر كلّ عنصر من هذه العناصر، ولا تجد في بنية نصوصه ما هو مهمل أو موضوع بقصد الحشو، فالدبوس الضئيل يدمي في نصوصه بالقدر الذي يُحدِثه الرمح من نزف:
«لو نطقتُ بما لا يُفهم،/ لو أفلَتَ عقال الغامض،/ لتعقّبته كلابُ الصيد،/ يُقاد من رقابه، عاريًا بلا قناع».
وهذا القناع الذي يتوارى خلفه الشاعر أو نصوصه لا يبدو بأية حال من الأحوال متعلّقًا بسمته الشخصي، فهو ليس ذاتيًّا على الإطلاق وإنما هو تصوير ثلاثي الأبعاد، يقوم به سائح عارف بتفاصيل الشوارع التي يمرّ بها عابرًا أو ساكنًا، وفي لحظة سكينة شعرية أو فاصل نفسي يبرز صوت الشاعر بشكل غير محسوس لكنه يعلو في النص كما لو أنّه صرخة ناي جريح؛ كي يشير إلى ذاته التي تتنقل وسط ذلك الزحام ذاته والتي تريد أن تخبرنا أنّه هنا، وأنّه لا يقود تلك الجموع وحسب، وإنما هو فرد من الرهط يوجعه أنّه يملك ما لا يملكه الآخرون من القرائن على فساد العالم :
«سأموتُ بشَعْرٍ طويلٍ/ ولحيةٍ كَثَّةٍ بيضاء/ في مغارةٍ عالية،/ فلا حاجة إلى كَفَن/ أو قبر».
إنّه يتحدث عن الموت رديفًا للحياة الناقصة، وعن الحياة كما لو أنّها جرح ناقص لا يلتئم، ولا يودي بك إلى الموت، يكتب عنه كمرآة ينقصها كثير من الزئبق الذي يتولّى منح الناظر إليها صورة واضحة: «ابحثْ عن صديقك،/ لم يخرج من غرفته منذ يومين./ فتّشت عنه لم أجده./ عدت بها إلى غرفته. سريرُهُ مقلوب/ ورأيت ثياب نومه مكوّمة على الأرض أمام مرآة كبيرة لم تكن موجودة من قبل. وكأنما لمحته فيها، ضحكتُ في سري ودمعتْ عيناي».
شاعر عراقي
الصوت والكلمة
محمود عبدالغني
أحمد الملا شاعر يعبر عن كل شيء بالصوت، وعن كل شيء بالكلمة. في القصيدة لا يمكن التعبير عن الشيء من دون صوتيات. تسمع الشيء والفكرة، وإذا لم تفعل لا بد أن تكون موضوعًا للتوبيخ. إذا أراد الشاعر أن يستمر الصوت، لا بد أن تكون الكلمة قوية. كيف يولد شاعر مثل هذا؟ إنه الشاعر غير القادر على الكلام، الذي يجد نفسه عاجزًا عن الكلام، وهو يخوض مغامرة العالم الغريبة، فيتكلم، وفي هذه الحالة يتكلم ويصوت ما دام قد وجد نفسه مجبرًا على الكلام. لقد كان يخبئ صرخته، وحين أُجبرَ صرخ: «خبأتُ صرختي لمزيد من الندم/ لم أفلتها سهوًا/ عضضتُ عليها/ ولن أفرط في إطلاقها».
كيف نسمع صوتيات وأصوات القصيدة؟ سلامة الكلمة والقول هما اللذان يضمنان ذلك. هناك سؤال آخر أهم من السابقين، بل هو منجمهما العميق: كيف يحدث التزاوج العظيم بين الصوت والكلمة؟ إنها موهبة الشاعر. الموهبة عامل صغير لكنه مثالي، لا أحد يتحدث عنه. الشاعر يضبط نفسه ولا يتكلم (لا يصرخ)، لكن حين تأتيه الكلمة من بحيرة مجهولة، يطلقها، يطلق القصيدة، وحين تسمعها تبقى تنصت مذهولًا إلى صوت عتيق يتدفق:
«وأرسلها عبر جملة قصيرة/ ممهورة بصوتي».
وبعد ذلك؟ كل شيء ينحني للصرخة.
* * *
قصائد أحمد المُلا هي نص سيري؛ لذلك فانتماؤها للناس، وانتماء الناس إليها سهلٌ جدًّا. بل إذا تُدُووِلتْ على نطاق واسع (طبعات، قراءات، نقد، تداول…)، ستحصد في كل مرة جمهورًا جديدًا، فمثل هذا الشعر يحتاجه الناس في سنوات الكساد الاقتصادي، والإفلاس السياسي، والتدهور الاجتماعي والقيمي. إننا نعيش في زمن كما لو أنه سنوات تلت الحرب مباشرة. (اقرأ قصيدة «ما أبحث عنه» من ديوان «يوشك أن يحدث» وقصيدة «اتجاه الحيرة» من ديوان «ما أجمل أخطائي»).
هناك نوع من الفنائية في مجموعة «ما أجمل أخطائي». كل شيء نخافه هو داخلنا. حملناه معنا: «الفزع في جلدك/ الفزع في رئتيك/ حملته فيك…».
هنا تعود إمكانية البقاء والكلام إلى درجة الصفر. نحن كمتحدثين مهددون بالخرس، سنكتم كلماتنا، سنعجز عن القول. وذات يوم سيحدث الانفجار الكبير، حسب تعبير علماء الأرض، وسيتحدث (سيصرخ) الشاعر، فتعود أصغر كلماته إلى الصوت والفعل.
* * *
أحيانًا يكون لانعدام الكلام أهمية تساوي الكلام. في الأولى نحن في جزيرة من الهدوء، وفي الثانية في أرخبيل متكلم مليء بالصوتيات والكلام. من يستحق وَهْبَه هذه الطاقة؟ الذات التي هي في حاجة دومًا إلى البطء والسرعة.
نحن لا نرى ما نراه: «حتى طرق نافذته/ هدهد بمنقاره/ وطار قبل أن يراه».
أليغوريا، بما هي نظام من العلاقات بين عالمين، ومفارقة سامع الصوت من دون رؤية من يُحدثه، رغم أننا حاضرون بكل حواسنا ويقظتنا؛ إنها إحالة إجبارية على كائن يحمل الأخبار.
الشاعر أحمد الملا، هو صانع كل هذا.
شاعرٌ وكاتبٌ مغربي

يريد لكلّ شيءٍ أن يتباطأ لبرهة
أكرم القطريب – شاعر سوري
لا يمرّ نصّ أقرؤه للشاعر أحمد الملا إلّا يؤكّد لي أنّه ليس من الصعوبة تقدير مكانة دقته الشديدة في صياغة قصائده، فأنصتُ هادئًا لتلك الحداءات الطويلة التي ميزت أسلوب كتابته البطيئة، المفردة، والآتية من عزلة أكيدة. هذا الشعر يركن في تلك السهوب ويعيث فيها متواليات ومناجاة لا تنتهي لجمال غائب مذهل لا يراه، حتى في غنائيته الشريدة، التي لها صلة حثيثة بالمكان، تراه يذوي بعيدًا منه.
سأقول: إنّني لستُ في وارد تقديم حكم نهائي لهذه القصيدة، التي تذوب وتتلاشى فيها أصوات عديدة وتنجرّ في ثناياها مشاهد مكسرة تتناثر في صحراء المجاز: أرض متحللة، يباب، مدن ووجوه تذهب في العدم، إشاراتها التاريخية وظلال أشخاصها غير المرئيين. غموض ومناداة وخفقان القلب، تعاويذ اختفاء العالم، إلى تلك الرافعات الضخمة، تبنى مدينة ليست موجودة إلا في الحلم. صوت العابر الذي يلحق بالنهايات. تلتفتُ مفتونًا لثراء اللغة والسرد المقتضب الذي لا يبهت، إنما يتركك تنتبه إلى ما ينهار خلف الكادر، إلى أهوال العرافين. من الصعب تجاوز تلك السطور القليلة من دون أن نلمح المؤثرات الثقافية والبصرية وبعض القطع قصيرة النَّفَس، الآتية من صوت بشري يتعذب وينتشي فقط من مجرّد كلمات يريد أن يكتبها.
مرة واحدة بما يكفي وكأنه يريد لكل شيء أن يتباطأ لبرهة، فكيف نفسِّر هذه القصائد بأن نركن إلى تفسيرات السرد التي لا تستطيع أن تقف في وجه هذه الحماسة، وهي تمتلك أصل حزن كل هذا الشعر، وما يمكن أن يفعله وحده، أن يعلمنا ضرورة اكتشاف ما وراء هذه النداءات، بينما يرمّم جسر الاختلافات بيننا، ويردّ
الجميل للخيال.
تمارين ومسودات تجمع كل هذه الدواوين التي كتبها في قصيدة واحدة، مقطّعة ومبوبة إلى عناوين، يربطها خيط واحدٌ واهٍ وروابط رمزية، ليست مجرد نثر أو مثالًا للتعايش الرومانسي، إنما كتابة قد تنقذ حياة شخص ما، فاللغة، والأصوات، والمكان… كلّها ثيمات تشرح قوة الشعر الغامضة الذي من دون شك، وبكثير من الشجاعة، بقي يحب الظل.
إنها لغة أحمد الملا، ابن الجزيرة العربية، لغة منفى وفَقْد، غير مرجحة إلا لشاعر مثله.
الإتيان بعالمٍ والانقلاب عليه بآخر
بهاء إيعالي
من غير الممكن حصر تجربة أحمد الملا في مسارٍ شعريّ واحدٍ، فالشاعر السعوديّ ابن الأحساء يحاول أن يتعامل مع الكتابة على أنّها أشبه بالتمارين والرياضات الروحيّة للتأمل، فيلج في ماهيّة الأشياء، كلّ الأشياء التي لا يتورع عن الاغتراب منها، ليصل إلى نتاجٍ شعريّ واسعٍ لا يعيد إنتاج ما سلف، ويروي ما ألمّ به من عطشٍ لترك علامةٍ فارقةٍ حادةٍ في الشعر.
 هذا النتاج لطالما أدهش الشاعر القارئ بجديده لا بتجدّده، ففي العودة إلى مجموعته «سهم يهمس باسمي» نجد أن النص ينسحبُ نحو لغةٍ هادئةٍ خفيفةٍ تكرّ كسواقٍ صغيرةٍ في عوالمَ صوفيّةٍ روحانية، صوفيّة تسحب الشاعر معها بحضوره وأشيائه الماديّة الحسيّة لتروحنها وتقيم لها كياناتها الرمزية المتحدّثة بأصواتٍ خفيضةٍ هامسةٍ تبتعد موسيقاها من الحضور الخارجي، وإن أرادت الخروج فخروجها صامتٌ هامسٌ وخفيف، تمامًا حين يقول: «لن يطلع صبح من خزانتك/ لا بئر تنبع في جدار/ ليست عناقيد تتدلى من السقف/ أو شجرًا هائمًا في الزجاج».
هذا النتاج لطالما أدهش الشاعر القارئ بجديده لا بتجدّده، ففي العودة إلى مجموعته «سهم يهمس باسمي» نجد أن النص ينسحبُ نحو لغةٍ هادئةٍ خفيفةٍ تكرّ كسواقٍ صغيرةٍ في عوالمَ صوفيّةٍ روحانية، صوفيّة تسحب الشاعر معها بحضوره وأشيائه الماديّة الحسيّة لتروحنها وتقيم لها كياناتها الرمزية المتحدّثة بأصواتٍ خفيضةٍ هامسةٍ تبتعد موسيقاها من الحضور الخارجي، وإن أرادت الخروج فخروجها صامتٌ هامسٌ وخفيف، تمامًا حين يقول: «لن يطلع صبح من خزانتك/ لا بئر تنبع في جدار/ ليست عناقيد تتدلى من السقف/ أو شجرًا هائمًا في الزجاج».
هذه اللغة الهادئة لا تلبث إلا أن تنقلب على نفسها، لتشفّ عن قسوةٍ حادّةٍ في مجموعته «تمارين الوحش»، فتجد الشاعر يفرج عن ضراوة الكائن المتواري فيه ويندفع الأخير لتخريب العالم الخرب أصلًا، ولربّما جاء هذا الإفراج بعد أن عجز عن لجمه وترويضه ليتماثل ووحشه ويتقمّص دوره، فنجده يقرّ بالتناقضات فيه ولا يحاول أن يخفيها: «شككت طويلًا في براعة النوم/ شككت في الليل/ أنهر الحلم بيدين عاريتين/ فزعي ملطخٌ بدمٍ لزجٍ وحار…».
ولعلّ الغاية المضمرة من هذا التخريب هي تكوين وجودٍ جديد من دون حطام القديم، فالوحش ومهما استشرست ضراوته ففيه تلك الطفولة الصادقة التي تعطيه جانبه الإنساني، هنا يأتي دور الأنثى كمروّض فعليّ لجنوح الوحش المتطرّف وضراوته، فيبدو وكأنّه قد عاد طفلًا جراء حضورها: «كم أحب التفاصيل وأشمّها/ أتحسس بحنان الواله/ لن يدعك تحطّين قطعةً قبل أن يمسح مكانها بملطّف…».
هذا الانقلاب الحاد في عوالم أحمد الملا، ليس إلا رغبة دائمة منه بعدم ارتداء ألبسته نفسها، وكأنّه لا يرغب في الإبقاء على الفِلْم البطيء لحياته المستعملة، بل يحاول أن يجعل من حياته تجددًا دائمًا بأفلامٍ متفاوتة السرعة.
شاعر لبناني

أثر العين
طارق الطيّب
لقائي الأول بالشاعر أحمد الملا كان قبل شهور في مهرجان «ميديين» العالمي للشعر في كولومبيا، الذي يُعدّ أكبر مهرجان شعري عالمي في أميركا الجنوبية، ضم في تلك النسخة ما يزيد على مئتي شاعرة وشاعر من العديد من أنحاء العالم.
رغم أنه كان لقائي الأول وجهًا لوجه بالشاعر ابن الأحساء في شرق السعودية، فإنني شرعتُ من فوري أفتّش في ذاكرة الأزمان، التي سبقت مولِديْنا، أينَ التقينا من قبل؟ فالعين لم تعد تستغرب العين التي لاقت، بل أحسّت بأن تاريخًا أزليًّا أقدم بكثير من هذا اللقاء الفاتن قد سبق.
ولأحمد الملا حضور لافت بين الناس، بطبيعته البسيطة الأصيلة الموروثة وابتسامته الآسرة التي تجذب الجميع إليه. في لقاءاته العديدة ضمن هذا المهرجان بالجماهير العريضة المتعطشة للشعر، أبدع الملا بقصائد عميقة وبصوت عربي خلاب، مزج فيه قصائده مع عازف موسيقيّ محترِف، مما أضاف بهجة إضافية لجمهور متفاعِل مرحِّب هامَ به، فصار نجمَ الافتتاح والختام.
في كولومبيا أهداني الملا ديوانه «كتبتنا البنات»، هذا الديوان البديع الذي قرأته في كولومبيا مرةً، وأعدت قراءته في فيينا مرةً أخرى. ديوان تبرز فيه -من وجهة نظري- تجربة الوجدان وحس الطبيعة بصفاء، مقارنة بديوان «تمارين الوحش» الذي تتجلى فيه تجربة الوجدان والوجود الحسي بجلاء أيضًا؛ ففي «كتبتنا البنات»، تبرز جدلية الحياة والموت عبر سؤال الحنين في قاموس ثريّ لشاعر منشغل بالطبيعة: بالبحر، والتلال، والشجر، والورد، والجبال، والغابات، والطين، والجليد، والصخر، والملح، والشمس، والليل، والظل، والجنة، والنار، والغيم، والسناجب، والغربان، والطير، والفخاخ، والعاج والريش.
شاعر منشغل بالمرأة القريبة التي يعرفها في: زعفران الأم، وكهرمان الجدة، وسند الأخت، وأحلام البنات. متأملًا الندوب والتعاويذ والابتهالات والأضرحة، مدركًا أسرار الغزاة والرعاة، صاعدًا للأعالي وهابطًا أيضًا للأعالي حين يحدثك عن القهوة أو عن كتاب في مكتبة.
يقول الملا في قصيدته «وقصصت رؤياك» في ديوان «كتبتنا البنات»: «أما بعد/ فأكلتنا الحروب حربًا حربًا/ لا سجّيناكَ بثوبك/ ولا نفضنا التراب عن جبينك/ (…) امرأة آوتك من التيه/ اصطفتك من بين الطارقين وأغلقت الباب./ امرأة نسجت لك الليل/ أشعلته وقرّبت الكتابَ بين يديك/ امرأة وضّأتك بالضوء/ امرأة وضعت لك ووضعت عليك./ في غيابك تغيبُ ولا نرى نارها إلا في أول البشرى».
يكتب أحمد الملا عن ثمرات ناضجة بأسلوب رزين متأمل وهذه مزيته التي تلازمه.
* * *
في الديوان الثاني الذي قرأته لأحمد الملا «تمارين الوحش» تعلو تجربة الوجدان والوجود الحسي، وتنقلنا لسؤال الحياة ببصيرة المتأمل والعازف في آنٍ؛ المتأمل في التجربة الشعرية والمبتعد من القصيدة الشعرية الكلاسيكية والمتمسك بقيمة التراث من دون قيد أو سَجْن، فهو عازف لأنه شاعر لا يهدر وقته في الدفاع عن قصيدته النثرية بحروب خارجها، وإنما يكتبها بخير وسيلة للدفاع عنها.
يقول في قصيدته «فِلمٌ بطيءٌ لحياةٍ مستعملة» في ديوان «تمارين الوحش» ملخّصًا عينه الفنانة الثاقبة التي ترى مدى الأفق: «(…)/ لا أشتهي صورةً ذابلةً/ لحياةٍ اهترأتْ/ من شدّةِ الاستعمال».
ويقول في نص «هيوستن: شهواتٌ مُصَفّدة»: «(…)/ كنتُ الكأسَ،/ ملآنةً برَهافةِ السُّكْرِ/ وانكسرتُ./ زُجاجتي زَلّتْ من فوقِ رفٍّ مُهْمَل،/ سَليلةَ صحراءٍ مُتْرَعَةٍ بنَواعِمِ الرِّمال./ (…)/ كُنتُ البدويَّ/ في الصَّمّان،/ والذِّئبَ الجريحَ في الرُّبعِ الخالي،/ بيني وبين النجوم، نَسَبٌ ورِفقةُ حُدَاء».
أحمد الملا شاعر واسع الرؤية عميق البصيرة، ولا غرابة في الأمر فالرؤية البصرية منحة وهبة امتلكها منذ مولده ويسعدنا بنقلها لنا شعرًا.
شاعرٌ وروائي سودانيّ
صحراء شاسعة في كفّه
عاشور الطويبي
 «ليتنا استطعنا/ تأويلَ أحجارِنا/ ولم يكن الرحى تفسيرَنا الوحيد./ ليتنا أطعنا/
«ليتنا استطعنا/ تأويلَ أحجارِنا/ ولم يكن الرحى تفسيرَنا الوحيد./ ليتنا أطعنا/
نفرةَ الجسد وصراحتَهُ الجارحة»؛ أحمد الملا.
* * *
«شاعرٌ يتلو واقفًا/ قصائدَه في مقبرة، كلَّ صباح./ يهمسُ أحيانًا في الرمل/ وعلى كل حجرٍ، يغنّي/ ويرقّقُ القول./ يتخيّلُ أشجارًا/ ولا يكرّرُ لونَ
وردة»؛ أحمد الملا.
* * *
«صحراءُ شاسعةٌ في كفِّه»؛ أحمد الملا.
* * *
كيف لشاعرٍ يحمل الصحراء في كفّه، أنْ يأخذ قفزته العظيمة بين حجر وبحر؟ كيف له وهو يغرس جسده بين جبل ووادٍ غير ذي زرع، أنْ يشهد طيران شهقته في فضاء الكون؟ كيف له وهو المسافر أبدًا في القرب والبعد، في السابح والطائر من لذائذ الحياة ومراراتها، أنْ يُبعد بين أوتار اللحن الخالد الملقى في مفازة الروح؟ كيف له، وهو الذي نسج من موج الكلام رداء القلق، أن يسكن في باطن كفّ اليقين؟ كيف له، وهو الذي سرق نار اللحظة، أنْ يخبئ نضارة القصيدة في عين الصقر؟ كيف له، وهو الراكض في مضمار الفتوّة، أنْ يمنح التيه أسماءه الجديدة؟
الخطوات التي ليست له، لدبيب الأرض. الخطوات التي له، لا يراها غيره، وهو الهارب أبدًا منها! «هب لي سبيبة خيل أقبض بها على الزلزلة العظيمة» يقول وهو يلوّح بيده إلى كائن يحرث حقل ورد.
أحمد الملا، وشعراء من جيله وجيل بعده، جوابون في أرض الشعر وسمائه، زادهم مخيلة لا تتعب وأيدٍ لا تتوقّف عن الحفر في ملكوت هذه التي نسميها: القصيدة/ الروح!
طوبى له ولهم.
شاعرٌ ومترجمٌ ليبي









 يأتي المشهد الثاني استمرارًا لتلك العلاقة الملتبسة وللحركة الداخلية نفسها، فيبتدئ باللقطة الافتتاحية نفسها «حظي قليل» لكن تلك العلاقة تنفتح زمنيًّا إلى ولادة الشاعر في غير زمنه، وتقدم إضاءة أخرى حول رفضه وجحود عمله «فكلما أعلنت ولادة شجرة/ رجمتُ بأحجار مقلوعة من سوري/ يتشهون وردي/ ويوغرون صدر النهر…»(٧).
يأتي المشهد الثاني استمرارًا لتلك العلاقة الملتبسة وللحركة الداخلية نفسها، فيبتدئ باللقطة الافتتاحية نفسها «حظي قليل» لكن تلك العلاقة تنفتح زمنيًّا إلى ولادة الشاعر في غير زمنه، وتقدم إضاءة أخرى حول رفضه وجحود عمله «فكلما أعلنت ولادة شجرة/ رجمتُ بأحجار مقلوعة من سوري/ يتشهون وردي/ ويوغرون صدر النهر…»(٧).
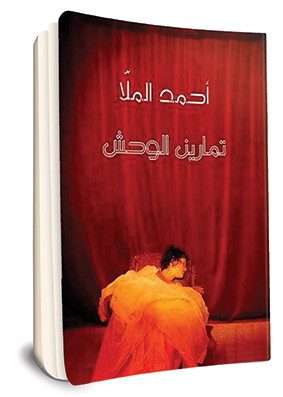 «كان يا ما كان/ يندفع المجنون خلف دمه/ ملتاثًا بليلاه/ يصرعه الهوى بين المنازل والهضاب/ فريدًا، لا خيل له ولا خلان». – «أكتب حكايتي»، ص 146.
«كان يا ما كان/ يندفع المجنون خلف دمه/ ملتاثًا بليلاه/ يصرعه الهوى بين المنازل والهضاب/ فريدًا، لا خيل له ولا خلان». – «أكتب حكايتي»، ص 146.
 حاول هذا الجيل من الشعراء والسينمائيين وكُتّاب السرد نَفْضَ القُبح الإنساني الذي أغرقه، وشكّل ميراثه الدموي القريب، كأنما يقول صارخًا: أنتم أيها الكبار الناضجون مسؤولون عن عشرات الملايين من القتلى بحكمتكم الكاذبة. لقد أورثتمونا الدم، وأطلقتم أعمق ما فينا من ألم وإحباط ويأس؛ لذا سنريكم -في الطريق نحو الحرية- أقبح ما في الإنسان وأكثره جنونًا.
حاول هذا الجيل من الشعراء والسينمائيين وكُتّاب السرد نَفْضَ القُبح الإنساني الذي أغرقه، وشكّل ميراثه الدموي القريب، كأنما يقول صارخًا: أنتم أيها الكبار الناضجون مسؤولون عن عشرات الملايين من القتلى بحكمتكم الكاذبة. لقد أورثتمونا الدم، وأطلقتم أعمق ما فينا من ألم وإحباط ويأس؛ لذا سنريكم -في الطريق نحو الحرية- أقبح ما في الإنسان وأكثره جنونًا. الكلمات (مادة الشعر) تبدو هي الطرف الثاني في البحث المشترك عن الشعر، بحيث يكون البحث قائمًا بين الشاعر واللغة، لكنها في هذا الكتاب كله كلمات/ لغة ذات مواصفات خاصة؛ إنها تخلع عن نفسها كلفة المعنى، وتتحرك في فضاء المخيلة بما يعني أنها تشكل وسيطَ تعبير مختلفًا ذا سمات مغايرة، تُراوِح بين التصوير اللغوي والفن التشكيلي، وتقترب تشكيلاتها دومًا من سمات المشهد السينمائي الفجائي.
الكلمات (مادة الشعر) تبدو هي الطرف الثاني في البحث المشترك عن الشعر، بحيث يكون البحث قائمًا بين الشاعر واللغة، لكنها في هذا الكتاب كله كلمات/ لغة ذات مواصفات خاصة؛ إنها تخلع عن نفسها كلفة المعنى، وتتحرك في فضاء المخيلة بما يعني أنها تشكل وسيطَ تعبير مختلفًا ذا سمات مغايرة، تُراوِح بين التصوير اللغوي والفن التشكيلي، وتقترب تشكيلاتها دومًا من سمات المشهد السينمائي الفجائي.


 هذا النتاج لطالما أدهش الشاعر القارئ بجديده لا بتجدّده، ففي العودة إلى مجموعته «سهم يهمس باسمي» نجد أن النص ينسحبُ نحو لغةٍ هادئةٍ خفيفةٍ تكرّ كسواقٍ صغيرةٍ في عوالمَ صوفيّةٍ روحانية، صوفيّة تسحب الشاعر معها بحضوره وأشيائه الماديّة الحسيّة لتروحنها وتقيم لها كياناتها الرمزية المتحدّثة بأصواتٍ خفيضةٍ هامسةٍ تبتعد موسيقاها من الحضور الخارجي، وإن أرادت الخروج فخروجها صامتٌ هامسٌ وخفيف، تمامًا حين يقول: «لن يطلع صبح من خزانتك/ لا بئر تنبع في جدار/ ليست عناقيد تتدلى من السقف/ أو شجرًا هائمًا في الزجاج».
هذا النتاج لطالما أدهش الشاعر القارئ بجديده لا بتجدّده، ففي العودة إلى مجموعته «سهم يهمس باسمي» نجد أن النص ينسحبُ نحو لغةٍ هادئةٍ خفيفةٍ تكرّ كسواقٍ صغيرةٍ في عوالمَ صوفيّةٍ روحانية، صوفيّة تسحب الشاعر معها بحضوره وأشيائه الماديّة الحسيّة لتروحنها وتقيم لها كياناتها الرمزية المتحدّثة بأصواتٍ خفيضةٍ هامسةٍ تبتعد موسيقاها من الحضور الخارجي، وإن أرادت الخروج فخروجها صامتٌ هامسٌ وخفيف، تمامًا حين يقول: «لن يطلع صبح من خزانتك/ لا بئر تنبع في جدار/ ليست عناقيد تتدلى من السقف/ أو شجرًا هائمًا في الزجاج».
 «ليتنا استطعنا/ تأويلَ أحجارِنا/ ولم يكن الرحى تفسيرَنا الوحيد./ ليتنا أطعنا/
«ليتنا استطعنا/ تأويلَ أحجارِنا/ ولم يكن الرحى تفسيرَنا الوحيد./ ليتنا أطعنا/


0 تعليق