هل نحتاج إلى مناسبة للاحتفاء بالمتن الشعري الذي يراكمه الشاعر سيف الرحبي (1956 – ) ؟ منذ أكثر من أربعة عقود، أم أن كل كتاب يصدره، سواء كان شعرًا أو رحلات أو يضم افتتاحياته، التي لا تشبه أغلبية افتتاحيات سائر المجلات، الأدبية والثقافية منها، هو في حد ذاته مناسبة فريدة للقراءة وإعادة القراءة وإثارة الأسئلة حول كتابة تذهب بالقارئ إلى أقاليم جديدة، وتبتكر علاقة مع موجودات وكائنات لا يتنبه لها عادة الشعراء والكتاب، كتابة تقول الوجود وتكتشف خفاياه على طريقتها، التي تمزج الشعري والملحمي بالفلسفي والفجائعي، مع مسحة تشاؤم تطغى حينًا وتتخافت حينًا آخر، حول المصير الإنساني الذي تتهدده الكوارث بالفناء.
يقف سيف الرحبي، كما يقول الناقد السعودي سعد البازعي، على رأس تجربة شعرية «قد تكون بين الأكثر كثافة في التفاعل مع البيئة المحيطة، من ناحية، واختلافًا في مفردات البيئة التي يستدعيها، من ناحية أخرى، وكذلك، في طبيعة العلاقة بينه وبين تلك المفردات».
يكتب سيف الرحبي، الذي أصدر عشرات الكتب وبات باعتراف نقاد كثر أحد الأركان الأساسية للقصيدة العربية الحديثة، وهو ممتلئ بالعالم، على تلاطم أحواله، عنيفًا وموحشًا كان أم مسالمًا، قاحلًا أم وارفًا بالظلال والأشجار والأنهار والبشر. لا يكتب عن الأشياء والموجودات والمخلوقات التي تفرد بتأمل أحوالها، بقدر ما يرى العالم من خلالها، ويتفحص مآل الإنسان ومأزقه الوجودي، في برهات متقطعة ومتعددة، لكن توحدها مقادير عادلة من القسوة والشر والبؤس، الذي يغزو الوجود كله.
لعل سيف الرحبي، الذي يَوقِّع أعمالًا شعرية تَسهَر بقُوَّة على فجر القول بحسب الناقد المغربي نبيل منصر، بين ندرة من الشعراء، استطاعوا بلورة مشاغلهم بمفردات أضحت معروفة، ومعروفة لا تعني اكتمال معناها، بقدر ما أخذت تتوالى لتصير هوية، بدورها، ليست قارة على ملامح، إذ هي قلقة، ومتحولة.
الشعر ليس خيار العارف بالطريق
سيف الرحبي
العين التي شاهدت، أول ما شاهدت في إطلاق نظرتها الأولى إلى الوجود والأشياء، تلك الأرض الشاسعة التي تلتقي أطرافها الثلاثة في سديم الصحراء والجبال والبحار المتلاطمة في الواقع والمخيلة .الأرض المترامية بحياة قليلة وسراب هائل، وصفها الرحالة «ويلفرد ثيسجر» وهو يقطع الرُّبع الخالي في ثلاثينيات القرن العشرين فيما يشبه عبور الأسطورة، بصحراء الصحاري. هذه الطبيعة المحتشدة بالهوامّ والذئاب وبنات آوى، أراجيح طفولتنا البعيدة، والمحتشدة بالحنين. هذه الطبيعة اليتيمة التي قُدَّت من براثن بركان، على صفحتها وُلدت وتفتحت أسئلتنا الأولى، دهشتنا وهواجسنا كمشروع وجود صعب وممكن.
ربما كتبتُ أول قصيدة وفق النظام المغلق في كهوف السلف ولغته، لأن أي خروج عنه مروق وإلحاد، وما زال أصحاب هذا الرأي الظلامي عند رأيهم حتى لحظتنا الراهنة، وبشكل أكثر عنفًا وتطرفًا ولاعقلانية. لكن ما ظل يطاردني لاحقًا، بجانب التكوين الشعري الكلاسيكي الذي لا أشك في الإفادة منه، هو تلك القصيدة العنيفة التي يكتبها المكان نفسه بغموضه وموته، وكيف تنبجس الحياة الشحيحة من مخالب ذلك الموت القاسي ذي الحضور الكلي. كانت الجنازة اللامرئية في رأسي بحجم ذلك الفراغ الذي يتدفق فيه الزمن كثيفًا وحادًّا، محاطة بجوقات النادبات والمنشدين.
* * *
حدثٌ جوهري، طبع حياتي ووسمها بقدره الخاص، هو انفصالي المبكر عن ذلك المكان الولادي، ورحيلي نحو القاهرة ومن ثم الشام، وبيروت. وقد بدأت في دمشق نشر الكتب الأولى والمقالات، لينفتح المشهد الحياتي لاحقًا إلى آخر مصاريعه ومتاهاته، وكأنما الأسلاف الرُّحل خلعوا عليّ لاشعورهم الجمعي، عبر نسيج من الاختيارات والصدف التي كانت تلفّ مناخات تلك المرحلة.
* * *
كان الجوُّ القاهري يعجُّ بالأيديولوجيات والاتجاهات في حقولها المختلفة، على رغم أن بيروت كانت الأكثر صخبًا وسجالًا وعمقًا في مغامرة التجديد والاختلاف. من البوابة القاهرية ولجتُ إلى بوابة القراءة للأدب الحديث برموزه ورواده ووجهاته المختلفة عربيًّا وغير عربي. كانت تلك المرحلة المبكرة للانفصال، الرابعة عشرة من العمر، بقدر ما هي منطلق الدخول في الطور الثاني والمعترك الجديد الذي طبعني سلوكًا وكتابة بطابعه الحاسم، أصابتني بصَدْع كيان، على ما يبدو كان مستعدًّا أكثر لتلقي الصدوع والانشطارات من الانسجام البراني والتآلف.
* * *
وجدت نفسي جزءًا من جيل عربي يقتسم سمات الكتابة والحياة والترحل. جيل غير مستقر بالطبع، هائم بين ثكنات الأفكار والشرطة والمدن، تلفحه رياح اليأس والنقض والتسكع. لقد فتح عينيه ذات صباح على هزائم وانهيارات لا تُحصى، وعلى ما هو أحقر وأبشع من الحروب الأهلية التي عرفها التاريخ. كان عليه أن يغامر في مواقع كثيرة اهتزَّ يقينها مفهومًا ولغة كانت ذات يوم مثار عاطفة جياشة وربما مشروعًا لا شك في نبل مراميه وأهدافه.
كان عليه أن يبحث بين الأنقاض والجثث عن لغة تستطيع لمّ شمل هذا التشظي والانكسار الذي يلفّ الفرد والجماعة بآفاقه المدلهمة… ها هو الربع الخالي مرة أخرى، لكن في زمان ومكان مختلفين وعبر وعي مختلف. متاهة في المكان ومتاهة في الرأس جعلت المُثل والرموز والأقنعة تتكسر عند أول شروع في التفكير والكتابة.
* * *
ليس في ذهني وهم القطيعة التي يرتهن بها البعض، ولم أرَ يومًا أن قصيدة النثر حلت محل سابقاتها، على رغم انتشارها وتحولها إلى ما يشبه المتن الشعري، كذلك لا أرى ولا أستسيغ التفكير في أن هذا النمط التعبيري يحلّ محلّ آخر ويقصيه من أرض الإبداع، فأشكال التعبير في تاريخها مفتوحة على المتغيّر والمتحول.
* * *
الوجود جميعه خريطة لهواجسنا وأحلامنا وتناقضاتنا، مسرح لصنيع الكتابة وتجلياتها المختلفة. فالحياة والموت والمسألة الاجتماعية والانحطاط الحضاري والحب والكراهية، لا تنفصل عن شعرية الأشياء ولا تقابلها.
* * *
اللغة مهما كانت محمَّلة بتاريخها الطويل وتراكماتها، ليست ممارسة قبلية ومعطاة سلفًا، بل على صعيد الكتابة، محاولة كشف وسبر أغوار وعتمات، وهي محصَّلة اندماج المعيش بالمتخيل. هذا المعيش الذي أفضى إلى ما هو عليه عربيًّا، صار أكثر استفزازًا للكتابة الشعرية التي واصلت نقضها وضديتها حتى حدود العدوانية.
* * *
الموت كما الحياة. مسرح الكتابة. إن هذا الجسد المحاط بهوامّ الموت وهواجسه ومطارقه التي لا تهدأ ليل نهار، لا يمكن مواجهته أو التخفيف منه إلا عبر اللغة وربما الذوبان فيه وتحويله إلى كائن أليف. إنها المنطقة الأكثر خطورة التي تلجها الكتابة، المنطقة التي تشبه منطقة في الربع الخالي تُدعى «عروق الشيبة» التي تبتلع تحولات رمالها الهائجة قطعان الجمال والماشية والبشر من غير أثر وكأنها لم تكن.
إذا كان العالم هو مادة الشعر، فمكان ما يستحيل عالمًا، هكذا يلتهم الربع الخالي العالم ويستوعبه. وكما عبر إزرا باوند: «تأريخ كائن ما لا يعبرّ عن المكان المغلق الخاص بحياته بل عن إرادة تشرده».
* * *
الذئاب والضباع وبنات آوى ومختلف ألوان الجوارح والسباع، والصخور البركانية ولا نعدم طيورًا أليفة وجنانًا خضراء لا حدود لتموجاتها الناعسة، قبل أن يقطف الجد الأكبر تفاحته ويسقط على هذه الأرض الرهيبة. لتبدأ ملحمة الفَقْد والقتل والحنين… هذه العناصر التي سكنت أعماقنا وسرت في عروق السلالة، ذابت في نسيج النص مع الشوارع الكبيرة في ليل المدن وأنفاق المترو والمقهى الملاصق للأستوديو، وتلك المرأة ذات الملابس الخفيفة في صيف الحديقة العامة حيث يتصادم الغرباء، جامعة إياها وحدة التيه والاغتراب الأزليّين.
* * *
لا يمكنني الشروع في أي كتابة مهما كان هاجس جدتها ومدنيتها إلا ويتدفق ذلك الكون البري، منازل الخطوة الأولى ليكون لحُمة النص وسداه. لقد فرضت عليّ هذه «التيمات» أو الموضوعات، إن كانت هناك موضوعات لهذا المناخ الملحمي، أن أمضي بجانب القصيدة المقطعية والشذرة في كتابة قصائد طويلة تشكل متن الديوان وتتوسل مناخات شبه ملحمية، لكن لا توجد فيها عناصرها المعروفة ولا تستدعي حبكات وأساطير وتصورات جاهزة، بل تتلمس طريقها في العتمة بأدوات معرفة قليلة وبألم وحدس أكبر ربما عبر متواليات تحاول الانتظام فيما يشبه النص المفتوح.
* * *
إنني أحاول التجريب، بوصف التجريب قرين حياتنا ومكونًا بين مكونات شتاتها ونسيجها، إن صحَّت هذه المفردة الأخيرة. أو إنني في خضمِّ هذا المناخ وتأثيراته المختلفة من طور زمني إلى آخر. كالصدفة تمامًا، كالصيد في الظلام الكاسح، التجريب بهذا المعنى يشبه عصا الأعمى الباحثة في الزقاق عن مخرج، إن ثمة مخرجًا يوصل إلى الطريق العام أو الجماعة. إنه ليس خيار العارف بالطريق.

الانحياز للكائنات
سعد البازعي – ناقد سعودي
في نص قصير بعنوان «شبه» من مجموعته «جبال» يقول سيف الرحبي:
لم نعد نشبه هذا البحر
ولا هذه الأرض
يبدو أن قرونًا مرت بزواحفها
ونحن نيام
الشبه المفقود بالمكان، بحرًا كان أم جبلًا، يشكل قلقًا عميقًا يتكرر في عدد من مجموعات الرحبي التي بدأت تملأ أفق الشعر في الجزيرة العربية منذ ما لا يقل عن أربعة عقود لتشكل ركنًا أساسيًّا من التجربة الشعرية العربية الحديثة. والقلق المشار إليه عنوان تميز لدى الشاعر العماني من حيث هو يرسم علاقة مختلفة بمعالم البيئة في جنوب الجزيرة بصفة خاصة حيث تشمخ الجبال بين رمال الربع الخالي وبحر العرب ويمتد تاريخ من التفاعل الإنساني المنتصر حينًا والمهزوم حينًا آخر، أو ربما أحيانًا.
في أعمال نقدية سابقة وجدت أن إرثًا خاصًا يربطني بشاعر تتمدد رؤيته وتتشكل لغته من جغرافيا الانتماء والهم المشتركين. كان حاضرًا في عدة قراءات لشعر هذه المنطقة من الوطن العربي. رأيته شاعر قصيدة نثر من طراز رفيع، ورأيت لديه أنموذجًا استثنائيًّا لملامح ما أسميته «ثقافة الصحراء»، الثقافة الناجمة عن الشعور بأننا «لم نعد نشبه هذا البحر ولا هذه الأرض» وأننا بحاجة إلى معانقتهما مجددًا تلمسًا لملامح تتسرب في أسفلت المدن ومداخن المصانع وحمى الاستهلاك. تلك الثقافة التي رأيت بعض سماتها لدى محمد الثبيتي وعبد الله الصيخان وعلي الدميني وغيرهم هي ما تبينته بعد ذلك، حين اتسعت الدائرة، لدى أحمد راشد ثاني من الإمارات وعلي الشرقاوي من البحرين وسعدية مفرح من الكويت وسيف الرحبي من عمان، وآخرين.
لكن مثلما أن لكل من أولئك الشعراء سماته المتفردة، يقف الرحبي على رأس تجربة شعرية قد تكون بين الأكثر كثافة في التفاعل مع البيئة المحيطة، من ناحية، واختلافًا في مفردات البيئة التي يستدعيها، من ناحية أخرى، وكذلك، وهو ما يهمني هنا، في طبيعة العلاقة بينه وبين تلك المفردات. في حوار نشر في الملحق الثقافي لصحيفة «الخليج» الإماراتية عام 2010م وصف الرحبي جانبًا رئيسًا من تلك العلاقة بالبيئة المحيطة حين أشار إلى ثنائية الصحراء والبحر بوصفهما «الكيانين الجبارين اللذين اعتاد أسلافنا، وجبلوا على الصراع معهما»، مضيفًا أنهما، إلى جانب الجبال، يشكلان طبيعة «تنسحب وتخترق استعاريًّا ورمزيًّا ما يطمح التعبير الشعري الأدبي إلى قوله عبر أدواته اللغوية والجمالية». غير أن اللافت هنا هو ما اختص به الشاعر العماني الجبال تحديدًا في قوله إن «هذه الأوتاد الصخرية الضاربة في عمق أعماق الأرض تشكل ربما نوعًا من الثبات الأزلي الذي يتوسل إليه أحيانًا النشيد الشعري ويلوذ به من تلك التحولات العاصفة الخطيرة في الزمن والصحراء والبحر». تتميز الجبال إذا على المكونين الآخرين، الصحراء والبحر، بهذا الرسو أو الرسوخ الذي يجد فيه الشاعر الملاذ الآمن، حين يضيف في المقابلة نفسها: «يحتل الجبل هذه المكانة الشعرية الاستعارية كملاذ روحي».
غير أن قارئ الرحبي سيجد أن الملاذات في شعره لا تنحصر في الجبال وإن برزت هذه التكوينات الصخرية الهائلة على نحو يفوق غيرها، كما في مجموعته «جبال» الصادرة عام 1996م. لكن الجبال لا تستدعي الصخور فحسب وإنما تستدعي كائنات أخرى تأتي الطيور في مقدمتها، الطيور التي تطل كثيرًا من قصائد سيف لتطاول الجبال نفسها. كما في قصيدة «لقالق» من مجموعة «جبال» أيضًا:
آه من يمتلك روح اللقالق
في عزلاتها الكبرى أمام البحر
وحيدة تنام وحيدة تستيقظ
بعيدة عن السرب
كانت في الماضي تتنزه على أطراف النهر
بأعماق الوادي
تطاول الجبال بأعناقها…
لكن هذا التماهي باللقالق، التماهي الذي يؤكده الإعجاب بعزلة تلك الطيور وتأبيها على الانضمام إلى «السرب»، يخرج عن رومانسية حالمة تعد بالتنامي في النص حين يدخل المشهد سرب من نوع آخر، سرب إنساني ولا إنساني، سرب البشر حاملين عنفهم المعتاد:
كانت البنادق مهيأة للصيد،
بنادق بأيدي صبية يصلون إلى رأس الوادي بنهايته في
أعالي (سمائل)
وكانت اللقالق تفصد الهواء الفاسد
فوق الرؤوس.
عنف الإنسان وسلم الكائنات
ثمة تقابل هنا بين عنف الإنسان وسلم الكائنات، بل عنف الفعل الإنساني متمثلًا بالصيد، وجمال ولطف الفعل الذي تمارسه اللقالق حين «تفصد الهواء الفاسد فوق الرؤوس» وكأنها تسعى لإصلاح أهواء البشر وليس هواءهم فحسب.
يتكرر التماهي بالطيور في قصائد أخرى لسيف الرحبي على نحو يشكل موقف نقدٍ للمجتمع البشري بقدرما يعلن انتماءً أو انحيازًا للطبيعة سواء تمثلت بمكوناتها الرئيسة، الصحراء والبحر والجبل والنهر، أو بالكائنات المتسقة في حياتها مع تلك المكونات. يحدث ذلك على نحو يستدعي قراءة نقدية بيئية من النوع الذي استطاع في السنوات الأخيرة أن يستكشف سمات العلاقة الأدبية بالبيئة ويطرح أسئلة تختلف عما اعتاد نقاد الشعر الرومانسي تحديدًا طرحه (والمقصود في المقام الأول الشعر الرومانسي الأوربي بوصفه الذي جعل البيئة موضوعة شعرية كبرى وأثيرة).
هنا تتساءل القراءة عن مدى التماهي بالبيئة، مدى الإحساس بمكوناتها، وقدرة النصوص على استيعاب ذلك في خطاب لا يتنازل عن أدبيته أو شعريته بل يجعل تماهيه جزءًا من تلك الأدبية أو الشعرية. ولأني أجد لدى سيف الرحبي ما يبرر تلك القراءة رأيت هنا أن أذكّر ببعض سماتها لا على سبيل الاستكشاف المستقصي أو الطرح المتكامل، وإنما من أجل وضع تلك السمات موضع النظر لقراء سيف وقراء الشعر العربي المعاصر بصفة عامة. فبعض ما لدى سيف مطروح لدى شعراء عرب آخرين أشرت إلى بعضهم آنفًا.
لو تأملنا فقط مجموعة «قطارات بولاق الدكرور»، وهي من مجموعات الرحبي الأخيرة (2010م)، لأدهشنا في قائمة القصائد عدد تلك التي تتجه إلى الطبيعة أو الكائنات كما تشير العناوين: «مطر»، «أنهار»، «الشعور بالبركان»، «عواء الذئب»، «طائر العقعق»، «وحيد القرن»، «الغابة»، «على حد الصيف عن البراكين والموتى والحيوانات». وهناك بالطبع ما لا تشير إليه العناوين في القصائد وهي من الكثرة بحيث تكاد تحتل مساحات المجموعة بأكملها.
النظر إلى العالم من زوايا الكائنات
ما يسترعي الانتباه بصفة خاصة هو النظر إلى العالم من زوايا تلك الكائنات، سعي الشاعر إلى التوحد بها، بالجبل كما بالنهر أو الطائر أو حتى الضفدع، لكي يبدو العالم كما لم يبد من قبل. في بعض تلك النصوص تبدو الصورة رومانسية تقليدية بامتياز، كما في «غابة» حيث يسود الانسجام بين عناصر المشهد: «كل شيء ينحني بحنان وكبرياء/ تحت سمائه المسترخية». وفي بعضها الآخر تدخل الطبيعة عوالم القسر الإنساني فتتخلى عن ذلك الاسترخاء الرومانسي الحالم، كما في «الزنزانة»:
الطبيعة المصابة بالدوار والارتجاف
تنعكس على حدقة الضفدع المذعور
قافزًا من ساقية إلى أخرى
والظبي المطارد في القمم والسفوح
وتنعكس أكثر على عين السجين
الذي يفكر، بأن لا خلاص
من هذه الزنزانة..
ومن الاتصال الكئيب للكائنات بالزنازين تنتقل الصورة إلى اتصال كئيب آخر. هو الآن بين الأنهار وأطماع الإنسان:
النوافير والسواقي والقنوات
المتدفقة من رحاب المسيسبي، والتيمز
والسين، وغيرها، بمصباتها الكبيرة حيث يحج السلمون
والحنكليس في دورات سلالية متعاقبة..
الأنهار التي صنعت الخير والنماء والموسيقا
لشعوبها الآهلة،
بين ضفاف الدساتير والأقمار السيارة
والتقنيات الممسكة بعنق الكون والتاريخ..
هل هي الأنهار المتدفقة دمًا ووبالًا على الشعوب الأخرى؟
هنا لا تتخلى الطبيعة عن استرخائها أو حتى علاقتها بالزنازين فحسب وإنما تصبح مسرحًا لمجازات تكشف ممارسات الإنسان المستنير منها والمدمر، تكشف التنوير والتدمير معًا، التنوير على حساب التدمير، تنوير الذات وتدمير الآخر، الغرب المستعمِر في مقابل العالم المستعمَر. هنا يستدعي النص قراءة ما بعد كولونيالية إلى جانب كونها قراءة بيئية، فثمة تواشج في الدلالات. ولكن اختيار سيف الرحبي لصيغة السؤال في «هل هي الأنهار» بدلًا من طرح الرؤية في صيغة تقريرية لا يدعم شعرية اللغة فقط وإنما يساءل مشروعية الربط بين النهر وبين الفعل الإنساني، يخفف، بتعبير آخر، من الربط الحتمي بين براءة الطبيعة وما يقترفه البشر، إن لم يلغه تمامًا. وبهذا يبقى الشاعر منحازًا للطبيعة في براءتها الأولى في مقابل الفعل البشري المشين أحيانًا، إن لم يكن غالبًا.
قصائد سيف الرحبي ليست بطبيعة الحال عزفًا متواصلًا من هذه الزوايا لكنها تمنحنا فرصًا مبهجة بقدر ما هي مؤلمة للوقوف على علاقات نكاد ننساها حين لا نعود «نشبه هذا البحر/ ولا هذه الأرض». إنه الشعر وهو ينهض بدوره الإنساني ومحققًا المفارقة الدائمة في اجتراح الجمال حتى حيث يقيم الألم.
المُتخيَّل المأتَمِيُّ وخصوصية الذات الشاعرة
نبيل منصر – ناقد وشاعر مغربي
يَكتُبُ سيف الرَّحبي قصيدةً مُختلِفة، مُوقِّعًا أعمالًا شعرية تَسهَر بقُوَّة على فجر القول، بِـ«تحويلِه داخِل قِصة اللغة وهجرتِها الكونية». لَمْ يتأتَّ ذلك فقط من إيثار لِلترحُّل عُهِد في الشاعر، بل مِن دمغة طَبَعَها الزَّمن على أحاسيسِه (بودلير)، فحوَّلَها إلى حَساسية في قول الشِّعر وفي تفجير مُتخيَّلِه. المُترحِّل يَحمِل لغتَه إلى ذُرى نَشيدِه الشعري، ما دام يَقِف مُتخفِّفًا مِن تقاليدِها الوِراثية. وقفةٌ فيها مأساتُه وخَلاصُه، «أنقاضُه» المَأتمِية وأحلامُ يَقظتِه الفردوسية. إنَّ حَساسية الشاعر (وهي حساسية بالزَّمن وبِما يَتجاوزُه) قادَتْ تَرحُّلاتِه وانطبَعتْ بها، لتُصبِح وَسْمًا لِلُغة الشعر عَمودية الاختراق. عمودية تمتَصُّ النُّسوغ الثقافية والوجودية، فيما هي تُبلور رُؤيا شعرية مُتوهِّجة، من قلب شكلها الكِتابي المُتجدِّد.
تقدَّمَ سيف الرَّحبي في «الفَيض الغِنائي» العَربي بِرِواقِية مُخلِصة. زادُه في هِجْرتِه اللغوية التي جَعلتْ قصيدَته لا تظفَر بِصَوتِها الخاص إلا بالنأي والتهجُّد في مَكانِها البِكر. وهو مَكانٌ شِعْريٌّ خافِتُ الإضاءة، قبل أن يَكون صحراءَ أو بَحرًا أو مَدينة، أو جَسدًا أو يوتوبيًّا أو مَوتًا أو تجريدًا، أو كُلَّ ذلك في قصيدة شعرية كبيرة. هي إذن رواقية مَكانٍ شعريٍّ خُصوصي، لم يُعوِّل الرحبي في بِنائِه على غَير ما يَصعَدُ مِن جَوفِه. الثقافي نفسُه يَخضَع لِقانون هذه الرِّواقية المُحوِّلة، التي تَقِفُ بالشِّعر بَعيدًا من غِنائية الآخرين. رواقية لُغة وبِناء ومُقام شِعري يُوثِر النأيَ والعُكوفَ على صوتِ الداخل العميق، بِجعله أساس الكشف والرُّؤيا. أساسُ كتابةٍ مُتحرِّرة مِن الإرث، فيها يكون الشاعر «مِلْكَ نَفسِه وكاهِنَها وَسيِّدَها في آن».
يَسْعَى سيف الرَّحبي نحو مَشهدِه الشِّعري، فلا يُقيمُه في الصمت، وإنَّما فيما «لَمْ يَخفُتْ صَخبُه بَعْدَ الكلمة». طاقة المَشهَدِ تَشتدُّ وهي تَظفَر بِصَوغ اللغة الشِّعرية وتَصعيدِها، فَتنبَعِثُ صاخِبة حتَّى وهي تَغُور في تُخوم الصحراء. تلك، حياةٌ شعريةٌ للمَشهَد الذي تَبنيه اللغةُ بِحَساسية المُترَحِّل، الذي يُضفي شيئًا عَميقًا مِن ذاته على الأشياء. أشياءُ المشهَد زاخِرة بهِبَات اللُّغة الشِّعرية، حتَّى وإن جَنحَتْ (تلك الأشياءُ) نحو تَقشُّفٍ طبيعي أو أنطولوجي. قد يَكونُ التقشُّفُ أثرًا لِلزمن أو لِلفعل الإنسانِيِّ المَأتَمِيَ المُنطَلق والمآل. تتبدَّل الجُغرافيات والمصاير مُستَسْلِمَة لما يَنتَسِجُ لها، في السِّر أو العَلن، مِن أقدار، مُحرِّكة في أعماق الشاعر الجُرحَ والفقدانَ والمَراثي.
تَرَحُّل سيف الرَّحبي، بالرَّغم من كُل وُعودِه في العَيش الحُر، مُحفَّزٌ عَميقًا بالبحث عن الكلمة. ولَعَلَّ الامتلاءَ بِهواءِ الأمكنة الرَّحب (في اسم الشاعر «الرَّحبي» يتأسَّسُ هذا المَعنى) يَعِدُ بانبثاق هذه الكلمة، التي تستعيدُ طاقاتِها الأولى على الخَلق. الكلمةُ، التي وَلدَتْ العالَم وسَمَّته في التأويل الديني، قادرَةٌ، في التَّأوين الشِّعري، على الِانبِثاق من مَجهولِها الأرضي لِتُسَمّي تجربة الشاعر وتَمنحَه مكانَ الإقامة. إنها «بيتُه الحقيقي» الذي سَعى الشاعر الرحبي وراءَه، مَفتونًا بها بِوصفها «الكلمة الحقيقية التي تَحتوي من يسعى وراءها». السَّعي إذن ضربٌ في العالَم، وفي المكان اللغوي الذي أبدَعَه، وفجَّر يَنابيعَه الرَّمزية، التي يَسهَرُ عليها الشعر، فيما هو يُبدِع ما يَرمُز «لِإمكانيات التجربة الإنسانية» ككل.
تَجربةُ سيف الرَّحبي مَشدودةٌ بقوة لِخصوصية عالَمِه، لكنها مُنفَتِحة على «رَحابَة» التجربة الإنسانية. وهي ليست فحسب خصوصية فضاء ولغة ومُتخيَّل، بل خصوصية بِناء تَجربَة العالَم مِن «مادة التجربة» ذاتِها. لذلك، فما وقَّعَه سيف الرَّحبي كِتابة وانحناءً (طيلة أربعة عقود) على لَوحِه الشعري، ليس إملاءً مُتعالِيًا لِقول شعري سعيد وهائم، بِقدر ما هو انغراسٌ في صلصال العالَم، وانفطارٌ بِرِياحِه العاتية، وسقوطٌ في أجْرافه وأماكنه السَّحيقة. هذه التجربة عَركتْ اسمَ سيف الرحبي الذي «جُبِل مِنها» أخيرًا، فيما هو مُؤتمَن على صيرورة تشكُّلها المُستمر(غادامير)، في تفاعُل جدليِّ مع تجرِبَة الحياة والعالَم. إن الخصوصيَّ في النهاية هو أفقُ التجربة الإنسانية، فلا حُدودَ للتَّراسُل فيما بينهُما، على نحو يَمنحُ الاسمَ الشِّعرِيَّ الشخصي دَمغة التوهُّج والِاغتناء.
خصوصية ذات كاتبة
خُصوصية تجربة الرَّحبي هي خُصوصية ذاتٍ كاتِبة، يلتمُّ فيها كل «تاريخ ذاتية» الشاعر. الذاتُ، هنا، بالمعنى الغاداميري الذي يَجْعلُ منها تكثيفَ حاضِرٍ لِكُلِّ الأزمنة التي تقَعُ في الذاكرة وخَلْف النِّسيان. في مَلعب الأنا، يَقَع هذا التَّكثيف الذي تحتضِنُه لُغة الشعر وتَمنحُه مَداه العمودي. مَلعبٌ يتَّسِع لِذوات الآخرين، لذلك يَكونُ اللقاء بالأنا لقاءً بِتفتُّح العالَم وبـِ «الأذن المفتوحة لِألحانِه»(7)، حتى وإن هَيمَن عليها الحِسُّ الرثائي الفجائعي. هذا النسيان (الوَجهُ الآخر لِلذاكرة) هو ما تتفتَّحُ له “أنا” الشاعِر، التي تعيشُ في حاضرِها كُلَّ الأزمنة بأنقاضِها ومُنقلَباتِها الكونية. أنا «ذلك الفرد» الذي يصير «فجوة رهيفة» تعبُر من خلالها الذوات والعالَم إلى الصَوغِ الشِّعري المنشود.
لَمْ يَكتُب سيف الرحبي إذن قصيدة «مُعلقة في الهواء»، مُنقطِعة الجُذور عن القوة الحيَّة لتاريخه وتُراثِه، وإنما مارَس تحوُّلاتِه بما هي، بتعبير الخطيبي، «اختراق تحوُّلات الحياة والموت داخل قصة نَسَبِه الرمزي». تَرحُّل الشاعر أتاح لِقصة هذا النَّسَبِ تَجَذُّرًا في لُغة الكتابة، بِما يَنهَض بأعباء حَداثة شعرية، تَستبطِن في جَسدِها الشخصيِّ تحوُّلاتِها الفنية والوُجودية، في حوار مُرهَف مع الشعرية الكونية. الرهافة لَمْ تترك «خُدوشًا» على جَسدية النص الشعري عند سيف الرحبي، المُنبَثِق بِقُوَّة مِن اعتمالات «الحياة والموت» في تُراثِه الشَّخصي وأفقِه الكوني. لذلك، لم تُنهِك قصيدة النثر في تَجسُّداتِها الرمزية والسريالية قِوى الشاعر، وإنما بَقِيَتْ صدى بَعيدًا، وأثَرًا مَعجونًا بِقوة التحولات الشعرية والوجودية، المشدودة لِشجرة أنسابِه الرمزية، ولِكثافة ذاته الكاتِبة.
تَجديدُ سيف الرَّحبي يَأخذُ هذه الأبعاد. انخراطُه في كتابةِ شِعر آخرَ بالنثر، منذ سبعينيات قَرن مَضى، لَم يَكُن مُدلَّلًا بِتوقيع الآخرَين، وإنما بِقوى العمل الذاتية المُخترَقة بِحَدْسٍ شعري بَصير. لذلك، انفلتَتْ قصيدة النثر لدَيه مِن سياقِها الشعري العَربي العام، إلى ما يَنهضُ من الأعماق الوجودية والميثولوجية لِشخصه، التي هي بُعدٌ آخَر مِن ثَراء قِصَّة نَسَبِه الرَّمزي. اكتناهُ هذا الثراء شِعريًّا يَستدعي تمارين صامتة وطويلة في التضحية والتحلُّل والمَحو، لِجعْل قِصة النسب تتوهَّج بِقُوَّة التَّوقيع الذاتي. توهُّجٌ مُتطلِّبٌ يمتدُّ فِعلُ المَحْوِ فيه أيضًا إلى أثَر الكلام الشَّخصي، لِيصيرَ جِسْمُ الكتابة ذلك الطِّرس المَشغول بإعادة كتابة مُستمِرة لِهواجِسَ قويَّة ومُلِحَّة، لا تكون شخصية إلا بالمعنى الذي يَجعلُ مِنها مُختَرِقة لِما سمّاهُ الخطيبي بِتَحوُّلات الحياة والموت.
لَمْ يَلتحِقْ سيف الرحبي بِمَصيره المَرسوم بِخطاطة «نظرية» التحديث الشعري العربي، وإنما عمل على تأسيسِه ذاتيًّا على أرض تَجربَتِه الشخصية. لقد أسَّسَ حياتَه وِفق هذه الضرورة الشِّعرية القصوى، التي هي نظير الرَّغبة في الهواء عند الشاعر ريلكه. لذلك، فالتقدُّم في قراءة الشعر العربي في قدامتِه ومُنعطفِه الحداثي، النَّصِّي والنَّظري، يَعني نِسيان هذا المُنجَز والِانبثاق من ضَرورَةٍ ذاتيةٍ لِتحوُّلاته المُفضية إلى مُغامَرة الشاعر، في انهماكِه على لَوحِه الشَّخْصِي كتابةً ومَحوًا وإعادة كتابة لهواجِس لا تنفكُّ تعود، في إلحاح وُجودِي على وُجودٍ بالشعر وعَبْر لُغتِه «السُّفلِيَّة الاتقاظ». إن سيف الرحبي هو نِتاج مَسْلكِه الشِّعري الوَعْرِ، الذي يَجْعل قصيدتَه تَنطلِقُ في صَحرائِها وبَراريها ومُدُنِها وبِحارِها مُحفَّزَة بِدَمِها الشخصي. تَحفيزٌ صامتٌ لَم يَزدهُ الإشرافُ على صحافة ثقافية (مجلة نِزوى) غير نُسكِية مَسعى يَكونُ بالشِّعر وليسَ بِجَوقَتِه المُنشِدة.
 قصيدةٌ تَعكِفُ على ذاِتها
قصيدةٌ تَعكِفُ على ذاِتها
يَكتُب سيف الرحبي قصيدة لا هي سريالية ولا صوفية ولا يَومية ولا تجريدية. قصيدةٌ تَعكِفُ على ذاِتها، دونما حاجةٍ إلى الِانغراس في اتِّجاه عام أو مَذهب شِعري أو أدبي. الكتابة بالنثر لَدَيه بَحثٌ عن الشعر في أمكنته الوَحشية غير المطروقة. أمكنةُ الفضاء الخارجي مُتصادِيةً مع أعماق ذاتية تَحيا دأبَها شِعريًّا على الأرض. أعماق تأتمِنُ على لُغة شعرية وتكون هذه الأخيرة مُؤتَمَنة على تَحوُّلاتِها في تماسٍّ مع تَحوُّلات الحياة والموت. هذه الأعماق، تَستلُّ خيوطًا نُورانية مُرهَفة من وهَج التجربة الشعرية الكونية، لكنها تَعرِفُ كيف تُلحِمُها بِسَداها الشخصي، الذي يَجعلها تنضح مُغتَرِبَة داخل انْجِرافاتِ كتابة شَخصية تَهدِم وتبني بذات القوة. تنتَشِرُ تجربة سيف الرحبي، في جُغرافيتِها الشِّعرية الخاصَّة، بهذا النُّتوء المُؤمِّن لِدمْغة التوقيع الشخصي.
يَكتُبُ سيف الرَّحبي مَشهدَه الخُصوصي كِتابة داخلية، لا تُعوِّل على رَصْدِ الحَوَاس فحسب، بل تَسْتضْمِرُ ما تَراه أو تلمَسُه أو تُنصِتُ إليه، لِيَنْهَضَ مِن انجِرافاتِه الباطنية ناضِحًا بالنَّشوة الإيروتيكية، أو الحُزن المَأتَمِي، أو الفَرَح الطفولي، أو الحِكمة المُقطَّرة مِن القفائِر الجَبلية العالية، أو النغمة المُنفلِتة من قياثِر البِحار والرياح، والكَمانات المُخبَّأة في الأرواح أو بين الجبال والغابات. يَكتُبُ حَساسيته بالزَّمن الهارب وتحوُّلات المَكان وتَصَحُّر الرُّوح وعُتو الآلة وضُمور الشِّعري والإنساني، على نَحْوٍ يُبَلوِر نَزْعَة شِعرية أبولونية تَجْنَح لِحُلم اليقظة ولِلَوعَة المَراثي، دون أنْ تَجعلَ قصيدة الرحبي تَفتقِد بَعض الوَثبات الديونيزوسية، المُنتشِية بالجَسد وبالعِطر البعيد لنساء التجربة والذاكرة.
ثمَّة بذرَة مِمَّا يُسَمِّيه بورخيس بـ «الِانفعال المَلحَمي» في كتابة الرحبي. عَناوينُ أعمالِه الشعرية وما تطفح به كمتخيَّل من عَوالم الطبيعة البِكر (الصَّحارى، الجبال، البَراري، الصُّخور، الحَيوانات) تكشِفُ عن حضور هذا الانفعال، الذي يَنعكس أيضًا على بناء التجربة الشعرية كشكل ومُمارسة نصية. لا يَكتبُ سيف الرحبي قصائد قصيرة فحسب، مُحكمة البناء وطافحة الغرابة أحيانًا، مهما كانت مادتُها مطروحة في الفضاء الحَميم أو مُجتلَبة مِن الأصقاع أو الميثولوجيا، بل يكتُب أيضًا قصائد طويلة، تتَوالى مقاطِعها مثل أمشاج أو أمواج أو هبَّات رَملية، تنبثق عنها تشكيلات شِعْرية مُتبايِنة الحَجْم والنَبرة والصيغة، لكنها تنشدُّ بخُيوط وُجودية ورؤيوية إلى عالَم شِعري شبكي البناء والأبعاد.
تُجسِّد قصيدة «الجندي الذي رأى الطائر في نومِه» هذا البناءَ التَّعدُّدي، المُتشعِّب والمُمتَد، ذا الكيان الشبكي. قصيدة تضعُنا بنبرِها الغنائي وصوتِها الملحمي في قلب الهول المأتمي، حيث تَمْتزجُ الكوابيسُ بِقسوة أحلام اليقظة وجِراحِها المُقترِنة باختلال الشرط الإنسانيِّ وفُقدانِه لِلبوصلة. لَم يَعُد الشرطُ أفق حُبِّ، كان يَعِدُ بانجراف إيروتيكي لِقصيدة تلهَج بالنشوة ومَديح الملذات والفراديس الأنثوية، بل الشرطُ ما يُحوّل الكتابة ويَذهبُ بها في اتجاه كتابة الفجيعة والهول والفقدان:
«كان عليَّ أن أكتُب في مديح خِصرِك/ المُتلاشي/ في الأماسي الناعِسة على الضفاف/ أن أصف أيامنا الجميلة/ كان عليَّ أن أكتُب/ عَنِ الصباحات التي تسيلُ على الوجنتَين/ عَنِ الخلاخيل الفضية والرؤى والأساور/ إكسسواراتك المفضلة/
عَن الموت الذي شيَّدَ أبراجَه عاليًا/ عَن اللمسة الحانية/ والرغبة المُحتدمة بين عاشقين». (نفسه، ص 88/ 89)
تراجعَ الوَعدُ الغرامي بِمُخيِّلته المُبتهِجة، وانساقتِ القصيدة لكتابة حِسِّها المأتَمي بالمكان واللحظة الوجودية العسيرة. الذاتُ على وعي بهذا المنُقلب، لكنها لا تَملِك أمام سَطوته غير الأسى. هي تُذكِّر في ثنايا الكتابة بِخَيط الحُب المقطوع، وتبقى مُتحسِّرة على ما لا تَستطيع إنقاذه: الحُب الذي كان «قطرة في ظلام الصحراء» (ص61)، قطرةَ الوعود المُخصِبة والمُضيئة، أخْلى مَكانَه لـ «الإعصار» ولذلك «القبر المَفتوح كنهرٍ من عظام الهالكين» (نفسُه، ص 66). «قطرة» النور والماء استحالتْ، في هذا المُتخيَّل المأتمي، «نهرًا» من عظام الأموات، وبَدَلَ مَكان الصَّبوة، لَنْ تَجِد الحَواسُّ أمامَها غير شَقِّ «القبر المفتوح».
رؤيا الجُندي تتقاطَعُ مع رؤيا الشاعر. لعلَّه قِناعُه الذي يُجسِّد ما اصطُلِح عليه بالمُعادِل المَوضوعي. غير أن الشاعِر كثيرًا ما يُفصِح عن صَوتِه الشعري وهو يَكتُب فَجيعة الإنسان. لا يَكشِف عنه لحظة استرجاع بَعض خيوط أو أنفاس ذلك الحُب الضائع، بل أيضًا عندما يَنصهِر في نسج ما قُدِّرَ لَه مِن رِداء مأتَمِي فَرضتْه آلهة الحديد والدمار على الإنسان. ثمة رؤيا الجندي ورؤيا الطائر ورؤيا الشاعر مضفورة جميعُها في نَسيج رُؤيوي لَيليٍّ، يَجعَل القصيدة تفيضُ عن حُدودِها المعهودة، بِجمعِها بين الِانفعال الغنائي والانفعال المَلحمي. ثمة توالُج أصواتٍ تتوزَّع كلامَ الذات الشاعرة فيما هي تَكتُبُ رُؤيا الهَول، مُنتزَعة مِن الكوابيس الليلية، وِمِن الدم المَسفوك على امتداد الخَطو وتاريخ السُّلالة:
«حين رأى الدَّم لِأوَّل مَرَّة/ وَبِعُيون المُخيِّلَة التي لا تُخطِئ/ حَسبَه مياهًا حمراء/
مِن فَرط ما كان يتدفَّق مِن النوافذ والعُروق/ حنفية السماء المفتوحة على مصراعيها/ قال: هذه يَنابيع الأسلاف آتية/ مِن مسارِبِهم الخَفِيَّة/ وعودهم وأحلامهم/
وهذه شهقتهم الأخيرة». (نفسُه، ص80)
الانخراط في انجرافاتٍ مَأتمية
دَمُ الولادة يَنصَهِرُ مع دَم المَوت، في قَدَر بَشَري يَأخُذ أبعادَ السَّماء والأرض؛ لذلك فهو يَنخَرط في انجرافاتٍ مَأتمية تأخذ قُوَّةَ الشَّيء المادِّي القاتِل، قُوَّة «الحِجارة» التي سَنَّتْ القتلَ في مَشهد قابيل الذي دَوَّنتْه القِصَّة الدِّينية، لِتمنَحَ الأشعارَ المُنطلَقَ الأوَّل السَّحيقَ لِلمَراثي. الدَّمُ الأوَّلُ مُنصَهِرًا مع المَوت الأول، يَملأ المُنتَشِرَ (الأرض / الصحراء) بِنُتوئِه المُتعاظِم لِيَجعَل مِن الحِجارَة «جَبَلًا»، ولِيَمنَحَ النَّشيد انفعالَه المَأتَمِيَّ المُتعاظِم: «يَستَحضِرُ مَشهدَ قابيلَ وهابيلَ. رُبَّما صَرعَ أخاهُ في طَقْسٍ يُشبِهُ هذا. رُبَّما الصخرةُ الحادَّة، أداة الجريمَة نفسُها الجبال المُتاخِمة بعد أن كَبُرَت مع الأحقاب وتغذَّتْ مِن غزارة الضحيَّة وبَذخ الأدوات» (نفسه، ص78). كُل «الجِهات والمَرايا» التي «تُبَعْثْرُها» الذاتُ الكاتِبَة، مُنذ مُفتتَح قَولِها الشِّعري، لا تُفصِحُ فحسب عن تَدحرُج هذه «الصخرة»، بل تُصبحُ صَدًى لِهذا النَّشيد، الذي تَغرقُ «القصيدَة» في رِمالِه، في الوقت الذي تَعبُرُ فيه المُنتَشَر الأرضي: صحراءَ الرَّبع الخالي.
الجُندِيُّ في القصيدة هو واحِدٌ من «جُند» الشِّعر، الذين يَحمِلون في رُؤياهم هَوْلَ المصير. بأعماق الشاعر انبثق هذا «الجُندي» حامِلًا طائرَه. بأعماقه تشكَّلَتْ رُؤياه، بِما هي رُؤيا بَصيرةٌ بالمُنتَشِر والنَّاتِئ وبِما يَقبعُ خَلف قِشرة الأشياء والظواهِر. الجُندِيُّ الذي يُمزِّق الأغشية، ويَنهض ضِدَّ بَداهة القتل ووأد الإنسانِيِّ في أجراف التاريخ والأنانيات ومُنقَلَب الأزرار والتِّقنية. هذا الجُندي هو الذي تَجلَّى بذات الشاعر، فحوَّل مَجرى قصيدته، مِن قطرة الحب إلى«”بركة الدم»، مِن وُعود الخصب إلى يَنابيع المآتم. تَحويلٌ جَعَل من تجربة الشاعر، في القصيدة، بَلورةً وتمديدًا شَخصيًّا مُختلِفًا لِأنفاس مِن «الأرض اليباب»:
«علَيَّ أن أبَعثِرَ أشلاءَ اللحظة/ وأسوقَ الجُيوشَ إلى حَتفِها/ كجُندي يَستعِدُّ يومَ حَرْبِه/
الجُندِيُّ الذي رأى الطائر في نَومِه/ فانتشلَه مِن بِركَة الدَّم». (نفسُه، ص62/63)
بِقلْب «الجُندي» تجلَّى طائرُه (مثلما تَجلَّى الجنديُّ بقلب الشاعر). ذلك ما جعَل رؤيا الشاعر مُركَّبة، تُعوِّل على نَسيج مُتعدِّد الطبقات. تعدُّدٌ يَصلُ إلى نقطة في البناء النصي تتصادى فيه الأصواتُ وتتلاشى الحدود. يتعاظم المُتخيلُ المَأتمِيِّ ويَصير تَموُّجات لِهَبَّات رَملية واحدة. رُؤيا الطائر خَضَعَت لِذاتِ المصير: المُنقلَبُ الأرضي جَعلَها بِدَورِها َتتحوَّل مِن كائنات «الرُّوح» النُّورانية المُحلِّقة، إلى السُّقوط في «لُجَّة المَعدن الهائج». الهَلاكُ أحدَقَ بطائر الفراديس في مُنقَلَبِ «الأرض اليباب»، فما عاد هاجِسًا بِغُيوب السماء ورُؤاها البِلَّورية، وإنَّما خائضًا في «الدم». الشاعِرُ انجرفَ بعيدًا من مَراقي الحُب، وكذلك «الطائر» الذي تَجلَّى بأعماق جُنْدِيِّه:
«كانَ لهُ فضاء/ يَذرَعُ تخومَه النَّجمِيَّة/ جيئَة وذهابًا/ مُتَنَزِّها بين جَنائنه ذات المخلوقات الأثيرية/ كأنَّما صُنِعتْ من قُبلات مَلاك./ فجأة ضاق به الفضاء/ ضاقتْ به أحلامُه/ سَقطَ في بركة الدم/ عَوى كذئب/ لكن لَمْ تكن له روح ذئب/ وما فائدتُها في لُجَّة المعدن الهائج/ ما فائدة الروح؟». (نفسه، ص67/68)
تلاشَتِ «الجنائن» وغارتِ «المخلوقات الأثيرية». صارَ «الإنسان» في مُنقلَبِه الأرضي وَجهًا لِوَجه أمام مَصيره. على الأرض، يَحْيا قِصَّة سُقوطِه الثانية امتدادًا مأتميًّا، بَشريًّا لِخطيئته الأصلية. امتدادٌ بَشَري لِأن «الخطيئة» الأرضية قَرنَتِ البناء والتقدُّم بالهَلاك. انهارَ عَلى اليدِ بُنيانُها الذي شيَّدَتْه بِالدَّم والنار والحديد. استكانَ الإنسانُ لِيَبابِه ولم يَعُد قادًرا حتَّى على اللهج بِنَشيد الحَمد. الطائرُ «رسول الروح الهاربة من الأسر» (ص71) ضاق به غِناؤُه، وهو الآن «يَرفُسُ في بِركة الدَّم» (ص66). وليس بَعْدَ هذا الضِّيق سِوى «قبر مَفتوح»، يُجسِّد رَمزيًّا مآل الفناء المأساوي:
«رأى جوارحَ تَجثم على قَبر مفتوح/ قال: هؤلاء قومي/ ضاربين أكبادَ الإبل/
مِن كُل فَج عميق/ مِن الجُروف النازفة عبر الأودية./ هؤلاء رعاياك/ حُفاة عُراة/
لَم يَعُد يتطاولون في البُنيان/ لم يعد يُشيِّدون مُدُنًا في الفراغ/ لَم يَعُد يخترعون القنابل النيترونية/ صاروا أضغاث أحلام/ فردة حذاء،/ في الطريق». (نفسُه، ص76/77)
ثمَّةَ خَيبةٌ في الفعل الإنساني ومَصيرِه. لَحظة «كُسوف» جَوهرية ومَديدة تطبعُه بِجَوٍّ مَأتمي، تُغَنِّي قصيدةُ «الجُندِي الذي رأى الطائر في نومِه» نَشيدَه مُتجرِّدَةً مِن كل وَهْم، بِما في ذلك وَهْم القبض على مِثال عابِر للتاريخ أو العَودة إلى جَوهر أو أصل. الفِعلُ المأتمِيُّ مُتأصِّلٌ وفاجِعٌ، ولَمْ يزِدْهُ «التقدُّم» غيرَ رُسوخ أكبر في «أرض اليباب». «التقدُّم» سُقوطٌ في صِيغ مَوتٍ لَمْ يَعُد مَعْروضًا كحَدَث ومَصير طبيعيين، وإنما كاقتلاع يَطمِر الحَياةَ نَفسِها، بِما يُقحمُه فيها مِن شبكة الهلاكِ المُتعدِّد الوُجوه. تنَتَهِي القصيدةُ بالتذكير بمُحْتملاتِ «المُخيِّلة المُحِبَّة» التي ضاعَتْ نِعمُها، في مُنقَلَب الكابوس الأرْضِيِّ، الذي حَوّل الحياةَ (والشعر المُنعكِس على صفحتِها) إلى مَأتَم مُتواصِل.
يَنثَني سيف الرَّحبي على «لَوْحِه» لِيَكتُبَ تَجربَتَه الشعرية. وهو ليس «مُؤوِّلًا»” غنائيًّا لكلِمة السَّماء (الإلهام)، ولكنَّه يَعكِف على كتابةٍ مادِّية لا تَنْسَى أبدًا أنها تَكتُبُ(10)، ما يَدْمَغُ اللغة بِأثَرٍ شَخْصِي. الترَحُّل في المكان هو أيضًا هِجرةٌ في المُتخيَّل وفي اللغة، بما حَملَها على تَفجير طاقات شِعرية كامِنة ومجهولة. ولم يَكن سَعيُ الرحبي في الطبيعة البِكر والجُغرافيات والأزمة والأصقاع مُنفصِلًا عن «ذاكرة الحاضر»، بما هي ذاكرة فَجِيعَة، فيها تُنْصَبُ «ولائم الغُبار»، ويضوع «بَخور المآتم»(11). بَيدَ أنَّه سَعْيٌ بِقَدر ما اكتنَه «صحراء البشر الكبيرة»، حَرَصَ على لَمْلمة «شذرات مِن الجَمال هائِمة على الأرض»(12).
هوامش الدراسة:
(١) عبد الكبير الخطيبي: “ما وراء الصدمة”، مجلة الكرمل، العدد 12، السنة، 1984م، ص105.
(٢) شارل بودلير، ما وراء الرومنطيقية (كتابات في الفن)، ترجمة كاظم جهاد وأم الزين بنشيخة المسكيني، منشورات كلمة 2019م، ص 28 و29.
(٣) جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم جهاد، دار توبقال، 1988م، ص 87.
(٤) هانس جورج جادامير، مَن أنا ومَن أنت (تعليق حول باول تسيلان)، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم، منشورات الجمل، 2018م، ص 40.
(٥) المرجع نفسُه، ص 46.
(٦) المرجع نفسُه، ص31.
(٧) المرجع نفسُه، 64.
(٨) عبد الكبير الخطيبي، مجلة الكرمل، مرجع سابق، 100.
(٩) قصيدة طويلة ضمن كتاب يحمل العنوان ذاته، هو:
ـ سيف الرحبي، الجندي الذي رأى الطائر في نومه، شعر، منشورات الجمل، 2000م.
(١٠) الكتابة والاختلاف، مرجع نفسه، ص53.
(١١) سيف الرحبي، سألقي التحية على قراصنة ينتظرون الإعصار، شعر، دار النهضة، 2007م، ص 98 و103.
(١٢) ما وراء الرومنطيقية، مرجع سابق، ص129 و195.
«نزوى» التي أسسها سيف
سمير درويش
 منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
حين صدرت «نزوى» كانت الصحافة الثقافية في سلطنة عمان متراجعة إلى حد كبير أمام مشاهد طاغية مجاورة، في الخليج العربي نفسه، مثل المشهد العراقي الذي كانت تصدر عنه مجلات قوية لعبت دورًا مهمًّا في إنتاج الثقافة العربية، مثل «الطليعة» و«أقلام»، وكذلك هناك مجلة «العربي» الكويتية إلى جانب عالم الفكر، وسلسلة عالم المعرفة والمسرح العالمي، وفي قطر مجلة «الدوحة» التي شهدت مجدها في الثمانينيات، وفي الإمارات مجلات تظهر وتختفي، وفي البحرين مجلة «البحرين» الثقافية، استطاعت نزوى أن تحفر لنفسها مكانًا في هذا المشهد، وأن تكون قبلة كثير من الأدباء والمثقفين العرب.
من حسن حظ «نزوى» أنها وجدت تمويلًا دائمًا من واحدة من المؤسسات الصحفية الحكومية الكبرى في سلطنة عمان، وفرت لها الدعم المالي واللوجستي المطلوب، ومن حسن حظها -أكثر- أن رئيس تحريرها شاعر كبير ومهم في المشهد الشعري والثقافي العربي، وهو مثقف تنويري يحرص على إفساح المجال للكتابات والأفكار الجادة، لديه مساحة قد لا تتوافر لغيره.
إنتاج مجلة ثقافية رصينة ليس عملًا سهلًا كما قد يبدو، فالمجلة تحتاج إلى تحديد رؤيتها من الواقع ومتغيراته، رؤيتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والتعليمية. إلخ، هذه الأشياء التي قد لا تظهر بشكل مباشر، ولكنها تشكل النسق العام الذي تسعى المجلة إليه. كما أنها تحتاج إلى ترسيخ شخصيتها الجمالية والموضوعية، دون أن تغلق الباب أمام المختلفين في الرأي والتوجه، وهو عمل شاق بالفعل. تحقيق كل هذه الأشياء مجتمعة لا يخلو من صعاب، كما لا يخلو من أخطار، ومن المؤكد أنه سيصطدم كل مرة بالأشخاص والمؤسسات التي تدير المشهد الثقافي والاجتماعي في الدولة، والحقيقة أن «مجلة نزوى» نجحت إلى حد كبير في تحقيق تلك المعادلة وهذه التوليفة الصعبة، ومن المؤكد أن
شخصية سيف الرحبي وعلاقاته الداخلية والخارجية بالمشهد الثقافي العربي ورموزه ساعدا كثيرًا على أن تحقق معادلة النجاح بامتياز.
تجربة «نزوى» -أخيرًا- تجربة ملهمة، يمكن أن يتمثلها كثير من الأدباء والمبدعين والمثقفين العرب في دول مختلفة، وبخاصة أن المجال أصبح أوسع كثيرًا من عام 1994م وما بعده، فقد غزت مواقع التواصل الاجتماعي الواقع العربي والعالمي، وأصبح في إمكان أي أحد أن يصل لجمهور واسع بإنتاج ثقافي يعرف إلى أي الناس يتوجه، وإلى أي غاية، حتى لو غابت -أو خافت- المؤسسات الداعمة، فالوسائط الجديدة حلَّت كثيرًا من المشكلات المعقدة.
شاعر مصري رئيس تحرير «ميريت» الثقافية
قصيدة المشهد البصري
حاتم الصكَر – ناقد عراقي

سأطلق على قصيدة سيف الرحبي تسمية موجزة ودالّة: قصيدة المشهد البصري؛ ذلك أنها تتقدم للقراءة عبر هذه التقنية التي اقترحتها الحداثة الشعرية في مراحلها التالية للرواد، وخصوصًا منذ الستينيين والجيل التالي لهم الذي ينتمي إليه سيف الرحبي (1956-).
لقد ازدحمت المرائي في مخيلته وتغذت بما اختزنه بصريًّا من مشاهد غنية بالتفاصيل التي وجد نفسه داخلها، بل مراقبًا لها وهو يعيشها. وقد منحه ذلك قدرة على استحضار الأمكنة بجزئيات يشكل وجودها الشعري عنصرا الترقب والرصد البصري الممتزج بمشاعر مسقَطة على تلك الأمكنة. ومن ثم تغدو الموتيفات التي يجمعها في القصيدة متسلسلة عبر زاوية نظر موازية للمنظور التشكيلي. فتلك المَشاهد فضلًا عن هويتها البصرية تتقدم باسترسال لا يحكمه رابط لغوي صارم ولا حدود أو نهايات وتتجاور فيه الأشياء متضادة أو متناظرة في هارمونية وإيقاعات خاصة تحيل إلى لوحة شعرية مبصَرة أكثر منها قصيدة لغوية الأداء. إنها تثير من جديد علاقة الشعر بالتشكيل التي كانت من ثمار الحداثة الشعرية وانفتاحها على الأجناس والأنواع. حيث تمت عمليًّا فرضية التداخل النصي بين الأجناس والأنواع ما يمكن تسميته بالتناص النوعي أو الإجناسي.
ولما كانت قصائد سيف تتوسل السرد كميزة لقصائد النثر، فإنها تعتني كذلك بالمشهد وعناصره التشكيلية بشكل متواتر يدعو للتحليل والرصد عند القراءة. وهذه العناية بالبصري في القصيدة واعتماده أساسًا في التوصيل، يأتي من خزين بصري موازٍ تحفل به القصائد. وترد معضدات له وبطاقات قراءة مساندة من تفوهات سيف في مقالاته، والكِسَر السيرية التي دوَّنها عن حياته وبيئته، والمرائي التي شكّلت وعيه الأول وصلته بالمكان.
لقد درجنا أن نبحث في قصائد النثر عن تعيين مكاني وتحيين زماني، حيث يستعين الشاعر بقدرته على استحضار العناصر المكانية في ترتيب خاص داخل القصيدة ليخلق التكوين المقصود بالمشهد السردي-المكاني، وهو يُسقط على المشهد رؤيته المتكونة من وعيه به، ثم يتعزز التعيّن المشهدي- المكاني بالتحيين الزماني، وهو جناحٌ موازٍ للمكان، يعمل على تأطير العناصر المكانية بذاكرة زمنية، تستحضر المفردات أو العناصر التي تقوم بتحيينها لإنجاز مشهد غائب يمتلك حضوره في هذه العلاقة بين غياب العنصر كفعل، وحضوره كمفردة شعرية ضمن مفردات القصيدة. وسيكون لعلاقات الغياب والحضور أهمية كبيرة في قراءة قصائد سيف.
وكما أن لكل مشهد تشكيلي منجز خلفيةً، فإن التلازم المكاني -الزماني سيكون خلفية المشهد الشعري الموصوف بالبصري في قصائد سيف الرحبي.
فالصحراء هي الخلفية العامة للمشهد: تحضر لا بتجسيداتها المعروفة التي تحضر في الذاكرة كالرمال والفراغ والعزلة والحياة البدائية وعناصرها، بل بتعويم المكان ليغدو إيهامًا أو موجودًا ظلّيًّا يوحي بأكثر مما يعني في القراءات التقليدية. إن الصحراء فضاء لا يتم نقله مشهديًا بطريقة فوتغرافية تماثل ما يفعله الرسامون الواقعيون المنهمكون في دقة المماثلة للمرسوم والتفنن ببراعة في نقله وكأنه هو بهيئته ذاتها على سطوحهم التصويرية بعلاقة إيقونية تتعمد المطابقة بين المتخيل والمرسوم.
إن ذلك لا يخلق منظورًا مشهديًّا بل نقلًا دقيقًا قد يبهر المبصر، لكنه لا يزيد معرفته بجماليات المكان أو ما يخبئ من دلالات. وهذا ما تجنبه الفن الحديث والأسلوب التجريدي خاصة.
ولكن زمانية الفن الشعري تختلف في المعالجة البصرية لموضوعها دون شك؛ لأنها ليست معاينة مكانية كما في الرسم. ولذلك تتجاوز الصورة بمعناها التقليدي وعناصر التشبيه المألوفة لتبتكر سلسلة خيالية تقتات على منظور تصممه الذاكرة، ولكن الكلمات والجمل الشعرية تنزاح عنه إلى ما يوحي به كأثر. وهذه الانزياحات تمثل طريقة في النهايات التي تقترحها قصائد سيف على قارئها كما سنبين.
* * *
تنبني قراءة قصيدة سيف الرحبي على هذين المركزين المتجاذبين فيها:
أ- استدعاء عناصر المكان من الذاكرة ودمجه بالحاضر الماثل ثم دفعه إلى مشهد بصري متكون من تلك العلاقات المتوترة بين الذاكرة وما تعنيه من موجودات ودلالاتها، وبين الابتعاد عنها والانغماس في حاضر مؤسٍ وحزين يقرب من الاغتراب، وهو ليس غريبًا عن مجال اشتغالات الشعر الحداثي في مراحله التالية للكتابات المبكرة في الشعرية العربية، لتأثره بما جرى من أحداث مفصلية، ومن تبدلات الوعي بفعل تبدل مؤثراته ومكوناته، وشهادة الشعراء على لحظات من أشد الأزمنة دراماتيكية وحزنًا وخذلانًا.
ب – إقامة أو تأثيث المشهد البصري بالعناصر اللونية المنبثقة من انعكاسات وجود الأشياء في النص، والظلال المنبثة في المسكوت عنه أو المغيّب، والخطوط المتكونة داخل العمل كامتدادات أو تمددات للمخيلة. والتأكيد على خلفية العمل ونهاياته المفتوحة، وكأنها لوحات بلا أطر أو حدود مشرعة على شتى إمكانات التأويل عند المعاينة البصرية. والأهم من ذلك موقع الشاعر في معاينة المشهد لتمثله ثم إعادة تمثيله نصيًا. وهو من آليات الاستيعاب البصري، وتشبه إنجاز أو تحديد المنظور في اللوحة، واتخاذ هيئة مناسِبة لرؤية المشهد تتنوع بحسب زاوية النظر.
وفي شعر سيف إشارات صريحة للمشهد تشجع على تبني استنتاجنا حول مشهدية قصائده. وسأمثّل لذلك ببعض أبياته:
يذوب المشهد في رأسك /كما يذوب السكر بين شفاه عذراء/خلَّفها الطوفان.
وقد استخدم المشهد في نص بصري قصير يفيد عنوانه «الغرباء في مرآة المكان» بوجود الوعي التصويري البصري لا القائم على آليات البلاغة المألوفة: كانت البواخر تعبر المضايق باتجاه برمودا، البواخر التي تحمل الجرحى والمهجّرين. كان يرقب المشهد، كان كمن يرقب المشهد والضباب، كانت البواخر التي تبحر في أعماقه وحناياه.
لكنه يوسّع المشهد ويصرح به في آخر بيت في قصيدة «مدينة تستيقظ»: تستيقظ آخر الليل،/ تُلقي نظرة على الشارع الخالي، إلا/ من أنفاس متقطعة، تعبره/ بين الحين والآخر./ وحده النوم يمشي، متنزهًا بين/ قبائله البربرية،/ تتقدمه فرقة من الأقزام./ وهناك رؤوس وهمية تطل من النوافذ/ على بقايا الثلج الملتصق بالحواف وكأنما/ تطل على قسمتها الأخيرة في/ ميراث الأجداد./ المصابيحُ تتدافع بالمناكب، قادمة/ من كهوفٍ سحيقةٍ/ لا تحمل أي سر./ السماء مقفرة من النجوم/ الجمالُ تقطع الصحراء باحثة/ عن خيام العشيرة/ القطاراتُ تحلُم بالمسافرين./ لا أحد… لا شيء…/ أغِلقِ الستارة/ فربما لا تحتملُ/ مشهد مدينةٍ تستيقظُ.
لقد حمل النص مواصفات المشهد كلها: البداية باليقظة ثم التفاصيل (النوم، الرؤوس الوهمية، المصابيح، السماء، الجِمال، القطارات ثم الخلاء: لا أحد فتنغلق الستارة تحاشيًا لمشهد كهذا (مشهد مدينة تستيقظ) وهو فعل لم يحصل دلالة على هجاء المكان الذي يرتهن عالمه بالسكون، وكل شيء خاوٍ ومطفأ ومقفر. وفي نص آخر سنجد تجسدًا لحركة جماعية لمهزومين مخذولين بزمنهم الذي يعيشون، فيكون مسار سيرهم عناءً، كما يسير الجنود الأسرى العائدون من الحرب أو الذاهبون إلى سجونهم. فهم:
يحملون الأيام الثقيلة/ يجرجرونها كسلاسل السجين/ هي التي حملتهم عبر غابات عصية/
وجبال تسرح في أمدائها أحلام الوعول.
تتركب هنا الصورة البصرية المتخيلة والممكنة التصور من غائبين (يحملون) أعمارهم (الأيام الثقيلة) لكنهم لتعاستهم (يجرجرونها) كما يفعل السجين، ثم ستكون الأيام تلك مسؤولة عن شقائهم، فقد أخذت خطاهم إلى (غابات عصية) تتعب فيها خطاهم، و(جبال) يعانون وعورتها على رغم أنها تخبئ في الغياب (أحلام الوعول) التي تسرح في أمدائها.
* * *
 تلك التشخيصات النظرية هي نتيجة قراءة عينات من قصائد كتبت في مراحل مختلفة من تجربة سيف الرحبي. وهي تؤكد في التحليل الحس البصري في القصائد. سأذكّر هنا بالمهيمنة التشكيلية أو المشهدية البصرية في نصوصه، وأنه يبث رسائله البصرية بطرق شتى، تعقبتُ بعضها وحصرته في كيفيات تؤشر لهذا الحس الذي أزعم وجوده مشغِّلًا مهمًّا في الكتابة الشعرية لديه، وفي فعل القراءة بالضرورة.
تلك التشخيصات النظرية هي نتيجة قراءة عينات من قصائد كتبت في مراحل مختلفة من تجربة سيف الرحبي. وهي تؤكد في التحليل الحس البصري في القصائد. سأذكّر هنا بالمهيمنة التشكيلية أو المشهدية البصرية في نصوصه، وأنه يبث رسائله البصرية بطرق شتى، تعقبتُ بعضها وحصرته في كيفيات تؤشر لهذا الحس الذي أزعم وجوده مشغِّلًا مهمًّا في الكتابة الشعرية لديه، وفي فعل القراءة بالضرورة.
ومن ذلك:
– مشاكلة البورتريه المعروف في الرسم بنوعيه الشخصي للفنان ذاته، والغيري لشخصيات يرسمها. وسأتوقف عند نماذج وضع لها في العنوان وصف (بورتريه). والعنوان كما نعلم في برنامج القراءة والتلقي من عتبات النص، ومن أهم موجهات قراءته. ولدى سيف من النوع الثاني: بورتريه ل(سرور) وهي القرية التي ولد فيها. وهي تصلح لمقايسة مدى المشاكلة لعناصر البورتريه ومكوناته، وما جرى عليها من تعديل. وثمة بورتريهات لأصدقاء حاول أن يستعير آليات الصور المرسومة لهم بشواخص شعرية يؤطرها الخيال. كهذا البورتريه ليوسف الخال الذي يدلنا العنوان عليه: يوسف الخال.
أما زلتَ بهيئتك الأبوية/ تقرأ صحف الصباح/ وتحاور الأصدقاء؟/ ميممًا وجهك شطر المغيب.
– واستخدام النظر وسيلة لتوصيل الدلالة كما في عنوان قصيدته «أُسرح النظر» وفيها هذا المقطع الذي يؤكد أن محصول النص متأتٍ من النظر للأشياء لاحتوائها زمانيًّا ومكانيًّا في سطح القصيدة ومتنها الصوري:
أُطلق سراح النظر إلى آخره/ فأرى القوم على المواقد/ يرتبون الأيام والشعاب/ أمام شمس نازفة في العيون/ صامتين ثكالى/ يخبط الموج أقدامهم.
لقد أقام سيف المشهد البصري على أس النظر الذي توسل به لاستعادة زمانية المكان، ثم اصطفت مفردات المشهد التي يمكن تخيلها: الجماعة حول المواقد بما توحي تلك الكسرة المشهدية من التئام، ثم ما يفعلونه في جلستهم تلك: يرتبون أيامهم وكذلك الشعاب التي تعرفها جبالهم. والترتيب هو انزياح ذو أهمية في القراءة، يتصل بزماني هو (الأيام) ومكاني (الشعاب). ثم يستمر في بيان ملامح المرسومين في البورتريه الجماعي هذا: صامتين ثكالى والموج يكاد يغرقهم، بينما يكتمل المشهد بخلفية الشمس المشرقة بحدة وكأنها تنزف.
– المنظور المحدد دومًا بميزة خاصة هي كونه يبدأ من الضيق إلى المتسع أو الصغير المحدود إلى المطلق اللانهائي. من اليقظة المموهة بالنعاس أو الصبح غير المكتمل ضياءً. وزاوية المنظور من (النافذة) غالبًا أي من بؤرة بصرية تسمح بتحديد المرئي للتعبير عنه بطريقة ما، بتسميته مثلًا كما في قصيدة «أمام النافذة»: مأخوذًا بجلبة الشارع/ بنداء الباعة وصراخ الشحاذين/ والبكاء المر لسكارى منتصف الليل./ الحوذيُّ يجر عربته أمام الغيم/ والجزار يفقأ عين الضحية،/ بسكين يبزغُ من يده ملتهما/ مسافة المكان بين غرفتي وعنق/ الخراف./ كذلك الرعودُ وهي تنقر نافذة/ بيتي ليل
نهار مثل طيور الوادي/ مبشرةً بمقدم ضيف/ ربما لن أراهُ بعد اليوم/ و(نافذة): ليس أمامك سوى هذه النافذة/ التي يطل منها الأطفال/ نحو حربٍ جديدةٍ/ غير هذا الأفق الذي يسقطُ/ بين قدميك/ مغميًا عليه/ ليس أمامك غير هذه النافذة.
– المشهد الساكن القريب من الطبيعة الصامتة حيث يراقبه الشاعر من الأمام ليرصد إيحاءاته وانعكاساته الشعورية عليه. مثال ذلك: المرآة النائمة على الكرسي في بهو الفندق، أي هناءة تجرفها في هذه الاستراحة العابرة.
– المنظر الطبيعي (لاند سكيب): ويختار له سيف الأوقات غالبًاـ لاسيما الصباح -وقت اليقظة ومواجهة العالم وإحصاء أخطاء الأمس أو خساراته، والغروب كتنوع للزوال والسير نحو النهايات بأسى وخوف أحيانًا، ها هو الغروب مثلاُ في نص «ضياء نجمة في غابة»، حيث نلاحظ انعكاس الغروب كدالٍّ طبيعي على الأمكنة التي تضم ضمنًا البشر، ويعكس عليهم مدلولاته وأبرزها الموت والانتهاء: غروبٌ على دير الراهبات/ يسيل شبقًا على النحور والشفاه/ غروبٌ على ثكنةٍ للعسْكر/ غروبٌ على ضفاف الأحلام/ غروبٌ على مكبّرات للصوت/ تنعق بالكوابيس والوعيد/ غروبٌ على الصبايا المراهقات/ يتقافزن على حبال الأمنيات/ غروبٌ على المقابر والجوامع والإسطبلات/ غروبٌ على الشعراء والعُشّاق/ على الجلادين والسجون/ غروبٌ يحمل البلاد إلى حتفِها/ في مقبرة السُلالات .. ***بعد قليل: تذهب الأشجار إلى غروبها/ تعانق الظِلالَ/والأشباح ***القرويّات يحملن الغروبَ/ في جرار الفخّار على
الرؤوسِ/ والأكتاف.
– احتشاد التفاصيل تمامًا كما في اللوحات:
وهي سمة تنقذ النص من رتابة السرد. وقد بينا ذلك في ثنايا الدراسة. ومنها تداعيات النص السابق «ضياء نجمة في غابة». كالتداعي من الغروب على المكان إلى تفاصيل المكان ذاته من الداخل (غروب على الدير…)، ثم الاستطراد (يسيل شبقًا على النحور والشفاه). وممكن التوقف عند التفصيل ومعاينته مكبرًا كما في معاينة اللوحات الزاخرة أو المزدحمة بالتفاصيل.
– النهايات المفتوحة كما يرشحها المشهد البصري – وهي تقنية تقترب من التجريد الذي لا يحدد سردًا ذا بداية ونهاية في اللوحة.
حكاية قديمة
بين النوم واليقظة/ بين الصحو والمطر/ كان يمضي حمارُ جارنا القديم/ الذي أتذكرهُ الآن تحت شجرة التين/ عائدًا من أسفاره السعيدة/ بين البندر والقرية/ كان يمضي القيلولة تحت الشجرة المثقلة/ بالظهيرة والعصافير/ ناعسًا وعلى رأسه تاجٌ من الذباب/ لا يتذكر شيئًا/ لكنه يسرحُ أحيانًا فيرفسُ الجذع/ برجلين معروقتين بالألم/ وفي المساء يمضي لجلب الزرع من الحقول/ المبعثرة كدموعٍ خضراء سكبتها الآلهة./ في الرواح والمجيء يرسل نهيقه العالي كصراخ أضاعته / السلالة بين الأحراش، فتشرئبُ أعناق الحمير./ مرحًا/ مختالًا كطائر كركي بين إناثه/ وفي الليل حين يأوي إلى شجرته التي/ تلمعُ فيها عيونُ الديكة حالمةً بمقدم/ الثعالب، يكونُ قد غادر موقعهُ إلى/ ديارٍ بعيدةٍ يخوض فيها سهوبًا وأودية/ بحمله الثقيل وربما حَلَمَ بأنثى لم يطأها/ حمارٌ قبله…./
بالأمس رأيتُ حمارًا هرمًا تحت شجرة/ عتيقة.
هذه القصيدة تصلح موضوعًا لما هو إنساني في شعر سيف الرحبي، متمددًا من عزلته وشعوره بالأسى، فيرتد إلى ذكرياته ليعزز حالته تلك بما ظل في الذاكرة. مفردات يوم كامل لحمار القرية التي عاش فيها الشاعر صغيرًا، إنه بشكل ما يستعيد وحدته وشجنه وترقبه. يرصد رواح الحمار ومجيئه. حمار قرية تعب من مسيرته اليومية وأحماله الثقيلة (لنتذكر أنه وصف أصحابه بأنهم يجرجرون أيامهم الثقيلة…).
الاستهلال – كما في أغلب قصائد سيف – يستدعي بداية زمنية ذات دلالة على الحياة ذاتها (بين النوم واليقظة) و(بين الصحو والمطر) بتلون الأجواء التي توازي زمن الوقت. ثم يبدأ السرد: نتعرف على الشخصية (حمار جارنا القديم) ثم ندخل في يومياته:
– في الصباح يعود من أسفاره بين المدينة والقرية.
– في الظهيرة قيلولة غريبة: ناعسًا وعلى رأسه تاج من الذباب.
– في المساء يجلب الزرع من الحقول.
– في الليل يحلم عائدًا إلى وديان غادرها ويحلم بأنثى بكر.
في الخاتمة يضع له سيف مصيرًا مختزلًا في جملة شعرية يكون الحمار فيها عجوزًا نكرة (تحت شجرة عتيقة). في النص تسلسل سردي واضح الدلالة على الرتابة والتعب والهروب إلى الحلم. وفيه انقطاع عن السرد لإيجاد نهاية موجزة، بينما ذهب النص إلى الانزياحات والتفاصيل لكسر السرد، والرجوع للمركز الشعري المولّد للنص (الحقول المبعثرة كدموعٍ خضراء سكبتها الآلهة).
ولا تخفى المشهدية في النص كله، لكنها متحركة لا ساكنة بحكم اختيار متابعة يوميات الحمار ومصيره.
خاتمة
تبدأ القصائد كما تبدأ أحداث الحياة عند سيف الرحبي: بين نوم ويقظة قد يعنيان شروقًا وغروبًا، صباحًا ومساءً، ميلادًا وموتًا. لكنها تحدث خارج حيز قدرته أو سيطرته كإنسان، فتنتهي فجأة أو تتوقف دون حركة أو تنقطع. وتلك نقطة الدرامية في شعره التي هي بحاجة لدراسة منفصلة، بعد أن خصصنا هذه الدراسة للمشهدية البصرية ومكوناتها الجزئية، وكيفيات التعبير عنها، وتوصيلها، وما تحمله من دلالات على عذابات جيل وأحلامه وأوهامه أيضًا.
الشعر بصفته مرثية للوجود
رضا عطية – ناقد مصري
يمتاز الشاعر العماني سيف الرحبي بشخصية إبداعية تميزه بوصفه أحد أبرز شعراء الكتابة الجديدة وتحديدًا الموجة الثالثة من شعراء قصيدة النثر العربية التي كانت في أواخر سبعينيات القرن العشرين وفي ثمانينياته. يبدو شعر سيف الرحبي تمثيلًا لتجربة حياتية وإبداعية ممتدة في الزمن ومتسعة في المكان سفرًا وارتحالًا. الشعر عند الرحبي هم وجودي وتعبير جمالي عن هموم إنسانية كبرى تشاغل الذات وترافقها أينما ذهبت وحلت.
الشاعر عند سيف الرحبي رائيًا والشعر بمثابة رؤيا للوجود وتمثل ميتافزيقي يمنح العالم فلسفة لتفسيره ويهب الوجود تأويلًا لحركته، فالشعر بمثابة رسم تشكيلي للوحة كبرى تعيد تصوير الوجود، لذا فالنص الشعري بمثابة علامة جمالية ولوحة إبداعية يرسمها الشاعر ويعيد المتلقي إنتاج دلالاتها، في اختلاف مرجئ، يبقي على دال النص مفتوحًا على تأويلات متجددة، ومدلولات لا تنتهي.
الشعر مرثية وجودية
الشعر عند سيف الرحبي يبدو كمرثية للوجود، وكأنَّ الشاعر يعزف لحنًا جنائزيًّا حزينًا بكلماته، فالشعر تجسيد جمالي للمعاناة الوجودية وتمثيل فني لها، وتفجير للغة يتناسب مع شعور الذات بالألم، كما في قصيدة «الأرخبيلات البحرية»:
أتأملُ مشهدَ مدينةٍ تستبيحُ نعاسَها بالحرائق. مشهدُ مدينة تحترق في مساءٍ من مساءات رحلاتي الألف، أستمع إلى قيثارة امرأة عمياءَ وسط أنقاض الفيضانات، لحظة يحلق طائرٌ، يرتطمُ بأجسادٍ خرافيةٍ مثل حشرجة قتيلٍ يتذكّر ليلةً فاسقةً بين أفخاذِ الهملايا. المدينةُ تحترقُ/ الطائرُ يرتطمُ بثدي الريحِ. وكما لو أنّ رجلًا نائمًا رمى قبعةً في غابةٍ من الشموع، أو حجرًا في بركة دمٍ، استيقظتُ لأغسلَ عن وجهي دخانَ المذابحِ. ولا بأسَ أن نُضيفَ إلى هذا المشهدِ جلَبَةَ القصفِ لرعودٍ بحريةٍ بعيدةٍ تقتربُ حتى تلامسَ الأرخبيلاتِ المفعَمَةَ برُعاةٍ غامضين يرتكبونَ مجازرَ غامضةً في المخيلةِ، بينما: «موجة واحدة تدحرجُ خاصرتها منذُ طروادة».
إنه الشعر أو…؟! البحرُ الذي يخلعُ معطفَهُ على الخلائقِ/ المستكينةِ في كهوفِ النملِ/ البحرُ المتوثبُ كالنَّمِرِ في أحشاءِ امرأةٍ/ يمشي من غيرِ خفٍ على صفيحِ الوقتِ/ مترنِّحًا بثمالةِ الغامضِ/ مُدَحرِجًا ثالوثَ الزمنِ كعينٍ مفقوءةٍ في/ غيبوبةِ كائنٍ يستعيدُ ماضيَهُ بُرهةَ الاحتضار.
يتمركز الشاعر في موضوع يتمرأى له العالم بل الوجود من خلاله في إطار بانورامي وسياق منفتح، ليضعنا إزاء لوحة وجودية منفتحة تُمشهد الوجود، لوحة تتعالى على قيود التعيين الزمكاني، في ترسيم لكون «ديستوبي» يتمثَّله الشاعر انعكاسًا لإحساسه المأزوم وشعوره الاغترابي المتفاقِم.
من البداية يستهل الشاعر قصيدته/ مشهده الشعري ومعاينته الوجودية بمدينة تحترق في عز نعاسها، فيتبدى تنكير الـ«مدينة»، لتخليصها من التحديد المقيد، فهي ليست مدينة بعينها، قد تكون جماع المدن التي مر بها الشاعر، أو قد تكون مدينته الضائعة، فتبدو هذه المدينة في حالة نعاس وقت احتراقها، النعاس يعني غفلة وتغيُّب عن الواقع الراهن في لحظته الآنية، ثم ما يلبث الشاعر أن يقرن هذه المشاهدة زمنيًّا «في مساءٍ من مساءات رحلاتي الألف»، فالشاعر إذن في حالة ترحال، والترحال يعني عدم استقرار، وحالة بحث مستدام عن مكان ما، أو مدينة ما مفقودة، تنقيب عن كون يوتوبي ينشده الشاعر ولا يجده ولم يعثر عليه بعد.
وفي المقابل ثمة «قيثارة امرأة عمياءَ وسط أنقاض الفيضانات» يستمع إليها الشاعر، فهل ترمز المرأة العمياء إلى الذات الإنسانية في عمائها الوجودي؟ …في رؤية تعاين خرابًا وجوديًّا عارمًا في
اجتياحه التدميري.
يتبدى الحس الإليوتي مساكنًا سيف الرحبي في تمثله الوجود أرضًا يبابًا تحترق، كما تتجلى النزعة السوريالية في تشكيلات الصور الراسمة تمثيلات الذات للوجود كما في: «لحظة يحلق طائرٌ، يرتطمُ بأجسادٍ خرافيةٍ مثل حشرجة قتيلٍ يتذكّر ليلةً فاسقةً بين أفخاذِ الهملايا» فالطائر رمز الروح المحلقة أمام ارتطامه بأجساد خرافية فيعني تمكُّن القوى الخرافية من الهيمنة على الوجود وكفها القوى المتحررة المحلقة من ممارسة فعلها، أما التمثيل الصوتي لارتطام الطائر بالأجساد الخرافية بحشرجة قتيل فتعكس الشعور العدمي بموات الوجود وفساده، كما تكشف صورة مثل «أفخاذِ الهملايا» عن التمثل المجسِّد للعالم في صورة تصغِّر العيانات الكبرى في إطار بانورامية الصورة الكلية، وكذلك البعد الإيروسي في تمثُّل موجودات العالم، ويكشف التشكيل السوريالي للصورة عن لا منطقية العالم وعبثية الوجود من ناحية وفزع الوعي المتمثل هذا العالم الديستوبي من ناحية أخرى.
حين يصبح النص روح المكان وذاكرته
فاطمة الشيدي – كاتبة وأكاديمية عُمانية
لا يمكن أن تقرأ سيف الرحبي بمعزل عن المكان، فهو الشاعر الذي جاء نصه الشعري منسلًّا من الذاكرة المكانية بقوة، منبعثًا من سيرة الطفولة الحلم، منفجرًا كفلج عماني قديم، موشومًا بنمنمة الربيع وذاكرة السماء الأولى العابقة بلذة الجبال والسواقي والطفولة بهواجسها البيضاء واندهاشاتها الأولى.
إن المكان لدى سيف الرحبي -الذي فيه ولد في بلدة سرور بسمائل، في سلطنة عمان، وتنقل بين أفانين المدن العربية والأوربية، بعشق طائر يهفو للحرية والجمال، ويتمدد على خارطة المكان بكل تبايناته من سحر الشرق، وحرارة الروح، ودفء الذاكرة المأخوذ به؛ شكّل تكوينًا نحتيًّا مهمًّا في الذاكرة الشاعرة، المجترحة به حد الإتلاف والفناء، وحد التشيؤ كعنصر من عناصره الفيزيقية والميتافيزيقية، المشكّلة لذاته الإنسانية، وذاته الشاعرة التي جعلت المكان نصًّا، والنص خارطة للأمكنة.
ويُراوِح التشكّل الأول لدى سيف الرحبي بين تشكيلتين جغرافيتين متباينتين، فالأولى تشكيلة جبلية ومائية عذبة في سمائل وهي لا تفتأ تظهر في نصه، وتتجلى في كل كتبه “أودية وشعاب/ قرى معلقة على رؤوس الجبال/حدائق بابل معادة على شكل كابوس يتدلى من السقف/ قرى
وأودية وشعاب…”
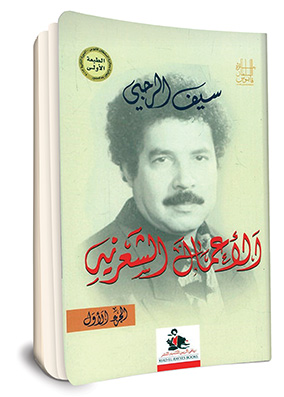 ثم يأتي التشكيل البحري لمطرح أو لمسقط بشكل عام، لتحضر الطبيعة الجغرافية المالحة والممتدة، لتحفز بؤرها الخلجانية، وجمالها البحري في ذاته، وترسم تشكلها المتدفق في جوانيته «طفلة تركض حافية على الشاطئ/ تصطدم بالسواري/ بالألواح/واللافتات/ تريد أن تقول شيئًا …»
ثم يأتي التشكيل البحري لمطرح أو لمسقط بشكل عام، لتحضر الطبيعة الجغرافية المالحة والممتدة، لتحفز بؤرها الخلجانية، وجمالها البحري في ذاته، وترسم تشكلها المتدفق في جوانيته «طفلة تركض حافية على الشاطئ/ تصطدم بالسواري/ بالألواح/واللافتات/ تريد أن تقول شيئًا …»
وتشكل تداعيات المكان (الجبل – الصحراء – الغابة – المدينة – البحر) لدى سيف الرحبي، عبر لغته المتخمة بالعذوبة والجمال صورًا مكانية غاية في الدهشة والإبهار، مبتعدة من التصوير الطبيعي للمكان إلى خلق علاقة من نوع بعيد بين المكان والإنسان عبر المتخيل اللامرئي، حيث «يفتح الوجود نفسه على هول اللامعنى، لا معنى للحياة وتفاهة الذات في عالم مشيأ موات، وهي ما يمنح مقام الإنسان معنى إذا يجعل منها حدث مواجهة لهول اللامعنى لا سيما في حضرة العدم وتجلياته الذي يمد الكائن بالمعنى».
وعلى الرغم من التداخل الدائم بين المكانين (الفيزيقي/الميتافيزيقي) إلا أن حضور المكان في النص الرحبي ليس حضورًا مباشرًا وواضحًا بحيث يمكن القبض عليه بلا ملابسات تخيلية، وهذا ما يشكل البنية الصورية المثيرة والمبهرة للنص الرحبي، فهو يستحضر صورة من عوالم خفية، وكأنه يتماهى بذاته ومكانه واحتراقاته فيها، ليتشكل ضمن صورة غرائبية بعيدة، تتمثل حضوره بين عالمين متوازيين حي/ لا حي.
وعلى هذا النحو يتقدم الكلام ماحيًا المسافات الفاصلة بين المحتمل، وغير المتوقع، وتتخذ ظاهرة استبدال السياقات الممكنة والمتوقعة بسياقات غير محتملة طابعًا انتشاريًّا في النص الرحبي لكأن «قانون الاستبدال هو الذي يمنح الكتابة امتداداتها، وهو الذي يمد الكلام بالمعنى، ويستل النص من مكوناته البانية لجسده… إنه يستدعي المحلي ويفتحه على الكوني المحجب فيه، ومن الذاتي ينفذ إلى البشري الشامل، فتنفتح السيرة الذاتية على محنة الكائن مطلقًا، وتصبح الكتابة إطلالة على الرعب المحتمي من المكان بأقاصيه وأصقاعه وكواه المعتمة».
«كنا نائمين في الصحراء/ حين مر البدو على أحصنتهم/ قاصدين البئر./
نهضت المدينة على أجسادنا/ لكن بقيت الإشارة/ إشارتك باتجاه النبع/
هي ما تبقى لي/ من زاد الطريق».
من الوعي إلى اللاوعي
وينطلق المكان لدى سيف الرحبي من الوعي إلى اللاوعي، فهو يفجر مسافات الهدوء والسكون الداخلي، أو الرعب النفسي أحيانًا، فالنوم السكينة والهدوء؛ تمثل حالة الصفاء الذهني، والنقاء الروحي التي ما تفتأ تُغتال بالجلبة الحياتية، والفوضى العامة والصخب المبرر، فالنص ينطلق من منحى نفسي، مارًّا باتجاه الآخر والحياة المبررة بالمبدأ الشخصي البرجماتي. معادِلًا (أي الشاعر) للحلم والجمال (بالإشارة)، تلك الإشارة التي تؤطر المكان بروعة البهاء والهدوء، بل والتدفق والغنى والثراء والجمال (النبع)، هذه الأسطرة والهيمنة الروحية في مداها الأوسع هي خيار الإنسان الأنقى للبقاء، وهذا البقاء هو المعادل الشرطي للحياة، ببعدها البعيد، ودربها الممتد في القادم عبر هذا الضامن للبقاء/الزاد.
المكان هنا يتجلى ببعديه الفيزيقي الحقيقي (الصحراء- المدينة – النبع – البئر) والميتا فيزيقي المتخيل: (بدائية الروح – جلبة العصر – الأمل المشرق بالغد) على رغم غياب الدلالات للغد إلا من إشارة أو إيماءة. لقد حضر المكان بشكل واسع وممتد وجارح في ذاكرته ومخيلته الشعرية، بما في هذا المكان (عُمان) من غنى وتناغم وتباين جم في معطياته، وتنوع في بيئاته الطبيعية، فالبحر بزرقته، والصحراء بهيبتها ترسم خيوط الصورة المتشكلة في مسامات الوجدان للشاعر العاشق للذرات وللذرى، والسهل يصبغ روحه بالأخضر والجمال، ويحفر في ذاته أخاديد، وينحت في ثنياتها ولهًا وحزنًا وقداسة وطهرًا لكل الجمال الموجود في الكون.
فيأتي الجبل الذي يتطلع برأسه إلى السماء ويلف جسده بحرارة الوقت والقوة على الأرض؛ ليشكل الهيلمان الأوسع في نفس الرحبي، وينعكس ذلك حضورًا في نصوصه، إن هذا التشكيل المكاني المهيب والذي يرمز بشكل جارح للهيبة والحذر، وهي سمات رجل الصحراء أو رجل الربع الخالي كما يريد سيف الرحبي لنفسه، كما يرمز للثبات والثقة والشموخ والعزة والأنفة.
ثم تأتي الصحراء بامتداداتها الواسعة وأنثوية مدلولها الجغرافي واللغوي، والقابعة كجدة شمطاء تحكي عناق الذرات، وتبكي هجرة الإنسان عنها، وتسطّر فكرة الغموض والقسوة التي توَلّد العشق، يقول الرحبي: «تحتلني أمكنة الطفولة الأولى مع شتات أمكنة أخرى لاحقة، مع صرف النظر عن مدى تحقق ذلك إبداعيًّا، فالهاجس الأساسي فتح نوافذ باتجاه المكان الغائب بتحولاته وتقلباته، هذا المكان المخترق بالزمن والبشر والروائح والأصوات، ومخترق براوي ثقله، وهو الذي يحاول أن يروي بعض جوانبه، كما يريد أن يتحقق من بعض تبعات أعبائه، لذلك فليس هناك راوٍ «متأله» يدرك الباطن والظاهر، وإنما الراوي نفسه ليس إلا ذريعة يجري التخلي عنها لاحقًا، ربما من فرط سطوة المكان بجباله وشعابه ومتاهاته. فالمكان ليس مجرد ديكور لشخصية أو شخصيات وإنما روح النص ولحمته وسداه.
إن نص الرحبي يحاول أنسنة المكان، وتأنيثه في علاقة قريبة، فالصحراء، والمدينة، والقرية، والغابة أنثى الشاعر في جميع هيئاتها الأم، والحبيبة، واللغة، يكتب لها وبها، ويتشكل المكان في أنوثة اللغة الساحرة والمسامرة للشاعر، والمنبثقة من الجبال كغزالة شاردة، أو سميرة تتقن فن الرواية والشعر والإنشاد، فالقصيدة النص تنسلخ منها روح الأم، فتحرسه عند المهد، وترقيه عند السحر، وروح العشيقة الشاعرة التي تغازله بأجمل القصائد، وأعذب الألحان.
وكأنه بذلك استلف من المكان المواربة والبوح في ثنائية غير متناقضة لتأتي لغته ناعمة كالرمال، قاسية كالقيظ، سامقة كالنخلة، صبورة كالجمل، هادئة كالسماء الصافية، غاضبة كالبحر، عاشقة كالمساء، تتجلى فيها روعة العشق، وحضور المكان الممتزج بالإنسان.
وبالتالي فهي لغة الطبيعة، لغة تشبه لغة المياه في الساقية، ولغة الجبل ولغة الأشرعة المهفهفة، والغابات والجبال والصحراء، لغة المكاني بكل غرائبيته وبدائيته، بكل تجلياته البعيدة والقريبة، «حشود من الحركات والصور التي تتوالد غزيرة، لا تكل ولا يدركها التوقف، فتصبح حركات النص ولوحاته، ومشاهده ورموزه وصوره، كما لو أنها تتراءى على أديم مرايا مهشمة، أو لكأن النص محكوم من الداخل بنوع من الفيض الدائم، هو الذي يتشكل مأخوذًا بنصوص أخرى، وأزمنة أخرى يتملك منجزها الجمالي، ويحاورها أو يستكشفها ويصهرها في محارقه، فيما يمعن هو في مزاوجة ذاته من صميم ذاته».
لغة العام والشامل والإنساني
إن قصائد الرحبي بما تحمل من ألق المكان، هي لغة العام والشامل والإنساني، لغة المكان الكون، و«هكذا تمعن الكتابة في توسيع ذاكرتها مأخوذة بها، حتى لكأن النص إنما يتشكل مأخوذًا بالبعد الكوني المتكتم على نفسه في جميع الثقافات محاولًا أن يمتلكه، أو لكأنه يفتتح مجراه مسكونًا بهاجس محو الحدود بين الأزمنة والنصوص، التي ينفتح عليها لحظة تشكله وصيرورته، فتصبح العلاقة بين النصوص على أديمه، كما لو أنها أصوات تتنادى أو لكأن كل نص يمضي في حركة طافحة تحنانًا وحبًّا».
 وبذلك «يخرج النص الرحبي من ذاكرة الوقت والمكان وسيرتهما، ليدخل ذاكرة اللغة التي تعيد تشكيل صورة المكان بدلالاتها الفنية المفتوحة على تاريخ الإنسان والمكان، في اتحادهما دلالة ومعنى، بصورة تكشف عن توتر لحظة الراهن ودراميتها ومأساويتها الفاجعة أيضًا». والحاضر الذي يعبّر عن فجيعة الراهن، وتوقه المحاصر بالهلاك والحنين وفوضى الأشياء وضياعها.
وبذلك «يخرج النص الرحبي من ذاكرة الوقت والمكان وسيرتهما، ليدخل ذاكرة اللغة التي تعيد تشكيل صورة المكان بدلالاتها الفنية المفتوحة على تاريخ الإنسان والمكان، في اتحادهما دلالة ومعنى، بصورة تكشف عن توتر لحظة الراهن ودراميتها ومأساويتها الفاجعة أيضًا». والحاضر الذي يعبّر عن فجيعة الراهن، وتوقه المحاصر بالهلاك والحنين وفوضى الأشياء وضياعها.
على مدار السنوات/ برؤوسها النابتة في الصخر،/ أشجارًا تغالب حتفها في الريح./ علينا أن نقتحم الأمكنة والمفازات/ كي نفوز بلمسة اشراقة/ كأشباحه موج متطاير في الظلمة/ أو كعصفور يسكن القلب منذ الأزل/ لكنه دائم الطيران».
فكأن السنوات (الزمن) بامتداداته الموجعة، وعتي حيواته، ورعونتها، تشق الصخر محاولة بأقصى درجات صعوبة الفعل، لتظهر كأنها أشجار عالية بمدلولاتها – أي الأشجار – من الرفعة والثبات والخضرة والحياة، لتقف في وجه الموت، والريح، بالمعنى الحي للحياة، بحركتها وسيرورتها، واضطرابها ولا ثباتها.
إن زمان سيف الرحبي الموغل في الجدب والرعونة والأزمة؛ يسير بلا رصيد حقيقي مرغوب، لكنه من القوة بحيث يحقق فعله في وجه الحياة، وفي دواخلنا شئنا أم أبينا…
ويواصل الشاعر مكانياته حيث يزفر: «لا نكاد نعبر المحيط بقواربنا الشراعية/ والصحراء بالجمال التي أعطبها/قيظ المسافة، إلا وتتلقفنا الضفاف الأولى/ بنهم جارف/ نهم العارف بصروف الأيام».
إننا حين نتحدث عن المكان (فيزيقي/ميتافيزيقي) فإننا لا نتحدث بانفصال، بل بامتزاج حقيقي، فالشاعر الذي يستخدم ضمير الجمع (نكاد/نعبر/قواربنا/تتلقفنا) حتى يضفي حكمه على المطلق، أو يستخدم الضمير الجمعي فيعمم جرحه على البشرية، وكأنه يفترض أن العبور المطلق باختلاف المكان الذي يتم العبور منه إليه (المحيط – الصحراء) هو مطلق المكان للإنسان في بدائيته الروحية، وكينونته الخلقية الأولى، ثم باختلاف الوسائل ووهنها وضعفها (القوارب الشراعية – الجمال التي أعطبها قيظ المسافة) كحلول متاحة في تمثل هشاشة الوسيلة، مقارنة بالغاية العليا (البحر – الصحراء)، وكأن الشاعر يقرر أن النهاية هي حضن الضفاف الأولى (الوطن/الروح/ المرأة) تلك الضفاف التي تتلقف كل هذا العناء بعناء أكبر، ووحشية تلقي، وجوع رغبة (نهم جارف)، لتسحب كل شيء في طريقها بهدوء الحكمة، وسيرورة الطبيعة المتغيرة واحتواء ذلك التغير بالمعرفة الحقة بحوادث الأيام وتقلباتها.
الطبيعة المتلاشية
إن المكان يتجاوز لدى الرحبي الوجود إلى اللاوجود، حيث الطبيعة المنهارة والمتلاشية أي الذاهبة بجبالها، وشجرها، وحيواناتها، (الذئاب والأسود) وطيورها (من غربان وعقبان)، فهو نفي شامل يتصل بالكون كله وما وراء الطبيعة ليتحول لوقوف على الأطلال، أو نعي نهائي للوجود بأكمله عبر اللغة النامية بسوقها وورقها وزهرها فوق الوجود والعدم، مصحوبة بنحيب ضمني عبر تجربة الذات المتوجعة التي تشعر باللاجدوى من كل شيء.
«من أي الجهات/ يصدح هذا الصوت/ بجرف المسافة/ كإله غاضب/ من الماضي أم من المستقبل؟/ من كهوف القدماء/ أم من ناطحات سماء المدن؟/
صوتك الذي يسري في عتمة أعصابي/ عبر الأزمنة والوديان».
المرأة هنا ليست الكائن بل هي جزء من المكان، أو هو جزء منها، حيث تشكل جغرافيات الذاكرة، وفيوضاتها في اللغة. «ظلك الوحيد الذي يتبعني/ كحكاية من غير بداية ولا نهاية/ حكاية الخلق الأولى بعد الطوفان/ ظلك الذي يفترسني من غير رحمة».
فالمرأة لدى سيف الرحبي هي الظل الذي يلاحقه ويستوطن روحه، وحين يهرب منه فهو هارب إليه، إن هذا الذي لا يملك القدرة على الانفكاك من سيطرته، يتبعه كحكاية بلا بداية ولا نهاية، حكاية قديمة من زمن نوح، كمعادل زمن للقديم، بكل امتداداته وغوره في الماضي، غير أن هذا الظل الرحيم القاسي يفترسه ببشاعة، فهو وحشي المزاج والسطوة والحضور الدائم والوجد المتأصل.
حيث يستحيل المكاني الفيزيقي إلى ساحة للمتخيل العاطفي، ويتحول المتخيل إلى استنهاض المكاني الحقيقي في هوة الذاكرة والشعور، في علاقة تبادلية يعانق فيها الشاعر ذاته وذاكرته ومرابعه.
المرأة لدى سيف الرحبي هي الظل الذي يلاحقه ويستوطن روحه، وحين يهرب منه فهو هارب إليه، إن هذا الذي لا يملك القدرة على الانفكاك من سيطرته، يتبعه كحكاية بلا بداية ولا نهاية.
ذئب الثلوج يعود إلى جباله وحيدًا
 عاشق التاريخ والأساطير وسير الأماكن
عاشق التاريخ والأساطير وسير الأماكن
صبحي موسى
حين تلتقي سيف الرحبي فإنك لا تكاد تشعر به، فبينما الأصدقاء من حوله هادرون في صخبهم حول الشعر والذكريات والتاريخ والفن تجده صامتًا، ينصت ويتأمل ولا يتحدث، كأنه جاء ليتشرب الحياة من حوله، محاولة مزجها في أتون كبير يخصه، حيث مطبخ الشعر والمقالات وكتب الرحلات، تلك التي سرد فيها علاقته بالأماكن والأصدقاء والشعر، متحدثًا عن القاهرة التي تلقى تعليمه فيها، وعن بيروت التي شكلت مزاجه الأثير، وعن البلدان الأوربية التي تنقل بينها وأقام فيها، وعن قريته سرور ومدينته مسقط، حتى إن العالم لديه يبدو كرحلة لا تنتهي، بدأها منذ الصغر وما زال مستمرًّا فيها، إن لم يكن
بجسده فبذهنه.
يترك الأصدقاء يتحاورون من حوله بالساعات وهو يتأمل صامتًا، لا يجيبهم إلا بكلمات قليلة، ربما ضحكة لا تنبئ عن شيء، وربما جملة تسهم في ضبط إيقاع الكلام، لكنه سرعان ما يعود إلى ترحاله الداخلي، أو حسبما يقول في قصيدته “أصدقاء”: «أصدقاء/ يحجزون المقاعد في الصباح/ كي نشرب القهوة وندخن/ لا يكاد يسطع الكلام من أفواههم/ إلا وتمتلئ الطاولات/ بالغياب».
صدرت للرحبي مجموعات شعرية عديدة، وكتب رحلات وأخرى ضم فيها مقالاته. وقُدمت عدد من أطروحات الدكتوراه عن أعماله، وترجمت عدة مختارات من قصائده إلى بعض لغات العالم.
شاعر وروائي مصري
تجربة كبيرة تحتاج إلى مزيد من الاحتفاء
صلاح حسن
أتابع تجربة سيف الرحبي الشعرية من خمسة وثلاثين عامًا، وهي تتطور وتنضج بهدوء، وتكبر عبر مراحلها المتعددة. يكتب سيف نصوصه بعد أن يكون قد التقط فكرتها، وهو يعرف متى تبدأ القصيدة ومتى تنتهي، لهذا تجد نصوصه مقتصدة ومكثفة حتى في النصوص الطويلة التي يكتبها. الشيء الآخر في تجربة سيف الرحبي أن نصوصه غير متشابهة، ولكل نص شخصية خاصة وفكرة مبتكرة، مما جعل تجاربه متنوعة وحيوية وخاصة به. سيف شاعر ملتاع ومهموم، لذلك يحاول صياغة هذه الهموم فلسفيًّا، ونادرًا ما نجد نصًّا يخلو من فكرة عميقة أو غير مصوغة بلغة شعرية متينة ومكثفة، إنها واحدة من أهم التجارب الشعرية العربية في قصيدة النثر.
استفاد سيف الرحبي كثيرًا من تنقله في البلدان العربية والأوربية، مما أكسبه ثقافة بصرية مختلفة، وجعل نتاجه متنوعًا وثريًّا، تحضر الطبيعة في شعره بقوة وتنوع غريب ومتناقض بما يجعله مختلفًا عن السائد، وقد ساهم ترحاله المتواصل بين البلدان في إثراء وحضور الطبيعة في شعره، الثقافة السينمائية التي اكتسبها سيف جعلت صورته الشعرية مختلفة ومركبة وغير مألوفة، لا أستطيع في هذه الشهادة المقتضبة أن ألم أو أحيط بهذه التجربة التي تستحق أن تُكتب عنها كثير من الدراسات.
شاعر ومسرحي عراقي مقيم في هولندا
اقتراح شعري جديد
فتحي عبدالله
لقد ترك سيف الرحبي مجتمع الصحراء مبكرًا إذ أتى إلى مدينة القاهرة لدراسة الثانوية هنا وعاش كل تعقيدات المدينة وقسوتها مع الاغتراب والانفصال عن الأهل والأقارب، ولم يستمر بها كثيرًا فتم ترحيله إلى دمشق ومنها إلى مدن الصقيع والثلج، فدخل مفهوم الحداثة من بابه الواسع، أي من المعيش واليومي وفي إطار ما هو معرفي.
استطاع أن يتعرف إلى أشكال الكتابة الجديدة، وقدم أول اقتراحاته الشعرية في نموذج خاص لا يرتبط باقتراحات الرواد في شعر الحداثة، وإنما يرتبط بنمط قصيدة النثر. وكانت نصوصه تتمتع بأكبر قدر من العدمية والعبث واللغة الحادة والعنيفة والخيال المديني، وعكس اقتراحه الأول أزمة الإنسان الحديث وقلقه تجاه مصيره الذي ابتعد كثيرًا من الخرافات.
وبعد أن ترك أوربا وعاد إلى مجتمع الصحراء، بما يملك من رؤية كلية للوجود وللصراع البشري بل وللصراع مع الجبال والصحراء بكل مخلوقاتها، اكتشف شعرية أخرى أكثر إنسانية، إذ إن الذات الشخصية لا وجود لها إلا مع الجماعة، ويتم ذلك عبر قوانين خاصة وعادات وتقاليد بل وطقوس فريدة في كل الأوقات. واكتشف الشاعر أن النموذج القديم لا يصلح، فاخترع اقتراحًا شعريًّا جديدًا يناسب تلك الحالة، وهي القصيدة ذات الإطار الملحمي والمركبة، مما استدعى خيالًا وحشيًّا ولغة مادية متوترة، ووقائع تاريخية تتحول في رؤيته إلى حالة أسطورية مزج فيها بين أنماط كتابية كثيرة وبين عوالم متعددة، منها ما هو أسطوري ومنها ما هو واقعي ومنها ما هو مجرد وما هو مجسد.
قدم سيف الرحبي مشروعًا شعريًّا كبيرًا ومختلفًا، وهو من أهم النماذج في قصيدة النثر العربية. كما قدم سيف كتابة حرة لا ترتبط بأي نمط أو نوع محدد مما هو معروف، وهي كتابة تمزج بين ما هو فكري ومعرفي وما هو شعري، وتمزج كذلك بين الوقائع اليومية في السياسة والثقافة وبين التاريخ والأساطير منذ نشأة البشرية حتي اليوم، كما كتب يومياته الشخصية وهي كثيرة ومتنوعة وبها أماكن كان لها دور كبير في الثقافة مثل باريس وبيروت ودمشق والقاهرة والمغرب، كما قابل والتقى رموز تلك الأماكن وأظهر تأثيرها في الإبداع والفنون، كل ذلك كتبه في لغة جميلة وسرد نوعي لا يخضع للمنطق أو العقل وإنما يأتي استجابة لحالة روحية تعكس ارتباط الشاعر وحنينه لما حدث في أيامه الماضية.
ومن أهم أفعاله الثقافية رئاسة تحرير مجلة نزوى التي أصبحت أهم مطبوعة عربية؛ لأنه فتحها لجميع أنماط الكتابة شرط أن تكون لها قيمة، ولم تتحول بمرور الوقت إلى سلطة ثقافية يمكن استغلالها لصالحه ولصالح مشروعه الشعري.
شاعر مصري
 يصافح القارئ بالشعر
يصافح القارئ بالشعر
أحمد السلامي
بداية، أظن أن مساحة كبيرة من الديمومة الشعرية العربية، إنتاجًا وتلقيًا في وقتنا الراهن، تدين لسيف الرحبي ولمجلة نزوى بالكثير. فكلما لمحت هذا الاسم الكبير أجده مرادفًا للإعلاء من شأن الشعر، له دوره الصامت في المحافظة على مكانة الكتابة الشعرية كاشتغال لم يفقد صدارة الاهتمام، أن تجعل باب الافتتاحية في المجلة مشرعًا على القصيدة، وهي تتأمل وتنسج تداعياتها بخطاب نثري مختلف، ذلك يضع المتلقي في متن شعرية تتجرأ على كسر التبويب المصمت المتعارف عليه في ذاكرة المجلات الثقافية العربية. هذا هو سيف الرحبي الذي يصافح القارئ بالشعر. أجد هذه الإشارة مدخلًا مناسبًا لمشاركتي في هذا الاحتفاء.
على مستوى التجربة ومكانتها في الشعرية العربية، حتى الذين ليسوا من جيل الرحبي ولم يجايلوا بداياته، يجدون له حضورًا في وعيهم. ليس بوصفه اسمًا مكرسًا وحاضرًا ضمن نخبة تعولمت عربيًّا وصارت أيقونات بارزة في عواصم الثقافة وأنشطتها ومطبوعاتها، فحضور سيف يتأسس على خصوصية تجربته وتمرده على التشابه والتماهي مع السائد المجايل له. لديه نجاحه المختلف والصعب كذلك. لقد استطاع أن يجعل الشعر اشتغاله الأثير وعنوانه الدائم. به يعرف ولا يشار إليه إلا بوصفه سيف الشاعر. ظل ولا يزال يحفر قصيدته كما عاش ويعيش تجربته الحياتية وتأويلاته المتجددة لإيحاءات ومرئيات، تستدعيها الجغرافيا والمنافي والراسخ من طبوغرافيا الأمكنة وما تشف عنه في الوجدان الذي يتجوهر ويتعتق في وعي الشاعر.
يرتبط اسم سيف الرحبي لدى الأجيال الأحدث كذلك باسم مجلة نزوى، على رغم أن تجربته أكثر شساعة، لكن منجز المجلة لم يكن عابرًا من ناحية الأثر والدأب والاستمرارية والتقاليد والمحتوى الغني الذي أسهم في تربية الذائقة وتكوين بؤرة مشعة للتبشير بالكتابة الجديدة، في وقت غلب عليه انطفاء الحماسة في مراكز ثقافية شهيرة، فيما واصلت نزوى مهمة تبئير الحداثة وما بعدها في المخيال الثقافي العام، عبر نشر النص الجديد والترجمات الملهمة. لا أنكر أنني اهتديت إلى أسماء بارزة عربية وعالمية في حقول أدبية وفنية وفلسفية من خلال أبواب مجلة نزوى. نحن كذلك في اليمن كجغرافيا محسوبة على الأطراف المقصية الواقعة على الهامش استفدنا من مجلة نزوى، وأوصلنا أصواتنا ونماذج من نصوصنا إلى الساحة العربية، لذلك نكن عاطفة خاصة تجاه المجلة وتجاه سيف، باعتباره أيضًا العماني الذي لا يجهل اليمن بل اندمج في مرحلة من حياته مع عوالمها وناسها. وعمان بالنسبة لليمن فضاء لتاريخ حضاري مشترك بحكم الجغرافيا المتجاورة. أيضًا لا أنسى صديقنا الشاعر طالب المعمري الذي لا أحد ينكر بصمته في التواصل واستحضار الأسماء من غياباتها.
أعود إلى التداخل بين الرحبي الشاعر ونزوى المجلة، وهو تداخل مبرر ثقافيًّا من زاوية التلقي والأثر والدور الذي استطاعت المجلة أن تتموضع فيه. لقد حافظت نزوى بإصرار من سيف الرحبي نفسه على وجودها بشقيه الفيزيائي الملموس ورقًا وإخراجًا وتبويبًا وعوالم غنية وكتابات وترجمات وحوارات مدهشة لن تجدها إلا على صفحاتها، وهناك الوجود الآخر العابر للمجلة ككتلة ورقية تلمس ثقلها بين يديك، وأعني به الوجود الثقافي الرمزي والتراكم الذي حققته في المشهد الثقافي العربي عامة.
شاعر يمني
 مفازة الرحبي والكوني
مفازة الرحبي والكوني
فتحي نصيب
ينتمي سيف الرحبي إلى جيل أدبي تالٍ على التجربة الشعرية التأسيسية التي اصطلح على تسميتها بالشعر الحديث، والتي نشأت وترعرت في المراكز الحضرية (بغداد والقاهرة ودمشق)، لكن الرحبي يطل علينا من شرفة الخليج العربي الذي يحده مدى البحر، وشساعة صحراء الربع الخالي التي يصفها بأنها (مفازة مروعة، بالغة الجفاف والضراوة بل ومرعبة).
كيف أثرت هذه البيئة القاسية في الإبداع الشعري بل والأهم كيف وُظِّفَت فنيًّا وأدبيًّا؟ هنا يمكن أن نجري مقارنة بصحراء الكوني الذي رأى فيها المكان (المتعالي) أو الفردوس المفقود، مقابل ما تحمله المدينة والمدنية من إشكالات وأزمات أجبرته على أن يدير ظهره ويتجه إلى أسطرة الصحراء الكبرى، تلك التي تماثل صحراء الربع الخالي في قسوتها وضراوتها. المفارقة أن رؤية الكوني تعد نكوصًا إلى المرحلة الجنينية التي تنظر بغضب إلى الحداثة والمدينية من ناحية، وكذلك محاولة بعث الحياة سحريًّا في عرق سكاني يعيش على تخوم هذه الصحراء التي ينتمي إليها الكوني، في حين يكتب الرحبي عن (رجل من الربع الخالي) متجاوزًا البيئة كواقع جغرافي، واشتغل بوعي لتكون هذه الصحراء معادلًا موضوعيًّا للوضع العربي الراهن والبائس، فالربع الخالي بقسوته يشبه الحالة العربية التي تسود فيها (غرائز الانحطاط وترتد إلى ما قبل الدولة، وما قبل الحداثة، وحيث التشظي والطوائف والقبائل) ولذا فإن محاولته الشعرية هي إعطاء هذه البيئة الجغرافية هذا المعنى.
كيف تجلت هذه الرؤية الفكرية على المستوى الفني لقصيدة الرحبي؟ صرح الشاعر بأن لغته الشعرية (خشنة وقاسية) لأن من سمات رؤيته للنص الشعري الجديد (التحرر من الأعباء البلاغية والزخرفة التي يتم كسرها لصالح آفاق تعبيرية أكثر سعة، وتلم شمل هذا الحطام المتشظي في أحداقنا وقلوبنا) على حد تعبيره في كتابه «ذاكرة الشتات». هذه التجربة الشعرية القلقة تعبر عن البنية النفسية والتاريخية للواقع العربي الراهن في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، التي حاول الرحبي قولها أدبيًّا مستعيرًا قول آرثر رامبو «أنا الرائي» بالمعنى الوجودي، والتي نجدها في ثنايا تساؤلات الرحبي فيما كتبه شعرًا ونثرًا.
ترى إلى أي مدى تمكن الرحبي من قطع هذه «المفازة» المنغرسة مثل صخرة مسننة في خلايا الإنسان ووجوده كما يتساءل هو نفسه؟ ربما يظل هذا السؤال الحارق مفتوحًا في تجربة سيف الرحبي ضمن أنطولوجيا الشعر العربي المعاصر.
كاتب وناقد ليبي مقيم في فرنسا
العالَم بنظرةٍ مختلفة
ريم داوود
التقيته للمرّة الأولى وأنا طالبة جامعية في نحو العشرين، في السنوات الأولى للتسعينيات. الواقع أنني قابلته مرّتين متقاربتين، إحداهما في القاهرة والأخرى في مسقط، لا أدري أيّهما سبقت الأخرى، لكن أستاذي الكاتب الراحل «جمال الغيطاني»، كان حلقة الوصل بيننا في المرتين.
كنتُ حينها صحفية تحت التمرين في جريدة «أخبار الأدب» الأسبوعية، التي رأس «الغيطاني» تحريرها لسنوات. اقترب موعد سفري السنوي لمسقط، فأعطاني ظرفًا كبيرًا، لا أعرف محتوياته، وإن كنت أظن أنه كان كتابًا، إضافة إلى خطاب. حملتُ الظرف لـ«سيف الرحبي» في المقرّ القديم لمجلّة «نزوى»، الذي كان عبارة عن فيلا في منطقة «مدينة قابوس». رحّب بي الرجل، وكان بالغ اللطف والتواضع، معي أنا، الشابّة الصغيرة التي تكاد تتعثّر في خجلها. خلال حديثنا القصير، فهم أني سأسافر إلى «لندن»، لألحق بوالديّ اللذين سبقاني لقضاء إجازة الصيف هناك. استسمحني بدماثته المعهودة في المرور عليه ثانيةً، قبل سفري، ليرسل معي ـ بدوره ـ كتابًا وخطابًا للكاتبة اللبنانية الراحلة «ميّ غصّوب». أخذتهما منه بالفعل، وحملتهما إليها في مكتبة «الساقي».
بعد عودتي لمصر، وفي صباح شتوي بارد، استدعاني الغيطاني لمكتبه، وأخبرني أن سيف الرحبي موجود في القاهرة، واقترح عليّ لقاءه وإجراء حوار معه. لم أكن مستعدة لإجراء لقاء لم أحضّر له جيدًا. قلت ذلك بشيءٍ من القلق. قال «الغيطاني» مُطَمئِنًا، كعادته، إنها ستكون مجرّد دردشة خفيفة.
حتى ذلك الوقت، انحصر معظم عملي في تغطية الندوات. كان إجراء لقاء صحفي، بمفردي خطوة كبيرة أثارت توتّري. التقيت سيف الرحبي في أحد مطاعم منطقة «المهندسين»، صباح اليوم التالي. أخرجتُ جهاز التسجيل من حقيبتي، وبدأنا نتكلم عن الكتابة والحياة وأمورٍ شتّى. حين انتهى اللقاء اكتشفتُ، لصدمتي البالغة، أن الجهاز لم يسجّل كلمة واحدة!
غمرني شعورٌ هائلٌ بالارتباك والحرج البالغ. أحسستُ بضيقه هو أيضًا، لكنه تجاوز المسألة خلال لحظات، ووعدني أنه سيكتب كل ما تكلّمنا فيه ويرسله لي. أوفى بوعده وبعث لي بإجاباتٍ على أسئلتي. نُشِر اللقاء في «أخبار الأدب»، ثم أعادت صحيفة «الأيام» البحرينية نشره. عبر أعوامٍ طويلة، جمعتنا لقاءات قصيرة، سريعة، لكنها مليئة بالودّ والكرم والمحبّة الصافية. ما من مرّة زرته فيها في مكتبه، إلّا وخرجت محمّلة بكتبٍ ـ له ولغيره ـ ومطبوعات مختلفة؛ والأهمّ من ذلك بحكاياتٍ وذكرياتٍ مدهشةٍ، وقصصٍ عن أشخاصٍ كنتُ أظنّ أنّي أعرفهم، لكنني أتعرّف إليهم من جديد عبر نظرته العميقة والمختلفة للناس.
مترجمة وصحفية عمانية تقيم في القاهرة
جمعنا حبنا المشترك للقاهرة
حبيبة محمدي
«سيف الرحبي» شاعرٌ كبيرٌ ومبدعٌ حقيقيّ. يَكتبُ بلغةٍ خاصةٍ، لغة شامخة، له معجمه الذي يخصّه وحده. قرأتُ له قبل أن ألتقيه. فهو من جيلٍ يسبقني بخطواتٍ في التجربة الشعرية، فقد بدأ النشرَ في مطلع الثمانينيات، وقتها كنتُ أقدم برنامجًا إذاعيًّا في الإذاعة الجزائرية، أقرأ فيه نصوصًا شعرية مع الموسيقا، وكنت أسعى إلى أن أطَّلِعَ على جديد الشِّعر في الجزائر، والوطن العربي كلِّه، بهدف التعريف بشعراءِ عالمِنا العربيّ، تحصلت على بعض دواوينه، وقرأتُ نصوصًا له، ولم أكن أعرفه شخصيًّا ـ بَعْدُ ـ مثلما فعلتُ مع شعراء كثيرين آخرين غيره.
وبعد إقامتي في القاهرة، كنا نلتقي في المناسبات الأدبية والثقافية، والحقيقة أننا لم نكن نحتاج إلى وقتٍ كبير كي نصير صديقيْن، بعد أوّل لقاء ـ فما يجمعني بالشاعر سيف الرحبي كثيرٌ ـ جَمعَنا أوّلًا، أمرٌ مهم ومشترك، هو عشقنا لمصر الحبيبة، ولمدينة القاهرة أيضًا، فأنا درستُ في مصر وطني الثاني، فقد أقمتُ بها طويلًا، حيث عشت بين أهلي وعِشرتي الجميلة، ولا أزال العاشقة الأولى لها، وهو أيضًا درس بمصر، وكان يزورها باستمرار، لدرجة أنه ـ على ما أذكر ـ اتخذ له مسكنًا دائمًا في القاهرة. والمصادفة أنه كان جارًا لي في الحيّ نفسه، حيّ «الدقي» العريق! فيما عرفتُ ذلك لاحقًا! جَمعَتنا أيضًا طريقةُ الحياة، وأسلوبها، فهو -مثلي- يحيا بالشِّعر ولا يكتبه فقط… ببساطته وتلقائيته.
لصديقي الكبير سيف الرحبي منزلةٌ كبيرة في قلبي وعقلي، فهو إنسانٌ راقٍ جدًّا، طيب، وصديق وفيّ لأصدقائه، إنسان متصالح مع نفسه جدًّا.. إنه شاعرٌ حقيقي بحجم الكون، وبحجم الإنسان.. مع «سيف الرحبي» تنسى جنسيتَه الأصلية، وتشعر فقط، أنَّكَ في رحاب نورٍ روحاني، وفي حضرةِ كائنٍ كونيّ فقط.. جوهره الشِّعر كتابةً وسلوكًا…
حقًّا هو كبير، إنسانيًّا وإبداعيًّا..
أما قيمتُه الشِّعرية، فمن المفترض أن يُقَيِّمَها النقادُ الحقيقيون بكلِّ موضوعية، فهو موهبة كبيرة، منذ «نورسة الجنون».. حتى «رجل الربع الخالي» وغيرهما من الدواوين والكتب… سيف الرحبي شاعرٌ حقيقيّ.. يكتب كما يحيا… شاعرٌ حَمَلَ أَرَقَ الصحراء، وعاش في عواصم العالم كلِّها، الأوربية والعربية بكلِّ تفتحٍ وتنوير…
إنَّه صديقُ الزمنِ الجميل، باقٍ في شغاف الرُّوحِ، شاعرًا باذخًا، يعانقُ الكلمةَ بكلِّ صدقٍ.. وإنسانًا مفرطًا في إنسانيته. وما أَحوجنا في عالمِنا العربيّ، إلى تكريمِ المبدعِ، وهو لا يزال على قَيْدِ الإبداعِ والحياة!
شاعرة وكاتبة جزائرية
روابط جمعتني به
منى حبراس السليمية
لا أذكر متى على وجه التحديد سمعت باسم سيف الرحبي لأول مرة. في صفوف المدرسة على الأرجح، ولكني عرفته بوضوح أكثر في الجامعة. كان اسم سيف الرحبي يشي بالمختلف ولكنه ليس بالمحمود بالضرورة. لم يقل أستاذ متطلب اللغة العربية الذي درسته في سنتي الجامعية الأولى شيئًا سلبيًّا عن حداثته الشعرية، ولكني لم أستطع تجاوز إحساسي بأن الأستاذ لا يحب حداثة الرحبي.
قرأت بعض شعره في الجامعة، ولا أعرف أي دافع جعلني أحاول تقليد ما يكتبه. كتبت نصًّا شعريًّا نثريًّا (أبدو واثقة وأنا أصفه كذلك) بدأته على هذا النحو: «أمسكت لوحًا من حبر دمائي/ يعزف إبداع الظلام». ثم ما عدت أتذكر ما تلا هذا الطلسم من نص طويل (ما زلت أحتفظ به على كل حال)، وذهبت به إلى الأستاذ المتكتم كمن يود أن يكتشف شيئًا. قلت له: «كتبت نصًّا» وناولته الأوراق، وراح يقرأ ثم قال: «نعم هذا نص حداثي». ولم يُعقّب.
كنت سعيدة بحُكمه لسبب مجهول! ألأني كتبتُ نصًّا حداثيًّا؟ أم لأن الأستاذ لم يذمّ ما كتبت، ومن ثم فهو لا يكره سيفًا؟ أم تراه قال (حداثي) تعبيرًا يضمر به رأيه عن كل ما لا يحب؟ لست أدري!
في الفصل الدراسي التالي قال لي أستاذ الأدب العماني الدكتور محسن الكندي: اقرئي لسيف الرحبي «منازل الخطوة الأولى» فهو يحكي عن مدينتك سمائل وعن سرور. خرجت من محاضرته وقصدت المكتبة الرئيسة باحثة عن منازل سيف الأولى، فإذا به كتاب صغير قليل عدد الصفحات، فأتيت عليه سريعًا. وأحسب أن كتابه ذاك هو ثاني سيرة ذاتية عمانية بالمعنى الفني بعد كتاب «مذكرات أميرة عربية» للسيدة سالمة بنت سعيد، وإن كانت تقتصر منازل سيف على سيرة الطفولة كما يشي العنوان.
الشيء الخاص الذي يربطني بسيف الرحبي فقد عرفته من سيف نفسه لاحقًا، وهو أنه كان زميل والدي رحمه الله في البعثة التي أوفدتها الحكومة مطلع السبعينيات ليدرسوا في القاهرة ضمن رفقة مكونة من خمسة أشخاص: والدي، وسيف الرحبي، وسماء عيسى، وأبو سرور حميد بن عبدالله الجامعي، وشخص خامس أنسى اسمه دائمًا، وفي كل مرة أستعين بذاكرة سماء عيسى ليذكرني باسمه (وأرجو أن يغفر لي إن كان يقرأ هذا). التقيت سيف الرحبي مرات عدة، أذكر أولها في مكتبه بمجلة نزوى أواخر عام 2013م بعدما نُشرت لي أول مادة في المجلة في عددها 77، ثم توالت اللقاءات بين فينة وأخرى خلال زياراتي التي أقوم بها إلى المجلة لرؤية صديقتي الكاتبة هدى حمد، منسقة التحرير بالمجلة.
شكّلت هدى رابطًا ثالثًا يجمعني بسيف، فمعها كنت ألتقيه وأشخاصًا آخرين يزورونه من خارج السلطنة أو يأتونها زائرين فيطلبون لقاءه، وكانت هدى نقطة الاتصال في كل ذلك. مع هدى اقتربت من سيف الرحبي الإنسان الذي يفصح عن خواطره كما لا تفصح عنها نصوصه. رابط آخر جمعني بسيف، وهو زوجته الفنانة التشكيلية بدور الريامي التي كانت زميلتي في العمل في وزارة التعليم العالي قبل أن تتقاعد هي وأستقيل أنا بفاصل زمني لا يتجاوز سنة، وقبل أن يصبح اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ارتبط اسم سيف الرحبي عربيًّا بمجلة نزوى التي تأسست في 1994م حتى أصبحا شيئًا واحدًا. وبالنسبة لي فقط ارتبط اسمه بمعاني يندر أن تجتمع في شخص واحد: الماضي والحاضر، الكتابة والصمت، الشعر والنثر، التفاؤل والحذر. ولا أعرف إلى أيها هو أقرب، فمتى ما حضر سيف الرحبي حضر كله، وبعض تلك المعاني يخصني وحدي، منذ راح يحدثني عن أبي على الرغم من قصر عمر الصحبة التي جمعتهما معًا.
ناقدة وأكاديمية عمانية
«نزوى» التي أسسها سيف
سمير درويش
 منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
حين صدرت «نزوى» كانت الصحافة الثقافية في سلطنة عمان متراجعة إلى حد كبير أمام مشاهد طاغية مجاورة، في الخليج العربي نفسه، مثل المشهد العراقي الذي كانت تصدر عنه مجلات قوية لعبت دورًا مهمًّا في إنتاج الثقافة العربية، مثل «الطليعة» و«أقلام»، وكذلك هناك مجلة «العربي» الكويتية إلى جانب عالم الفكر، وسلسلة عالم المعرفة والمسرح العالمي، وفي قطر مجلة «الدوحة» التي شهدت مجدها في الثمانينيات، وفي الإمارات مجلات تظهر وتختفي، وفي البحرين مجلة «البحرين» الثقافية، استطاعت نزوى أن تحفر لنفسها مكانًا في هذا المشهد، وأن تكون قبلة كثير من الأدباء والمثقفين العرب.
من حسن حظ «نزوى» أنها وجدت تمويلًا دائمًا من واحدة من المؤسسات الصحفية الحكومية الكبرى في سلطنة عمان، وفرت لها الدعم المالي واللوجستي المطلوب، ومن حسن حظها -أكثر- أن رئيس تحريرها شاعر كبير ومهم في المشهد الشعري والثقافي العربي، وهو مثقف تنويري يحرص على إفساح المجال للكتابات والأفكار الجادة، لديه مساحة قد لا تتوافر لغيره.
إنتاج مجلة ثقافية رصينة ليس عملًا سهلًا كما قد يبدو، فالمجلة تحتاج إلى تحديد رؤيتها من الواقع ومتغيراته، رؤيتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والتعليمية. إلخ، هذه الأشياء التي قد لا تظهر بشكل مباشر، ولكنها تشكل النسق العام الذي تسعى المجلة إليه. كما أنها تحتاج إلى ترسيخ شخصيتها الجمالية والموضوعية، دون أن تغلق الباب أمام المختلفين في الرأي والتوجه، وهو عمل شاق بالفعل. تحقيق كل هذه الأشياء مجتمعة لا يخلو من صعاب، كما لا يخلو من أخطار، ومن المؤكد أنه سيصطدم كل مرة بالأشخاص والمؤسسات التي تدير المشهد الثقافي والاجتماعي في الدولة، والحقيقة أن «مجلة نزوى» نجحت إلى حد كبير في تحقيق تلك المعادلة وهذه التوليفة الصعبة، ومن المؤكد أن شخصية سيف الرحبي وعلاقاته الداخلية والخارجية بالمشهد الثقافي العربي ورموزه ساعدا كثيرًا على أن تحقق معادلة النجاح بامتياز.
تجربة «نزوى» -أخيرًا- تجربة ملهمة، يمكن أن يتمثلها كثير من الأدباء والمبدعين والمثقفين العرب في دول مختلفة، وبخاصة أن المجال أصبح أوسع كثيرًا من عام 1994م وما بعده، فقد غزت مواقع التواصل الاجتماعي الواقع العربي والعالمي، وأصبح في إمكان أي أحد أن يصل لجمهور واسع بإنتاج ثقافي يعرف إلى أي الناس يتوجه، وإلى أي غاية، حتى لو غابت -أو خافت- المؤسسات الداعمة، فالوسائط الجديدة حلَّت كثيرًا من المشكلات المعقدة.
شاعر مصري رئيس تحرير «ميريت» الثقافية








 قصيدةٌ تَعكِفُ على ذاِتها
قصيدةٌ تَعكِفُ على ذاِتها منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
 تلك التشخيصات النظرية هي نتيجة قراءة عينات من قصائد كتبت في مراحل مختلفة من تجربة سيف الرحبي. وهي تؤكد في التحليل الحس البصري في القصائد. سأذكّر هنا بالمهيمنة التشكيلية أو المشهدية البصرية في نصوصه، وأنه يبث رسائله البصرية بطرق شتى، تعقبتُ بعضها وحصرته في كيفيات تؤشر لهذا الحس الذي أزعم وجوده مشغِّلًا مهمًّا في الكتابة الشعرية لديه، وفي فعل القراءة بالضرورة.
تلك التشخيصات النظرية هي نتيجة قراءة عينات من قصائد كتبت في مراحل مختلفة من تجربة سيف الرحبي. وهي تؤكد في التحليل الحس البصري في القصائد. سأذكّر هنا بالمهيمنة التشكيلية أو المشهدية البصرية في نصوصه، وأنه يبث رسائله البصرية بطرق شتى، تعقبتُ بعضها وحصرته في كيفيات تؤشر لهذا الحس الذي أزعم وجوده مشغِّلًا مهمًّا في الكتابة الشعرية لديه، وفي فعل القراءة بالضرورة.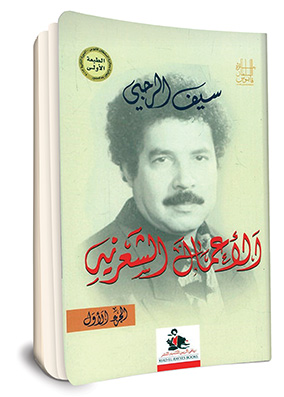 ثم يأتي التشكيل البحري لمطرح أو لمسقط بشكل عام، لتحضر الطبيعة الجغرافية المالحة والممتدة، لتحفز بؤرها الخلجانية، وجمالها البحري في ذاته، وترسم تشكلها المتدفق في جوانيته «طفلة تركض حافية على الشاطئ/ تصطدم بالسواري/ بالألواح/واللافتات/ تريد أن تقول شيئًا …»
ثم يأتي التشكيل البحري لمطرح أو لمسقط بشكل عام، لتحضر الطبيعة الجغرافية المالحة والممتدة، لتحفز بؤرها الخلجانية، وجمالها البحري في ذاته، وترسم تشكلها المتدفق في جوانيته «طفلة تركض حافية على الشاطئ/ تصطدم بالسواري/ بالألواح/واللافتات/ تريد أن تقول شيئًا …» وبذلك «يخرج النص الرحبي من ذاكرة الوقت والمكان وسيرتهما، ليدخل ذاكرة اللغة التي تعيد تشكيل صورة المكان بدلالاتها الفنية المفتوحة على تاريخ الإنسان والمكان، في اتحادهما دلالة ومعنى، بصورة تكشف عن توتر لحظة الراهن ودراميتها ومأساويتها الفاجعة أيضًا». والحاضر الذي يعبّر عن فجيعة الراهن، وتوقه المحاصر بالهلاك والحنين وفوضى الأشياء وضياعها.
وبذلك «يخرج النص الرحبي من ذاكرة الوقت والمكان وسيرتهما، ليدخل ذاكرة اللغة التي تعيد تشكيل صورة المكان بدلالاتها الفنية المفتوحة على تاريخ الإنسان والمكان، في اتحادهما دلالة ومعنى، بصورة تكشف عن توتر لحظة الراهن ودراميتها ومأساويتها الفاجعة أيضًا». والحاضر الذي يعبّر عن فجيعة الراهن، وتوقه المحاصر بالهلاك والحنين وفوضى الأشياء وضياعها. عاشق التاريخ والأساطير وسير الأماكن
عاشق التاريخ والأساطير وسير الأماكن يصافح القارئ بالشعر
يصافح القارئ بالشعر مفازة الرحبي والكوني
مفازة الرحبي والكوني منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.
منذ نهاية عام 1994م، أي منذ 26 عامًا، تصدر «مجلة نزوى» الفصلية بانتظام، عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والتي يرأس تحريرها الشاعر العماني الكبير سيف الرحبي. وضعت «نزوى» نفسها منذ ذلك التاريخ، في صدارة المشهد الثقافي العربي، لكونها مجلة أدبية ثقافية ثقيلة، تحرص على انتقاء مادتها بعناية، ووضعت اسم سلطنة عمان وحركتها الثقافية والأدبية في قلب المشهد، فالمجلات الثقافية ـ في النهاية ـ تعكس صورة المجتمع الذي تصدر عنه، وتسعى لتأكيد وجود مثقفي وأدباء الوطن في مكانهم بين أقرانهم، كما أنها – في الأخير – كرَّست لاسم رئيس تحريرها كواحد من أهم شعراء موجة السبعينيات في الوطن العربي.


0 تعليق