تطرح المستويات المذهلة التي وصل إليها العلم اليوم أسئلة حول المبادئ الأخلاقية التي ينطلق منها، والغايات العملية التي يصبو إليها. سواء أتعلَّق الأمر بالطب أم بالعلم التقنيّ، فإن زخم الاكتشاف والاختراع لا يترك الوعي المعاصر بلا مبالاة. بل إن التقدُّم الذي وصلت إليه بعض الحقول العلمية تجعل السؤال الأخلاقي في صُلب بنيانها المعرفي. سأبيِّن لاحقًا طبيعة هذا السؤال في مجالين هما الذكاء الاصطناعي والطب. قبل ذلك سأعرج على مسألة مهمَّة تخصُّ هذه المرة السؤال الفلسفي للعلم.
هل فعلًا ليس العلم بحاجة إلى الفلسفة؟ هل ينحصر نطاقه في الخبرة والكفاءة والمنفعة ولا تهمُّه الأسئلة الوجودية الكبرى التي تشغل بال الإنسان المعاصر؟ أخيرًا، هل فعلًا أن السعادة التي يبتغيها الإنسان المعاصر ليست من اختصاص العلم في شيء وأن الدرس الفلسفي على عاتقه العناية بهذا الشق الأساس من الانشغال الراهن؟
* * *
يقول فرانسوا رابليه، وهو كاتب فرنسي من عصر النهضة، «العلم بلا وعي هو خراب النفس»، إذا قصدنا بالوعي «الوعي الأخلاقي» على وجه التحديد. ستجد عبارة رابليه المدوِّية استجابة في عصر الأنوار من لدن كاتب آخر جمع بين السؤال الفلسفي والأسلوب الأدبي والشاعري وهو جان جاك روسو، الذي أبدى امتعاضًا من التطوُّر الكاسح للعلم في زمانه دون كوابح. يتجلَّى ذلك في مقالة «خطاب حول العلوم والفنون» التي دوَّنها من أجل مسابقة أكاديمية ديجون بفرنسا سنة 1750م، وظفر بها على جائزة الأكاديمية في جوابه عن سؤال: «هل أسهم إرساء العلوم والفنون في تطهير الأخلاق؟». جاء جواب روسو بالنفي، وبيَّن فيه العلاقة العكسية بين تطوُّر العلوم والفنون وفساد الأخلاق بتراجع الفضائل التي تربَّى عليها الوعي الأوربي منذ الدرس الأخلاقي الإغريقي العريق. فيما كان عصر الأنوار متفائلًا بالتطوُّر الحازم للبشرية نحو ما يُغذِّي طموحاتها ويجلب لها السعادة، أبدى روسو موقفًا متشائمًا أمام انهيار الفضائل بمقدار صعود العلم.
كان تشاؤم روسو «فراسة» نافذة إذا أخذناها معيارًا لما حصل في عصر العلم الوضعي (القرن التاسع عشر) وعصر العلم التقني (القرن العشرين) بالتراكم المتنامي للقوة، وظهر ذلك جليًّا بتسخير العلم من أجل التسلُّح الصاعد انتهى بحربين عالميتين مدمِّرتين. لا نفهم من تشاؤم روسو أنه كان ضدَّ العلم في ذاته كوسيلة لتحسين المعيش والإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والصحية للبشر، بل إن مخاوفه المشروعة كانت تخصُّ «استعمالات» العلم، التي كانت في الجانب السياسي والعسكري منها مدمِّرة (مثلًا، استعمال القنبلة الذرية في هيروشيما وناغازاكي). هنا بالضبط يُطرح السؤال الأخلاقي حول استعمالات المعرفة العلمية، ليس فحسب لدواعٍ صراعية مثل الحروب والنزاعات، بل كذلك لأغراضٍ مستقبلية مثل الاستنساخ وموقع الذكاء الاصطناعي في حواضر الغد.
في حقيقة الأمر لا يُطرح العلم من وجهة نظر الخير أو الشر، بل إن استعمالاته هي التي تطرح السؤال الأخلاقي حول الفاصل بين «ما يجب فعله» و«ما ينبغي تفاديه». ما يطرحه العلم، قبل كل شيء، هو مسألة الفعَّالية والمنفعة، إذا كان ما يُقدِّمه للبشر يغدو في مصلحتهم؛ ولقد أثبت التاريخ الحديث والمعاصر المصلحة التي يسديها العلم للبشر في ميادين متنوِّعة مثل: الطب والتقنية والمواصلات، وما العلم في هذه الحالة سوى اشتغال البشر على ذواتهم بوساطة المعرفة المخزَّنة في بنوك المعلومات والمستثمرة في صفقات التبادل والتداول. إذا جاز لنا الرجوع إلى مخطط قديم له ترجمات معاصرة مماثلة، نقول على منوال الفلاسفة الرواقيين: إن المعرفة هي منطق وفيزياء وأخلاق.
* * *
يقوم المنطق على توافق الفكر مع ذاته، وتفادي التناقض والتهافت. فهو من قبيل «الصحيح أو الخاطئ»؛ والفيزياء التي ينخرط فيها العلم، هي معرفة تسعى إلى الفعَّالية بالاعتماد على الخبرة التقنية والكفاءة الشخصية. غايتها جودة الأداء التي ستصل في الذكاء الاصطناعي إلى مستوياتها العُليا. الفيزياء هنا هي من قبيل «الفعَّال أو المعطَّل» (خبرات، آلات، أجهزة). أخيرًا، الأخلاق هي الفعل القائم على تفادي الألم والظن والحكم القيمي؛ فهي ليست حقيقية ولا زائفة، بل هي من قبيل «النافع أو الضارّ». مثلما أن هدف العلم هو «الفعَّالية»، فإن مسعى الأخلاق هو الامتياز والفضيلة. إذا قرأنا روسو في ضوء هذا التقسيم المبدئي للمعرفة، نجد أن العلم تَفَانَى في فعَّاليته إلى غاية الكمالية أو الهوس بالكمال، ويزدادُ إسرافًا في بلوغ منتهى الجودة والرُّقيّ التقنيّ.
ينجرُّ عن ذلك أن التَّناهي البشري لا يقوى على هذه الغاية الكمالية، وفوَّض بلوغها إلى البرمجة التقنية والذكاء الاصطناعي، وأن الهوس المتنامي في بلوغ الكمال على جميع الصُّعُد الصحية (التجميل واستئصال الشحم)، والرياضية (كمال الأجسام وتناول المنشِّطات)، والتكنولوجية (الهواتف الذكية)، هو مدخل مبتذل نحو الاصطفاء الدارويني كما لجأت إليه بعض الأنظمة الشمولية مثل النازية باستعمال العلم البيولوجي لغايات اصطفاء النسل. فالمرامي ليست كمالية فحسب، بل مالت نحو العنصرية بإقصاء الإرث الجيني الذي لا يُبدي استعدادات طبيعية نحو الجودة والكمال. أمام هذه الاستعمالات المفرطة، كانت هنالك الحاجة إلى «أخْلَقَة» المعرفة العلمية بالنظر في النتائج العملية للعلم إذا كانت بالفعل في مصلحة البشرية وليس ضدَّها.
من هذا المقام، أصدر إدغار موران كتابًا بديعًا تجاوب فيه مع نداء رابليه، عنوانه «العلم بالوعي» (منشورات فايار، 1982م)، يشرح فيه طبيعة العلم وتاريخ نموِّه وتعثُّره، وكذلك الوعي بالرهانات الحضارية والأخلاقية للمهام العلمية. يُعدُّ هذا الكتاب من أحسن ما نُشر حول «أخْلَقَة» العلم، ليس بالمعنى الساذج في فرض قواعد أخلاقية، وإنما النظر في الطريقة التي يتفادى بها العلم ما يضرُّ بمصلحة البشرية؛ بأن ينفتح على معارف أخرى على سبيل التخاصص والتلاقح بين الأفكار، ومنها المعارف الإنسانية والعلوم الاجتماعية والدراسات الفلسفية. من شأن هذا الانفتاح أن يضع العلم أمام ذاته فيما بات يُعرف بالانعكاسية، أي أن يُفكِّر العلم فيما لا يُفكِّر فيه عادةً وهي الشروط الذاتية والموضوعية لعملية تبلوره وانتظامه في خطابٍ معقول؛ ثم أمام مسؤولياته تجاه النوع البشري والحيواني والبيئة والصحة.
* * *
كان الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر قد عاب على العلم انتفاء التفكير في ذاته، فكان أن أورد في كتابه «ما هذا الذي يُدعى فكرًا؟» (1951م) عبارة «العلم لا يُفكِّر». لا يمكن للعلم أن يكون موضوع ذاته، ولا يمكنه أن يُفكِّر فيما هو يقوم أساسًا على الحساب الآلي والبرمجة التقنية. هكذا اعتنت المعارف الأخرى بدراسة تاريخ العلم وفلسفته وأشكال نموِّه وتطوُّره بين جدل الاتصال والانفصال أو التراكم والقطائع الإبستمولوجية. وأبرز معرفة في دراسة العلم موضوعًا للبحث هي العلوم الاجتماعية. غير أنه لا يكفي عالم اجتماع أو فيلسوف في دراسة العلم، بل على عاتق العالم نفسه أن يشتغل على حقله العلمي فيما هو يشتغل على موضوعاته في المخبر وباستعانة أجهزة في الحساب وآلات في القياس. غير أن العالم ينأى بنفسه عن دراسة حقله دراسة نقدية؛ لأنه يظنُّ أن هذا ليس من مهمَّته، ما دامت مهمَّته هي دراسة المادة أو الكون واستخلاص قوانين ثابتة بالملاحظة والتجريب.
إلا أن هذا الادِّعاء يجرُّه نحو نوعٍ من «الدُّوغمائية» العلمية التي تزعم أن مرجعياتها الواقعية (المادة، الكون، الطبيعة) هي كفيلة بأن تضمن لها المتانة العلمية والحصانة الموضوعية. لكن الدراسات النقدية للمعرفة العلمية من بول فايراباند إلى كارل بوبر مرورًا بتوماس كون وبرونو لاتور أثبتت كيف أن المعرفة العلمية لا تعقد علاقة امتيازية بالحقيقة، وليس لها الصدارة والعلياء والكبرياء. بل إن المعرفة العلمية تتحدَّدُ أساسًا بما ليس هو علم، أي بمجموع التشكُّلات الثقافية والممارسات الخطابية وغير الخطابية. إذا صوَّرنا المعرفة العلمية في صورة جبل جليدي، نقول: إن الظاهر منها هو ما يُقدِّمه العلم من فرضيات ونظريات، أي المنتوج النهائي المعلَّب في قوانين علمية، أما الباطن أو المغمور في البحر فهو الجزء الأكبر ويتلخَّص في تاريخية العلم وسيرورته من تشكُّلات ثقافية وخطابات وممارسات ونقاشات وسجالات في مخابر البحث حول المناهج المراد تطبيقها، والبرامج الواجب سلوكها والميزانيات المعتمدة،… إلخ.
هكذا ينادي إدغار موران بأن يعي العلم حدوده الضمنية وكذلك الطابع المعقَّد أو المركَّب لبنيانه المعرفي ككل. يساعده الخطاب الفلسفي على مباشرة هذا الوعي بالتعقيد أو التركيب، ليس فحسب في طبيعة الأشياء التي هي موضوعات بحوثه، بل كذلك في طبيعته بالذات، أي في نمط رؤيته للعالم ومعالجته لموضوعات البحث. من شأن هذه المبادرة أن تُقحم الثقافة والروح النقدية في المعرفة العلمية كما نادى بذلك الفيلسوف الألماني إدموند هوسيرل في عزِّ ما سمَّاه «أزمة العلوم الأوربية» وتفادي أن ينغلق العلم في مسلَّماته أو أن يرتقي بها إلى القداسة. إذا كان العلم قد تأسَّس على الفاصل بين الذات والموضوع، ومن ثمَّة استحالة العملية الانعكاسية بأن يُباشر العلمُ فحصًا لذاته وليس فحسب لموضوعاته، فإن من الصعب عليه أن يباشر مثل هذا النوع من العملية الانعكاسية. نقول: «صعب عليه» وليس مستحيلًا.
* * *

على العلم أن يتغلَّب على صعوبة الاشتغال على ذاته بالمقدار نفسه الذي يشتغل فيه على موضوعاته. يساعده الفكر الفلسفي على تذليل هذه الصعوبات. لا يتعلَّق الأمر بإغراق العلم في الذاتية (أو حتى «الذاتوية») كما قد يُفهَم من ذلك، ولكن فقط أن يعي العلم حدوده الخاصة وأن يُباشر العالِـمُ التفكير «فلسفيًّا» في موضوعات علمية تخص الكون والطبيعة والمادة والحياة والإنسان. لقد خلَّد بعض العلماء عملًا فلسفيًّا بسيطًا، فكتب أينشتاين «كيف أرى العالم؟» (1934م)، يطرح فيه رؤيته الفلسفية لموضوعاته العلمية الخاصة بالنظرية النسبية وأصل الكون، مثلما فعل كذلك نيلز بور. إذا أتينا الآن إلى الجانب التطبيقي للعلم وتمفصله بالتقنية، ونخصُّ بالذكر الذكاء الاصطناعي، هل أسهم هذا التطوُّر في جلب السعادة للإنسانية؟ بصيغة أخرى: ألا يعمل الذكاء الاصطناعي على تطوير الحياة الإنسانية نحو الأمثل؟
يُقدِّم فِلْم «آي، روبوت» («أنا، الإنسان الآليّ») الصادر سنة 2004م، مع الممثل الأميركي الشهير ويل سميث، رؤية حول الذكاء الاصطناعي يكتنفها الإعجاب والاحتراس أو الانبهار بما يمكن لهذا الذكاء أن يُقدِّمه من خدمات وتسهيلات في حياة البشر، وفي الوقت نفسه المخاطر التي تنجرُّ عن إسناد كل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للإنسان الآلي. يطرح الفِلْم أسئلة فلسفية وميتافيزيقية حول الرُّوح التي تسكن الآلة والشعور والاستشعار والتماثل بين البرمجة التقنية والدماغ البشري، أي أنه يطرح المسألة من زاوية أن يكتسب الإنسان الآلي في يومٍ من الأيام المشاعر البشرية نفسها من فرح وحزن وغضب وحب. غير أن المخاطر الواقعية الناتجة عن التطوُّر المذهل للذكاء الاصطناعي تكمن أساسًا في الخمول البشري بإسناد الوظائف الدقيقة للآلة، إضافة إلى ندرة العمل المأجور التي تُسبِّب بطالة واسعة باستيلاء الآلات على كل
الوظائف والأعمال.
النتائج الاجتماعية لتفاقم البطالة والكسل هي رهيبة. لقد بدأت بوادر الاستيلاء الآلي على الوظائف والأعمال بداية في البنوك والمتاجر ومستقبلًا في المواصلات بتكفُّل الآلات بسياقة الحافلات والمترو أو حتى الطائرات. من شأن التعميم الكاسح للآلات والأجهزة في المؤسسات البنكية والتجارية وغيرها أن يضمن للمؤسسات المالية وللمساهمين الربح السريع والوفير بأقل تكلفة، وفي ذلك انحسار لقيمة العمل بالنسبة للإنسان، والتمييز في فرص العمل بانتقاء الأجْوَد والأقْدَر، وانتشار الجشع والطمع في الربح الدائم. نلمس هنا كذلك الاستعمال الدميم لنتائج العلم وتحويل الحياة الإنسانية إلى برمجة آلية تنتظم بموجبها الحياة اليومية عمومًا، لكنها لا تحل المشكلات الوجودية والنفسية المتجذِّرة في مخاوف الإنسان المعاصر. هل فِعلًا يمكن للبرمجة الآلية أن تفكُّ تعقيدات الحياة البشرية وما يمسُّها من مخاطر اجتماعية وصحيَّة- نفسانية كالمخدِّرات والعنف والانتحار؟
* * *
في الأخير، وعروجًا على المسألة الصحيَّة، تُقدِّم البيوطيقا أو أخلاقيات الطب الحيوي بعض جوانب التطبيق العملي للتقنية العلمية على المشكلات الصحية والوراثية والنتائج الأخلاقية المترتِّبة عن ذلك. فهي معرفة متعدِّدة الاختصاصات تنسج حول الفاعلين العلميين شبكة من العلاقات والمبادلات على مستوى المعارف والخبرات، وتطرح أمامهم المسؤوليات والواجبات تجاه القرارات الكبرى الخاصة بمصير الأفراد والمجتمعات (الموت الرحيم مثلًا: تحديد النَّسل، الإجهاض،… إلخ). هنا بالضبط يتحدَّد المفهوم الأقوى للشخص بالمعنى الذي طرحته الفلسفة الشخصانية في حقبة من تاريخها الفكري المعاصر. أيُّ حقٍّ يُضمَن للشخص تجاه حياته؟ بأيِّ معنى يحتاج الشخص إلى رعايةٍ تضمنها له قوانين وتعهُّدات؟ هل يدخل الموت الرَّحيم مثلًا في احترام حق الموت بعد استنفاد كل الطرق العلاجية ولتفادي الرعاية العقيمة والإسراف في الأدوية؟ طُرحت هذه المشكلة مثلًا في الحالات القصوى مثل الشلل الرباعي أو الحالة الإنباتية المستديمة.
ينبري هنا البُعد المعياري لهذه الأخلاقيات الحيوية والمسؤوليات الملقاة على عاتق المتخصصين، بما في ذلك المجالس الأخلاقية لكل دولة في مناقشة الحالات الفردية التي تمسُّ من قريب أو من بعيد طبيعة المجتمع ونوع المشكلات التي تُطرح عليه. إذا كانت هذه المبادئ الأخلاقية مثل البيوطيقا تطرح بالفعل مشكلات صحية في ضوء التخاصص والمشاورة، وتسعى لمناقشتها وحلِّها بما يضمن جميع الحقوق المخوَّلة، إلا أن بعض الاستعمالات تبقى رهن التأثيم، مثل الاستنساخ الذي قد يطول النوع البشري؛ والإجهاض الذي يُسبِّب كل سنة احتجاجات عارمة في الغرب، خصوصًا من لدن الجماعات المسيحية المتطرِّفة التي تَعَضُّ بالنواجذ على التعاليم الدينية. على الرغم من أن رجال الدين لهم كذلك رأي في الأخلاقيات الحيوية، فإن هذا يصطدم في الغالب مع القرارات العلمانية التي تضمن حق الإجهاض مثلًا، إما لدوافع موضوعية مثل الاغتصاب، وإما لدواعٍ ذاتية وهي عدم الرغبة في الإنجاب.
في ختام هذا البحث، نلمس اليوم العودة السعيدة للسؤالين الفلسفيّ والأخلاقيّ في الزخم العلميّ والتقنيّ الذي ألقى بظلاله على البشرية. الدَّرس الممكن استخلاصه من ذلك هو أن العلم اليوم على محك «السؤال» الذي، عندما يُصرف إلى صيغة المفعول، يصبح «المسؤول»، ومن ثمة يطرح مطلب «المسؤولية». أيَّة مسؤولية تُلقى اليوم على عاتق العلم لتفادي التجارب المؤلمة في الماضي مثل استعمالات العلم لغايات صراعية (الحروب) أو جينية (العنصرية)؟ وحده السؤال الفلسفي من جهة؛ أي سؤال الدوافع النقدية والهواجس الوجودية، والسؤال الأخلاقي من جهة أخرى؛ أي سؤال القيم والمعايير، يمكنهما أن يضعا العلم أمام المسؤوليات التاريخية في توجيه مسار الإنسانية. السؤال (الفلسفي- الأخلاقي) هو في مقام «التقويم» لما اعوجَّ في العلم في حقبة تاريخية من عُمر البشرية، وهو مدعوٌّ لأن يواصل مهمَّة التساؤل والمساءلة من أجل مسؤولية مشتركة.

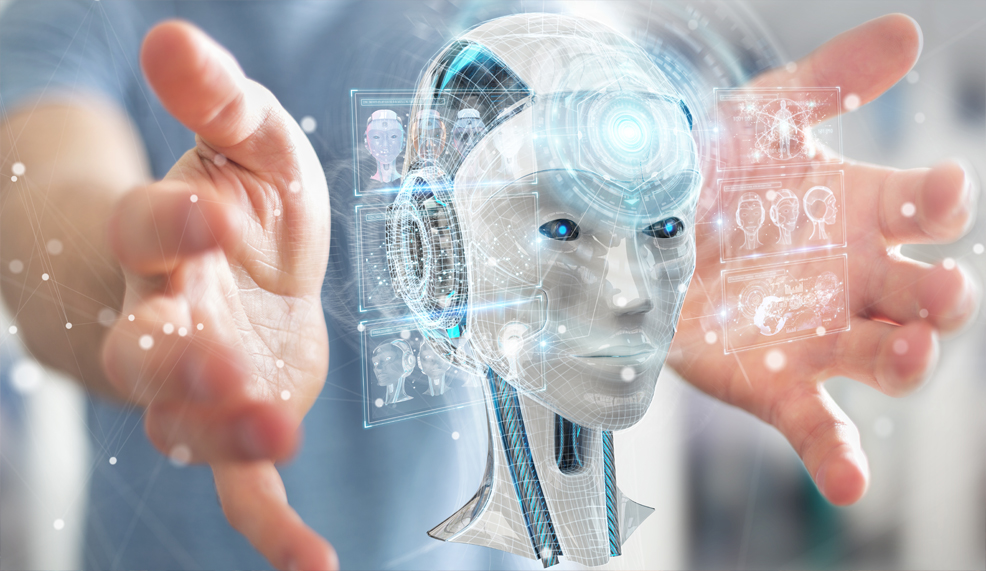









0 تعليق