منذ القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشر، أي منذ سقوط الدولة الرومانية الغربية حتى إرهاصات عصر النهضة الأوربية، عاشت القارة الأوربية ظلامًا معرفيًّا وفكريًّا دامسًا لمدة ألف عام من الزمان، ولذلك أطلق على هذه الحقبة من التاريخ الأوربي «العصور المظلمة».
خلال هذه الحقبة، تجمدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، في طول أوربا وعرضها، فسادَ الإقطاع في الأرض، وحكم الأباطرة المقدس، وهيمنة الكنيسة ورجال الدين من الإكليروس، وتحكم الخرافة في العقول، وفوق ذلك كله، وهو موضوعنا هنا، جمود وتبلُّد العقل القروسطي على مقولات ثابتة تدور في فلك الدين ولا شيء غيره، وتعتمد على منهج ينتج حقيقته وفق آليات فكرية لا تتعداها، هي آليات «القياس والاستنباط» لنصوص ثابتة من الكتاب المقدس لا تتعداها، ثم من نصوص منتقاة من فلسفة أرسطو، للتوفيق بينها وبين نصوص الكتاب المقدس، أو محاولة التوفيق بين الوحي والعقل، وفق تصورهم، وهو الأمر الذي بلغ مداه مع الفيلسوف توما الأكويني، الذي كان متأثرًا كثيرًا بكتابات القاضي ابن رشد (أفيروس) في الأندلس.
هذا النهج الذي يعتمد القياس والاستنباط، كطريق وحيد «للحقيقة»، يسمى «المدرسية» أو «السكولاتية» و«أهم الصفات التي يتميز بها هذا التعليم ارتباطه بعلم اللاهوت، وتوفيقه بين الوحي والعقل، واعتماده في البحث على طرق القياس البرهاني، وعلى تفسير النصوص القديمة، ولا سيما نصوص أرسطو» (المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، 1982م، ص 369).
بمعنى أن هذه المدرسة الفكرية لا تستقي معلوماتها من الواقع المتغير كمرجعية، بل يكون النص الثابت، والمقدس في أكثر الأحيان، هو المرجعية الوحيدة لكل أنواع المعارف، فيشرع ويقسم ويُؤَوّل ويفسر استنباطًا وقياسًا وتفريعًا وفق منطق معين، حتى لو كانت «الحقائق» المستنبطة تتعارض مع أبسط وقائع الحياة، بل أحيانًا مع البديهيات الملموسة والمَعِيشة، فلا يناقش «الثالوث المقدس» مثلًا، بوصفه منافيًا للعقل وطبيعة الحياة وقوانينها الطبيعية، بل كأصل ثابت، ومرجعية معينة، وما على الباحث إلا محاولة إثبات هذا الأصل وفق آلية استنباطية معينة، أو «قياس فرع على أصل»، وهو الثالوث المقدس في مثالنا، للوصول إلى «حقيقة» معينة.

طه حسين
مثل هذا «الباراديم»، أو النموذج الإبستمولوجي (المعرفي) الذي يؤطر لطرق الوصول إلى الحقيقة، أبقى أوربا والفكر الأوربي أسيرًا في شرنقة من التخلف الفكري، ضمن دائرة مفرغة لا نهاية لها من الإعادة وإعادة الإعادة، حتى بزوغ عصر النهضة، وحقبة التنوير، التي أعادت العقل النقدي إلى الثقافة الأوربية، وحررته من الشرنقة الفكرية المدرسية، وسمحت لفراشة المعرفة أن تحلق من جديد.
مع ديكارت كانت البداية للعقل الأوربي الحديث، وبطبيعة الحال لا نعني أسماء مثل سبينوزا وكانت وفولتير وديدرو وبقية فلاسفة الموسوعة، ولكن ديكارت له قَصَبُ السَّبْقِ والريادة في هذه المجال، حيث إنه بدأ من الصفر حين ألغى كل فكر سابق، وفق «الكوجيتو» المنسوب إليه. يقول رينيه ديكارت: «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، جملة في غاية البساطة، ولكنها زلزلت كيانًا فكريًّا بقي مهيمنًا، ولا كيان غيره،
لمئات السنين.

زكي نجيب محمود
منهجية الشك هذه ألغت كل ما هو متعارف عليه من معرفة سابقة غير يقينية تمام اليقين، أو «قطيعة معرفية»، كما حددها «غاستون باشلار»، ولا يبقى شيء يقيني إلا «الأنا»، فطالما أنا أشك، فلا بد يقينًا أنني موجود؛ إذ لا يعقل أن يوجد شكٌّ من دون وجود شاكٍّ. جعل ديكارت من هذه «الأنا» الشاكّة، حجر زاوية لفلسفة، زلزلت الكيان الفكري الأوربي لسنوات كثيرة قادمة، وكانت إرهاصًا للأزمنة الحديثة. وبهذه المناسبة، فقد حاول طه حسين أن يطبق المنهجية الديكارتية في كتابه «في الشعر الجاهلي»، ولكن الإكليروس الديني الإسلامي ثار ضدَّه، فاضطر إلى التراجع لاحقًا.
مع ديكارت وصحبه التاريخيين من فلاسفة النهضة والتنوير، ترك العقل الأوربي منهجية القياس والاستنباط المدرسية كمرجعية وحيدة لاستشفاف «الحقيقة»، من خلال نص لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه، وفتحوا كتاب الطبيعة والحياة المَعِيشة بكل تفاصيلها وأفعالها وانفعالاتها، وفي ذلك يقول فيلسوف الوضعية المنطقية،
الدكتور زكي نجيب محمود: «لقد كان العامل الأول في النهضة الأوربية هو تحول الناس من حالة الاكتفاء بما كتب الأقدمون، إلى كتاب الطبيعة المفتوح لكل من أراد منهم أن يقرأ علمًا جديدًا… (تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1978م، ص 54)».
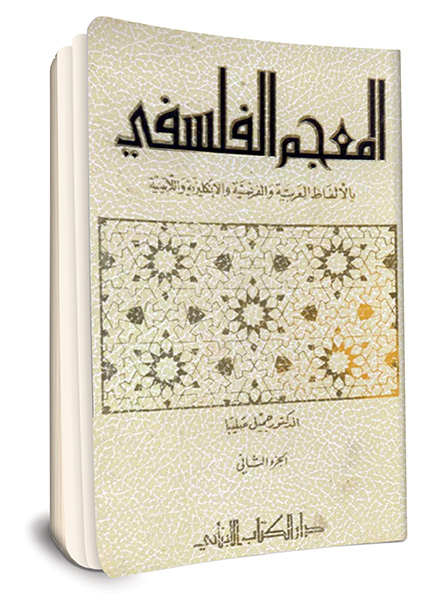 بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.
بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.
حين جعل الإمام محمد بن إدريس الشافعي من القياس مصدرًا من مصادر التشريع، بعد القرآن والسنة والإجماع، في كتابه «الرسالة»، ربما لم يكن يعلم أنه قد حدد الأطر التي لا تتجاوزها الحياة العربية في مختلف المجالات، وليس في مجال «استنباط» الأحكام الشرعية في الفقه فقط، فأصبحت الحياة العربية، ولا أستثني العديد من بلاد المسلمين، مجرد إلحاق فرع بأصل، رغم أن هذا لم يكن هو الوضع قبل الشافعي، بل قبل نشوء المذاهب الفقهية الكبرى، فكلنا يعرف اجتهادات عمر بن الخطاب التي عطل فيها نصوصًا من الكتاب والسنة، وكانت مرجعيته في ذلك المصلحة العامة للجماعة، وليس القياس، وإلحاق فرع بأصل.
بل كلنا يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، المؤكّد أن مرجعية أحكام المعاملات الدنيوية، أو القوانين التي تنظم أمور الحياة البشرية في هذا المجال، هي الحياة ومتغيراتها، وليس نصوصًا ثابتة، قد يكون هنالك سياق خاص بها حياتيًّا، أو ظروف تنزيل معينة، أو قصد بها التخصيص وليس التعميم، أما أمور العبادات والماورئيات، فهذه يحكمها النص الثابت، حين يصح ثباته، ولكن آفة الفكر الفقهاء وقياساتهم التي ألغت مرجعية وآلية كل واقع، وأبقت آلية القياس والاستنباط كي لا يكون في الساحة غيرهم، عدا نفر قليل منهم، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان، صاحب مدرسة الرأي في تاريخنا الفقهي، رغم أن تلامذته حوّلوا فقهه إلى نصوص يقاس عليها،
ونسوا المرجع الأول الذي استند إليه أبو حنيفة، ألا وهو الواقع المتغير.
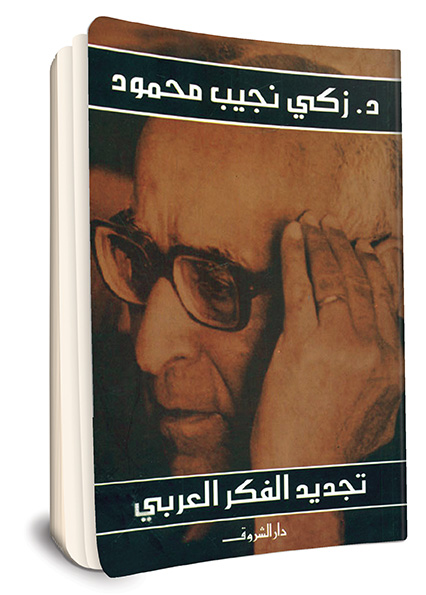 اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.
اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.
بل حتى في الاكتشافات العلمية، يأتي أصحاب «مدرسة» الإعجاز العلمي في القرآن، ليقولوا لنا: إنها ليست اكتشافات، فهي مذكورة في القرآن، من كروية الأرض حتى غزو الفضاء، استنادًا إلى نص هنا أو نص هناك، يفسر ويُؤَوَّل حسب الحاجة وحسب الغرض، المهم هو وجود نص يشرعن للاكتشاف.
حقيقة الأمر في النهاية، نحن اليوم بحاجة إلى ديكارت عربي، وكوجيتو عربي، وقطيعة كاملة مع تراكمات المعرفة القياسية، والفكر الاستنباطي في تراثنا، فهل يكون ذلك؟









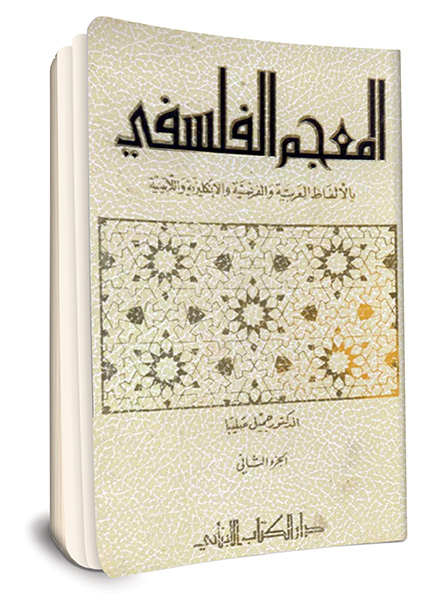 بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.
بالانتقال إلى ثقافتنا العربية والإسلامية، بل بالانتقال إلى مجمل حياتنا، السياسي منها والاجتماعي حتى الاقتصادي، نجد أنها في مجملها قائمة على آلية القياس والاستنباط، والبحث عن الأصل لإلحاق الفرع به لاتحاد العِلّة، وفق تعبير الإمام الشافعي، ووفق مقولة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»، وهذه المقولة في حدّ ذاتها قياس.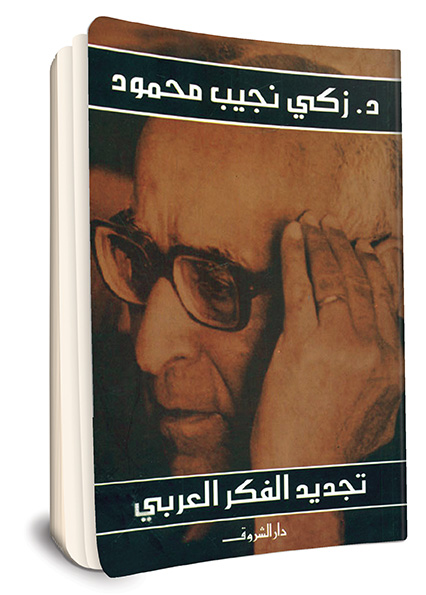 اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.
اليوم انظر حولك في واقعنا العربي، فكرًا واجتماعًا وسياسة، فكل شيء قائم على القياس، سواء كانت المرجعية نصًّا مكتوبًا أو حادثة تاريخية معينة جعلت نموذجًا يقاس عليه. في تجاهل نسبي للمتغيرات الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، ولكنها سلطة القياس في العقل العربي.


يعود بنا هذا الأشكال إلى أفلاطون الذي ميز بين الفكرة أو المثال و النسخة و نسخة النسخة. . هذا التمييز الذي يتغذى على معيار التشابه… وهي روح الديانات السماوية. . فكرة النموذج تقود إلى التراتبية. . حتى مع ديكارت نجده مسكون بهذه الفكرة. . على عكس اسبينوزا ومن قبله الرواقين… هذا الفكر القياسي. . هو فكر في اتجاه واحد. . ليس هناك إبداع. . ويبدو أن الحضارة الإسلامية يوم بلغت مدى هذا الاتجاه لم تستطع أن تبدع .. لأنها ترى كل محاولة للبدء في أي اتجاه جديد..هو انتكاسة لقيم تقوم على فكرة النموذج.
لقد حاول دولوز قلب الافلاطونينة و إعادة تسليط الضوء على الهوامش التي نبذات وفق معيار التشابه و القياس. . و كتب في الإختلاف و التكرار.