أصبحت الديمقراطية «أيقونة» العصر السياسية، وبخاصة في منطقتنا العربية، فلا تجد كاتبًا أو مثقفًا أو سياسيًّا، حتى لو كان في غاية الاستبداد في سلوكه، إلا ويتغنى بها، تغني قيس بليلى، وكأنها تحولت إلى عصا ساحر قادرة على فعل الأعاجيب، قادرة على انتشال جذري للأنظمة السياسية والمجتمعات، من قاع التخلف إلى قمة الرقي والازدهار والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
والديمقراطية المتحدث عنها هنا هي الديمقراطية الليبرالية تحديدًا، فالديمقراطية بشكلها الصافي، وفي المجال السياسي، هي كما وصفها الرئيس الأميركي إبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة (1809 ــ 1865م)، بأنها: «حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب»، بمعنى أنها حق الشعب في تقرير مصيره واختيار من يمثله ويعبر عنه في السلطة السياسية.
ولكن الديمقراطية بهذا المعنى لم تعد كافية، فمزجت، وفق تدرج تاريخي معين، بالليبرالية وقيمها، من تسامح وحرية فردية مطلقة، لا يقيدها إلا القانون، فلا تكتمل الديمقراطية والحالة هذه إلا بالقيم الليبرالية، ولم تعد مجرد آلية سياسية، بل تحولت إلى نظام سياسي اجتماعي، ولم تعد قاصرة على مجرد صندوق اقتراع وانتخابات، بل أصبحت مرتبطة بحقوق وحريات نابعة من القيم الليبرالية، التي تخلو منها «الديمقراطيات» العربية، ولذلك كانت انتكاساتها، ولكن ذلك حديث آخر.
أما الثقافة السياسية، التي هي فرع أو جزء من الثقافة العامة للمجتمع، فهي ببساطة مجموعة القيم والرموز التي يتصور بها هذا المجتمع وأفراده علاقته بالسلطة السياسية، والعملية السياسية بوجه عام، وكيف هي طبيعة هذه السلطة وعلاقته بها.
بمعنى، أن طبيعة السلطة السياسية وبنيتها في أي مجتمع، تتحدد بشكل كبير، بطبيعة الثقافة السياسية السائدة في ذلك المجتمع، أي المفاهيم والقيم والرموز التي يدرك من خلالها العقل الجمعي طبيعة النظام السياسي المهيمن على المجتمع، وعلاقته بأفراده وجماعاته. بمعنى أن استمرارية أي نظام سياسي، مرهونة بطبيعة الثقافة السياسية في ذلك المجتمع، والعلاقة بين النظام السياسي، والثقافة السياسية، علاقة جدلية، بمعنى أن كلًّا منهما يؤثر في الآخر: فالسلطة السياسية تسعى لترسيخ تلك الثقافة السياسية، أو لنقل الثقافة ككل، التي تدعم وجودها في الإدراك العقلي قبل السلوك الفعلي، كما أن الثقافة السياسية تدعم السلطة السياسية التي تتوافق مع تصورها لما يجب أن تكون عليه السلطة وكيف تعمل.
وبالعودة إلى حديث الديمقراطية، هناك سؤال يفرض نفسه في الحالة العربية: هل تنسجم الثقافة السياسية العربية مع قيم ومبادئ الديمقراطية الليبرالية؟ يقول غابرييل ألموند وسيدني فيربا، في كتابهما المشترك «الثقافة المدنية»: إن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح وتستمر في بلد ما من دون حد معين من الثقافة المدنية، التي من أبرز قيمها قيمة «التسامح»، والشعور الوجداني بالمشاركة السياسية والمجتمعية، والحرية السياسية، وحكم القانون، أي القيم الليبرالية بإيجاز العبارة، حين تصبح جزءًا من الثقافة العامة للمجتمع، فهل تُوجَد مثل هذه الثقافة وقيمها ومفاهيمها في الحالة العربية عمومًا؟
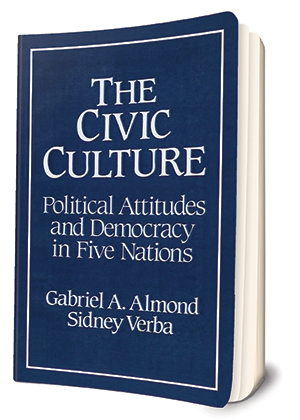 يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.
يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.
وربما كان بيت أحمد شوقي، الذي تغنت به أم كلثوم: «وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا» خير تعبير جزئي عن أحد مفاهيم الثقافة السياسية العربية، بل الثقافة العربية عامة، من أن الغلبة للأقوى، «فإن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب»، ولا وجود لمفهوم «المشاركة»، في حلبة المصارعة تلك، سواء في ذهن الحاكم أو المحكوم، وفي ذلك يقول فؤاد إسحاق الخوري في كتابه «الذهنية العربية: العنف سيد الأحكام» (بيروت: دار الساقي، 1993م): «هي القوة أو الهيمنة أو السيطرة في المجتمع العربي التي تفصل النخبة أو الخاصة عن العامة، والوجهاء والأعيان عن أبناء الشارع. فالألفاظ والكلمات التي نستعملها للدلالة على أصحاب النفوذ والقوة تشير بشكل لا يقبل الجدل إلى عنصر القوة والهيمنة» (ص 91).
لفظة «سياسة» لدى الإغريق تعني المشاركة في شؤون المدينة، وفي ذلك يقول أرسطو إن الإنسان حيوان سياسي (مدني). أما في العربية، فهي مشتقة من ساس، يسوس، فسائس الخيل هو مدربها، وسائس الناس هو آمرها والمتحكم فيها، فليس هناك إلا آمر ومأمور، حاكم ومحكوم، وما يحدد موقع هذا وذاك هو القوة، وهو ما ينطبق عليه قول عمر بن أبي ربيعة: «إنما العاجز من لا يستبد»، رغم أن القصيدة غزلية وتشبّب بهند التي يحبها.
أما المشاركة الشعبية في تحديد طبيعة السلطة السياسية، وهو أمر جوهري بالنسبة للديمقراطية، فهو أمر غير وارد في الثقافة السياسية العربية، سواء كنا نتحدث عن الحاكم أو المحكوم. فمفهوم مثل «الشعب»، وهو مفهوم جاءنا من الغرب الحديث، لا وجود له في القاموس السياسي العربي، بل نجد لوصفه ألفاظًا مثل: الدهماء، الرعية، الغوغاء، العامة، وغير ذلك من ألفاظ فيها ما هو مسكوت عنه من تقليل أهمية هذه الكتلة من الناس، بل في أحيان كثيرة احتقارها.
الديمقراطية قائمة بكليتها على «الشعب» وحكمه، وبواسطته ولأجله، وهذا أمر غير وارد في أدبيات السياسة العربية. والشعب، في الأدبيات السياسية الحديثة، هو مجموع مواطني الدولة، والمواطنة مفهوم قانوني حديث يتحدث عن الفرد، بوصفه محل حقوق وواجبات، وهو الآخر لا محل له من الإعراب في الثقافة السياسية العربية، فهو، أي الفرد، ليس إلا رقم هلامي ضائع في كتلة الدهماء والعامة.
بمعنى، أن «الفردية»، وهي إحدى قيم الليبرالية، و«المواطنة»، وهي إحدى قيم الديمقراطية، غائبتان غيابًا شبه كامل عن الحياة السياسية العربية. حتى عندما جاءت مثل هذه المفاهيم من الغرب الحديث، فإنها ابتسرت واستهلكت من دون أن يكون لها مضمون فعلي في الممارسة الفعلية، وبخاصة في الأنظمة الانقلابية العربية، فيكثر استخدام كلمة شعب ومشاركة سياسية ونحوهما، ولكن في النهاية يُقتَل نصف الشعب باسم الشعب، وتقتصر المشاركة السياسية على نخب عسكرية وغير عسكرية، وأحزاب معينة، ويبقى «الزعيم» الأوحد هو سيد الموقف، ومرجعية كل شيء في السياسة والمجتمع، وبالتالي لا معنى «للتعددية» والاختلاف الذي ما وجدت الديمقراطية إلا للتعبير عنه.
الزعيم، أو المنقذ، هو المفهوم القابع في الذهن السياسي العربي، كطريق للنجاة من الذل والظلم والقهر والفقر، ولذلك كانت سياسة «الانتظار» هي الموقف شبه الوحيد لدى الجماهير (= العامة) حتى يأتي المنقذ، سواء بصفة دينية كالمهدي، أو بصفة سياسية بحتة كالزعيم. قد يقول قائل: إن قضية الزعامة والزعيم، المنقذ والإنقاذ، موجودة حتى في الغرب الحديث، وما حديث النازية والفاشية والستالينية منا ببعيد، وهذا أمر صحيح، ولكنه كان أمرًا تاريخيًّا طارئًا، فرضته ظروف أوربية خاصة، ثم ما لبثت مثل هذه الأنظمة أن تلاشت، ولكن المهم في المسألة، أو لنقل الأهم، أن مثل هذه المفاهيم لم تترسخ في الذهنية السياسية الأوربية وثقافتها السياسية، كما هو الوضع في الحالة العربية، والحالة – الإسلامية إلى حد بعيد.
خلاصة الأمر هو أن مفاهيم الثقافة السياسية العربية، القابعة في ذهن الحاكم والمحكوم معًا، تتناقض تمامًا مع مفاهيم وقيم الديمقراطية والليبرالية، ولا ديمقراطية حقيقية من دون حاضن فكري واجتماعي لها، ألا وهو الثقافة المدنية، كما أسماها غابرييل ألموند.
لذلك فإن محاولة «دمقرطة» المجتمعات والأنظمة السياسية العربية، من دون وجود ثقافة سياسية مناسبة تدعمها، هي محاولة فاشلة، ونظرة واحدة إلى «الديمقراطيات» العربية القائمة، إن كان لنا أن نسميها ديمقراطيات تجاوزًا، تُبيّن هذه الحقيقة. فالديمقراطية في عالم العرب، لا تعدو أن تكون صندوق اقتراع، تتحكم في أصواته القبلية والطائفية والإقليمية، وفوق ذلك كله الحاكم الفرد، أو الزعيم الملهم.
لذلك يمكن القول، أو لا بد من القول كنتيجة: إن دمقرطة المجتمعات كخطوة إصلاحية، يجب أن تبدأ من تغيير المفاهيم في الثقافة السياسية كما حدث في التاريخ الأوربي والمجتمعات الأوربية، قبل أن تبدأ رحلة الحداثة، سواء في الفكر أو السياسة أو الاجتماع.
بإيجاز ما هو موجز أصلًا، نحن في حاجة إلى خطاب عربي جديد في هذا المجال، ينقض ما هو قديم، ويبني ما هو جديد، والخطوة الأولى في كل ذلك هو نوع من «ثورة» ثقافية تجديدية جذرية، وليس مجرد تحسينات أو إصلاحات شكلية سطحية، والطريق طويل لا شك، ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة أولية واحدة.







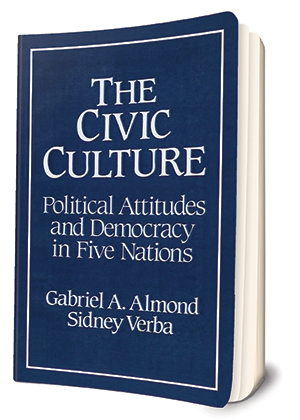 يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.
يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.


0 تعليق