يكشف هذا الكتاب «العصبيات وآفاتها هدر الأوطان واستلاب الإنسان» الصادر حديثًا عن المركز الثقافي العربي بيروت لمؤلفه الدكتور مصطفى حجازي المستور والمسكوت عنه في جل الدراسات التي تناولت واقع مجتمعاتنا، وتتمثل فرضيتها الأساسية في أن البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ظلت على امتداد التاريخ العربي محكومة منذ تسعة قرون بثلاثية بنية العصبيات والفكر الأصولي والاستبداد، ويرى المؤلف أن هذه الثلاثية مغروسة بعمق في البنى الاجتماعية، وترسخ في اللاوعي الثقافي الجمعي منذ تسعة قرون، منذ بدايات عصر انحطاط الحضارة العربية الإسلامية. جدير بالذكر أن هذا العمل القيم والمهم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ المنطقة العربية يعد امتدادًا لعملين سابقين للمؤلف هما: سيكولوجية الإنسان المقهور، وسيكولوجية الإنسان المهدور، وهو يقدم إجابة فكرية تحليلية لأسباب إخفاق عمليات التغيير وبناء الديموقراطية في العالم العربي.
يمثل اللاوعي الثقافي الجمعي البنى العميقة الاجتماعية منها والنفسية سواء بسواء، ويظل فاعلًا بقوة بالخفاء، لأنه يحدد البنى الذهنية الحاكمة للبنى الاجتماعية وعلاقات السلطة على وجه الخصوص، وكذلك للنظرة إلى الذات والكون، ويصدق ذلك على واقع الشرائح الشعبية العربية على وجه الخصوص ورسوخ الذهنية العصبية وما تولده من أصوليات واستبداد تشكل هذا الوعي، الذي استمر ما يقرب من ألف عام من التاريخ العربي الإسلامي مما يشكل قرون الانحطاط منذ عهد السلاجقة والبويهيين ثم العثمانيين من بعدهم، وسيادة عصور الاستبداد السياسي والأصولية الدينية والقضاء على الانفتاح الفكري والديني «تكفير المعتزلة» والفلسفي «تحريم التفلسف وشيوع مقولة كل من تمنطق تزندق» وتجيير الفكر الأصولي لخدمة السلطان واستبداده، وتعميم الجبرية وذهنية الخضوع بمثابة حتمية تصور وكأنها هي طبيعة الحياة ذاتها والقدر المنزل، ذلك أن العالم العربي ورغم مظاهر الحداثة لم يحقق النقلة النوعية التي تمثلت بالثورة الثقافية المواكبة للثورة الصناعية في الغرب، والتي تخدم احتياجاتها في إعداد الإنسان المنتج وتأطيره المؤسسي والقانوني، وإطلاق العنان لسلطان العقل محل سلطان الغيب، الخادم والمبرر للحكم الإلهي والكنيسة.
يؤكد المؤلف على فكرة أساسية وهي أنه لا يمكن بناء حداثة مستقبلية على تراكمات الماضي وتركها كما هي، من دون مراجعة وتدقيق وفرز وتمحيص، فالتغيير لا يشمل السطح فقط أي الأنظمة السياسية الاستبدادية، وإنما يتناول الأصوليات التي أصبحت نوعًا من الثوابت التاريخية، لا بد للتغيير من أن يصيب ثوابت اللاوعي الثقافي هذا، والتي اتخذت على مر القرون طابع الثوابت الأبدية.
تنتظم هذه الثوابت ضمن مثلث العصبيات والأصوليات والاستبداد السلطاني، وهي ككل مثلث تتبادل التعزيز والاعتماد المتبادل فيما بينها، ولو برزت في كل حالة صدارة إحداها على الركنين الآخرين للمثلث، اللذين يتراجعان إلى الخلفية، إنما لا يمكن فهم دينامية فعل أي من هذه الأركان وسطوته على الواقع بمعزل عن الركنين الباقيين وإلا وقعنا في سطحية التحليل واجتزاء الرؤية، وهو ما تقع فيه العديد من الأدبيات الرائجة في الموضوع، من مثل الكلام في الأصوليات بمعزل عن المثلث الذي تشكل أحد أركانه، كذلك هو الحال في الرؤى المختزلة حول الاستبداد وفيض الكتابات العربية الراهنة فيه، وكأنه ظاهرة فريدة قائمة بذاتها. يرى المؤلف أن هذا الاختزال هو المسؤول عن عجز هذه الكتابات أو حتى التحركات السياسية وانتفاضاتها، في حين تستفحل أركان هذا المثلث باطراد، ولذلك لابد من تغيير منظور المقارنة بالتالي، والتعامل مع بنية المثلث وآليات عمله وليس مع أحد أركانه معزولًا عن بنيته الكلية الدينامية، تلك هي المقاربة التي تتوسلها الدراسة الحالية للمؤلف.
إن العلاقة التعزيزية والترابطية والتكاملية بين أطراف الثلاثية تتجلى من خلال أن العصبية هي في بنيتها النفسية ذات نزعة أصولية، بمعنى أنها تقوم على القطعية التي تلغي الآخر، إذ تسبغ على كيانها كل الفضائل، وتسقط على الآخر الخارجي كل المثالب، مما يمهد السبيل إلى إلى تفجر العنف فيما بينها وبين الخارج، ذلك أن العنف هو النتاج المباشر لعدم الاعتراف بالآخر، ناهيك عن شيطنته وإسقاط كل العيوب الذاتية عليه، تلك هي السمة الأصولية للعصبية حتى بمعزل عن الدين على أن رباط الدم المكون لنواة العصبية يتعزز ويتفاقم من خلال رباط العقيدة الدينية أو السياسية أيضًا «الأخوة في الدم، والأخوة في العقيدة الدينية والسياسية»، وعلى صعيد المشهد السياسي غالبًا ما تتلازم العصبية السياسية مع العصبية الدينية «من مثل المارونية السياسية والسنية السياسية والشيعية السياسية».
لقد ترسخت العصبية في اللاوعي الثقافي الجمعي خلال تسعة قرون، وما يزال، تمامًا على غرار اللاوعي الفردي ومكبوتاته، ناشطًا في الخفاء طالما استمرت الأمة في تعثرها، وما زال هو بدوره يشكل أحد أبرز قوى التعثر الخفية، طالما لم يتم الكشف عنه في بنيته وديناميات فعله، ويتم العمل على تصفيته، وخصوصًا أن القوى الأجنبية الطامعة في ثروات العالم العربي تشتغل على إثارته تحديدًا، مما يتجلى في المشهد الراهن لواقع العالم العربي ومآزقه، واطراد تعرضه للتفكك والدمار الذاتي، ذلك أن مثلث العصبية – الأصولية – الاستبداد هو في الأساس ضد قيام وطن جامع، إذ تتركز غايته في إقامة نظام حكم (غلبة إحدى العصبيات، إقامة دولة أو خلافة إسلامية أو طائفية أو إقامة نظام حكم استبدادي إلغائي، يقوم على الأجهزة الأمنية التي تحميه).
أسلوب التفكير للعصبية وخطابها
يرى المؤلف أن الخطاب العصبي، كما يتجلى في لغة زعيم العصبية، يتصف باليقين القطعي، فالعصبية هي دومًا على حق والآخر هو الباطل، وحقوق العصبية قاطعة مطلقة ولا تحتمل التسويات مما يعتبر بمثابة انتقاص، ليس من هذه الحقوق، وإنما هو مس بكيان العصبية ذاتها، يستدعي الانخراط في الصراع دفاعًا عنه كاملًا غير منقوص، تمامًا كالقتال دفاعًا عن الشرف الذي لا يتجزأ أو يقبل التسويات.
وكما تقوم العصبية على التعميم إذ أي مس بأي جزئية أو أي شيء منها هو مس بالعصبية كلها، تقوم أيضًا على الاجتزاء في النظرة والتفكير، حيث تركز الأحكام على بعض الخصال أو السلوكيات فتضخم سلبياتها بحيث يمكن أن تصل حد شيطنة الآخر، تلك هي إحدى الخصائص الأساسية في النظرة إلى العصبيات الأخرى.
تتضافر أساليب التفكير في الأمور ومقاربتها هذه وتعزز بعضها الآخر، وتضاف إلى العديد غيرها، مما لم يعرض لها المؤلف، وتؤدي إلى بلورة نظرة مغلقة على نفسها إلى الذات والوجود، تسجن أعضاء العصبية ضمنها، وتدفع إلى تصلب الرؤى والمواقف، وهو ما يشكل المدخل إلى التنكر للآخر، كما يشكل المدخل الذهني الذي يشرعن الصراع ويفتح أبواب العدوانية، كما تشاهد في حروب العصبيات القبلية، والعصبيات الطائفية وتبلغ أوجها في العصبيات الأصولية التي تمثل الحالة المتطرفة لأخطاء أساليب التفكير هذه.

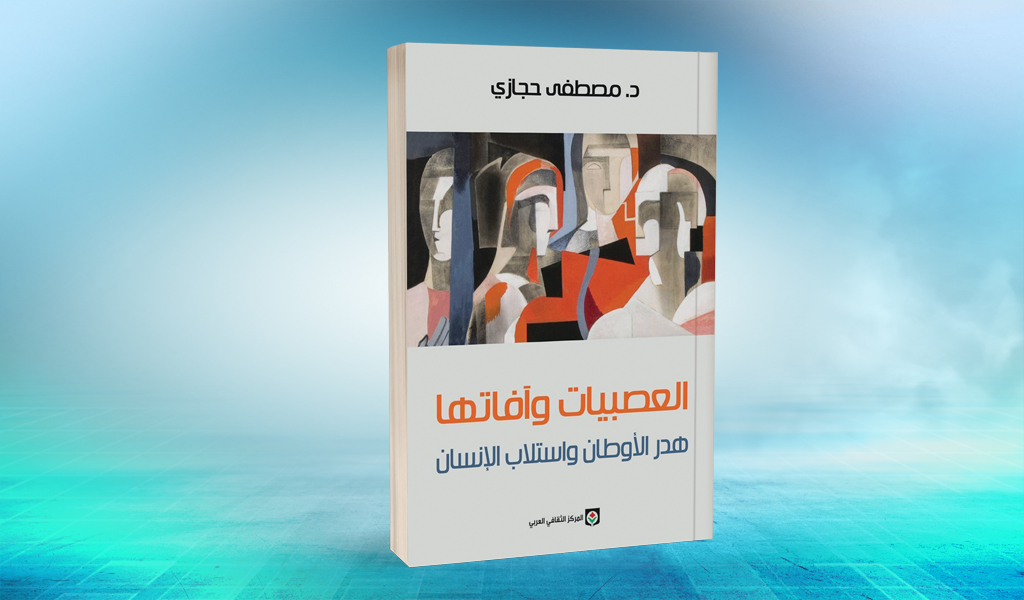








0 تعليق