لا شك في أن روايات الحب قد تعرضت، منذ زمن غير قليل، للإبعاد أو الإهمال، وصارت روايات المتعة والجنس الأكثر حضورًا وهيمنة. والسؤال الذي يشغلنا هو: أين تكمن قوة الأدب: أفي كتابة الحب والعشق أم في كتابة الجنس والمتعة؟ ما الذي تصعب -أو تستحيل- كتابته: الحب أم الجنس؟ ربّما أن الحجج التي تسند هذا النزوع إلى إبعاد روايات الحبّ قد تكون مقنعة، وبخاصة لطبقات القرّاء الآتية:
الرجال الراشدون الذين خبروا الحياة، واكتسبوا من التجارب ما يسمح لهم بأن يطلبوا من الرواية أن تهتمّ بأشياء جدّية وصلبة، لا بمسائل ترتبط بالشعور والطيش والشباب وانعدام التجربة.
القراء الذين ملّوا حكايات الحبّ المتشابهة: في كل زمان ومكان، هناك رجل يجري وراء امرأة، وهناك دومًا هذا البحث السعيد أو الحزين عن النصف الآخر المفقود. وهذه اللعبة التي تعاد في كلّ مرة لا تشغّـل في العمق إلا عددًا محدودًا من التوليفات والتجارب التي استنفد الأدب الشعري والسردي صورها.
الرجال والنساء الذين يريدون من الحبّ أن يتحرر من رومانسيته، وأن يسترجع فعل الحب جوانبه الواقعية والطبيعية، وعناصره المادية والملموسة، بلغة تقول الجسد والجنس والمتعة واللذة، لا بلغة تضفي نوعًا من الأسطرة على فعل الحبّ، وتصوغه صوغًا مثاليًّا فوق إنساني، متعالية على وجوده المادي الملموس.
للردّ على هذه الحجج، يمكن أن نستحضر ردود الناقد المعاصر بيير لوباب في كتابه الذي صدر سنة 2011م حول تاريخ روايات الحب(1)، فنتساءل: ماذا لو كانت الرواية أصلًا جنسًا أدبيًّا غير جدّي، يرتبط بالطيش واللعب والشباب أكثر من ارتباطه بالرشد والجدية والنضج؟ ماذا لو كانت الرواية نوعًا أدبيًّا طائشًا مرتبطًا «أصلًا بانعدام التجربة وبانفعالية الشباب، وبخاصة عند البنات الشابات…»(2)؟ هل يمكن للبالغين الراشدين الذين يفهمون الحياة على أنها مصالح، أن يقتنعوا بما تعلمه روايات الحبّ للشباب؛ أن الحب هو الشيء الأكثر أهمية في الحياة؟
وللرد على من يفضلون كتابة الجنس والمتعة على كتابة الحب والعشق، يمكن أن نستحضر ما يقوله أحد أكبر مُنظِّري الحب في هذا العصر، المحلل النفسي جاك لاكان. ففي نظره، الحبّ علاقة؛ ولذلك فهو يقودنا في تجربة جوهرية إلى معرفة الاختلاف، إلى لقاء الآخر. أما في الجنس، فإنه «لا وجود لشيء اسمه العلاقة الجنسية»(3)؛ ذلك لأنه في الجنس يكون كل واحد من الطرفين منشغلًا بمتعته، صحيح أن هناك جسد الآخر، لكن المتعة هي دائمًا متعتك، فالجنس لا يجمع بل إنه يفرّق. فأن تكون عاريًا ملتصقًا بالآخر هو صورة أو تمثل خيالي، والواقع هو أن المتعة تحملك بعيدًا، بعيدًا جدًّا، عن هذا الآخر.

Claire Legendre
وعلى العكس من ذلك، فإنه داخل الحب تحاول الذات اقتحام «كينونة الآخر»، ففي الحب تذهب الذات أبعد من ذاتها، بعيدًا من نرجسيتها. في الحب، الآخر هو الغاية، فعلاقة الحب تفرض عليك أن تسير نحو الآخر، أن توجد معه، أن يشاركك وجودك. وبهذا المعنى، لن يكون الحب مجرد قناع متخيل لواقع الجنس والمتعة، بل هو تجربة فريدة من نوعها تقودنا إلى اكتشاف المجهول والمختلف: الآخر.
والحب، بهذا المعنى اللاكاني، لا يمكن أن يفسّر علميًّا كما كان يظن فرويد، ولا جدوى من التفاسير العلمية النظرية كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين(4)؛ ذلك لأن الحب لا يمكن أن نتحدث عنه، كما قال أفلاطون، إلا من خلال حكي الحكايات.
وإذا كان صحيحًا أن الروائيين قد حاولوا منذ قرون بناء وصف كامل للحب، فتناولوا شروط ميلاده، ومدته الشديدة التغيّر، وآثاره واضطراباته المتغيرة، وما يخلقه من سعادة أو تعاسة، وما يلقاه من رفض أو قبول من مؤسسات المجتمع… إلا أن الأصح، في نظر بيير لوباب، أن الرواية، وعلى عكس التراجيديات القديمة أو التحليلات النفسية الفرويدية، لا تعتقد أن الأحاسيس المتعلقة بالحب هي أحاسيس أزلية ثابتة، ومن هنا فهي لا تكفّ عن استثمار الوقائع الجديدة، مستخدمة تقنيات سردية غير مسبوقة قادرة على أن تأخذ في الحسبان الأشياء التي لا تزال مجهولة بخصوص شيء اسمه: الحبّ.
ومع كل ذلك، نفترض أن أفضل ردّ على من يستبعد روايات الحب لصالح روايات الجنس، هو أن نتأمل بعض النماذج الروائية المعاصرة: نموذج روائي نسائي مغربي ونموذج روائي نسائي فرنسي. ونحن نحرص على أن لا يشتمّ من كلامنا أيّ موقف أخلاقي ما من الجنس؛ لأن الموقف هنا ليس من الجنس في حدّ ذاته، بل من كتابة الجنس مقارنة بكتابة الحب، أو الأدق من نوع معيّن من كتابة الجنس، وبخاصة تلك الكتابات التي تكتب الجنس بوصفه حاجة بيولوجية، وتكتبه بلغة تقريرية مباشرة جافة: أي أن المسألة المطروحة هي مسألة الكتابة؛ ذلك لأن السؤال الذي يشغلنا هو: أيّ واحد من العنصرين، الحب أم الجنس، يفتح آفاقًا جديدة أمام إشكالية الكتابة؟ متى يكون التخييل قويًّا متدفقًا مدهشًا: أمع الحبّ أم مع الجنس؟ ما الذي تستحيل كتابته، أو نجد صعوبة في الحديث عنه: الحبّ أم الجنس؟
تشخيص مباشر للجنس
اللافت للنظر في السنوات الأخيرة نزوع الكتابة إلى تشخيص الجنس تشخيصًا مباشرًا ومكشوفًا، وهذا النوع من الكتابة يعرف اليوم تزايدًا ملحوظًا، في الغرب كما في الشرق، عند الكتّاب كما عند الكاتبات، مع الإشارة إلى أن حضور الجنس في روايات الكاتبات وقصصهن هو ما يصنع الحدث اليوم في آدابنا العربية كما في الآداب الأجنبية.
وسنكتفي في هذا المقام بمقاربة نموذج من الأدب الفرنسي المعاصر؛ لأنه الأكثر تعبيرًا عن استحضار الجنس بمعناه البيولوجي، وبخاصة في الروايات النسائية التي تنزع إلى تسجيل الجسد والجنس بشكل مكشوف ومفصّل وفاضح، مزيلة كل الطابوهات التي تتعلّق بـ«حياء» المرأة بخصوص الجسد والجنس. ويمكن أن نستحضر هنا كاتبات من مثل: Claire Legendre – Virginie Despentes – Catherine Millet – Raphaela Anderson – Chatherine Breillat – Christine Angot – Clotilde Escalle – Alina Reyes…
وفي هذا النوع من الروايات، نجد الجنس مكتوبًا بطريقة بورنوغرافية خالصة، وذلك بانتهاك كل الطابوهات التي تعلقت بالجسد داخل الأدب، وبخاصة جسد المرأة الذي كان أخرس في التراث الأدبي ولم يكن له الحقّ في الكلام. وفوق ذلك، فالأمر يتعلق بروايات لم تعد تقدم جسد المرأة بوصفه موضوعًا للرغبة الجنسية، بل بوصفه هو الآخر ذاتًا للرغبة، ومن هنا نجد هذه الروايات ترفض عدَّ جسدِ المرأةِ مجردَ حقل للحدث أو فراغ للملء أو لحم للأكل، مركّزة على كتابة شهوانية الجسد النسائي المكبوتة.
وقد أثارت كاثرين مايي Catherine Millet ضجة كبيرة سنة 2001م بروايتها: الحياة الجنسية لكاثرين م. (5)La vie sexuelle de Catherine M، ففي هذه الرواية تقصّ كاثرين حكايتها الجنسية. وبهذا وبغيره، عدَّ النقاد الفرنسيون الرواية الأكثر وضوحا بخصوص الجنس، لم تكتب امرأة مثلها من قبل.

فاتحة مرشيد
والواقع أن القارئ يجد نفسه في البداية أمام كتابة جديدة مغايرة لما ألفه في الآداب الرومانسية. ففي هذه الرواية، كما في مثيلاتها، يسترجع فعل الحبّ والجنس جوانبه الواقعية والطبيعية، المادية والملموسة. وهي بهذا تقدّم كتابة لا تخفي جنس موضوعها، وتعمل على انتهاك الصمت الذي تحيط به تجربة الجنس، وبجرأة غير مألوفة في تاريخ الأدب.
ومع ذلك كلّه، يشعر القارئ أن شيئًا ما ينقص هذه الرواية الجريئة، المحمودة جرأتها والمطلوبة في مجال كالأدب. ولا شك أن سبب هذا الشعور أن الرواية مكتوبة بتقنية باردة، يتحول معها الجنس إلى تجربة إكلينيكية مكتوبة بلغة فقيرة، أي إلى فعل ميكانيكي لا يتألف إلا من مجموعة من الحركات وردود الأفعال. وبعبارة أوضح، فالرواية توظف الجنس في معناه الغريزي البيولوجي بالشكل الذي يجرّده من ذلك العمق أو ذلك الغموض الذي نفترض أنه الأكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بالأدب والكتابة.
ومن أجل توضيح هذه الفكرة، نقدّم ملاحظتين مركزيتين، تتعلق الأولى بالجنس في هذه الرواية، وتتعلق الثانية بالذات الممارسة للجنس كما تتقدّم في الرواية نفسها:
أ ــ يبدو أنه من خلال إزالة الحجاب عن الأجساد في حميميتها، ومن خلال العرض المباشر للممارسات الجنسية، يفقد الجنس في رواية كاثرين مايي تعقيده وغموضه؛ أي أنه يفقد ما يجعل منه لعبًا وانخراطًا في الوقت ذاته، وما يجعل منه تعبيرًا عن الإثارة الغريزية وتمظهرًا للرغبة الإنسانية، وما يجعل منه خليطًا من الغريزة والاستيهام. وفي كلمة واحدة، يجد القارئ هذه الرواية كأنها تفتقر إلى ذلك الشيء الآخر الذي ينتمي إلى نظام الواقع وإلى نظام الغرابة في الوقت نفسه.
وبهذا المعنى، يمكن أن يستخلص القارئ أن هناك انفصالًا بين الجنس والرغبة في هذا النوع من الكتابة التشخيصية للجنس. فالكاتبة الفرنسية كاثرين مايي تتحدث عن حياتها الجنسية كأيّة ممارسة أخرى، كممارسة لم تعد لها أية علاقة بالرغبة. وهي تعلن أنها تعدّد من شركائها الجنسيين، على نحو يجعلها لا تتمكّن أبدًا من إشباع رغبتها ولذّتها.
ومن هنا تأتي ملاحظات النقاد النفسانيين الفرنسيين حول الرواية مناسبة، فعلاقة كاثرين بالجنس علاقة شراهة، أي أنها من النوع الذي يستهلك غذاءه بكمية كبيرة إلى الحدّ الذي يجعلها لا تدري ما تأكله. ويبدو كأن كاثرين «تتقيّأ» الرجال الذين استهلكتهم، فهي مصابة بالتخمة. وككلّ أكول فاقد شهوته إلى الطعام، نجد كاثرين بحاجة إلى حركة مزدوجة: الابتلاع والتقيّؤ، وذلك من أجل التحكّم في فراغها والإحساس بالحياة من خلال الغذاء المستهلك والمقيّأ، وهو ما يجعل كاثرين تبدو كأنها بحاجة إلى رجال باستمرار من أجل التحكّم في فراغها الداخلي. وفي جميع الأحوال، يواجه القارئ حركة مزدوجة متناقضة بشكل صارخ؛ ذلك لأنه إذا كان الاستهلاك يمنع الرغبة من الظهور، فإن هذه الرغبة تصير، من خلال التقيّؤ، مخنوقة بالتغذية الزائدة عن الحاجة.
وهكذا، فالجنس حاضر في هذه الرواية بوصفه حاجة لا بوصفه رغبة. وإذا كانت الحاجة تتميز بالاستيعاب والاستهلاك، فإن الرغبة بالعكس تبدأ من هنا حيث الإشباع ليس مباشرًا، من هنا حيث الذات تواجه الواقع والآخر والممنوع والاختلاف. فالحاجة تتطلب بالضرورة أن تكون مشبعة، ويأتي إشباعها من استهلاك موضوعها، أما الرغبة فهي لا توجد إلا بدءًا من اللحظة التي تتخلّى فيها عن اعتبار موضوعها شيئًا للاستهلاك. وموضوع الرغبة الجنسية بالأخص شيء غير قابل للاستهلاك، فهي رغبة لا تظهر إلا في اللحظة التي تدرك فيها الذات الراغبة أن الآخر يملك ما لا تملك، وأنّه مختلف عنها، فالآخر هو من لا يمكن أن تكونه الذات، ولهذا فالآخر هو من يحيل على نقصان الذات وفقدانها، وهو في الوقت ذاته من يمكنه أن يتقدّم على أنه يستطيع أن يملأ هذا النقصان. وبهذا المعنى، فالرغبة تتغذى من فعل أن الآخر لا يمكن أن يكون لي كلية، فهو موضوع الرغبة، لكنه ليس موضوعي.
والكتابة، في معناها الأصيل، لا يمكن أن ترتبط بالحاجة، بل إنها ترتبط بالرغبة. فالرغبة بوصفها فقدانًا متواصلًا هي، على حدّ تعبير ت. تودوروف، الموضوع الجوهري الخاصّ بالأدب، فبكلامه عن الرغبة التي تشكو فقدانًا يستمر في الحديث عن نفسه.
أشياء وأدوات بلا هوية
ب ــ بعد قراءة الرواية، يجد القارئ نفسه أمام مفارقة؛ حيث يلاحظ غياب البعد الذاتي في رواية كاثرين مايي، أي غياب الذاتية الملازمة لكلّ رغبة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالشخوص الأخرى موضوع الجنس، فهي تتقدّم بوصفها مجرّد أشياء وأدوات من دون هوية، من دون أسماء، من دون وجوه. ومن ناحية أخرى، سيلاحظ أن الكاتبة في روايتها السير-ذاتية تريد أن تجعل من الكتابة فضاءً تعرض فيه الذات في كامل حميميتها، حيث إن هذا العصر هو عصر نشر الحميمي من دون خجل، وعصر الانكشاف وانتهاك الممنوعات، عصر ينظر إليه بعض النقاد النفسانيين على أنه زمن استيهام جديد: الذات الشفافة. والسؤال الذي يطرحونه هو: هل يمكن أن تكون هناك في الواقع ذات شفافة بالكامل؟ وهل يمكن للذات أن تقول كلّ شيء عن ذاتها؟
ومن هنا يمكن أن نفترض أن هذا الخطاب الروائي المعاصر، الذي يبدو أنه يتحدث عن الممنوع والحميمي، عن الجسد والجنس، لا يفتح فضاء للجنس داخل الكتابة والأدب، قدر ما يتعلق الأمر بقلق داخل الجنس، بقلق داخل المتعة واللذة. وبعبارة أخرى، يمكن القول: إن الفضل يعود إلى هذا الأدب في أنه يبوح بكل المتع واللذّات، لكن هناك شيء ما ينفلت من الكلام. فعندما نقرأ رواية كاثرين مايي، سنلاحظ أن هناك شيئًا ما يُحكَى، ويتعلق الأمر بنوع من الصمت: صمت القلق الذي يغلف المتعة نفسها.
روايات نجحت في كتابة الحب
أفترض أن بعض الروايات المغربية المكتوبة باللغة العربية، التي صدرت مؤخرًا، قد نجحت في أن تكتب الحب، بالمعنى الذي يفيد العلاقة بالآخر، ويدفع الكتابة في اتجاه لقاء بالآخر. وأقترح عليكم الوقوف قليلًا عند رواية: لحظات لا غير، الصادرة سنة 2007م، للشاعرة الروائية فاتحة مرشيد(٧). فهي، في افتراضي، رواية نجحت، إلى هذا الحدّ أو ذاك، في العبور من الأنا إلى الآخر. وبمعنى آخر، فمن خلال علاقة الحب، في هذه الرواية، تقود الكتابة الذات إلى لقاء آخرها، الآخر الموجود في الخارج والموجود في الداخل أيضًا.
ينبغي لنا أن نوضح أولا عبارة الآخر. في المعاجم اللغوية، تفيد عبارة «الآخر» أن شيئًا ما ليس مثيلًا، أي أنه مختلف أو غريب أو مميّز، فالآخر ليس هو الأنا، وليس هو الذات (Petit Robert). واصطلاحًا، يتحدد الآخر بأنه شخص مختلف عن الأنا، واختلافه يتحدد بالنظر إلى الذات، فالآخر لا يمكن أن يوجد إلا من خلال اللقاء أو الصدام بالأنا، والأكثر من ذلك، أن الآخر Autre,autre,، هو، في التحليل النفسي، وبصفة عامة، كل ما أو من يحدد الذات، من الداخل أو من الخارج(7).
وفي رواية : لحظات لا غير، نجد الآخر بهذا المعنى الخارجي، فالآخر هو ذلك الشخص الآخر الذي يختلف عن الذات، كما نجده بالمعنى الداخلي، فالآخر هو هذا الغريب في دواخلنا، أو هذه الأنا الأخرى التي نجهلها أو نتجاهلها، والتي توجد بداخل الذات نفسها. نسمي الأول الآخر الخارجي، وهو يستتبع الاشتغال بما معنى اللقاء بالآخر الخارجي. ونسمي الثاني الآخر الداخلي، ويستتبع الاشتغال بالمقصود بلقاء الآخر الداخلي.
3 ــ 1 ــ الكتابة واللقاء بالآخر الخارجي
تتأسس رواية: لحظات لا غير، على بنية ثنائية مزدوجة مؤسسة على لقاء بين فردين، شخصيتين، الطبيبة النفسانية أسماء، ووحيد، الأستاذ الجامعي والشاعر الذي حاول الانتحار. وهكذا، نكون في البداية أمام محللة نفسانية وأمام مريض هو موضوع التحليل يشاركان معًا في جلسات تحليلية ـ نفسانية. هما معا يتكلمان ويتحاوران، يتحدث المريض عن الشيء الذي أتى به إلى هذه الجلسات، أي عن ألمه، وتحاول الطبيبة تحليل شخصيته والنفاذ إلى أعماق لا وعيه من أجل الوصول إلى علاجه.
وهكذا، فالعنصر الأساس والضروري الذي لا بد منه للجلسات من هذا النوع، وللقاء بالآخر من هذا الشكل، هو الحوار: وهو يحتل جزءًا مهمًّا من الرواية، وبأشكال متعددة: هو حوار شفوي مباشر بين الطبيبة ومريضها، أو حوار رسائلي عبر البريد الإلكتروني، أو هو تبادل للرسائل والقصائد والقصص، أو هو مونولوج أو صمت..، إلى حدّ يمكن معه القول: إن الحوار عنصر بنائي أساسي في هذه الرواية، بل إن الكتابة تتقدم كأنها الوسيلة الوحيدة لمواصلة الحوار مع ذلك الآخر، الذي رحل ومات، ولم تستمتع معه الذات إلا بلحظات لا غير.
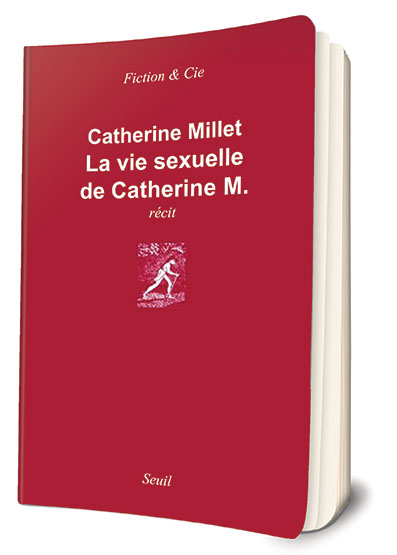 والحوار هو الذي سمح للطبيبة بأن تكتشف بأن مريضها ليس من ذلك النوع العادي الذي يرتاد عيادتها. إنه مختلف واستثنائي، وبخاصة في ردوده وأجوبته وحواراته. يتعلق الأمر بأستاذ جامعي، يساري، شاعر، درس بفرنسا، متزوج من أجنبية، ينتمي إلى جيل الأسئلة والقضايا الكبرى، ومحاولته الانتحار هي التي أتت به إلى لقاء الطبيبة، لكنه على حد تعبير الطبيبة نفسها: «لا يترك لي مجالًا لممارسة خبراتي المهنية. وكأنه يحاول إشعاري بقدراته على فهم النفس البشرية» (ص21).
والحوار هو الذي سمح للطبيبة بأن تكتشف بأن مريضها ليس من ذلك النوع العادي الذي يرتاد عيادتها. إنه مختلف واستثنائي، وبخاصة في ردوده وأجوبته وحواراته. يتعلق الأمر بأستاذ جامعي، يساري، شاعر، درس بفرنسا، متزوج من أجنبية، ينتمي إلى جيل الأسئلة والقضايا الكبرى، ومحاولته الانتحار هي التي أتت به إلى لقاء الطبيبة، لكنه على حد تعبير الطبيبة نفسها: «لا يترك لي مجالًا لممارسة خبراتي المهنية. وكأنه يحاول إشعاري بقدراته على فهم النفس البشرية» (ص21).
ولأن شخصيته متميزة، وبخاصة في حواراته، وبفضل كتاباته وأشعاره، فقد تحول اللقاء الطبي بين الطبيبة ومريضها إلى لقاء حب وزواج، بشكل جعل الطبيبة تتمرد على تقاليد وأخلاقيات الطبّ النفسي التي تمنع أي علاقة حبّ بين الطبيب ومريضه، وكأن التحليل النفسي قام أصلًا ضد الحب!
من الأسئلة التي تدعو إلى التأمل باستمرار: ما معنى اللقاء بالآخر في الحب؟
نكتفي بإشارة واحدة تتعلق بهذا الذي يولده حبّ بين فردين: أن يشكلا معًا زوجًا، والزوج هو جمع بين فردين كل واحد منهما هو في لقاء بالآخر، وهو ما يستدعي أن نتأمل التفاعلات التي تستتبعها فكرة الزوج، أي فكرة اللقاء بالآخر داخل الحبّ.
ينبغي لنا أن نسجل أن صورة الزوج، بمعنى الثنائي، حاضرة بقوة، وبوجه سلبي، داخل الرواية: ففي الواقع، فشلت كل علاقات الزواج (الطبيبة وزوجها الطبيب الجراح، وحيد وزوجته الأجنبية)، والزوج، أي الثنائي، الوحيد الذي يبدو أنه الصورة المثالية لكل لقاء بالآخر داخل الحب، هو الزوج الذي يتألف من أسماء ووحيد، لكنه الزوج الذي لم يستمر إلا لحظات لا غير، بعد رحيل الحبيب بسبب مرض عضال، وتبدو الكتابة في النهاية كأنها نشيد شعري يتغنى بهذا الزوج، الثنائي، المثالي المفقود!
ولا شك في أن فكرة الزوج، بهذا المعنى، هي التي تفسر لماذا جاءت الكتابة مؤسسة في شكل بنيات مزدوجة: سرد/ شعر، قصة/ رواية، مونولوج داخلي/ رسالة، كلام/ صمت… بشكل يدفعنا إلى عدِّ الآخر هو النص الآخر، هو الجنس الآخر، ويدفعنا إلى إعادة النظر في مفهوم التناصّ، وإخراجه من معناه التقني المحدود الإشكالية، ومعالجته في بعده النفساني، بوصف التناص هو أولًا وأخيرًا لقاء بالآخر وتفاعل معه.
وفي ختام حديثنا عن هذا اللقاء بالآخر، في معناه الخارجي، ينبغي أن نسجل أن هذه الرواية: لحظات لا غير، هي من تأليف الطبيبة أسماء، هذا ما نكتشفه في نهاية الكتاب، حيث تنتهي الرواية من حيث بدأت، فلولا رحيل ذلك الآخر، ذلك الوحيد من نوعه، لَمَا خرجت هذه الرواية إلى الوجود، مع الإشارة إلى أن الرواية تصرح في أكثر من مكان أن وحيد هو الذي أعاد الطبيبة إلى الكتابة، أو الأصح، بفضل الآخر عادت الكتابة إلى الطبيبة.
3 ــ 2 ــ الكتابة واللقاء بالآخر داخل الذات
يستدعي اللقاء بالآخر، بمعناه الخارجي، لقاء بالذات. وفي هذه الحالة، يصبح الآخر هو تلك الأنا الأخرى التي توجد في داخل الذات. واللقاء بالآخر، بهذا المعنى، هو الذي يدفع الشخصية الروائية إلى السؤال عن هويتها، والبحث في/ عن ذاتيتها.
في رواية لحظات لا غير، وبفضل خصائص هذا الآخر الخارجي الوحيد من نوعه، ستنقلب الأدوار، وستتحول الطبيبة إلى مريضة/ موضوع التحليل النفسي، ويتحول المريض/ المحلَّل (بفتح اللام المضعَّفة) إلى طبيب نفسي/ محلِّل (بكسر اللام المضعَّفة)، إلى حدّ جعل الطبيبة النفسانية تتساءل: «كيف أعادتني حصص علاجه إلى نفسي؟ أتراني أحلّله أم أنه يحللني؟» (ص 35).
الطبيبة أسماء إنسانة في نهاية الأمر، امرأة عرفت عدة انكسارات (فشل في الزواج، المرض،…)، وهذا اللقاء بآخر مختلف، أي وحيد، وبالرغم من أنها الطبيبة وهو المريض، فإنه اللقاء الذي دفعها إلى أن تواجه في داخلها أناها الأخرى، المقموعة والمكبوتة والمستورة، ولهذه الأنا الأخرى أوجه عدة: الأنا الكاتبة المستورة التي لولا وحيد لَمَا عادت إلى الظهور، المرأة العاشقة التي لا تزال، على حد قولها، ورغم انكساراتها، تحلم «كما الصبايا برجل يختزل كل رجال العالم» (ص 40)، المرأة المثقفة الإنسانة التي تتمرد من أجل أن تعيد للحياة المهنية وللحياة عامة بُعْدَها الإنساني في أَجْلَى صُوَرِهِ: الحُبّ!
وبهذا المعنى، فالآخر الداخلي هو الوجه الخفي من هويتنا، ونحتاج إلى ذلك الآخر لكي نتعرّف إلى أنفسنا، أي إلى هويتنا الأصلية. والآخر، بهذا المعنى، هو المرآة التي من خلالها نتعرف إلى صورتنا الأخرى، من خلالها نمارس التفكير في ذواتنا، ونحدد هويتنا، بشكل أفضل وأعمق. وهذا المعنى الثاني للآخر في هذه الرواية هو ما التفت إليه مؤسس التحليل النفسي س. فرويد في مقالته عن «الغرابة المقلقة»، وهو ما كرست له جوليا كرستيفا كتابًا كاملًا تحت عنوان: (Etrangers à nous-mêmes 1988). وسواء استحضرنا مقالة فرويد أو كتاب كرستيفا، فإن رواية فاتحة مرشيد تكشف أن لقاء الآخر، في معناه الثاني، لقاء يضع الأنا أمام الوجه الخفي، المقموع والمكبوت، من هويتها. ولا شك أن ظهور ذلك الآخر فينا يساعدنا على اكتشاف الغرابة الموجودة في دواخلنا، وهي بلا شك غرابة مقلقة، قد تقلق الذات نفسها، وتدفعها إلى طرح أسئلة مزعجة: «هل الطبيب يمرض؟» (ص 81)، «هل كان اختياري لمهنتي حبًّا في تخليص النفس البشرية من معاناتها أم إنه رغبة دفينة للتعرف على خبايا لا وعيي؟» (ص 82).
ومعنى هذا أن فكرة الغرابة تجعل الشخصية بين هويتين: بالنسبة لأسماء، هي طبيبة/ عاشقة، وبالنسبة لوحيد هو متزوج/ عاشق. كل شخصية نجدها موزعة بين هويتين: هويتها الأصلية والهوية التي اكتشفتها بعد لقائها بالآخر. واكتشاف الغرابة بالداخل يؤدي لا محالة إلى غرابة خارجية: أضحت الطبيبة غريبة في محيطها الطبي المهني الذي لن يقبل أبدًا بعلاقة عاطفية جنسية بين الطبيبة ومريضها، والمريض أصبح غريبًا في محيطه العائلي، ويكفي أن نستحضر ردّة فعل زوجته الفرنسية. ومن المهم جدًّا أن نشير إلى انتصار الأنا الأخرى في النهاية، وهي رمز الحياة والحب والإبداع. فعلى الرغم من رحيل الآخر، بمعناه الخارجي، أي الحبيب وحيد، فإن الأنا الأخرى، الإنسانة العاشقة الكاتبة، قد بقيت حية، ومن هنا لا غرابة أن تنتهي الرواية بقولة دالة: «تريّث قليلًا أيها الموت… إنّي أكتب» (ص 174).
4 ــ وأخيرًا، يبقى أن نشير إلى أن رواية الحب، على العكس من رواية الجنس -على الأقل، انطلاقًا من النموذجين أعلاه- هي رواية تحتفي باللغة، بالشعر، تتخللها مقاطع وقصائد شعرية، وهي تكتب الجنس أيضًا، لكن بلغة استعارية رمزية، أي أنها لا تكتبه بوصفه حاجة بيولوجية، بل بوصفه رغبة فيها من الغرابة والغموض، وهو ما يجعل الكتابة تستعين بالرمز والتصوير والشعر.
واللافت للنظر في رواية الحب، التي تناولناها أعلاه، ليس هو هذا الجمع بين الشعري والعاطفي والجنسي فحسب، بل نجد حضورًا للعنصر السياسي أيضًا، حيث الحكاية هي حكاية شخوص اكتوت بنار العشق والشعر والنضال، تقاسي المرض والنسيان والفقدان، ولم تفز من الحياة إلا بلحظات لا غير، ولم تجد وسيلة أفضل لتقاوم قوى الموت، لتقول ألمها وروحها غير الحبّ والشعر والحكي والكتابة. فأساس الكتابة هنا أساس نفساني، بحيث لا يمكن الفصل بين الحرف والفقد، بين الكتابة والألم، وأساسًا بين الكتابة والآخر.
وفي افتراضنا، فالدرس الأساس في هذه الرواية هو أن الحب هو أساسًا لقاء بالآخر، فالحب يُحْيِي الحوار والتواصل، وأنْ تُحِبَّ معناه أن تُحْسِنَ الإصغاءَ للآخر، إلى محكيه. وفي لقاء الآخر، تفقد الأنا توازنها، وتعمل من أجل إعادة اكتشاف هويتها. والكتابة تساعدنا على العبور من ذواتنا إلى الآخر، إنها باب مفتوح في وجه الآخر، ذلك الآخر المكبوت المقموع في دواخلنا.
هوامش:
1) Pierre Lepape : une histoire des romans d’amour, ed. Seuil, 2011.
2) ibid, p 12.
3) Alain Badiou, Nicolas Truong : Eloge de l’amour, ed. Flammarion, Paris, 2009.
4) Annie Le Brun : Anthologie amoureuse du surréalisme, ed. Syllepse, Paris, 2002.
5) Catherine Millet : La vie sexuelle de Catherine M., ed. Seuil, Paris, 2001.
٦) فاتحة مرشيد: لحظات لا غير، المركز الثقافي العربي، البيضاء، بيروت، 2007م.
7) R.Chemama, Dictionnaire de la psychanalyse, Larousse, 1993, p28.









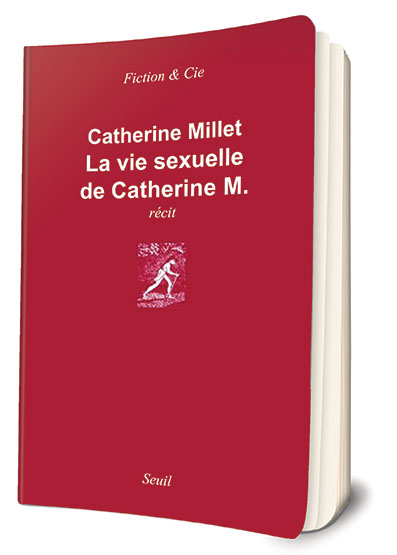 والحوار هو الذي سمح للطبيبة بأن تكتشف بأن مريضها ليس من ذلك النوع العادي الذي يرتاد عيادتها. إنه مختلف واستثنائي، وبخاصة في ردوده وأجوبته وحواراته. يتعلق الأمر بأستاذ جامعي، يساري، شاعر، درس بفرنسا، متزوج من أجنبية، ينتمي إلى جيل الأسئلة والقضايا الكبرى، ومحاولته الانتحار هي التي أتت به إلى لقاء الطبيبة، لكنه على حد تعبير الطبيبة نفسها: «لا يترك لي مجالًا لممارسة خبراتي المهنية. وكأنه يحاول إشعاري بقدراته على فهم النفس البشرية» (ص21).
والحوار هو الذي سمح للطبيبة بأن تكتشف بأن مريضها ليس من ذلك النوع العادي الذي يرتاد عيادتها. إنه مختلف واستثنائي، وبخاصة في ردوده وأجوبته وحواراته. يتعلق الأمر بأستاذ جامعي، يساري، شاعر، درس بفرنسا، متزوج من أجنبية، ينتمي إلى جيل الأسئلة والقضايا الكبرى، ومحاولته الانتحار هي التي أتت به إلى لقاء الطبيبة، لكنه على حد تعبير الطبيبة نفسها: «لا يترك لي مجالًا لممارسة خبراتي المهنية. وكأنه يحاول إشعاري بقدراته على فهم النفس البشرية» (ص21).


0 تعليق