قال ابن إسحاق، أول مؤرخ لسيرة رسول الله: «واجتمعت قريش يومًا في عيدٍ لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له.. فخلص منهم أربعة نجوا وهم: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى، وعبيدالله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل.. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء.. يا قوم التمسوا لأنفسكم، فوالله ما أنتم على شيء..». لم يتغير الوضع كثيرًا منذ ذلك الزمان في زمننا الحاضر، تغيرت الأصنام وأسماؤها، والأوثان وصفاتها، ولكن المضمون واحد: «فوالله ما أنتم على شيء». تشرذمت قريش في ذاك الزمان إلى شيع وأحلاف وأحزاب عشائرية وغير عشائرية، كما يصف ابن هشام في تاريخه للسيرة النبوية، وجدت نفسها في حالة تنافس يصل إلى حد الصراع أحيانًا، وهو ما يحدث ذاته اليوم في عالم العرب وبقاع أخرى من عالم المسلمين. جاء الإسلام ووحَّد كلمة العرب وأصبح لهم «مرجعية» واحدة، وصار القوم على شيء، ولكن ذلك لم يدم طويلًا؛ إذ عاد التشرذم والتحزب والتعنصر القبلي والطائفي والإقليمي، وما زلنا نعيش ذلك حتى اليوم، لدرجة أن بعضًا وصل إلى قناعة بأن العرب قوم يستعصون على الاتحاد، فديدنهم هو التشرذم والفُرقة، ولكن هذا تعميم غير علميّ وبالتالي غير صحيح، فهم، أي العرب، بشر مثلهم مثل غيرهم من شعوب العالم، تجري عليهم السنن والقوانين، ويتأثرون بالظروف ويؤثرون فيها.
وهنا يأتي السؤال الوجودي في حياة العرب وهو: لماذا كان هذا هو حال العرب؟ لماذا كان التشرذم هو عنوان تاريخهم في معظم المراحل، لولا قبسات من نور الاتفاق في هذه المرحلة أو تلك؟ الجواب ببساطة هو: هيمنة الدين على مختلف جوانب الحياة العربية، ماضيًا وحاضرًا، ولكن هذا الجواب يحتاج إلى نوع من الاستفاضة في الشرح والتعليل.
فمنذ ظهور الإسلام في ديار العرب، كان الدين هو المتحكم في الحياة العربية، اجتماعيًّا وسياسيًّا، سواء في إسباغ الوحدة على الكيان السياسي، ومن ثم فرض التجانس الثقافي والاجتماعي على الكيان محل الدراسة، أو من خلال التمردات والثورات التي ترفع الشعارات الدينية. فالدين أعطى ويعطي مشروعية للنظام السياسي المهيمن، وفي الوقت ذاته للحركات المناوئة لهذا النظام. فالخوارج مثلًا، الذين أعلنوا الثورة على علي بن أبي طالب في أول أمرهم، كانوا يرفعون شعارًا دينيًّا، «إن الحكم إلا لله»، ضد سلطة تطرح نفسها على أنها خلافة للرسول، وهنا تكمن شرعيتها. والذين قتلوا عثمان بن عفان نقموا عليه لأسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن ذلك كان مؤطرًا بغلاف ديني، ناهيك عن ثورات الشيعة عبر التاريخ العربي وغيرهم، وكلها تحمل المضمون الديني ذاته.
المضمون الديني
نحن نعلم أن كل تلك الثورات كانت لأسباب اجتماعية حين تحليل موضوعها سوسيولوجيًّا، ولكنها لا تستطيع أن تطرح نفسها على هذا الأساس؛ إذ لا بد من مضمون أيديولوجي لها يتخذ الدين شعارًا، وبغير المضمون الديني فإنه لن يُكتَب لأي ثورة أو تمرد النجاح. بل حتى السلطات الحاكمة إنما تقمع هذه التمردات والثورات في ظل تفسير ديني مختلف، وشعار ديني مناوئ، وبنصوص دينية أُعطِيت تفسيرًا معينًا، وهو ذاته ما كان يفعله المتمردون، بل انبثق عن ذلك مذاهب دينية مختلفة خلال مراحل التاريخ العربي الإسلامي. فالإرجاء كان مذهب الدولة الأموية، والقدرية، ومنها الاعتزال، كان مذهب الدولة العباسية حتى خلافة المتوكل، الذي جعل مذهب أهل الحديث هو المذهب الرسمي للدولة. والصراع الصفوي العثماني كان في ظاهره دينيًّا، بينما هو في حقيقته صراع على النفوذ أولًا وآخرًا، وعلى ذلك يمكن القياس.
المراد قولُه هنا هو أن الدين عامل رئيس، وربما الأهم، في الثقافة والحياة العربيتين، ولا يمكن الوصول إلى قلب العربي البسيط وعقله، أو العامة من الناس، من دون أن يكون للخطاب الديني دور في ذلك. بل إنه حتى في الأيديولوجيات التي ترفع شعار العلمانية والدولة المدنية، تجد أن هنالك رجوعًا إلى الدين من أجل إثبات مقولة ما، أو «التسويق» للفكرة لدى العامة، وذلك مثل القول بأن أبا ذر الغفاري هو أول اشتراكي في الإسلام، حين كانت الاشتراكية هي الموجة السائدة، أو القول بأن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية ذاتها، أو أن عمر بن الخطاب هو نموذج المستبدّ العادل، وهكذا. من هنا تنبع ضرورة نشوء خطاب ديني جديد يبشر بقيم جديدة تركز على قيم التسامح والسلام والثقافة العلمية ضمن قيم أخرى. خطاب يعيد تفسير النصوص وتأويلها، فالنص فضاء مفتوح، في مقابل الخطاب المتطرف اليوم، خطاب داعش والقاعدة وغيرهما، الذي ينذر بالعنف وسفك الدماء وتكفير الآخر. الخطاب المتطرف والمحرض على العنف هو في النهاية خطاب يستند إلى نصوص مقدسة، فداعش أو القاعدة لم يأتيا بنصوص من عندياتهما، ولكن زاوية القراءة لهذه النصوص تختلف، ومن هنا تنبع ضرورة إعادة قراءة الدين من زاوية أخرى، بعد أن أحرقت القراءة المتطرفة الحرث والنسل، ودمرت البشر والحجر، وعاقت التنمية، ودمرت الإنسان، وهو مفهوم لا تعرفه هذه القراءة. وهناك قراءات متعددة للنص الديني خلال الحقب التي مر بها تاريخ الإسلام، ولكن يمكن القول: إنها كانت وما زالت، إلا بعض محاولات هنا وهناك، مثل قراءة محمد أركون للنص الديني ومحاولة فهمه من خلال آليات ومنهجيات جديدة، ولكن جُلّها كان يركز على إعادة قراءة النص من خلال المنهجيات التقليدية التي لا تخرج في معظمها عن القواعد الأساسية التي نظَّرَ لها الشافعي في كتابه «الرسالة»، بينما المطلوب اليوم هو قراءة النص بنظرة فلسفية، واستكناه معانٍ جديدة تدور حول قيم مختلفة، ليس من الضروري الرجوع فيها إلى اجتهادات «السلف الصالح»، أيًّا كان ذاك السلف.
إعادة الاعتبار للإنسان
بإيجاز العبارة، إن المحور الذي يجب من خلاله إعادة قراءة الدين هو «أنسنة» الدين، وإعادة الاعتبار للإنسان فيه، بعد أن اختطف تاريخيًّا، وبدلًا من أن يكون النص الديني عبئًا على الإنسان، يعود ليكون عونًا له على ممارسة إنسانيته من دون إحساس بذنب أو خطيئة أو تضحية ما أنزل الله بها من سلطان. الخطاب الديني المعاصر ملغم بالكراهية والبغضاء ونفي الآخر والعنف، والحديث هنا عن الخطاب الديني الإسلامي الذي يجد قبولًا واسعًا لدى معظم المسلمين، سواءٌ الخطاب الذي ينذر بالويل والثبور علانية، أو ذاك الذي تستتر البغضاء ومن ثم العنف، في تلافيفه من دون إعلان صريح؛ إذ إن الجميع يستندون إلى مرجعية واحدة. وفي هذا المجال، يطرح بعضٌ العودة إلى بعض طروحات مدارس إسلامية معينة من أجل الخروج من دائرة العنف، وأزمة الخطاب الإسلامي المعاصر، المجاهر بالكراهية والمخفي لها بين ثنايا النصوص، من أجل خطاب إسلامي جديد، ولا أظن أن هذا هو الحل.
يطرح بعضٌ العودةَ إلى الصوفية كأساس لخطاب جديد، حيث إن مبادئ الصوفية تحمل قيم التسامح والسلام ونبذ العنف، ولكن الصوفية في النهاية هي تجربة ذاتية فردية لا يمكن لها أن تكون أساسًا لخطاب سياسي واجتماعي عام. فعلى الرغم من تعدد تعريفات الصوفية وتطوراتها عبر القرون، من الزهد البسيط في بداية أمرها، إلى التصوف الفلسفي، وانتهاءً بالتصوف الرث (تصوف الدراويش)، أو تصوف العامة، فإن بنيتها وجوهرها في تناقض وجودي مع نهر الحياة. فهي بحث عن السعادة الروحية الذاتية، وتختلف تجارب البحث عن السعادة هذه من فرد لآخر. والتصوف، وفق تعريف أبي الحسن الحصري، وهو التعريف الذي أجد أنه الأقرب لمعناها العميق، هو: «قطع العلائق، ورفض الخلائق، واتصال بالحقائق». ورغم وجود مدارس وزوايا صوفية شاركت في الحياة العامة، كالسنوسية والمهدية مثلًا، فإن ذلك لا يمنع من التعميم والقول بأن الصوفية لا يمكن أن تكون محور خطاب ديني عام، فبينها وبين زخم الحياة بون شاسع، وإن حدث ذلك، أي تحولها إلى خطاب عام، فإنه لا يكون إلا في حالة ضعف الدولة وبؤس المجتمع، كنوع من اكتفاء ذاتي خارج الدولة والمجتمع.
الخلاصة لحديث أرى أنه قد طال، أن تحديث الخطاب الديني هو ضرورة ملحّة في عالم العرب والمسلمين، إن كان لهم أن يتحرروا من أسر الماضي، وقيود التراث، وتحكم الأموات بالأحياء. خطاب ديني جديد تكون نقطة ارتكازه هي الإنسان، والإنسان فقط..

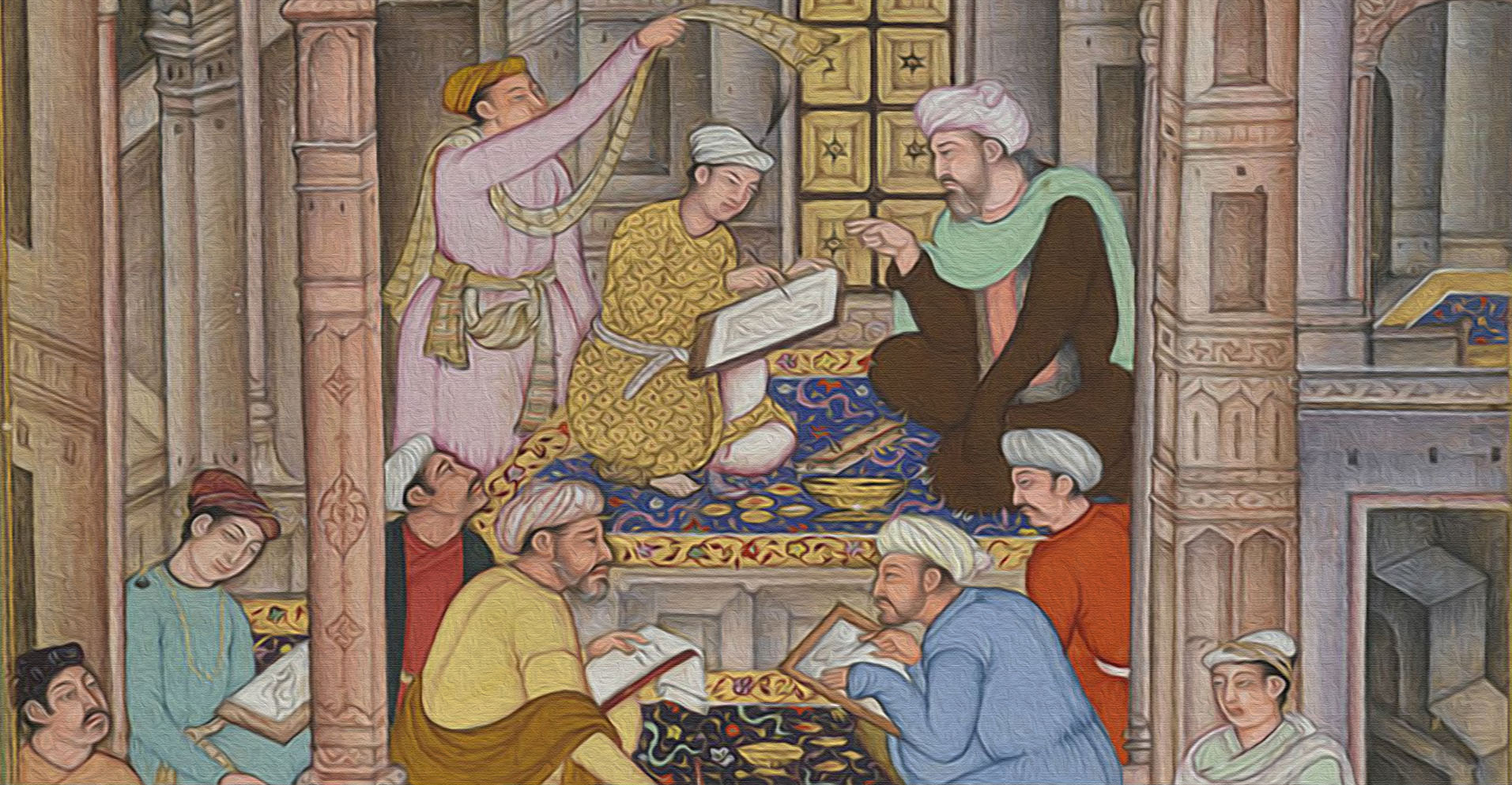








0 تعليق