ترجمة الشعر ليست وردية كما جاء في العنوان، لكنها مغامرة ما زال كثير من النقاد يعدونها «خيانة» إلا أن أهم ما يعرفه القارئ أن الشعر المترجَم يفقد كثيرًا من بريقه في أثناء القيام بعملية فصله عن اللغة الأم إلى لغة جديدة؛ أو إلحاقه بأم أخرى إن شئنا الدقة؛ فيصبح كما لو أنه ابن بالتبنِّي ولنا أن نتخيل معنى ذلك!
من المعروف أيضًا، أنه ليس من الأفضل قراءة الشعر والأدب إلا باللغة التي كُتب بها، هذه الهواجس حول الترجمة يثيرها كتاب «حوارية العتمة والضوء» للسعودي حسن مشهور، المترجم من الإنجليزية والصادر عن دار أروقة بالاشتراك مع نادي نجران الأدبي؛ هذا الكتاب الذي يعكس قدرة المترجِم على الاستفادة من التراكم النصي في الترجمة العالمية، ومن ثم الاستفادة من هذا الإرث العميق الذي كلّله المترجم باستعراض مكثف لحياة كبار الشعراء العالميين في مشهد يبدو كما لو أنه لوحة معلقة في جدار الصمت؛ القابل للحركة والتفاعل.
حسن مشهور أديب ومترجم له أعمال صحافية وإبداعية وبحثية نشرت في كُبريات الصحف والمجلات العربية، وقد فاز بجوائز إبداعية عدة، آخرها جائزة التميز في الأدب لعام 2017م، مقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان. ولعل أهم ما يلفت القارئ أن المترجِم في مقدمته عدّ هذا النوع من الشعر المترجَم «حلقة وصل بين الثقافات المتباينة ومن ثم يعزز العلائقيات بين الحضارات الإنسانية المتعددة… وإنه من خلال التلاقح مع النتاجات الشعرية التعبيرية لثقافات أخرى تحدث الفائدة ويتحقق الثراء في شقه التوليدي الثقافي لدى الحضارات».

حسن مشهور
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن أهم ما يود المترجِم إيصاله لنا هو أن الترجمة بؤرة تجديد طوال الوقت، فالشعراء الذين وردت أسماؤهم في الكتاب كانوا دائمًا محطَّ أنظار المترجِمين العرب طوال عشرات السنين، وقد ترجم كثير من المترجمين أعمالًا خالدة لهم؛ منها نصوص وردت في الكتاب احتفظ المترجم ببصمته في التعاطي معها؛ لكن هذه النصوص تظل هي الأقدر على النفاذ إلى عمق القارئ لأن الترجمة فنّ يقوم على فتح آفاق جديدة في اللغة والفكر والخيال، أما حالة التكثيف القصوى فإنها تتجلى في جديد المنهجية المتخذة؛ لأنها منهجية متينة تقوم على الترابط بين النص والنثر، وقد تجلت الإضافة في انتقاء النصوص؛ وبخاصة تلك التي يتمتع جوهرها بدعوة للخلود وإن طاردها شبح الموت، وهناك نصوص بعينها قادرة على الانفجار والتشظي قادرة على الليونة والتطويع، وهناك أيضًا نصوص عصية. إضافة منهجية أخرى التزم بها المترجم أمام كل شخصية تمثلت بتقديم عرض سيري مُنتقًى بعناية وفُرِز ليكون وجبةً سائغة تقدم للقارئ على طبق مكشوف شهي، وهو عرض تبدو فيه بصمة المترجِم نفسه وليس بصمات منحازة لمترجمين آخرين.. وتجدر الإشارة إلى ضرورة الالتفات إلى استخدام لغة التقصي التي تعني الوصول إلى محاولة بالغة في التكوين العام، مثل الوصول إلى اسم المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر؛ أو المذهب الذي يؤمن به. وخلص المترجم إلى أن هناك اتجاهًا تعبيريًّا لكل شاعر، وهي عمليه قد تكون معروفة لكن الجهد الذي أثرى عملية الترجمة يرتكز في البوتقة التي ترادف فيها «حوار العتمة والضوء» العتمة التي يسوقها العالم بتحولاته، والضوء الذي يحمله الشعر لتمزيق تلك العتمة.
الشعراء الذين ترجم لهم مشهور عددهم 12 شاعرًا وهم: سان جون برس، وآنا أخماتوفا، ولوركا، وشللر، ولارمانتين، وشيلي، وماتسو باشو، ودانتي إلغري، ووليام وردزورث، ولورد بيرون، وراينر ماريا ريلكه، وميلاد فينوس. وتكاد تكون الترجمة هنا قد غطت الأفق العالمي فيما يخص بلدان هؤلاء الشعراء والزمن الأورسطي الذي ينتمي إليه معظمهم. كما أننا نستطيع أن نقول: إننا على موعد مع أجزاء أخرى لترجمات لاحقة وشعراء جدد يمثلون العصور التالية. ويوثق الكتاب الذي بين أيدينا للشعراء الذين تغلب على أعمالهم الرومانتيكيةُ بأبهى حللها، فنجدهم يمجدون الطبيعة ويتغنون بجمالها ويوغلون في الالتصاق بها ومن ذلك لارمانتين الذي قال: أيتها الطبيعة/ حدادك يؤلمني/ وجمالك يفرحني/ وها أنا ذا أسير/ متعثر الخطى/ في الطريق/ طريقي المهجور/ أحلم ولو لثانية أخيرة/ أن أرى هذه الشمس/ التي تضاءلت/ وعلاها الشحوب/ فوهنت.
يقول ابن عربي: «المكان إذا لم يؤنث لا يعوَّل عليه»؛ فها هو الكتاب يحتوي على مشاركة نسوية تجسدت بالروسية آنا أخماتوفا التي ولدت في بلدة صغيرة تدعى بلشوي، وبدأت تنظم الشعر في وقت مبكر من حياتها، واستمرت حتى تزوجت برفيق طفولتها الشاعر نيكولاي قوميليف، ثم عادت فانفصلت عنه. أصدرت بداية ثلاث مجاميع شعرية حملت أسماء: المساء عام 1914م، والسبحة 1914م، والسرب الأبيض عام 1918م، تقول في أحد نصوصها:
«يا موت.. يا موت/ أنت بسيط كما الأعجوبة/ فهلا أتيت إليَّ/ هلُمَّ بأي قناع تريد/ كقنبلة غازية/ فلتنفجر ببدني/ أو فلتسرقني كما اللصوص/ أو اجعل نهايتي بدخانك التيفوسي». عاشت آنا أخماتوفا في حقبة القيصرية واستولت عليها مشاعر الموت كما حدث للإسباني لوركا، الذي ينتمي مثلها إلى بداية القرن العشرين، وتنبأ أن جسده سيختفي عن الوجود حين قال: «حينها علمت أنني قد قتلت/ في المقاهي/ في المدافن والكنائس/ بحثوا عن جثتي/ لكن باؤوا بالفشل/ سرقوا جثثًا ثلاثًا/ نزعوا منها/ تلك الأسنان الذهبية/ لكنهم لم يقفوا لي على أثر».
الياباني ماتسو باشو الذي يعدّ المعلم العظيم لشعر الهايكو، بل الأب الروحي لهذا النوع من الشعر، نجده هنا يحتفل بموضوع النهايات نفسها التي تشربها لوركا وآنا أخماتوفا؛ يقول تحت عنوان خريف: «يا خريف/ هل سأشيخ/ وأنا لم أزل/ أطير تهدهدني الريح. وفي نص آخر يقول: في عالمنا/ لا شيء ينبئك/ عن تلك النهاية». مرت سنوات طويلة تمتد إلى قرون على وفاة هؤلاء الشعراء، لكن أشعارهم تبحر في صمت العماء البشري، كأنها لآلئ تضيء الآماد بقوة. ولا يزال الحلم بتفوق الترجمة على النص الأصلي قائمًا.

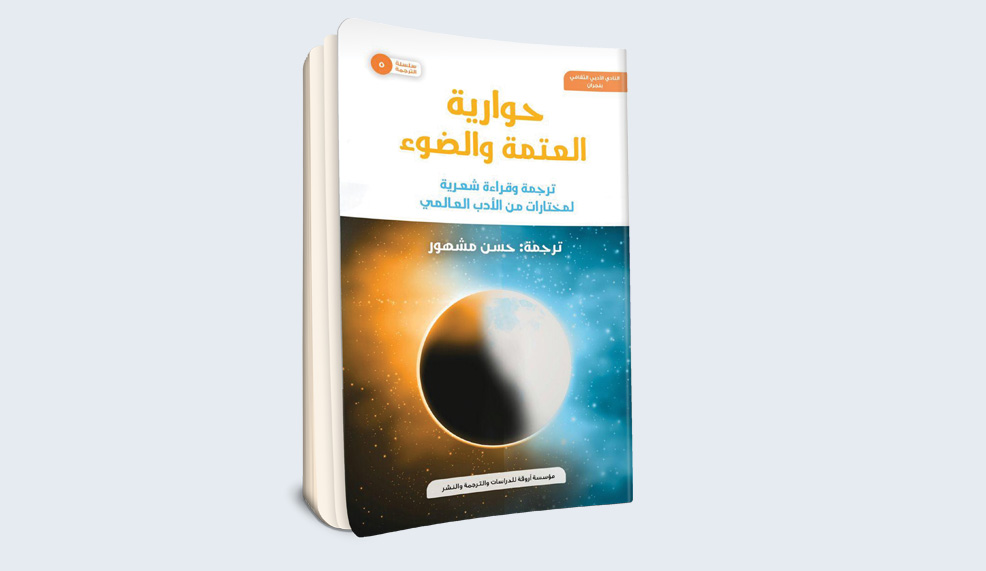









0 تعليق