ينتاب المرء في أحايين عدة، الشعور بأن حياتنا الثقافية العربية على مدى نصف قرن، على الأقل، قد بالغت في الانشغال بالثنائيات المتقابلة، فيما كانت الحياة الثقافية الفعلية (النتاج الإبداعي) قد حسمت تلك الثنائيات بغير ضجيج وبعيدًا من الشعارات الفارغة. ومنها على سبيل المثال مسألة العالمية والمحلية. وحيث انقسم نقاد وباحثون بين مناصرة العالمية أو الكونية، وبين الانحياز إلى المحلية أو الخصوصية. وفي واقع الأمر، إن المبدع لا يحفل مسبقًا وبصورة قصدية بهذا التصنيف المتعسف. إذ إن جُل اهتمامه يدور حول الإصغاء إلى نبض روحه والبحث عن إيقاع خاص يشتمل على الأسلوبية والهوية الفنية، الذاتية، بالاستناد إلى تجاربه وتفاعله مع الواقع، وتثاقفه التلقائي غير المتعمد مع ثمرات الفكر والإبداع الإنساني ولا يعنيه كثيرًا بعدئذ إذا ما صُنِّف لإبداعه على أنه يعكس خصوصية محلية، أو يستشرف آفاقًا إنسانية تفيض عن أية بيئة محددة. فالفيصل هنا هو جدارة الإبداع وأصالته (ابتكاره الذي لا يُحيل إلى غيره). وليس من المبالغة في شيء القول: إن الحكم على عمل أدبي ما بأنه زاخر بالخصوصية، أو يتوفر على بُعدٍ كوني هو من قبيل الأحكام «الخارجية»، القابعة خارج السياق الذاتي للعمل. فكاتب مثل صموئيل بيكيت لا يقل جدارة عن كاتب آخر مثل أنطوان تشيخوف، رغم بُعد الشقّة بينهما. فكلاهما ترك بصمة لا تُمحى، ومن الخطل الحكم عليهما من زاوية الخصوصية أو العالمية، وإن كان مثل هذا التقييم مفهومًا ومطلوبًا من زاوية سوسيولوجية محضة، لكن هذه الزاوية المهمة ليست ذات علاقة بالنقد الأدبي.
إن الأصل في الإبداع هو التعدد والتنوع، وأن يجترح كل مبدع خصوصيته وتميزه. علمًا أن العواطف والهواجس البشرية الكبرى: الحب، والموت، والطفولة، والوحدة، والشيخوخة، والعَوَز… تكاد تكون متماثلة لدى الشعوب. وإذا اتفقنا مع من يذهب إلى أن العالم قرية واحدة، فإن الانشغالات الإنسانية المشتركة في الإبداع تتخطى التصنيف الثنائي بين عالمية ومحلية، وتجعل كل إبداع متميز على صلة بكل بيئة أو واقع. هذا مع ملاحظة استدراكية مفادها أن السرد أكثر قابلية لتمثيل الواقع الاجتماعي من الشعر مثلًا، ومع ذلك فإن أحدًا لا يملك حق مصادرة الاستثناءات كما في نموذج الكاتب الإيرلندي الفرنسي بيكيت.
وإلى مسألة العالمية والمحلية، فلطالما برزت مسألة أخرى تتعلق بالفصحى والعامية. وهي مسألة تتصل بلغتنا العربية حيث تتسع الشقة بين اللهجة العامية أو الدارجة وبين الفصحى. وفي قناعة المرء أن هذه الثنائية بدورها لا تخلو من افتعال. فالعامية هي لغة الكلام والتعامل اليومي، أما الفصحى فهي لغة الفكر والإبداع. العامية كلام، والفصحى كتابة. والخلط بينهما يشوّه صورة كل منهما. وبما أن العامية كلام فإنه يسع المبدع الاستعانة بها بعض الاستعانة في الحوار السردي القصصي أو الروائي أو المسرحي، لكن السياق العام يبقى فصيحًا. وحين تقتحم العامية السياق أو المتن فإنها تفسد العمل وتُحدث ثقوبًا فيه! إذ إن منطق تداول العامية يختلف اختلافًا بيّنًا عن الفصحى. فعلى سبيل المثال في حوارات الحياة اليومية العملية، فإنه يمكن للمتحدّث أن يكرر النطق بجملة أو عبارة من دون أن يترك ذلك أثرًا سلبيًّا، بينما التكرار في السياق الفصيح يُحتسب ضعفًا وركاكة…
وفي القناعة أن إفراط كاتب موهوب مثل يوسف إدريس في استخدام العامية هو أحد الأسباب التي جعلت درجة الاهتمام به، أقل من الاحتفال بنجيب محفوظ الذي يعتمد الفصحى. أما الشعر الشعبي القائم على العامية، فإنه يندرج في معايير تاريخية الإبداع في خانة الإبداع الشفوي المقترن بأداء الشاعر وبالاحتفالات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، لكنه لا يصمد طويلًا في خزانة الأدب مقارنة بالشعر الفصيح، ويشهد على ذلك تراثنا الأدبي منذ المعلقات حتى قصيدة النثر لدى أنسي الحاج! الذي يقاوم التقادم بل يزداد أهمية مع تراخي الزمن. وجملة القول أن الإبداع قرين الأصالة والتجدد معًا، وأن الترجمة تمتحن الإبداع وقدرته على تخطي حدود اللغة والواقع الثقافي المحدود مهما اتسع هذا الواقع.

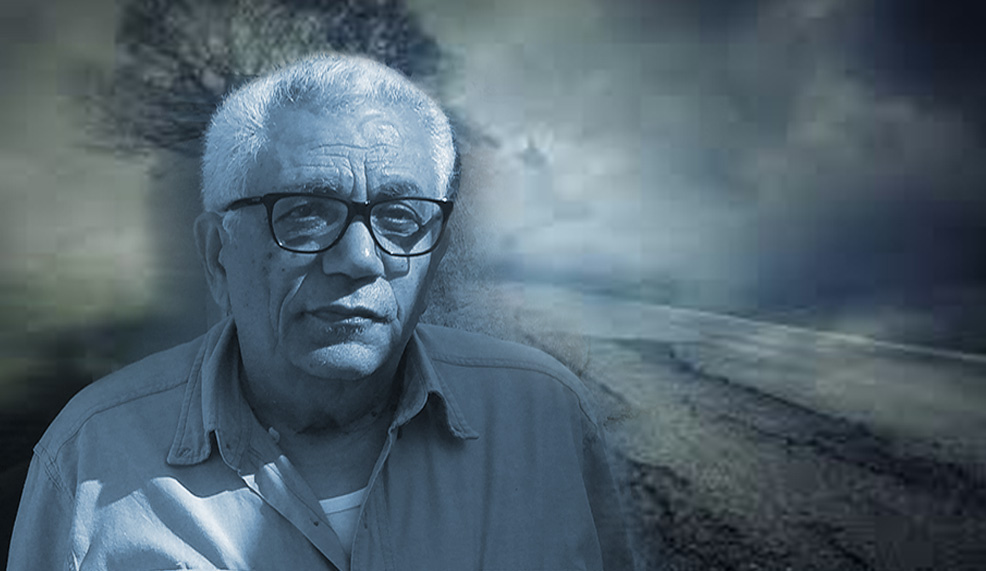








0 تعليق