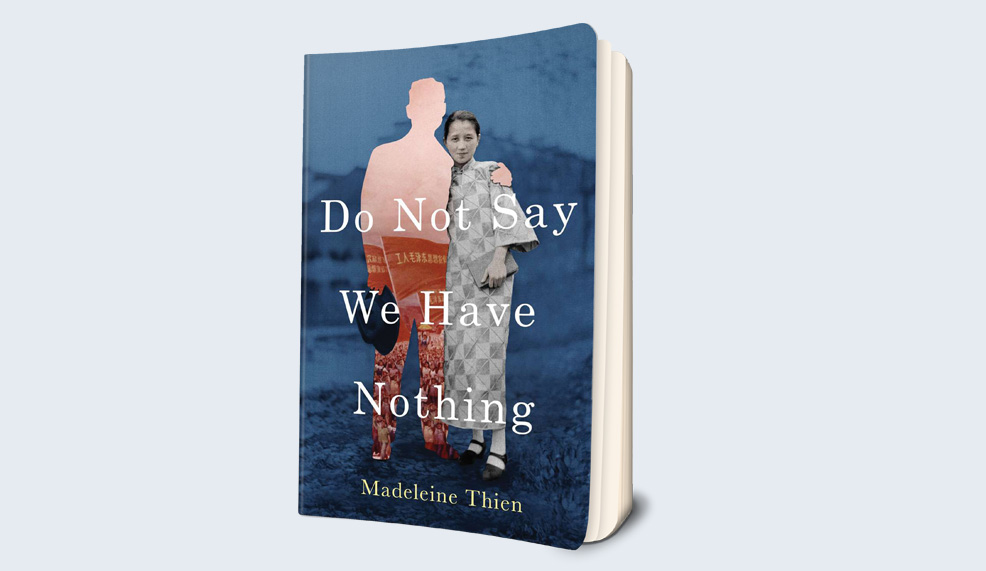علي عبدالأمير صالح - كاتب ومترجم عراقي | سبتمبر 1, 2023 | كتب
لم تكن كتاباتها صيغًا أو قوالب جاهزة، ولا تعبيرات سمجة، ومستهلَكة، ولا فذلكات لغوية صادرة من مؤلفة تلهث وراء الشهرة السريعة، والمجد الزائف، بل هي آثار فذّة نابعة من تأملاتها العميقة في كنه الحياة والوجود والموت، في ماهية الألم والقلق والحب والخذلان والكرامة والحرية والجنون، هي التي عاشت سنواتها الطويلة في انشغالات اجتماعية ووظيفية، وتنقلات بين (بهرز) و(بغداد)، و(عمّان) و(باريس)، و(بيرن)، و(زيورخ)، وعلى صعيد الكتابة تنقلت بين القصة القصيرة والرواية والمسرح والسيرة والمقالة والدراسة والترجمة وسواها.
كنز من الذكريات
تكتب لطفية الدليمي دومًا عن خياراتها الفكرية، ورؤيتها الإحيائية للعالَم؛ لكونها ترى الجمال مرادفًا للحياة والحب والعمل والصدق. كما تكتب عن شغفها بالفنون والآداب، وعن مغامراتها الحياتية والإبداعية، وعذاباتها في الوطن وبلد اللجوء، ناهيك عن مشاهداتها الكثيرة. وحين أقول مشاهداتها، فأنا أعني أن لطفية الدليمي جرّبت أن تعيش في باريس، مرةً، قريبة من مركب آرثر رامبو السكران، ومن أسطوانات أديث بياف ذات الصوت الشجي، ومن وجودية سارتر، وجرأة سيمون دي بوفوار. وخرجت من تلك التجربة بكنز من الذكريات الجريئة والمثيرة. وأنا أعني هنا ما سطّرته في «كراساتي الباريسية».

لطفية الدليمي
سمحت، دومًا، لقلمها أن يتمتع بكامل حريته، وأن ينساب على الورق فيكتب ما يشاء، من دون قيود. فما أحلى أن تتنفس بملء حريتك، وأن تكتب ما يحلو لك، وأن تصرخ تعبيرًا عن استيائك ووجعك، وأن تفكر وتبدع وتتعلّم تقنيات الأمل والفرح، وتزج نفسك في نهر الحياة الشهي، والمتدفق؛ تبتكر نمطك الخاص في العيش، وتقاوم محاولات التدجين، وتكتسب شخصية عصية على التطويع، وترفع عقيرتك بالغناء في زمن كبت الحريات وتحريم البوح العاطفي، حتى الوجد الصوفي، وأن تجعل روحك المفعمة بالعشق والجرأة تحلّق في سماء التمرد والحرية، في الزمن الذي تقيّد فيه السلطاتُ المتنوّعة بكل جبروتها، وشراستها، وعنفها، رِجليكَ، وأرجلَ كلِّ المبدعينَ في العراق، و(العالَم العربي)، ومنها رِجلا (لطفية الدليمي).
لا، لم تشأ هذه السيدة العراقية، ابنة سومر وبابل وأكد وآشور، أن ترسف بقيودها الثقيلة، وتتشكّى، وتندب حظها العاثر؛ لأنه لم تكن ظروفها الحياتية مناسبة تمامًا، بل غالبًا ما كانت مليئة بالمتاعب والآلام. لا، لم تفعل ذلك على الإطلاق. شاءت أن تبتكر، أن تبدع، أن تندفع مرةً وإلى الأبد في فضاء الخيال الذي لا حدود له، وهو، بالطبع، الخيال، الذي يأخذنا إلى النبل، والسمو، والخصوبة.
وعبر كتاباتها السردية لم تشأ أن نلتفت إلى جمال لغتها، ورشاقة أسلوبها، وقوة حبكتها الروائية، وتماسك أحداثها فحسب، بل كانت تريدنا أن نعدّل مفاهيمنا، أن نغيّر طرائق تفكيرنا، أن نتخلّص من كل العقليات المتكلسة التي ظلت تفرض سيطرتها علينا طوال عقود من الزمن. إنها تريدنا أن ندرس الواقع، والحياة، والوجود، بكل ما أوتينا من حرية، وتفتح، وأريحية، وأن نوظف كل إمكاناتنا في الخروج من قوقعة الجمود، وأن نجدد حياتنا، وأن نرتقي ونتطور ونهذب ذائقتنا، ونثري عقولنا، ونحرر أرواحنا ليس من خلال الفلسفة والأدب والشغف بالرسم والموسيقا فقط، بل حتى من خلال العلوم والتقنيات والمستقبليات والذكاء الاصطناعي. وفيما هي تسرد لنا تجاربها الحياتية في كراساتها الباريسية، لم تشأ الدليمي أن تلمع شخصيتها، أو تعدّل ذكرياتها وتزوّقها، بل كانت صادقة مع نفسها، وتركت ذكرياتها تتكلم بكل عنفوانها، وجرأتها، وصدقها، إذا جاز لنا أن نستعير تعبير فلاديمير نابوكوﭪ الذي منح سيرته عنوان «تكلّمي أيتها الذكريات».
ذاكرة استثنائية
يعيش المرء تجربة فريدة وهو يجد نفسه في كل كتاب تؤلفه السيدة لطفية الدليمي إلى درجة التماهي. فالوسادة التي تنام عليها هي الوسادة ذاتها التي سفحنا عليها دموعنا لمّا اكتشفنا الكذب والخداع الذي سوّقه لنا المحتلون، وباعونا لعبة عاطلة لم نستطع تفكيكها، ولا إصلاحها. إضافة إلى أنه سرعان ما يُدرك القارئ أنها تفعل ثلاثة أشياء معًا؛ هي تعيش حياتها، وحياة الآخرين، وفي الوقت نفسه تكتب وتحلم؛ وفي أحلامها تُسائل الواقع القاسي، وتفتش عن مفاتيح الخلاص. وحين تعيش أيامها، فهي في الوقت نفسه تحتج على سقط المتاع الذي يحيطنا، لا تأبه بأن تكون وحيدة في الدرب الذي تسلكه، فما يتأجج في رُوحها من عواطفَ، وما يتوقد في دماغها من أفكار، هي التي تمكنها من اختراع شخصيات ظلّية حميمة، شبيهة بها، بشكل دائم.
ولو لم تتمتع لطفية الدليمي بذاكرة استثنائية لما تمكنت من سرد تجاربها الحياتية، وانكسارات أبناء جيلها، ووصف الدمار الذي لحق ببلادها، جراء الحروب المتتالية، أو الاقتتال الطائفي بعد 2003م. فالسرد المؤثر يتطلب قدرة على جمع الحقائق الضائعة التي نعثر عليها في حياتنا اليومية، إلا أننا قلَّما نلتفت إليها. كانت تتألم وتعاني، وهي تنصت إلى أصوات الرصاص في ليالي الرعب التي تواترت على بغداد بعد الاحتلال الأميركي، وترهف السمع للخطى المريبة في حديقة بيتها الخلفية. تقول في ص43: «أدفن وجهي في الوسائد وأنشج، لا أسمع سوى وجيب قلبي ولا أدرك سوى رجفة جوارحي».
تصف كل شيء جرى لها وللعراقيين إبان تلك الحقبة الزمنية التي تشردوا فيها، وتعذبوا، وانكفؤوا على أنفسهم لائذين بالصمت، كاتمين نشيجهم، لا يفكرون إلا بالحفاظ على أرواحهم، وبما تبقى من صبرهم. تصف هذا بواقعية صادمة كي تنفس عن معاناتها، إلا أنها، على ما نعتقد، أثثت فصول كتابها هذا بالخيال؛ لأنه وحده الذي يسدّ ثغرات ذلك الواقع القاسي، الصارم، ويتغلب على عجزه وضآلته وقصوره؛ لأننا بواسطة الخيال، ومن خلاله، ننتصر على أنفسنا، وهو الذي يمكننا من فتح مسارات ودروب في جدار جهلنا. الخيال هو المَلَكة التي جعلت كل شيء ممكنًا ومتاحًا؛ هو الإرث العظيم الذي ورثته البشرية منذ براءة الأيام الأولى. وها نحن، في هذا الكتاب الشائِقِ نَتعرّف إلى ما في نفوسنا من مخاوفَ، وتطلعات، ومآسٍ. ففي ص 29، تكتب قائلة: «تأتي الكلاب الضالة إلى الحديقة فأجد ذراع رجل وكف طفل، وأسمع استغاثات مروِّعة، وأرى مصيرنا موكولًا لقاتل وكلب وغراب».
صاحبة «سيدات زحل» منحت نفسها كل الحرية في التخيل، وحمت نفسها من السلطات القمعية التي أرادت أن تحرمها من حق الدخول إلى (جمهورية الخيال)، وتصادر جرأتها، واستقلالها، وكرامتها الفردية، والتماهي مع الشخصيات الأدبية والفنية التي أحبتها، وتأثرت بها، ومنها آرثر رامبو، وستندال، وجان كوكتو، وريلكه، ونيتشه، وسيمون دي بوفوار، وسارتر، وهرمان هيسه، وكازنتزاكي. هؤلاء الشعراء والكتاب والفلاسفة هم دعائم أملنا، وهم الذين يحثوننا على الاستمتاع بالشمس، وخضرة المروج، وشدو الطيور، ويحرضوننا دومًا على إزالة البقع المعتمة من أرواحنا، والحفاظ على بذور التمرّد في داخلنا.
العين الثالثة للخيال
وعلى الرغم من أن الكاتبة الدليمي تمتلك ذاكرة مدهشة، فإننا نحسب أن شأنها شأن أغلب الكُتاب، لا تكتب الماضي إلا بقدر كبير من الخيال، فهو الذي يملأ فجواته، يشخّص ما وقع فيه، يبحث عن الدوافع والرغبات التي كانت كامنة فيه وحرّكت تجاربه. يسعفنا التخييل دومًا في بناء ما يتعذر بلوغه، وما لا يُمكن استعادته إلا داخل اللغة ومتخيلاتها، فالماضي برمته ينحل في اللغة، بما أنه «مسكن للكينونة»، كما يقول هايدغر. وبما أن الدليمي تمتلك ذخيرة واسعة من المفردات، لا بل المفردات المعبّرة، والشاعرية، المكتنزة بالمعاني والدلالات كان باستطاعتها أن تطوّعها لتخلق حيزها الخاص، وعالَمها المميز، وتترك بصمتها على كل ما ترويه، وتصفه.
«نحن بحاجة إلى استرداد العين الثالثة للخيال»، هذا ما تقوله آذر نفيسي في كتابها المعنون «جمهورية الخيال». وتضيف هذه الكاتبة الأميركية من أصل إيراني: «إن مهمة الدفاع عن حق الخيال والتفكير الحر هو مسؤولية؛ ليس مسؤولية الكتاب والناشرين فقط، بل مسؤولية القراء، أيضًا».
وفيما تتمشى لطفية الدليمي مرتبكة، وحزينة، وحيدة في متاهات أزقة باريس الضيقة أو شوارعها التي تؤطر أرصفتها المقاهي والضحكات وأشذاء القهوة ورنين الأنخاب يُخيّل إليها أنها تلمح «شبح الكاتبة جورج صاند رفقة عشيقها الموسيقار شوبان، وهما يترجلان من عربة تجرها الخيول، أسمعها تتحدث عن كل ما أصاب فرنسا خلال جنون وقائع (كومونة باريس)، وبعد انحسار جحيمها من إراقة دماء وخراب وثأر ونهب وتدمير مبانٍ وتماثيل ونُصب عظيمة» ص 99.
وهي في كتابها هذا لا تبهرنا فقط بفصول الكتاب المكتوبة بتدفق وانسيابية لافتين، وحسن اختيارها للمفردات، وجمال أسلوبها، ورشاقة عباراتها، وعمق المعاني التي استقتها من تجاربها، وتأملاتها، وقراءاتها، باللغتين العربية والإنجليزية، بل تُبهرنا، أيضًا، بجرأتها الفريدة، وصراحتها الأخاذة، ودفاعها عن الجمال، والأنوثة، والحرية، والعدالة الاجتماعية بعد أن انهارت النظريات والأيديولوجيات، التي ظللنا مخدوعين بها على مدى عقود طويلة من الزمن، وبعد أن انكشفت لعبة المحتلين الغزاة، وباتت وعود الحاكم الطاغية تبعث على الضحك. وها نحن، أخيرًا، نستيقظ من الحلم اللذيذ لكن المُضلِّل الذي ما فتئنا نلهث وراءه كالمغفلين، نجد أنفسنا وسط الخرائب والدمار، نرى بعيوننا أرتال التوابيت تشق طريقها إلى المدافن، وطوابير الأرامل اللائي فتك بأزواجهن أولئك الذين سمموا حياتنا بمفاهيم الكراهية والقتل التي أدخلوها من الأبواب الخلفية للتاريخ. فإذا تعين على العراقيات أن يمتنعن عن لبس الفساتين الهفهافة، المزينة بالدانتيلا، وارتداء الشالات الملونة المزخرفة بالأشعار والرسوم، فكيف يتسنى لهن كبح عواطفهن، وكيف يستطعن أن يتخفين وراء الصمت، ممتثلات للسلطات التي أصدرت أوامر ظالمة بإزاحتهن من المشهد اليومي.
تلك الرحلة الباريسية عرّضت لطفية الدليمي لمأساة إنسانية هائلة، ولم يكن باستطاعتها أن تُرغم نفسها كي تكون متفائلة؛ لأنها عانت مكابدات اللجوء، وتعين عليها في بحر عامين أن تنام تحت 45 سقفًا، في منازل وفنادق جيدة ورديئة، وفي غُرَف مستأجرة وشقق معتمة، في عمارات بلا مصاعد، وفي منازل أبناء وصديقات. وفي الوقت نفسه لم يكن باستطاعتها أن تقتلع بلادها من ذاكرتها. وهي ذي عالقة الآن بين عالَمين؛ عالم البلد الذي لجأت إليه، والعالم الذي احتضن طفولتها، وشبابها، وبدايات تكوينها، وتمرّدها.
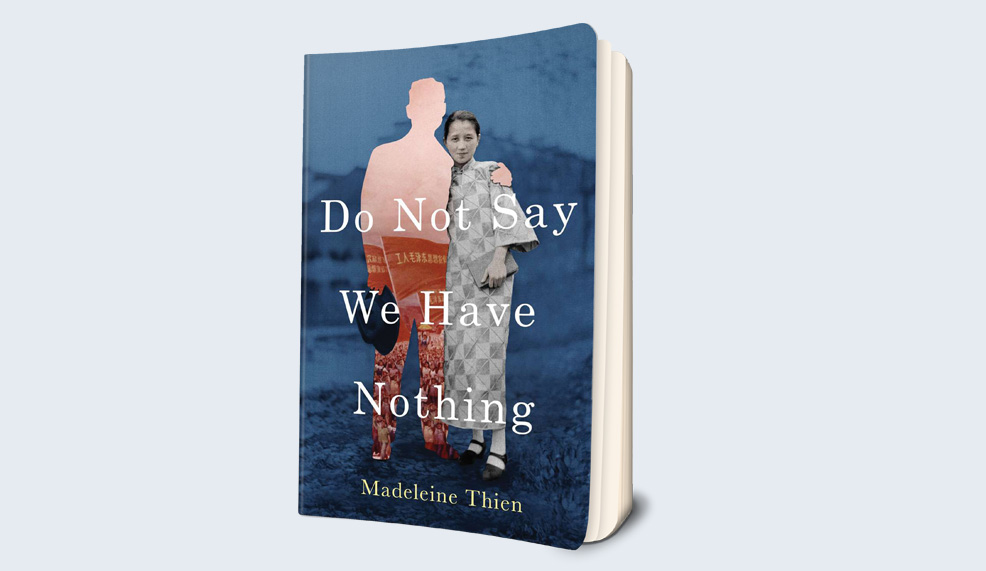
علي عبدالأمير صالح - كاتب ومترجم عراقي | نوفمبر 1, 2018 | كتب
«في عامٍ واحد، غادرنا أبي مرتين. في المرة الأولى، كي يضع نهايةً لزواجه، وفي الثانية، حين انتحر. يومذاك، كنتُ في سن العاشرة» في روايتها المعنونة «لا تقولوا إننا لا نملك شيئًا»، الصادرة في عام 2016م، تأخذنا الكاتبة الصينية الكندية مادلين ثين إلى داخل أسرة كثيرة الأفراد في الصين، وترينا حيوات جيلين متعاقبين – أولئك الذين عاشوا في أثناء «الثورة الثقافية» التي أطلقها ماو تسي تونغ في عام 1966م ودامت عشرة أعوام، وأولادهم، الذين أصبحوا طلبة جامعيين محتجين في «ساحة تيانانمين» في قلب العاصمة بكين. في لب هذه الرواية الملحمية ثمة شابتان: ماري جيانغ «جيانغ لي – لينغ» وأي – مينغ.
من خلال العلاقة المتبادلة بينهما تسعى ماري جيانغ إلى جمع أجزاء حكاية أسرتها الممزقة في فانكوفر يومنا الحاضر، باحثةً عن أجوبة في الطبقات الهشة لقصتهم الجماعية. يكشف مسعاها هذا النقاب عن كيف أن كاي، أباها المُبهم، جيانغ كاي، وهو عازف بيانو موهوب، ووالد أي – مينغ؛ سبارو، المؤلف الموسيقي الخجول واللامع، إضافة إلى تسهولي، معجزة الكمان، كانوا مرغمين على أن يتخيلوا من جديد ذواتهم الفنية والشخصية إبان الحملات السياسية في الصين وكيف أن مصائرهم تتردد عبر الأعوام بعواقب ثابتة. برعتْ ثين في تدوين رواية على قدرٍ كبير من النضج والتعقيد، الفكاهة والجمال، رواية هي في آنٍ حميمية وسياسية بنحوٍ كبير، مدتْ جذورها في تفاصيل الحياة بالصين لكنها استثنائيةً في كونيتها.
ومما يلفت القارئ والناقد الأدبي هو قوة الحبكة ومتانة الأسلوب ورقة الكلمات وشاعريتها بحيث إن المتلقي لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يلتهم صفحات هذه الرواية الأخاذة، فنرى الكاتبة تقفز من زمنٍ إلى زمن في لعبة سردية ذكية؛ إذ يتنقل الروي بحرية بين الماضي والحاضر، تارةً للأمام، وطورًا للوراء. وفي صفحات هذا الأثر الروائي المهم تُعرّفنا ثين موسيقا بتهوفن وباخ وشوستاكوفيتش وكثير من الموسيقيين الغربيين، والإرثَ الأدبيَّ والفكريَّ والفنيَّ للكُتاب والفلاسفة والرسامين والموسيقيين الصينيين منذ زمن السلالات الحاكمة والاحتلال الياباني حتى يومنا الحاضر. نتعرّف آلاتٍ موسيقيةً صينيةً لم نسمعْ عنها من قبلُ، ولا يفوت الكاتبة أن تصف لنا درجات السلالم وطرائق العزف والأحاسيس التي ترافق الاستماع للألحان والمؤَلفات الموسيقية؛ وهذا بالطبع لم يأتِ من الفراغ، على نحو ما يقول اليونانيون، بل من خلال دراسة عميقة، متخصصة؛ لأن كاتبتنا درست الموسيقا والباليه قبل شروعها في الكتابة الإبداعية. نعم، حازتْ ثين شهادةَ البكالوريوسِ في الرقص المعاصر من «جامعة سيمون فريزر» قبل نيلها شهادة الماجستير في الكتابة الإبداعية من «جامعة كولومبيا البريطانية»، بعد حصولها على منحة دراسية.

مادلين ثين
وفضلًا عن ذلك، لا يفوت القارئ اللبيب أن ينتبه إلى أن الكاتبة تعمدتْ أن تتخذ روايتها هذه بنية مؤلَّف موسيقيّ، فالجزء الثاني من الرواية سمّته المؤلفة «الفصل صفر»، وهو يتكوّن من سبعة أجزاء على غرار درجات السلَّم الموسيقي السبع، وفي نهاية الكتاب تضع لنا الخاتمة التي سمّتها: «التقفيلة»، وهي المقطع الختامي من اللحن الموسيقي. وهذه إشارة واضحة إلى أن الكاتبة تريدنا أن نتلقى أو نتذوق عملها الروائي بوصفه مؤلَّفًا موسيقيًّا حاله حال تلك المؤلَّفات التي أبدعها الموسيقيون الأثيرون لديها من أمثال: باخ، ودميتري شوستاكوفيتش، وليونارد كوهين، وغلين غولد، وسواهم. ولِمَ لا، وهي التي مَوْسَقتْ كلماتها ووفرتْ لنا متعةً ما بعدها متعة حين أخذتنا إلى عالمها المشحون بالعواطف الجياشة، وكدنا نذرف الدموع ونحن نقرأ بشغف ما دوَّنه قلمها الذهبي. اقرؤوا معي هذه الكلمات الجميلة التي تتحدث فيها مادلين ثين عن بطلها الشاعر وِين الحالم: «كل شيء في الجو هو زوجته الحبيبة، سويرل، السماء الفيروزية، الرمل الذي يومض كالنجوم، نور الشمس الذي يلامس جلودنا». الزوجان وِين الحالم وسويرل، لم يعودا يعيشان معًا. لقد تقاذفتهما حملات الرئيس ماو يَمْنةً ويَسْرةً، ولم يتمكنا من العيش معًا، وتعيَّن عليهما أن يقضيا شطرًا كبيرًا من حياتيهما في الصحراء. وها هم المدانون يكابدون ظروفًا قاسيةً بسبب جرائم لم يرتكبوها بل لُفقتْ ضدهم زورًا وبهتانًا. دعونا نقرأ السطور الآتية: «كانوا قد نقلوني في عربة خفيفة ذات دولابين يجرها حصان إلى جيابانغو. على مدى أشهر، رفضتُ أن أصدق أنني حللتُ هناك. رجالٌ جريمتهم الوحيدة هي الانتقاد النزيه، كانوا يحفرون الخنادق ويصيبهم الهزال. في أثناء تلك الحقبة، هناك في ديارهم، كانت أُسَرُهم تُقِيم في أمكنةٍ مخزية، كان أطفالهم يُعامَلون بازدراء في المدارس أو يُطردون منها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، صُودرتْ بيوتهم، رُميتْ ممتلكاتهم في الزبالة، أُرغمتْ زوجاتهم على التسول في الشوارع، على إفراغ المراحيض العمومية والإبلاغ عن أزواجهن. كنا قادرين على الاحتجاج مطالبين بكل ما نريده إنما ذلك لا فائدة منه. أخبرنا الحراس أننا محظوظون، ليس لأننا فقط استثنينا من الإعدام، بل لأن ثمة سقوفًا فوق رؤوسنا وأحذيةً في أقدامنا».
سَلَّطتْ مادلين ثين في روايتها هذه الضوءَ على حقبةٍ مظلمةٍ من تاريخ الصين المعاصر حيث قوبلت نتاجات الموسيقيين والكتاب الصينيين بالشك وتعرّضتْ لأقسى أنواع العنف الفكري، وهو الأمر الذي يذكّرنا بما تعرّض له المثقفون والكتاب في بقاع شتى من العالم، من مثل سولجينتسين وباسترناك في الاتحاد السوفييتي السابق، وما عاناه نظراؤهم في أثناء الحملة المكارثية في أميركا في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، حينما كان يجري البحث عن أي دلائل تشير إلى اعتناق الكتاب وكتاب السيناريو والمخرجين والممثلين السينمائيين أفكارًا شيوعية وُصفتْ بأنها «نشاط معاد للمصالح الأميركية». وهذا هو ما عرضه لنا راي برادبري في روايته الشهيرة «451 فهرنهايت»، وللعلم نقول: إن درجة الحرارة هذه هي درجة الحرارة التي تحترق عندها الكتبُ.
على النحو نفسه، ضاعتْ كثير من إبداعات الأدباء والفنانين ومنهم الموسيقيون إبان «الثورة الثقافية» في الصين، حيث تحدثنا الروائية الصينية الكندية كيف أن «المعهد العالي للموسيقا في شنغهاي» قد أُغلق في عام 1966م، في أثناء تلك «الثورة» المقيتة، ودُمرتْ جميع البيانوات الخمسمئة الموجودة فيه ويُجبر سبارو، أحد المؤلفين الموسيقيين المشهورين آنذاك على العمل في «معمل تصنيع الصناديق الخشبية»، ومن ثم في «معمل لصناعة الأسلاك الكهربائية» وبعدها في «معمل لصناعة أجهزة الراديو». ويستمر ذلك عشرين عامًا، يبتعد فيها من شغفه، مرغمًا على الصمت والعزلة ويهيمن عليه الشعور بالحزن والحسرة على ضياع موهبته في زمن يُجبر فيه أبناء الشعب على أن يكونوا كما أراد لهم الحزب، فهو الذي يصوغ حيواتهم كما يشاء، ويُقَوْلِبهم كما يشاء، ويزُجُّهم في السجون بسبب «جرائم سياسية مفبرَكة».
يقول أحد شخوص الرواية: «أعطانا الرئيس ماو طريقةً واحدةً للنظر إلى العالم، وهكذا فعل ماركس وإنجلز ولينين. جميع الشعراء والكتاب، جميع الفلاسفة. كانوا يتفقون على المشاكل لكنهم لم يتفقوا على الحلول»، وفي الصين، إبان «الثورة الثقافية»، كان الناس يخفون الأشياء، أو يبدعونها سرًّا، أو يستفيدون من الفنون المتاحة لديهم كي يصقلوا براعاتهم اليدوية ومهاراتهم، بحيث إنه فيما بعد، حين يتوافر لديهم نوعٌ مختلف من حرية التعبير، تكون بحوزتهم القدرة التقنية على العمل وفقًا لما تشاء أخيلتهم. فإذا كان النظام، أو الأيديولوجيا، أو المكان يريدك أن تختفي، فإن العيش والإبداع هو شكل من أشكال المقاومة، وبخاصةٍ، إنْ كنتَ تقوم بذلك بعزٍّ وكرامة. وللفن القدرة على قول أشياء كثيرة، وعلى تمويه الأفكار وأساليب الكينونة.
تؤرخ لنا مادلين بلغةٍ رشيقةٍ وأسلوب جميل ما وقع في أثناء تلك الحقبة الحاسمة في تاريخ الصين. تكتب ثين: تسرد أي – مينغ، إحدى الشخصيات الرئيسة في روايتنا هذه على مسمع صديقتها ماري جيانغ، فتقول الأخيرة: «روتْ لي عن تلك الأيام، والليالي حينما أقبل إلى «الساحة» أكثر من مليون إنسان. بدأ الطلبة إضرابًا عن الطعام استمر سبعة أيام وأي – مينغ نفسها أمضتْ الليالي على الأسمنت المسلَّح، نائمةً بجوار أفضل صديقاتها، ييوين. جلستا في العراء، لا يوجد تقريبًا شيء يحميهما من الشمس أو المطر. إبان تلك الأسابيع الستة من المظاهرات، شعرتْ أنها بالفعل في وطنها الصين؛ فهمتْ، لأول مرة في حياتها، أنها فهمتْ، ما هو شعورها حين تنظر إلى وطنها من خلال عينيها هي وتاريخها هي، أن تصبح واعيةً أسوةً بملايين البشر سواها. لا تريد أن تكون هي نفسها نهرًا راكدًا، كانت تريد أن تكون جزءًا من المحيط الهادر. لكنها لا تريد الرجوع الآن، قالت لي. حين مات أبوها، كانت قد طُردتْ من بلدها. هي، أيضًا، فارقت الحياة».
أبدعت لنا مادلين ثين روايةً عابقةً بالمرارة، والألم، واللوعة، والقنوط، والغضب، عن «جمهورية الصين الشعبية»، في «زمن الزهو»، و«الانتصارات الكبرى»، و«الوطن الاشتراكي»، و«الزعيم المحبوب»، «ربان السفينة» الذي سيقود بلاده وشعبه إلى الرخاء والعيش الرغيد، كما كان يزعم.

علي عبدالأمير صالح - كاتب ومترجم عراقي | مارس 1, 2018 | ثقافات
يُعدُّ الكاتب الكوري الجنوبي هوانغ سوك – يونغ واحدًا من أكثر الكتاب الآسيويين شهرةً في عالمنا المعاصر. وهو فضلًا عن موهبته الأدبية، ناشط لا يعرف الكلل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. حُكم عليه بالسجن في كوريا الجنوبية؛ بسبب خرقه «قانون الأمن الوطني»، بعد أن قام برحلاتٍ غير مخوَّلة إلى كوريا الشمالية. كان هدفه من تلك الزيارة تعزيز الانفتاح بين الكوريتين ودعمه. وطوال مسيرته الأدبية والحياتية، كان هوانغ يدافع دفاعًا قويًّا من أجل علاقاتٍ أفضل بين حكومتيْ بيونغ يانغ وسول.
حصل هوانغ على أفضل الجوائز الأدبية وأرفعها في كوريا الجنوبية، كما رُشِّح للقائمة القصيرة لجائزة Femina Etranger Prix الأدبية الفرنسية، الرفيعة المستوى، الخاصة بالكُتاب الأجانب. ولد هوانغ سوك – يونغ في تشانغ تشوان، منشوريا في الرابع من يناير عام 1943م، خلال حقبة الحكم الياباني. بعد التحرر من الاحتلال الياباني، انتقل إلى مسقط رأس أمه بيونغ يانغ، وسكن هناك مع أقارب أمه. في عام 1947م انتقلتْ أسرته إلى «الجنوب» ونشأ في يوونغ ديونغبو. ترك هوانغ مدرسة «كيونغ بوك» الثانوية في عام 1962م، وابتعد من المنزل كي يتجول في الأقاليم الجنوبية. عاد إلى المنزل في أكتوبر، وفي نوفمبر تلك السنة حاز جائزة «المؤلف الجديد الأدبية» التي تمنحها مجلة «ساسانغغي» عن قصته القصيرة المعنونة «بالقرب من حجر الوَسم». عاش هوانغ حياته متنقلًا من مكانٍ إلى آخر بحثًا عن عمل، وزاول العمل اليدوي والمهن المتعلقة بالمعبد حتى عام 1970م حين فازتْ قصته القصيرة «الباغودة» في «مسابقة جوسون إلبو الخاصة بالكاتب الجديد»، وبدأ مسيرته الأدبية بشكل جاد. وشارك في حرب فييتنام. وفي عقد السبعينيات من القرن العشرين، نشر هوانغ سوك – يونع سلسلةً متصلةً من الأعمال الأدبية أصبحتْ ذائعة الصيت فيما بعد، من مثل «بعيدًا من المنزل»، و«تاريخ السيد هان»، و«الطريق إلى سامبو»، و«حلم بالحظ الوافر»، وأصبح مؤلفًا من الطراز الأول في العالم الأدبي الكوري. وفي أثناء عقد السبعينيات انهمك في العمل السري لدى «مجمع غورو الصناعي»، وساهم في حركة المقاومة من خلال عضويته في «جمعية الكتاب من أجل الحرية المتحققة» فيما كان يدبج روايته الملحمية «جانغ غلسان».
في ثمانينيات القرن المنصرم أكمل روايته «ظل الأسلحة» التي سلَّطتِ الضوء على نظام العالم الرأسمالي في أثناء حرب فييتنام. فعل هذا كله فيما كان يعمل بلا كلل من أجل تنظيم القتال الساعي إلى نشر الحقيقة المتعلقة بـ«حركة دمقرطة غوانغ جو» إضافة إلى مجموعة متنوّعة من حركات المقاومة الأخرى. بعد أن زار هوانغ «كوريا الشمالية» في مارس 1989م، لم يعد قادرًا على العودة إلى كوريا الجنوبية وطلب اللجوء بوصفه مؤلفًا زائرًا في «أكاديمية برلين للفنون». في عام 1991م واصل حياة المنفى في نيويورك. وبعد عودته إلى كوريا الجنوبية في عام 1993م، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وأُطلق سراحه في عام 1998م، بعد مضي خمس سنوات. وعقب ذلك، أظهر سنةً بعد سنة أن روحه الخلاقة لن تموت من خلال نشره لعدد من الآثار الأدبية: «الحديقة القديمة» (2000م)، و«الضيف» (2001م)، و«شيم تشيونغ» (2003م)، و«الأميرة باري» (2007م)، و«نجمة المساء» (2008م)، و«حلم غانغنام» (2010م)، و«أشياء مألوفة» (2011م)، و«خرير الماء الشحيح» (2012م)، و«الغسق» (2015م). مُنح هوانغ جائزة «مانهيي للأدب»، وجائزة «لي سان للأدب»، وجائزة «ديسان الأدبية»، وجوائز أخرى سواها. آثار هوانغ الرئيسة تُرجمتْ ونُشرتْ في أنحاء العالم، ومن بين هذه البلدان: فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والسويد.
حلم أن يصبح كاتبًا
حصل هوانغ على شهادة البكالوريوس في الفلسفة من «جامعة دونغغوك»، وكان قارئًا نهمًا وراوده حلم أن يصبح كاتبًا منذ سنوات صباه. يقول في إحدى المناسبات: «في السنة الرابعة من دراستي الابتدائية، كتبتُ شيئًا ما لـدرس الكتابة الإبداعية. واختيرت كتابتي لدخول المسابقة الوطنية، ونلتُ الجائزة الأولى. كانت قصة عن شخصٍ ما يعود إلى منزله بعد فراره إلى «الجنوب» إبان الحرب الكورية؛ كان عنوانها «يوم العودة إلى المنزل». بعد رجوعه إلى منزله، يجد بطل القصة أن قريته بأسرها تحولتْ إلى أنقاض في أعقاب الدمار الذي لحق بها في أثناء الحرب. كانت قصتي تصف وقتًا ما بعد الظهر الذي أمضاه وهو يصنف الأطباق وحاجيات الأسرة في منزله. كانت تلك هي أول مرة أتلقى فيها مديحًا من المجتمع الأوسع، وقررتُ أنني حين أكبر، بدلًا من أن أكون رجل إطفاء أو جنديًّا، سأكون [كاتبًا]، على الرغم من أنني لم أكنْ متيقنًا تمامًا ما معنى ذلك. أعتقد أن الكتابة شيء تفعله بمؤخرتك؛ لأنه يتعين عليكَ أن تقضي وقتًا طويلًا جالسًا إلى طاولة الكتابة».
الواقع، أعادت الجملتان الأخيرتان إلى ذاكرتي ما قاله أورهان باموق، الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 2006م، حين قال: «أجلس ساعاتٍ طويلةً إلى طاولة الكتابة، حتى كادتْ الطاولة أن تصبح جزءًا من جسمي». كتب هوانغ سوك – يونغ للمسرح، وقُتل عدد من أعضاء الفرقة المسرحية حينما كانوا يمثلون في إحدى مسرحياته في أثناء انتفاضة كوانغ جو في عام 1980م. خلال هذه المدة الزمنية، انتقل هوانغ من كونه كاتبًا ملتزمًا سياسيًّا يحترمه الطلبة والمثقفون، إلى الإسهام المباشر في النضال. يقول: «حاربتُ ضد دكتاتورية بارك تشونغ – هِي. عملتُ في المصانع والحقول في تشولا، واشتركتُ في الحركات الجماهيرية في أنحاء الوطن… في عام 1980م اشتركتُ في انتفاضة كوانغ جو. ارتجلتُ المسرحيات، كتبتُ كراسات وأغاني، نسّقتُ مجموعةً من الكتاب ضد الدكتاتورية، وأسستُ محطة إذاعية سرية تحمل عنوان «صوت كوانغ جو الحرة». وعن عودته إلى سول في عام 1993م بعد منفاه الاختياري، يقول الكاتب الكوري الجنوبي: «يتعيّن على الكاتب أن يقيم في بلد لغته الأم». وخلال الأعوام الخمسة التي قضاها في السجن قاد ثمانية عشر إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على القيود ومنها منع تزويدهم بأقلام الحبر والتغذية غير الكافية. منظمات كثيرة في بلدان العالم المختلفة، من بينها منظمة «قلم» الأميركية ومنظمة «العفو» الدولية حشدتْ جهودها من أجل إطلاق سراحه، وفي عام 1998م أُخلي سبيله خلال عفو عام جماعي قضى به رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا آنذاك كيم – دايي – جونغ.
يعرّف هوانغ الواقع الكوري بوصفه «حالة تشرد على المستوى الوطني»، وبشكل مستمر كان يكشف سيكولوجية الناس الذين فقدوا «وطنهم»، الرمزي أو الحقيقي. الوطن في نظر يونغ ليس، ببساطة، مكانًا يولد فيها الناس ويترعرعون بل هو حياة مجتمع تضرب جذورها في الشعور بالتضامن. هذه الفكرة المتعلقة بـ«الوطن» هي أيضًا أساس لمحاولة هوانغ في كشف التناقضات الاجتماعية من خلال الأشخاص الهامشيين والأجانب. نزعات هوانغ الأدبية ترتبط ارتباطًا قويًّا بتجاربه الشخصية. «من أجل الأخ الصغير» (1972م)، و«ضوء الفجر الكاذب» (1973م)، و«علاقة مشبوبة العاطفة» (1988م)، هي قصص تدور حول مراهقة الكاتب، التي تتناول موضوعات من مثل رفض أحد الأبوين، وكراهية التنافس، والشعور بالإنسانية والتضامن اللذين يتقاسمهما الناس في هامش المجتمع.
يمكننا أن نقسم منجز هوانغ الأدبي ثلاثة أصناف: الصنف الأول يتعامل مع فقدان الإنسانية والخراب اللذين طالا الحياة بسبب التحديث، والحرب، والنظام العسكري. الصنف الثاني يعبّر عن الرغبة في العودة إلى حياة صحية وإنعاش القيم المتضررة. أما الصنف الثالث فهو الذي يشمل الرواية التاريخية.
بطلة النساء جميعًا
ثمة أشباح، وشامانات، وأرواح وأشباح أطفال ماتوا إثر إصابتهم بالتيفوئيد. الكلب هندونغي يسلك سلوك البشر. ثمة ساحرات، وعفاريت ومعابد مظلمة. تتحدث باري بنحو تخاطري مع تشيلسونغ، الجرو، ومع شقيقتها الصماء الخرساء التي تكبرها سنًّا. يمكنها أن تتكلم مع أقاربها الأموات. يمكنها أن تقرأ صحة زبونها أو زبونتها من خلال النظر إلى النقاط الوسطية المستخدمة في الوخز بالإبر في كعبَيِ القدمين، تلمع هنا وهناك بألوان مختلفة، بحسب المرض. بوسعها أن تقرأ الأرواح، بوسعها معالجة الأرواح. في سجلات الشامانية(*) الكورية، حكاية «الأميرة باري» هي حكاية «الأميرة المهجورة ». هي الطفلة السابعة والأخيرة للملك، ملك ليس لديه أولاد ذكور. الإلهة الشامانية، «الأميرة باري»، هُجِّرتْ عند الولادة لأنها أنثى. تسافر إلى العالم السفلي كي تبحث عن إكسير الحياة، وتولد ثانيةً في عالم جديد. كانت قد تحولت إلى إلهة، على غرار النوتي شارون عبر «نهر ستيكس»، تحمل الأرواح إلى العالم السفلي. إن مصير «الأميرة باري»، شبيه بمصير كثير من النساء عبر التاريخ: يتعذبن ويُتوقع أن يقمن بـ«الشيء المناسب». كثير من النسوة من أمثال «الأميرة باري» في عالمنا يتعذبن بسبب أفعال آبائهن وآمالهم، وعليهن أن يضحين لأن المجتمع لا يهبهن الحرية، ولا فضاءً يتحركن فيه. يتعذبن في الفخ الذي نصبه المجتمع لهن، ويُجبرن على أن يكنَّ مخلصات، جريئات أو حليمات. تهب باري حياتها الخاصة من أجل حياة الملك، بالضبط مثلما يريد الآباء من نسائهم. «الأميرة باري» هي بطلة النساء جميعًا: إنها تضحي وتتعذب كي تتغلب على القيود الدنيوية وكي تصبح إنسانةً خارقة. إنها تداوي العالم. وبوسعها أيضًا أن تتحدث مع الكلاب، وهذا شيء ممتاز وظريف.
مستندًا على هذا الأساس ما قبل البوذي العميق للأسطورة والحكاية، ينسج هوانغ حكايةً جميلةً، ممتعةً جدًّا، ومكتوبةً بعناية تأخذ بطلتنا، هي نفسها الطفلة السابعة، في رحلةٍ حول العالم. من «كوريا الشمالية»، أي البلد الدكتاتوري، الذي يمتاز بالقمع والاضطهاد، البلد الفقير والجائع، إلى البراري المنشورية للصين الحديثة في «جِيلين»، إلى مدينة – ميناء داليان ذائعة الصيت الواقعة في لياوننغ – يُقال: إن داليان هو أجمل الموانئ الطبيعية في شرق آسيا – ووراء المحيط صوب لندن، إنجلترا. تكبر باري كإنسانة تتعلم كيف تحب بإحساس لطيف، إحساس الجدة، وتداوي جروح العالم. هي نفسها، بوصفها رائية أو شامانية، يمكنها أن تقرأ أمراض الناس وتفهم ما هو الشيء الخطأ الذي حصل لهم، وتساعدهم على الشفاء. وخلال بحثها عن إكسير الحياة، تعثر عليه وتشفي جروحنا.
وفضلًا عن كل ما تقدم، لا يفوتنا أن ننتبه للأفق الإنساني العميق الذي يتجلى لنا ونحن نقرأ هذه الرواية، بحيث إننا لا نملك سوى أن نتعاطف مع بطلتها «باري» وهي التي مرتْ بظروفٍ غاية في القسوة؛ تفرُّق أفراد أسرتها، وفقدان جدتها التي كانت تروي لها الحكايات، فأرغمتها نوائب الدهر على التنقل بين المدن والقارات، عبرت الأنهر، وركبت السفن، وتعرّضتْ للقمع والابتزاز والاغتصاب والاحتيال، ونامت مع رجال غلاظ، ومقززين، لكنها ظلتْ تحلم بالماء الواهب للحياة، هذا الماء هو الذي سينقذ البشرية جمعاء من الآثار المدمِّرة للعولمة، التي كثفها الانفصال والصراع. وما نقصده بالانفصال هو رسم الحدود بين الدول والأمم، والقوميات، التي بدلًا من أن يسودها التعايش والمحبة والتسامح والتضامن، أخذت تتقاتل وتحتلّ كل أمة أرض الأمة الأخرى، وراحت تنهب ثرواتها، وتنتهك أعراضها، وتسلبها حقوقها الإنسانية وكرامتها، وتجهض أحلامها المشروعة، وتدمر مستقبلها وآمالها في العيش الرغيد.
نعم، في أثناء الرواية، وتحديدًا في الحوارات بين شخصياتها المتعددة الجنسيات نعثر على مشاعر التضامن والتسامح والمحبة والأخوَّة والإصرار على العيش على الرغم من الحروب البربرية وسياسة التجويع وغطرسة الجنرالات. يقول الجد عبدول، وهو إحدى شخصيات الرواية لـ باري: «لا أعرف ما هو هذا الماء الواهب للحياة الذي تتمنين الحصول عليه، إنما علينا أن يبكي أحدنا على الآخر حتى ننقذ أنفسنا. مهما تكنِ الأشياء التي نمر بها فظيعةً، فلا يمكننا أن نتخلى عن أملنا في العالم أو في الآخرين. «والحق، لا يمكننا أن نقصر الرواية على موضوع مركزي محدد؛ لأن هذا العمل الأدبي يرصد بامتياز أهم المشاكل التي يواجهها الإنسان المعاصر: التحديث، واللجوء، والهجرة غير الشرعية، والاغتراب، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها، والإرهاب، والظلم، وغياب العدالة، والجوع، والبطالة، وعدم تكافؤ الفرص، وتشتت الأسر وابتعاد الأولاد من أوطانهم الأصلية الحقيقية والرمزية، ومصادرة الحريات بشتى أنواعها، وقسوة الحروب وآثارها المدمِّرة، والظلم الذي تتعرض له النساء في المجتمعات الآسيوية، ومنها المجتمعات المحافظة والمتشددة. «لكن كلما جاء ذكر موضوع أوطاننا الأصلية، كان يبدو أنه، دومًا، ينتهي بالقتال والمجاعة والمرض والجنرالات القساة، المرعبين القابضين على السلطة. كان لا يزال هناك كثير جدًّا من البشر يموتون في كل زاوية من زوايا العالم، والبشر يعبرون حدودًا لا نهاية لها بحثًا عن الطعام، لمجرد أن يكون بمستطاعهم أن يعيشوا من دون التهديد المستمر للموت».

كازو إيشيغورو
سفينة رمادية
لقد جمع الكاتب الكوري الجنوبي هوانغ سوك – يونغ حشدًا هائلًا من البشر في سفينة رمادية: «محملة ببشر من كل الأشكال والألوان، هم لاجئون بأسمال رثة، أمي وشقيقاتي، أشخاص من شتى بقاع العالم عانوا الجوعَ، عُذِّبوا، اضطهدوا أو ضُربوا حتى الموت، قُصفوا بالقنابل، أُحرقوا، أُغرقوا، عانوا أمراضًا لا علاج لها أو فارقوا الحياة بسبب قلوبٍ كسيرة». وفي روايتنا هذه شخصيات تنتمي إلى كوريا، والصين، وبنغلادش، وباكستان، وفييتنام، ونيجيريا، وبريطانيا، وتايلاند. وكان الكاتب يلمِّح بين الحين والآخر إلى أن البشر سواسية، ولا توجد اختلافات جوهرية بين شعب وآخر، أو بين أمة وأخرى. ويتساءل أيضًا: لماذا يتعين علينا أن نملك حدودًا بين دولةٍ وأخرى؟ ولماذا لا يكون العالم على غرار المبنى السكني الذي يجتمع فيه أناسٌ من جنسيات شتى تنتمي إلى زوايا العالم كافة؟
يتساءل أبطال الرواية عن السبب الذي يجعلهم يعانون ويتعذبون. لماذا هم موجودون على ظهر سفينة تمخر بحر الدم؟ «لماذا نحن هنا؟» ويسأل رجل غير مألوف مع قنابل يدوية مربوطة بحزامٍ إلى صدره عن مغزى موته؟ ومن وراء نسيج يغطي وجهها وتتمتم امرأةٌ مجللة ببرقع: ماذا يعني موتي أنا أيضًا؟ وعلى الرغم مما تخبر به شخصيات الرواية، ثمة جذوة الأمل الذي لا ينطفئ، وثمة حكمة ودفء إنساني يمنعنا التهور وانتهاك حقوق الآخرين والاعتداء على خصوصياتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. تقول باري: «لماذا يواصل الله تعذيبي؟ لم أقترفْ أيَّ شيء خطأ. ما الاختلاف عندما يكون المرء مؤمنًا ولديه دين؟» فيرد عليها الجد عبدول: «الله يراقبنا، لكنه لا يتدخل في حياتنا. ليس له لون، ولا شكل، وهو لا يقهقه أو يبكي، وهو لا ينام ولا ينسى، ليس له بداية ولا نهاية، لكنه موجود هناك على الدوام. الوجع والعذاب هما نتيجتا أشياء خطأ ارتكبتها أيدينا من قبل. إن غرض الأشياء الجيدة والسيئة في الحياة هي أن تعلّمنا أن نغدو أناسًا أفضل، ولهذا السبب عليكِ أن تتغلبي على هذه المصاعب وأن تقدّري جمال الحياة. هذا هو ما يريده الله منا. سارعي، إذًا، وكُلي شيئًا ما واستعيدي قوتكِ!»
وها هو ذا يحدثنا عن الحنين إلى مسقط الرأس، والمنزل الأول الذي حدثنا عنه كثير من الشعراء والكتاب، العرب والعالميين: «في اليوم الذي رحلتْ فيه أمي وشقيقاتي تنحيتُ جانبًا ورفضتُ البكاء. كانت كل واحدة منهن تحمل رزمةً صغيرة من المؤن. وفيما كن يمضين في طريقهن واصلن النظر للوراء. كنَّ يتطلعن إلينا، بالطبع، لكنهن أيضًا، على الأرجح، كنَّ ينقشن صورة بيتنا المحبوب في أذهانهن. ما من واحدةٍ منا كانت تعرف أن هذه هي آخر مرة ترى كل واحدة منا الأخرى. في لحظةٍ ما بدأن يظهرن في أحلامي. كل واحدة منهن كانت تقف بجانب الأخرى: أمي، سووك، وجونغ، يتطلَّعن إليَّ من مسافةٍ ما، يبتسمن برقة ولطف ولا ينطقن بكلمة واحدة. ربما كانت هذه أشباحهن» وهذه السطور تطفح باللوعة والحنين والحزن، وهي تكتظ بهذه الأحاسيس التي لا يشعر بها إلا من غادر منزله، مسقط رأسه، مدينته قسرًا، غادرها من دون رجعة وإلى الأبد، وتدمع عيناه كلما يأتي ذكر الوطن الذي تنخره الأزمات والمصاعب، لكنه يظل عزيزًا، أثيرًا على القلب على الرغم من كل شيء.
غطرسة الأقوياء ويأس الفقراء
في نهاية الرواية، يرسم لنا الكاتب الآسيوي اللامع هوانغ سوك – يونغ صورةً بانورامية لما آل إليه عالمنا المعاصر بعد بدء الحرب على أفغانستان، وازدياد حدة التطرف وضيق الأفق وتنامي أعداد الإرهابيين في بقاع العالم كافة، «الغضب هو الجحيم الذي صنعناه بأيدينا نحن»، وهذا الغضب نفسه هو الذي أجج مشاعر الكراهية بين المسلمين المتطرفين وسواهم من الديانات الأخرى، وهو الذي حدا بالدول العظمى لأن تشنّ حربها على العراق. يقول الكاتب عن هذه الحرب: «هذه الحرب هي الجحيم بعينه، وسببها هو غطرسة الأقوياء ويأس الفقراء. نحن فقراء ولا شيءَ لدينا نعطيه، إنما يجب أن يكون لدينا الإيمان بأننا لا نزال قادرين على مساعدة الآخرين. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يغدو فيها العالم أفضل حالًا».
ولا ينسى الكاتب الآسيوي المخضرم أن يتطرق إلى الخلاف بين الكوريتين والعداء المستديم بينهما، ناهيك عن الوضع العام في بلدان شتى في جهات العالم الأربع، ومنها الهند وباكستان وأفغانستان وبريطانيا ونيجيريا والعراق. كما يكشف لنا هذا العمل الروائي موهبة الكاتب الكوري وثقافته الموسوعية حين يحدثنا عن الطب الصيني التقليدي، والوخز بالإبر، والضغط الواخز، وعن شتى أنواع الزهور والأشجار والأزياء وألوان الطعام والشراب في كوريا والصين، كما يعرض لنا طقوس الباكستانيين وعاداتهم وأنواع الأطعمة التي يتناولونها والألبسة التي يرتدونها. كل ذلك نجده في أثر أدبي اختلط فيه الواقع بالخيال، وتسربتْ فيه الأحلام والرؤى إلى حبكة الرواية، بحيث يتعذر علينا أن نعرف متى انتهى الحلم ومتى بدأت الحقيقة. وهي، حتمًا، حقيقة مُرة، وقاسية، لأن بطلة الرواية «باري»، لا يريدها أبوها، لكونها الطفلة السابعة في الأسرة، وترميها أمها في الغابة، ولن تكون محظوظةً وسعيدةً في الأعوام اللاحقة، سيعاقبها المهرِّبون، ويستغلها الرجال القساة. نعم، حال «باري» هي حال الفتيات اللواتي يؤتى بهن من بلدانهن الأصلية كي يعملن في أوربا من دون رخصة عمل، ويُجبرن على ممارسة شتى المهن القذرة والوضيعة لإعالة أنفسهن، يتهددهن دومًا خطر التسريح من العمل والإبعاد إلى بلدانهن الأصلية.
إنما، في خاتمة المطاف، ثمة دومًا أناس طيبون، مسامحون، يحترمون الآخر، يحترمون عِرقه، ودينه، وثقافته، وأفكاره، وعاداته، وطقوسه، ولغته، ولا يعترفون بالحدود التي رسمها المستعمرون الطماعون أو الجنرالات المستبدون، والساسة المتغطرسون، ولا يترددون في التعبير عن مشاعر التضامن والمحبة والتسامح والتعايش والأخوة حيال الآخر المختلف عنهم جملةً وتفصيلًا. وهذه هي القيم التي آمن الكاتب بها ودافع عنها خلال حياته ومسيرته الأدبية ودفع ثمنًا باهظًا عنها، وأودع السجن، هو الذي عرفناه ناشطًا قويًّا في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأدب والحياة على السواء.
كل ذلك جاء بجُمَل وعبارات موحية، عميقة الدلالات، مكتوبة بعناية ودقة نادرتين، وبأسلوب حديث أخَّاذ ناجم عن فهم المؤلف العميق لحقائق عصره وتناقضاته، وتعاطفه العميق والقوي مع أولئك الذين اجتُثوا من جذورهم وعاشوا عبر التهميش والحرمان في الظل الذي يرميه التحديث. وفيما هو يفعل ذلك أظهر هوانغ أيضًا فهمًا شاملًا للأزمات الإنسانية النفسية، والأفعال التافهة المتنوعة التي يقترفها البشر، وأشياءً كثيرة سواها. وعلى أي حال، يتعين علينا ألّا ننسى أن هذه الجوانب من أدب هوانغ ما كان لها أن تتحقق لولا إحساسه العميق بالجمال فضلًا عن أسلوبه وبنائه التجريبيين اللذين استخدمهما في قصصه، وكانا سِمتين بارزتين لأدبه منذ أن أمسك بالقلم وأخذ يدوّن القصص والروايات التي نالت التقدير والاستحسان من القراء والنقاد على السواء؛ بحيث قال عنه كنزابورو أوي، الكاتب الياباني الحائز على جائزة نوبل للآداب لسنة 1994م: «لا ريب، أن هوانغ سوك – يونغ هو أقوى صوت روائي في آسيا اليوم».
الهوامش:
* الشامانية : دين بدائي من أديان شمالي آسيا وأوربا يتميز بالاعتقاد بوجود عالَم محجوب، هو عالم الآلهة والشياطين وأرواح السلف، وبأن هذا العالم لا يستجيب إلا للشامان – م.