الإشكالية اللغوية في الجزائر عندما أشعل الطاهر وطّار فتيل الصراع

الطاهر وطار
لعل القضية التي ما برحت تتصدر المشهد الأدبي في الجزائر هي الإشكالية اللغوية، التي تثير سجالًا تلو آخر. الكتاب الذين يكتبون بالفرنسية ويصدرون رواياتهم وكتبهم بها من ناحية، والكتاب الذين يكتبون بالعربية ويصدرون كتبهم من خلالها، دائمو الصراع والجدل إلى حد القطيعة. هذه القضية ليست محض أدبية، إنها تمس وتلامس مفاصل مهمة ورئيسة في الكتابة كما في المواقف من عدد كبير من القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية.
الدكتور حاج أحمد الزيواني (1967م)، وهو من الأسماء الأدبية الجديدة، التي تكتب باللغة العربية، وأثبتت حضورها في المشهد الأدبي الجزائري، يرى أن إشكالية الصراع الأيديولوجي بين المعرّبين والفرانكفونيين متجذر ومتأصّل، «فأمام سؤال التاريخ ومُعطى الماضي، فإن المسألة محكومة بطول فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، إضافة إلى ذهنية القابلية للفرانكفونية، كأحد اللّبنات التي عملت عليها منظومة ما بعد الكونيالية ثقافيًّا، وغير خافٍ على أحد أنه منذ الرعيل الأول للكُتّاب الفرنسيين المقيمين بالجزائر، مورست وصاية فوقية، على الثقافة الجزائرية المستلَبة، مما مهّد السبيل بعد ذلك لأن يقتفي الكُتّاب الجزائريون مسار الكتابة بالفرنسية بعد ذلك». ويضيف صاحب رواية «كاماراد رفيق الحيف والضياع» الصادرة حديثًا عن دار فضاءات الأردنية: «في اعتقادي أن الصراع بين الطرفين مفتعل؛ إذ لا يمكننا تجاهل ما قدّمه الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية في الفترات السابقة، سواء على مستوى الفرنسيين المعمّرين أو الجزائريين، وحتى نضيّق من الهوّة، علينا أن نواجه الحقيقة التاريخية بشجاعة، ونعتبر ما قُدّم بالفرنسية من أدبنا إغناءً له، وبالمقابل فإن العربية ستظل هي اللغة المتجذرة، وإن ظهرت لنا باهتة بالمركز، أي الجزائر العاصمة، فإن الفرانكفونية سرعان ما تنكمش، عند خروجنا من العاصمة نحو المناطق الداخلية».
على حين يعتبر الروائي والإعلامي الجزائري سعيد خطيبي (1984م) الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، الصراع اللغوي في الجزائر مجرد «اختراع صحافي، تطوّر بالموازاة مع تحوّلات سياسية عرفتها البلاد. مباشرة بعد الاستقلال (1962م)، حصل أن وجدت مؤسسات مهمّة في الدولة نفسها بين أيدي واحدة من النخب: الفرانكفونية أو العربية أو الأمازيغية، ثم حصل تداول على تلك المؤسسات، وكلّما وصل فريق لغوي، واجه انتقادًا من الفريق الآخر». ويقول صاحب رواية «كتاب الخطايا»: «في الوقت الحالي مثلًا، نجد أن الإعلام والعدالة تسيطر عليهما غالبية من المعرّبين، لكن هذا الأمر لن يدوم، ستواصل العجلة الدوران، وسيتواصل هذا الصراع الأيديولوجي في عمقه، فمن سوء حظ الجزائر أنها أخفقت مع السياسات المتعاقبة في تحديد هوية لغوية لها، تركت الباب مفتوحًا، وبالتالي الصراعات ستظلّ مفتوحة، لكن هذا الأمر لا يحمل، فيما يبدو، بعدًا سلبيًّا فقط، بل إيجابيًّا أيضًا؛ لأنه أفرز حراكًا ثقافيًّا وصدامات انعكسا إيجابًا على حقلي الإبداع والسوسيولوجيا في البلد».
أما الروائي عبدالقادر ضيف الله (1970م)، فيعتقد أن الصراع «مسألة وهميّة، أو ربما مثل الشمّاعة التي تعلق عليها انهزامات كثيرة، يعيشها الوضع الثقافي المتردّي في الجزائر، إن كان الصراع قد بدأ يومًا أيديولوجيًّا، وحاول الكثير استغلاله لأجل مصالح آنية وحزبية تحديدًا، فإن الواقع على مستوى الكتابة يختلف، وبخاصة مع الأجيال الجديدة التي أصبحت تتحكّم في أكثر من لغة، وأصبح أمر اللغة الأجنبية والاختلاف اللغوي، يشكل أمامها عامل إثراء، باعتبار اللغة أداة تواصل في المقام الأوّل، أكثر منها أي شيء آخر». ويقول صاحب رواية «تنزروفت، بحثا عن الظل»: «كما أن النفخ فيما نسميه الصراع اللغوي ليس سوى واجهة تخفي قضايا كثيرة، لا زلنا نعيش معها من دون حل؛ مثل: قضية المرأة، وقضية الحرية، وقضية التعامل مع الدين في السياسة، وإشكالية التعدّد اللغوي والثقافي الذي يحتاج إلى شجاعة للخوض فيه بعقلانية وعلمية، بعيدًا عن الذاتية الضيّقة».
لكن متى اندلعت شرارة هذه القضية، ثم راحت تكبر حتى أوشكت أن تلتهم كل شيء؟ في شهر مارس من سنة 1992م، أقيمت في باريس ندوة أدبية حول الأدب الجزائري، شاركت فيها نخبة من الكتّاب والنقاد الجزائريين، وأيضًا من الكتّاب الفرنسيين المهتمين بشأن الأدب الجزائري، وكان من بين الحضور الروائي الجزائري الراحل الطاهر وطار (1936 – 2010م). تفاجأ صاحب رواية «الحوّات والقصر»، أن الندوة لم تتطرّق، ولو على سبيل التلميح، إلى الأدب الجزائري الناطق باللغة العربية، الذي يُعتبر هو نفسه أحد مؤسسيه الأوائل، لم يأت ذكره، كأدب جزائري، على لسان جميع المشاركين في الندوة. فقد اكتفت المداخلات، واقتصر النقاش، طوال اليومين اللذين استغرقتهما الندوة، على التصدّي للأدب الجزائري الناطق باللغة الفرنسية فقط، وكأنه لا أثر لأدب جزائري باللغة العربية، أو هكذا استنتج الطاهر وطار.
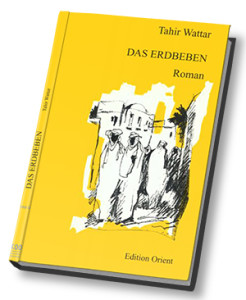
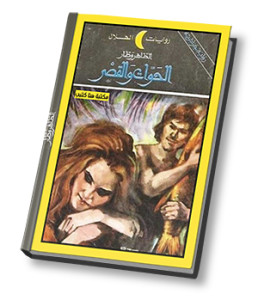 من هنا ثارت ثائرته، وسرعان ما طلب عقد ندوة صحفية مباشرة بعد عودته إلى الجزائر، ليصدر بيانًا احتجاجيًّا، موجّهًا إلى المثقّفين والرأي العام، يدعو من خلاله إلى «إعادة فتح ملف أدب الجزائريين المكتوب باللغة الفرنسية، وإعادة النظر فيه، والعمل على تحديد قيمته وجزائريته»، متسائلًا في البيان نفسه: «هل صحيح أن الحرب مع فرنسا انتهت؟ الحرب الحضارية لم تنته، إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر، اتّسع بدرجة كبيرة بعد الاستقلال، مقارنة بما كان عليه الوضع أثناء الوجود الاستعماري»، ثم يختم بيانه بضرورة تطبيق ما أطلق عليه «الشرط اللغوي للوطنية»، في تقويم انتماء الأدب الجزائري الناطق بلغة أجنبية، «نعتبر المفكرين من أصل غير عربي مثل ابن الرومي والفارابي عربًا؛ لأنهم تكلّموا باللغة العربية، وكتبوا بها، فبأي حق نتنازل عن هذا المعيار، ونقلبه عند الحديث عن عروبة الأدب الجزائري، المكتوب بالفرنسية؟».
من هنا ثارت ثائرته، وسرعان ما طلب عقد ندوة صحفية مباشرة بعد عودته إلى الجزائر، ليصدر بيانًا احتجاجيًّا، موجّهًا إلى المثقّفين والرأي العام، يدعو من خلاله إلى «إعادة فتح ملف أدب الجزائريين المكتوب باللغة الفرنسية، وإعادة النظر فيه، والعمل على تحديد قيمته وجزائريته»، متسائلًا في البيان نفسه: «هل صحيح أن الحرب مع فرنسا انتهت؟ الحرب الحضارية لم تنته، إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر، اتّسع بدرجة كبيرة بعد الاستقلال، مقارنة بما كان عليه الوضع أثناء الوجود الاستعماري»، ثم يختم بيانه بضرورة تطبيق ما أطلق عليه «الشرط اللغوي للوطنية»، في تقويم انتماء الأدب الجزائري الناطق بلغة أجنبية، «نعتبر المفكرين من أصل غير عربي مثل ابن الرومي والفارابي عربًا؛ لأنهم تكلّموا باللغة العربية، وكتبوا بها، فبأي حق نتنازل عن هذا المعيار، ونقلبه عند الحديث عن عروبة الأدب الجزائري، المكتوب بالفرنسية؟».
القطيعة تبلغ ذروتها
لم يمر الموقف الذي تبنّاه وروّج له الطاهر وطار مرور الكرام، فقد تناقلته بتفاصيل أكثر معظم الصحف الجزائرية، وانبرى الكتّاب من كلا الطرفين، كلّ واحد منهما يسعى للدفاع عن وجهة نظره. ولأوّل مرّة يحتدم الصراع بينهما، ويأخذ وجهة أخرى مغايرة، بلغت حدّ الاتهام بالتواطؤ والخيانة، لم تلبث أن بلغت القطيعة ذروتها بين الطرفين. قطيعة كانت فيما مضى خفيّة، لم يسبق لها أن خرجت للعلن. أولى إرهاصاتها وأخطرها عاش تبعاتها الطاهر وطار بنفسه، وهو في مستشفى باريس طريح الفراش، ففي الوقت الذي جاء لزيارته معظم الكتّاب المعرّبين، بما في ذلك الكاتب واسيني الأعرج، رغم الخلاف الشديد الذي كان قائمًا بينهما، قبل مرضه بمدة قصيرة.

سعيد خطيبي
وكان ذلك الخلاف قد تجلّى من خلال تبادلهما مقالات «شديدة اللهجة» على صفحات الجرائد الجزائرية، إثر تراشق واضح، أفرزه تعارض في موقف كل منهما إزاء الأحداث السياسية التي جرت في الجزائر آنذاك، وبخاصة عقب توقيف المسار الانتخابي إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بأغلبية مقاعد البرلمان الجزائري. ففي الوقت الذي أيّد فيه الكاتب واسيني الأعرج، مع كوكبة أخرى من الكتّاب الجزائريين، توقيف المسار الانتخابي، وقطع الطريق أمام حكم الإسلاميين، فاجأ الطاهر وطار الجميع بموقفه المختلف، معلنًا معارضته الشديدة لعملية توقيف المسار الانتخابي، ومؤيّدًا فكرة مواصلته إلى آخر المطاف، مهما كانت درجة الأخطار المحدقة بالبلد، معترفًا أمام الصحافة الجزائرية: «لقد تمّ إيقاف المسار الانتخابي لحماية مصالح فئوية، خلقت وضعيات حسّاسة، وكل مسّ لهذه الوضعيات هو نهاية عهد وبداية آخر، كان رأيي أن يستمر المسار الانتخابي، وتستمر اليقظة، ويستمر البرلمان الجديد… أنا ديمقراطي حقيقي ولا أستنجد بالدبّابة لأحمي النظام…».
 رشيد بوجدرة أبرز المعارضين
رشيد بوجدرة أبرز المعارضين
هو الرأي الذي عارضه شكلًا ومضمونًا عدد كبير من الكتّاب الجزائريين، لا سيما كتّاب اللغة الفرنسية، وهكذا سيؤلّف رشيد بوجدرة (1941م) أحد أبرز المعارضين للطاهر وطار، خلال تلك المدة، كتابًا بالفرنسية يحمل عنوان «فيس الحقد»، يتناول مخاطر التطرّف الديني، مجسّدًا في حزب «الفيس» (الأحرف الأولى بالفرنسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ). بدوره، يؤلّف الروائي رشيد ميموني (1945 – 1995م) كتابًا تحت عنوان «عن الهمجية عمومًا والأصولية خصوصًا»، يقول عن عمله إنه «أشبه بصرخة ملحّة اعتملت في داخلي، كتبته بسرعة فائقة عشية الانتخابات التشريعية في كانون الأول، ديسمبر 1991م، قصد التنبيه إلى المخاطر التي كانت تحدق بالجزائر، في حال استيلاء جبهة الإنقاذ على الحكم».
وقد بلغ الوضع، فيما يبدو، سوءًا بين الطرفين المتصارعين، وبخاصة بين الطاهر وطار ومناوئيه، عندما شرع الأول في إطلاق تصريحاته النارية ضدّ ما يعتبره رموز الأدب الجزائري الناطق بالفرنسية، فها هو مثلًا يعتبر مقتل «الطاهر جاووت» (1954 – 1993م) الصحافي والروائي الجزائري باللغة الفرنسية، على أيدي الجماعات الإرهابية بمنزلة «خسارة لفرنسا» حسب وصفه وليس للجزائر، رغم ما يمثله هذا الأخير من رمزية كونه أوّل كاتب وإعلامي جزائري تطاله يد الإرهاب، التي اغتالت بعده مجموعة كبيرة من الصّحافيين والكتّاب، خلال ما بات يطلق عليه في الجزائر «العشرية السوداء» المدة التي شهدت تنامي العنف فيها.
حرب بالفرنسية ضد الطاهر وطّار
كردّ فعل مباشر لموقف الطاهر وطار؛ شنّت الصحافة الجزائرية الناطقة بالفرنسية حربًا إعلامية ضدّه، ولعلها الصّحف التي كانت تحظى خلال تلك الحقبة بنفوذ خاص، ومصداقية معيّنة لدى شريحة معتبرة من الرأي العام، في بداية الانفتاح الإعلامي في الجزائر، من خلال حجم مبيعاتها؛ إذ استطاعت أن تتفوّق على الصحف المعرّبة، قبل أن تتغيّر الأوضاع في العقد الأخير، وتحتل الصحف المعرّبة الريادة. وهي الحملة التي أثّرت فيما يبدو، في نفسية الطاهر وطار، الأمر الذي ألزمه الصمت مدة من الزمن، بعد أن شعر بتخلي الجميع عنه، قبل أن يشتدّ عليه المرض، وينتقل مضطرًّا إلى فرنسا للعلاج.
وهكذا امتنع الكتّاب الجزائريون باللغة الفرنسية، حتى عن زيارته في المستشفى. وما أثار حفيظة الطاهر وطار خاصّة موقف الكاتب الجزائري «ياسمينة خضرا» الذي أعلن صراحة للإعلام الفرنسي والجزائري رفضه زيارته؛ بسبب المواقف التي أدلى بها، وبخاصّة في حق الطاهر جاووت، رغم أنه كان يشغل منصب مدير المركز الثقافي بباريس، خلال تلك الحقبة، وهي مؤسسة عمومية تابعة للدولة الجزائرية.
يصنّف الطاهر وطار الكتّاب الجزائريين بالفرنسية إلى صنفين: ما اصطلح على تسميتهم الرعيل الأوّل، على غرار: كاتب ياسين، ومولود معمري، ومالك حداد، ومحمد ديب. بالنسبة إليه، هؤلاء يمتلكون وجدانًا جزائريًّا، حتى وهم يكتبون بلغة غير لغة الشعب الجزائري، فضلًا عن أنها لغة الاستعمار. فالكاتب، حسب مفهوم الطاهر وطار لمسألة الانتماء، إذا كان يملك وجدانًا عربيًّا إسلاميًّا، عندها لا يهمّ بأية لغة يكتُب؛ إذ بمجرد ترجمته إلى اللغة العربية، يعود الكتاب إلى جذوره، وكأنّه كُتب أصلًا باللغة العربية. أما بالنسبة للرعيل الثاني، هناك حسب تعبير الطاهر وطار «من تشكّ حتى في أصله العربي الإسلامي، ربما يكون يهوديًّا، وهناك مثلًا شاعرة يهودية اسمها مريم بن كوهين، حذفت كوهين، وصارت تدعى مريم بن، كما أنّ كُـتّابًا مثل رشيد ميموني، وبوعلام صنصال، ومجموعة الذين كتبوا فيما بعد، ليس فيهم من الجزائرية سوى الاسم».
 في خضمّ النقاش المحتدم، تدخّل الكاتب الجزائري محمد ديب (1920 -2003م)، وهو واحد من الكتّاب المؤسسين للأدب الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، شارحًا الإشكالية اللغوية في الجزائر، حسب وجهة نظره، معتبرًا أن مسألة اللغة ليست اختيارية؛ لأن الكاتب الجزائري في حقبة زمنية «لم يختر طوعًا لغة إبداعه، بل كتب باللغة الوحيدة التي كانت في متناوله»، ثم يمضي مبرّرًا السياق التاريخي، الذي دفع أقرانه إلى استخدام الفرنسية، «خلال الحقبة الاستعمارية، لم تكن هناك إمكانية لتعلّم اللغة العربية، ولم يكن أمام الشعب الجزائري خيّار آخر سوى إرسال أبنائهم إلى المدارس الاستعمارية لتعلّم الفرنسية، وحتّى اللغة الفرنسية لم يكن تعلمها متاحًا، سوى لقلة قليلة من أبناء الجزائريين».
في خضمّ النقاش المحتدم، تدخّل الكاتب الجزائري محمد ديب (1920 -2003م)، وهو واحد من الكتّاب المؤسسين للأدب الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، شارحًا الإشكالية اللغوية في الجزائر، حسب وجهة نظره، معتبرًا أن مسألة اللغة ليست اختيارية؛ لأن الكاتب الجزائري في حقبة زمنية «لم يختر طوعًا لغة إبداعه، بل كتب باللغة الوحيدة التي كانت في متناوله»، ثم يمضي مبرّرًا السياق التاريخي، الذي دفع أقرانه إلى استخدام الفرنسية، «خلال الحقبة الاستعمارية، لم تكن هناك إمكانية لتعلّم اللغة العربية، ولم يكن أمام الشعب الجزائري خيّار آخر سوى إرسال أبنائهم إلى المدارس الاستعمارية لتعلّم الفرنسية، وحتّى اللغة الفرنسية لم يكن تعلمها متاحًا، سوى لقلة قليلة من أبناء الجزائريين».
التاريخ وضعنا في ظروف خاصة
أما بالنسبة للشاعر والمؤرّخ جمال الدين بن شيخ (1930 – 2005م) يرى أن «اللغة تعيش مع الشخص، والإنسان عليه أن يقبل التاريخ كما هو، والتاريخ قد وضعنا في ظروف خاصة عشناها، ولا يمكن القفز فوق هذه الظروف، فأنا لا ألوم البتّة من يستعمل الفرنسية في الكتابة، ولكن أن يستعمل هذه اللغة بصراحة، ولا يحاول أن ينافق الآخرين، ويقول هكذا وبكل صراحة: إنني خلقت في مرحلة، ودرست في مرحلة معينة، ووليد ظروف… فأنا أطلب من الذين يكتبون باللغة الفرنسية، أن يواصلوا الكتابة بها، ولكن عليهم من جهة أخرى، ألّا يدلسوا الواقع الحضاري للعرب…».
الشاعر مالك حداد (1927 – 1978م) يُعتبر وفق منظور الطاهر وطار «نموذجًا حقيقيًّا للكاتب الملتزم بقضايا وطنه، وثوابت أمّته». كما يُوصف مالك حداد بأنه «شهيد اللغة العربية»، عندما أعلن قراره المبدئي بالتوقّف نهائيًّا عن الكتابة باللغة الفرنسية، وهو في أوج عطائه الأدبي، وقال قولته الشهيرة: «اللغة الفرنسية هي منفاي». قالت عنه الكاتبة أحلام مستغانمي في مقدّمة روايتها «ذاكرة الجسد»، والتي أهدتها لروحه: «مات متأثّرًا بسرطان صمته ليصبح شهيد اللغة العربية، وهو أوّل كاتب يموت قهرًا وعشقًا لها». وعلى النقيض تمامًا يقف كاتب ياسين (1929 – 1989م) صاحب الرواية الشهيرة «نجمة» معتبرًا «اللغة الفرنسية غنيمة حرب» يُفترض استغلالها إيجابيًّا، واعتبارها مكسبًا لفتح أفق واسع للعلم والمعرفة.
الفرنسية تتصدر المشهد الأدبي
رشيد بوجدرة
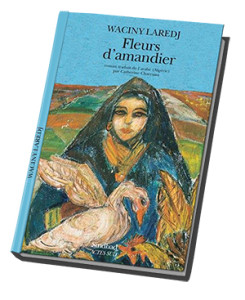 لم يكن أكثر الناس تفاؤلًا في الجزائر يعتقد أن اللغة الفرنسية ستصمد، بل وستعود بقوّة، تتصدّر المشهد الأدبي في الجزائر، بعد مضي أكثر من خمسة عقود من نيل الجزائر استقلالها، رغم سياسة التعريب الشاملة، المنتهجة من جانب الدولة الجزائرية منذ السبعينيات، ولعلّ من أبرز مظاهر تمكّن اللغة الفرنسية عشرات الكُتب التي لا تزال تصدر باللغة الفرنسية، إلى جانب مقروئية باتت تنافس اللغة العربية، وبخاصّة على مستوى الأعمال السردية.
لم يكن أكثر الناس تفاؤلًا في الجزائر يعتقد أن اللغة الفرنسية ستصمد، بل وستعود بقوّة، تتصدّر المشهد الأدبي في الجزائر، بعد مضي أكثر من خمسة عقود من نيل الجزائر استقلالها، رغم سياسة التعريب الشاملة، المنتهجة من جانب الدولة الجزائرية منذ السبعينيات، ولعلّ من أبرز مظاهر تمكّن اللغة الفرنسية عشرات الكُتب التي لا تزال تصدر باللغة الفرنسية، إلى جانب مقروئية باتت تنافس اللغة العربية، وبخاصّة على مستوى الأعمال السردية.
وهكذا أصبحت الرواية الجزائرية باللسان الفرنسي تُشكّل الحدث الأدبي ليس في الجزائر فحسب، بل في فرنسا كذلك، لكن هذه المرّة من جانب كتّاب عاشوا في الجزائر، وتعلموا في مدارسها، وسرعان ما أصبح حضورهم ملفتًا، من خلال ترشّحهم لمختلف الجوائز الأدبية الفرنسية، على غرار بوعلام صنصال، وكمال داود، ومايسة باي، وياسمينة خضرا، وآخرين… والأمر فيما يبدو، لم يعد مقتصرًا على الجيل «القديم» بل إن الفرنسية كلغة استهوت عددًا من الكتّاب الجزائريين من جيل شملته سياسة التعريب، مثل: كمال داود، ومصطفى بن فوضيل، وسليم باشي… إضافة إلى توجّه عدد من الكتّاب الجزائريين المعرّبين، لسبب أو لآخر، إلى الكتابة باللغة الفرنسية، في اختيارهم الانتقال بين كتابة المقالات وتأليف أعمال روائية، على غرار: مرزاق بقطاش، وجيلالي خلاص، ومحمد ساري، وواسيني الأعرج، وأمين الزاوي، وسعيد خطيبي، أو التأرجح في الكتابة بين اللغتين العربية والفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لرشيد بوجدرة.
تتعدّد مسوّغات الانتقال إلى اللغة الفرنسية، لعلّ أهمها في اعتقادهم، حرية البوح التي تتيحها ربما الكتابة باللغة الفرنسية، بعيدًا من إكراهات الرقابة بمختلف أشكالها، ومن خلال اللجوء قسرًا إلى رقابة ذاتية، قد يفرضها قارئ معرّب، يبدو مؤثثًا بالمواقف المسبقة للأشياء. من جهة أخرى، ثمة عامل الاهتمام الذي قد تتيحه اللغة الفرنسية، من خلال إمكانية احتضان العمل من جانب وسط أدبي فرنسي، يكفل اهتمامًا إعلاميًّا وأدبيًّا واسعًا له، كما قد يسمح لكاتب مغمور في بلده، أن يطمح إلى الحصول على واحدة من آلاف الجوائز المتاحة، وربما جائزة أدبية مرموقة، وهو ما حدث مع الكاتب والصحفي كمال داود (1970م) من خلال عمله الأول «مينورسو تحقيق مضاد» والذي كاد أن يحصل على جائزة غونكور الشهيرة، لولا فارق نقطة وحيدة، رجّحت في آخر المطاف كفة الكاتبة «ليدي سالفير» للفوز، ولكنه استطاع مع ذلك، أن ينال سنة 2015م جائزة غونكور لأفضل عمل روائي أوّل، وأن يكتب مقالات في أكبر الصحف والمجلات الفرنسية، وينتزع هذه السنة جائزة أحسن صحافي في فرنسا.
لغة الذهاب والانفتاح على الآخر

أمين الزاوي
من ناحية أخرى، يشاطر الروائي أمين الزاوي (1956م) كاتب ياسين رأيه القائل بأن اللغة الفرنسية غنيمة حرب؛ إذ يعتبر أن اللغة الفرنسية اكتسبها الجزائريون، بحيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد والحقل الأدبي والثقافي في الجزائر، كما وصفها «بلغة الذهاب والانفتاح على الآخر». أمين الزاوي بعد أن بدأ كتاباته باللغة العربية وحدها، وأنجز مجموعة من القصص والروايات بها، عاد في السنوات الأخيرة لينجز أعماله، تارة باللغة العربية، وتارة أخرى باللغة الفرنسية؛ مسوّغات هذا الانتقال يلخصها في أنه روائيّ يجيد الكتابة باللغتين الفرنسية والعربية، ويضيف: «أنا الوحيد من جيلي، جيل الاستقلال، الذي يمارس الكتابة إبداعيًّا روائيًّا من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين بشكل متناغم، وما أطرحه من مشكلات وأسئلة فلسفية وتراثية وسيكولوجية وسياسية في رواياتي بالفرنسية أطرحه بالعربية.
صحيح أنّ النصوص مختلفة، أي ليست ترجمة مطلقة، ولم أحاول يومًا ترجمة أعمالي من لغة إلى أخرى، بل كلّ نصّ قائم بذاته، ولكنّني أمين ووفيّ للقارئ، حيث إنّني لا أخون قارئي بالعربية كما بالفرنسية، فما يشغلني من هموم أكتبه في هذه اللغة أو في تلك».

واسيني الأعرج
أما الروائي واسيني الأعرج (1954م) الذي يعترف بأن اللغة الفرنسية كانت لغة الكتابة الأولى له، وأنه تعلّمها في مراحل التعليم الأولى في عهد الاستعمار، يصف اللغة الفرنسية بأنها «كانت شبيهة بالقدر ولم تكن خيارًا»، فقد كان الخيار آنذاك إمّا الفرنسية أو الأمّية، على حين أن تعلم اللغة العربية كان عن طريق الكتاتيب، بوصفها فضاء بديلًا للمدرسة الفرنسية، بادر بتأسيسها السكان الجزائريون؛ من أجل الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية من محاولات طمسها من جانب الاستعمار الفرنسي. إذ يعتبر اللغة الفرنسية ضربًا من التعدّد الثقافيالمفيد للأدب الجزائري: «أنظر للغنى اللغوي أو الثقافي وحتى العرقي كحالة إيجابية، والتي تفترض بالضرورة القدرة على الاستيعاب والاضطلاع بالحالة… اكتساب لغة جديدة هو فسحة ثقافية تنفتح على عالم لا نعرفه جيدًا. بفضل اللغة الفرنسية اطلعت على جزء مهم من الأدب العالمي ولم أنتظر الترجمة العربية. من عرف لغة قوم عرفهم وعرف جزءًا من العالم المخفي».
الروائي رشيد بوجدرة (1941م)، بعد أن كان يكتب في بداياته باللغة الفرنسية، منجزًا عشرات الروايات بها، فاجأ الجميع بقرار الكتابة بالعربية، والتخلي عن الكتابة بالفرنسية، ها هو يعترف أنه قبل أن يقرأ للكاتب الفرنسي مارسيل بروست، قرأ ألف ليلة وليلة، وتأثر بها أيّما تأثر. علاقته باللغة العربية حسب تعبيره هي علاقة عشقية؛ لأنها بحر، وأن الفتوحات الإسلامية أضافت للغة العربية كلمات من جميع الدول والأمصار، ولأنها أيضًا تمكّنه من استعمال اللهجات الشعبية المختلفة، والكلمات السوقية، ولغة الشارع، وهو أمر لا تتيحه له الفرنسية. ورغم أنه عاد من جديد إلى الكتابة بالفرنسية، لكنه تعرّض للتهميش والإقصاء من اللوبي الفرانكفوني في الجزائر وفي فرنسا؛ بسبب مواقفه المنتقدة لنشاط المنظمة الفرانكفونية، وموقفه المؤيّد لاتجاه الكتابة بالعربية، مما حرمه، كما صرح، من نيل جائزة من الجوائز الأدبية الكثيرة، التي يتيحها المشهد الأدبي في فرنسا.
