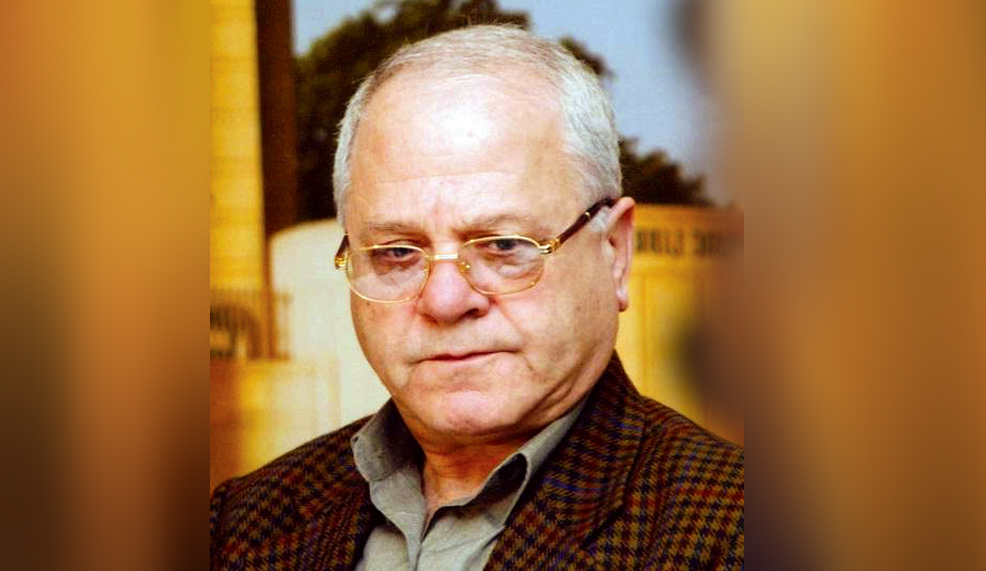
الزلزال السوري روائيًّا .. أصوات جديدة من الداخل
في السنوات الخمس الماضية من عمر الزلزال السوري الذي تفجر سنة 2011م، تواتر حضور الأصوات الجديدة في الشعر والرواية، ومنها ما نيّف على الأربعين؛ إذ لم يكن الظهور لأول مرة حكرًا على شباب العقد الثاني أو الثالث. وقد توزعت تلك الأصوات، كسواها، بين لاجئ أو منفي أو مهاجر، وبين مقيم أو نازح، أي بين الداخل والخارج. وهنا تأتي فيما أظن الإشارة المهمة إلى أصوات الداخل، الجديدة أو المخضرمة التي تتوحد في مثل هذا المقام مع أصوات الخارج في التعبير الحر والنقدي عن كل ما يعنيه الزلزال، ابتداءً من الحراك السلمي ضد الطغيان إلى العصف المدمر الذي لم يوفّر حجرًا ولا بشرًا، واستوت فيه البراميل المتفجرة مع الاحتلالات والتشققات جميعًا. ولأنه لا بد من الاختيار، فقد اخترت الروايتين التاليتين، وكل منهما هي الأولى لصاحبها:
«حقول الذرة» لسومر شحادة: فازت هذه الرواية لسومر شحادة بالمركز الأول في جائزة الطيب صالح في دورتها السادسة. وعلى الرغم من أن الرواية لا تسمّي فضاءها بمقتضى إستراتيجية اللاتعيين، فإن في منتهاها ما يكفي من الإشارات إلى اللاذقية وريفها. وعبر جمهرة من الشخصيات الشبابية، ترسم الرواية لوحات للزلزال منذ بدايته في المظاهرات السلمية، إلى قمعها، إلى العنف المتأسلم. ومن الكثير الذي تثبته ألسنة ملهم أو لمى أو موفق أو عدي أو هاني… أن المدينة باتت سجنًا كبيرًا، تقطعها الحواجز وانهيار الثقة بين الناس، وبين أركان السلطة، وبينها وبين الناس. فهذه لمى التي تعمل في الإغاثة ترى أن السلطة سوقت للإجرام كي تسيء إلى قيم الثورة، لكن ذلك لا ينفي الإجرام عن الثوار، لكأن المطلوب إعادة الدولة إلى الصفر، وإعادة المجتمع إلى ما قبل نشوئها، أو تسليم البلد للمنتصر وهي (على العظم) وهذا ملهم الذي يكتب رواية الزلزلة كما يحياها، يخالف أقرانه الشباب؛ إذ يرى أن المشكلة ليست مع شخص الرئيس، بل مع (شخصيته). وإذا كان الأقران يرون أن إسقاطه سيحل مشاكل الفقر والفساد ومصادرة الرأي، فملهم يرى أن إسقاطه دون إسقاط كامل المنظومة التي يمثلها ستعيد المجتمع إلى حلقة أكثر شناعة. وفي موقع آخر يتساءل ملهم عن أيقونة الدولة الفاشلة التي شققت أهلها الانتماءاتُ المختلفة. وعن الطائفية يذهب ملهم إلى أن الطوائف هي دم الطغاة الفاسد، ولا يفرق بين المقاتلين المتأسلمين ومن ينادون بعبارات عصرية بتسليحهم من بقايا اليسار أو بقايا من المنافي أو في سجون السلطة.
حراس الثورة وحراس السلطة
كما يرى ملهم أن هناك ما يحاك (ضدنا جميعًا)؛ إذ يتلاقى حراس الثورة مع حراس السلطة بتلقائية. ومما تحفل به الرواية من (التنظير) ما تذهب إليه من أن الحياة مع الاستبداد ممكنة، ولكن بوجود الحب. ومن ثم فـ(هم) أي رجال السلطة، يعلمون ما يفعلون؛ إذ يطلقون الحريات الشخصية مع انعدام شبه كامل للحريات العامة، ويطلقون حريات المحافظين في تغييرهم لسلوكيات المجتمع. ومن هذا التنظير في الدفتر الرابع «الحرائق» من الرواية المبنية كدفاتر، ما يبثه ملهم بعد مصرع صديقه موفق، وبعد انغماسه في الحرب بمقاتلة أهله سعيًا إلى جعلهم يفكرون بمصير مختلف. وهكذا انضم إلى من يصفهم بالمتمردين الذين أرهبوا قرى الريف بفهمهم البدائي للدين، وعدَّ نفسه المخلص الذي سيجمع الجميع. فملهم يرى أن الحرب تحتاج إلى كم هائل من اللاعقلانية، وأن أول استكانة لإرادة القطيع تعني وداع الحرية الذاتية. وقد قرأت لمى في أوراقه التي عثرت عليها أن العاقل (الآن) هو من يتمسك بالسلطة.
«موسم سقوط الفراشات»: هذا صوت (نور) الكسير الناعم كرموش عينيها الصغيرتين/ ينسحب الصوت على رؤوس أصابعه ليغطي العاشق نزار، كي لا يبرد/ هو صوت يسيل مبحوحًا كماء وعسل/ هو صوت حافٍ يلهث والرصاص يلاحقه…
بمثل هذه الصور المتفردة والشفيفة، تزدان رواية «موسم سقوط الفراشات» لعتاب عدي شبيب. ولكيلا توهمنا الصور بالرومانسية، تصفعنا الرواية لنصحو على السفينة المثقوبة المسماة وطنًا، وعلى وطن كل من فيه مريض، وكل من فيه يفر من ناره بطريقة مختلفة. هكذا تبدو مدينة حمص – فضاء الرواية – امرأة ماتت بالذبحة القلبية، منذ مستهل الرواية، لتمطر رصاصًا في نهايتها، وتحترق في حفلة حقد وهزيمة. وهي الحرب إذن التي جعلت الوطن في بؤرته حمص، على ما تقول هذه الرواية، كما ستقول: إن الحرب حولت الوطن إلى موسم واحد تتشابه به طقوسنا في سقوطنا. ومنذ ذلك اليوم الحمصي من شهر إبريل 2011م – الإشارة إلى الاعتصام السلمي الشهير في ساحة الساعة – «لم نكن سوى فراشات»، وكل من سقط كان طوباويًّا حد الهوس،… وما أكثر وأوجع حكايات الحرب.
بالحكاية نهضت هذه الرواية، فبعد مهاد قصير يعلن نزار أنه سيكون الحكواتي، وستبذّه نور التي تقلب البداية المألوفة للحكاية «كان ياما كان» لتجعلها الخاتمة. ونور تحسن الحكي كجدة عجوز، وتجزم بأنه لا يمكن إلا للمرأة أن تحكي الحكايات. أما نزار فإنه يسجل الحكايات ليكتب الرواية، وهو من كتب قبل الحرب مسرحيات لأطفال التوحد، وعمل مدرسًا لهم. ولسوف يتولى الحكاية هذا الذي يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، منذ الفصل الذي حمل اسم أحد أحياء حمص: «باب السباع»، فيحكي حكاية العجوز المقيم في هذا الحي (السني)، الذي يمضي إلى صديقه أبي سليمان في حي عكرمة (العلوي) حاملًا طاولة النرد، ليلعبا وليغلب صاحبه. وقد ألف الحاجز العسكري مروره بسيارته العتيقة، حتى إذا جاءت بالسيارة امرأة، فوجئ الضابط، وكان جواب المرأة أن أباها أصيب باكتئاب جراء الحرب، وتعذرت مغادرته البيت، وأوصى بطاولة النرد لصديقه.
زمن الحرب والتعفيش
في فصل «لولو» تتولى نور حكاية الفتاة لولو التي كان صبي النجار يملأ الجدران باسمها، حتى إذا اختفى أخذت كتابات لا تشبه الحب تحتل الجدران، كإبر لئيمة في العيون، تشتم النظام وتهدد سكان الحي من طائفة الفتاة العلوية. وفي الحكاية أن الصبي اختفى لأنه ينام النهار بطوله، كيلا يرى لولو، في حين يخرج ليلًا في المظاهرات. لكنه سيكتب «سامحيني» وقد علمت في أيام القطيعة أنها صارت عدوته كما شاء جنون الوطن. من شخصيات الرواية المرسومة بفرادة: بشارة النحات الذي يصمم المناظر لمسرحيات نزار. لقد بات حلم بشارة في زمن الحرب والتعفيش (أي نهب الغنائم من حيث أمكن) أن يشتري كل كتاب منهوب، وكل ثوب وكل خزانة، ليعيدها إلى مالكها الحقيقي. وبعد موت بشارة يؤلف صديقه نزار حكاية عن موت رجل واحد، بعدما أصغى لألف حكاية، وهو ينتظر الحكاية الواحدة بعد الألف لتكون هي الحقيقة. وكان بشارة قد اختفى أيامًا، ثم عُثِر عليه موسومًا بالتعذيب، واتهم الأمن المعارضة بقتله، في حين اتهمت المعارضة الأمن، وعلى صفحة الشهيد النحات بات كل ما يكتب عليها موسومًا بالطائفية.
تؤكد الجملة الأخيرة في الرواية أنْ لا نهاية للحكاية. ولكن في هذه النهاية المفتوحة، وبعد أن يعود نزار عن عزمه على الهجرة، يتّقد مشهد حمص القديمة إبان استسلام المسلحين وخروجهم منها بالباصات سنة 2013م، بعدما أضرموا النار عشية التسوية في البيوت والسيارات، وفاحت رائحة شواء مرعبة، وأعقبهم اللصوص، ثم الفضوليون، ثم طائفة غريبة من الممسوسين بالشوق، وهذا ما يتصادى مع ما آلت إليه شخصية أخرى بالغة التفرد، هي شخصية جاد المثلي والموسيقي الذي بدا في النهاية / اللانهاية حرًّا من الخوف، ولسان حاله: لقد انتهينا وهزمنا، فما في هذه الحرب من منتصر، وإنها لحرية الهزيمة.
أليس هذا هو نبض روايتي عتاب شبيب وسومر شحادة، كما هو نبض أغلب روايات الزلزال؟

 ربما
ربما



