
أحمد بوقري - كاتب سعودي | مايو 1, 2023 | نصوص
يتسامر نفر في الأعالي.
كائنات أثيرية
تتماوج ظلالها في الأقاصي
يتساقط الزمن على رؤوسهم ندفًا بيضاء لا ثقل لها..
تحيط بهم
كراتٍ متطايرة من الثلج
تظللهم
سحاباتٍ من الرذاذ والضياء والهواء المعقّم
جلسوا على حافتي غياب
كلٌّ يتكئ على قصصٍ وحكايات وأشعارٍ وذكريات كانت لهم على كوكبٍ سفلي يلمع الآن تحتهم كومضة خافتةٍ في هذا الدجى العظيم..
كانوا رحلوا واحدهم تلو الآخر على جناح طائر الموت
قدموا في مواكبٍ من الغبطة الباردة
من الدجى السفلى
إلى الدجى العليا
«كأن الدجى زادت وما زادت الدجى
وَلَكِنْ أطَالَ اللَّيْلَ هَمٌّ مُبَرِّحُ»
أنشدت روح إعرابي، واحد منهم وسمعوا ارتطامه بنجمةٍ راحلة.
على حافة الغياب
في النقطة الفاصلة بين الجحيم والفردوس
ينتظرون كل مساء الطائرَ القادم بما يحمل من الأمداء الدنيا
يصيحون بفرح عندما يلوح لهم من بعيد
يجيء أسودَ كطائر الرخ:
«جاء الموت.. جاء الموت
بحصادٍ جديد»
ويترك لهم كائنًا أثيريًّا آخرَ
يضع بينهم روحًا طليقة جديدة
«هذا أنت أخيرًا بيننا يا صاح»
يتعرفون عليه من صوته وضحكاته
كيف تركت الدنيا السفلى؟
يتلمظ فمه من سكرة الموت
ويعبّ سكِرًا جديدًا من الرذاذ الذي حوله
يحكي لهم قصة سفره إلى السماوات العلى.
يعرفهم واحدًا واحدًا من أحاديثهم وآخر لم يلتقه من قبل يحوم حوله اشتياقًا
يرتمي على حافة الغياب شرقًا قربهم
يتكئ على طاولةٍ من الهواء البارد
بغبطةٍ قصوى يهمس لهم وللنجوم الراحلة بين الأزمنة.
«ها أنا ذا بينكم يا أصحابي السابقون
أفلتّ من سجن اللحم الذي أحاطني سبعين
عامًا ونيف
وصرت طليقًا بينكم كما أنتم في هذه العليّة
هل تذكرون الشاعر الأرضي الذي أنشد:
أعطني حريتي.. أطلق يدي
إنني أعطيت ما استبقيت شيئًا
هو أنا معكم..
علي ابن أبي
هربت من لحمي ودمي
أنقذت من أوجاعي وأوجاع العالم السفلي
هربت من رائحتي قبل أن تنتن
هؤلاء نحن الطلقاء لا رائحة لنا
أنقياء
صعدنا إلى هذه الحافة السماوية
ولم نستَبقِ لنا من شيء كان ملكنا
تركناه للأرواح الأخرى المحبوسة في أقفاصها المترهلة
وفررنا واحدنا بعد الآخر إلى هذا الفردوس السماوي
حيث نحن هنا
نرى بعضنا عبر الهسيس والهمس والذكرى».
تتراقص روح حسن مستغرقة في ابتسامتها واخضرارها الأبدي.. تصطدم بالأرواح الصديقة منتشيًا بعودتها إلى حيث الأعالي.. يحيّي علي ابن أبيه، بقربه، يمتلئ كأسه الأثيري برذاذ البحر، وتحلّق روحه بين ضفتي الغياب مناجيًا كل الأرواح المتقاربة ويصدح كطيرٍ من ماء:
«غيمةٌ تعبر، الآن، أرضَ السواد
فرحٌ عابرٌ
في ثيابِ الحداد
ها هي الأرض تمتد خضراءَ.. خضراءَ
ملء البصر»
…
على حافة الغياب الأخرى
همس أحدهم:
من هذا الذي بقربنا يا صديقي الفيلسوف نيتشه؟ خرجت الكلمات كأنها أحجار ملساء من فمه الكثّ بشاربه الذي لا يرى
أظنه هوميروس الذي كتب إلياذته قبل أن يكسو اللحم والعظم أرواحنا.. وجدته ذات قرن قبل دقيقة من لحظتنا هذه بقرب صديقه دانتي يتناجيان تحت ظلال الغياب ويرتعبان من ذكر الجحيم والفردوس بينما كان يغتسلان معًا في بحيرة المطهر العظمى. ها هي تلوح لنا في الأفق. حدثني.. أقبلت روح إليوت جذلى ترثي «الأرض الخراب».. وظلّ يتلمّس ذكريات القول الشعري واحدةً بعد أخرى حتى قبضت كفه الأثيرية على قصيدته/ المرثاة « الأرض الخراب»، وأخذ ينشد:
«.. على سهول مترامية، تتعثر بأرض متصدعة
يسوّرها الأفق المنبسط وحده
أيّة مدينة خلف الجبال
تتصدع وتعمر وتنفجر في الهواء الشفقي
بروج متهاوية..
……
ما ذلك الصوت الصاعد في الهواء
نشيج نواح الأمهات
ما تلك الحشود المتلفّعة تفيض»
بين القلق الروحي والفزع الجذِل تصادمت الأرواح..
بين الترقب لطائر موت قادم وبين الفرح للقاء روحٍ جديدة،
بين انهمارات الهمهمات وموسيقا الهمسات
تصاعد صوت روح ويتمان عميقًا ممتلئًا بالشمس والهمس واللوعة، يصدح من بعيد ويقترب من ضفة حافة الغياب الأخرى تتساقط كلماته العارمة كالرذاذ:
«ها نحن أيضًا نصعد قبة السماء
مدهشين وهائلين كالشمس،
نجد ذواتنا، آهٍ أيتها الروح، في هدأةٍ وبرودة
انبلاج الفجر»
تقاربت الأرواح أكثر فأكثر فرحة ومضطربة، حين سمعوا دويًّا هائلًا قادمًا من العالم السفلي، الاهتزازات الأرضية العظمى المتلاحقة لم تنتهِ، خلفت وراءها سحابة هائلة من الغبار ورذاذ البحر والنار، وتراقصت في السماء كزهرة فطر هائلة وسوداء، ووصلت أطرافها عند حافة الغياب بضفتيها. صاحت روح هيغل المنزوية في كهفها الأثيري: إنني أرى الآن وفي الأسفل بكل وضوح ميتافيزيقي أنقاض التاريخ تحت ركام الجغرافيا.. يا لها من فينومينولوجيا جديدة للروح، وأنصتت الأرواح كلها متقاربة لصوته العميق القادم كأنه من بئر مثقوبٍ في السماء. اقترب طائر الموت هذه المرة حاملًا على كتفه كيسًا هائلًا بحجم الكوكب الأرضي، محتشدًا بكل الكتب التي كتبت قبل انقضاض الجغرافيا على التاريخ المتهالك، وتركه بين الأرواح المتقاربة مخلّفًا ظل ابتسامة صفراء تقطر رمادًا ودمًا. تجمعت كل الأرواح المفكرة والشاعرة والضالة والهائمة على وجوهها تنقّب في الكيس عن كتابها الذي كتبته بيمناها.. ثم مضت كل روحٍ إلى قممها الفردوسية ترقب بهلعٍ ضاحك ما يجري في العالم السفلي من تحولاتٍ نارية.

أحمد بوقري - كاتب سعودي | مايو 1, 2021 | الملف
مقدمة حوارية، قلت لمحاورتي:
* «ما الذي يعنيه العيش الجيد لك سيدتي؟ كيف تلوح لك صور جودة الحياة في الواقع؟».
** «ببساطة تلوح لي بدءًا على المستوى الشخصي. أن تكون كل حاجياتي ملباة ومشبعة، أو على الأقل هو شعور إنساني جميل يجتاحني كل لحظة كحالات متجددة بالرضى النسبي، ومؤملة أن تلبى بوتيرة زمنية أسرع لو لم تكن ملباة كاملةً. وأن أشعر بقدرٍ من السعادة أو بالرضى المتصاعد بتحقق إنسانيتي وغاياتها ورغباتها الصغيرة والكبيرة، تحققًا نسبيًّا في لحظةٍ ما.. أي بلغة أرسطو: «الشعور بالسعادة والأمل في الآن نفسه». وبلغة الشارع الدالة أن أعيش بعضًا من «البحبوحة» ضمن دائرتي الفردية، وإمكانياتي، وفي كل مناشطها ومظاهرها وتجلياتها على المستوى الجمعي.. وأن أشعر بالانتماء إلى محيطي ودائرة علاقاتي. كل ذلك يؤول في ذهني إلى معنى جودة الحياة».
* «تقصدين الرضى الذاتي وحده، لا الرضى الجمعي!».
** «أقصدهما كليهما.. وفيما أظن، الرضى الذاتي تراكمي في مستواه الأفقي من ذاتٍ إلى أخرى ليس إلا مكوّنًا للرضى الجمعي، وفي نهاية المطاف سيخرج البعد الذاتي للرضى والسعادة من قشرته الأنوية نحو أفقه الجمعي.. حيث لا ديمومة له في غياب فضائه الخارجي، كيف تنظر أنت للأمر؟».
«لا أبتعد كثيرًا من رؤيتك، لكن أجد لزامًا علينا هنا تحديد مفهوم ودلالات وتمظهرات العيش الجيد ماضيًا، وفي الزمان والمكان المعينين حاضرًا. هناك مشترك دلالي كوني لمفهوم جودة الحياة لا يُختلف عليه. لكني أيضًا أجد ما هو نسبي في مكان يتجلى مطلقًا في مكان آخر على هذا الكوكب، بمعنى ما هو نسبي عندك الآن قد يكون في حالة مطلقة لغيرك الآن.. وما كان مطلقًا في لحظة زمنية مضت، أصبح نسبيًّا في لحظة حاضرة، ناهيك عن تفاوت مفهوم الجودة من فردٍ لآخر ومن زمن لزمنٍ. جودة الحياة بالرغم من مشتركاتها العامة ليست ذات قوام واحد على امتداد الجغرافية الكونية.. وعلى امتداد الزمن الكوني، وعلى امتداد الجغرافية البشرية أيضًا، تختلف وتتباين بناء على المستويات الثقافية، وعمق المدى الأنثروبولوجي، وتعدد أطيافه، والأولويات المجتمعية.. والحاجات المتغيرة».
** «وما المشترك الكوني العام في نظرك عند تحديدنا للمفهوم والمعنى والتداعيات المنعكسة؟».
* «هذا ما سأحدده في بحثي هنا… كيف نصل إلى جودة ملموسة للحياة بدءًا من البنى الكبرى الموضوعية الواقعة في دائرة وعينا، نزولًا إلى انعكاساتها وتأثيراتها في البنى الصغرى، وأقصد البنى الذاتية البسيطة الفردية، وطموحاتها في تحقق معايير الرضى والاستمتاع بالحياة.. ونستطيع أن نؤكد في الوقت ذاته أن جودة الحياة ليست ذات مفهومٍ واحدٍ مجرد ومعلق في الفراغ بلا جذور.. لا شك له دوافع، وعوامل مادية اقتصادية مؤسسة وهي في تناسج وتفاعل خلاق مع العوامل النفسية والفكرية والروحية ومتناقضاتها.. أظنك توافقينني هذا الرأي؟».
** «ما تقوله يا صديقي يبدو لي مشجعًا للغاية، ومدخلًا مهمًّا للخوض عميقًا في تأريخية المفهوم والتجليات.. في الواقع والمؤمل.. في النسبي والمطلق.. في الذاتي والموضوعي وما يحقق الوحدة الكلية لهما.. وهذا في نظري، يمهد لمناقشة أعمق لتفكيك المفهوم وإعادة تركيبه في بيئته المعاصرة».
مفهوم جودة الحياة في المنظور الفلسفي
قاربت الفلسفة على مدى تاريخها العريق معنى «جودة الحياة» في معانٍ مختلفة لا تبتعد كثيرًا من جوهر المفهوم المعاصر وغاياته الإنسانية، لكنها كثيرًا ما كانت تشير إليه بمفاهيم مجردة من جذورها الواقعية: كالبهجة أو السعادة، أو كاللذة والرضى والمتعة. إذ بدأ تجلي مفهوم جودة الحياة في الكتابات الفلسفية قديمها وجديدها منذ أرسطو وأفلاطون حتى عصرنا الحالي، في عدم تركيزه على المصطلح ذاته بل ما يؤدي إليه في المعنى، فما زال المفهوم يمتُّ بمرجعيته إلى الحقل الاقتصادي والمادي على الرغم من محاولات تبيئته في حقل الدلالات النفسية والقيمية والاجتماعية.
إن الاشتغال المعمّق على تقليب مفاهيم السعادة والبهجة في التربة الفلسفية قديمها وجديدها، والمقاربات الفلسفية التي ارتكزت إلى مفاهيم الفضائل الأخلاقية والسعادة الفردية واللذة، إنما كان اللبنات الأولى المؤسسة لمعنى جودة الحياة، وليست إلا إنصاتًا لدبيب صيرورة الحياة وقلق المعنى الإنساني الراغب في الحياة المطلقة السعادة في السياقات الزمنية، امتدّ عميقًا وعميقًا جدًّا في التاريخ الفلسفي الكوني.
منذ أرسطو وأفلاطون مرورًا بفلسفات ونظريات الفلاسفة الإسلاميين مثل: الفارابي وابن مسكويه وابن خلدون، وصولًا إلى اشتغالات كانط وإسبينوزا وهيغل، تجلى مفهوم جودة الحياة ليس فيما هو كمصطلح خارج حدود الأنا-خارج حدود النسبي، بل فيما يؤدي إليه في المعنى والدلالة. وظل السؤال في بُعْده الفلسفي مُشرعًا في حدود تجريداته وملموسيته في الواقع حتى اللحظة، في فلسفات معاصرة وليس آخرها فلسفات ورؤى آلان باديو التجريدية.
حلمَ الفارابي بمدينته الفاضلة ومن قبله أَسَّسَ أفلاطون معالمَ جمهوريته، وكلاهما في تقديري حلمَا بجودة فُضْلَى للحياة، ومثالية للمدينة الفاضلة أو السعيدة. وعدّ الفارابي السعادةَ التي هي «أسمى الخيرات وأعظمها وأكملها»، هي ما يشيّد أركان هذه المدينة/ الحلم أو الجمهورية الفاضلة عند أفلاطون، والسعادة التي عناها كل منهما هي السعادة العقلية والروحية ولم يربطاها بمادة أو بشيء ما خارج حدود العقل والنفس، فالسعادة هي الخير المطلق.
وقد يبدو لنا أن تشييد هذه المدينة ليس إلا صرحًا في الهواء أو الخيال لكنه في الحقيقة هو مشروع سياسي أخلاقي، أسس لدولة تقوم فيها جودة الحياة التي هي جودة عقلية ونفسية (من الروح) ضمن حدودها المقترحة على «العمل الجاد، والتعاون والتدبير الحسن، والاحتكام إلى العقل والمنطق وحب الفلسفة والحكمة»، رئيسها فيلسوف فاضل، والفلاسفة هم أعظم أجزائها، ومن داخلها فقط تُمارَس الفضائل الأخلاقية التي هي وحدها مبدأ السعادة للإنسان، خلافًا للمدينة الجاهلية كما يسميها الفارابي التي في نظره مبدؤها الأساس وغايتها هي اللذة واليسر والإشباع حيث لا تراتبية لها.
في جمهورية أفلاطون (التي هي المصدر الفلسفي والسياسي التدبيري لمدينة الفارابي الفاضلة، فهي لا تبتعد في تأسيسها من سياسات مدنية عادلة للحكم في الجمهورية الفاضلة لها تراتبيتها في توزيع المهام نابعة من خصالها العقلية والبدنية، وهي التي تتحقق بها السعادة والتوازن في جمهوريته المثالية كما كان يأمل) الخصلة الرئيسة الأولى: «الحكمة» وهي التي تنتمي إليها طبقة الحكام، و«الشجاعة» وهي التي تنتمي إليها طبقة الحرّاس، و«التحكم في النفس» وهي التي ينتمي إليها الأخلاقيون الذين يضبطون السيطرة على الغرائز والشهوات، أما الخصلة الرابعة فهي «العدل».
ومعنى العدل عند أفلاطون التناغم بين طبقات الجمهورية، وأن كل طبقة تصنع ما هي مهيأة له. وفي استبعادِه طبقةَ الشعراء والفنانين والمبدعين ما يؤكد أن دولته دولة عقل سياسي فلسفي يميل للاستفراد، وسعادتها سعادة عقلية وخلقية تميل إلى الاستبداد العقلي والمعرفي، فالشعراء والفنانون أقرب إلى الخيال والأحاسيس والمشاعر العاطفية التي هي في نظر أفلاطون ذات تأثيرٍ سيئ لاتخاذ القرارات السليمة! هذه المثالية الفلسفية تقودنا إلى مثاليات أخرى في التاريخ الفلسفي المعاصر، تجاوزت كل المفاهيم السابقة والأنساق الفلسفية لكن في نظري لم تقطع معها تمامًا وإن تغيرت اللغة وتراكمت المعارف الوجودية، وتحدثت المجتمعات بنيويًّا.
آرتور شوبنهاور الفيلسوف الألماني الأكثر تشاؤمية كما يُعرَف عنه يبدو لنا في كتابه «فن العيش الحكيم» أنه «قدَّم وصفة دسمة عابرة للأزمنة والأمكنة لفن عيش ممكن»، على حد قول مترجم الكتاب، فكيف لاحت لنا مدينة العيش الحكيم الشوبنهاورية مشيّدة نظريًّا في كتابه هذا؟
إنها مدينة مؤسسة على الممكنات الذاتية وليس الموضوعية، فسعادة الإنسان تنبع من ذاتيته وكينونته لا مما يملكه من ثروات أو ممتلكات، أو ما يمثله في أذهان الآخرين من مكانة، «فالأبلهُ أبلهُ، والأخرقُ أخرقُ حتى النهاية، حتى لو أقاما في جَنّة النعيم تحيط بهما الحور». أما المُطلَق في السعادة، هو فيما نحن فيه من طبعٍ وخصال نفسية وسجايا وقدرات عقلية وبدنية، ومَلَكَات متّقدة. أما النسبية في السعادة، فهو ما يأتي من خارج من خيراتٍ، فالشرط الذاتي لا تغيره الشروط الموضوعية حسب تصوّره. فالسعادة تنبع من «الثراء الداخلي للإنسان، ثراء العقل والروح، الذي بقدر ما يرفع صاحبه ويسمو به بقدر ما يبعده من الملل»، وعدم إحساسه بجمال وجودة العيش من حوله، كما قال أرسطو: «السعادة من نصيب المكتفين بذواتهم».
لا يبتعد الفيلسوف الفرنسي المعاصر أندريه كونت سبونفيل من الفكرة السقراطية الأفلاطونية أو الفارابية، المُتمثّلة في أن الحكمة أي الفلسفة هي مصدر كل السعادات، والتفكير فيها جزء من تقاليدها، والفكرة ذاتها لا تحتمل أنها فكرة خاصة بالتفكير الفلسفي الغربي بل لها خصوصية كونية، أي بمعنى ما إن التقنية الحديثة بكل وسائلها، وهي صادرة من الغرب، تشكل وعدًا بالسعادة للإنسان وجودة لحياته، وحسب قوله: «إنه بات من الممكن أن نحمِل في جهاز الكمبيوتر الشخصي كل الموسيقا التي نحبّها، فهذا يعني أن التقنية قادرة بالفعل على إنتاج السعادة، ولكن لا تستطيع هذه السعادة أن تكون كافية»؛ لأنها راجعة في الأساس إلى الطبيعة البشرية، أي هي ذاتية قبل أن يصبح الموضوع منتجًا لها فمن هنا تبدو نسبيتها، «تساهم التقنية في السعادة ولكنها لا تكفيها»؛ لأنها غير مكتملة.

سعادة الإشباع
أما حسب الفيلسوف الفرنسي آلان باديو الأقرب إلى الألتوسرية (فلسفة لوي ألتوسير)، فالسعادة عنده لا وجود لها في عالمنا المعاصر، وحسب رؤيته القلقة فما هو موجود هو سعادة الإشباع، أي سعادة اللذات الحسية والمادية الفردية: سعادة الاستهلاك، أي أن العالم محكوم بشكل مطلق بسعادة (أيديولوجية الاستهلاك)، والسعادة التي تطرحها هذه الأيديولوجية ليست السعادة الحقيقية، فالسعادة كما هي في نظره قائمة في جوهرها على عدم الرضا الثابت وعدم القناعة بنظام العالم، وينفي التصور الرواقي للسعادة، وهو التصالح مع أقدارنا والرضا بما نحن فيه.
في تصوره النهائي: السعادة الحقيقية هي الرغبة المتأججة لتغيير العالم، وعنده اللقاء بحقيقة «حب» أو بحقيقة سياسية أو علمية أو فنية هي السعادة، والوصول إلى كل هذه الحقائق هو إبداع وظيفته ليس الإمتاع، بل تغيير العالم. ومع أنه في هذه التصورات البسيطة يعيد الاعتبار للتصور الماركسي الذي جعل من مهمة الفلسفة تغيير العالم، وهو ما حدث في روسيا والدول المحيطة، ولم تنل سعادتها المؤملة، يستدرك باديو ويقول: إن العالم ليس واحدًا، وعالمه هو «الواقع المستحيل».
في اعتقادي يدخلنا باديو برؤية الواقع المستحيل في متاهات مفهومية يضرب جوهرها التناقض، وتفتقد لمنطقها اللغوي ومنطقها الفعلي.. وهو لم يقدم إجابة شافية عن الطرق التي تقودنا إلى معنى السعادة الحقيقية التي هي تَجَلٍّ لمفهوم جودة الحياة. إنه في تصوري، ينقض كل الإمكانيات الجذرية للأفعال الملموسة والأفكار الماثلة والمتراكمة التي تحققت في السياق التاريخي الإنساني كله، فيدفع بنا باديو إلى المستحيل الميتافيزيقي على طريقته البروميثيوسية «واصل لا تتخلَّ»!
من أفضل وأمتع الكتب الفلسفية المعاصرة التي قرأتها والتي بثّت بطريقة خلاقة معنى الأمل المطلق والتي تناولت مسألة السعادة، بما تعنيه لنا هنا جودة العيش في طرقها ومسالكها وراهنيتها الفاعلة، هو كتاب الفيلسوف الفرنسي الشاب فريدريك لونوار «السعادة: رحلة فلسفية».. فهو يتفق مع شوبنهاور بأننا «بمرور الوقت نتعلم أن السعادة تنبع من داخلنا، وأن ما يسبب السعادة هو تجلي الذات وتناغمها المثالي الكامل». كيف يبدو ذلك؟ هل السعادة ممكنة؟ حسب قوله: «حتمية ممارسة السعادة في اللحظة الراهنة، تكون بالعودة إلى النفس، والبحث عن الملكة التي بها يواجه الإنسان ما يحدث له».
نعم هي ممكنة الحدوث حين توضع الطوباويات والأحلام التي وضعها الأفراد والفلاسفة موضع العمل والتنفيذ.
يقول الفيلسوف ديفيد هيوم: «النهاية الكبرى لكل نشاط مضنٍ للإنسان هو بوصولة للسعادة، ولهذه الغاية تُبتَكَرُ الفنون، وتُهَذَّب العلوم، ونُظِّمَت القوانين، وشُكّلت المجتمعات بالحكمة الأعمق من خلال الوطنيين والمشرّعين». السعادة الممكنة المستديمة ليست تلك الوقتية والقصيرة المدى، كأن يحصل طفل على لعبة ويسعد بها، أو يحصل عامل على زيادة في دخله، أو يفوز آخر بجائزة مالية ويشتري بها بيتًا أو سيارة، وكما يقول الفيلسوف الروماني لوكريتيوس فإن هذه السعادات الصغرى على أهميتها لا تنتهي، وهي تشبه التعطش للحياة الذي لا ينطفئ فينا.
واللافت إقرار عمانويل بأن السعادة هي دائمًا غير مستديمة ووقتية، وهي ليست إلا «إشباعًا لكل رغباتنا وكل آمالنا وكل ميولنا، سواء كانت ممتدة من حيث تنوعها أو مشتدّة من حيث درجتها، أم أيضًا مستمرة من حيث المدة». وأن السعادة المطلقة -منطقيًّا وميتافيزيقيًّا- غير متاحة على الأرض! إنها هناك ما وراء العالم على غرار الرؤية الأفلاطونية.
تجليات جودة الحياة في الواقع المعيش
بعد استعراضنا للمفهوم في الاشتغالات الفلسفية علينا الوقوف أمام مقاراباته في واقعنا المعاصر، كما يتخذه من مدلولات نظرية وعلمية وعملية. عندما نُخرج هنا المفهوم من قشرته الذاتية الفردية (السعادة والرضا واللذة والمتعة) إلى دائرته الكبرى يتجذّر معنى الجودة في محددات منظومية وأقاليم حياتية متعددة، تبدأ من وعي المنظومة السياسية وأفقها التجديدي إلى المنظومة التعليمية: حداثتها وإبداعيتها، والمنظومة الاقتصادية والإدارية: تماسها مع العمليات المالية العالمية وتلبيتها لحاجات الداخل، والمنظومة الثقافية: تعدديتها وتوسعها الاجتماعي، إلى تحققاتها في بقية المنظومات والتدابير المدنية.
إذًا في مقاربتنا لمعنى جودة الحياة في واقعٍ معين أو بيئة حضرية محددة يتجه بنا القول إلى الخروج من التجريدات الفلسفية النظرية، على أهميتها وثرائها العقلي والذهني، لنذهب مباشرةً إلى الملموس المجسد في الواقع العملي، لكي يصبح لمعنى جودة الحياة معنى حقيقي له استحقاقاته وضروراته الفعلية والعملية وحقوقه الذاتية والموضوعية معًا في غير انفصال. ولعلي أذكر هنا بعض القواعد والمرتكزات العملية، وذلك على سبيل التمثيل العملي وليس النظري، التي من دون تحققاتها وتجليها في الواقع المجتمعي لا يمكننا أن نقطف ثمارًا لمعنى جودة الحياة:
أولها- الحق في جودة العيش ويعني به السكن النظيف الملائم. الحق في جودة الدخل. الحق في جودة الرعاية الصحة. الحق في إبداعية التعليم وحداثته كالحق في الماء والهواء. الحق في جودة الثقافة.. والفنون البصرية والسمعية. الحق في تنوع وتوسّع الترفيه وحريته. الحق في تشجيع ودعم الخلق والابتكار. الحق في جودة البيئة وترطيب قسوتها الطبيعية. الحق في جودة المحيط وعلاقاته التبادلية (المحيط الاجتماعي وخلوه من الإكراهات العصبية والعقدية والقبلية، محيط خالٍ من الوصاية البطريركية، محيط يخضع بكل أفراده وشرائحه لقوة القانون والضوابط الرشيدة). وليس آخرها: الحق في جودة المشاركة السياسية البناءة.
قراءة في «رؤية 2030»
الرؤية والحلم
وقبل تقديم قراءة في رؤية 2030، لا بد من التوقف عند مبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر»، التي تهدف إلى زراعة ٥٠ مليار شجرة؛ إذ تأتي هذه المبادرة اتساقًا مع «رؤية ٢٠٣٠» التي تهدف بدورها إلى تحسين جودة الحياة والبيئة المحيطة. وحلم سموه بتحويل المنطقة إلى شرق أوسط أوربي. لنتخيّل السعودية وما جاورها في ظلال هذه الأشجار. والاخضرار الممتد بعد سنوات قليلة. لنتخيّل الأشجار تزهر براعم الفرح.
وفي قراءة معمّقة لبرنامج جودة الحياة الذي أعدّته «رؤية ٢٠٣٠» الطموحة، ما يشير إلى الانتباه المرهف والذكي إلى معظم هذه المعايير والمرتكزات، التي تشكل المهاد الرئيس لمعنى ومبنى مفهوم جودة الحياة، والوعود بها. ويلاحظ أن هذا البرنامج التفصيلي والعلمي الدقيق لمفاهيم جودة العيش قد وعى أن السعادة الجمعية كما تشمل جانبها الروحي الإشباعي، تشمل جانبها المادي فهي فضيلة علمية وعملية في الآن ذاته. إن برنامج جودة الحياة «٢٠٣٠» أخذ على عاتقه تهيئة المهاد الأولي والضروري في المكان محددًا بجدول زمني قياسي، مشيرًا إلى كل شروط الجودة بشمائلها وخصائصها، بمظاهرها وتجلياتها، بعناصرها وكل ممكناتها الموضوعية، في كل أبعادها المادية والروحية، سواء أكانت اقتصادية أم إدارية أم فكرية وفنية. وهذا لا يعني التحقق المطلق للسعادة الفردية، بل يعني أن هذه البيئة الممهدة صارت مبذولة لكل منا، للأخذ منها بما يحقق نسبية السعادة في إقلاعها نحو التكامل والمطلق والأمل.
وفي تصوري لا يمكننا التمتع بجودة العيش من حولنا إلا بشروط صحية دماغية وقلبية سليمة، إضافة إلى عقلية متفتحة غير تجزيئية التصور، فالسعادة الفردية وحدها تجزيئية وواحدية ذات طابع أنوي، لا يمكنها أن تشعرنا بممكنات جودة الحياة المحققة للكل في المكان، كما يقول شوبنهاور: «إن الاشتغال على أفكارنا واعتقاداتنا عنصر جوهري لبناء حياة سعيدة». بمعنى علينا تحديث أفكارنا الساكنة ونبذ معتقداتنا الاجتماعية السلبية العتيقة. فالتحرر من القلق النفسي والأفكار المسبقة الجاهزة وعصرنة أفكارنا والشعور بالثقة والطمأنينة، فيما هو حولنا، يجعل إحساسنا بجودة الحياة أكثر إيجابية وامتلاء.

أحمد بوقري - كاتب سعودي | نوفمبر 1, 2018 | الملف
ما مستقبل الثقافة في السعودية في ظل التحولات الجديدة (رؤية ٢٠٣٠)؟ لا يمكن أن نفهم مفردة الثقافة هنا في رموزها الإنتاجية وأبعادها الروحية بعيدًا من أبعادها المادية المؤسسية الماثلة أو في حركتها الذاتية معزولة عن علاقاتها المجتمعية، أي في بعدها الذاتي الفردي بعيدًا من منظومتها ونسيجها الاجتماعي، أو تفهم في نظامها القيمي ورمزياته المجردة والمجسدة، بعيدًا من سلوكياتها وآليات عملها وتجلياتها المضمرة والمعلنة، وتأثيرها الحيوي في مجمل هذه الأنساق وبوعي تراكمي متباين في مستوياته من مرحلة تاريخية لأخرى، ومن زمنٍ اجتماعي لآخر.
ما فهمته حقيقةً هي في كل ذلك، الثقافة في شموليتها: (إنتاجًا إبداعيًّا وفكريًّا، ورموزًا وظواهر إنسانية، وحركة وسلوكًا). الثقافة في كليتها وتنوعها لا في تجزُّئِها أو تشظيها.
في راهنها وفي سياق هذا التحول المجتمعي الحثيث؛ هل من تصور لعلاقة جديدة بين الثقافة والمجتمع؟ هل من مستقبلٍ وظيفي على الثقافة ومحركاتها أن تؤديه مجتمعيًّا في السنوات القليلة المقبلة؟
حقيقة قبل الشروع في تفحص واقعنا الثقافي في راهنه كما هو في آفاقه المسدودة وتصحره..
وجدتني مدفوعًا -وأنا أفكر في المستقبل والدور- مستعيدًا كتاب طه حسين الشهير «مستقبل الثقافة في مصر»، فالكتاب صدر منذ ثمانين عامًا وأكثر لكنه في حالتنا وجدته لم يزل يكتسب راهنية وحيوية معاصرة لكونِ أطروحاته الرئيسة لم تزل هي إشكالات واقعنا الثقافي والقيمي محليًّا وعربيًّا. عندما رجعت للكتاب حاولت من خلال إعادة قراءته أن أقترب أكثر لأعرف كيف فكر طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر، وبالتالي كيف علينا الآن التفكير في مستقبل الثقافة في بلدنا؟
الحقبة التي صدر فيها الكتاب كانت حيوية سياسيًّا ومجتمعيًّا في التاريخ المصري، وقَلِقَة على المستوى الرمزي والقيمي والديني إلا أنها كانت واعدة بروح التغيير، تمامًا كما هي حالتنا الراهنة سياسيًّا ومجتمعيًّا، يحدونا التفاؤل بوعود التغيير وحيوية الحراك الاجتماعي في ظل تحولات وطنية طموحة، ملموسة ومتسارعة.
واقعنا الآن في حقيقته واعدٌ وقلق في آن، لكنه القلق الإيجابي المنتج كما ألمسه ينبئ بولادة صعبة وجديدة لمجتمع سعودي غيره بالأمس، وغيره في المستقبل.. الخروج من عباءته القديمة ليس سهلًا بمقياس ثقافي، لكنه ليس صعبًا بمقياس الزمن الاجتماعي. أهمية كتاب طه حسين كونه جاء في زمنه ولحظة كتابته بمثابة (مانفيستو) ثقافي- تربوي، مهّد لمشروع تنويري كبير لم ينغلق في أحاديته الثقافية أو طوباويته الذهنية، بل جاء ممتلكًا آليات الفعل والحركة والدور في أبعاده التعليمية والتربوية، ومؤكدًا على خلفية انتماءاته الحضارية والمكانية وهويته متموضعةً داخل علاقاتها التاريخية بالآخر الأوربي.
عندما نتأمل أفق هذا المستقبل نتأمل في اللحظة ذاتها حالة قرينة وموازية وهي: مستقبل التعليم والتربية الاجتماعية والسلوكية في مجتمعنا.. ونصبح على يقين أن لا مستقبل حقيقي للثقافة والإبداع الفكري من دون العمل على تحديث التعليم ومنظومته كلها من أدناها في الدرجة إلى أعلاها، ونرى ضرورة العمل على تحديد المفاهيم التربوية نظريًّا وعمليًّا وتجديدها وموضعتها من جديد في عالم الدلالات الفلسفية والحضارية المعاصرة ونقد السائد المعرفي واللغوي والمفاهيمي، ونؤكد في سياق البحث والتأمل ضرورة بناء جديد للعقل التربوي واللغة والإنسان قبل الحديث عن عقل ثقافي جديد ومستقبل حقيقي للحياة الثقافية والإبداعية والفكرية.
هل نحن في حاجة إلى مانفيستو ثقافي؟ أو إلى عقدٍ ثقافي جديد يؤسس لمرحلة تنويرية ملحّة؟ من جانبي لا أشك في ذلك، بل أطالب به لأنه سيكون المقدمة النظرية الضرورية ودليل عمل لحراك ثقافي جديد وصحي يخرج حياتنا الثقافية ومشهدنا برمته من حالة التصحر والجمود والمراوحة بين الفقر المعرفي والجفاف العملي. حراك ثقافي جديد يكون رافدًا وداعمًا للحراك الاجتماعي المتسارع الذي تقوده الدولة بكل همة مؤسساتها وهياكلها المدنية. وهذا ما يقودنا إلى أننا في حاجة ملحّة إلى سياسات ثقافية إستراتيجية وعملية وبالتوازي في حاجة إلى سياسات تعليمية وتربوية جذرية ومغايرة لما ساد في السنوات الماضية. إذًا ما دور المثقف بكلّيته المفهومية (مبدعًا ومفكرًا وفنانًا وباحثًا ومتأملًا) في الخروج من هذا المشهد الثقافي العابر وانفتاحه على فضاء اجتماعي أكثر حيويةً وتنوعًا وتفاعلًا؟ في يقيني: بعد الانزياحات الشكلية التي حصلت في واقعنا الاجتماعي أخيرًا وعلى الأقل منها بين الخطاب الديني المتشدد والتصورات المغلقة والمعادية للثقافة وبين الخطاب المدني -ناهضًا من جديد- وتصوراته العصرية المنفتحة على العالم الثقافي الكوني يبدو لي أن صار لزامًا على المثقف السعودي النظر إلى مستقبل الثقافة بشكلٍ آخر.
المشهد بعد الآن لا يُحتَمل أن يبقى عابرًا ومتقطعًا أو غائبًا ومتصحرًا كما كان قبل رؤية ٢٠٣٠، بل في ظني سيتسع المشهد إلى ما هو أكثر بانورامية يتسع له فضاء جمعي أكثر غنًى وتنوعًا وتفاعلًا وجذبًا.
الخروج من زمن المناخات المسممة للحياة الثقافية وتلك الأيدي الخفية التي كانت تضع العصا في عجلة الحركة الثقافية والحداثة الإبداعية يدفعنا بالفعل إلى مشروعية التفكير في مستقبل واعد للثقافة في السنوات المقبلة، ويضع على كاهل المثقف وهو يرسم طريق المستقبل، وعي الضرورة في التقارب المجتمعي وانفتاح الدائرة المغلقة وكسر الثوابت المفتعلة في العلاقة بين المثقف والمجتمع من خلال خلق بيئة حاضنة وسليمة تحقق التمتع الكلي بالمنتج الفكري والإبداعي والفني في فضاء جمعي أكثر اتساعًا (مسرح، وسينما، وندوات، وأمسيات، ومهرجانات موسيقية) بما يحقق ضرورات الانفتاح على الثقافات الأخرى، مع ضرورة الإبقاء على عناصر الخصوصية والهوية الإيجابية غير مرتمية خلف جدار العزلة والرفض للتنوع الثقافي الإنساني وغير متمسكة بالمعاني المتهافتة للمقاومة السلبية إزاء المنتج الثقافي الكوني، بدعوى الخوف من «التغريب» التي صمّت بها آذاننا طيلة عقودٍ عجاف من الزمان؛ لأننا في المحصلة الأخيرة لن نجنيَ غير الخروج من سياق العصر وأفق التاريخ برمته.
ومن هنا نؤكد على وجوب وضع حد للتيار المعادي للثقافة، والمتشدد في خطاباته وتصوراته العقدية كي لا يكون قيدًا على الإبداع الثقافي والفكري، وبالموازاة تحجيم دوره في الرقابة على كل الحياة الاجتماعية والحراك الثقافي، فكفى أن تجمدت وتكلست هذه الحياة في بعديها طيلة العقود الثلاثة الماضية، وقد أحدثت ما أحدثت من الخراب العقلي والانفصام الفكري بيننا وبين الآخر المتحضر بداعٍ متهافت وزائف هو حراستنا من «التغريب» وحراسة هويتنا وخصوصيتنا من الانكشاف والتفتيت، في اللحظة التي سعت وسائل الميديا الجديدة المنفلتة من عقالها إلى اكتساح الخصوصيات والهويات وكسر دوائرها المغلقة..! لقد هيأ الشرط الاجتماعي الجديد وانفتاح أفق رؤية ٢٠٣٠ في تهيئة الكيفيات والظروف الملائمة لتغيير ثقافي حقيقي يجذب المثقف إلى التفكير الجدي في المشاركة والوعي بضرورة إحداث نقلة نوعية في الحياة الثقافية والفنية.
فما فضاءات هذا التفكير الجديد للثقافة؟ وما حاضناته وبيئاته الرئيسة؟
سلطة المثقف
المثقف غالبًا ما يكون منتجًا للمعرفة والموقف معًا. والمعرفة هي في تنوع أجناسها الإبداعية، والموقف يتأتى من المعنى الأخلاقي وضميره المجتمعي وتحولاته، متواريًا في سلطة رمزية.
ودور المثقف لا يشبع لا يؤسس إلا حين يتلقى إنتاجه الإبداعي والفكري في فضاء مجتمعي مفتوح وحر. هو كما تقول خالدة سعيد: «عارف يرتبط بموقفٍ نابع من الضمير الفردي من حيث هو معرفة ووعي في علاقته بالتاريخي والفضاء الجمعي ومن ثمّ سجاله الجمعي». وللمثقف أن يدافع عن سلطته الرمزية أمام السلطة المباشرة للسياسي وإلا فقد دوره وشرعيته في فضاء تلقيه الجمعي، فهو وحده المعنيّ بمستقبل الثقافة ومستقبل التحول والتغيير الاجتماعي يقع تحت وعيه النقدي لأنه مهموم بالنقد لا الانتقاد ومهموم بمفاهيم التجديد والتحول وإعادة تقييمها من وقتٍ لآخر.
وكنت طرحت في مكانٍ آخر سؤالًا: هل على المثقف أن يكون متماهيًا ومنسجمًا ومتصالحًا حتى يرضى عنه المجتمع والسلطة السياسية؟ وضربت مثلًا بسُلطة ذلك المثقف الخائف من المجتمع الذي كان على رأس مؤسس أدبية ويأمر بإيقاف عرض فِلْم لاحتوائه على موسيقا تصويرية، ففي نظره هناك ما يوجب على مؤسسته ألا تبدأ بما يختلف حوله المجتمع! ومثلًا بالمثقف الجسور المحبّ لمجتمعه وغير المتماهي معه، الذي يطلق المبادرات الجريئة فيدخل السينما في مؤسسته ويسمح للمرأة بالجلوس في قاعة واحدة مع الرجال، بل الصعود إلى منصة الكلام أمام جمعٍ من الجنسين معًا. (هذا ما حدث قبل رؤية ٢٠٣٠). تلك سلطة ثقافية غير منتجة ومتماهية وهذه سلطة فاعلة مجابهة ومنتجة للموقف الإبداعي والأخلاقي في آنٍ.
فهل من واجب وجود المثقف أن ينزل بأفكاره وموقفه إلى مجتمعه متماهيًا مع وعيه السائد ولغته المتخشبة فيتبنى هذا الوعي ويتماثل معه ويفقد نقديته؟ أم واجب وجود المثقف أن يرتقي بوعي مجتمعه الساكن إلى مستوى ما يفكر فيه ويمنحه لغته المتخيلة الخلاقة ويكشف له عن جماليات الحياة وإبداعاتها وجديدها وينظر إلى تحولات الوعي المجتمعي المتناقضة برؤية مستقلة عن شرطها السياسي، فيدفع بها إلى نقلات نوعية في البنية الذهنية والرؤية العقلية تتواءم مع الزمن مع واقعها الحضاري المعولم وتندرج في سياقه التاريخي بدلًا من الخروج منه؟
بالطبع لست متبنِّيًا هنا لمفهوم المثقف العضوي بحرفيته الذي سكه الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي واستهلكه التاريخ، كما أنني أرفض موقف المثقف المسطرة في وجهيه العقدي والأيديولوجي (المثقف السلفي) الذي وصفه بدقة المفكر الفلسطيني أحمد برقاوي: «بأنه يحمل بيده خطوطه الحمراء والأسس والقواعد القديمة المتوارثة» غير المبدعة. بل أقول بضرورة وجود المثقف النقدي المبدع الذي ينأى عن الأيديولوجي إلى المعرفي والإنساني والحضاري، المثقف الذي لا يمضي مطمئنًا ضمن مقولة: «إيثار السلامة وتجنب الندامة» في علاقاته مع السلطة السياسية والاجتماعية فيعمل بدلًا من ذلك على إيجاد قواسم مشتركة بين السلطتين الثقافية والسياسية مع إبقاء المسافة بينهما بما يحقق الاستقلالية النسبية للمثقف، وعلاقة طه حسين وثروت عكاشة وإياد مدني -على سبيل المثال- بالسلطة السياسية مثالية في دلالتها على ما تحقق في عهدهم من استقلالية نسبية للعمل الثقافي المنتج. هذا المثقف النوعي هو ما يسوّغ الظروف لوضع سياسات ثقافية خلاقة ومنفتحة على فضائِها الاجتماعي بالمشاركة البناءة مع المؤسسة السياسية والاجتماعية.

من فعاليات الأيام الثقافية بأبها
سياسات ثقافية جديدة.. كيف.. ولماذا؟
قبل عقدٍ من الزمان بالتقريب وضعت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية إستراتيجية ثقافية طموحة لم تكتمل ولم تنفذ وجرى إشراك الأندية الأدبية ومثقفيها في مناقشاتها وصياغتها النهائية. وكنت أشرت في دراسة لي إلى معوقات جوهرية ذهنية وموضوعية أشارت إلى بعضها الإستراتيجية نفسها ولم يجرِ تخطيها لأن الشرط السياسي والاجتماعي الانفتاحي لم يكن مواتيًا كما هو الآن في ظل (رؤية ٢٠٣٠). هذه المعوقات الجذرية لو جرى تجاوزها في تلك السياسات الثقافية لانكسرت الدائرة المغلقة التي قبع المثقف تحت حصارها ردحًا من الزمن ولَكان منكشفًا أمام دورٍ طليعي لمثقف حقيقي في فضائه المجتمعي.
كان يمكن لحلّ العائق الأول متمثلًا في الرؤية الأحادية لقضايا الحياة والدين والمجتمع والمرأة تلك التي «نبذت ثقافة الحوار الداخلي والخارجي والتسامح وقبول الآخر وتعميق الحرية المسؤولة».. كما وردت في الإستراتيجية، كان يمكن أن يضيف لحراكنا الثقافي قيمة حضارية وإنسانية حيث في مملكة الحرية ينتفي تجريم الخيال والمجاز ومحاكتهما.. كما أن حل العائق الثاني في التخلص من (السلطة الأبوية الثقافية) كان يمكن أن يخلصنا أيضًا من ممارسات الوصايا والاستعلاء والإقصاء والفصل بين الجنسين في المجتمع، وهذا ما تحقق في ظل رؤية ٢٠٣٠ مثمنًا إيجابياتها طامحًا إلى تكريس دائرة الانفتاح وتوسيعها لخلق بيئة خلاقة ليؤدي المثقف دوره الحضاري والاجتماعي بكل سلاسة. أما حل العائق الثالث بتجاوز إشكالات الرقابة التي مارستها بعض المؤسسات الثقافية والأهلية بأطيافها المتعددة على نفسها وعلى غيرها أو تلك الرقابات التي يمارسها المجتمع ضد نفسه، أو الرقابة الذاتية القاتلة التي يمارسها المبدع ضد إبداعه وفكره فإنه كان سيدفع بحراكنا الثقافي تمامًا إلى وضع أسس جديدة ومغايرة لسياسات ثقافية منتجة وذات بعد حضاري تشارك فيها السلطتان معًا السياسية والثقافية.
التخلص من هذه العوائق وغيرها كثير وغير منظور في يقيني سيمهد لعلمنة حقيقية للفعل الثقافي، ويمهد لحاضنة خصبة لدورٍ جديد لمثقفٍ جديد في بيئته المجتمعية وفضائه الثقافي، بل يصنع مسارًا للحراك الثقافي ليتحرك في خطٍّ أفقي تفاعلي بدلًا من الدوران الدائري حول نفسه والانغلاق على ذاتية الإبداع والتفكير.
مناهج تعليمية مغايرة ومتقدمة
لن يكتمل الدور التاريخي للمثقف إنتاجًا وفكرًا وتأثيرًا وموقفًا إلا حين يعاد النظر في المناهج التعليمية والتربوية، تلك البيئة الخصبة التي انتبه إليها طه حسين في كتابه المشار إليه، محددًا الإقلاع الثقافي الحقيقي من حقولها وفضاءاتها، من خلال عمليات إصلاح جذرية للمنهج واللغة العقلية والأدبية والنفسية بل امتد الإصلاح إلى المعلمين والتلامذة. فما الذي ننظر إليه ثقافيًّا في مناهجنا التعليمية الحالية، وما الذي نسعى إلى تغييره ليحقق دورًا أكبر للمثقف والثقافة بحيث يلعبان تأثيرًا واعيًا في المجتمع ونقله نظريًّا ورمزيًّا، وتربية وعيه وخلقه الإنساني إلى حالة أرقى من التقدم والانفتاح على التنوع الثقافي الكوني.
السؤال الذي يطرح نفسه أمامي هنا: ما كمية ونوعية الجرعة الثقافية التي يقدمها منهاجنا التعليمي في مدارسنا وجامعاتنا؟ إشكالية كهذه لا بد من طرحها ومعالجتها في أي إستراتيجية ثقافية جديدة تدفع بتغيير واقع ازدراء الثقافة الجديدة والمعاصرة وتهميش دورها الفاعل المكرس في المنهج الأدبي التعليمي، لكي لا يبقى عقل تلاميذنا أسير ثقافة السائد ورؤية التقليد لا التجديد. على هذا الواقع التعليمي أن يتجاوز بؤس المادة الثقافية والأدبية المقدمة لعقول شبابنا بوعي نقدي ومغاير، فيلتفت إلى المنير والجذري والتقدمي في تراثنا العربي الإسلامي؛ إذ يجري بشكل واضح تغييب الإنتاج الفكري والفلسفي والإبداعي القديم لمفكرين ومبدعين كابن رشد وابن سينا والفارابي وشعراء كأبي نواس وبشار بن برد والحلاج بحجج عقدية وبعقلية إقصائية تسلطية.
كما على مناهجنا الجديدة أن تلتفت إلى الجديد والمدهش والنقدي والإنساني في نصوص الحركة الأدبية المعاصرة، فلا يمكن أن نركن في دروس اللغة والأدب إلى نصوص الحركة الأدبية حتى منتصف القرن الماضي وحدها كأن الأدب واللغة والخلق الإبداعي توقف هناك ولم يتطور..!
كما لا يمكن بقاء هذا الواقع بائسًا في معطياته الثقافية وطرق تدريسه للغة والأدب والفكر لأن بقاءه بعد (رؤية ٢٠٣٠) فيه إجهاض لروح الرؤية وغاياتها في جودة الحياة فكرًا وواقعًا، ولا يخدم دور الثقافة والمثقف في التأثير الحقيقي والجذري في المجتمع والإنسان.

أحمد بوقري - كاتب سعودي | مايو 1, 2018 | دراسات
مقدمة في جماليات النص: عندما نحضر إلى نصوص محمد علوان السردية المائزة، لا بد أن تستيقظ حواسنا البصرية والذهنية والانفعالية تمامًا للرؤية والرؤيا في آنٍ.. فتخلبنا جمالية اللغة في تشكيلاتها الرشيقة، ويأسرنا المتخيل السردي مبتكرًا واقعه وإحالاته الجديدة. نصوصه البديعة ليست مكتوبة للمتعة الفنية ولا من أجل اللعبة اللغوية التخييلية فقط بل توسلت نحت اللغة ولُعب التخييل لتعكس في مرآتهما صيرورات الذات الساردة – المسرودة: مصايرها وتحولاتها عبر أزمانها الواقعية. نحن أمام نصوص مصطخبة بهموم الواقع والفرد معًا، وهموم الميتاواقع والمافوق، بمعنى أنها لا تتوقف عند جماليات السرد وفنياته فتتعداها للزخم الرؤيوي الذي تحتشد به مفرداتها الحية.. نحن إزاء نصوص تعرف ما تقول وما تبوح به، تتوارى بحزنٍ أو بفرح لما تقوله أو تكتشفه أو تعريه.. إنها لعبة تشكيل ومعنى وكشف، لا لعبة سردية مُنبَتَّة الصِّلة بتاريخها ومرجعيتها أو مستقطرة من تجريداتها أو تهويماتها. مارَسَ علوان دهشة السرد – الرؤيا، والرؤية – اللغة – كما يمارس الفيلسوف دهشة السؤال- منذ مجموعته المائزة «الخبز والصمت»، فكتب يحيى حقي مدهوشًا بتقنية السرد وجدّته ومثمنًا هذه الثنائية الخلاقة التي تجاوزت مفهوم القص التخييليّ إلى مفهوم القص الواقعي منغمسًا في التخييل الواقعي المحتمل والممكن..!
منذ «الخبز والصمت» المجموعة العلامة الفارقة في التجربة القصصية السعودية حتى «هاتف» الأخيرة، ومحمد علوان يصقل عوالمه الميتاواقعية التي لا تنفصل عن واقعه الحلمي وما بعد الواقعي في توازٍ مجازي ومجاوز وإن لم يبتعد في جُلّ نصوصه من عصب المعيش واللّامعيش!.. انتقلت واقعية محمد علوان من الفردية المغمورة في أحلام الجماعة في نصوصه البكر إلى الفردية المنغمسة في حلمها البسيط والفطري والإنساني كما في «دامسة»، و«هاتف» وستكون لي وقفات سريعة عند هذه النماذج النصوصية – العلامات لنكتشف كيف نجح علوان في تضفير الذاتي بالموضوعي مشكلًا بنيته السردية المائزة.
في هذا السياق ألحّ علي سؤال مركزي في القراءة النقدية للسرديات: هل ظلت القصة القصيرة تعبيرًا لحظويًّا عن تحولاتٍ حميمة في عالمها ونسيجها الاجتماعي؟ عندما سألت القاص محمد علوان عن مرجعيات القص لديه؛ هل من مرجعية ذاتية لا تنفك علاقاتها بالمكان والزمان لها وشائجها الباقية في الوعي واللاوعي؟ أم هي من هواجس المكان وينابيع الذكرى؟
أجابني: هواجس المكان والذكرى تبزغ في لحظة لا أستحضرها، وربما لا أُمنحها بقصدية.. مسألة الكتابة تكتب نفسها بنفسها غير أني أرقب دائمًا نضوج اللحظة.. النص هو الجنون ذاته الذي لا يستدعي طبيبًا. فهل انتمت مجموعته الأولى إلى عالمها الموضوعي الخارجي جماليًّا أم انكفأت إلى عالمها الداخلي أم زاوجت بينهما؟ وكيف تفاعلت مجموعته الأخيرة «هاتف» مع العالمين رؤيويًّا وتشكيليًّا؟

محمد علوان
سأحاول في متن هذه القراءة تتبع تذبذبات هذا المؤشر التحولي من مستواه الجمعي – الضرورة، إلى مستواه الفردي – الحرية. إلا أن التحول السردي يبدو جليًّا نائسًا بين اللغوي والتخييلي في أغلبية نصوص علوان، فملامح التشكيل الفني والرؤية الجمالية يرصد فيها هذا الانتقال الهادئ من الواقعية الجديدة في صورها النقية والقريبة من جذورها الجمعية في المكان والزمان إلى صور الواقعية النقدية المشبّعة برؤى الفرد وتخيلاته وصبواته واستيهامات الانكفاء على الداخل. اتخذ النص السردي عند علوان ملامحه بين صوره الانعكاسية المتعالية والمنفصلة – المتصلة عن واقعها في بدايات تجربته نحو الصورة الفنية ذات المرجعية الذاتية فتمرأى الواقع مضطربًا ذاهبًا إلى صورة تخييلية حلمية إمّا متشظيًا متفتتًا في أحداثٍ منثورة مفتقدة لسياقها التتابعي الزمني أو متشكلًا من جديد في اللغة الفنية منسكبًا في رؤى وتجليات واقع حلمي متخذًا صورة خلاصه الفردي. لحظتا التشظي والتشكّل ليستا إلا لحظتَيِ اللغة – التخييل في إرهاصات سردية تحققان التوافق بين ما هو إنساني وما هو واقعي وما هو تجريدي وما هو تخييلي في وحدات سردية قد تجتمع كلها في نصٍّ واحد.
تتفتت هذه اللحظة الإبداعية إلى لحظاتٍ من التناقض والتصارع بين ما هو واقعي وميتاواقعي في حالة من فقدان الجسور المرئية مع خارجها متحولة إلى حالة قصصية تحاول أن تبني جسورًا لا مرئية جديدة داخل فضائها وعالمها الذاتي المحبط في محاولة لإعادة التشكيل الجمالي والتمثيل الواقعي، لكن هذه المرة عبر التمثيل الجمالي اللا انعكاسي لرؤية ذاتية طاغية لم تشفَ من وشائجها وعلاقاتها الخارجية ولم تستطع التخلص من ذاكرة المكان وزمنها النفسي. وهو ما يقودنا إلى اكتشاف أن التجريبية الجديدة في القول السردي عند علوان في قصصه الأخيرة ليست إلا تحولات فنية في خلق تشكيل سردي مغاير. هذا التحول الجمالي ليس بالضرورة معنيًّا بمفهوم الانفصام المطلق مع بداياته المائزة في تشكيل عالمه السردي كما في «الخبز والصمت» بقدر ما هو دالّ على تحول لغوي ورؤيوي فني في مفهوم السرد وقدرة جديدة على تخييلٍ لواقع ما بعد، لا يقطع مع ملامح واقع الماقبل.
تميزت قصص علوان بأنها كانت تمتح لغتها وقوامها من طين القرية وذاكرتها غير منفصلةٍ عن آليات الغرف من نبع الخيال والطفولة.. هذا النحت الجمعي شكّل بين يدي علوان وليدًا فنيًّا مغايرًا فانبثق هاجسه الجمالي مقتربًا من الواقع ومبتعدًا منه في الآن ذاته. فابتعدت نصوصه التشكيلية.. أقصد لوحاته البوحية من همّ الانغماس في تفصيلات الواقع وصيروراته ومآلاته، إلى همّ الرؤية الناقدة من بعد في نأيٍ جلي عن تجسداته أو مؤثراته المباشرة التي كانت لا تنفك تحط على أسطح نصوصه كأطيافٍ ولمحاتٍ متماوجة تلوّن النسيج القصصي المتخلّق من واقعية التخييل وواقعية اللغة الساردة لا من الانعكاس المرآوي السطحي واللغة الباردة وهو ما أضفى على بنية السرد العلواني بعدًا واقعيًّا جديدًا ومغايرًا.
شعرنة الواقع ورصد تحولاته في اللغة – التخييل
المتابع لتجربة علوان القصصية لا شك يرصد لديه هاجس التشكيل اللغوي وشعرنة الحدث القصصي، فلغة النص: شعر – سردية بل إن كثيرًا من نصوصه قصائد- سردية، وقليلًا ما يذهب سرده في سياق تتابعي زمني للحدث، ويغيب الحدث في بعضها ليصبح البوح اللغوي هو الحدث أو الحوار الداخلي التذكري ضمن تيار الوعي هو لحمة النص. اللغة هي الحكاية وهي بدء السرد ومنتهاه، في إطار فلسفته الجمالية في الكتابة. وتكاد تكون الموضوعة الرئيسة في قصصه هو ابتكار الحلم ونقد الواقع المعيش، غير أن هذا الابتكار الجمالي للحلم لا يفلت من محرضات هذا الواقع فنجد الحلم يتشكل وفق صيرورة من الأحداث الصغيرة المختزنة في الذاكرة واللاوعي مسوقة في سلسلة من المشاعر والأفكار والمناجاة الداخلية متحولة في نسيج النص الكلي نحو بنية سردية متماسكة.. نحو واقع فني ممكن. اللغة الساردة في نصوص علوان ليست سردية.. تقترب من البوح الشعري منكشفة في متتاليات حكائية لها بدء ولها منتهى وتكاد تنفلت كثيرًا من العقدة والحبكة وتختفي لحظة التنوير لكنها كومضة سردية لا تفتقد وحدة انطباعها. اللغة الساردة ليست مستكينة لتقاليد السرد وخصائصه وعناصره الفنية.. هي في ثورة فنية وشعورية تكاد تكون نسيج وحدها، هي لغة لاقطة موشورية تضفر في أطيافها ملامح سرديات وأطياف أحداث ورؤى وتداعيات واستيهامات حلمية، يتفتت الحدث الجوهري في الفكرة ويعاد تشكيله في اللغة وفي أفق التخييل ومن ثمّ يجعل من الفكرة عظمًا مكسوًّا بلحم اللغة ملمّحًا لجسد الحدث أو اللاحدث! هو نوع من السرد يلامس الواقع بخفة وينأى عنه في ذات الوقت. وتتفتّق الصورة الفنية في صورٍ متعالية تكاد تكون تجريدات ما فوق واقعية. في مجموعته المتميزة «دامسة» يكاد السرد يتخذ سمتًا آخرَ يتخلص علوان في بعض نصوصه من غياب الحدث أو تفتته، إلى تركّزه في وحدة انطباعية جديدة حتى لو لم يبتعد النص من أفق التحليق المافوق واقعي، منجذبًا إلى زوايا التقاطٍ رؤيوية مضببة باللغة ومتسربلة بالتخييل غير مبتعدٍ من ذات مستويات تقنياته ومفاهيمه السردية وتشكيلاته اللغوية النائية عن الخوض في المنظور الأرسطي التتابعي.
إذًا النص القصصي العلواني ليس وحدة سردية واحدة.. هو نص لجماع وحدات سردية متقطعة ومتداعية كما قال الشاعر الفرنسي فيرلين: الأسد ليس إلا قطيع من الخراف المهضومة.
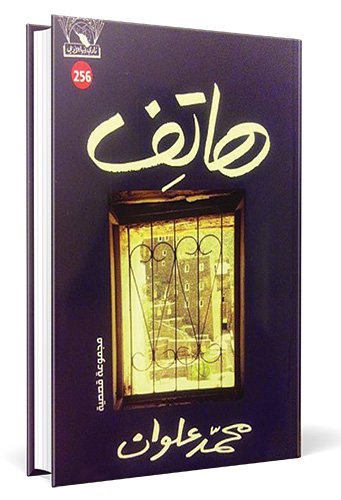 في قصة «دامسة» يستعيد علوان اللامرئي ويجسده في الحركي والجوهري، فكما هي الثيمة الفنية التي تستولي على طرائق البوح السردي في عالمه الإبداعي فإن الحدث الخارجي يتسرب عبر الوعي لا عبر التشكيل الفني له. فالوعي بالصيرورة الواقعية يخلق عنده وعيًا مجاوزًا لحقيقته فيتم عبر هذا الوعي القلق تخليق الرؤية وتشكيل الموقف. يقول الناقد لوسيان غولدمان صاحب البنيوية التوليدية ونظرية الوعي المطابق: كل حدث اجتماعي يستند في بعض جوانبه إلى عملية تشكيل لوعي جديد وكل وعي ليس إلا تصورًا مطابقًا أو وعيًا مطابقًا مع بعض جوانب الواقع وليس كلها. فثمة وشائج فنية في الحقيقة تربط بين مجموعات محمد علوان نتلمسها في تفتيت سردية الحدوتة وانكساراتها في الذاتي والموضوعي.. في الحلمي والتخييلي وفِي اللغة الساردة أيضًا حيث الذاتي في جل قصصه يضيء موضوعه لكن لا يسير في سياقاته ومصايره.. كل نص يخلق مكونًا مصيريًّا جديدًا. أرجع إلى نص دامسة الذي ضمته مجموعته الثالثة بنفس العنوان، وأنا هنا أذهب إلى النصوص العلامات في تجربة علوان ولا أتناول بالتفصيل كل مجموعة.. أذهب إلى النصوص التي تؤكد رؤيتي النقدية والجمالية في السرد العلواني. اللامرئي في قصة دامسة هو شجرة الحب- العشق المكبوت النامية بغتة في الظلام الدامس والمؤول إليه هي الفتاة دامسة وهو اسم الحبيبة الذي طابق الزمن والمكان في دفقة شعورية غامضة.. واللامرئي أيضًا هي الحبيبة لا ملامح لها غائبة في الظلام وتسمى به وتصيب حبيبها بالجنون. وقد لعب المكان في هذا النص – ويكاد يكون هو المرئي الوحيد- دورًا جوهريًّا كحاضن لحركة القص في تصاعدها وتناميها كما لعب الزمن النفسي غروب الحبيبة- غروب المكان لعبته التخييلية المتقنة.. وعزف سيمفونية حزنية للغروب الجزئي الذاتي الرومانسي بكل إيحاءاته ومخزوناته في الذاكرة متوحدة مع الغروب الكلي المأسوي المتصاعد إلى غروب حالك دامس للمكان كله.. إنها الحركة الأخيرة لموسيقا الزمن.. الحركة الإيقاعية الساكنة والمنحدرة تأخذ معها إلى هوّتها كل الأحلام الصغيرة والأمكنة المألوفة ويغيب في فوهة الزمن الفاغرة وجه الحبيبة المباح فينطبق الاسم والمعنى وينطبق المكان على الزمان ويتحولان إلى سديم في عين العاشق الذي ذهب عقله.. بل يصبح ذهاب العقل الشتيمة العذبة الرقراقة: «الله يأخذ عقلك» التي قذفته بها الحبيبة في بداية النص حقيقيًّا ونافذًا كما لعبته لغة علوان في نصه هذا مفعمة بطاقة التخييل المبدعة في إنتاج الدلالة الفنية ونجحت في ترك الأثر الانطباعي البلاغي والصوري للنص في ذهن المتلقي.
في قصة «دامسة» يستعيد علوان اللامرئي ويجسده في الحركي والجوهري، فكما هي الثيمة الفنية التي تستولي على طرائق البوح السردي في عالمه الإبداعي فإن الحدث الخارجي يتسرب عبر الوعي لا عبر التشكيل الفني له. فالوعي بالصيرورة الواقعية يخلق عنده وعيًا مجاوزًا لحقيقته فيتم عبر هذا الوعي القلق تخليق الرؤية وتشكيل الموقف. يقول الناقد لوسيان غولدمان صاحب البنيوية التوليدية ونظرية الوعي المطابق: كل حدث اجتماعي يستند في بعض جوانبه إلى عملية تشكيل لوعي جديد وكل وعي ليس إلا تصورًا مطابقًا أو وعيًا مطابقًا مع بعض جوانب الواقع وليس كلها. فثمة وشائج فنية في الحقيقة تربط بين مجموعات محمد علوان نتلمسها في تفتيت سردية الحدوتة وانكساراتها في الذاتي والموضوعي.. في الحلمي والتخييلي وفِي اللغة الساردة أيضًا حيث الذاتي في جل قصصه يضيء موضوعه لكن لا يسير في سياقاته ومصايره.. كل نص يخلق مكونًا مصيريًّا جديدًا. أرجع إلى نص دامسة الذي ضمته مجموعته الثالثة بنفس العنوان، وأنا هنا أذهب إلى النصوص العلامات في تجربة علوان ولا أتناول بالتفصيل كل مجموعة.. أذهب إلى النصوص التي تؤكد رؤيتي النقدية والجمالية في السرد العلواني. اللامرئي في قصة دامسة هو شجرة الحب- العشق المكبوت النامية بغتة في الظلام الدامس والمؤول إليه هي الفتاة دامسة وهو اسم الحبيبة الذي طابق الزمن والمكان في دفقة شعورية غامضة.. واللامرئي أيضًا هي الحبيبة لا ملامح لها غائبة في الظلام وتسمى به وتصيب حبيبها بالجنون. وقد لعب المكان في هذا النص – ويكاد يكون هو المرئي الوحيد- دورًا جوهريًّا كحاضن لحركة القص في تصاعدها وتناميها كما لعب الزمن النفسي غروب الحبيبة- غروب المكان لعبته التخييلية المتقنة.. وعزف سيمفونية حزنية للغروب الجزئي الذاتي الرومانسي بكل إيحاءاته ومخزوناته في الذاكرة متوحدة مع الغروب الكلي المأسوي المتصاعد إلى غروب حالك دامس للمكان كله.. إنها الحركة الأخيرة لموسيقا الزمن.. الحركة الإيقاعية الساكنة والمنحدرة تأخذ معها إلى هوّتها كل الأحلام الصغيرة والأمكنة المألوفة ويغيب في فوهة الزمن الفاغرة وجه الحبيبة المباح فينطبق الاسم والمعنى وينطبق المكان على الزمان ويتحولان إلى سديم في عين العاشق الذي ذهب عقله.. بل يصبح ذهاب العقل الشتيمة العذبة الرقراقة: «الله يأخذ عقلك» التي قذفته بها الحبيبة في بداية النص حقيقيًّا ونافذًا كما لعبته لغة علوان في نصه هذا مفعمة بطاقة التخييل المبدعة في إنتاج الدلالة الفنية ونجحت في ترك الأثر الانطباعي البلاغي والصوري للنص في ذهن المتلقي.
لا شيء غير اللغة الشعرية المتدفقة خالقة لفضاء السرد في نص الحكاية تبدأ هكذا الذي هو عنوان المجموعة القصصية الثانية لعلوان. كُتب النص كقصيدة نثر بل كنشيد شعري مأسوي متلظٍّ بعطش الصحراء: الريح تجوس خلال الرمل.. خلال الأشجار والشجر معرّى من أوراقه.. الريح.. الريح تخرّ الوجوه وجهًا وجهًا.. اللغة في هذا النص هي مفتاح السرد وبابه وفضاؤه.. وعندما نقرأ هذا المقطع بعيدًا من أجواء النص يحيلك إلى لحظة شعرية مشبعة بالأنين: اللحظة… انفصلت العربة الأم.. اللحظة التي لا تُحَدُّ بزمان أو مكان أصبحت في مجال لا معلوم.. بكى الرجل.. صرخ الطفل.. الأم الأرض أغرقتها أمطار الحلم.. أروتها الأنهار اللامرئية. من يأتي إلى نص الحكاية تبدأ هكذا الميتاسردي على أنه يمتلك خصائص القص وعناصره سيصاب بالإحباط والدهشة معًا؛ لأنه -أي القارئ- لا يستطيع القبض على علاقات داخلية للحدث الجوهري متتبعًا تصاعدًا منطقيًّا له ويصدمه المشهد الأخير من النص الذي تنفصم عراه وعلاقاته الداخلية مع مشهدية رحلة العذاب والموت والضياع.. ولا بد يتساءل: هل المشهد الأخير حين يهمّ الرجل البدين بالنوم مع زوجته لكي تبدأ حكايتهما دالٌّ على فعل ديمومة وبدء الحياة من جديد؟ هل البدين ليس إلا هو ذاته الطفل الخارج من جسد أمه الميتة؟ أسئلة دهشة يتركها لنا النص تنثال بمرارة طعم التراب في الحلوق الناشفة.. هذه الدهشة الجمالية تتأتى من النص نثرًا ليس إلا بذورًا من شجرة اللغة حرّكت طاقات التخييل والتداعيات وهي في ظني ليست إلا أحداثًا غير منظورة يؤول إليها النص كما قال جبران خليل جبران في شذرة ذكية: إن البذرة المختفية في قلب التفاحة هي شجرة غير منظورة.. فما كنه الحكاية إذًا في نص الحكاية تبدأ هكذا وقد تُرك النص مفتوحًا على كل الاحتمالات؟

يحيى حقي
كما قلت: منذ «الخبز والصمت»- النص، عندما صدحت صرخة اللغة المدوية بـ«لا» كبيرة عجزت عن التعبير عنها أصابع الفتى اليمنى المسرود عنه؛ لأنها مصابة بجرح قديم موروث أبًا عن جد.. حتى «هاتف» – النص حيث ألم الذكرى والفقد صار منبعًا لهاتف داخلي غامض يقود السارد إلى الأمكنة الحميمة.. هذا الهاتف معادله الموضوعي: الهاتف الآلة، حيث يلعب تخييل الذات الساردة إلى استحضار الزمن الخارجي المنقضي في لحظة باهرة في أتون الزمن النفسي ينكأ بمشاهد الأمكنة القديمة للراحلين ويستعيدهم فردًا فردًا ويحلم بمهاتفتهم غير أنه يصدم بحقيقة واضحة بسقوط أرقام هواتفهم من دليل الهاتف. أقول منذ المجموعة الأولى لعلوان حتى مجموعته الأخيرة وهمّه الفني الأساس تغيير شروط كتابة القصة القصيرة، فاجترح -في نظري- ثورة فنية قوامها اللغة – التخييل وسطحها الواقع المتشظي. لم يرتكن إلى مفهوم البنية التقليدية كما لم يكتفِ بالأفق الحداثي بعيدًا من جذره الواقعي والتاريخي. زاوج علوان بين الأفق وبين الجذر.. الأفق هو كتابة قصة مغايرة يتناغم فيها الحداثي والواقعي والنفسي والشعري في رباعية جمالية خلاقة.. فجاءت قصصه- نصوصه- قصائده السردية تجلِّيًا لهذه الأبعاد والأضداد!
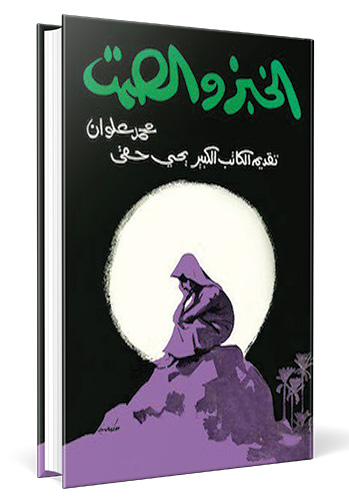 «هو وابنته والكلب».. في هذا النص البديع يتجلّى وعي علوان الجمالي والشعري.. فالصورة فطرية بسيطة مفعمة بالحلم والرغبات.. محفوفة بالجوع الخارق حيث افتضاض بكارة الطبيعة تؤول بالنتيجة إلى افتضاض بكارة الإنسان متربصًا بالأوهام والخراب.. جوع العصفور المحبوس أعلى أغصان الشجرة خائفًا من التقاط الحب المنثور تحت الشجرة مساوٍ لجوع الكلب المتربص للعصفور ومساوٍ لجوع الفتاة سعدى الغريزي تحت ماء قِربتها وهو يسيل حزنًا وشهوة.. ومساوٍ لجوع أهل القرية للماء وقد اكتشف في آبارها البترول واعدًا بالأحلام والأوهام.. هكذا نرى الجوع منقسمًا ثلاثَ وجوه.. يتبدى أولها في الجوع الفطري الغريزي منتقلًا إلى الجوع الوهمي للثروة ومنتهيًا إلى الجوع المأسوي – جوع الكلب ملتهمًا العصفور الجائع.. وجوع الفتاة الشهويّ وقد استحال جفافًا بعد أن ذهب الماء عنها عندما خربت الأرض وفضت بكارة الطبيعة.. الفعل المؤلم لا بد أن يؤول إلى خراب مطلق.
«هو وابنته والكلب».. في هذا النص البديع يتجلّى وعي علوان الجمالي والشعري.. فالصورة فطرية بسيطة مفعمة بالحلم والرغبات.. محفوفة بالجوع الخارق حيث افتضاض بكارة الطبيعة تؤول بالنتيجة إلى افتضاض بكارة الإنسان متربصًا بالأوهام والخراب.. جوع العصفور المحبوس أعلى أغصان الشجرة خائفًا من التقاط الحب المنثور تحت الشجرة مساوٍ لجوع الكلب المتربص للعصفور ومساوٍ لجوع الفتاة سعدى الغريزي تحت ماء قِربتها وهو يسيل حزنًا وشهوة.. ومساوٍ لجوع أهل القرية للماء وقد اكتشف في آبارها البترول واعدًا بالأحلام والأوهام.. هكذا نرى الجوع منقسمًا ثلاثَ وجوه.. يتبدى أولها في الجوع الفطري الغريزي منتقلًا إلى الجوع الوهمي للثروة ومنتهيًا إلى الجوع المأسوي – جوع الكلب ملتهمًا العصفور الجائع.. وجوع الفتاة الشهويّ وقد استحال جفافًا بعد أن ذهب الماء عنها عندما خربت الأرض وفضت بكارة الطبيعة.. الفعل المؤلم لا بد أن يؤول إلى خراب مطلق.
النص والتلقي
يطرح نص «ذهول» البديع القصير والدال، لمحمد علوان وهو أحد النصوص الحديثة مسألة مهمة جدًّا هي: كيف يُتلَقَّى النصُّ داخلَ النصِّ؟ كما يطرح علينا نحن قراء نصه السردي كيف كان تلقينا للنص اللغوي الحاضن؟ النص/ اللوحة داخل النص/ اللغة يجتمعان معًا داخل نصٍّ واحد تفاعلي وجدلي في آنٍ..! التخييل والترميز والميتاواقع المتحرك هنا ليس إلا إعادة إنتاج للنص الجامد/ اللوحة وحركته هي في مبتغى تسييله في نص لغوي موازٍ ومطابق لحركة الواقع! فالنص نصان غير منفصلين لحمته وسداه هي حالة الذهول الوقتية المنبثقة من درجة الارتماء داخل الإطار اللوني، والفاصلة بين حركة السكون وسكون الحركة القابعة في مستوى القراءة الصامتة. الحركة التي ينتجها النص اللغوي السردي لعلوان هي المسافة غير المرئية بين اللون والحرف… بين الإطار – الحصار وانفتاح الخارج والمعنى. جرس الواقع ضاغط وحصاره زمني مباغت يؤول إلى ميتاواقع اللحظة المتلقية، وهو ما يدفع بنا وبكاتب النص كمتلقين مركبين للنص إلى الخروج القسري من حالة التلقي الاستيهامية ليعيدنا إلى حالة التلقي الذاهلة في بعدها الساكن.. وما تلقينا نحن الخارجين عن النص إلا تلقي لنصين معًا في حالة اشتباكهما الحيوي معًا.
ذهول
داخل هذا المتحف الضخم.. والتاريخ يحاصرك من كل جانب.. هذا الصمت الذي يشعرك بمسحة فرشاة الرسام.. صوت إزميل النحّات.. أنت الآن في خزانة الفن.
وقف مذهولًا أمام تلك اللوحة الصغيرة المذهلة.. ظل يتابع تفاصيلها..
ثلاثة رجال بقبعاتهم المتشابهة وأمام ثلاثة كؤوس وزجاجة ثبّتت تلك اللحظة.. المشهد تنقصه الأنفاس.. حركة الأصابع والرموش لكي تكون الصورة مشهدًا تبعث به الحياة الحركة.
داخل حالة الدهشة تلك، شعر أنّ يد أحدهم تمتدّ إلى الزجاجة تمسك عنقها.. تسكب ما في جوفها إلى الكؤوس الثلاثة.
شعر أن السمكة التي في اللوحة تكاد تصدر رائحة شوائها.. بل أبصر بخارًا وكأنه يخرج.. تخيّل الرائحة والطعم والمذاق.. امتدت يد أحدهم لتعبث بإتقان بجسد السمكة وأخذ يوزع على صاحبيه.. لم يتبقّ منها سوى تلك الأشواك المتماسكة.
القبعات مع مرور الوقت أصبحت فوق الطاولة.. خشي أن يصدر صوتًا أو غناءً أو صراخًا.
لم يلتفت لا يمنة ولا يسرة.. ركّز بكل أحاسيسه على ما يحدث في هذه اللوحة.
غير مصدق ما يجري.
فجأةً انتشله من انغماسه في اللوحة جرس.. التفت فإذا بزوار المتحف يتجهون إلى باب الخروج… أما هو فقد ارتبك وشعر كأنه كان نائمًا أُجبر على اليقظة.
أعاد النظر إلى تلك اللوحة فإذا بها جامدة مثلما شاهدها أول مرة…
الرجال الثلاثة يعتمرون قبعاتهم والزجاجة ملأى والكؤوس فارغة.. لكنه أحس بالذهول.
محمد علوان – ٢٣ سبتمبر ٢٠١٥م

أحمد بوقري - كاتب سعودي | نوفمبر 6, 2016 | مقالات
 لمّا كتبت قبل ثمانية أعوام مقالة عن الظاهرة الأوبامية البازغة (نُشرتْ في كتابي: السيف والندى)، وهي في ذروة صعودها السياسي، كنت مفعمًا بالأمل حقًّا، وما أكتبه الآن عن الظاهرة في أفولها أجدني مفعمًا بالخيبة، خيبة الأمل ومرارته هي ما توسم به لا جرأته! فأوباما لم يكن متصفًا بالجرأة المأمولة طيلة أعوام حكمه الثمان، والجرأة التي أقصد: جرأة الفعل السياسي، وشجاعة قيادة العالم إلى ضفاف الأمل بالعيش الآمن والمستقر، والأكثر أهمية تأسيس براديغم جديد في الرؤية والمعرفة السياسية الكونية إزاء مشكلات وأزمات عالمنا المعاصر.
لمّا كتبت قبل ثمانية أعوام مقالة عن الظاهرة الأوبامية البازغة (نُشرتْ في كتابي: السيف والندى)، وهي في ذروة صعودها السياسي، كنت مفعمًا بالأمل حقًّا، وما أكتبه الآن عن الظاهرة في أفولها أجدني مفعمًا بالخيبة، خيبة الأمل ومرارته هي ما توسم به لا جرأته! فأوباما لم يكن متصفًا بالجرأة المأمولة طيلة أعوام حكمه الثمان، والجرأة التي أقصد: جرأة الفعل السياسي، وشجاعة قيادة العالم إلى ضفاف الأمل بالعيش الآمن والمستقر، والأكثر أهمية تأسيس براديغم جديد في الرؤية والمعرفة السياسية الكونية إزاء مشكلات وأزمات عالمنا المعاصر.
تأملنا منه أن يقترح هذه الرؤية الجديدة والإستراتيجية المغايرة، لكننا كما خبرنا من سنواته الثمان العجاف لم نكن أمام براديغم سياسي كوني جديد يضفي على التصور السياسي الأميركي العتيد أبعادًا إنسانية وأخلاقية مغايرة لما آلت إليه من توحش عولمي؛ بل كنّا أمام أوباما طائعًا وجبانًا خاضعًا لمواضعات الفكر الإستراتيجي المتجدد دومًا في صور تنكيله بمصائر الشعوب وثرواتها واستقرارها، ومستسلمًا تمامًا لخطوطه العريضة المرتبطة بالحفنة المالية والعسكرية المهيمنة وتحالفاتها.
ولا نعلم حتى الآن هل أحلام أوباما النبيلة المؤملة في عالم جديد خالٍ من القهر والتعسف وكبرياء القوة سحقت بلا إرادة منه؟
أم بإرادة رغبوية إدارية مشتركة ومتفق عليها تكتيكيًّا، أو أنها اصطدمت بقوة دفع التاريخ السياسي التقليدي الذي استوحش واستمرأ التوحش؟ هنا علينا ألا نبتعد عن حقيقة جذرية في المشهد السياسي الأميركي كما عبر عنه المفكر المصري المعروف سيد القمني في واحدة من تحليلاته بعد خطاب أوباما في القاهرة العام ٢٠٠9م، إذ قال ما معناه: «لا ننسى أن دور أوباما في المنظومة الإدارية الأميركية هو أحد الأدوار وليس كلها وأهمها؛ فهو لا يستطيع أن يخرج من قواعد التكتيك والإستراتيجية المؤسسية، ولا يكفي تأثيره بمفرده لتغيير قاعدة واحدة من قواعد اللعبة السياسية».
لكنني هنا أضيف أيضًا حقيقة أخرى عن هذه المنظومة الإستراتيجية العامة، فروح الفردية، وروح المغامرة والتحمّس للمبادرات الفردية المُضافة، والهوس بالتغيير ولو كان شكليًّا وإن كان مصدره فرديًّا يعد سمة أساسية في طبيعة ومكونات الثقافة الأمريكية، وعقلها السياسي القديم والمعاصر في آن.

المزاج الأميركي
وهذه المعرفة التاريخية بالمزاج الأميركي هي ما جذبنا إلى هذه الظاهرة المغايرة: ظاهرة صعود زنجي إلى سدة الرئاسة لأول مرة. وهو ما جعلني أقول في السياق نفسه في مقالي السابق: «إن أوباما ليس إلا ابنًا للمؤسسة السياسية العتيدة، وليس ناقمًا عليها كما توهم بعضهم، وهو ليس منقذًا أو مخلّصًا مفترضًا للبشرية المعذبة جراء سياسات مؤسسته السياسية الخرقاء، بل هو ثمرة أنضجتها وأفرزتها ممارساتها المهيمنة عولميًّا من حيث لا تريد ولم تتوقع». إلى أن قلت في آخر السطر: «يخلق انتخاب أوباما جملةً من الحقائق والوقائع المستقبلية المتخيلة في تصوري، فهذا الانتخاب الاستثنائي ليس إلا حركة ضمير مستترة للمخيلة الأميركية الجامحة والجريحة، المتعبة والمبدعة في آن».
لنسأل الآن: ما الذي تكشّف لنا بعد هذه السنوات العجاف من حكم أوباما لأكبر دولة رأسمالية مؤثرة في العالم؟ في التحليل الثقافي يمكنني القول بدءًا: تكشفت زعامته ككاريزما خطابية مفوّهة ليس أبعد، على المستوى الشخصي للرجل، الرجل يمتلك ملكات الكلام الهادئ الرصين، وهي ميزة يحسد عليها، ولا يمتلك ملكات الأثر الكوني خلافًا لمن كان قبله الذي امتلك المؤثر الفاعل، وأقصد بوش الصغير الذي تميز بفعله التدميري الوحشي، ولم يتميز برصانة القول وذكاء الكلمة المهذبة.
بمعنى أن قوة خطاب أوباما لم توازها على الأرض قوة الفعل! من القول إلى الفعل كانت هناك فجوة هائلة من الاضطراب الذهني، والتشوش الإستراتيجي، صراع فردي نفسي وفكري واجتماعي عاشته الأوبامية من مستوى الخطاب إلى مستوى الضرورة الفعلية الممكنة، في وجُود طبقة سياسية وطغمة مالية حاكمة في الخفاء وغير رحيمة، تعمل من وراء كواليس المسرح السياسي، وتحيك التآمرات والأحابيل، وتضع العراقيل.
أوباما في نظري لم يُجِد استخدام ثقافته الإنسانية المرموقة كما انطوى عليه خطابه السياسي، أو هو لم يُرِد الاصطدام بثقافة الواقعية السياسية الرائجة تاريخيًّا التي اصطبغت بالاستعلاء العولمي، وتفشت فيها روح الهيمنة وشهوة الاحتواء، وفعلًا تكشّف الرجل جزءًا أصيلًا من منظومة ونسيج الطبقة السياسية المسيطرة، فاستسلم خياله السياسي الخلاق المغاير لأحابيلها، وأعطبه الأفق المحاصِر للرؤية قصيرة النظر والمترددة التي اتّبعها في معالجاته السياسية لأزمات المنطقة العربية ومشكلات العالم.
الوجه التطهري
مجيء أوباما من قلب الأقلية السوداء المقهورة تاريخيًّا في أرض أميركا، إنما كان يمثل الوجه الآخر المختفي في السياسة الأميركية، الوجه التطهري المبدئي، وجه التسامح والحريّة والمساواة، فكما هو معروف فللسياسة الأميركية وجهان: وجه يمثل القوة الطاغية المتفردة ماليًّا وطبقيًّا، ووجه آخر يمثل القوة / الظل.. أقليات وأعراق مظلومة، وحركات تحررٍ عرقية، وحسب ما يرى المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد فإن للمجتمع الأميركي أيضًا وجهًا آخر مغايرًا لما هو ظاهر في سياسات الطبقة الحاكمة، ولمعرفة هذا الوجه في حقيقته الوجودية يصبح من الملحّ معرفة الديناميات الداخلية لتشكل هذه السمات الأخرى الفاعلة في حركيّة المجتمع الأمريكي المعاصر، الذي هو بوتقة انصهارٍ لمتناقضاتٍ عدة، مجتمع عجيب بتعقيداته البنيوية، ومفعم بتياراته الاجتماعية والسياسية المعاكسة والبديلة والمنتظرة (هناك خزان من خياراتٍ وتنوعاتٍ حاكمة ولا تحكم)، تفرضها البنية المتجددة لمنظومة الفكر الإستراتيجي، ويلجأ إليها الوعي الجمعي المأزوم في لحظة تاريخية طارئة، غير أن الطبقة السياسية الطاغية والمعاندة كثيرًا ما تختزل هذه التيارات لمصلحتها ووفق سياقات أهدافها الآنية، وكثيرًا ما تحولها إلى شعاراتٍ تبسيطية مسطحة، مفرغةً إياها من وعودها ومضموناتها الاجتماعية النقيضة.
فالدينامية الداخلية التي حدثنا عنها إدوارد سعيد في بعض أفكاره النيرة عنى بها معرفة طبيعة مواقف الإنسان الأميركي اليومية والمتحولة؛ فهو معزول جغرافيًّا، ومهموم بالأساس بحاجاته الشخصية الصغيرة وقضاياه الشديدة في محليتها. هذه الدينامية النفسية العجيبة هي في ظني التي وقع أوباما في أحابيلها، ولم يستطع خروجًا من حصارها، فكان بالنسبة له هذا الخروج المغامر من هذا الطوق الاجتماعي بمثابة قفزة في الفراغ التاريخي!
فعندما بشّر بنموذج أميركي ذي نزعة إنسانية حال ترشحه في ٢٠٠٨م، فقد مصداقيته القولية بعد سنواتٍ قليلة، فاستعاد هذا النموذج المتخيّل والمقترح وجهه الحقيقي، وجهه الأصيل القبيح بقوة دفع هيمنة الطبقة السياسية المتكونة من ملاك المال، وملاك المآل الكوني، وأقصد الطبقة الحاكمة المأزومة التي كان همها الخروج من مأزقها الاقتصادي الطارئ الذي كاد يودي بأسس إمبراطوريتها الكونية، فلجأت إلى صورتها الأخرى، وقد وجدتها ناضجة في ملامح الظاهرة الأوبامية المغرية!
الضرورة التاريخية الضاحكة كانت ترى في صعود هذه الظاهرة البديلة ليس دلالة تحولٍ بنيوي؛ بل مخرجًا افتراضيًّا من مرحلة البوشية المتوحشة وما قبلها، البوشية التي أغرقت صورة الإمبراطورية المضمحلة في وحل المشكلات العالمية التي صارت عبئًا أكثر تهديدًا للنموذج الأميركي – المثال التاريخي الرأسمالي الكوني للهيمنة.
ركوب التاريخ الجريح
وهكذا تم اكتشاف أن انتخاب أوباما ممثلًا للطبقة الوسطى الطامحة للوجود السياسي، الطبقة المتعلمة والمتحررة، سليلة الفكر التحرري والإنساني، ليس في نهاية المطاف إلا إحدى المغامرات السياسية الأميركية المعروفة بقدرتها الجموح على ركوب التاريخ الجريح، والقفز منه إلى تاريخٍ متجددٍ يعاود السيطرة، ويجدد الهيمنة من بعد المأزق التركيبي السياسي الاقتصادي الذي اجتاح صورة الحلم السياسي الأمريكي في أقسى استبداديته ومحوريته الكونية.
إن بزوغ الظاهرة الترامبية الجديدة الآن بما تنطوي عليه من شوفينية وعنصرية وتمركز مالي طبقي، ليس إلا دليلًا على صلف منطق القوة والاستعلاء الفردي. وهو دليل على منطق المغامرة ذاته، ومعاودة منطق المقامرة في الدينامية الداخلية المضطربة في الفكر السياسي الأميركي المعاصر. ما سبق قوله عن الدينامية الداخلية المستترة يقودني للقول بشكلٍ غير ظني، إن التفكير المزدوج لأوباما هو الذي أوقعه طيلة سنوات حلمه السياسي المتعثر في إخفاقات جمة على المستوى السياسي الخارجي، وإخفاقات اقتصادية نسبية على المستوى الاجتماعي الداخلي.
وعوده السياسية المتركزة في ثيمته الشعارية المغوية: «التغيير» التي سيطرت على حملته الانتخابية لم تصمد طويلًا أمام حقائق وبنيات هذا التفكير والوعي المزدوج، معانيًا منه بين شدٍ وجذب في مدى رؤيته الكونية في حل المشكلات والأزمات المتراكمة. نكرر القول بأن أوباما كان مشدودًا إلى تاريخه القهري الأسود إذا جاز التعبير، غير أنه لم يكن منفلتًا بشكلٍ لا ينكره حصيف إلى رؤية الحلول من خلال منظور ذات الطبقة السياسية العتيدة.
«الأسود» والعقدة الثقافية
 رؤية الأسود عبر رؤية الأبيض لم تكن إلا عقدة ثقافية، ومشكلة نفسية تكرّست عبر السياق التاريخي للهيمنة الطبقية على الأقليات المظلومة، فالنغمة الأخلاقية الجهيرة التي طربنا لها نحن في عالمنا العربي في خطاباته السياسية اختلطت بنغماتٍ نشاز سيطر عليها قرع طبول الطبقة السياسية العتيدة والمتربصة. تلك الطبول الصاخبة كانت تصم أذنيه، وتشوّش وجدانه النقي المزدوج، وفكره ذا الملمح الإنساني الفردي المنكسر، دفنت تيارًا سياسيًّا ناهضًا كان بمكنته أن يحفر عميقًا في المجرى التاريخي للتفكير السياسي الإستراتيجي برمته، ويؤسس لرؤية سياسية جديدة.
رؤية الأسود عبر رؤية الأبيض لم تكن إلا عقدة ثقافية، ومشكلة نفسية تكرّست عبر السياق التاريخي للهيمنة الطبقية على الأقليات المظلومة، فالنغمة الأخلاقية الجهيرة التي طربنا لها نحن في عالمنا العربي في خطاباته السياسية اختلطت بنغماتٍ نشاز سيطر عليها قرع طبول الطبقة السياسية العتيدة والمتربصة. تلك الطبول الصاخبة كانت تصم أذنيه، وتشوّش وجدانه النقي المزدوج، وفكره ذا الملمح الإنساني الفردي المنكسر، دفنت تيارًا سياسيًّا ناهضًا كان بمكنته أن يحفر عميقًا في المجرى التاريخي للتفكير السياسي الإستراتيجي برمته، ويؤسس لرؤية سياسية جديدة.
وهكذا أيضًا تلمسنا أثر هذه النغمات الأخلاقية الخافتة في مواقف سياسية متذبذبة، وجدناها جلية واضحة في تراجعه وتقاعسه في الانحياز التاريخي الضدي لأحداث منطقتنا العربية، انحيازه الضدي لمنطق الثورة السورية، والثورة المصرية، ففي حالة الأولى تركها لمصيرها لتأخذ مداها في تأجيج الصراع الأهلي الداخلي، وإحداث التفكيك والتمزيق الجغرافي للدولة السورية امتثالًا لأهدافٍ مشتركة بعيدة في الإستراتيجية الأميركية وربيبتها إسرائيل، كبادئة لتمزيق الشرق العربي كله وتفكيكه، ومن ثمّ إعادة تشكيله.
أما في حالة الثورة المصرية فانتصر لها زيفًا في انحيازه المشبوه لصعود تيار الإسلام السياسي المتمثّل في الإخوان المسلمين، فيما كان يبدو له متسقًا مع الرؤية الإستراتيجية الأميركية المهيمنة، ومتسقًا مع منطقها الجديد في النأي عن خوض الحروب الخارجية المباشرة التي اقترفها كل من بوش الابن، ومن قبله بوش الأب. أما منطقه الاقتصادي الاجتماعي فقد تماسك وتماهى إلى حد كبير ونسبي مع رؤيته في جملة من الإصلاحات السطحية التي امتثلت لها الطبقة السياسية العتيدة على مضض، وهي الآن ما تؤول إليه، ونرى ملامح تراجعها إلى منطق التنكيل فيما لو فازت الترامبية البديلة!
لقد كان الخطاب السياسي لأوباما مهترئًا وغير ذي اتساق مع ما جاء به من تضمينات للبعد الإنساني الأخلاقي، وتم تفريغه من محتواه الثقافي، ومن هنا جاء حسمه لكثيرٍ من الأزمات الكونية باهتًا وزائفًا ومنتميًا بامتياز لأهداف النموذج الأميركي المهيمن ذي الطبيعة الإمبراطورية التي تروم خضوع الجغرافيا الأرضية لشهواتها.







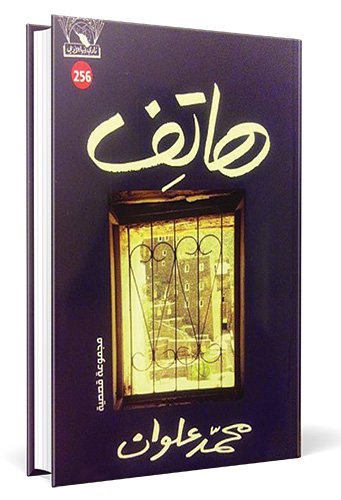 في قصة «دامسة» يستعيد علوان اللامرئي ويجسده في الحركي والجوهري، فكما هي الثيمة الفنية التي تستولي على طرائق البوح السردي في عالمه الإبداعي فإن الحدث الخارجي يتسرب عبر الوعي لا عبر التشكيل الفني له. فالوعي بالصيرورة الواقعية يخلق عنده وعيًا مجاوزًا لحقيقته فيتم عبر هذا الوعي القلق تخليق الرؤية وتشكيل الموقف. يقول الناقد لوسيان غولدمان صاحب البنيوية التوليدية ونظرية الوعي المطابق: كل حدث اجتماعي يستند في بعض جوانبه إلى عملية تشكيل لوعي جديد وكل وعي ليس إلا تصورًا مطابقًا أو وعيًا مطابقًا مع بعض جوانب الواقع وليس كلها. فثمة وشائج فنية في الحقيقة تربط بين مجموعات محمد علوان نتلمسها في تفتيت سردية الحدوتة وانكساراتها في الذاتي والموضوعي.. في الحلمي والتخييلي وفِي اللغة الساردة أيضًا حيث الذاتي في جل قصصه يضيء موضوعه لكن لا يسير في سياقاته ومصايره.. كل نص يخلق مكونًا مصيريًّا جديدًا. أرجع إلى نص دامسة الذي ضمته مجموعته الثالثة بنفس العنوان، وأنا هنا أذهب إلى النصوص العلامات في تجربة علوان ولا أتناول بالتفصيل كل مجموعة.. أذهب إلى النصوص التي تؤكد رؤيتي النقدية والجمالية في السرد العلواني. اللامرئي في قصة دامسة هو شجرة الحب- العشق المكبوت النامية بغتة في الظلام الدامس والمؤول إليه هي الفتاة دامسة وهو اسم الحبيبة الذي طابق الزمن والمكان في دفقة شعورية غامضة.. واللامرئي أيضًا هي الحبيبة لا ملامح لها غائبة في الظلام وتسمى به وتصيب حبيبها بالجنون. وقد لعب المكان في هذا النص – ويكاد يكون هو المرئي الوحيد- دورًا جوهريًّا كحاضن لحركة القص في تصاعدها وتناميها كما لعب الزمن النفسي غروب الحبيبة- غروب المكان لعبته التخييلية المتقنة.. وعزف سيمفونية حزنية للغروب الجزئي الذاتي الرومانسي بكل إيحاءاته ومخزوناته في الذاكرة متوحدة مع الغروب الكلي المأسوي المتصاعد إلى غروب حالك دامس للمكان كله.. إنها الحركة الأخيرة لموسيقا الزمن.. الحركة الإيقاعية الساكنة والمنحدرة تأخذ معها إلى هوّتها كل الأحلام الصغيرة والأمكنة المألوفة ويغيب في فوهة الزمن الفاغرة وجه الحبيبة المباح فينطبق الاسم والمعنى وينطبق المكان على الزمان ويتحولان إلى سديم في عين العاشق الذي ذهب عقله.. بل يصبح ذهاب العقل الشتيمة العذبة الرقراقة: «الله يأخذ عقلك» التي قذفته بها الحبيبة في بداية النص حقيقيًّا ونافذًا كما لعبته لغة علوان في نصه هذا مفعمة بطاقة التخييل المبدعة في إنتاج الدلالة الفنية ونجحت في ترك الأثر الانطباعي البلاغي والصوري للنص في ذهن المتلقي.
في قصة «دامسة» يستعيد علوان اللامرئي ويجسده في الحركي والجوهري، فكما هي الثيمة الفنية التي تستولي على طرائق البوح السردي في عالمه الإبداعي فإن الحدث الخارجي يتسرب عبر الوعي لا عبر التشكيل الفني له. فالوعي بالصيرورة الواقعية يخلق عنده وعيًا مجاوزًا لحقيقته فيتم عبر هذا الوعي القلق تخليق الرؤية وتشكيل الموقف. يقول الناقد لوسيان غولدمان صاحب البنيوية التوليدية ونظرية الوعي المطابق: كل حدث اجتماعي يستند في بعض جوانبه إلى عملية تشكيل لوعي جديد وكل وعي ليس إلا تصورًا مطابقًا أو وعيًا مطابقًا مع بعض جوانب الواقع وليس كلها. فثمة وشائج فنية في الحقيقة تربط بين مجموعات محمد علوان نتلمسها في تفتيت سردية الحدوتة وانكساراتها في الذاتي والموضوعي.. في الحلمي والتخييلي وفِي اللغة الساردة أيضًا حيث الذاتي في جل قصصه يضيء موضوعه لكن لا يسير في سياقاته ومصايره.. كل نص يخلق مكونًا مصيريًّا جديدًا. أرجع إلى نص دامسة الذي ضمته مجموعته الثالثة بنفس العنوان، وأنا هنا أذهب إلى النصوص العلامات في تجربة علوان ولا أتناول بالتفصيل كل مجموعة.. أذهب إلى النصوص التي تؤكد رؤيتي النقدية والجمالية في السرد العلواني. اللامرئي في قصة دامسة هو شجرة الحب- العشق المكبوت النامية بغتة في الظلام الدامس والمؤول إليه هي الفتاة دامسة وهو اسم الحبيبة الذي طابق الزمن والمكان في دفقة شعورية غامضة.. واللامرئي أيضًا هي الحبيبة لا ملامح لها غائبة في الظلام وتسمى به وتصيب حبيبها بالجنون. وقد لعب المكان في هذا النص – ويكاد يكون هو المرئي الوحيد- دورًا جوهريًّا كحاضن لحركة القص في تصاعدها وتناميها كما لعب الزمن النفسي غروب الحبيبة- غروب المكان لعبته التخييلية المتقنة.. وعزف سيمفونية حزنية للغروب الجزئي الذاتي الرومانسي بكل إيحاءاته ومخزوناته في الذاكرة متوحدة مع الغروب الكلي المأسوي المتصاعد إلى غروب حالك دامس للمكان كله.. إنها الحركة الأخيرة لموسيقا الزمن.. الحركة الإيقاعية الساكنة والمنحدرة تأخذ معها إلى هوّتها كل الأحلام الصغيرة والأمكنة المألوفة ويغيب في فوهة الزمن الفاغرة وجه الحبيبة المباح فينطبق الاسم والمعنى وينطبق المكان على الزمان ويتحولان إلى سديم في عين العاشق الذي ذهب عقله.. بل يصبح ذهاب العقل الشتيمة العذبة الرقراقة: «الله يأخذ عقلك» التي قذفته بها الحبيبة في بداية النص حقيقيًّا ونافذًا كما لعبته لغة علوان في نصه هذا مفعمة بطاقة التخييل المبدعة في إنتاج الدلالة الفنية ونجحت في ترك الأثر الانطباعي البلاغي والصوري للنص في ذهن المتلقي.
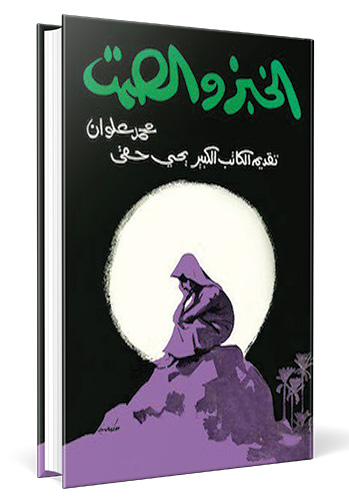 «هو وابنته والكلب».. في هذا النص البديع يتجلّى وعي علوان الجمالي والشعري.. فالصورة فطرية بسيطة مفعمة بالحلم والرغبات.. محفوفة بالجوع الخارق حيث افتضاض بكارة الطبيعة تؤول بالنتيجة إلى افتضاض بكارة الإنسان متربصًا بالأوهام والخراب.. جوع العصفور المحبوس أعلى أغصان الشجرة خائفًا من التقاط الحب المنثور تحت الشجرة مساوٍ لجوع الكلب المتربص للعصفور ومساوٍ لجوع الفتاة سعدى الغريزي تحت ماء قِربتها وهو يسيل حزنًا وشهوة.. ومساوٍ لجوع أهل القرية للماء وقد اكتشف في آبارها البترول واعدًا بالأحلام والأوهام.. هكذا نرى الجوع منقسمًا ثلاثَ وجوه.. يتبدى أولها في الجوع الفطري الغريزي منتقلًا إلى الجوع الوهمي للثروة ومنتهيًا إلى الجوع المأسوي – جوع الكلب ملتهمًا العصفور الجائع.. وجوع الفتاة الشهويّ وقد استحال جفافًا بعد أن ذهب الماء عنها عندما خربت الأرض وفضت بكارة الطبيعة.. الفعل المؤلم لا بد أن يؤول إلى خراب مطلق.
«هو وابنته والكلب».. في هذا النص البديع يتجلّى وعي علوان الجمالي والشعري.. فالصورة فطرية بسيطة مفعمة بالحلم والرغبات.. محفوفة بالجوع الخارق حيث افتضاض بكارة الطبيعة تؤول بالنتيجة إلى افتضاض بكارة الإنسان متربصًا بالأوهام والخراب.. جوع العصفور المحبوس أعلى أغصان الشجرة خائفًا من التقاط الحب المنثور تحت الشجرة مساوٍ لجوع الكلب المتربص للعصفور ومساوٍ لجوع الفتاة سعدى الغريزي تحت ماء قِربتها وهو يسيل حزنًا وشهوة.. ومساوٍ لجوع أهل القرية للماء وقد اكتشف في آبارها البترول واعدًا بالأحلام والأوهام.. هكذا نرى الجوع منقسمًا ثلاثَ وجوه.. يتبدى أولها في الجوع الفطري الغريزي منتقلًا إلى الجوع الوهمي للثروة ومنتهيًا إلى الجوع المأسوي – جوع الكلب ملتهمًا العصفور الجائع.. وجوع الفتاة الشهويّ وقد استحال جفافًا بعد أن ذهب الماء عنها عندما خربت الأرض وفضت بكارة الطبيعة.. الفعل المؤلم لا بد أن يؤول إلى خراب مطلق.
 لمّا كتبت قبل ثمانية أعوام مقالة عن الظاهرة الأوبامية البازغة (نُشرتْ في كتابي: السيف والندى)، وهي في ذروة صعودها السياسي، كنت مفعمًا بالأمل حقًّا، وما أكتبه الآن عن الظاهرة في أفولها أجدني مفعمًا بالخيبة، خيبة الأمل ومرارته هي ما توسم به لا جرأته! فأوباما لم يكن متصفًا بالجرأة المأمولة طيلة أعوام حكمه الثمان، والجرأة التي أقصد: جرأة الفعل السياسي، وشجاعة قيادة العالم إلى ضفاف الأمل بالعيش الآمن والمستقر، والأكثر أهمية تأسيس براديغم جديد في الرؤية والمعرفة السياسية الكونية إزاء مشكلات وأزمات عالمنا المعاصر.
لمّا كتبت قبل ثمانية أعوام مقالة عن الظاهرة الأوبامية البازغة (نُشرتْ في كتابي: السيف والندى)، وهي في ذروة صعودها السياسي، كنت مفعمًا بالأمل حقًّا، وما أكتبه الآن عن الظاهرة في أفولها أجدني مفعمًا بالخيبة، خيبة الأمل ومرارته هي ما توسم به لا جرأته! فأوباما لم يكن متصفًا بالجرأة المأمولة طيلة أعوام حكمه الثمان، والجرأة التي أقصد: جرأة الفعل السياسي، وشجاعة قيادة العالم إلى ضفاف الأمل بالعيش الآمن والمستقر، والأكثر أهمية تأسيس براديغم جديد في الرؤية والمعرفة السياسية الكونية إزاء مشكلات وأزمات عالمنا المعاصر.
 رؤية الأسود عبر رؤية الأبيض لم تكن إلا عقدة ثقافية، ومشكلة نفسية تكرّست عبر السياق التاريخي للهيمنة الطبقية على الأقليات المظلومة، فالنغمة الأخلاقية الجهيرة التي طربنا لها نحن في عالمنا العربي في خطاباته السياسية اختلطت بنغماتٍ نشاز سيطر عليها قرع طبول الطبقة السياسية العتيدة والمتربصة. تلك الطبول الصاخبة كانت تصم أذنيه، وتشوّش وجدانه النقي المزدوج، وفكره ذا الملمح الإنساني الفردي المنكسر، دفنت تيارًا سياسيًّا ناهضًا كان بمكنته أن يحفر عميقًا في المجرى التاريخي للتفكير السياسي الإستراتيجي برمته، ويؤسس لرؤية سياسية جديدة.
رؤية الأسود عبر رؤية الأبيض لم تكن إلا عقدة ثقافية، ومشكلة نفسية تكرّست عبر السياق التاريخي للهيمنة الطبقية على الأقليات المظلومة، فالنغمة الأخلاقية الجهيرة التي طربنا لها نحن في عالمنا العربي في خطاباته السياسية اختلطت بنغماتٍ نشاز سيطر عليها قرع طبول الطبقة السياسية العتيدة والمتربصة. تلك الطبول الصاخبة كانت تصم أذنيه، وتشوّش وجدانه النقي المزدوج، وفكره ذا الملمح الإنساني الفردي المنكسر، دفنت تيارًا سياسيًّا ناهضًا كان بمكنته أن يحفر عميقًا في المجرى التاريخي للتفكير السياسي الإستراتيجي برمته، ويؤسس لرؤية سياسية جديدة.