
علي الدميني - شاعر و كاتب سعودي | مارس 1, 2018 | نصوص

علي الدميني
على زمن الشعر أن يتنزّلَ في سير راحلتي، من خيام القبيلةِ
حتى شطوط «الكاريبيّ»، إني انتظرتُ جنون تبدّيهِ عامين
حتى تجمّد في الروح شوقُ المياهْ.
على زمن الشعر ألا يخون الصداقةَ،
يا طالما أربكتني اشتعالاتُه في دمي،
ومشيتُ على النار منتشيًا خلفهُ،
حين يصفو
ويا طالما بتُّ في حضنهِ عاريًا،
كصبيٍّ يفاجئه العشق من عُنُقٍ يتبدّى على النافذة!
إلى « كوستاريكا»: وضعتُ على ظهر هذا الجواد جراحي، وعِقْدًا من السحرِ يعصمني من حنيني إلى البيتِ،
هل سوف أُشفى من الذاكرةْ؟
من تراجيع أغنيتي في الطفولةِ
قرب المياه التي تتحدّر من جبلٍ قرب باب السماء،
بلا لغةٍ
فتكون خلاسيةً مثل أسرار قلبي،
ومكشوفةً كحديثي عن الحبِّ بين الصبايا،
اللواتي أدرّبهنّ على المشي خلف قطيع الشياهْ.
سأمضي،
وما كنتُ يومًا أجيد السباحة من دون أمّي،
ولكنني سأجرّبُ، كيف يكون الجواد رفيقًا، وظلًّا صديقًا،
وإن راحَ يعدو كما الريح خلف الطرائد،
دون اتجاهْ.
يقول جوادي: لماذا تركت البنادق في مهجع البيت نائمةً،
فأقول له: سوف نمضي إلى بلدٍ سرّح الجُنْدَ والبندقيةَ،
حتى بنى جنّةً من رحيق الموسيقا،
وزيّنها ببياض الحمام!
يصيح الجواد: أتتركني دونما عملٍ أيها الوغدُ،
ماذا سأروي لأحفادي القادمين؟
فيا خجلي! هل أحدِّثهم أنني سرتُ في البرِّ والبحرِ،
لا بندقيةَ للصيد، أو للدفاع عن النفس والمعصية؟
إلى كوستاريكا، حملت جراحي وتعويذتي،
وتركتُ جوادي على أرض جيرانكم في الشمال القصيّ،
أتيتُ
وفي الكفِّ عشرون نصًّا من الشعر،
دوّنتها بالإشارةِ،
خارج قيد القواميس والمرجعيات،
ها أنذا فاقرؤوني بأعينكم
مثلما تبصرون حديث «الفراشات» في زرقة الضوء
أو ترسلون إلى جسدٍ لاهبٍ في الحديقة، أغصانَ أشعاركم
والهدايا القليلةَ من فتنة الصمت
والاشتهاء!
أنا.. لم أقل للقصيدة، كوني كما يشتهي نبضُ قلبي
ولكنني قلتُ صيري: كما تتفتح وردةُ أنثى
على النافذة.
وطيري كما يتلامعُ ريش العصافير عند الظهيرة
في نهر « تاركوز»،(1)
رِفّي كهمس العشيق على وجه «آنا أسترو»(2) وهي تنشد أشعارها
في هوى «سان خوزيه»(3)، أرضِ المخيّلةِ البكرِ،
أرضِ الندى والسلام.
وسيلي غناءً بحاناتها،
بين لحن الكمنجات
والفاتناتِ، وبرق السّهام!

أنا
لم أقل للقصيدة كوني إناءً من الحزنِ، لكنني
قد ربطتُ الجواد غريبًا على البحر،
ثم أفضتُ إلى النهر،
أبحثُ عن حُلُمٍ خبّأتْهُ القناديل، لي،
من ربيع العنبْ.
وعن فرحٍ أشعلته الميادين
في رقص «بونتو جوانتكسكو»،(4)
حيث لا شيء في الكون إلا هديل الطبول
وحُمّى الطربْ.
سأبحثُ عن زهرة «البُنّ»، تلك التي عطّرت قريتي في الصباحات
فتنةُ فنجانها،
وابتساماتُها في المساء.
وتلك التي يتعشّقها الناسُ في وطني،
مثلما تعشقون النبيذ وأحلى النساء.
أحبُّ المدينة نافرةً كالجيادِ
وخضراء كالفرح العائلي.
أحب الشواطئ فاتحةً صدرها للغريب،
ومترعةً بابتسام الطفولة
والجسدِ الناحلِ.
ولي شغفٌ فادحٌ كالغواية
أن أتملّى الطيور البهيّة في «كوركوفادو»(5).
لأبني هنالك عشًّا لقلبي،
ونهرًا لروحي،
وأغنيةً في رثاء جوادي.

على زمن الشعر أن يتبدّى كما قمر
دامع في الغروبِ، يئنُّ على الساحلِ.
وداعًا جوادي
فبعد غدٍ، سوف أحملُ ما يتبقى من الوشمِ
في صفحات كتابي
وما سالَ من قُبـَلِ الورد والشعر فوق عروقِ قميصي
وأمضي
بدون سلاحٍ
وحيدًا
وحيدًا
إلى ما سيُشبِهُ وعدَ الفراديسِ للأرضِ
في الزمنِ المقبلِ!
(*) هذه القصيدة كنتُ هيأتها كتحية احتفائية لمدينة «سان خوزيه» في مهرجان الشعر العالمي بكوستاريكا عام 2016م، الذي كنت مدعوًّا له.
(1) نهر يجري في الوادي الأوسط الذي تنام على جوانبه مدن كوستاريكا.
(2) شاعرة ومسرحية وممثلة شهيرة في كوستاريكا.
(3) العاصمة.
(4) أشهر رقصاتهم الشعبية.
(5) محمية كبيرة للطيور في سان خوزيه فيها أكثر من 350 نوعًا من الطيور.

علي الدميني - شاعر و كاتب سعودي | ديسمبر 27, 2016 | دراسات
قطيعة وتجاوز

علي الدميني
منذ أن غادر محمد العلي طريق متابعته لدراسة المنهج الديني، وسلك طريق التعليم المدني – رمزيًّا وثقافيًّا – فقد خلع عباءة «رجل الدين» وعمامته، واختار طريق «طالب المعرفة»، متخليًا عن مسار «العقل التقليدي» ومنحازًا إلى فضاء بناء «العقل النقدي»، وإلى فكر السؤال والنقد والعقلانية، وإلى حلم التقدم الإنساني الذي يتغيا حرية الإنسان وسعادته، وذلك من خلال الإسهام في إنتاج القيم الحديثة المرتبطة بضرورات العصر، والانخراط في الممارسة الفاعلة لصياغة رؤية مختلفة لحياةٍ جديدة. وهنا نراه وقد انتقل منذ مطلع ستينيات القرن المنصرم من ضفة سيادة سلطة النمط والتقليد والأنساق التراثية المهيمنة على الفكر والإبداع والحياة، إلى ضفاف تيارات التنوير والتقدم الحضاري في العالم العربي، وهي العلامات البارزة للسير على الطريق إلى الحداثة.
في حوار لمحطة (LBC) اللبنانية مع محمد العلي قال: «إن شهادة السطوع التي حصلت عليها حين تخرجت من المعاهد الدينية في النجف، قد خلقت مني متمردًا! مضيفًا، أن النجف مدينة إما أن تدفعك إلى الخمول والاستسلام الذي ليس بعده صحو، أو تدفعك إلى التمرد»(1).
وفي عام 1963م عاد العلي مع عائلته إلى الدمام التي كانت تنمو كحاضرة للمنطقة الشرقية، وعبر أربعة أعوام فيها، تجاوز العلي محاضرته الأولى التي قدمها في الرياض عام 1964م، باشتغاله على تطوير رؤيته وتعميق مرتكزاتها الفكرية والأدبية والاجتماعية، وتوّج ذلك بكتابة مقالة أسبوعية في جريدة اليوم أضحت مع الزمن مضمارًا ومنبرًا لصوته وأجراس حراكه الثقافي، وقدم خلال عقد السبعينيات عددًا من المحاضرات المهتمة بحقل الأدب والفكر الاجتماعي، كما انحاز إلى كتابة شعر التفعيلة وفق رؤية إبداعية وفكرية متميزة، تطورت خلال مرحلة قصيرة لتتجاوز ما أبدعه شعراء المملكة في تلك المرحلة وما قبلها، من العواد إلى حسن القرشي، وسعد البواردي، وغازي القصيبي، ومحمد المنصور، والرميح، وناصر أبوحيمد، ومحمد العثيمين وسواهم، وما قدمه الشعراء الشباب الذين جعلوا الشعر الحر خيارهم الشعري منذ البدء، مثل سعد الحميدين، وأحمد الصالح، وعلي الدميني، وغيرهم.
وقد غدت قصائده مثل «العيد والخليج، لا ماء في الماء، آهٍ متى أتغزّل، وغيرها»، كمرتكزات للقصيدة الحداثية في المملكة في أبعادها الجمالية والدلالية، في عقد السبعينيات من تلك المرحلة.
وبالموقف الحاسم والقاطع نفسه مع الرؤية التقليدية، شكّل كيانًا شخصيًّا مستقلًّا على مستوى البعد الثقافي الواقعي والرمزي، للمثقف الحر والصادق مع ذاته، ومع قراء كتاباته الصحفية منذ بدأها في جريدة اليوم حتى هذه اللحظة، فلم يرضخ لضرورات السير مع القطيع، أو ينحني لجني صفقات الأرباح بالتكيف مع أدوات أو مغريات التهجين المؤسساتية، مثلما لم يكتب مجاملًا مؤسسة أو مسؤولًا أو صديقًا أو كاتبًا، وأخلص فقط لتدوين ما يؤمن به تمامًا، وضمن أفق رؤيته النقدية، على رغم ضيق الحيز المتاح للتعبير الثقافي الحرّ في صحافتنا، وإكراهاته المستبدة.
وطيلة عمره المكلل بالعطاء المستمر، لم يشأ العلي جمع قصائده ومقالاته في كتاب، لأسباب كثيرة، وقف عليها الناقد أحمد بوقري حين قال: «أشار علي الدميني في كتابه (أمام مرآة محمد العلي) إلى أسباب متفرقة أو مجتمعة كالزهد في الأضواء، أو القناعة الناقصة لأهمية ما كتب، أو السأم الوجودي… أو لعطالة المناخ الثقافي القادر على الاستقبال والحوار والتحريض، وقد أزيد عليه وأقول: إنها ربما راجعة إلى الحس السقراطي الفلسفي، الذي انطوت عليه شخصية محمد العلي. فهذه الشخصية في إهابها تهوى طرح الأسئلة ولا تبحث عن الأجوبة الآنية، بل تحث الآخرين على المشاركة الدؤوبة في البحث عن المعنى، وخلق الدلالات والتأويلات. إنها الشخصية السقراطية التي لا تجد نفسها بين دفتي كتاب، قدر ما تجدها في حضورها الفيزيقي والصوتي والحركي، وكأنه «المشّاء» في غياب فاعل، لا يتحقق حضوره إلا في الأثر الذي يتركه ويطبع بميسمه أفق التحول، وصيرورة التجدّد الإبداعي»(2).
عتبات المشروع الثقافي

غازي القصيبي
مهمومًا بسؤال المعنى.. معنى الوجود الإنساني، وبدأب متواصل، يمضي العلي باحثًا عن أفق الحياة التي تنعم بمثالات العدالة والكرامة والحرية، خارج أثقال الأساطير والتراكمات الثقافية وسلطاتها الكثيرة، ليقود خطواته نحو تشييد معمار مشروع ثقافي، فكرًا وإبداعًا، تساؤلًا ونقضًا، هدمًا وبناءً.
وعلى رغم أنه لم يشر في أي كتابة أو حوار إلى أنه صاحب مشروع، ولا سيما وهو لم يعمد إلى نشر نتاجاته في كتب، إلا أننا وقد تجمعت بين أيدينا معظم كتاباته في مجلدات عديدة قام بها محبوه، لن نعدو طريق الصواب حين نقول: إننا أمام عتبات مشروع ثقافي لافت ينهض على المقومات الآتية: عدة معرفية، وعين نقدية قارئة للتراث العربي والثقافة المعاصرة، ومنفتحة على الحداثة. رؤية جدلية لتحليل الواقع، ورؤيا متشوفة لآفاق المستقبل. ملكة ثقافية نقدية تنطوي على قدرٍ كبير من فاعلية الشك المعرفي، وعلى الشجاعة الكافية للتعبير عنها، مثلما تستطيع موضعة ذاتها بقدر من الحيادية «الإبستمولوجية»، حيال الإشكاليات التي تتناولها.
وفي عجالة يقتضيها مقام هذه المقالة، سأقف على بعض تجليات مشروعه وفق المحاور الآتية:
أولًا: المنحى الإبستمولوجي
وهو منحى نقدي يروم الوقوف على الأسس المعرفية المكرسة بفعل السلطات المختلفة عبر الزمن، والحوار مع مرتكزاتها، إما لتأكيد مصداقيتها، أو لطرح الأسئلة حولها ونقضها، وهو ما يصب في موضوعة «نسبية الحقيقة». ولذا نقف في كتاباته على اهتمام عميق ومستمر بتحديد «المفاهيم» وتطورها عبر الزمن، سواء في مقالاته القصيرة أو الطويلة أو في محاضراته، وقد خصص الشاعر أحمد العلي القائم على نشر نتاجه كتابًا ضخمًا بعنوان «نمو المفاهيم»، وقف فيه على موضوعات ومفاهيم كثيرة منها: الشك واليقين، مفهوم التراث، نمو المفاهيم، ما هو التاريخ، الفرق بين الرؤية والموقف، عن الثقافة ومكوناتها، المثقف والأيديولوجيا، مفهوم الوطن».
كما نقرأ في كتابه الآخر «درس البحر» مقاربات معرفية معمقة أيضًا عن إشكالات وظواهر ثقافية واجتماعية قارب فيها كثيرًا من الاهتمامات مثل: «ما هو المجتمع، ما هو المفهوم، التفكير الحضاري، كيف نقرأ الماضي، كيف نقرأ الحاضر، التخلف، ثقوب الوعي، قتل العرب، العدالة، وسواها من عشرات العناوين المختلفة في النقد والشعر والفكر والاجتماع».
ولعل هذه الفقرة من كتابه «نمو المفاهيم» تأخذنا بكل وضوح صوب الجوهر الثقافي المحرك لفاعلية مشاغل العلي وضميره، المنبثة في كل كتاباته وقصائده، حيث يقول: «إن أول اشتياقات الإنسان الروحية هو البحث عن المعنى… إن الوصول إلى معنى الوجود الإنساني وإلى معارفه وتصوراته وقيمه ومواقفه وحاجاته الروحية والبدنية، هو هدف الإنسان الأول.. لأنه بهذا الوصول إلى بلورة معنى الأشياء يصل إلى الاطمئنان الروحي، ويتخلص من كلام المجهول والتخبط في التفسير»(3).
ثانيًا: منحى النقد الثقافي

سعد الحميدين
تنحو قراءات العلي في الحقل الثقافي لاستخدام مكوناته المعرفية المتصلة بحقول علوم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والأدب، لمقاربة العديد من الظواهر وأنساقها المضمرة في مكونات الثقافة والواقع الاجتماعي، كما يقف في مقارباته النقدية للأدب على التشكيل الجمالي للنص، وعلى دلالاته كقيمة ومحرك اجتماعي، مثلما يشير أيضًا إلى جماليات الثقافة الشفوية وتمثلاتها في الشعر والمثل والنكتة واللعب والضحك.
ولذا نراه يشتغل على الثقافة لكونها «كل طريقة للحياة يعيشها الناس»، وبما قال عنها غرامشي وإدوارد سعيد من أن «الثقافة تعد مسرحًا تشتبك فيه قضايا سياسية وعقائدية مختلفة، وأن كل ثقافة تولد ثقافة مغايرة ومضادة»(4).
وإذا كانت جهوده الكتابية في محاضراته ومقالاته المتسلسلة الطويلة، قد اعتنت بجوانب فكرية وفلسفية وأدبية واجتماعية، فإننا سنكتفي هنا بأن نعرض لبعض مقالاته التي يمكن أن يغلب عليها طابع التفاعل اليومي مع الأحداث أو الآراء التي يناقشها كجزء من الانشغال بالنقد الثقافي:
أ- كتب عن لعبة «البلوت»، والأسهم، وذهنية التحريم، وقارب لعبة كرة القدم في مباريات كأس العالم في عام 1996م في عدة مقالات نختصر هنا بعض مرئياتها:
– «بعض الأقدام تجاوزت صراع الأفكار بين الروح والجسد.. لأنها متأكدة من أن الروح والجسد شيء واحد.. فالهدف لا يحرزه الجسد وحده ولا الروح وحدها.. يحرزه الإنسان بلا أجزاء» (ولنلحظ التورية الكامنة في كلمة الهدف).
– «أحبُّ كرة القدم؛ لأنها لا تحمل أحكامًا مسبقة، فالأحكام المسبقة هي التي أعاقت وتعيق البشر، أو معظمهم عن رؤية الواقع، وعن قراءة التاريخ قراءة ناقدة وموضوعية».
– «حكام المباريات يشغلون مهنة من أصعب المهن وأعسرها.. يركضون ويتابعون ويحكمون بالقانون، ومع هذا تلاحقهم لعنات النقاد والجماهير! أما (حكّام الدول).. فإنهم يمشون حتى في المدرجات كالطواويس».
– «إنها لغة لا يمكنك فيها أن تكذب مثل لغة الأفكار.. إنها عارية تمامًا من الأقنعة والرموز وضباب الماضي».
– «إنك (وهذا هو الجوهر) تستطيع التعبير فيها عن نفسك، أما لغة الأفكار فهناك سيوف صقيلة تمنعك من هذا الحق البسيط في التعبير عن النفس»(5).
ب- وضمن هذا المحور، تحتفي إحدى سلسلة مقالاته بحالة «الضحك»، ذاهبًا في البحث عن جذورها الإنسانية كتعبير عفوي وكحاجة نفسية، وكحكاية دالة في مدوناتها، من الجاحظ إلى هنري برجسون، ومن الماضي إلى لحظة انتظار شاعر لشاعرة في مقهى لتقرأ عليه قصيدتها الجديدة، حيث خصص لها مقعدًا بجواره، ولكن صديقًا آخر ثقيل الوزن والدم يهبط عليه فجأة ويحتل ذلك الكرسي!!
ويستمر في التنقيب عن حالات «الضحك» ودلالاته، بالإشارة إلى ما أورده الفقيه ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، من قيام معلم بإدخال سورة على سورة، وهو يعلّم أحد الصبيان الفقراء، لأن والد الصبي لا يفكّ الحرف ولا يملك مالًا لدفعه للمعلم، بقوله: «حين سكنت موجة الضحك في داخلي بعد قراءة هذه النكتة، أخذني عجبٌ من نوع آخر، هو أن راويها رجل فقيه يوصف بأنه إمام، وكان عجبي عن مدى التسامح الذي يملكه هذا الرجل»(6).
ج- يأخذ حديثه عن النظام العالمي الجديد شكلًا من أشكال النقد الثقافي، حيث يحضر ذلك الشبح المرعب الذي تشكّل كأنساق ثقافية وسياسية وأخلاقية مهيمنة منذ تم تداوله في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، وغدا كأطياف لا تفارق مقاربات العلي، للمثقف ودوره، وللتكوين الثقافي والتغير في القيم، حيث يقول: «منذ زمن وأنا أكتب عن المثقف، ما هو تعريفه؟…. الموضوع يؤرقني فعلًا …. لماذا؟ لأن المثقف مثل أي شيء في ظل النظام العالمي الجديد، دخل في متاهة اللاتحديد، وتخلى عن أن يكون ضميرًا»(7).
ثالثًا: منحى القراءة الحوارية
ينتظم البعد الحواري جل نتاجات العلي، حيث تأخذ أقوال أو آراء أو تصريحات أطراف متعددة ومتناقضة حول الموضوع نفسه موقعها في القراءة أو البحث. وبذلك تصبح عناصر المقابلة والمقارنة والتضاد والمفارقة شديدة الحضور، فتفتح أبواب الشك والتساؤل مساراتها من أجل تعميق مضمار الأسئلة المستفزة والمحفزة على التأمل والتفكير، قبل أن يضع رأيه أو يلمّح إليه،كأحد الآراء الممكنة، ضمن هذا الأفق الحواري الخصب.
وتنبني معظم محاضراته ومقالاته الطويلة على هذا النسق. انظر كتبه: نمو المفاهيم، درس البحر، هموم الضوء، البئر المستحيلة. ويمكننا في هذا المجال أن نشير إلى محاضرته الموسومة بـ «مفهوم التراث» لنرى تبديات تلك الحوارية المتعددة الأصوات، سواء في تعدد محاورها أو تعدد آراء الكتاب الذين استشهدت بهم، مثلما نجده في ابتعاد الكاتب عن اليقينية أو الإطلاقية أو الوعظية الدوغمائية.
ولنقف معه على المحور الذي تحدث فيه عن النقد الأدبي لكونه أحد مكونات التراث الأدبي العربي، فنراه يورد تعريف محمد مندور للنقد الأدبي في كتابه النقد المنهجي عند العرب، وما تبعه – كما قال – من تعاريف لا حصر لها، حتى يأتي إلى ضرورة نقد تلك التعريفات، متكئًا على محاضرة المسدي في هذا الصدد، والتي ركّزت على أهمية نقد النقد. وبعد تفتيق الأسئلة حول «كيف يولد النص؟ وما هي قسماته؟ هل هي فردية أم اجتماعية؟ ما هي علاقته بسياقه؟ ما هي إضافته؟ على أي منهج يمكن قراءته؟» يذهب إلى الإشكاليات التي تطرحها هذه الأسئلة في ضوء استحضار كلام الجابري عن تداخل الأزمنة الثقافية في تراثنا العربي وحاضرنا اليوم، ويأتي بما يعضدها عند إحسان عباس في كتابه تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ليستحضر بعد ذلك الناقد حازم القرطاجني مثبتًا ما قاله عن الشعر والشعرية، حتى يطرح التساؤل العريض الآتي: «هذه الرؤية المشرقة لحازم القرطاجني، الذي تفصلنا عنه عدة قرون، أليست أكثر حداثةً من رؤوس لفيف يتربّع على كراسي الجامعات عندنا الآن؟». وهنا، وبعد تلك الرحلة الحوارية الطويلة بين العديد من الآراء والرؤى يقول: نعم إنها لكذلك، يقصد رؤية حازم، ومن ثم يقوم بمحاورة زكي نجيب محمود وأدونيس حول مفهوم التراث(8). ويمكن لنا أيضًا أن نتأمل البعد الحواري في متون مقالاته المتسلسلة والتي خصصها لقراءة عدد كبير من الكتب التي عنيت بتطور الفلسفة أو الحضارة عند ديوارنت، وتلك التي اهتمت بقراءة ثقافة الماضي، أو غيرها من الكتب التي بحثت في نقد ثقافة الحاضر والرنو صوب ملامح المستقبل، حيث يعرض للأفكار والآراء ويعارضها أو ينقضها أو يوسع من مدى رؤيتها، من خلال ما كتبه آخرون عن الإشكالية أو الفكرة نفسها، ثم يطرح بعد ذلك آراءه وملحوظاته حولها. انظر كتابه: هموم الضوء.
أما مقالاته القصيرة، فإنها تتشكل على هيئة كبسولات صغيرة، مكثفة لغةً ودلالة، اعتصر فيها جوهر الفكرة وشكّلها بطريقة تنبني على المفارقة الكامنة في اختلاف رؤيتين أو هدفين، ويعمقها، للتلميح إلى رؤيته، بفاعلية السخرية الضمنية وحرقة الأسئلة، حيث إنه غالبًا ما يطرح على قارئه تساؤلًا في آخر المقالة، ليبقي أفق الحوارية مفتوحًا ومنطلقًا من القارئ نفسه إلى ذاته وإلى واقعه وفكره ومواقفه هو!!
رابعًا: مفهوم الحداثة عند محمد العلي
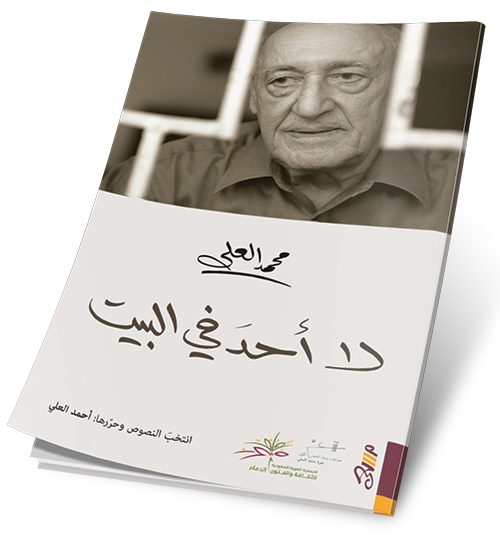 العقل الديناميكي والعقلانية النقدية يشكلان رافعة فاعلية الإنسان في واقعه، من أجل تجاوز حمولات الاستبداد الثقافية والسياسية المتعاضدة عبر الأزمنة؛ لكي يبلغ زمن الحرية وإعلاء قيمة الإنسان وذاته، وهي الرافعة الرئيسة لثقافة عصور النهضة والتنوير التي دشّنت في الغرب زمن الحداثة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تمثل -في نسبيتها– أفضل تجليات تحقق النزوع التاريخي للبشرية صوب حياة جديدة ومختلفة.
العقل الديناميكي والعقلانية النقدية يشكلان رافعة فاعلية الإنسان في واقعه، من أجل تجاوز حمولات الاستبداد الثقافية والسياسية المتعاضدة عبر الأزمنة؛ لكي يبلغ زمن الحرية وإعلاء قيمة الإنسان وذاته، وهي الرافعة الرئيسة لثقافة عصور النهضة والتنوير التي دشّنت في الغرب زمن الحداثة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تمثل -في نسبيتها– أفضل تجليات تحقق النزوع التاريخي للبشرية صوب حياة جديدة ومختلفة.
بيد أن هذه الديناميكية العقلانية والنقدية مشروطة بظروفها الزمانية والمكانية، التي تجعل من مفهوم الحداثة مفهومًا نسبيًّا، في تشكّل مقدماته وأولوياته، وفي تحقيق مستوياته المختلفة في الواقع. ولذلك فإن العلي يأخذ كغيره من المفكرين العرب بمفهوم الحداثة التاريخانية، حيث يرى محمد عابد الجابري بأن الحداثة «ظاهرة تاريخية، وهي ككل الظواهر التاريخية مشروطة بظروفها، محدودة بحدود زمنية ترسمها الصيرورة على خط التطور»(9). أو كما يرى الباحث التونسي الدكتور حمادي بن جاء بالله «بأن حداثة عصرنا نتاج مطاف تاريخي فكري حلمت به الإنسانية منذ أقدم العهود، وعبّرت عنه الأساطير والأديان والفنون؛ إذ ليس من ثقافة إنسانية مهما كانت درجة وعيها بذاتها إلا وحلم الحرية ثاوٍ في أعماقها. وما أنجزه العصر الحديث حقق جوانب من ذلك الحلم لا يستهان بها بعد أن تهيأ، بتوسط العقلانية اليونانية – العربية – الأوربية -اللاتينية، وبفضلها»(10)؛ فالحداثة عند محمد العلي تنبثق من تلك الرؤية التاريخانية التي ترى أنها رؤية للكون والحياة وللإنسان وللمستقبل؛ وأنها تعني «ألا يسبقك الزمن»، وأن عمادها العقلانية والحرية، حيث يقول عن الأولى: «يقوم التحضّر على دعائم كثيرة من أهمها العقلانية… والعقلانية هي الاستناد إلى الترابط السببي في تفسير الظواهر المادية والاجتماعية والنفسية والأدبية والفنية جميعًا…»(11). كما يقول عن الحرية: «هناك أحلام تشترك فيها الإنسانية جمعاء… حددتها الفلسفة القديمة بثلاث قيم هي: الحق والخير والجمال. أما الفكر الحديث فيحددها في ثلاث قيم هي: الحرية والعدل والسلام. ونقصد بالحرية هنا معناها الفلسفي لا السياسي؛ فالتخلص من الفقر حرية، والخروج من الجهل حرية، والشفاء من الأمراض حرية، وكل أنواع الانفكاك من القيود التي تكبّل وصول الإنسان إلى السعادة، تسمى: حرية»(12). وفي حوار ثقافي مع العلي في النادي الأدبي بجدة يقول أيضًا: إن «الحداثة مفهوم يتغير، بمعنى أنها صيرورة تتطور، والمعنى الآخر للحداثة هو تجدّد المعنى، فحينما يتجدد المعنى لأي شيء… يتجدّد المفهوم… وهذا يعني أن يكون ما في أذهاننا مستعدًّا لأن يهبط ليحلّ غيره محله، و تلك هي الحداثة»(13).
ويوضح ذلك في كتابه «هموم الضوء» حين يقول: «والخروج من نظام تفكيرنا الراهن – ليصبح تفكيرًا في العقل وليس بالعقل وحسب – إلى نظام آخر يستوعب ثمار العصر ومنعطفاته… ليس سهلًا، فهو يستلزم شيئًا يسمونه (الحداثة) التي هي ليست شكلًا بل مضمونًا»(14). ويؤكد في كتاب جديد يصدر قريبًا عن دار الساقي، على هذا المعنى للحداثة بقوله: «الحداثة قفزة في القيم والمفاهيم. قفزة في تبلور الذهنيات وكل ما يتميز به الحاضر عن الماضي. الحداثة هي انتقال المجتمع، لا الأفراد من مستوى ذهني إلى مستوى أرفع منه».
خامسًا: الموقف من التراث والحداثة
لا يتفق العلي – ضمن رؤيته التاريخانية للحداثة – مع من يرى في الحداثة قطيعة كلية مع التراث، حيث يرى في التراث ما يبقى وما لا بد أن يموت، فيقول في هذا السياق: «يحتاج الماضي إلى قراءة، لنعرف ما غرسه فينا من أشجار مثمرة، ومن أشواك أيضًا، ويحتاج الحاضر إلى قراءة لنعرف إلى أين نتجه»(15). أما في تعقيبه على ما قاله الدكتور برهان غليون حول التراث والحداثة، من أنه «ليس من الممكن التخلي عن هذه الثقافة لغيرها»، فإنه يؤيد الرؤية، ويعدد أسباب قناعته بها، بقوله: «لأن طرق السلوك والتفكير وتحرك الوجدان مصاغة حسب هذه الثقافة، فهي البنيان الداخلي بكامله، وحين نلغيها نكون قد ألغينا في الوقت نفسه الذاكرة والوجدان»(16). وفي حوار مجلة النص الجديد معه قال: «الحداثة، كما أفهمها، مصطلح عربي تليد قبل أن يكون غربيًّا. الغرب ابتكر أسلوب حداثته وفق مقاييسه ومسار تطوره وحدودها. ولكننا نحن ورثنا مقاييسها، وأدخلنا عليها مفهومًا غريبًا أحالها إلى شبح مخيف بالنسبة للغالبية من مثقفينا وقرائنا. هذا المفهوم هو أن كل حداثة تبدأ من القطيعة مع التراث! هذا المفهوم خاطئ ومضلّل. إن الحداثة ليست شيئًا سوى (التطور والارتقاء على الذات، وانتقاء الإيجابيات في التراث وتعميقها لإغناء الحاضر»(17).
سادسًا: حداثة القصيدة عند العلي(18)
تجربة العلي تعد إحدى التجارب المؤسسة للحداثة الشعرية في المملكة، بما توافرت عليه من رؤية تنويرية وموقف تقدمي، وبما نهضت عليه من عدة إبداعية تميزت: بالعذوبة اللغوية، وأناقة بناء الصورة وتفردها، وكثافة التعبير في بناء الجملة الشعرية، والنص الذي يجمع بين البساطة والعمق، والوضوح والغموض الشفاف، وكذلك بالإفادة من معرفته الموسوعية بالتراث الشعري والإبداع المعاصر، لإنتاج نص خاص ومتفرد في رؤيته وتعبيره، بكل المقاييس النقدية وبكل ممكنات الاستقبال الجمالي.
كسر الغنائية في نصه الشعري
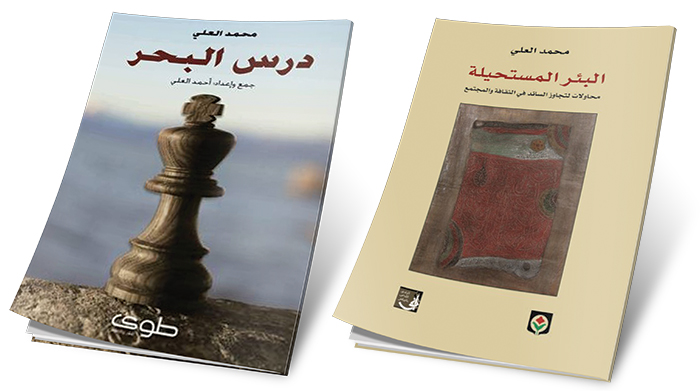 قد يذهب النقد الحداثي إلى توصيف العلي بالشاعر الغنائي، نظرًا لحضور ذات الشاعر في كليّة النص، لكونها بؤرة انعكاس التجربة ومنبعها في نصه الإبداعي، كذاتٍ رومانسية تنشد الحرية الفردية، وتتمرد على جميع الأنظمة والقوانين الاجتماعية، وتتولّع بالتغرّب والتغريب، والفرار إلى عوالم جديدة متخيلة، متدثرة بالكآبة والحزن. لكن قارئ قصائد العلي سيقف حتمًا أمام روحه المتشبثة بالحرية، وإعلاء قيمة الفرد، مثلما سيرى غابة من الحزن الشفيف تطبع كثيرًا من نتاجه الشعري، لابتعاد الأحلام عن التحقق، ولكن جدل هذين المكونين سيتضافران في تشكيل جمالية بنية نصيّة، تخرج القصيدة من غنائيتها التقليدية أو نزوعها الرومانسي، إلى أفق مغاير ينبني على امتزاج الخاص بالعام، والذاتي بالموضوعي، والفردي بالاجتماعي، والداخل بالخارج.
قد يذهب النقد الحداثي إلى توصيف العلي بالشاعر الغنائي، نظرًا لحضور ذات الشاعر في كليّة النص، لكونها بؤرة انعكاس التجربة ومنبعها في نصه الإبداعي، كذاتٍ رومانسية تنشد الحرية الفردية، وتتمرد على جميع الأنظمة والقوانين الاجتماعية، وتتولّع بالتغرّب والتغريب، والفرار إلى عوالم جديدة متخيلة، متدثرة بالكآبة والحزن. لكن قارئ قصائد العلي سيقف حتمًا أمام روحه المتشبثة بالحرية، وإعلاء قيمة الفرد، مثلما سيرى غابة من الحزن الشفيف تطبع كثيرًا من نتاجه الشعري، لابتعاد الأحلام عن التحقق، ولكن جدل هذين المكونين سيتضافران في تشكيل جمالية بنية نصيّة، تخرج القصيدة من غنائيتها التقليدية أو نزوعها الرومانسي، إلى أفق مغاير ينبني على امتزاج الخاص بالعام، والذاتي بالموضوعي، والفردي بالاجتماعي، والداخل بالخارج.
ويمكن أن نلخص أبرز خصائص شعرية العلي في النقاط الآتية:
– الحساسية اللغوية العالية وتجليها في رهافة وأناقة الصورة الشعرية (في صياغة الجملة، وفي تشكيل البنية الكلية للنص).
– المفارقة الحاملة لأبعاد تراجيدية السخرية، (عبر توظيف الدوال المتباعدة لإنتاج دال آخر)، بحسب الدكتور محمد الشنطي.
– تعد قصائده من النماذج البارزة على مفهوم الانزياح التي نظر لها نقاد الحداثة (جان كوهين مثلًا)، والتي تقوم على فاعلية الانتقال من مجاز المفردة إلى مجاز القصيدة، وتحويل كنائية الكلمات والجمل إلى فضاء استعاري كلي للنص، ينهض بمهمة التعبير المنتج لدواله الجديدة خارج الحمولات الجاهزة أو المرجعيات التقريرية المباشرة.
– استثمار فاعلية التناص مع التراث، وتوظيفه بشكل خلاق في إثراء جماليات النص وبؤره الدلالية.
– العلي شاعر تجربة غنية بمذخورها المعرفي والفني والحياتي، فكرًا وموقفًا، ويتبدى فيها صراعه الحضاري من أجل استيلاد الجديد، لذلك تغدو تجربته الشعرية أنموذجًا لتجادل المعرفي والجمالي مع الواقع، من أجل إنتاج بنية نص حداثي متجاوز، يقوم على فاعلية ما أسماه الدكتور كمال أبو ديب «الفجوة مسافة التوتر» في جل قصائده.
– يعمل على إخراج نصه من السمة الغنائية إلى التأملية الدرامية، عبر تشكيل حالة النموذج الفني التي لا يستخدم فيها تقنية القناع أو التوظيف الرمزي الأسطوري أو التاريخي، إنما يقوم بإنتاج رموزه الخاصة وأساطيره الصغيرة المختلفة، وتفتيق ثنايا النص بالأسئلة والحوار.
 ولعل أجمل ما قيل عن ملامح النموذج الفني، وتشكيل الصورة الشعرية في تجربة العلي ما كتبه الدكتور محمد الشنطي(19)، إذ يرى أن بنية النص الشعري عند شاعرنا، تنهض غالبًا على المزاوجة بين خصوصية الدلالة وعمومية التجربة، واستخدام الثنائيات لتفجير المفارقة، وفي تجاوز المستوى الغنائي والتقرير الحسي، إلى توظيف فاعلية التداخل النصوصي، أو التضمين بالاستعارة، واستدعاء النماذج التراثية، والإفادة من آليات السرد والتحول، وبناء درامية النص حول الجدل والحوار والاستهلال بالسؤال والافتراض، ليبتعد النص عن الموقف الرومانسي والنبرة الغنائية.
ولعل أجمل ما قيل عن ملامح النموذج الفني، وتشكيل الصورة الشعرية في تجربة العلي ما كتبه الدكتور محمد الشنطي(19)، إذ يرى أن بنية النص الشعري عند شاعرنا، تنهض غالبًا على المزاوجة بين خصوصية الدلالة وعمومية التجربة، واستخدام الثنائيات لتفجير المفارقة، وفي تجاوز المستوى الغنائي والتقرير الحسي، إلى توظيف فاعلية التداخل النصوصي، أو التضمين بالاستعارة، واستدعاء النماذج التراثية، والإفادة من آليات السرد والتحول، وبناء درامية النص حول الجدل والحوار والاستهلال بالسؤال والافتراض، ليبتعد النص عن الموقف الرومانسي والنبرة الغنائية.
– يتميز بالقدرة على الإيجاز والاختزال، والعمل على إبراء الشعر من اللغو، حيث يبدو كمن يجر اللغة إلى ما هو أبعد من اللغة، بحسب تعبير صبحي حديدي عن أحد الشعراء. لذلك نلحظ قصر نصه الشعري وكثافته، حتى وإن تعددت مقاطعه وبؤره الدلالية، وغالبًا ما يتكون العنوان من كلمة واحدة تحمل أبعادها الإيحائية الشاسعة، مشحونة بمقدرتها على التجادل مع الجملة الأولى في النص والتي تحمل بؤرة النص وإمكانيات تنميته.
– يتكئ على ذاته في ابتكار أساطيره ورموزه الخاصة، حيث لا يعتمد في شعره على توظيف أي معطى جاهز يتمثل في الأساطير المعروفة، أو الرموز الأسطورية أو التاريخية، أو تلك التي ترمّزها الحياة.
الصوت… والأجراس
في الختام، هدفت هذه القراءات «الصوت … والأجراس» إلى القول بأن النزوع إلى الحداثة ظاهرة تاريخية تعمقت عبر مراحل النهضة والتنوير في أوربا التي وضعت العالم على بوابة الواقع المنبني على العقلانية والتجريب العلمي والحرية وحقوق الإنسان، والمتحققة في نسبيتها في الحداثة كمفهوم متعدد الأبعاد في مختلف الحقول الاجتماعية والثقافية والسياسية، وليس في الإبداع وحده. وقد حاولتُ إلقاء الضوء على مقومات وفواعل ذلك النزوع والتشوف الحارق للحداثة لدى بعض آبائنا من الأدباء في المملكة، عبر ما أنتجوه، من محمد حسن عواد إلى محمد العلي.
وإذا كانت الأجراس التي دقوا نواقيسها، وأحدثوا أصواتها في فضائنا الاجتماعي والثقافي، لم تكن مؤثرة بالشكل الذي حلموا به، أو لم تعمل كما ينبغي على ترابط الأجيال، وتكامل الفعل الثقافي المؤثر في الطريق إلى الحداثة، التي نشهد اليوم خصوبة عطائها وبخاصة في الحقل الأدبي في المملكة، إلا أن تلك الأصوات قد أسهمت في تعميق الجرأة لدى الكتاب والمبدعين على اجتراح التعبير عن تطلعاتهم نحو التقدم والحداثة. كما أنها قد هيأت المناخ – وإن بشكل جنيني- لخوض المغامرة الفردية مثلما فعل هؤلاء الآباء، على رغم إكراهات الأنساق الثقافية والاجتماعية والمؤسسية المحافظة. ولعلنا لن نجاوز الحق والحقيقة إن ذهبنا إلى أن محمد العلي – بحكم الزمن والمتغيرات – يعد اليوم أكثرهم فاعلية وحضورًا وتأثيرًا في حياتنا الثقافية، عبر كتاباته المستمرة، وإبداعه ومواقفه الثقافية والنضالية خلال ما يقارب الخمسين عامًا، وأنه هو الأكثر قربًا إلى الفاعلية الأعمق لمفهوم الحداثة من كل رصفائه الشيوخ، ومن أدبائنا الشباب في المملكة.
—————————————-
المراجع:
(1) حوار على محطة LBC أجراه معه أحمد عدنان www.youtube.com
(2) الطريق إلى أبواب القصيدة – كتاب عن تجربة علي الدميني الثقافية والإبداعية – النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية – 2014م – ص 165، 166.
(3) نمو المفاهيم – دار الانتشار العربي والنادي الأدبي بالرياض – 2012م – ص 10.
(4) سحر كاظم حمزة الشحيري – مجلة جامعة بابل – مجلد 122 – العدد 1 – 2014م.
(5) كلمات مائية – دار الانتشار العربي – 2009م – ص 163-171.
(6) درس البحر – دار الجمل ودار طوى – 2012- ص 346.
(7) حلقات أولمبية – دار مدارك ونادي تبوك الأدبي 2013م – ص58.
(8) انظر محاضرة «مفهوم التراث» – ص 73 و ما بعدها، في كتاب «نمو المفاهيم» -مصدر سابق
(9) نحن والتراث- المركز الثقافي العربي-1991م- ص 17.
(10) الحداثة – جدل الكونية والخصوصية – المركز الثقافي العربي – بيروت 2014م – حوار مع د.حمادي جاء بالله.
(11) درس البحر – مصدر سابق – ص 203.
(12) درس البحر – مصدر سابق – ص 168.
(13) نشرت جريدة الجزيرة ملخصًا للحوار أعده صالح الخزمري – العدد 13203 – 21\11\2008م).
(14) هموم الضوء – دار الجمل ودار طوى – 2013م – ص340.
( 15) درس البحر – 234 – مصدر سابق.
(16) هموم الضوء – ص 338 – مصدر سابق.
(17 مجلة النص الجديد – العدد الأول – 1993م ص44-45.
(18) (اتكأت في هذه الفقرة على كتابي « أمام مرآة محمد العلي» دار الانتشار العربي- 2012م- ص 132 وما بعدها).
(19) من كتاب عزيزة فتح الله – محمد العلي / دراسات وشهادات – دار المريخ 2005 م- ص 140.

علي الدميني - شاعر و كاتب سعودي | أغسطس 30, 2016 | دراسات

علي الدميني
عمل مفكرو النهضة والأنسنة والتنوير، منذ القرن الرابع عشر الميلادي في أوربا حتى قيام الثورة الفرنسية، على التأكيد على دور أسئلة النقد والشك والنقض؛ لتسييد ثقافة العقلانية وفضاءات الحرية لمواجهة أسئلة وتحديات حياة مجتمعاتهم، ولذلك عادوا إلى ثقافة العقل في الفلسفة اليونانية، وإلى ما حمله فلاسفة المسلمين منها وبخاصة «ابن رشد»، ثم فتحوا الأبواب بشكل نسبي للفكر النقدي؛ لمقاربة كل المنظومات التي وقفت أمام تطور المجتمعات وتقدمها في مختلف الحقول والميادين.
هؤلاء الأفراد لم يكونوا يمتلكون ترف رسم أفكارهم على الجدران أو جذوع الأشجار في نزهة ريفية، لكنهم ببصيرة معرفية وشجاعة إنسانية حاولوا ثقب الجدران والأسوار؛ لتفتيق فضاء كوى النور والآفاق المستقبلية، فعلقوا الأجراس وقرعوها بقوة؛ لتعبر عن مصداقية صوت العقل والضمير وجدارتهما برفض كل أشكال الاستبداد والظلم والتخلف التي كانت تعم حياة مجتمعاتهم. وعلى الرغم مما عانوه من تحديات دفع بعضهم حياته ثمنًا لها، فقد ظلت أصواتهم حية وفاعلة في وجدان مجتمعاتهم وفي المجتمعات الإنسانية الأخرى عبر مئات السنين؛ إذ أسهموا بفاعلية نوعية في تعبيد الطريق واستنبات الأشجار المعرفية الجديدة التي أنتجت «تيارات نقدية وفكرية وفلسفية ومذاهب سياسية ، كالإصلاح الديني عند لوثر، وفلسفة التاريخ ( هيغل وماركس)، وفلسفة القانون ( مونتسيكو)، ونظريات العقد الاجتماعي (هوبز ولوك وروسو)، والحداثة الفلسفية ( ديكارت)».( إبراهيم الحيدري – عصر التنوير والحداثة – موقع الحوار المتمدن – 14\1\2015م).
إن التوق إلى حياة تبتسم فيها الحرية، وتتجلى فيها مصابيح العقلانية، وتتعمق عبر مخاضاتها ملكات النقد والشك والنقض والبناء والإبداع، هي أصوات «الحداثة» المقموعة عبر العصور القديمة، رغم ما بقي منها من أوراق حية قليلة تبدّت في الفكر والفلسفة والآداب. لهذا يقرع كانط (مؤسس الفلسفة النقدية) في عام 1784م أجراسه بصوت عالٍ؛ لتحديد مفهومه للتنوير بالقول إنه: «خروج الإنسان من قصوره المعرفي الذي اقترفه في حق نفسه من خلال عدم استخدامه «لعقله» إلا بتوجيه من إنسان آخر». وقال بعد ذلك جملته الشهيرة: «كن شجاعًا واستخدم عقلك».
موقع معابر _ كانط والتنوير:
http://www.maaber.org/issue_january09/perenial_ethics1.htm
 لكل هذا، فإننا نرى أن هذا الصوت وسواه قد أسهما في خلق حالة «من التحولات البنيوية الجذرية والانقلابات في أغصان الحياة التي وضعت أسسًا لقيام عصر التنوير في أوربا وأميركا، وقيام الثورة الفرنسية في عام 1789م، التي قضت على السلطات والبنى الإقطاعية والكنسية والاستبدادية، وتُـوجت بلائحة حقوق الإنسان، وتدشين عصر الحداثة الذي رأى فيه هيغل زمنًا جديدًا .. زمنًا صنعناه بأنفسنا» (إبراهيم الحيدري – المرجع السابق).
لكل هذا، فإننا نرى أن هذا الصوت وسواه قد أسهما في خلق حالة «من التحولات البنيوية الجذرية والانقلابات في أغصان الحياة التي وضعت أسسًا لقيام عصر التنوير في أوربا وأميركا، وقيام الثورة الفرنسية في عام 1789م، التي قضت على السلطات والبنى الإقطاعية والكنسية والاستبدادية، وتُـوجت بلائحة حقوق الإنسان، وتدشين عصر الحداثة الذي رأى فيه هيغل زمنًا جديدًا .. زمنًا صنعناه بأنفسنا» (إبراهيم الحيدري – المرجع السابق).
الحداثة إذن تبدأ بذلك النزوع والتطلع الإنساني الطويل لبلوغ أزمنة الحرية والعقلانية والإبداع والثورة على قيود الأنماط ومؤسساتها، في كل المسارب والحقول، وإن تعددت أشكال وأساليب البحث عنه للإمساك به باليدين؛ لذا ترى غيرترود هيلمفارب مؤلفة كتاب «الطريق إلى الحداثة» أن عصور النهضة (والأنسنة .. باعتبار الإنسان محور الحياة والكون، ومصدر المعارف) والتنوير تحديدًا، هي محطات ومقدمات أساسية في بنية فكر وعصر الحداثة، وأن أبرز السمات التي ترتبط بالتنوير هي العقل والحقوق والطبيعة والحرية والمساواة والتسامح، والعلم والتقدم، حيث يكون العقل في المقدمة. وعلى الرغم من أنها تذهب في هذا الكتاب إلى الانتصار للتنوير البريطاني ضد التنوير الفرنسي الذي احتكر مفهوم التنوير بجدارة مستحقة، فإننا سنرى معها أن «التنوير البريطاني قد حمل سمة إصلاحية غير ثورية؛ لأنه عايش مراحل إصلاح دينية وسياسية، ويمثل (سوسيولوجيا الفضيلة)، أما التنوير الفرنسي الذي لم يصاحبه إصلاح ديني أو سياسي، فقد كان تنويرًا ثوريًّا، واستند إلى (أيديولوجيا العقل)، فيما مثّل التنوير الأميركي (علم سياسة الحرية) المتأثر بثقافة الإصلاح والتنوير البريطاني». (غيرترود هيلمفارب – الطريق إلى الحداثة – ترجمة د. محمود سيد أحمد– نشر عالم المعرفة الكويتية – سبتمبر 2009م).
حمزة شحاتة ( 1910- 1972م)

حمزة شحاتة
في الجزء الأول من هذه الكتابة، وقفنا على النواظم الأساسية في اشتغالات محمد حسن عواد، (نشر في هذه المجلة، العددان 475- 476) وهي تأكيد دور العقل والعلم والحرية والثورة على التقاليد الاجتماعية والأدبية وبخاصة في حقل الشعر، كأسس للنهضة والتنوير والنزوع إلى الحداثة. وعلى الرغم من أن كتاباته قد افتقرت إلى العمق المعرفي والفلسفي، فإن نبرتها الراديكالية الشجاعة العالية دقت الأجراس وأحدثت أصواتها تفاعلات نسبية مع مضامينها القوية، في حياتنا الثقافية؛ لذا يمكننا أن نعده منتميًا للأفكار النهضوية العربية التي انحازت إلى التنوير الفرنسي.
أما حمزة شحاته، الشاعر البارز الذي نهل بتميز عصري من تراث الحداثة الشعرية العربية القديمة، والكاتب المبدع في أسلوبه البياني المعاصر، فقد نهل من منابع الفكر والفلسفة النهضوية الأوربية التي وصلتنا عبر أبرز الكتاب والأدباء العرب المتأثرين بفاعلياتها. ويمكن عده أقرب إلى التنوير البريطاني النقدي والإصلاحي الذي جعل من الفضائل والتعاون والضمير مسارًا رحبًا لتوجهاته.
وفي هذه الوقفة السريعة على منجزه الثقافي البارز (الذي قُمع بقسوة)، سنشير إلى بعض تجليات تلك الجذور الفكرية في محاضرته وبيانه الموسوم بـ«الرجولة عماد الخلق الفاضل»؛ إذ سنرى أنه منذ البدء في محاضرته سيسفر عن خطابه المعرفي الناهض على الفكر العقلاني والفلسفة الإنسانية، حين يقول: «وأنا أريد التجريد والتعرية، كباحث لا كمحاضر … والتجريد في مرحلته الأولى رد المسائل إلى أصولها المفروضة، وإلى أساساتها العارية… فالتجريد يمس العقائد الفكرية –لا شك– ويهدم منها شيئًا ليقيم شيئًا محله» … ويمضي للتركيز على أهمية الشك المعرفي بقوله: «والجديد متى استطاع أن يقيم الشك في نفسٍ، فإنه قد غزاها الغزوة الأولى».
وحين يتعمق في منحى التجريد الفلسفي يقف على منشأ الفضائل بالتساؤلات الآتية: كيف نشأ الشعور بهذه الفضيلة؟ وكيف فُرِضَت وكيف تم الإيمان بها؟ أو الاصطلاح عليها؟ وكيف سادت أحكامها؟
ويذهب في الإجابة عن تساؤلاته إلى البعد التاريخي العميق لتكون التجمعات البشرية، كباحث سوسيولوجي، مؤكدًا أن الخير والشر كانا متزامنين ومرافقين للوجود البشري البسيط، ويقول في هذا المنحى: «ولا شبهة، أن الإنسان قد عرف النفع والأذى قبل أن تقوم في نفسه فكرته الأولى عن الخير والشر، باعتبار مفهوميهما العام، فاهتداؤه إلى الخير والشر، كان بعد عقيدته في النفع والأذى».
ويصل بعد ذلك إلى أن ترسُّخ قيم الفضائل لم يتم إلا في فجر المدنية الفكرية الأولى للإنسان، نافيًا أن تكون تلك الفضائل موضوعًا غريزيًّا نابتًا في قلب الإنسان، بل يردها إلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في التجمعات البشرية، وهنا نرى صدى وعمق الصراع الفلسفي بين جون لوك وهوبز حول خيرية الإنسان الطبيعية وخيريته المكتسبة والمترسخة بفعل القانون!
وحول القيم الإنسانية الفاضلة التي أنتجتها حاجة المجتمعات للتعاون من أجل الوقوف ضد كل ما يهدد حياتهم ووجودهم من مخاطر، والعمل على التطور والنهوض، يقول بعد ذلك: «كلنا يؤمن بضرورة الارتقاء والنهوض… فهل أفادنا هذا الإيمان؟»، ليؤكد على أنه لا قيمة لذلك من دون العمل بهذه القيم والفضائل لبلوغ مرحلة الوفاء لهذا اليقين النائم!
إنها ثقافة عارفة وفكر عميق، نجدها في كتابات حمزة شحاتة، تنبئ عن فجر مفكر بارز ومنهج فلسفي مطلع يعمد إلى الغوص عميقًا صوب الجذور؛ لإعادة الظواهر والقناعات والقيم إلى أسبابها لكي تسمو الفضائل إلى مصاف الضمير، وهو ما عبر عنه «بالحياء» إذ يقول: «الحياء: قوة النفس، وحرية العقل، وميزان الضمير. والرحمة عدالة النفس. والعدالة رحمة العقل وبصره وسلطانه».
ويختتمها بشعارات ثقافية يكون الحياء الغائب عنصرًا مهيمنًا على خطابها، قائلًا: أيها الكاتب الذي يئد الحق والجمال والقوة ليظهر … استحِ!
أيها الشاعر الذي يصنع الكذب والباطل والتملق في شعره فيسجل به عارًا على أمته… استحِ! أيها الفاضل الذي يتاجر بفضيلته ليفيد بها مالًا وسمعةً…. استحِ!
أيها الوطني الكاذب الذي يتنكّبُ سبل الجهاد، ويروغ من التضحية الصادقة، فيجعلها فلسفةً تتعلّق بالممكن وغير الممكن… استحِ! (اعتمدت في نقل الأجزاء المنصوص على نسبتها لمحاضرة حمزة شحاتة، على نصها المنشور في مدونة محمود صباغ):
نص محاضرة الرجولة عماد الخلق الفاضل لحمزة شحاتة
وبعد هذه الخلاصة المجحفة بحق ما ورد في المحاضرة، يخيل لي بأن حمزة شحاتة قد كتبها وفي ذهنه كلمات الشاعر:
فإما حياة تسر الصديق *** وإما ممات يغيظ العدا!
لقد كانت المحاضرة بيانًا شاملًا إلى الأمة، من مفكر نهضوي وتنويري، وكانت من جانب آخر، رصاصته الأخيرة، كمثقف عميق وشجاع ومبدع؛ إذ كان يكتبها وهو يتحسس رأسه رمزيًّا وحياته معنويًّا، ولكنه كان مصرًّا على الجهر بها في ذلك المشهد الجماهيري الكبير، فكانت كتابًا وبلاغًا قرأه مدة خمس ساعات متواصلة، قوبل خلالها بعض فقراتها بالتصفيق الحاد لأكثر من ثلاثين مرة !!
وقد عبر في محاضرته عن إحساسه بذلك الخوف، بقوله: فإذا خفت الليلة، فإني أخشى خطرًا عرفت مشابهه في نفسي، فإن كُتبت لي السلامة –ولا أتوقعها– فإنما تكون أثر الحظ، وخارقة من خوارق المعرفة. وما أود أن تكون خاتمتي بينكم موتًا، بل انتحارًا. فالانتحار –هنا على الأقل– أضمن لتحقق الاختيار من الاستسلام للموت. ولعله أدلّ عندي على الحيوية، وتركز الإرادة ، ووضوح الفكرة ، وقديمًا قالت العرب: «بيدي لا بيد عمرو». (من مقتطفات في كتاب عبدالله عبدالجبار – التيارات الأدبية في قلب الجزيرة العربية).
كل ما توقعه حمزة شحاتة خلال المحاضرة قد حدث، فقد ألغي النشاط الثقافي لجمعية الإسعاف الخيري في مكة، ولم تنشر المحاضرة أو أجزاء منها في الصحف آنذاك، ولم يتفاعل مع مضمونها الكتاب، وتعرض شخصيًّا لكثير من المضايقات على خلفيتها، ومنها استدعاؤه من مدير الأمن العام؛ إذ طلب منه نص المحاضرة، فأجابه بأنه أحرقها! وحينما رأى هذا المثقف الواعي والنابه أنه يبذر في واد غير ذي زرع، وينحت في صخرٍ من فراغ، قرر الهجرة إلى مصر عام 1944م، ومنذ ذلك التاريخ حتى وفاته كان قد كسر قلمه إلى الأبد!
ولذلك، وكما يشير الدكتور عبدالله الغذامي في كتابه المهم «حكاية الحداثة»، إلى أن الحداثة في بلادنا بدأت من محمد حسن عواد وحمزة شحاتة، ومؤكدًا على: «أن انكسار وانسحاب شحاتة قد حرم الحركة الثقافية عندنا من نموذج مهم له من القوة والعمق ما كان سيكون سببًا لبدء حركة التحديث الثقافي الواعي». (عبدالله الغذامي – حكاية الحداثة – المركز الثقافي العربي).
عبدالله عبدالجبار ( 1919 – 2007م)

عبدالله عبدالجبار
ربما يكون أقرب التوصيفات لهذه القامة الأدبية السامقة هو المثقف النهضوي والتنويري، الذي كانت بوصلة التقدم والحرية والعدالة الاجتماعية والغد الأجمل تقوده إلى دروب الخيارات الصعبة فيقبل التحدي بصلابة رجل المواقف، ويمضي في مساره برحابة أفق ورؤية واعية، محتملًا النتائج من دون خوف أو تردد.
وهو شخصية وطنية تقدمية ترتكز على مقومات الثقافة الواسعة والعميقة، التي تمتد من سعة الاطلاع على التراث إلى المدارس النقدية الحديثة –في مرحلته– حيث يُعد كتابه «التيارات الأدبية في قلب الجزيرة العربية» أحد أهم المراجع الأدبية التي رصدت بوعي مختلف مسيرة الحياة الأدبية في الحجاز قبل توحيد المملكة وبعدها حتى تاريخ نشر الكتاب في عام 1959م؛ لذلك سيلحظ قارئ كتابه موقفه النقدي ذا البعد الاجتماعي والأخلاقي والثوري من النتاجات الأدبية التقليدية الميتة، مثلما سيقف على رؤاه النهضوية التنويرية ، وبخاصة ما يتعلق منها بالحرية والعدالة الاجتماعية، بما يسمح لنا بالقول بأنه ينتمي للتيارات المتأثرة بالتنوير الفرنسي، وبما يماثله بعد ذلك من تبديات اجتماعية وثقافية مختلفة في خندق ثقافة اليسار العربي.
ويبدأ الجانب النقدي من كتابه بالوقوف على معنى انطلاق رصاصة التحرر من الاستعمار التركي وبدء الثورة العربية من مكة المكرمة في عام 1916م، وأثر ذلك في المناخ الثقافي والإبداعي العام في المنطقة، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة تكوين المملكة العربية السعودية وما صاحبها من حراك متعدد الأشكال والتباينات.
وفي لمحات مختصرة وعميقة –تعكس سعة اطلاعه– يشتغل على قراءة وتحديد ملامح النصوص الشعرية التي ضمها كتابه، ويصنفها بحسب موقعها، ضمن ما جرى تبيئته في الثقافة النقدية العربية، عن مسارات المدارس النقدية الحديثة الأوربية التي انتشرت في مراكز النهضة العربية، مستعينًا في ذلك بعناوين تلك المدارس النقدية الرئيسة، وبما فتقه منها من عناوين فرعية.
ففي تصنيف الشعر المنتمي إلى الكلاسيكية في بلادنا، يضع توصيفًا للكلاسيكية الميتة المعتمدة على محاكاة القدماء في أساليبهم في المديح والنفاق، بحيث تغدو التسمية جزءًا من رؤيته الجمالية والدلالية في تقييم النص. ويضع تعريفًا آخر أسماه الكلاسيكية الحية التي تجمع بين السير على محاكاة أساليب الشعر القديمة في حياة شعريتنا العربية وامتزاجها بالبعد الوجداني الذاتي (الرومانسي) للشاعر، من زهير بن أبي سلمى إلى أبي تمام والمتنبي وأبي نواس والمعري، وامتدادها عندنا من الأسكوبي إلى حمزة شحاتة. (عبدالله عبدالجبار – التيارات الأدبية في قلب جزيرة العرب –إشراف محمد سعيد طيب وعبدالله الشريف– دار الفرقان).
وعن التيار الرومانسي في شعرنا، يكتب خلاصة ناقد مطلع عليها في مراجعها، مشيرًا إلى بواعثها الإنسانية التي يتشابه فيها كل البشر والناتجة عن وعي ضدي بالواقع المعيش الذي يبعث على «القلق والاضطراب [التي] عاش في ظله الأدباء، وشعورهم بتخلخل المجتمع وانتكاس القيم، وعدم قدرتهم على تحقيق مآربهم وآمالهم العريضة، في جو يسوده الجهل والفوضى والجمود والاستبداد… فهناك إذن مطامح عظيمة تجتاح قلوب الشعراء، ولكنها تصطدم دائمًا بعقبات وحوائل تحول دون تحقيقها في واقع الحياة». ( المرجع السابق – ص 274)، وقد اختار في هذا السياق عددًا من قصائد الشعراء؛ منهم: إبراهيم فلالي، وحمزة شحاتة، ومحمد سعيد المسلم، ومحمد حسن فقي، ومحمد عامر الرميح، ومحمد سعيد الخنيزي، وغيرهم. أما عن الشعر الرمزي في نتاجات شعرائنا في تلك المرحلة، فيذهب إلى تحليل معنى المعنى في قصيدة «الدودة الأخيرة» للشاعر حسين سرحان المنشورة في مجلة الآداب، عدد مارس من سنة 1958م، التي رأى فيها أنموذجًا لنقد الطبقة الجشعة التي تمتلك الجاه والمال والسلطة، وتقسو على البسطاء فتأكلهم، لكن مصيرها بعد ذلك سيقودها إلى أن يأكل بعضها بعضًا حتى تفنى!
ويورد قصيدة حسن القرشي «مناجاة» التي بدأها بالتغزل في فاتنة جميلة ما لبثت أن تحولت في النص إلى دلالة على «الحرية». كما يشير إلى رمزية قصيدة حمزة شحاتة ضد الاستبداد، الشهيرة «ماذا قالت شجرة لأختها»، وسواها من نماذج أخرى.
وقد استدعى ضمن حقل ثقافته النقدية، مقارنة دلالات تلك النصوص بما يترامى إلى مشابهاتها من قصائد رمزية، وقف فيها على ما أبدعه الشاعر الروسي «بلوك» في قصيدته «الاثني عشر» وما حوته من دلالات عن الليل والتسلط، والجنود الذين يرمزون إلى الشعب، والريح التي تومئ إلى القوى القادمة لتكوين الحياة الجديدة. وأشار إلى ما حملته قصيدة «الوردة الخفية» للشاعر الإيرلندي «ييتس» من رمزية، حيث تدل الوردة على وطنه إيرلندا.
الواقعية النقدية

 الناقد بعد كل هذا العرض ينتمي فكريًّا وممارسةً إلى «الواقعية النقدية»، حيث أفرد لهذا الحقل النقدي اهتمامًا ثقافيًّا معمقًا، تعرض فيه لمفهومها الذي تترابط فيه الذاتية الرومانسية بالذاتية الواقعية تاريخيًّا، فعرض لتجلياتها القديمة كواقعية تشاؤمية مغلقة وتصويرية باهتة، ثم تطورها بعد ذلك إلى واقعية تفاؤلية، سميت «بالواقعية النقدية الحديثة» على يدي «غوركي» وأمثاله، وتستند إلى الرؤية النقدية للواقع والبحث عن آفاق تطور الحياة في أبعادها الشاملة، من أجل الإعلاء من شأن إنسانية البشر. ويورد نماذج متعددة لشعراء تلك المرحلة في بلادنا ممن عبروا عن ذلك الاتجاه، في أبعاده الاجتماعية، والراديكالية، والوطنية والقومية، من أمثال حمزة شحاتة، وماجد الحسيني، والمنصور، والششة، وبابصيل ، وسواهم.
الناقد بعد كل هذا العرض ينتمي فكريًّا وممارسةً إلى «الواقعية النقدية»، حيث أفرد لهذا الحقل النقدي اهتمامًا ثقافيًّا معمقًا، تعرض فيه لمفهومها الذي تترابط فيه الذاتية الرومانسية بالذاتية الواقعية تاريخيًّا، فعرض لتجلياتها القديمة كواقعية تشاؤمية مغلقة وتصويرية باهتة، ثم تطورها بعد ذلك إلى واقعية تفاؤلية، سميت «بالواقعية النقدية الحديثة» على يدي «غوركي» وأمثاله، وتستند إلى الرؤية النقدية للواقع والبحث عن آفاق تطور الحياة في أبعادها الشاملة، من أجل الإعلاء من شأن إنسانية البشر. ويورد نماذج متعددة لشعراء تلك المرحلة في بلادنا ممن عبروا عن ذلك الاتجاه، في أبعاده الاجتماعية، والراديكالية، والوطنية والقومية، من أمثال حمزة شحاتة، وماجد الحسيني، والمنصور، والششة، وبابصيل ، وسواهم.
ولعل هذه المحاضرات -التي صارت كتابًا في جزأين فيما بعد- قد أسهمت في بقائه طويلًا مغتربًا عنا في مصر، حتى سُجن في العهد الناصري الذي عشقه، وبعد خروجه من المعتقل ذهب إلى لندن، حتى عاد إلى الوطن ليمضي فيه عشرين عامًا قبل وفاته، صامتًا من دون مشاركة في حياتنا الثقافية والأدبية، عدا تعيينه شرفيًّا مستشارًا لجامعة الملك عبدالعزيز، ولمؤسسة تهامة. وفي هذا السياق أذكر أنني ذهبت إليه في جدة لإجراء حوار ثقافي معه -بصحبة حسين بافقيه- لمجلة النص الجديد، لكنه اعتذر منا بأدب بالغ!
وهنا، أخلص إلى القول بأن كتابه «التيارات» لا يُعد إضافة أو رافدًا للنقد الأدبي في المملكة، خلال مرحلته وحسب، بل هو تجاوز لاشتغالات الناقد نفسه خلال المراحل السابقة لتأليف الكتاب. ولو قُدِّر للكتاب أن ينشر ويوزع في ربوعنا حينها لأسهم بعمق في ترسيخ ثقافة الدرس النقدي الحديث، ولعمل على تطوير الرؤية النقدية ذات البعد الاجتماعي والتحديثي والتنويري المفضي إلى دروب الحداثة، على الرغم من افتقاره إلى إيلاء البعد الجمالي في الإبداع حقه وموقعه في قراءة النصوص الأدبية التي اشتغل عليها في هذا الكتاب وسواه!
أصداء النهضة والتنوير
الأفكار الحضارية الفاعلة (كفكر إنساني) تمتلك أجنحة خفاقة تحملها على الانتقال بين الأمكنة والأزمنة، باحثة عن مثالاتها المتعطشة إلى حالات التخلّق والولادة والانبثاق؛ لذا وجدت في عالمنا العربي، كما في غيره، أفرادًا يحتفون بطيرانها قريبًا منهم.
ولذلك اشتغلت عوامل كثيرة على تأثر نخب العالم العربي بفكر النهضة والتنوير الأوربيين، يندرج ضمنها حالة التململ والرغبة في الانعتاق من نير الاستعمار التركي، والتأثر المباشر بالاطلاع على مكونات وعود الأفكار التنويرية للثورة الفرنسية، والبعثات التعليمية إلى أوربا، والحركة الثقافية للعرب في المهجر، فيما كان للحملة الفرنسية «على الرغم من طابعها وأهدافها الاستعمارية» على مصر في عام 1798م، والشام بعد ذلك، دور مهم في تشكيل مناخات فكر اليقظة والنهوض العربي، حين تعرفت تلك النخب المطبعة والكتاب والجريدة، فبدأت في تكوين جمعياتها الثقافية والسياسية.
وكان مثقفو رعيلنا الأول في المملكة (من أمثال محمد حسن عواد، وحمزة شحاتة، وأحمد سباعي، وعبدالله عبدالجبار، وحمد الجاسر، والجهيمان، وغيرهم من معظم المشتغلين بالهم التقدمي في بلادنا) من المتأثرين، بدرجات مختلفة، بفواعل تلك المرحلة العربية، ثقافيًّا وسياسيًّا وأدبيًّا؛ مما حدا بهم إلى الإسهام المبكر في نقد ثقافة الجهل والتخلف في مجتمعاتنا، واجتراح مهام إشعال أنوار الفكر الحر المتطلع إلى التقدم الإنساني والحضاري.

علي الدميني - شاعر و كاتب سعودي | مايو 9, 2016 | دراسات

علي الدميني
«كان العواد طالبًا يضيق به مقعد الدراسة كما يضيق به أكثر مدرسيه؛ لجرأته وشذوذ فكره، وراحته مع الكبار!!»(1). تمتد إمكانية «تعليق الجرس» من حالة العدم والاستحالة حتى الضبابية إلى أن تصل إلى الحد الذي يمكن أن تتحول فيه أي خطوة نمشيها في البيت أو الشارع أو مقعد الدراسة هي محاولة لرفع ذلك الجرس. وفيما يبدو الفضاء هنا متسعًا لكل إنسان لتجربة ذلك الاحتمال، إلا أن الفارق الوحيد بيننا ينهض من قدرة ذلك الفرد أو القلة من الأفراد على إحداث الصوت المختلف الذي يجعل من حمل الأجراس إشارةً إلى النجمة البعيدة!
ولذلك يغدو الكلام عن هذه النجمة ـ «الحداثة» وروادها في بلادنا حديثًا عن الإشارة إليها وهي تلوّح ببريقها لنا من أعالي أمكنتها من دون أن تترجّل إلى وهادنا الصحراوية الشاسعة، ودون أن نمتلك الجرأة على الصعود العصيّ إليها. ذلك أن الحديث عنها في واقع عربي ينتمي إلى عصور ما قبل الحداثة، والذي يتسم ويفتخر بسمات تغييب العقلانية وانعدام الحرية، وبعدم وجود المناخ الثقافي الضامن لنمو الفرد وملكاته وحقوقه، وبتسييد ثقافة تحتفي بالنقل ضد العقل والاتباع من دون الإبداع، سوف يغدو في أفضل أحواله حديثًا عن نسبية مفهوم «الحداثة» التي يمكن أن يتبنى التفكير في أسئلتها الجذرية فردٌ أو أفراد قلّة من أمثال ذلك الطالب المتسائل والمتمرد «محمد حسن عواد» أو«عبدالله القصيمي» أو «محمد العلي» ومن حضر بعدهم!
– وفي مقالة بعنوان: «أيها المتشاعرون»، يوجه خطابه إلى الشعراء المنخرطين في كتابة الشعر الشكلاني لا في إبداعه، تشطيرًا وتخميسًا وتشجيرًا قائلًا: «نظم الشعر جميل، ولكن أين الشعر فيما تنظمونه أو تروونه؟ كل هذا أيها المتشاعرون صديد فكري، وقيوء لو أنفق العمر أجمعه في مثلها لما وصل الناظم إلى الشعر… وما الشعر إلا روح شيطانية عاتية تأبى أن تسكن هذه الخرائب البالية المحطمة… والشعر ليس ألفاظًا ومعاني فقط، وإنما الشعر أمرٌ آخر خلف الألفاظ والمعاني» ص 46.
– «بطرفٍ من الفلسفة، وقبسٍ من التاريخ، ولمحةٍ من العواطف، وتيارٍ هائلٍ من التفكير، يتكوّن الأدب العصري الصحيح» ص 116.
– «أحسن وسيلة لتربية العقل هي التفكير بحرية، وعدم قبول الأشياء على علاتها» ص 113.
– «أتى الدين ليسدد خطوات الإنسان، ويقوده إلى طريق الحقيقة، والنور خلق ليقضي على الجمود، وليضع حدًّا للتعصب العنصري، والغشاوة الفكرية، ويُنهض الروح من مَبَارك كان معتقلًا فيها، فلا يجب أن نشوّه سمعته، فنفهم أن وظيفته هي أن يعلمنا الصوم والصلاة والاعتكاف فحسب» ص 114.
– «تعليم المرأة سنّة مدنية يجب ألا يهملها الشرقيون» ص117، كما يقول في خطابه إلى المرأة: «فكّري، واكتبي، واقرئي، واستعدي، وتعلمي، ودعي التقليد، فأمامك مستقبلٌ مثير حافلٌ بما حملته إلى الشرق وإلى الغرب، وستحمله مدنية القرن العشرين» ص 56.
– يقول في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب: «إن الأساس الذي بني عليه هذا الكتاب -بجزأيه- ليس هو تطوير فن الكتابة وحده، فهذا بعض جوانب الأساس، ولكن هو الخلق.. الإبداع.. إبداع الواقع وخلق المستقبل عن طريق فن الكتابة وفن التفكير. وأنا أستعمل كلمة «خلق» هنا وأكررها عمدًا وأضغط عليها للفت نظر المعنيين بالإصلاح من ولاة الأمور العامة، والمعنيين من حملة الأقلام الجريئة، إلى وجوب تحطيم الوهم القائل «ليس بالإمكان أبدع مما كان»(3).
هذه العناوين وتفصيلات مضامين مقالاتها، تعيننا على رؤية حامل الأجراس وهو يقرعها بعنف؛ ليصل صدى أصواتها إلى من حوله، ناطقة بلسان فصيح بأن طريق الرقي والتقدم ينطلق من ثورة فكرية تسعى لتسييد العقلانية ضد الخرافة، والمعرفة العلمية ضد ثقافة الوهم، وحرية الفرد وتعبيره وتفكيره ضد القمع، وحرية الإبداع الجديد ضد السائد والنمط المستهلك، وضد الاتباع والتقليد!
وحين نمد هذه العناوين إلى جذورها العميقة في الفكر والحقوق والإبداع والاجتماع، سنرى أنها تتقاطع -على بساطتها هنا- مع أهم مرتكزات «الحداثة» القائمة على العقلانية والحرية، وكيان الفردانية وحقوقها، وفي الثورة على النمط والاتباع في الإبداع. وحيث نرى -من منظور زمني ومعرفي مختلف- أن متون هذه العناوين تفتقر إلى العمق المعرفي والمنهجي، فإنها في لحظتها التاريخية تلك ستكون-رغم كل شيء- نزوعًا وتشوفًا مبكرين صوب آفاق الحداثة، وقد استقرّت في كيان هذه الذات المتمردة!
شهادة من أبرز المنافسين
لعل من أهم الشهادات التي عبر عنها أحد أبرز مجايليه من المنافسين والمحبين في آن، هو ما قاله عزيز ضياء عن هذا الكتاب: «والذين يعطون العواد صفة «الشعلة الاجتماعية» أو من يعتبرونه حامل شعلة رسالة اجتماعية أكثر من كونه شاعرًا ينصفونه ويضعونه في المكانة الرفيعة التي استحقها عن جدارة.. وكتابه «خواطر مصرحة» كان أشبه بقنبلة، لا أدري شخصيًّا كيف استطاع طباعته ونشره. وذلك في حد ذاته معجزة لم يسبق لها مثيل، ولم تتكرر حتى اليوم. وليس في أسلوب الكتاب ما يُنظر إليه كإبداع أو عمل فني متميز، ولكن الموضوعات التي عالجها –وبصراحة- هي التي استوقفت الأنظار، وزلزلت السطوح الراكدة والعقول الغافية أو الخامدة،… وكان العواد فتى فقيرًا جدًّا، ولكنه اكتشف ما وراء ذلك الواقع البائس من غد، فألّف كتابه وطرحه في الأسواق (سرًّا) وقد بلغ من شجاعته أن أصرّ على كل كلمة قالها وكانت مما يجب أن يقال… إلى آخر الشهادة المثبتة بكاملها في مجلة النص الجديد.(4)
ورغم كل ذلك فقد استمر العواد في قرع أجراسه التنويرية في الكثير من المجالات. وفي عنفوان ثورته على القديم شكلًا ومضمونًا ذهب مبكرًا في استهداف تحطيم «رمزية» الإلف والاعتياد والنمط السائد، بكسر العمود الشعري بكل أركانه البلاغية المهيمنة؛ ليبتكر خلقًا شعريًّا مختلفًا حين نشر قصيدتيه من الشعر الحر في صحيفة القبلة عام 1921م، وهما: «تحت أفياء اللواء»، و«نطلب العزّة أو يهراقُ دم». وفيهما كان سابقًا لمحمد فريد أبو حديد ولعلي أحمد باكثير، ناهيك عن نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب في الذهاب إلى كسر قيد النمط الشعري شكلًا، ودلالةً بما عبّر به عما يمور في وجدانه كمثقف طليعي ينشد أسباب القوة لكيان الأمة، عبر انهمامه بموضوعة الاتحاد العربي.
ولا يضير العواد أن تفجّرت رغباته العميقة في التحرر من قيد الوزن بعد أن قرأ نصًّا عاديًّا لشاعر عراقي مجهول رمز لاسمه بـ«ب.ن»؛ لأن العواد أكد هذه الرغبات الطموحة والمتجاوزة للسائد في كتابه وعناوينه التي أشرنا إليها آنفًا. هذا السبق التاريخي قد أحدث اختلافًا وتشكّكًا لدى بعض الباحثين، ومنهم الدكتور عبدالله الغذامي، ولكن الدكتور محمد الصفراني الناقد الأدبي والباحث الجاد قد وثّق هذا السبق التاريخي للعواد في كتابة شعر التفعيلة، في بحث عميق بالعنوان نفسه(4).
وقد لاقت هذه التجربة الجديدة لكتابة الشعر الحر صدى واسعًا في الوسط الأدبي في الحجاز؛ حيث تصادى معها عدد من الشعراء منهم: عبدالوهاب آشي، ومحمود عارف، وعباس حلواني، ومحمد علي باحيدرة، وحمزة شحاتة، ومحمد حسن فقي، وسواهم. وقد جمع محمود عارف كل تلك القصائد في مسودة كتاب مخطوط بعنوان «نفثات حرّة»؛ إذ باركها وتفاعل معها عدد من أدباء تلك المرحلة، منهم: عمر عرب، وسعيد العمودي، ومحمد سرور الصبّان، وعبدالله فدا، واستعد الصبان لطباعتها على نفقته الخاصة(5).
غير أن القوى المحافظة، متجلببة بالتقاليد الموروثة والمقدس لم تترك لحامل الأجراس فسحة كافية ليصل صدى صوته إلى محيطه، فتوقف الناشر عن طباعة تلك التجربة الشعرية الرائدة، التي لو قيض لها الطبع والانتشار لكنا قد مضينا على دروب الإبداع والتجديد والحداثة الشعرية مبكرين، بل وسبقنا بعضًا إن لم يكن كل العواصم الثقافية العربية في هذا المجال؛ إذ كان مقدرًا للتجربة أن تفتح الأذهان على الخلق الجديد في مختلف مجالات الحياة في بلادنا، وبخاصة ما يتعلق بفضاء الفن والأدب.
حامل مشعل التنوير
على الرغم من محاصرة الضوء الذي حمله العواد وبعض أقرانه، ورغم كل ما عاناه من القوى المحافظة والمهيمنة في كافة أبعادها، إلا أنه واصل العطاء -في حدود ما سمحت به الظروف والتحديات- بالروح الوثابة نفسها، كحامل لمشعل النهضة والتنوير والرنوّ إلى آفاق الحداثة الشعرية في بلادنا؛ إذ عمد في جهده النقدي الأدبي إلى تعميق معنى الشعر، وارتباطه بالوجدان الثقافي والفني للمبدع، بغض النظر عن قوالب التعبير الإيقاعية عن تلك الحالة الشعرية؛ إذ يقول في مقدمة ديوانه «الأفق الملتهب»: «طبيعة الشعر تتصل بالروح والنفس وما فيها من أفكار ومشاعر وخلجات، وهذه أشياء داخلية. أما طبيعة العروض فتتصل بالعمليات الفنية الخارجية التي تباشر قوالب الشعر وليس الشعر ذاته، وهذه العمليات هي أساليب لنظم الشعر…» إلى أن يقول: «ليس باللازم ألا يكون الشعر إلا منظومًا»(6).
إن هذه الآراء النقدية الأدبية حول مفهوم الشعر تتسق مع تكوين ثقافة وتطلعات هذا المثقف الرائد والباحث عن الجدّة والابتكار والإبداع في مختلف الآفاق، حيث يغدو هنا مشرّعًا لكسر حصر الشعرية في النمط الشعري الموروث، حين يمضي باتجاه الإمساك بالشعرية الكامنة خلف الوزن والقافية وعمود الشعر، التي يمكن أن نجدها في أي إبداع شعري، يمتد من القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة، وحتى قصيدة النثر التي رأى أنها تنطوي على إيقاعها الشعري الداخلي!
لقد اختط العواد طريقًا نهضويًّا صوب آفاق الرقي والحرية والإبداع، وقد بقي لنا من مسيرته الطويلة صدى صوته المدوي الذي خنقته الظروف والمؤسسات، بيد أن هذه الانشغالات الجليلة حقًّا وما رافقها من تحديات، قد جعلت من القصيدة عنده فضاءً لبثّ خطاب «الرسالة» من دون العمل على تطوير شعرية النص، لغةً وصياغةً وعذوبة شعرية، فغلبت على قصائده حمولات الرسالة التنويرية الأقرب إلى التقريرية المباشرة، بما أدى إلى حرماننا من أن يكون أحد آباء حداثتنا الشعرية الفاعلة!(7).
هوامش:
(1) د. محمد الصفراني – السبق التاريخي لمحمد حسن عواد في كتابة شعر التفعيلة – المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل – العدد 2 من عام 2010م.
(2) حوار مع عزيز ضياء – مجلة النص الجديد – العدد الخامس– إبريل عام 1996م.
(3) مرجع الإحالات إلى كتاب خواطر مصرحة – ضمن المجلد الأول لأعمال العواد الكاملة – القاهرة – دار الجيل للطباعة – عام 1981م.
(4) د.محمد الصفراني – المرجع بعاليه.
(5) محمد حسن عواد – المرجع بعاليه.
(6) د. محمد الصفراني – المرجع بعاليه.
(7) عبّر الشاعر عبدالكريم العودة عن ذلك في مقالة له بعنوان: «نحن جيل بلا آباء» – مجلة اليمامة – عام 1980م.








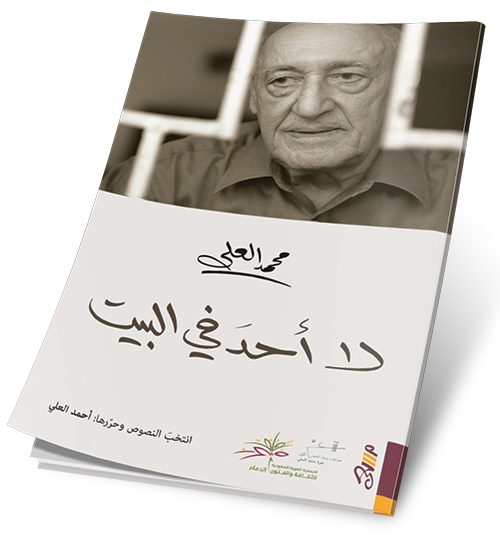 العقل الديناميكي والعقلانية النقدية يشكلان رافعة فاعلية الإنسان في واقعه، من أجل تجاوز حمولات الاستبداد الثقافية والسياسية المتعاضدة عبر الأزمنة؛ لكي يبلغ زمن الحرية وإعلاء قيمة الإنسان وذاته، وهي الرافعة الرئيسة لثقافة عصور النهضة والتنوير التي دشّنت في الغرب زمن الحداثة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تمثل -في نسبيتها– أفضل تجليات تحقق النزوع التاريخي للبشرية صوب حياة جديدة ومختلفة.
العقل الديناميكي والعقلانية النقدية يشكلان رافعة فاعلية الإنسان في واقعه، من أجل تجاوز حمولات الاستبداد الثقافية والسياسية المتعاضدة عبر الأزمنة؛ لكي يبلغ زمن الحرية وإعلاء قيمة الإنسان وذاته، وهي الرافعة الرئيسة لثقافة عصور النهضة والتنوير التي دشّنت في الغرب زمن الحداثة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تمثل -في نسبيتها– أفضل تجليات تحقق النزوع التاريخي للبشرية صوب حياة جديدة ومختلفة.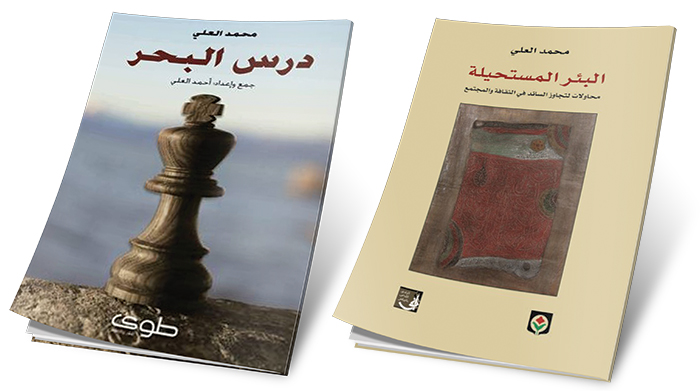 قد يذهب النقد الحداثي إلى توصيف العلي بالشاعر الغنائي، نظرًا لحضور ذات الشاعر في كليّة النص، لكونها بؤرة انعكاس التجربة ومنبعها في نصه الإبداعي، كذاتٍ رومانسية تنشد الحرية الفردية، وتتمرد على جميع الأنظمة والقوانين الاجتماعية، وتتولّع بالتغرّب والتغريب، والفرار إلى عوالم جديدة متخيلة، متدثرة بالكآبة والحزن. لكن قارئ قصائد العلي سيقف حتمًا أمام روحه المتشبثة بالحرية، وإعلاء قيمة الفرد، مثلما سيرى غابة من الحزن الشفيف تطبع كثيرًا من نتاجه الشعري، لابتعاد الأحلام عن التحقق، ولكن جدل هذين المكونين سيتضافران في تشكيل جمالية بنية نصيّة، تخرج القصيدة من غنائيتها التقليدية أو نزوعها الرومانسي، إلى أفق مغاير ينبني على امتزاج الخاص بالعام، والذاتي بالموضوعي، والفردي بالاجتماعي، والداخل بالخارج.
قد يذهب النقد الحداثي إلى توصيف العلي بالشاعر الغنائي، نظرًا لحضور ذات الشاعر في كليّة النص، لكونها بؤرة انعكاس التجربة ومنبعها في نصه الإبداعي، كذاتٍ رومانسية تنشد الحرية الفردية، وتتمرد على جميع الأنظمة والقوانين الاجتماعية، وتتولّع بالتغرّب والتغريب، والفرار إلى عوالم جديدة متخيلة، متدثرة بالكآبة والحزن. لكن قارئ قصائد العلي سيقف حتمًا أمام روحه المتشبثة بالحرية، وإعلاء قيمة الفرد، مثلما سيرى غابة من الحزن الشفيف تطبع كثيرًا من نتاجه الشعري، لابتعاد الأحلام عن التحقق، ولكن جدل هذين المكونين سيتضافران في تشكيل جمالية بنية نصيّة، تخرج القصيدة من غنائيتها التقليدية أو نزوعها الرومانسي، إلى أفق مغاير ينبني على امتزاج الخاص بالعام، والذاتي بالموضوعي، والفردي بالاجتماعي، والداخل بالخارج. ولعل أجمل ما قيل عن ملامح النموذج الفني، وتشكيل الصورة الشعرية في تجربة العلي ما كتبه الدكتور محمد الشنطي(19)، إذ يرى أن بنية النص الشعري عند شاعرنا، تنهض غالبًا على المزاوجة بين خصوصية الدلالة وعمومية التجربة، واستخدام الثنائيات لتفجير المفارقة، وفي تجاوز المستوى الغنائي والتقرير الحسي، إلى توظيف فاعلية التداخل النصوصي، أو التضمين بالاستعارة، واستدعاء النماذج التراثية، والإفادة من آليات السرد والتحول، وبناء درامية النص حول الجدل والحوار والاستهلال بالسؤال والافتراض، ليبتعد النص عن الموقف الرومانسي والنبرة الغنائية.
ولعل أجمل ما قيل عن ملامح النموذج الفني، وتشكيل الصورة الشعرية في تجربة العلي ما كتبه الدكتور محمد الشنطي(19)، إذ يرى أن بنية النص الشعري عند شاعرنا، تنهض غالبًا على المزاوجة بين خصوصية الدلالة وعمومية التجربة، واستخدام الثنائيات لتفجير المفارقة، وفي تجاوز المستوى الغنائي والتقرير الحسي، إلى توظيف فاعلية التداخل النصوصي، أو التضمين بالاستعارة، واستدعاء النماذج التراثية، والإفادة من آليات السرد والتحول، وبناء درامية النص حول الجدل والحوار والاستهلال بالسؤال والافتراض، ليبتعد النص عن الموقف الرومانسي والنبرة الغنائية.

 لكل هذا، فإننا نرى أن هذا الصوت وسواه قد أسهما في خلق حالة «من التحولات البنيوية الجذرية والانقلابات في أغصان الحياة التي وضعت أسسًا لقيام عصر التنوير في أوربا وأميركا، وقيام الثورة الفرنسية في عام 1789م، التي قضت على السلطات والبنى الإقطاعية والكنسية والاستبدادية، وتُـوجت بلائحة حقوق الإنسان، وتدشين عصر الحداثة الذي رأى فيه هيغل زمنًا جديدًا .. زمنًا صنعناه بأنفسنا» (إبراهيم الحيدري – المرجع السابق).
لكل هذا، فإننا نرى أن هذا الصوت وسواه قد أسهما في خلق حالة «من التحولات البنيوية الجذرية والانقلابات في أغصان الحياة التي وضعت أسسًا لقيام عصر التنوير في أوربا وأميركا، وقيام الثورة الفرنسية في عام 1789م، التي قضت على السلطات والبنى الإقطاعية والكنسية والاستبدادية، وتُـوجت بلائحة حقوق الإنسان، وتدشين عصر الحداثة الذي رأى فيه هيغل زمنًا جديدًا .. زمنًا صنعناه بأنفسنا» (إبراهيم الحيدري – المرجع السابق).


 الناقد بعد كل هذا العرض ينتمي فكريًّا وممارسةً إلى «الواقعية النقدية»، حيث أفرد لهذا الحقل النقدي اهتمامًا ثقافيًّا معمقًا، تعرض فيه لمفهومها الذي تترابط فيه الذاتية الرومانسية بالذاتية الواقعية تاريخيًّا، فعرض لتجلياتها القديمة كواقعية تشاؤمية مغلقة وتصويرية باهتة، ثم تطورها بعد ذلك إلى واقعية تفاؤلية، سميت «بالواقعية النقدية الحديثة» على يدي «غوركي» وأمثاله، وتستند إلى الرؤية النقدية للواقع والبحث عن آفاق تطور الحياة في أبعادها الشاملة، من أجل الإعلاء من شأن إنسانية البشر. ويورد نماذج متعددة لشعراء تلك المرحلة في بلادنا ممن عبروا عن ذلك الاتجاه، في أبعاده الاجتماعية، والراديكالية، والوطنية والقومية، من أمثال حمزة شحاتة، وماجد الحسيني، والمنصور، والششة، وبابصيل ، وسواهم.
الناقد بعد كل هذا العرض ينتمي فكريًّا وممارسةً إلى «الواقعية النقدية»، حيث أفرد لهذا الحقل النقدي اهتمامًا ثقافيًّا معمقًا، تعرض فيه لمفهومها الذي تترابط فيه الذاتية الرومانسية بالذاتية الواقعية تاريخيًّا، فعرض لتجلياتها القديمة كواقعية تشاؤمية مغلقة وتصويرية باهتة، ثم تطورها بعد ذلك إلى واقعية تفاؤلية، سميت «بالواقعية النقدية الحديثة» على يدي «غوركي» وأمثاله، وتستند إلى الرؤية النقدية للواقع والبحث عن آفاق تطور الحياة في أبعادها الشاملة، من أجل الإعلاء من شأن إنسانية البشر. ويورد نماذج متعددة لشعراء تلك المرحلة في بلادنا ممن عبروا عن ذلك الاتجاه، في أبعاده الاجتماعية، والراديكالية، والوطنية والقومية، من أمثال حمزة شحاتة، وماجد الحسيني، والمنصور، والششة، وبابصيل ، وسواهم.

