
أستاذ علم اجتماع الميديا أكد نهاية التلفزيون التقليدي جون لوي ميسيكا: الإنترنت لا تزيل الرابط الاجتماعي، بل تمنح الأشخاص إمكانية التحكم فيه
يؤكد أستاذ علم اجتماع الميديا بمعهد العلوم السياسية بباريس، والباحث في مجال وسائل الإعلام جون لوي ميسيكا نهاية التلفزيون، في كتابه الجديد «نهاية التلفزيون»؛ إذ يرى أن مشاهدة التلفزيون آخذة في الانحسار، إضافة إلى اختفاء تقاليد المواعيد المحددة لمشاهدة البرامج. ويذكر أن الإنترنت ستبتلع التلفزيون. ويقول لوي ميسيكا، في حوار معه صدر ضمن منشورات مركز «BNP Paribas» للبحث والاستشراف: إن الرابط الاجتماعي الذي ينشئه التلفزيون يتضمن مجموعة من الإكراهات، فالتلفزيون، في رأيه، يقدم الرسالة ذاتها إلى الجميع في الوقت نفسه، بينما الرابط الذي تنشئه الإنترنت يتسم بمرونة أكثر، كما أنّ هذا الرابط يمنح الشعور بالحرية، على العكس من التلفزيون التقليدي.
أصدرتم كتابًا بعنوان: «نهاية التلفزيون». فماذا تعنون بهذه النهاية في زمن تضاعف فيه عدد القنوات التلفزيونية، وتزايد إقبال المشاهدين عليها؟
 _ بالعكس، تؤكد آخر الإحصائيات أن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون يتناقص، بشكل واضح جدًّا لدى الشباب على وجه التحديد. إن القناة التلفزيونية تتحرك وفق العناصر الآتية: توصيل الصور المتحركة إلى البيت، وبرمجة المواد التلفزيونية وبثها وفق مواعيد محددة، والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين. ففي الوقت الذي تنحصر فيه المشاهدة التلفزيونية وتصبح محدودة جدًّا، وتتشذّر إلى حد أن تصبح فردية، وتختفي تقاليد المواعيد المحددة لمشاهدة البرامج تدريجيًّا، تاركة المجال لأنماط أخرى من المشاهدة؛ مثل: التلفزيون الاستدراكي، والفيديو تحت الطلب، والاشتراك في نظام الفيديو تحت الطلب، فإننا نلج عالمًا مختلفًا، فهذا العالم يقترح وجود عدد كبير من الصور المتحركة والبرامج المصورة المقدمة إلى الجمهور، لكنها لا تشكل تلفزيونًا بالمعنى التقليدي للعبارة. ويجب أن نضيف له المنصّات السمعية البصرية في شبكة الإنترنت؛ مثل: «اليوتيوب» و«الديلي موشن» التي تسمح ببث المحتويات التي ينتجها الأشخاص العاديون والهواة، وتغير بعمق العلاقة القائمة بين من يبث الصور ومن يتلقاها، وهي لم تعد ثابتة ومستقرة كما كانت في السابق.
_ بالعكس، تؤكد آخر الإحصائيات أن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون يتناقص، بشكل واضح جدًّا لدى الشباب على وجه التحديد. إن القناة التلفزيونية تتحرك وفق العناصر الآتية: توصيل الصور المتحركة إلى البيت، وبرمجة المواد التلفزيونية وبثها وفق مواعيد محددة، والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين. ففي الوقت الذي تنحصر فيه المشاهدة التلفزيونية وتصبح محدودة جدًّا، وتتشذّر إلى حد أن تصبح فردية، وتختفي تقاليد المواعيد المحددة لمشاهدة البرامج تدريجيًّا، تاركة المجال لأنماط أخرى من المشاهدة؛ مثل: التلفزيون الاستدراكي، والفيديو تحت الطلب، والاشتراك في نظام الفيديو تحت الطلب، فإننا نلج عالمًا مختلفًا، فهذا العالم يقترح وجود عدد كبير من الصور المتحركة والبرامج المصورة المقدمة إلى الجمهور، لكنها لا تشكل تلفزيونًا بالمعنى التقليدي للعبارة. ويجب أن نضيف له المنصّات السمعية البصرية في شبكة الإنترنت؛ مثل: «اليوتيوب» و«الديلي موشن» التي تسمح ببث المحتويات التي ينتجها الأشخاص العاديون والهواة، وتغير بعمق العلاقة القائمة بين من يبث الصور ومن يتلقاها، وهي لم تعد ثابتة ومستقرة كما كانت في السابق.
إنتاج مشترك
ألا تعلن شرائط الفيديو في شبكة الإنترنت نهاية البرمجة التلفزيونية بمعنى أنها تتيح لمستخدم الإنترنت حرية أكثر، ومجالًا أوسع للاختيار؟
_ بكل تأكيد. لقد انتقلت سلطة البرمجة التلفزيونية من يد المبرمج التلفزيوني إلى جمهور المشاهدين.
هل يغير «مبدأ»: إنني أشاهد متى أرغب في المشاهدة ما ننتظره من التلفزيون؟
_ في البداية يجب أن نلحظ ظاهرة مساهمات الجمهور المستخدِم في المحتوى، وهو ما أصبح يعرف لدى الأنغلوسكسونيين بــ «User Generated Content» أي أن البرنامج التلفزيوني سيغدو إنتاجًا مشتركًا أو إبداعًا يشترك فيه الباث والمشاهد. ثم إن (فورمات) المواد التلفزيونية -قوالبها- ومدوّناتها، وأوقات المشاهدة، كلها تتطور تدريجيًّا، لكنها لا تحدث بين عشية وضحاها. فعادات وسائل الإعلام راسخة بشكل عميق. فهناك أشخاص تعودوا عادات متعلقة بمشاهدة التلفزيون منذ عشرين سنة، ولا يغيرونها بسهولة. بيد أن الأشياء تتحرك بسرعة نسبية. فعندما نلحظ التزايد الكبير في عدد مشاهدي مواقع «تقاسم مواد الفيديو» video sharing، فإننا ندرك أن طريقة «استهلاك» الصور في طور التغيير. وهذا لا يعني أبدًا أن استهلاك الصور سيقل، بل على العكس.
إذن، ما الذي يجب القيام به تجاه الأشخاص الذين لم يكتسبوا عادات في مجال استخدام شبكة الإنترنت حتى ندفعهم إلى هذه الاستخدامات الجديدة؟
_ أعتقد أن جزءًا من الناس لا يتدافع نحو هذا الاستهلاك، ويجب انتظار قطيعة جيلية (نسبة إلى الجيل) هذا مع تعايش عدة طرق من استهلاك الصور. بكل تأكيد، لن تكون الأمور مغلقة من هذا الجانب أو ذاك، لكن أعتقد أن هناك تفاوتًا هائلًا بين أبناء الجيل الرقمي، والآخرين!
أنحن مشاهدون ومستهلكون أكثر حرية أم على العكس نحن خانعون أكثر؛ لتعدّدية اختيار الحوامل (التلفزيون، والإنترنت، والحوامل المتنقلة)؟
_ أعتقد أن الاثنين يحدثان معًا. ففي التلفزيون الكلاسيكي يوجد نظام من الهيمنة، رغم كل شيء، بين من يَستهلك، ومن يُنتِج، ومن ينشر، ومن يحدد مواعيد البث. فيجب ألّا ننسى أن التلفزيون ظل سنوات طويلة مسيطرًا على ساعة الأشخاص البيولوجية، ويتحكم في إيقاع حياتهم المنزلية ووتيرتها! فمن هذا الجانب يمكن القول: إن العرض «التلفزيوني» الجديد يمنحهم الحرية. لكننا نعرف جيدًا أن الشركات؛ مثل: غوغل وبعض محركات البحث ستقوم بدور حاسم، وستؤثر كثيرًا في أنماط الاستهلاك. فأدوات قياس السلوك وتحليله؛ أي ما يسمى برصد ملامح مستخدمي الإنترنت ومسالكهم في الإبحار عبر الشبكة؛ تطرح مشكلات واقعية في مجال الحرية الفردية واحترام الحياة الخاصة. يجب الإقرار بوجود رصيد من المعارف عن سلوك مستخدمي شبكة الإنترنت لم يحلم به حتى مجانين قياس المشاهدة التلفزيونية.
هل تعدّدية العروض التي تتيحها شرائط الفيديو في شبكة الإنترنت تعلن عن تفوق الصورة على الوسائط الأخرى؟
_ لا أعتقد ذلك. أظن ببساطة أن شبكة الإنترنت لم تكن مدة طويلة وسيلة متعددة الوسائط بالكامل؛ بسبب بسيط يتمثل في بطء تدفق البيانات ومختلف التطبيقات؛ لأنه لم يكن من السهل إنتاج صور متحركة وتوصيلها إلى المعنيّين. لكن ما نشاهده اليوم من سرعة تدفق البث، واستخدام الألياف البصرية، وتطبيق عدة برمجيات؛ مثل: البرامج المتعلقة بالصورة، وكل تقنيات الضغط على البيانات وتحجيمها، ومختلف التطبيقات الجديدة التي تقلل من حجم البيانات في الصفحات، تجعل الصورة المتحركة تأخذ المكانة التي تحتلها بقية الوسائط. إن شبكة الإنترنت أصبحت أداة ذات وسائط متعددة بمعنى الكلمة، تجمع الصوت والصورة والنص والإنفوغرافيا والتفاعلية، وتتيح تحميل الملفات بتدفق عالٍ ومنتظم، أي أن هناك كل الأشياء التي تُحَوّل بعمق طبيعة الإبداع. أعتقد أنه سيتم الطعن في فكرة التعارض بين النص والصورة بفضل هذه العُدّة التقنية التي تجمعهما بشكل ديناميكي أكثر من الورق والتلفزيون.
عدد من الإكراهات
إنّ التلفزيون يجمع جمهورًا متنوعًا حول البرنامج التلفزيوني، فيشكل رابطًا اجتماعيًّا. فهل تنشئ شبكة الإنترنت شكلًا جديدًا من الروابط الاجتماعية؟
_ يتضمن الرابط الاجتماعي الذي ينشئه التلفزيون كثيرًا من الإكراهات. فالتلفزيون يقدم الرسالة ذاتها إلى الجميع في الوقت ذاته، على حين يتسم الرابط الذي تنشئه الإنترنت بمرونة أكثر منه، مع جماعات سريعة الاندثار تستند إلى وشائج تسمح للأفراد بمغادرتها وقتما يشاءون. إنّ هذا الرابط يمنح الشعور بالحرية. بالطبع إنّ عائق هذه الحرية يكمن في هشاشة الرابط الاجتماعي، وضعف التضامن، ومخاطر عزل الأعضاء الضعيفة. فيمكن أن نكون أمام وضعيات لا يملك فيها الناس أي سبب للعيش معًا؛ مما يطرح مشكلة حقيقية على الجماعة الاجتماعية. لكن يمكن القول اليوم: إن شبكة الإنترنت لا تزيل الرابط الاجتماعي، بل تمنح الأشخاص إمكانية التحكم فيه أكثر من الوقت السابق.
هل تعتقدون أن منصات التشارك في شرائط الفيديو، التي يكون فيها المستهلك منتجًا ومبتكرًا، تملك مقومات البقاء والاستمرارية؟
 _ نعم، بكل تأكيد. إننا نعيش الآن بروز هذه المنصات ممثلة في كثير من المواقع؛ مثل: «ديلي موشن» و«اليوتيوب» التي تعاني صعوبات في العثور على أنموذج اقتصادي مناسب له مقومات الاستمرارية. لكننا نرى بكل وضوح إلى أين تتجه هذه المنصات، مع إمكانية إنتاج الأشخاص شرائط الفيديو، والاشتراك في إنتاجها. هناك فرص جديدة لاختيار المنتجات التي هي في طور التطور والبروز -الكتالوغات الاجتماعية على سبيل المثال- وذلك لأن هناك بعض شرائط الفيديو لا يُشاهَد في ظل تضخم تعداد ما هو معروض من شرائط في هذه المواقع؛ لذا يجب إيجاد وسائل تسمح بربط إمكانية الجميع في «الاستهلاك» بإجراءات انتقاء شرائط الفيديو، مع وضع سلم لترتيبها وتسلسلها. توجد ثلاثة أنواع من الإجراءات؛ إجراءان منها متاحان، وهما: محركات البحث، ومنح مستخدمي الإنترنت درجة لكل شريط فيديو. ويجب البحث عن الإجراء الثالث في الأنموذج الاقتصادي، أي جعل محترفي العمل التلفزيوني يشاركون في الاختيار والنشر.
_ نعم، بكل تأكيد. إننا نعيش الآن بروز هذه المنصات ممثلة في كثير من المواقع؛ مثل: «ديلي موشن» و«اليوتيوب» التي تعاني صعوبات في العثور على أنموذج اقتصادي مناسب له مقومات الاستمرارية. لكننا نرى بكل وضوح إلى أين تتجه هذه المنصات، مع إمكانية إنتاج الأشخاص شرائط الفيديو، والاشتراك في إنتاجها. هناك فرص جديدة لاختيار المنتجات التي هي في طور التطور والبروز -الكتالوغات الاجتماعية على سبيل المثال- وذلك لأن هناك بعض شرائط الفيديو لا يُشاهَد في ظل تضخم تعداد ما هو معروض من شرائط في هذه المواقع؛ لذا يجب إيجاد وسائل تسمح بربط إمكانية الجميع في «الاستهلاك» بإجراءات انتقاء شرائط الفيديو، مع وضع سلم لترتيبها وتسلسلها. توجد ثلاثة أنواع من الإجراءات؛ إجراءان منها متاحان، وهما: محركات البحث، ومنح مستخدمي الإنترنت درجة لكل شريط فيديو. ويجب البحث عن الإجراء الثالث في الأنموذج الاقتصادي، أي جعل محترفي العمل التلفزيوني يشاركون في الاختيار والنشر.
هل التهافت على فرص الإنتاج الجديدة سيتواصل أم أن نطلب من الإنترنت أن يكون نمطًا جديدًا من استهلاك شرائط الفيديو؟
_ أعتقد أنه سيستمر وسيصبح شبه حرفي. فما نلحظه اليوم أنه يوجد 10 في المئة فقط من المساهمين في تغذية موقع موسوعة «الويكيبيديا» بالمواد، على حين يوجد 90 في المئة من مستهلكيها. وستزداد الفرصة في المستقبل بفضل المنظومة التقنية، المساهمة في التحرير والاطلاع على المواد. لكن ستظل أغلبية مستخدمي هذه الموسوعة من المطلعين على محتوياتها بكل تأكيد.
هل يملك التلفزيون التقليدي مستقبلًا مزدهرًا؟
_ نعم بكل تأكيد، لكن ما سيحدث هو أن الإنترنت ستبتلع التلفزيون، كما هي الحال الآن، والإذاعة، والصحافة المطبوعة. سيكون هناك تلفزيون في شبكة الإنترنت. والذين يريدون متابعة النموذج التقليدي للتلفزيون بشبكة برامجه التي يعدها غيرهم سلفًا، أو الموجهة بخوارزمات، يمكنهم فعل ذلك، وسيمنحون الأدوات لتحقيق ذلك. سيظل الاستهلاك الساكن والسلبي للتلفزيون قائمًا. استهلاك الصور المريح والبطيء عبر إجراءات البرمجة التلفزيونية المعهودة.
هل يمكن حدوث التواؤم الدائم بين الحاملين؟ إن قناة التلفزيون الفرنسي الأولى، على سبيل المثال، مالكة منصة التشارك في شرائط الفيديو المسماة: «وات تيفي» وهي تعمل على بث شرائط الفيديو التي ينتجها الهواة عبر شاشتها. فهل يمكن تعميم هذه المبادرة؟
_ لا أعتقد أنه من الممكن أن يجري الأمر بهذا الشكل. إن «وات تيفي» فكرة لطيفة فعلًا، لكن ولع مستخدم الإنترنت بشرائط الفيديو في هذه المنصة لا يدل على أنه سيشاهدها عبر قناة تلفزيونية كبرى؛ لأن ما يبث عبر القناة التلفزيونية لا يتناسب مع ما نبحث عنه في شبكة الإنترنت، أي تشكيل الجماعة والاعتراف بها. بينما يمكن لهذا الأنموذج أن يتحقق في مجال الإنتاج، وفق منطق رصد الكفاءات، مع منتجي التلفزيون الذين يستطيعون متابعة الفنانين في شبكة الإنترنت، واختيارهم، والاقتراح عليهم إنتاج أعمالهم. هذا هو الأنموذج الذي أومن به.
شروط نقد الصورة
قال أستاذ علم اجتماع الميديا جون لوي ميسيكا: «إن التعارض الموجود بين الكلمة والمكتوب «هو تعارض بين ما هو مُخَزّن وما هو متدفق. وهذا ينطبق على كل أشكال الاتصال؛ أي ينطبق، أيضًا، على الصورة. إذن الصورة المخزنة في شبكة الإنترنت التي يمكن مشاهدتها أكثر من مرة، ولا «تستهلك»، أو تتلاشى في سريانها المتدفق كما هي حالها في جهاز التلفزيون، تخلق شروط نقد الصورة بقوة أكثر مما كان ممكنًا مع التلفزيون؛ لذا يجري التنديد بالتلاعب بالصورة، وبما تمارسه من التضليل، الذي أصبح مألوفًا لتكراره، وشجب اختلاق الصور المزيفة في شبكة الإنترنت. ولفت إلى أننا «نملك إمكانية المقارنة بين كثير من الصور، وفحصها وتحليلها. إذن يمكن معاينة كل المشكلات ذات الصلة بالتلاعبات بالصور. وبهذا نقترب من المقاربة التي تكون فيها الصورة المتدفقة شبيهة بالاتصال الشفوي، على حين تشبه الصورة المخزنةُ الكتابةَ. أي مع إمكانيات التخزين، والمقارنة والنقد، سيحدث تحوّل أساسيّ في الإنترنت، يرتبط بالسهولة التي يمكن بوساطتها مقارنة صورة بأخرى».
حوار:-ماتلد-كريستياني


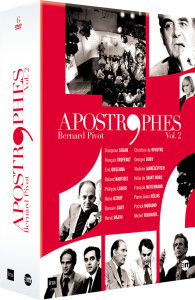 ولا يمكن تناسي دَوْر
ولا يمكن تناسي دَوْر 