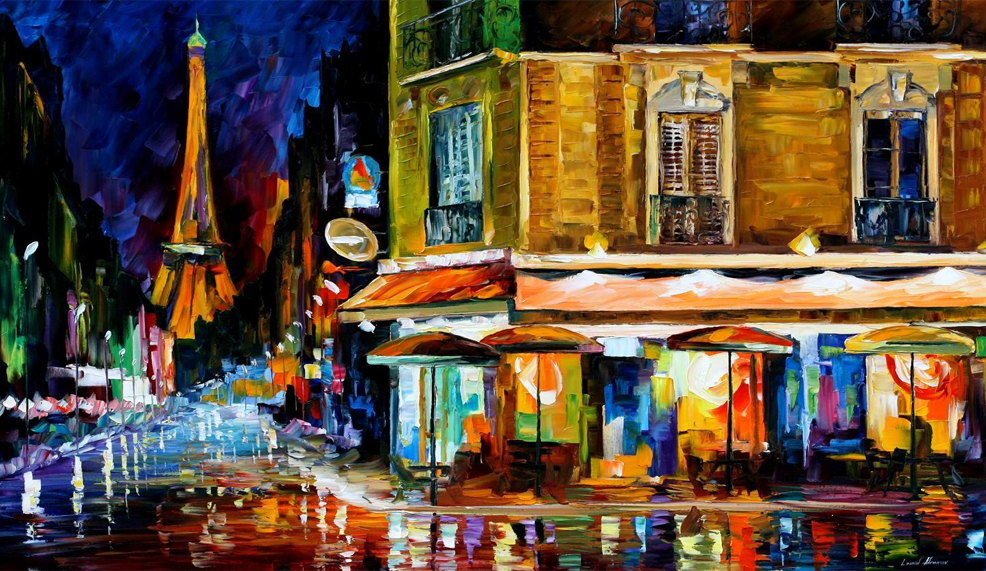
جمال شحيد - ناقد سوري | يوليو 1, 2020 | مقالات
قبل وصولي إلى باريس في سبتمر 1970م، كنت أعمل أمينًا لمكتبة في وزارة المواصلات في دمشق، فادّخرت مبلغًا من المال يكفيني لمدة سنة كطالب يتابع دراسته بعد الإجازة في الأدب الفرنسي. أتيت إلى العاصمة الفرنسية مزوّدًا بهذا المبلغ وبلغة فرنسية مولييرية، كانت تثير ابتسامة الفرنسيين عندما أكلّمهم؛ فكان عليّ أن أطعّمها باللغة الشعبية، لغة الشارع. ولكنني في البداية شعرت بالحنين العاتي إلى دمشق وإلى المدينة القديمة حيث كنت أسكن، وأوشكت أن أحزم حقيبتي وأن أعود إلى سوريا. فهدّأني بعض الأصدقاء والمستشرقين الذين علّمتهم في المعهد الفرنسي للدراسات العربية في الشام. وبقيت ونعم البقاء.
سجّلت في جامعة السوربون الجديدة دبلومًا يعادل الماجستير في أيامنا لمدّة سنة وفي المدرسة العليا لشؤون المكتبات، ظنًّا مني أنني لن أبقى أكثر من سنة في باريس. ولكن سرعان ما تحسّن وضعي الاقتصادي بسبب بعض التسجيلات الإذاعية والدروس الخاصة التي كنت أعطيها للمستشرقين الذين عرفتهم من قبل ووسّعوا دائرة معارفي. كان عنوان البحث الذي ترتّب عليّ إعداده في الجامعة يدور حول مقولة الاشتراكية في أعمال نجيب محفوظ الأولى، بإشراف الأستاذ أندريه ميكيل. وأذكر أنني في المِترو، أثناء ذهابي إلى المدرسة العليا لشؤون المكتبات، كنت أقرأ بعض أعمال نجيب محفوظ وأخط بالقلم على بعض العبارات والمقاطع، ممّا كان يثير فضول بعض الركّاب، المتعجبين ربما من وجود عربي يقرأ حتى في المِترو.
كانت الجامعات الفرنسية وقتئذ شديدة التسييس، بعد الثورة الطلابية التي اندلعت عام 1968م، وأجبرت الجنرال ديغول على التنحّي. وكانت السوربون الجديدة من الجامعات اليسارية التي تعجّ بالتروتسكيين والماويين والشيوعيين والاشتراكيين الذين كانوا يوزّعون منشوراتهم عند مدخل الجامعة. وتعرّضتْ جامعتنا لعدد من غزوات اليمين المتطرّف الذي كان يأتينا من كلية الحقوق في جامعة «أسّاس». فيدبّ الصوت في طوابق الجامعة الخمسة، فنقطع الدروس ونهرع بشعورنا الطويلة والمشعّثة إلى مدخل الجامعة، ونشتبك مع المهاجمين المزوّدين بالعصي الذين كانوا أحيانًا يحرقون المنشورات اليسارية، ثم يأتي البوليس الفرنسي متحنجلًا ليفضّ الاشتباك. ويصل بعد مغادرة المهاجمين وانصرافهم بنصف ساعة.
الحياة كلها مسيسة
وكان الحي اللاتيني، مهد الثورة الطلابية، حيًّا يساريًّا يعجّ بالمكتبات التي تبيع الكتب السياسية والأيديولوجية خاصة، ولا سيّما مكتبة فرانسوا ماسبيرو الواقعة في عطفة «لا هوشيت» قرب نهر السين. وكانت حياة الناس كلها مسيّسة، تحفزها مجموعة كبرى من المثقفين من أمثال جان بول سارتر، سيمون دو بوفوار، لويس ألتوسير، أندريه غلوكسمان… وعدد من الصحف والمجلات مثل: «ليبيراسيون»، و«قضية الشعب»، و«الأزمنة الحديثة»، و«الأنصار»، و«شارلي إبدو»، و«صباح باريس».
وأسهم في الحَفْز أيضًا عدد من المغنين مثل: جورج براسانس، وجان فيرا، وليو فيريه، وكلود نوغارو… والسينمائيين مثل: جان لوك غودار، ولويس مال، وبرناردو برتولوتشي. وأسهمت الأحزاب اليسارية الجديدة في إشعال الثورة، ومنها الرابطة الشيوعية والحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الفرنسي (الماوي) واليسار البروليتاري والنضال العمالي… ولعب السياسيون دورًا في خلق وعي ثوري، ومنهم: بيير ماندس فرانس، وفرانسوا ميتيران.
وخلقت هذه الثورة جوًّا تنويريًّا في التدريس الجامعي؛ وكُسر احتكار السوربون العريقة، فقُسِّمت إلى ثلاث عشرة جامعة، ومنها السوربون الجديدة أو باريس الثالثة التي درستُ فيها. وجدّدت الجامعة برامجها وعقليتها، فكنا نخاطب أساتذتنا بضمير المخاطب المفرد الذي يلغي المسافة والعلاقة الرسمية. واستمرت آثار 1968م سنوات عديدة غطّت السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
وكان جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار نشيطين جدًّا في أوساط الطلاب. وأذكر أنني كنت أراهما كثيرًا في شارع سان ميشيل وسان جيرمان، وكانا يحملان نسخًا من جريدة «قضية الشعب» الماوية، وتحيط بهما مجموعة من الشباب الذين كانوا يُصعدون سارتر على برميل قرب مقهى «الدوم»، فينبري منددًا بالإمبريالية والرأسمالية والرجعية ومناديًا بحرية الشعب وبوحدة الحركة اليسارية العالمية. فنصفّق له، ثم يبيعنا نسخ «قضية الشعب». وقبل سقوط الجنرال ديغول، اقترح عليه بعض مستشاريه أن يعتقل سارتر، فأجابهم: «لا أحد يوقف فولتير». مثْبتًا بذلك أنه ابن الجمهورية التي أنشأتها الثورة الفرنسية.
وبعد أن أنهيتُ دبلوم شؤون المكتبات والماجستير، سجّلتُ موضوع دكتوراه في الأدب المقارن مع الأستاذ رينيه إيتيامبل ومع أندريه ميكيل كأستاذ مشارك، وكان عنوانها متأثرًا بالجو الفكري السائد آنذاك: «الوعي التاريخي في روايات إميل زولا ونجيب محفوظ»، ونشرت في دار ميزونوف. وماحكني ذات مرة الأستاذ جمال الدين بن شيخ قائلًا: إن محفوظًا كاتب بورجوازي. فقلت له: إن الفيلسوف جيل دولوز اعتبر مارسيل بروست أقرب إلى الطبقة الشعبية ممّا كان يُظنّ. وكان ابن شيخ في لجنة مناقشة أطروحتي فتوجستُ شرًّا، ولكنه -وهو عنيف في العادة- كان دمثًا جدًّا أثناء الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات.
الجو الثقافي الكثيف
وتحسّنت أوضاعي المالية بسبب الدروس العربية التي كنت أعطيها، فاستفدت كثيرًا من الجو الثقافي الكثيف الذي عرفتْه وتعرفه باريس في شتى المجالات. كنت في الصباح أحضّر الأطروحة، وبعد الظهر أعطي دروسي في اللغة العربية؛ وفي المساء كنت أتفرّغ لسدّ الفجوة في ثقافتي. كنت من عشاق السينما. والمعروف أن صالات السينما في باريس كانت تعرض نحو مئتي فِلْم أسبوعيًّا. فإذا رغبتُ في مشاهدة فلم من الفترة الصامتة ومن كلاسيك السينما، كان عليّ ترصّده أسبوعين أو ثلاثة فيُعرض في السينيماتيك أو في أحد نوادي السينما أو في قاعة من القاعات. وعندما ترجمتُ كتاب دولوز عن السينما [السينما الحركة، السينما الصورة] لصالح المنظمة العربية للترجمة في بيروت، سهّلت لي مشاهدتي في باريس عددًا كبيرًا من الأفلام التي حلّلها دولوز عمليةَ الترجمة.
وتولّعتُ بعدد من المخرجين الإيطاليين من أمثال: فيليني، وأنطونيوني، وبازوليني، وبرتولوتشي، وفيسكونتي مع ممثلين وممثلات مشهورين (صوفيا لورين، وكلوديا كاردينالي، وجينا لولوبريجيدا، ومارشيلو ماستروياني، لينو فانتورا…). وشاهدت كثيرًا من أفلام «الموجة الجديدة» الفرنسية لمخرجين كبار من أمثال: فرانسوا تروفو، وكلود شابرول، وآلان رينيه، وكلود لولوش، وجان لوك غودار، وإيريك روهمر، وجاك ريفيت مع ممثلين معروفين: (جان بول بلموندو، وجان مورو، وأنوك إيميه، وجان لويس ترنتينيان، وبريجيت باردو، وكاترين دونوف…).
وحضرت آنذاك عددًا من المسرحيات في المسارح الباريسية الكبرى (كمسرح الكوميدي فرانسيز، ومسرح الأوديون، ومسرح الشاتليه، ومسرح الكارتوشري في فانسين…) والمسارح الصغرى (كمسرح شارع موفتار، ومسرح المدينة الجامعية في بولفار جوردان، ومسرح الهوشيت…). حضرت مسرحيات كلاسيكية ومسرحيات من القرن العشرين: فيدر لراسين وكاليغولا لألبير كامو، ولن تقع حرب طروادة، ومجنونة قصر شايو لجان جيرودو وأنتيغونا لجان إنوي ورينوسيروس، والمغنية الصلعاء لأوجين يونيسكو، والخادمات والزنوج والشرفة لجان جينيه، وفي انتظار غودو لسامويل بيكيت، وثورة 1789م لأريان منوشكين التي عرضتها في مسرح الشمس في فانسين ودمجت الجمهور بالممثلين دمجًا ناجحًا ومؤثّرًا جدًّا… وشاهدت بعض عروض الماجيك سيركوس وعددًا من عروض الميوزك هول كـ«المسيح سوبر ستار». وأذكر أني بكيت في آخر مشهد من فِلْم موليير لأريان منوشكين الذي شاهدته في سينما الكندي في دمشق التي كانت تعرض أفلامًا حديثة ومهمة آنذاك، ولا سيما في الحفلات التي كان ينظّمها النادي السينمائي الدمشقي الذي كنت عضوًا من أعضائه.
ولأن مقاعد الأوبرا غالية، بالنسبة لطالب مثلي، فلم أحضر إلا عرضين أو ثلاثة. وأذكر أني حضرت حفلة موسيقية لميكيس ثيوذوراكيس في صالة المتواليتيه، بأغانيه الثورية البهيجة والطافحة بالتفاؤل التي ترجمتُ بعضَها لاحقًا إلى العربية. ولكن شغفي الأساس كان المكتبات، ولا سيما تلك الموجودة في الحي اللاتيني PUF, Payot, Seuil, Gallimard, Gibert Jeune, Larousse, Hachette, Nathan, Maspéro، أو القريبة من الحي كـ Hatier و Fayard وLaffont و Stock و Grasset و Flammarion… إضافة إلى مجمّع الـ FNAC الذي أنشئ لاحقًا والذي يجمع قدرًا هائلًا من الكتب والمجلات والصحف والأسطوانات. وكان أستاذي إيتيامبل مسؤولًا عن المقالات الأدبية في موسوعة يونيفرساليس التي بدأت تصدر تباعًا في بداية السبعينيات من القرن العشرين التي تُعَدّ من أهم الموسوعات الجامعية في العالم. كنت لا أستطيع أن أمنع نفسي من تصفّح الكتب الجديدة وشراء بعضها إن لم يكن سعرها غاليًا، وكنت أتحيّن فرص التنزيلات التي برعت فيها مكتبة جيبير جون بفروعها الثلاثة في الحي اللاتيني.
هذا شأن مكتبات البيع، فما بالك بمكتبات القراءة: مكتبة جامعة السوربون الجديدة، ومكتبة المازارين، والمكتبة الوطنية التي أصبح أستاذي أندريه ميكيل مديرها العام، ومكتبة الأدب المقارن في السوربون القديمة.
باريس المقاهي والمطاعم
هذا لا يعني أنني قضيت سنواتي الباريسية الأربع مع الأفلام والكتب فحسب كراهب بنيدكتي من القرون الوسطى. عرفتُ أيضًا باريس المقاهي والبارات والمطاعم. كان يطيب لي أن أسهر مع الأصدقاء في البروكوب الذي اندلعت منه شرارة الثورة الفرنسية، وأصعد أحيانًا درج الساكريه كور الطويل لأشرب في Le Lapin agile، أو أشدّ الرحال إلى الشانزيليزيه، حي الأكابر، لأشرب فنجان قهوة في الـ Fouquet ثم أزور صديقًا صحافيًّا يعمل في مجلة باريس ماتش المصورة الذي كان يهديني كثيرًا من الأسطوانات.
الحق يقال: إن باريس قد غيّرتني كثيرًا. قَدِمتُ إليها طالبًا خجولًا ذا أفق ثقافي محدود، ففتحت أمامي ثقافات العالم المعاصر، وعلى الثقافة العالمية بشتى اتجاهاتها. في باريس، تختار اللون الثقافي والأيديولوجي والاجتماعي الذي يناسبك. ولأن لون بشرتي غير مستهجن في أوربا، لم يوقفني البوليس الفرنسي إطلاقًا، كان يطلب أوراق من معي من المغاربة والأميركيين اللاتينيين والأفارقة. عشت الديمقراطية الأوربية التي كانت سائدة آنذاك في مدينة الأنوار بأبعادها كافة؛ وعندما كنت أعود إلى باريس لاحقًا، كنت ألاحظ التغيرات الفكرية والسلوكية في الشارع الفرنسي. تحوّل المجتمع الباريسي إلى مجتمع عنصري لا يقبل الآخر بسهولة، مع أن الشاعر الفرنسي آرتور رامبو كان يردّد: «أنا هو الآخر».

جمال شحيد - ناقد سوري | يناير 1, 2020 | مقالات
كثيرة هي الروايات التي تتصدى لمسألة المخطوطات المفقودة وقد تخلق تشويقًا عنيفًا لدى القراء. في رواية «في ليالي إيزيس كوبيا» (الصادرة عن دار الآداب ودار الحوار عام 2018م) لواسيني الأعرج، نجابه مع الكاتب مسألة حقيقية، وهي البحث عن مذكرات مي زيادة (1886- 1941م)، الكاتبة اللبنانية الفلسطينية التي تألقت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، ولا سيما في مصر من خلال صالونها الأدبي المشهور وكتاباتها الأدبية والفكرية، ولا سيما في موضوعة النسوية.
المخطوطة المفقودة
يتخفى الكاتب تحت اسم «ياسين الأبيض»، ويعرب عن اهتمامه بالمخطوطات العربية، ولا سيما أنه عمل قرابة ثلاثين سنة في المكتبة الوطنية الفرنسية الجديدة (فرانسوا ميتيران). ويلتقي الباحثةَ اللبنانية الكندية روز خليل التي عملت في «مخبر الأبحاث الأنثروبولوجية والأدبية» في مونتريـال وفي «مخبر الأبحاث التاريخية والفنية» في الجامعة الأميركية في بيروت. ولكنهما كانا في البداية يريدان تصوير فِلْم وثائقي عن مي زيادة وعن العصفورية التي أمضت الكاتبة فيها خمسة أعوام. ولكن إدارة السوليدير التي استولت على أرض العصفورية منعتهما؛ لأنها كانت تروم طمس ماضيها ومرضها. وبدأ البحث عن مجموعة من التفاصيل التي قد تقودهما إلى المخطوطة: مستشفى نقولا ربيز الذي قضت فيه مي مدة نقاهتها بعد خروجها من العصفورية، قرية الفريكة حيث كان يسكن أمين الريحاني الذي كتب كتابًا بعنوان «رحلتي مع مي»، قرية شحتول –قرية أبيها– حيث أقيم لها تمثال دشّنه الرئيس أمين الجميّل عام 1986م، مدينة الناصرة حيث تلقت في مدرسة الراهبات اليوسفيات تربية دينية صارمة، ثم مدرسة راهبات الزيارة في عينطورة (لبنان) حيث وجدا الصفحات الثلاث الأولى من المخطوطة: «خط مي الأنيق والجميل يقودني نحو تخيّل أناملها الناعمة واللذيذة، وهي تسطّر حرائقها» (ص 25). وتنتهي رحلتهما في القاهرة، يلتقيان بالأسطى عادل وأم الصبايا اللذين باعاهما المخطوطة الأصلية. «أدركتُ من خلال أبحاثي أن بعض المخطوطات تكون أمامنا ولا نراها أبدًا؛ لأننا ننظر كثيرًا نحو المسافات البعيدة التي تلغي الأشياء القريبة وتمحوها أحيانًا» (ص 36). ورمّم ياسين 1002 كلمة ناقصة أو مشوّهة بسبب الدموع أو الرطوبة أو الحشرات. وبعد القراءة المتأنية للمخطوطة وتصويرها وإيداعها المكتبة الوطنية الفرنسية، يعلّق قائلًا: «كانت مي امرأة أخرى. من معدن نادر لا اسم له. أعطت كل ما لديها ولم تترك لنفسها شيئًا. الكثير ممن قرؤوا رسائلها افترضوها امرأة لعوبًا. لكنني لست متفقًا معهم. ليس دفاعًا عنها لأنها ليست في حاجة إلى ذلك. من حقها أن تعيش الحياة التي تشتهي، لكني خرجتُ بيقين كبير بعد هذه الرحلة. فقد كانت مي معشوقة من كل من تعرّف عليها، في زمن كان من الصعب العثور على امرأة ذكية ومثقفة وجميلة في الوقت نفسه. كانت تعرف جيدًا أين تضع قدميها. وكانوا يعرفون جيدًا حدودهم معها» (ص 39). وتكتمل رحلة المخطوط بعنوانه: «ليالي العصفورية… تفاصيل مأساتي. من ربيع 1936م إلى خريف 1941م».
ثلاث مئة ليلة وليلة لإيزيس كوبيا
لقد اختارت مي زيادة هذا الاسم المستعار لديوانها الأول الذي كتبته بالفرنسية بعنوان «أزاهير حلم» (1911م). وهو مؤلف من اسم الإلهة المصرية المعروفة وCopia اللاتينية التي تعني «الخصب والوفرة». وفي الحفل الذي أقامته مصر لتكريم خليل مطران، بمناسبة تقليده وسام الخديو (عام 1913م)، طُلب من مي أن تقرأ كلمة جبران خليل جبران الذي لم يتمكن من الحضور، فألقتها من دون وجل وببلاغة عالية: «هتفوا لي هتافًا كبيرًا، جعلني أزهو بنفسي. انتشيت بقوة وأنا أرى الأيادي ترتفع صوبي، لدرجة صرت أحلم بأن أكون أديبة كبيرة. وتقدّم منها الأمير محمد علي توفيق وصافحها قائلًا «آنسة مي، إننا نهنئ أنفسنا بك» (ص 128). وشمخت مي زيادة في عالم الأدب ونالت استحسان كبار الكتّاب والمفكّرين، فسمّاها وليُّ الدين يكن «ملكةَ دولةِ الإلهامِ»، وخليل مطران «فريدة العصر»، ومصطفى صادق الرافعي «سيدة القلم»، وشكيب أرسلان «نادرة الدهر»، والأب أنستاس الكرملي «حلية الزمان»، وشبلي ملاط «نابغة بلادي»، ومصطفى عبدالرازق «أميرة النهضة الشرقية»، وفارس الخوري «أميرة البيان»، وعبدالوهاب عزّام «النابغة الأدبية» (ص 118). وراح يتردد على صالونها الأدبي ممثلو الإنتليجنسيا العربية آنذاك: أحمد لطفي السيد، وطه حسين، والعقاد، ومصطفى صادق الرافعي، وأحمد شوقي، ورشيد رضا، وإسماعيل صبري، وسلامة موسى، وشبلي الشميل، وإسماعيل مظهر…
 وأعجبت مي بالنحاتة الفرنسية كامي كلوديل التي وضعها الفنان أوغست رودان في مستشفى المجانين، بالتواطؤ مع تجار الفن. وراسلتها مي زيادة وردت كامي كلوديل؛ لأن كلتيهما عَرَفَت المصير ذاته: مستشفى المجانين. قالت النحاتة العبقرية: «منذ 17 سنة رماني رودان وتجار الفن في سجن مستشفى المجانين، بعد أن استولى على منجزي الحياتي كله […]. فكرة واحدة ظلت تسكنه، خوفه من أن أحلّ محله، بعد موته، وأتجاوزه […]. كل تفاصيل وأجزاء منحوتاته المهمة، كنت وراءها» (ص 168). وجيّر رودان أهم أعماله التي هي «القُبلة» لشخصه مع أنها لكلوديل.
وأعجبت مي بالنحاتة الفرنسية كامي كلوديل التي وضعها الفنان أوغست رودان في مستشفى المجانين، بالتواطؤ مع تجار الفن. وراسلتها مي زيادة وردت كامي كلوديل؛ لأن كلتيهما عَرَفَت المصير ذاته: مستشفى المجانين. قالت النحاتة العبقرية: «منذ 17 سنة رماني رودان وتجار الفن في سجن مستشفى المجانين، بعد أن استولى على منجزي الحياتي كله […]. فكرة واحدة ظلت تسكنه، خوفه من أن أحلّ محله، بعد موته، وأتجاوزه […]. كل تفاصيل وأجزاء منحوتاته المهمة، كنت وراءها» (ص 168). وجيّر رودان أهم أعماله التي هي «القُبلة» لشخصه مع أنها لكلوديل.
وسرعان ما قارنت مي زيادة وضع ابن عمها جوزيف زيادة بوضع رودان؛ إذ أتى بها جوزيف من القاهرة إلى لبنان «بحجّة التغذية»: «لم يبق لي شيء إلا ظلال الموتى ولغة صامتة تخترق في أعماقي مثل القشر الناشف. متعبة جدًّا حبيبي ولا أملك أية قوة. فجأة تحولت إلى ظلّ أبيض، مثل غيمة صيف، تسير بعمى في إثر جوزيف، أو هو من كان يجرني نحو محطة الموت، التي لم تكن بعيدة من بيتي، وفراشي، ووسادتي. جوزيف كان قاتلي ومقتلي من دمي». وبدل تثبيت أملاكها عند الباشكاتب، استولى هو عليها. وليطمس كل شيء زجّ بها في العصفورية. ووجه الشبه بين رودان وجوزيف واضح وضوح الشمس. وعندما أهداها القنصل الفرنسي في جلسة فرانكوفونية في صالونها مجسّمًا رخاميًّا لمنحوتة «راقصو الفالس» لكامي كلوديل، كأنه كان يتوقّع لها مصيرًا مشابهًا لمصيرها.
وتتوقف المذكرات طويلًا عند أساليب المعالجة في العصفورية، وهي أساليب تزيد النزيل سوءًا: إبر المورفين التي تصل إلى العظم، جو نفسي خانق يدفع إلى الانتحار، سطوة الخوف من المجهول، مشاهد البؤس البشري بأبشع صوره… وبسبب إضراب مي عن الطعام، احتجاجًا على الظلم الذي تعرّضت له، نقص وزنها 28 كغ. فتقول لها الممرضة: الانتحار ليس حلًّا. فلجأت العصفورية إلى إطعامها من أنفها. وقررت مي أن تقول كل شيء: «أنا امرأة من حيرة وانتظار لا أعرف مؤداه، وخوف من مبهم يسطّره الآخرون لي. صممت أن أقول كل شيء. إلى الجحيم، كل ما يعيق البركان الذي في صدري» (ص 59). وتروي مي كيف انطلت عليها حيل جوزيف ابن عمها، فنقلها من القاهرة إلى بيروت حيث أبقاها في بيته شهرين ونصف الشهر، وانتزع منها كل أسرارها المالية والعقارية، ثم زجّ بها في العصفورية: «كنت امرأة بلا متكأ أسند جسمي المتعب عليه بثقة. الآن أمنح ظهري للفراغ وأستمع لتكسّر كل شيء ظننته حقيقة. أغمس عيني في سواد مريح قليلًا، وأتركني أهوي مثل ذرّة في الفراغ» (ص 63).
ومع أن مي امرأة مؤمنة، فإنها بدأت تشك في رحمة الله: «مريمتكَ أنا يا الله، فلماذا تخليت عني […]، خصّني بحضنك يا الله، لكي أعرف أنني منك» (ص 46، 157). وعندما تقول لها الممرضة: «إنك تنتحرين يا ابنتي، والرب لا يسعده ذلك»، تجيبها مي: «يا خالة، وين نحنا وين الرب؟ منسيون في هذا الظلام الفادح» (ص 52). وكانت تسمع التهم التي تقال عنها من أفواه الممرضات: «المجنونة المصرية، حارقة المكتبات، وآكلة الحديد، وقاتلة الأطفال… وما خفي كان أعظم» وتعلّق مي على هذه التهم بعبارة السيد المسيح على الصليب «سامحهم يا ربي، فهم لا يعلمون» (ص 148).
وبدأت فضيحة سَجْنها في العصفورية تنتشر، وراحت الصحف تنشر تكذيب خبر جنونها. وزارها في العصفورية مارونُ غانم وهو تاجر من الناصرة، وقرَّر أن يسخّر ماله وكل ما يملك من أجل إخراجها من العصفورية: «لن أعود إلى عملي إلا بعد وضع حدٍّ لهذا الظلم. لا تشغلي بالك أنت لا تعرفينني. مجرد قارئ من بين الآلاف، وربما الملايين من قرائك الذين يحبونك» (ص 164). وساندها خاصة «علية أهل الشام»: الأمير سعيد الجزائري، وآل الأيوبي والخوري والسيد فارس الخوري خاصة، رئيس المجلس النيابي السوري. «كلمات فارس الخوري وزنت كثيرًا في وقت تخلّى عني من أحببتهم في مصر» (ص 202). وكلّف فارس الخوري الوزيرَ السابق المحامي «حبيب أبو شهلا» للدفاع عنها. وتطوع لفعل ذلك أمام المحاكم اللبنانية. وأمام أعضاء المجلس النيابي قال فارس الخوري: «ما حدث لِمَيّ، هو أكبر جريمة ضد المرأة وضد العقل. كيف لا تهتمون بهذه النابغة اللبنانية؟ كيف تسجن مي بين جدران مستشفى المجانين، ولا يثور الرأي العام اللبناني ويظل هذا الخبر سرًّا مكتومًا؟ لقد وجدتُ فيها مي الكاتبة، الشاعرة التي عرفناها في الماضي، فكيف دبّرت هذه المؤامرة الدنيئة على نابغة النابغات؟» (ص 206).
وبعد خروجها من العصفورية وفي مدة نقاهتها في مستشفى ربيز، زارها أمين الريحاني مرتين ونقلها إلى قريته الفريكة. وساندتها جريدة «المكشوف» وصحفيوها، ولا سيما سعيد فريحة. وتدخّل أيضًا لصالحها الأمير عبدالله بن الحسين الذي راسل رئيس الجمهورية اللبنانية من أجل ميّ. وقررت جمعية «العروة الوثقى» أن تلقي مي محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت، واختارت هي عنوانها «رسالة الأديب في الحياة العربية». وفي 22 آذار/ مارس 1938م، ألقت مي محاضرتها في الويست هول أمام جمهور كبير، وحضرها جوزيف ابن عمها الذي لم يستطع أن يخفي علائم الارتباك والخوف أمام هذا الموقف الذي لا يُحسد عليه. قالت مي في بدايتها: «رسالة الأديب تُعلِّمنا كيف نخلق حضارة أدبية؛ إذ بها لا بغيرها، تقاس مواهبنا ويسبر غور طبيعتنا…» (ص 259). وانهالت عليها باقات الورد من شباب الجامعة، وشقت الزغاريد فضاء الويست هول الواسع. وفي مقابلة أجراها معها فؤاد حبيش مدير جريدة «المكشوف» قال: «أنت اليوم امرأة مثل النور». وصدر قرار في 1 حزيران/ يونيو بردِّ دعوى إلقاء الحَجْر نهائيًّا.
وقررتْ مي أن تعود إلى القاهرة. وألقت محاضرة في الجامعة الأميركية هناك، ولكنها كانت محاضرة باردة؛ وفي نهايتها طلبت أن تخرج من الباب الخلفي كي لا تلتقي كُتّاب مصر الذين تنكّروا لها في أثناء محنتها. ولكنها أصيبت بربو شديد. وتذكر مي أن طه حسين اتصل بها ليهنئها بالسلامة، فقالت له: إن صالونها قد أقفل. وطلب أن يراها فأجابته: «أنا هذه الأيام لا أرى إلا القساوسة. كن قسيسًا وتعال. ولا بأس أن أراك بعدها». فأجابها: يؤسفني ألَّا أكون قسيسًا، لا أصلح لذلك» (ص 292). وازدادت نوبات السعال، فذهبت لتصلي في الكنيسة: «أرى كاتدرائية مدينتي في الحي القديم في الناصرة تدعوني نحوها. وأسمع أذان الجامع الأبيض الذي يهزني كما يهز طفل صغير في عزّ نومه وهدأته» (ص 295). وفي صباح يوم الأحد 19/ 9/ 1941م تفيض روحها، بعد أن تراءت لها صورة أمها: «اغسليني يا أمي من دمي، ودثريني بصدرك». وبهذه الجملة الأخيرة، تنتهي يوميات العصفورية. ومشى وراء نعشها ثلاثة أشخاص فقط: خليل مطران، وأنطوان الجميّل، وأحمد لطفي السيّد.
يوميات مي والأدب
على الرغم من جو الحزن السائد في نَصّ اليوميات، لا تغفل مي زيادة عن إفراغه في قالب أدبي بهي، استقته من ثقافتها الواسعة واللغات التسع التي كانت تعرفها. تستهل يومياتها بنص شعري:
«موجودة وكأني لم أكن.
موجوعة، لا أحد يسمعني
لا شيء الآن سوى أني قررتُ الموتَ كتابة.
أكتب لكي أستمرّ فيّ.
الغياب، جهنّم الأرض […].
لا خيار لي سوى أن أكتب.
أكتب لا غير».
وهذه الكِتابة هي التي أنقذتها من الجنون المهيمن على العصفورية. في البداية كانت تكتب على «باكيت سجائر بخط ناعم كأنها آثار سرب نمل، ربحًا للمساحات» (ص 55). وتذكر مي أنها مُنعت من الكتابة، ولكن إحدى الممرضات التي قرأت عددًا من كتبها وكانت لطيفة معها، أتتها بأوراق وبقلمي رصاص ومبراة وممحاة. وكانت الشخص الوحيد في العصفورية الذي تعامل معها ككاتبة. ولكنها في ساعات يأسها كانت تقول: «فيمَ نفعتني ثقافتي في عمق عفن الطمع والكراهية؟ لا شيء. ماذا يعني أن تكون مثقفًا في مجتمع يشرب التخلف في كل ثانية، ويأكل نفسه بلا توقف؟» (ص 73).
ومي النسوية التي ارتقت بصالونها الأدبي القاهري إلى أعلى الأعالي، وجدت نفسها أمام ذكورة متخلفة: «يكفي أن يكون المرء امرأة، لِيُجَرَّدَ كليًّا من عقله وذكائه» (ص 81). وتذكّرها الممرضة يلوهارت بالمحاضرة التي ألقتها في الجامعة الأميركية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1922م في منتدى الويست هول بعنوان: «هوذا الرجل». ولهذه العبارة في الإنجيل والتراث المسيحي وقع خاص، وهي Ecce homo. ويُقصد بها الإنسان المعذَّب كالمسيح المدمّى عذابًا قبل رفعه على الصليب. وكثيرًا ما كانت مي زيادة تصرِّح بأنها امرأة حرة. وهذا يذكّر بما قاله لها فؤاد حبيش مدير جريدة «المكشوف»: «أنت اليوم امرأة حرة مثل النور» (ص 264).
ويلامس أسلوبها أحيانًا أسلوب السورياليين الذين كانت تعرفهم من دون شك. «أين أنا إذن؟ الجحيم رتبة من مراتب الكوميديا الإلهية؟ أين أنا، أصعد نحو التلاشي، أم أنحدر نحو التآكل؟ أم لا هذا ولا ذاك، الصعود إلى أسفل، تنطبق هذه المفارقة عليَّ تمامًا. من السماء التي كنت ألمسها كل صباح إلى اللاشيء» (ص 118).
وأنهي هذه العجالة باستشهاد صغير لجبران خليل جبران الذي قال عن مي زيادة: «هناك في مشارق الأرض صبية ليست كالصبايا. وقد دخلت الهيكل قبل ولادتها، ووقفت في قدس الأقداس، فعَرَفَت السرَّ العلويَّ الذي اتخذه جبابرة الصباح، ثم اتخذت بلادي بلادًا لها، وقومي قومًا لها» (من رسالة جبران إلى مي، بتاريخ 9 شباط/ فبراير 1019م) (ص 98).

جمال شحيد - ناقد سوري | مايو 2, 2017 | مقالات
اهتم الغرب بابن خلدون (1332- 1406م)، منذ بداية القرن التاسع عشر، فراح المستشرقون يترجمون «المقدمة» وأجزاءً من «كتاب العبر» منذ عام 1810م، مع سيلفستردي ساسي الفرنسي، وهامِر بورغشتال الألماني، ورينهارتدوزي الهولندي، وإدوارد بوكوك الإنجليزي، ودسلان الفرنسي، وألفريد فون كريمر النمساوي، وعبداللطيف صبحي باشا التركي… وفي القرن العشرين ترجمت المقدمة إلى معظم اللغات الكبرى في العالم، ومن بينها الترجمة اليابانية عام 1964- 1987م، والعبرية عام 1967م.
وظهرت في السنوات الأخيرة ترجمات علمية محققة ومذيَّلة بشروحات وتعليقات مفيدة، ومن بينها الترجمة الرائعة التي أنجزها الأستاذ المغربي عبدالسلام شدّادي، وتبنَّتها دار غاليمار الباريسية الفرنسية، وطبعتها في أجمل سلسلة أوربية وهي «مكتبة لابلياد» (2004، 1559 صفحة) التي تُعَدّ مفخرة للكتاب الفرنسي. وكتب الأستاذ شدادي مقدمة وافية لترجمته، وأرفدها بعدد كبير من الحواشي والتعليقات والفهارس. وأدرج ترجمة السيرة الذاتية لابن خلدون قبل المقدمة، وهي من أجمل السير الذاتية العربية في القرون الوسطى. وأضاف إلى متن «المقدمة» عددًا من الخرائط والمراجع المتعددة اللغات، فأتت ترجمته وافية جمعت كمًّا هائلًا من المعلومات يفيد منها القارئ الفرنسي كثيرًا. ولا نجد طبعة عربية للـ«مقدمة» بهذه الدقة العلمية، مع أنها من عيون تراثنا العربي.
وصدرت في الربع الأخير من القرن العشرين دراسات فلسفية وتاريخية وأنثروبولوجية حول «مقدمة» ابن خلدون في معظم اللغات؛ مما دفع بعضهم إلى القول بأن ابن خلدون هو مؤسس فلسفة التاريخ ومكتشف محرِّكه، وبأنه تفوَّق في كتابه هذا على أعمال المؤرخين القدامى كهيرودوت وسوثوكيذيذيس وأفتيخوس، والمسعودي، وابن العبري، والطبري… ويذكر آخرون أنه رسم الخطوط العريضة لـ«علم الاجتماع الإنساني» أو للأنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية التي صارت علومًا مهمة في الإنسانيات، ونوَّه بفضلها كلّ من إميل دوركايم وألكسيس دو توكفيل، وإدوارد إيفانز– بريتشارد.
الغرب لا العرب من أفاد من ابن خلدون
 على الرغم من ذلك، لم يستفد العرب كثيرًا من أفكار ابن خلدون ليخلقوا نظامًا سياسيًّا حديثًا، نظامًا يأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمعات علميًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا؛ بل نلاحظ أن الغرب هو الذي استفاد من أفكار ابن خلدون التي تنطبق على جميع المجتمعات البشرية بعامة، مع أن أمثلته مأخوذٌ جلُّها من تاريخ المغرب والأندلس والمشرق. وطبّق عدد من الباحثين المعاصرين نظريات ابن خلدون على مجتمعاتنا المعاصرة وعلى الجيوسياسة التي نشهدها الآن. وتمثيلًا لا حصرًا، هذا ما فعله الباحث الفرنسي غابرييل مارتينيز غرو في كتابه: «موجز في تاريخ الإمبراطوريات. كيف تنشأ، وكيف تضمحلّ» ترجمة د. علي نجيب إبراهيم (دار الكتاب العربي، 2017م). فبعد أن استعرض بروز الإمبراطوريات عبر التاريخ (آشور، والفرس، والإغريق، وروما، والصين) توقف عند الكسوف الإمبراطوري لجميع هذه الإمبراطوريات. لقد اندثرت الإمبراطورية العباسية وحلَّت محلَّها الإمبراطورية السلجوقية، واندثرت الإمبراطورية البريطانية وحلت محلها الإمبراطورية الأميركية، واندثرت الممالك الصليبية في المشرق وحلت محلها السلطنة الأيوبية، واندثرت الإمبراطورية المملوكية وحلت محلها الإمبراطورية العثمانية، وهكذا.
على الرغم من ذلك، لم يستفد العرب كثيرًا من أفكار ابن خلدون ليخلقوا نظامًا سياسيًّا حديثًا، نظامًا يأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمعات علميًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا؛ بل نلاحظ أن الغرب هو الذي استفاد من أفكار ابن خلدون التي تنطبق على جميع المجتمعات البشرية بعامة، مع أن أمثلته مأخوذٌ جلُّها من تاريخ المغرب والأندلس والمشرق. وطبّق عدد من الباحثين المعاصرين نظريات ابن خلدون على مجتمعاتنا المعاصرة وعلى الجيوسياسة التي نشهدها الآن. وتمثيلًا لا حصرًا، هذا ما فعله الباحث الفرنسي غابرييل مارتينيز غرو في كتابه: «موجز في تاريخ الإمبراطوريات. كيف تنشأ، وكيف تضمحلّ» ترجمة د. علي نجيب إبراهيم (دار الكتاب العربي، 2017م). فبعد أن استعرض بروز الإمبراطوريات عبر التاريخ (آشور، والفرس، والإغريق، وروما، والصين) توقف عند الكسوف الإمبراطوري لجميع هذه الإمبراطوريات. لقد اندثرت الإمبراطورية العباسية وحلَّت محلَّها الإمبراطورية السلجوقية، واندثرت الإمبراطورية البريطانية وحلت محلها الإمبراطورية الأميركية، واندثرت الممالك الصليبية في المشرق وحلت محلها السلطنة الأيوبية، واندثرت الإمبراطورية المملوكية وحلت محلها الإمبراطورية العثمانية، وهكذا.
ويعزف على النغمة ذاتها المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم الذي يرى في كتابه «عصر التطرفات» ترجمة فايز الصُّياغ (المنظمة العربية للترجمة، 2011م) أن الاستعمار الأوربي انحسر تدريجيًّا بعد الحرب العالمية الثانية، وفتح الطريق أمام الدول القومية في العالم الثالث الذي خلخلته الثوراتُ الاجتماعية والسياسية، التي اندلعت في عدد من بلداننا العربية بعد عام 2010م.
قرأ هذان المفكران الحاضرَ على ضوء ما ذكره ابن خلدون القائل: إن الأنظمة السياسية تشبه كل الكائنات الحية، تنشأ صغيرة ثم تكبر وتبلغ أوجها ذات يوم، ثم تبدأ بالانحسار وتتلاشى وتضمحلّ. فيأتي فريق آخر أشد قوة وفتوَّة ويستلم زمام الأمور. إذًا: عصبية ← مُلك ← عصبية ← مُلك… إلى ما لا نهاية. هذه هي حركة التاريخ، وهي قائمة على التغيير وليس الثبات. التأبيد غير وارد، حسب منطق ابن خلدون؛ لأن حركة التاريخ زوبعية ولا تتوقف؛ ولن توجد أمَّة أو سلالة خُلِّد سلطانُها ورفعت شعار التأبيد الذي ينتشر بسذاجة في بعض أنظمة الحكم المتخلفة. رأى ابن خلدون أن العنف هو عصب التاريخ، وأنه يخلق صنوَه: العنف ينشئ العنف. ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الإكرام والجلال؛ لهذا السبب يكره سياسيو العالم الثالث ابن خلدون، ويَعُدُّونه نذير شؤم يهدد كراسيهم، في حين أن المجتمعات المتقدمة بنت أنظمتها على القوانين الحديثة والمؤسسات؛ وهذه الأخيرة هي التي تبقى بعد زوال الأشخاص وانتقال السلطة دستوريًّا. إذا شئتَ أن يخلدك التاريخ، ابْنِ، أَنشِئْ، عَمِّرْ ثم ارحل. هذا هو علم الاجتماع الإنساني الذي طرحته «مقدمة» ابن خلدون التي استفاد منها الغرب كثيرًا وكرهتها أنظمتنا السياسية المتخلفة التي لا تعرف أن تقرأ التاريخ.
الذاكرة الجمعية والوقائع البشرية
من ينظر في التاريخ، عليه أن يبرز العلاقة بين التاريخ والذاكرة الجمعية وأن يحفز دور هذه الذاكرة في استجلاء الوقائع البشرية. وقد أكبّ المؤرخ الفرنسي بيير نورا على إظهار مطارح الذاكرة في التاريخ، وهي التي تبنيها الأمة عبر مسيرتها خلال قرون وقرون. فأصدر عام 1997م أربعة مجلدات كتبتها مجموعة من المؤرخين، عن المعالم والرموز والأوابد والمؤسسات والوثائق التي ترتكز على هذه الذاكرة الجمعية. ذلك أن الأمة المصابة بمرض «النساوة Amnésie» هي أمة آيلة للسقوط والاندثار اللذين تكلم عنهما ابن خلدون، كما سلف. وكان نورا وجاك لوغوف قد أصدرا عام 2011م كتابًا جماعيًّا عنوانه: «الاشتغال بالتاريخ» ساهم في إعداده 29 باحثًا عكفوا على دراسة فلسفة التاريخ وعلاقة التاريخ بشتى العلوم الإنسانية والمجالات الفكرية والاجتماعية، ودرسوا أيضًا صلة التاريخ بالأساطير والذهنيات واللغات والأجيال الشابة والسينما والفنون والآداب الاجتماعية وتفاصيل الحياة اليومية… (وستصدر ترجمته قريبًا عبر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مشروع ترجمان).
كل هذا لأقول: إن مهمة السياسي الناجح هي أن يعقل زمانَه ويربط السوابق باللواحق؛ كي تتوافر لديه الرؤية الشمولية للواقع الذي يعيش فيه، وكي لا يتوغل في أدغال متاهية ودروب قصيرة المدى. وإذا انقلبت الأمور عليه، يجب أن يتحلى بالتخلي عن السلطة تاركًا نهر التاريخ يمضي حسب مجراه. وهذا ما فعله عدد من رؤساء وزعماء العالم، بعد خسارتهم في الانتخابات أو عجزهم الصحي: باراك أوباما مؤخرًا، وديفيد كاميرون، والبابا يوحنا بولس الثاني. ومنهم من استبق الأمور فامتنع عن الترشُّح للانتخابات، لعلمه أن استطلاعات الرأي لم تكن لصالحه، كما فعل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. لئنْ كانت الدراسات التاريخية قد خطت خطوات جبَّارة خلال العقود المنصرمة، لا سيَّما مع مدرسة «الحوليات» التي أطلقها كلٌّ من مارك بلوخولوسيان فيفر وفرنان بروديل (عام 1972م)، فإنها ما زالت تستكمل مدرسة ابن خلدون ولم تخرج من عباءته. وإذا أهمل العرب ابن خلدون خلال القرون الماضية –على عكس ما فعله الغربيون منذ مطلع القرن التاسع عشر- فلأنهم استشعروا خطر نظرياته على أنظمتهم السياسية ومصالحهم الآنية.
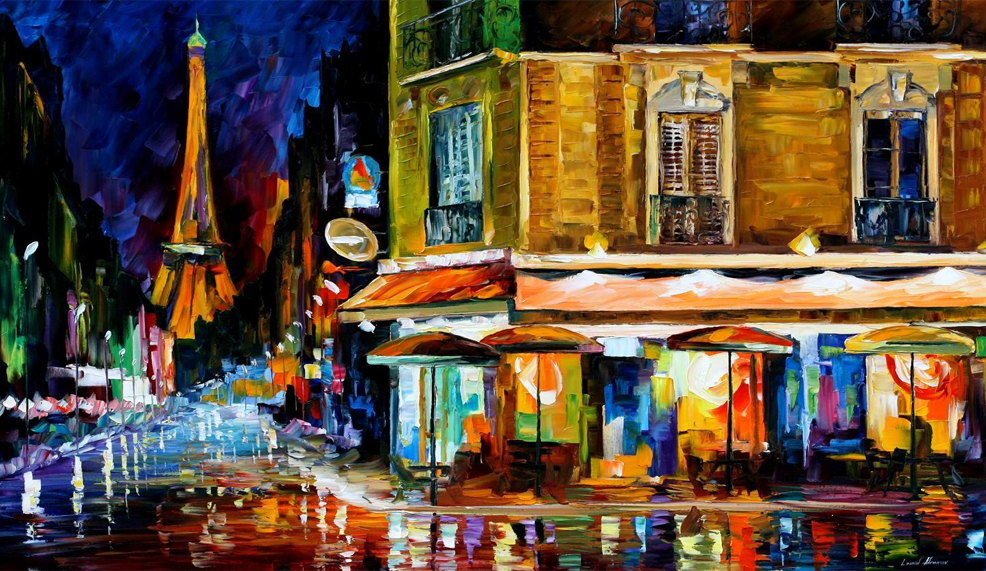

 وأعجبت مي بالنحاتة الفرنسية كامي كلوديل التي وضعها الفنان أوغست رودان في مستشفى المجانين، بالتواطؤ مع تجار الفن. وراسلتها مي زيادة وردت كامي كلوديل؛ لأن كلتيهما عَرَفَت المصير ذاته: مستشفى المجانين. قالت النحاتة العبقرية: «منذ 17 سنة رماني رودان وتجار الفن في سجن مستشفى المجانين، بعد أن استولى على منجزي الحياتي كله […]. فكرة واحدة ظلت تسكنه، خوفه من أن أحلّ محله، بعد موته، وأتجاوزه […]. كل تفاصيل وأجزاء منحوتاته المهمة، كنت وراءها» (ص 168). وجيّر رودان أهم أعماله التي هي «القُبلة» لشخصه مع أنها لكلوديل.
وأعجبت مي بالنحاتة الفرنسية كامي كلوديل التي وضعها الفنان أوغست رودان في مستشفى المجانين، بالتواطؤ مع تجار الفن. وراسلتها مي زيادة وردت كامي كلوديل؛ لأن كلتيهما عَرَفَت المصير ذاته: مستشفى المجانين. قالت النحاتة العبقرية: «منذ 17 سنة رماني رودان وتجار الفن في سجن مستشفى المجانين، بعد أن استولى على منجزي الحياتي كله […]. فكرة واحدة ظلت تسكنه، خوفه من أن أحلّ محله، بعد موته، وأتجاوزه […]. كل تفاصيل وأجزاء منحوتاته المهمة، كنت وراءها» (ص 168). وجيّر رودان أهم أعماله التي هي «القُبلة» لشخصه مع أنها لكلوديل.
 على الرغم من ذلك، لم يستفد العرب كثيرًا من أفكار ابن خلدون ليخلقوا نظامًا سياسيًّا حديثًا، نظامًا يأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمعات علميًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا؛ بل نلاحظ أن الغرب هو الذي استفاد من أفكار ابن خلدون التي تنطبق على جميع المجتمعات البشرية بعامة، مع أن أمثلته مأخوذٌ جلُّها من تاريخ المغرب والأندلس والمشرق. وطبّق عدد من الباحثين المعاصرين نظريات ابن خلدون على مجتمعاتنا المعاصرة وعلى الجيوسياسة التي نشهدها الآن. وتمثيلًا لا حصرًا، هذا ما فعله الباحث الفرنسي غابرييل مارتينيز غرو في كتابه: «موجز في تاريخ الإمبراطوريات. كيف تنشأ، وكيف تضمحلّ» ترجمة د. علي نجيب إبراهيم (دار الكتاب العربي، 2017م). فبعد أن استعرض بروز الإمبراطوريات عبر التاريخ (آشور، والفرس، والإغريق، وروما، والصين) توقف عند الكسوف الإمبراطوري لجميع هذه الإمبراطوريات. لقد اندثرت الإمبراطورية العباسية وحلَّت محلَّها الإمبراطورية السلجوقية، واندثرت الإمبراطورية البريطانية وحلت محلها الإمبراطورية الأميركية، واندثرت الممالك الصليبية في المشرق وحلت محلها السلطنة الأيوبية، واندثرت الإمبراطورية المملوكية وحلت محلها الإمبراطورية العثمانية، وهكذا.
على الرغم من ذلك، لم يستفد العرب كثيرًا من أفكار ابن خلدون ليخلقوا نظامًا سياسيًّا حديثًا، نظامًا يأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمعات علميًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا؛ بل نلاحظ أن الغرب هو الذي استفاد من أفكار ابن خلدون التي تنطبق على جميع المجتمعات البشرية بعامة، مع أن أمثلته مأخوذٌ جلُّها من تاريخ المغرب والأندلس والمشرق. وطبّق عدد من الباحثين المعاصرين نظريات ابن خلدون على مجتمعاتنا المعاصرة وعلى الجيوسياسة التي نشهدها الآن. وتمثيلًا لا حصرًا، هذا ما فعله الباحث الفرنسي غابرييل مارتينيز غرو في كتابه: «موجز في تاريخ الإمبراطوريات. كيف تنشأ، وكيف تضمحلّ» ترجمة د. علي نجيب إبراهيم (دار الكتاب العربي، 2017م). فبعد أن استعرض بروز الإمبراطوريات عبر التاريخ (آشور، والفرس، والإغريق، وروما، والصين) توقف عند الكسوف الإمبراطوري لجميع هذه الإمبراطوريات. لقد اندثرت الإمبراطورية العباسية وحلَّت محلَّها الإمبراطورية السلجوقية، واندثرت الإمبراطورية البريطانية وحلت محلها الإمبراطورية الأميركية، واندثرت الممالك الصليبية في المشرق وحلت محلها السلطنة الأيوبية، واندثرت الإمبراطورية المملوكية وحلت محلها الإمبراطورية العثمانية، وهكذا.