
الروائية العربية في مواجهة عالــمهـا الـخـارجـي وانـهـيـاراته – مايا الحاج
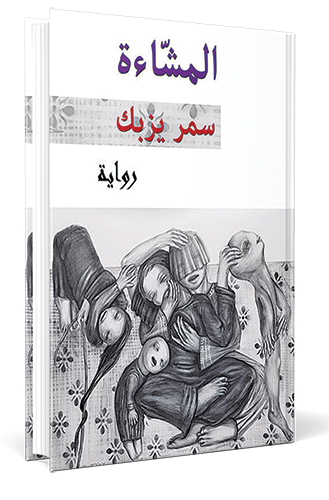 يصعب أن تُنادي ضدّ تجنيس الأدب ثمّ تجد نفسك منساقًا نحو الكتابة عن أدبٍ نسائي. لكنّ المسألة تغدو طبيعية في حال كانت غايتها تخليص هذا الأدب من تصنيفاته الجندرية. فالنظريات التي أرساها كثيرون من النقّاد العرب حول روايات النساء التي تنشغل بالذات على حساب العالم، وبالجسد على العقل، وبالمشاعر على الواقع، راحت تُثبت ضعفها يومًا تلو آخر. وما من شيء يُثبت تهافت تلك النظريات سوى دراسة الروايات (النسائية) الصادرة خلال السنوات الأخيرة، حيث انشغلت معظم الكاتبات العربيات بالوضع السياسي- الاجتماعي العام، فكتبن عن الحرب التي عُدَّت دائمًا من الموضوعات «الذكورية»، لا «الأنثوية».
يصعب أن تُنادي ضدّ تجنيس الأدب ثمّ تجد نفسك منساقًا نحو الكتابة عن أدبٍ نسائي. لكنّ المسألة تغدو طبيعية في حال كانت غايتها تخليص هذا الأدب من تصنيفاته الجندرية. فالنظريات التي أرساها كثيرون من النقّاد العرب حول روايات النساء التي تنشغل بالذات على حساب العالم، وبالجسد على العقل، وبالمشاعر على الواقع، راحت تُثبت ضعفها يومًا تلو آخر. وما من شيء يُثبت تهافت تلك النظريات سوى دراسة الروايات (النسائية) الصادرة خلال السنوات الأخيرة، حيث انشغلت معظم الكاتبات العربيات بالوضع السياسي- الاجتماعي العام، فكتبن عن الحرب التي عُدَّت دائمًا من الموضوعات «الذكورية»، لا «الأنثوية».
أمّا هذا التقسيم (الجندري) فيأتي جرّاء اعتماد النقاد والباحثين -في دراسة الأدب- انطلاقًا من جنس كاتبه، فأطلقوا على أدب المرأة تسميات كثيرة؛ منها: «الأدب النسائي»، و«الأدب النسوي»، و«الأدب الأنثوي»، من دون اشتقاق مسميات مقابلة كـ«الأدب الذكوري» مثلًا، وكأنّ الحالة الطبيعية للأدب أن يكتبه الرجال. ومن ثمّ منحوا كلّ نوع منهما معايير ومواصفات خاصة. وإذا اتفق معظمهم على أنّ روايات المرأة هي أساسًا ردّ فعل على واقعها الاجتماعي في ظل نظام بطريركي، وإلى الغرق في ذاتيتها بغية إثبات هويتها الأنثوية في كل ما تكتب، فإنّ دراسة الروايات الحديثة التي كُتبت في مُناخ الحروب العربية الراهنة توضح حساسية المرأة تجاه قضايا عالمها الخارجي وانهياراته. وإذا أحصينا الروايات (النسائية) السورية التي تناولت الحرب العاصفة في سوريا منذ سنوات، لوجدنا أنّها تُضاهي كمًّا ما كتبه الروائيون السوريون، إن لم نقل: إنها تفوقت. فمن رواية روزا ياسين الحسن إلى شهلا العجيلي ومها حسن وسمر يزبك وديما ونوس ولينا هويان الحسن وغيرهن، يمكن أن نسجّل حضور المرأة في مواقع عُدَّت دائما أنها بعيدة عنها.
عالم لا يخلو من التخييل

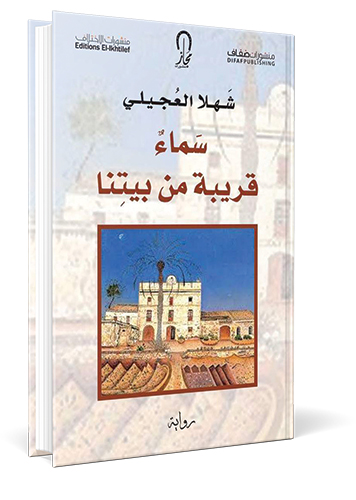 وقد تكون رواية «المشاءة» (دار الآداب)، ردًّا واضحًا على ما كتبه نقّاد، منهم مثلًا عفيف فراج، من أن الكاتبات النساء (العربيات) يتحركن في كتاباتهن في عالم الرجال، بوصفه خصمًا وحكمًا، لعنةً وبركةً، وينشغلن بقضايا الذات والأنا، من دون الخوض في قضايا إنسانية عامة. في هذه الرواية، لم تكن ذات الكاتبة سمر يزبك، المقيمة في باريس، مدماكًا بنت عليه عمارتها الروائية، إنما آثرت أن تتأمّل حرب بلادها الشعواء عبر نوافذ بيت فقير في حيّ شعبي (داخل المخيم)، وبعيون المهمشين والمحرومين. بدت سمر يزبك شديدة الالتصاق بواقعها، نقصد الواقع السوري الراهن، وإن اختارت أن تقدّم هذا الواقع عبر عالمٍ روائي لا يخلو من التخييل. بطلة القصة فتاة بسيطة جدًّا، مُصابة بداء المشي والخرس الاختياري. حين قُتلت أمها برصاصة خاطئة على حاجز التفتيش، نُقلت الراوية/ البطلة (المجروحة) إلى المستشفى. هناك تعرفت للمرة الأولى إلى سجينات اعتُقلن لانتمائهن المعادي للنظام. سمعت منهنّ حكايات لم تقرأها في كتبٍ كثيرة أهدتها إياها الستّ سعادة، أمينة المكتبة في المدرسة حيث كانت تعمل أمها في تنظيف الحمّامات. عرفت منهنّ أنّ الحياة في بلدها لا تحتمل الاختلاف، وإن في وجهات النظر. وصلتها حكايات الاغتصاب والتعذيب والخوف والسجون والقتل. ثم انتقلت مع أخيها إلى الزملكا في الغوطة الشرقية. سكنت في بيت تجتمع فيه عائلات، علمت من الحياة معها أنّها لم تكن تعرف شيئًا من حقيقة هذا العالم، «ولا حتى ظلال هذا العالم الذي اعتقدتُ أنّ الكتب أخبرتني عنه بكل شيء». شاهدت جريمة قصف الأطفال والعائلات بالكيماوي، ثمّ هربت من القصف إلى مكانٍ آخر لكنها ظلّت محاصرة في فسحة ضيقة داخل قبوٍ لا شيء فيه من مقوّمات الحياة. «وأنا حكاية سأختفي ربما… حلقي جاف، رأسي يدور، لم أعد أركّز في الحروف. وعليّ أن أصرخ». «المشاءة» لا تُقرأ إذًا كسجلّ اجتماعي لمؤلفتها، بل إنها عمل روائي قائم بذاته. ما يتعارض طبعًا مع دراسات نقدية طاولت الأدب النسائي. فالكاتبة سمر يزبك تطرقت في روايتها إلى تعقيدات الحرب السورية بما فيها توحش النظام وتطرّف المعارضين ولعنة الكيماوي وخطر الحصار، فقدّمت تصويرًا للحرب من الداخل؛ الداخل السوري، والداخل الإنساني.
وقد تكون رواية «المشاءة» (دار الآداب)، ردًّا واضحًا على ما كتبه نقّاد، منهم مثلًا عفيف فراج، من أن الكاتبات النساء (العربيات) يتحركن في كتاباتهن في عالم الرجال، بوصفه خصمًا وحكمًا، لعنةً وبركةً، وينشغلن بقضايا الذات والأنا، من دون الخوض في قضايا إنسانية عامة. في هذه الرواية، لم تكن ذات الكاتبة سمر يزبك، المقيمة في باريس، مدماكًا بنت عليه عمارتها الروائية، إنما آثرت أن تتأمّل حرب بلادها الشعواء عبر نوافذ بيت فقير في حيّ شعبي (داخل المخيم)، وبعيون المهمشين والمحرومين. بدت سمر يزبك شديدة الالتصاق بواقعها، نقصد الواقع السوري الراهن، وإن اختارت أن تقدّم هذا الواقع عبر عالمٍ روائي لا يخلو من التخييل. بطلة القصة فتاة بسيطة جدًّا، مُصابة بداء المشي والخرس الاختياري. حين قُتلت أمها برصاصة خاطئة على حاجز التفتيش، نُقلت الراوية/ البطلة (المجروحة) إلى المستشفى. هناك تعرفت للمرة الأولى إلى سجينات اعتُقلن لانتمائهن المعادي للنظام. سمعت منهنّ حكايات لم تقرأها في كتبٍ كثيرة أهدتها إياها الستّ سعادة، أمينة المكتبة في المدرسة حيث كانت تعمل أمها في تنظيف الحمّامات. عرفت منهنّ أنّ الحياة في بلدها لا تحتمل الاختلاف، وإن في وجهات النظر. وصلتها حكايات الاغتصاب والتعذيب والخوف والسجون والقتل. ثم انتقلت مع أخيها إلى الزملكا في الغوطة الشرقية. سكنت في بيت تجتمع فيه عائلات، علمت من الحياة معها أنّها لم تكن تعرف شيئًا من حقيقة هذا العالم، «ولا حتى ظلال هذا العالم الذي اعتقدتُ أنّ الكتب أخبرتني عنه بكل شيء». شاهدت جريمة قصف الأطفال والعائلات بالكيماوي، ثمّ هربت من القصف إلى مكانٍ آخر لكنها ظلّت محاصرة في فسحة ضيقة داخل قبوٍ لا شيء فيه من مقوّمات الحياة. «وأنا حكاية سأختفي ربما… حلقي جاف، رأسي يدور، لم أعد أركّز في الحروف. وعليّ أن أصرخ». «المشاءة» لا تُقرأ إذًا كسجلّ اجتماعي لمؤلفتها، بل إنها عمل روائي قائم بذاته. ما يتعارض طبعًا مع دراسات نقدية طاولت الأدب النسائي. فالكاتبة سمر يزبك تطرقت في روايتها إلى تعقيدات الحرب السورية بما فيها توحش النظام وتطرّف المعارضين ولعنة الكيماوي وخطر الحصار، فقدّمت تصويرًا للحرب من الداخل؛ الداخل السوري، والداخل الإنساني.


لينا هويان الحسن
أمّا ديمة ونّوس، فكتبت أيضًا «الخائفون» (دار الآداب) من وحي وضع سوريا المأسوي. عبر امرأتين هما: سلمى وسليمى، حكت ونوس عن الصورة والأصل، الشخص والقرين، الذات والظلّ، الغائب والحاضر، الوطن والمنفى. اعتمدت ونّوس لعبة «الرمز» في رواية الحرب السورية حيث غدا الجميع متشابهًا في خوفه، وقلقه، وغيابه، وربما في موته… الحرب أيضًا حضرت في رواية شهلا العجيلي: «سماء قريبة من بيتنا» (منشورات ضفاف). التقى البطلان، السورية جمان والفلسطيني ناصر مصادفة في رحلة العودة من إسطنبول إلى عمّان. ثم تحوّل لقاؤهما العابر إلى قصة حب يبحث كلّ طرف فيها عمّا ينقصه في الآخر. ومن هذا اللقاء الفلسطيني – السوري في الطائرة تتولّد رموز الاقتلاع العربي ومأسويته، فتحضر مقولة إدوارد سعيد، على لسان الراوية، لترسّخ هذا الواقع: «الجغرافيا عدونا الأول». تُصاب البطلة بمرض السرطان بينما تُدكّ بلدها بالكيماوي. والمعلوم أنّ السرطان وفعل الإشعاع الذري تجمعهما علاقة علمية وأحيانًا عضوية قائمة في أذهان الناس، بحيث يعني كلاهما التفكك والموت. وحين تُخاطب الشابة الجميلة المفعمة بالحياة والثقافة والذكريات نفسها قائلة: «متألمة، متهافتة، أَمَا لهذا الألم أن ينتهي؟ لا أعرف كيف أحدد شكل الوجع أو مكانه»، يصعب علينا تحديد ألمها. هل هذا وجعها الجسدي أم وجع سوريا النازفة؟

مها حسن
وإذا ألغيت اسم الكاتبة شهلا العجيلي، قد يصعب عليك التكهّن بجنس مؤلّف الرواية. إنّها تعتمد تقنية تقوم على وثبات زمنية وتباين في المستويات السردية، ما يتنافى والمقولة التي راجت عن أنّ الكاتبة «الأنثى» تؤثر المونولوج وتقنية الصوت الواحد. تنطلق الرواية بإشارة زمنية «كان يوم الإثنين 30/4/1947 يومًا ربيعيًّا مشرقًا من أيّام حلب»، قبل أن تنتقل إلى الواقع الراهن، فتقدّم صورتين متذادتين عن حلب الشهباء الشامخة (الماضي) وحلب الموجوعة والمغتربة (الحاضر). أمّا أحلام السوريين فاختلفت أيضًا. الفرار من سوريا بات وحده الحلم المنتظر. «المطارات سلالم الحكايات، ونحن السوريين ربما لنا حكايتنا المختلفة معها، فبمجرّد مرورنا من الكوة الأخيرة لأي موظف جوازات، نكون قد استلمنا صكّ ولادة جديدة». لا تستجيب رواية شهلا العجيلي إلى نظرية جورج طرابيشي بقوله: إنّ المرأة تكتب الرواية بقلبها بينما يكتبها الرجل، وأنّ العالم هو مركز أدب الذكور بينما الذات هي مركز رواية الإناث.
بانوراما الموت

جنى الحسن
وفي سياق آخر، كتبت لينا هويان الحسن عن حربٍ فقدت فيها شقيقها ياسر. ومع أنّ الذات كانت حاضرة في روايتها «الذئاب لا تنسى» (دار الآداب)، لكنّها رسمت بانوراما الموت السوري الذي لا يميز بين معارضة وموالاة وأناس عاديين لا ينتمون إلى هذه الفئة أو تلك. يسير الخطّ الدرامي في رواية الحسن بين «المدينة» و«البادية»، عبر رحلة إلى قريةٍ على تخوم بادية حماة، حيث مدفن الشقيق المقتول، ياسر. وبموازاة هذه الحركة المكانية، تشهد الرواية حركة في الزمان بين واقعٍ راهن (الحرب السورية) وزمنٍ ماضٍ (طفولة في البادية الرحبة). اتخذت الكاتبة من الصحراء بؤرة سردية بَنَت عليها روايتها، علمًا أنّ الصحراء كانت دومًا مكانًا أثيرًا في روايات الرجل (وليس النساء)؛ لما تعرضه من قيم «ذكورية» مثل الفروسية والحروب والغزل… وكانت لينا هويان كتبت عن باديتها في روايات عدة، منها: «سلطانات الرمل»، و«بنات نعش»، و«ألماس ونساء»، و«البحث عن الصقر غنّام».
وفي «مترو حلب»، تروي مها حسن تفاصيل المأساة السورية من جانب إنساني لا أنثوي، عبر ثيمات عامة مثل: الغياب والفقد واللجوء والمنفى. تصوّر حياة فتاة سورية تدعى سارة، اضطرتها ظروف بلدها المشتعلة إلى الهجرة لتجد نفسها وسط العاصمة الفرنسية محاطة بناس مختلفين وعادات جديدة وتقاليد لم تعتدها. ولعلّ هذه الصدمة التي عاشتها بطلة «مترو حلب» ما هي إلا صدمة آلاف من السوريين الذين توزعوا في عواصم أوربا والعالم.
الحرب والهوية

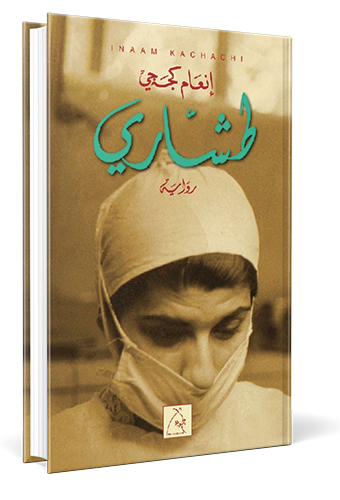 وبعد استعراض عدد من الروايات السورية، قد نأتي على ذكر روايات عربية (صدرت خلال السنوات الخمس الأخيرة)، انشغلت أيضًا بقضايا عُدَّت طويلًا ضمن حيّز روايات «الرجال»، كالحرب والهوية. ومن هذه الأعمال رواية «طشاري» (الجديد) للعراقية إنعام كجه جي التي حاولت من خلالها أن تتناول كارثة الشتات العراقي٬ في العقود الأخيرة٬ من خلال سيرة طبيبة عملت في أرياف جنوب العراق في خمسينيات القرن العشرين، وأبناؤها الثلاثة الموزعون في ثلاث قارات. وبمواجهة تمزق شمل العائلة يبتكر الحفيد، إسكندر، مقبرة إلكترونية، جعل لها موقعًا خاصًّا على الإنترنت، دفن فيها الموتى من العائلة حيث يتعذر جمعهم في مقبرة على الأرض، وخصص لكل فرد من أفراد السلالة المتفرقة في قارات العالم قبرًا خاصًّا به. وأيضًا رواية «طابق 99» (منشورات ضفاف) للبنانية جنى الحسن، التي عادت فيها إلى الحرب اللبنانية الأهلية، راصدة مجزرة صبرا وشاتيلا بأهوالها وتبعاتها العصيبة. أمّا في رواية «قيد الدرس» (دار الآداب)، تطرقت الكاتبة لنا عبدالرحمن إلى قضية الهوية عبر عائلة مكتومة القيد، تنتمي إلى قرية دخلت ضمن الأراضي الفلسطينية، فخسرت لبنانيتها من دون أن تصبح فلسطينية.، فانتهى أبناؤها حاملين هوية «قيد الدرس». وتسترجع لنا تفاصيل الحرب الأهلية اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي لتحكي قصة شتاتٍ رسخته الحرب بعنفها وقسوتها.
وبعد استعراض عدد من الروايات السورية، قد نأتي على ذكر روايات عربية (صدرت خلال السنوات الخمس الأخيرة)، انشغلت أيضًا بقضايا عُدَّت طويلًا ضمن حيّز روايات «الرجال»، كالحرب والهوية. ومن هذه الأعمال رواية «طشاري» (الجديد) للعراقية إنعام كجه جي التي حاولت من خلالها أن تتناول كارثة الشتات العراقي٬ في العقود الأخيرة٬ من خلال سيرة طبيبة عملت في أرياف جنوب العراق في خمسينيات القرن العشرين، وأبناؤها الثلاثة الموزعون في ثلاث قارات. وبمواجهة تمزق شمل العائلة يبتكر الحفيد، إسكندر، مقبرة إلكترونية، جعل لها موقعًا خاصًّا على الإنترنت، دفن فيها الموتى من العائلة حيث يتعذر جمعهم في مقبرة على الأرض، وخصص لكل فرد من أفراد السلالة المتفرقة في قارات العالم قبرًا خاصًّا به. وأيضًا رواية «طابق 99» (منشورات ضفاف) للبنانية جنى الحسن، التي عادت فيها إلى الحرب اللبنانية الأهلية، راصدة مجزرة صبرا وشاتيلا بأهوالها وتبعاتها العصيبة. أمّا في رواية «قيد الدرس» (دار الآداب)، تطرقت الكاتبة لنا عبدالرحمن إلى قضية الهوية عبر عائلة مكتومة القيد، تنتمي إلى قرية دخلت ضمن الأراضي الفلسطينية، فخسرت لبنانيتها من دون أن تصبح فلسطينية.، فانتهى أبناؤها حاملين هوية «قيد الدرس». وتسترجع لنا تفاصيل الحرب الأهلية اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي لتحكي قصة شتاتٍ رسخته الحرب بعنفها وقسوتها.
الحركة الروائية النسائية تُثبت اليوم أنّها لا تعيش على الهامش، بل تتحرّك في مركز الأحداث لتتتبَّع تفاصيلها وتنقلها إلى القارئ عبر رؤية تتجاوز حدود الجندر ومعاييره. فلا تتحرّك رواياتهن داخل عالم الرجل وحده، كما هي متهمة سلفًا، وليست كتاباتهن عنصرًا تزيينيًّا للمشهد الثقافي كما يريد بعضهم أن تكون. بل إنها أعمال إبداعية تخرج من رحم الواقع لتُضيء جوانب معتمة، بأساليب غير مألوفة، فتضعنا أمام حقائق غير مرئية دائمًا، تستشرفها بحسٍّ روائي وتقدّمها بتقنيات كلاسيكية حينًا، ومتقدّمة أحيانًا.
