
بواسطة سعد البازعي - ناقد سعودي | نوفمبر 1, 2018 | مقالات
فرغت مؤخرًا من تسجيل حلقات عدة من برنامج حول الترجمة بطلب من هيئة أبو ظبي للإعلام يتركز على قضايا الترجمة بصفة عامة، ويتناول في كل حلقة كتابًا من تلك التي نشرها مشروع «كلمة» الذي أكمل عشر سنوات، نشر خلالها ألف كتاب مترجم بواقع مئة كتاب في العام. ومع أنني رأيت في البرنامج ومشروع كلمة ككل مساهمة عربية وإنسانية فاتحة لجسور الثقافة كما هي الترجمة دائمًا، فقد آلمتني حقيقة أن الاهتمام بالترجمة بوصفها حقل نشاط معرفي وإبداعي لم يلقَ اهتمامًا موازيًا أو كافيًا في المملكة العربية السعودية، كبرى دول الخليج وأغناها بالموارد البشرية قبل المادية ومن أقدمها عناية بالثقافة. والترجمة ليست سوى ميدان من ميادين النشاط الثقافي الذي تبدو ساحاته الآن تائهة بين العديد من المؤسسات والأفراد. لكن لعل الترجمة هي أكثر تلك الميادين ضياعًا في تلك التعددية التي لم تكن مثرية دائمًا.
هي تعددية مثرية أحيانًا كثيرة واستطاعت في المملكة أن تنتج على مدى عدة عقود مشهدًا ثقافيًّا وعطاءً حيًّا ذا تراكمية غنية بالتنوع والعمق، لكن القياس بمشاهد ثقافية عربية بعضها أقل بكثير من ناحية الثراء البشري والموارد المادية يشكل غصة في حلق كل متطلع إلى عطاءات أكبر. ومع أن تأسيس هيئة للثقافة ثم فصل الثقافة عن الإعلام في المشهد السعودي جاء خطوتين واعدتين رأى صاحب القرار أنهما ستفيدان الحياة الثقافية في المملكة فإنه لا توجد حتى الآن مؤشرات كافية إلى أن ذلك الأمل ليس أكثر من كلمات على ورق.
بعض الخطوات التي تبنتها هيئة الثقافة بشرت بالكثير، ولا سيما تعاونها مع الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون، لكن ذلك التعاون، كما أفضى لي أحد مسؤولي الأندية، كان مظهريًّا قُصد منه إبراز الهيئة بوصفها راعية للثقافة على طريقة «رتبوا نشاط، أي نشاط، ونحن ندعمكم». لا تخطيط ولا رؤية، أي لا فكر ولا منهج. ثم جاء تبني الهيئة لحفلات غنائية يحييها مطربون من الدرجة الثالثة صادمًا لكثيرين، أنا أحدهم. تداخل عمل هيئة الثقافة بعمل رصيفتها هيئة الترفيه. أما وزارة الثقافة فبدت تائهة لا تدري أين تضع قدميها في مشهد ضخم ليس أكثر مسؤوليها عارفًا به ناهيك عن القدرة على التأثير فيه تأثيرًا فاعلًا. جاء تنظيم الوزارة ندوتين، حسب علمي، إحداهما حول الأدب السعودي والأخرى حول الترجمة (تفضلت الوزارة بدعوتي مشكورة للأخيرة) ليعد بنشاط قادم ربما تجاوزت به الوزارة حيرتها وصغر سنها لتكون أكثر فاعلية في مشهد عريق ونابض بالحياة.
لم أرد من هذا التقييم أن يكون قاتمًا، لكن واجب المصارحة والحرص على رؤية مؤسسات الثقافة وهي تمارس عملها على نحو يليق بالاسم الذي انتدبت للعناية به كان الدافع إلى ذلك. ولعل أول ما تحتاجه هذه المؤسسات هو أن تنسق فيما بينها لتتحدد الهويات والمهام؛ لأن الوضع الحالي من تداخل السلطات والمناشط ليس في مصلحة لا المؤسسات ولا الثقافة ولا مما سينعكس على سمعة المملكة ومكانتها في المشهد الثقافي العربي، وإن أدى إلى شيء فسيعرقل مشهدًا حيًّا وقادرًا في جوهره على الاستمرار من دون تلك المؤسسات، لكن عمل المؤسسات من شأنه دعم العمل وتنظيمه وتشكيل انطلاقات أكبر له، وهو ما نتمناه جميعًا.

بواسطة سعد البازعي - ناقد سعودي | يونيو 30, 2017 | مقالات
استوقفتني عبارة للمفكر الفرنسي جان بودريار وردت في كتابه «كرب القوة». العبارة ستفاجئ البعض وتحزن البعض الآخر. هي عبارة تتضمن شكوى لم نألفها وترفًا لم يمر بنا: ترف الحرية. هكذا سيراه من يبحث عن فتات من تلك المحلوم بها أبدًا، الحرية، تمامًا كما هو شعور الجماهير تحت نافذة القصر الإمبراطوري التي يقال: إن ماري أنطوانيت أطلَّت منها لتقول عبارتها الشهيرة: لِمَ لا يأكلون كعكًا، أو كما قالت. فماذا قال بودريار؟
قبل إيراد العبارة من الضروري معرفة السياق. جاءت العبارة ضمن مناقشة بودريار لما وصفه بالانتقال في تاريخ العالم الغربي من مرحلة السيطرة (domination) إلى مرحلة الهيمنة (hegemony)، الأولى هي مرحلة العبودية أو السيطرة المباشرة التي سادت في الماضي، والثانية هي مرحلة الخضوع غير المحسوس والمشاركة في عملية الإخضاع نفسها. وهذه الثانية هي المرحلة الحالية التي يسيطر فيها اقتصاد السوق والعولمة أو عملية التبادل التجاري الطاغي على كل شيء. ثم يشير إلى أن مرحلة العبودية أدّت في ذروتها إلى حركة تحرر سواء أكان سياسيًّا أم جنسيًّا أم غير ذلك، لكنها اتسمت بأفكار واضحة وقادة مرئيين، أما الثانية فلا تسمح، كما يقول، بالثورة عليها، وقبل إيضاح السبب وراء ذلك يلزم القول بأن الواقعين سواء تحت السيطرة أو الهيمنة ليسوا محصورين، كما قد يظن لأول وهلة، في أهل العالم غير الغربي، شعوب آسيا وإفريقيا… إلخ، الذين استُعمروا ونُهبوا طوال قرون، ليسوا أولئك فقط، إنما هم أيضًا الشعوب الغربية نفسها التي ظلت محكومة أيضًا بقوى سياسية واقتصادية واجتماعية، وبأوضاع من التفاوت الطبقي وعدم القدرة على تغيير شيء، مع أنها استفادت من الاستعمار والنهب الذي مارسته حكوماتها، وإن لم يشر بودريار إلى ذلك.
حروب التحرر
ذلك كله يقف وراء النتيجة التي توصل إليها المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي حين قال: «كل حروب التحرر من السيطرة لم تزد على أن مهدت الطريق للهيمنة، أي عهد التبادل العام – التي لا مجال للثورة عليها؛ لأن كل شيء بات محرَّرًا». التبادل العام هو اقتصاد السوق حيث تبادل السلع والأفكار وغيرها، السوق التي تعولمت ولم يعد ممكنًا السيطرة عليها، بل التي باتت هي، حسب بودريار تسيطر على الناس. في تلك السوق لم يعد مجال لثورة لأنه لم يعد هناك متسلط واضح يمكن الثورة عليه.
لكن هذا لن يبدو مقنعًا لشعوب كثيرة حول العالم تعرف المتسلطين، شعوب ما زالت في مرحلة تسبق تلك التي رأى بودريار أن العالم وصل إليها، مرحلة يهيمن فيها فرد مستبدّ أو عسكر، أو أقلية أو مجموعة من المتزمتين أو المؤدلجين أو أو. بالنسبة لأولئك سيبدو كلام بودريار ترفًا لا معنى له. ثمة أولويات تسبق العولمة. غير أن المشكلة لن تقف عند ذلك الحد. ستبدو المشكلة مضاعفة حين تكتشف تلك الشعوب أن ما يقوله المفكر الفرنسي لا يخلو من صحة، أن العولمة من خلال اقتصاد السوق وهيمنة الاستهلاك قوة طاغية أيضًا. صحيح أن بودريار لم يلتفت إلى تلك السلطة المضاعفة لكن ذلك ليس متوقعًا منه، فالالتفات هنا هو ما يجب على مفكِّري العالم غير الغربي فِعله.

بواسطة سعد البازعي - ناقد سعودي | مارس 16, 2016 | كتاب الفيصل, مقالات
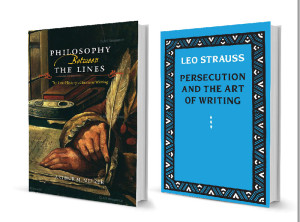 الفيلسوف الألماني ليو شتراوس معروف في الأوساط السياسية الغربية، سواء الدوائر الرسمية أو الأكاديمية المتصلة بالعلوم السياسية، بأنه منظّر ما عرف بتيار المحافظين الجدد؛ أي: السياسيون الذين اشتهروا في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بشكل خاص، وتولوا عدة مناصب مهمة ومؤثرة. وقد سمي أولئك بالمحافظين الجدد؛ لأنهم تبنوا أفكار شتراوس حول طبيعة النظام السياسي، وما ينبغي أن يكون عليه، وبشكل أكثر تحديدًا ضرورة أن يمارس النظام السياسي سياسات بعيدة عن أنظار الشارع فينأى عن اهتمامات الناس العاديين. أي أنه يجب أن تكون للساسة رؤيتهم وقراراتهم التي لا يستشيرون فيها العامة؛ لأن العامة لا تفهم في تلك الأمور، ولا ينبغي أن تستشار فيها. ومع أن هناك من ينفي عن شتراوس تبنيه لتلك الآراء، فإن المؤكد هو أن في كتاباته ما يشجع على ذلك النهج الذي اتبع فعلًا في أحداث كبرى شهدها العالم لعل أبرزها غزو العراق الذي تم بتضليل الرأي العام لتنفيذ «أجندة» رآها أولئك الساسة صحيحة وضرورية.
الفيلسوف الألماني ليو شتراوس معروف في الأوساط السياسية الغربية، سواء الدوائر الرسمية أو الأكاديمية المتصلة بالعلوم السياسية، بأنه منظّر ما عرف بتيار المحافظين الجدد؛ أي: السياسيون الذين اشتهروا في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بشكل خاص، وتولوا عدة مناصب مهمة ومؤثرة. وقد سمي أولئك بالمحافظين الجدد؛ لأنهم تبنوا أفكار شتراوس حول طبيعة النظام السياسي، وما ينبغي أن يكون عليه، وبشكل أكثر تحديدًا ضرورة أن يمارس النظام السياسي سياسات بعيدة عن أنظار الشارع فينأى عن اهتمامات الناس العاديين. أي أنه يجب أن تكون للساسة رؤيتهم وقراراتهم التي لا يستشيرون فيها العامة؛ لأن العامة لا تفهم في تلك الأمور، ولا ينبغي أن تستشار فيها. ومع أن هناك من ينفي عن شتراوس تبنيه لتلك الآراء، فإن المؤكد هو أن في كتاباته ما يشجع على ذلك النهج الذي اتبع فعلًا في أحداث كبرى شهدها العالم لعل أبرزها غزو العراق الذي تم بتضليل الرأي العام لتنفيذ «أجندة» رآها أولئك الساسة صحيحة وضرورية.
الاضطهاد وفن الكتابة
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وانضمام شرق أوربا إلى المعسكر الشيوعي نشر شتراوس كتابًا تأمل فيه أوضاع الكتاب الذين عاشوا تحت الحكم الشيوعي وما مارسه من اضطهاد معروف. لكن ذلك الكتاب عكس أيضًا معرفة شتراوس بالفلسفة في أوربا في العصور الوسطى وصلة تلك الفلسفة بمؤثراتها الإسلامية التي يعد شتراوس متخصصًا بها أيضًا. في كتاب «الاضطهاد وفن الكتابة» تناول شتراوس عددًا من الفلاسفة القدماء ومنهم الفارابي وابن ميمون، وتوقف طويلًا عند سبينوزًا موضحًا كيف واجه أولئك القيود المفروضة عليهم في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم الفلسفية وحاجتهم من ثم لإخفاء الكثير من تلك الآراء والقناعات عن عامة القراء. فالفلاسفة من هذا المنظور طبقة مستقلة من المجتمع، بل ومن عامة المثقفين، وقادرة نتيجة لذلك على رؤية العالم من زاوية مستقلة أيضًا، زاوية لا تصلها العامة وقد ترفض العامة نتائجها. ومن هنا فإن الفلاسفة مضطرون للتعبير عن بعض آرائهم بالطريقة التي لا يستطيع العامة فهمها (ومن هنا نستطيع أن نفهم أحد أسباب الربط بين شتراوس وتيار المحافظين الجدد).
في كتاب «الاضطهاد وفن الكتابة» طرح شتراوس نظريته حول الأساليب التي اتبعها بعض الفلاسفة قديمًا؛ لتمرير بعض أفكارهم بحيث لا تكون مستمسكًا عليهم فيعاقبوا بسببها، فتحدث مثلًا عن كيفية توظيف الفارابي لأفلاطون في كتاب له حول ذلك الفيلسوف اليوناني. يقول شتراوس: إن الفارابي يقوّل أفلاطون كلامًا لم يقله وإنما هو كلام الفارابي نفسه لا أفلاطون، فيصبح الفيلسوف القديم مطية لأفكار الفيلسوف المحدث. ثم تترى الأمثلة في عصور مختلفة؛ منها العصر الحديث حيث سعى كتاب من أوربا الشرقية لتمرير أفكار ومعتقدات وآراء غير مسموح بها بأساليب ملتوية؛ لكي يفلتوا من عين الرقيب الحكومي الشرس في بلدانهم.
نظرية شتراوس هذه انطلق منها باحث أميركي في كتاب أصدره مؤخرًا بعنوان «الفلسفة بين السطور» (2014م) مضيفًا عنوانًا جانبيًّا هو: «التاريخ المفقود للكتابة الإيزوتيريكية». المؤلف آرثر ميلتزر (Melzer) أستاذ فلسفة في قسم العلوم السياسية بجامعة ميتشغان ستيت الأميركية وكتابه إنجاز بحثي لافت يقع في 450 صفحة، ويبحر بالقارئ عبر عصور الفلسفة منذ العصر اليوناني حتى أواخر القرن الثامن عشر، وهذه حقبة طويلة اتسمت كما يقول ميلتزر بسيطرة نوع من الكتابة المزدوجة في التأليف الفلسفي يشير إليها بالكتابة الإيزوتيريكية (esoteric)، وكذلك بالفلسفة بين الأسطر. الإيزوتيريكية صفة لكل معرفة أو معتقدات مقتصرة على فئة محدودة من الناس؛ أي المعرفة المحاطة برموز أو دلالات لا يصل إليها إلا أهلها من الخاصة أو المختصين، وتقابلها المعرفة الإكزوتيريكية (exoteric) التي تشير إلى المعرفة المشاعة أو الواضحة. يقول ميلتزر ما سبق أن قاله شتراوس، وهو أن أهل الفلسفة ظلوا لقرون يكتبون بطريقتين؛ إحداهما إيزوتيريكية أو مقتصرة على القلة، أي ما سبق أن سماه بعض المؤلفين القدامى «المظنون به على غير أهله»، والأخرى إكزوتيريكية، أي مشاعة يفهمها الجميع. ويستشهد المؤلف في هذا السياق بعبارة للشاعر والكاتب الألماني المعروف غوته وردت في إحدى رسائله عام 1811م عبر فيها عن اعتقاده بأن شرًّا قد حل بالناس في النصف الأخير من القرن السابق، أي الثامن عشر، حين لم يعودوا يميزون بين المعرفة الإيزوتيريكية والإكزوتيريكية.
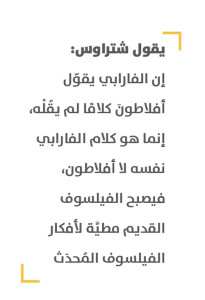 الغموض دفعًا للضرر
الغموض دفعًا للضرر
يميز ميلتزر بين أربعة أنواع من الكتابة الإيزوتيريكية. يتضمن النوع الأول الكتابة التي يختار فيها الكاتب – الفيلسوف الغموض دفعًا للضرر الشخصي نتيجة عدم تقبل أفكاره واحتمال الإضرار به نتيجة لذلك، أو لحماية المجتمع نفسه، أي دفع الضرر العام بإخفاء حقائق معينة. ويسمى هذا النوع الإيزوتيريكية الدفاعية أو الوقائية. أما النوع الثاني فيتضمن الكتابة الغامضة بقصد تحقيق مصلحة قد تكون إصلاحًا سياسيًّا، أو تعليم نخبة من طالبي المعرفة، ويسمى هذا إيزوتيريكية سياسية أو تربوية. هذه الأنواع يبسطها المؤلف في عدد ضخم من الأمثلة التي تحملها نصوص تتعرض لتحليل ينفذ بنا إلى مجاهل دلالية لا تبدو لأول وهلة، أو لا تبدو لقارئ اعتاد على القراءة فوق السطور أو على السطور وليس ما بينها؛ أي اعتاد على الدلالة الواضحة المباشرة بعد أن تربى في بيئة تعليمية وثقافية تقول له: إن ما يقوله النص هو ما يظهر للقارئ، ولا شيء في الخفاء.
كتاب ميلتزر لا صلة له بالآراء السياسية لليو شتراوس أو بالمحافظين الجدد، لكن معرفة الخاصة وتحويلها إلى سلطة تنأى بهم عن العامة هي الجسر الذي يربط بين الإستراتيجية السياسية والرؤية الفلسفية المعرفية، الجسر الذي تعبره الفلسفة أحيانًا لتؤثر في الشأن العام من خلال مفكرين مثل شتراوس حديثًا، ومثل أفلاطون والفارابي قديمًا.



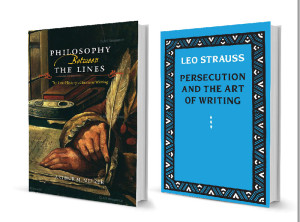 الفيلسوف الألماني ليو شتراوس معروف في الأوساط السياسية الغربية، سواء الدوائر الرسمية أو الأكاديمية المتصلة بالعلوم السياسية، بأنه منظّر ما عرف بتيار المحافظين الجدد؛ أي: السياسيون الذين اشتهروا في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بشكل خاص، وتولوا عدة مناصب مهمة ومؤثرة. وقد سمي أولئك بالمحافظين الجدد؛ لأنهم تبنوا أفكار شتراوس حول طبيعة النظام السياسي، وما ينبغي أن يكون عليه، وبشكل أكثر تحديدًا ضرورة أن يمارس النظام السياسي سياسات بعيدة عن أنظار الشارع فينأى عن اهتمامات الناس العاديين. أي أنه يجب أن تكون للساسة رؤيتهم وقراراتهم التي لا يستشيرون فيها العامة؛ لأن العامة لا تفهم في تلك الأمور، ولا ينبغي أن تستشار فيها. ومع أن هناك من ينفي عن شتراوس تبنيه لتلك الآراء، فإن المؤكد هو أن في كتاباته ما يشجع على ذلك النهج الذي اتبع فعلًا في أحداث كبرى شهدها العالم لعل أبرزها غزو العراق الذي تم بتضليل الرأي العام لتنفيذ «أجندة» رآها أولئك الساسة صحيحة وضرورية.
الفيلسوف الألماني ليو شتراوس معروف في الأوساط السياسية الغربية، سواء الدوائر الرسمية أو الأكاديمية المتصلة بالعلوم السياسية، بأنه منظّر ما عرف بتيار المحافظين الجدد؛ أي: السياسيون الذين اشتهروا في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بشكل خاص، وتولوا عدة مناصب مهمة ومؤثرة. وقد سمي أولئك بالمحافظين الجدد؛ لأنهم تبنوا أفكار شتراوس حول طبيعة النظام السياسي، وما ينبغي أن يكون عليه، وبشكل أكثر تحديدًا ضرورة أن يمارس النظام السياسي سياسات بعيدة عن أنظار الشارع فينأى عن اهتمامات الناس العاديين. أي أنه يجب أن تكون للساسة رؤيتهم وقراراتهم التي لا يستشيرون فيها العامة؛ لأن العامة لا تفهم في تلك الأمور، ولا ينبغي أن تستشار فيها. ومع أن هناك من ينفي عن شتراوس تبنيه لتلك الآراء، فإن المؤكد هو أن في كتاباته ما يشجع على ذلك النهج الذي اتبع فعلًا في أحداث كبرى شهدها العالم لعل أبرزها غزو العراق الذي تم بتضليل الرأي العام لتنفيذ «أجندة» رآها أولئك الساسة صحيحة وضرورية.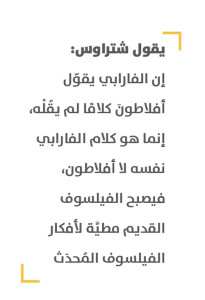 الغموض دفعًا للضرر
الغموض دفعًا للضرر