
سعد البازعي - ناقد سعودي | سبتمبر 1, 2023 | مقالات
النقد لون من ألوان الترجمة، والترجمة لون من ألوان النقد.
هذه العبارة هي ما سأحاول التفصيل فيها لإيضاح وجوه صحتها. مع أن العبارة اختصار لما قلته في مواضع أخرى وتختصر كثيرًا مما حاولت وحاول غيري إنجازه عند تناول النصوص الأدبية وغير الأدبية من فلسفية وثقافية عامة وغيرها.
قبل الدخول في تفاصيل العبارة أرى أن البدء ينبغي أن يكون بالقراءة. القراءة بما هي محاولة للعبور إلى النصوص، عبور القارئ إلى ما يحمله النص. حين نفتح كتابًا أو نشرع في قراءة نص ما فإننا نبدأ رحلة باتجاه ما يعدنا به ذلك النص، تمامًا كما يحدث حين ندلف إلى مبنى أو حين نفتح حوارًا مع أحد. القراءة والحوار مساعٍ للعبور نحو النصوص أو الذوات المحيطة بنا. الناقد الفرنسي جورج بوليه يقول: إننا حين نمد أيدينا إلى كتاب في الرف فإننا كمن يوقظ روحًا غافية لنحاورها.
النص الأدبي كحاجة جمالية
الحوار هو المحك وبيت القصيد، هو مدار القراءة النقدية ومدار الترجمة أيضًا. والترجمة الأدبية لون من الحوار مع النص، الحوار الذي يحدث على مستوى مختلف أو بطريقة مغايرة للحوار الذي ينشأ مع النص غير المترجم، النص الذي نشترك معه في لغة واحدة، لا نترجمه إلى لغة أخرى وإنما نستوعبه مباشرة، أو هكذا يفترض.
وقد يستغرب بعضٌ لو قلت: إن القراءة، أي قراءة، هي في نهاية المطاف لون من ألوان الترجمة. إننا نترجم الحروف والكلمات إلى دلالات ومشاعر، نحولها من صورتها المرسومة على الصفحة إلى ما يقابلها في أذهاننا من معانٍ وأحاسيس في عملية سيميائية أو استدلالية ننساها لشدة ألفتها وطابعها اللاواعي. وبهذا يكون كل قارئ مترجمًا بقدر ما أن كل مترجم قارئ.
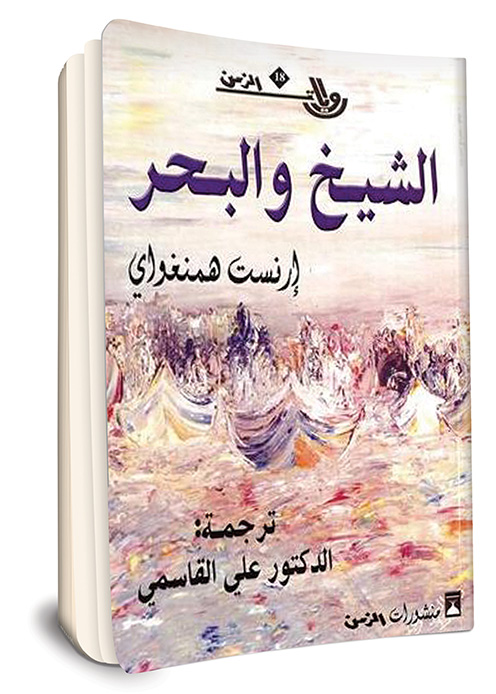 لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.
لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.
ولأضرب لذلك مثالًا: لو أن أحدًا قال لصديقه: كان الليل طويلًا ليلة البارحة ومملًّا وثقيلًا، أتاني بالهموم فلم أستطع النوم. كلام واضح لا يحتاج إلى إعمال الذهن؛ لأنه مباشر، كلام ذهب إلى الكلمات في دلالاتها الأساسية أو المألوفة. لكن لو أنه قال مثل امرئ القيس: «وليل كموج البحر أرخى سدوله/ عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي»؛ لأدرك القارئ أو السامع أنه ليس إزاء كلام مباشر مألوف. إنه كلام لا يقصد الإخبار فحسب، وإنما يقصد المتعة والجمال أيضًا. إنه كلام يتوسل المجاز أو اللغة المكثفة ليقول شيئًا ويحدث أثرًا يدرك قائله أن العبارة المباشرة لن تحدثه. لكن الفارق، بين الأدبي وغير الأدبي، ليس دائمًا بذلك الوضوح؛ ففي الشعر، ومنه معلقة امرئ القيس نفسها أبيات كثيرة لا تصعد إلى الكثافة التي رأينا في البيت السابق، ولا تستدعي من ثم مستوى موازيًا من القراءة النقدية التي تدقق في الدلالات والأبعاد المجازية. مطلع المعلقة المعروف جدًّا يقول: «قفا نبكِ من ذِكرى حبيب ومنزل…» إلى آخر البيت: هنا بداية لرسم مشهد شعري سيتنامى ويصل إلى مستويات عالية كالتي رأينا، لكن البداية نفسها ليست مكثفة: هي أقرب إلى التقرير لأن الخطاب شديد الوضوح. وكلما طال نص القصيدة تضاءلت مساحات التكثيف؛ لأن من الصعب أو المرهق للشاعر وللمتلقي معًا أن يظل النص على الوتيرة نفسها من الكثافة أو التصوير المجازي. لكن القصائد القصيرة تسمح بذلك الضغط سواء في الدلالة أو المجاز. من هنا قيل: إنه لا توجد قصيدة كلها شعر، وهو ما ينسحب على القصائد الطويلة ومنها قصائد كبار الشعراء والأعمال الملحمية في مختلف الثقافات من جلجامش والملاحم السنسكريتية إلى ملحمتَيْ هوميروس إلى الشعر العربي في عصوره العربية القديمة والحديثة إلى الشعر الغربي القديم والحديث وغيره.
من المباشر إلى المكثف والشعري
وما يحدث في الشعر يحدث في النثر، ومنه السرد. الرواية نص طويل ولغته مباشرة في الغالب، ما تتوخاه هو سرد الحكاية ورسم الأشخاص وإدارة الحوار توصيلًا لرؤية أو موقف أو فكرة ما، وهذا لا يستدعي لغة مجازية أو رمزية أو مكثفة. لكن الرواية نفسها تتخللها أحيانًا مقاطع أو لحظات من السرد نفسه تصعد إلى الشعر، وهناك أمثلة كثيرة لكن يصعب التوسع في الاستشهاد بها لكيلا يخرج هذا الحديث عن إطاره المعقول.
ومن الطبيعي أن تتأثر ترجمة الأدب بذلك التفاوت، فمترجم الأدب قارئ وناقد له بالضرورة. وليس من الضروري أن يكون النقد عملية مركبة من التحليل والحِجَاج والحكم. قد يكون النقد رؤية ضمنية تنطوي على تذوق ورؤية. وهذا ما أقصده حين أقول: إن الترجمة لون من النقد. أترجم النص الذي يهمني أو يعجبني وهذا بحد ذاته حكم نقدي، وإنْ كان في أبسط صوره. لكن الترجمة الأدبية لا يمكن أن تكون إلا مركبة، فازدواجية اللغة تعني ازدواجية الثقافة وتعني بالتبعية التفاوت في الفهم والاستدلال وفي التذوق أيضًا. ومع أن التفاوت ليس نهائيًّا أو عامًّا، بمعنى أن هناك كثيرًا من المشتركات التي لا تختلف فيها لغة أو ثقافة عن أخرى، فإن قدرًا لا بأس به من البِنَى اللغوية والمعايير الجمالية والمواضعات الاجتماعية والبيئية تختلف وتختلف معها إمكانيات النقل والاستيعاب ومستوى التفاعل أو نوعه.
وإذا كانت الترجمة بطبيعتها عملًا مركبًا، بغض النظر عن مستوى اللغة المترجم منها وإليها، فلنا أن نتخيل ما يحدث حين تصعد اللغة المترجم منها من المباشر إلى المكثف أو الشعري سواء كان المترجَم عملًا شعريًّا أو غير ذلك. ستتضاعف تركيبية الترجمة عندئذٍ وتتضاعف الصعوبة معها. لكن الترجمة يمكن أن تكون أيضًا وسيلة لاكتناه النص، أي قراءة نقدية له تساعد على تبين الدلالات والجماليات خلف كثافة اللغة وغرابة المفردات والتراكيب. وأضرب مثالًا من تجربتي الخاصة.
في المراحل الأولى من دراستي لأدب اللغة الإنجليزية وجدت صعوبة في منافسة الطلاب الأميركيين في تناول أدب كتب بلغتهم. اكتشفت في ترجمة النص إلى العربية وسيلة للوصول إلى جوانب دلالية وأحيانًا جمالية يصعب على القراءة المباشرة الوصول إليها. كان تمرير النص الأجنبي على مناظير اللغة العربية وسيلة لاكتشاف ما يصعب اكتشافه دون ترجمة. ومع أن الهدف لم يكن عندئذٍ التوصل إلى رؤية نقدية حول دور الترجمة في القراءة النقدية، وإنما كان المنافسة الطلابية المعهودة، فإنني الآن إذ أعود إلى تلك الوسيلة أرى أنها كانت مبررة ومثمرة، كأن النص يفتح مغاليقَ له لم تكن لِتنفتحَ لو ظل بلا ترجمة. فحين نتخلى قليلًا عما ألفنا من لغة وأساليب عيش في بيئة غير بيئتنا التي اعتدنا نكتشف أنفسنا من زاوية جديدة مغايرة. ومع أن ما قد نكتشفه ليس رائعًا بالضرورة إلا أنه مختلف على أية حال.
الاقتراب من النص من بعيد
وإذا كانت النصوص الأدبية بطبيعتها ابنة ثقافتها والأكثر إخلاصًا للثقافة من النصوص الأخرى كالعلمية وغيرها، من حيث هي ملتحمة بالموروث ومؤسسة على التصورات الفردية المنبعثة من تفاعل الإنسان مع بيئته، فإن ترجمة تلك النصوص سبب آخر لاكتشاف الجوانب التي يصعب تبيّنها بلا ترجمة، أو التي تكون الترجمة عاملًا مساعدًا على اكتشافها.
في إحدى أشهر قصائده التي كتبها في شكل السونيته، يقارن شكسبير بين المحبوب ويوم من أيام الصيف قائلًا: «هل أشبهك بيوم صيف؟ أنت أجمل وأكثر هدوءًا». ذلك التشبيه يصعب تصوره في قصيدة عربية؛ لأن الشاعر العربي يعرف أن الحبيب سيغضب لذلك التشبيه الذي يجعله ملتهبًا لا يطاق. الصيف الإنجليزي هو ما تغنى به الشعراء الإنجليز من شكسبير نفسه إلى كيتس في العصر الرومانسي إلى أودن في القرن العشرين. لكنه بالتأكيد ليس ما نجد في الشعر العربي أو شعر الصحراء عامة. إنه التحام بالبيئة يتكرر في استعمال الرموز والأساطير والحكايات التاريخية التي تحدّ من قدرة الترجمة وقدرة أهل البيئات المغايرة على التفاعل مع النص، أو تلون تفاعلهم بطرق لم يتوقعها الشعراء والكتاب.
في الترجمة تتجلى تلك الإشكاليات الأدبية بصورة واضحة. وكلما زاد التحام النص بخلفيته الثقافية أو ازدادت كثافته المجازية كلما ازدادت صعوبة الترجمة، واضطر المترجم إلى البحث عن بدائل تقترب من النص وإنْ مِن بُعْد. الترجمات الناجحة أو المتميزة عند أكثر القراء هي تلك التي تنسيك أنها ترجمة، أي التي تجعل النص كما لو كان قد كُتب بلغة القارئ نفسه. لكن من يستمتعون بتلك الترجمات لا يدرون في الغالب عن الثمن الذي دُفع لكي يصل النص إليهم بتلك الصورة. ما يحدث هو أن النص أعيدت كتابته من زاوية اللغة المترجم إليها، فبدلت الإحالات الغريبة وأزيلت أو خففت المجازات المعقدة.
نماذج تطبيقية
سأضرب مثالًا بثلاثة أعمال مترجمة؛ أحدها من الشعر، والآخران من السرد. العمل الشعري هو قصيدة عمر الخيام «الرباعيات» التي يرى بعضٌ، أو كثيرٌ ربما، أن أنجح ترجماتها هي تلك التي توارى فيها الأصل وحَلَّت مَحَلَّه قصيدةٌ عربية جديدة. ذلك ما سعى إليه الشاعر والمترجم العراقي أحمد الصافي النجفي، مثلما سعى أيضًا الشاعران المصريان أحمد رامي وأحمد زكي أبو شادي. ومع ذلك فإن بعض العارفين بالنص الفارسي يُثنون على ترجمة النجفي من حيث إنها أقرب إلى الأصل من معظم الترجمات الأخرى. لكن من المهم أيضًا أن كل الترجمات كانت نتاج قراءة نقدية للعمل، قراءة أفضت ابتداءً إلى اختيار النص للترجمة، أي الإعجاب به والقناعة بجدارته بالنقل إلى العربية.

جوخة الحارثي
يقول النجفي: إنه قرأ الرباعيات بترجمة اللبناني وديع البستاني، وتركت أثرًا عميقًا فيه، فقرر تعلم الفارسية ودراسة الأدب الفارسي بُغْيةَ «النفوذ إلى معانيه الدقيقة ومراميه السامية لأصل منها إلى الينبوع الصافي الذي سالت منه خيالات عمر الخيام الشاعر الذي شغفت به من دون باقي شعراء الفرس». بل إن النجفي يذهب أبعد من ذلك إلى شرح كيف كان ينتقي الرباعيات. يقول: إنه سعى إلى «تقريب التعريب بقدر الطاقة من الذوق العربي، وكان ذلك يلجئني أحيانًا إلى أن أفرغ الرباعية الواحدة في أكثر من عشرين سبكًا حتى أختار منها السبك الوافي بأداء المعنى والمطابق للذوق العربي…»، وإلى جانب ذلك الانتقاء النقدي بطبيعته نجد النجفي حريصًا في مقدمته لما أسماه تعريب الرباعيات، ومن باب الأمانة، على إخبارنا أن «هناك رباعيات جميلة لم أستطع مع إفراغ الجهد أن أبرز معانيها المهمة كاملة في الترجمة مع الموافقة للذوق العربي فنكبت عن ترجمتها معترفًا بعجزي وقصوري» (رباعيات عمر الخيام، تعريب السيد أحمد الصافي النجفي، د. ت. ص5، 7).
المثال السردي استمده من ترجمة إحدى أشهر الروايات في الأدب الأميركي: «الشيخ والبحر» لهمنغواي. لقد ترجمت هذه الرواية مرات عدة، أشهرها وربما أقدمها ترجمة منير البعلبكي التي صدرت عام 1958م. من المسائل التي طرحت في ترجمة رائعة همنغواي الجزء الأول من عنوانها: The Old Man، هل الأنسب ترجمة old man إلى الشيخ، كما في بعض الترجمات أو إلى العجوز، كما في ترجمات أخرى. والعنوان، كما يقول لنا نقاد السرد، هو العتبة الأولى التي ندلف منها إلى النص، ما يجعله بالتالي حاكمًا إلى حد مهم لقراءتنا للنص، فمنه تنشأ توقعات وتولد دلالات. ثلاث ترجمات، كما تخبرنا إحدى الباحثات، اختارت «العجوز» (العجوز والبحر)، في حين اختار علي القاسمي في ترجمة حديثة للرواية كلمة «الشيخ»، التي سبق أن اختارها البعلبكي. تقول الباحثة فتحية تمزارتي: إن القاسمي برر رفضه لكلمة «عجوز»؛ لأن تلك الكلمة «مشتقة من »العَجْز«؛ أي: عدم القدرة على العمل، في حين أنَّ الغاية الأساسية من قصة همنغواي هي تصوير نضال الإنسان المستمر، وكفاحه المتواصل وعمله الدائم من أجل التحكم في الطبيعة وترقية مستوى الحياة». هنا رؤية نقدية واضحة وحاكمة للاختيار الترجمي. ولا شك أن ثنايا الرواية مليئة بأمثالها من الاختيارات، وإنْ لم تكن بالمستوى ذاته من الوضوح.
المثال الثاني والأخير أجده في ترجمة معاكسة، أي من العربية إلى الإنجليزية. وهي رواية عربية حديثة (2010) ومترجمتها بريطانية. إنها رواية الكاتبة العمانية جوخة الحارثي «سيدات القمر» التي فازت عام 2019م بجائزة مان بوكر الدولية للترجمة. إشكالية النقل بدأت، كما هي الحال في رواية همنغواي، بالعنوان. قررت المترجمة، كما ذكرت الناشرة في إحدى المناسبات، أن الترجمة الحرفية للعنوان العربي سيقود القارئ إلى دلالة غير مناسبة؛ لأن «سيدات القمر» في الثقافة الأنغلوسكسونية لسن سيدات وإنما بائعات هوى؛ لذا استبدلت «أجرام سماوية» بالعنوان الأصلي، ليكون العنوان: Celestial Bodies. لكن هذا التعديل النقدي لم يتوقف عند العنوان وإنما شمل وضع عناوين لفصول الرواية التي لم تحمل عناوين في نصها العربي. كما تضمن إضافة شجرة نسب لشخوص الرواية، فضلًا عن أن المترجمة اقترحت حذف الفصل الأخير لولا أن الكاتبة اعترضت على ذلك. واعتراض المترجمة كان لضبابية ذلك الفصل وانتهاء الرواية بنهاية غير واضحة. كل تلك وغيرها في ثنايا النص ملحوظات نقدية تصب في صلب عملية الترجمة التي يتضح المرة تلو الأخرى أنها عملية نقدية أيضًا.
ولعلي بهذا أكون قد وضحت صحة العبارة التي ابتدأت بها: النقد لون من ألوان الترجمة، والترجمة لون من ألوان النقد.

سعد البازعي - ناقد سعودي | نوفمبر 1, 2022 | مقالات
في نهاية التسعينيات من القرن الماضي نشر أحد الباحثين اليابانيين كتابًا يقارن فيه بين مفهوم الحب في الثقافات الغربية وما يقابله في الثقافة اليابانية. منطلقه، في كتاب بعنوان «دون جوان شرق وغرب» (نيويورك، 1998م)، كان المواجهة التي حدثت بفعل الترجمة بين اللغة اليابانية من ناحية واللغات الأوربية من ناحية أخرى، وذلك عند وصف العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين الجنسين، الذكر والأنثى، هل يمكن وصفها بالحب أو بشيء آخر؟
المثقفون اليابانيون، الذين بدؤوا يقرؤون الآداب الغربية في عصر الميجي (1869- 1912م) كما يقول الباحث، واجهوا مشكلة أمام مفهوم الحب من حيث هو وصف تلك العلاقة: «…المساواة بين العاشقين أو الزوجين، الذكر والأنثى، التي يصفها الخطاب الأدبي الغربي، كانت في الغالب عصية على الفهم لدى مثقفي الميجي». في الثقافة اليابانية التقليدية ليست تلك العلاقة مما يمكن وصفه بالحب؛ لأن الأمر ببساطة هو أن الرجل غير مساوٍ للمرأة، الزوجة بصفة خاصة، ولذا لا تسمى العلاقة التي تنشأ بينهما «حبًّا»، بما يتضمنه مفهوم الحب في الاستعمال الغربي من تساوٍ بين طرفي العلاقة. ويزداد التعقيد في تلك المسألة المفاهيمية حين توصف العلاقة بين المحبين بالصداقة ليصير العاشق والعاشقة صديقين، فتنطوي العلاقة على حب واحترام في الوقت نفسه وهو ما يتنافى مرة أخرى مع طبيعة العلاقة بين الجنسين في الثقافة اليابانية السابقة لعصر الميجي.
كسر النموذج السائد
هذه الفجوة الدلالية التي حللها الباحث الياباني لا تختلف في جوهرها عن تلك التي وجد فيها خورخي بورخيس مرتعًا خصبًا لاستكشاف ضبابية المعرفة وما يكتنفها من التباسات الدلالة وتأزم المفاهيم، وذلك في القصة المعروفة التي نسجها حول ابن رشد وبحثه المستحيل عن دلالات في العربية تقابل المأساة والملهاة لدى أرسطو وقراره بجعل «المديح والهجاء» مقابلين لذلكما النوعين من الفنون المسرحية (المعروف تاريخيًّا أن متى بن يونس هو من قام بتلك الترجمة). وكان يمكن للكاتب الأرجنتيني أن يضرب مثالًا آخر بالمستشرق الإنجليزي السير وليم جونز حين بحث في المصطلحات الأدبية الإنجليزية وموروثها الكلاسيكي عن مقابل لمفهوم «المعلقة» في الشعر العربي ضمن ترجمته لسبع من المعلقات أواخر القرن الثامن عشر. لم يجد جونز مقابلًا أفضل من مصطلح «أود Ode» أي القصيدة الغنائية لدى اليونانيين والرومان لينطلق من ذلك داعيًا إلى اعتبار الشعر العربي منافسًا للشعر الكلاسيكي الأوربي ومتنفسًا لآداب أوربا خارج سياقاتها الثقافية التقليدية.
رأى جونز أنه عبر التفاعل مع الآخر ستجد أوربا مخرجًا مما عده أزمة ناجمة عن الوقوع في أسر النموذج اليوناني الروماني، النموذج الكلاسيكي، الذي قادها إليه المذهب الاتباعي حين ساد الآداب الأوربية في القرن الثامن عشر. ومع أن أوربا لم تنفتح بشكل واسع على ما تعرفت إليه في الثقافات غير الأوربية، أي لم تتخلَّ عن الخطوط الأساسية لهويتها الحضارية، فقد أدى اكتشاف ما لدى الآخر إلى التخفف من هيمنة الخصوصية مثلما كان ذلك التعرف ناتجًا من تأزم داخلي أو حالة اختناق استدعت كسر النموذج السائد وفتح نوافذ على المختلف.
كان ذلك الكسر وفتح النوافذ هو ما حدث للثقافة اليابانية، كما يحدثنا الباحث الياباني المشار إليه آنفًا، وما حدث كذلك للثقافة العربية وثقافات أخرى اتصلت بالآخر، سواء كان اليوناني قديمًا أو الغربي حديثًا، فيما عرف بعصر النهضة حين اجتاحت تلك الثقافة مصطلحات ومفاهيم وتيارات وفلسفات غربية كثيرة، بدلت ملامح الثقافات على نحو اختلف كثيرًا في حجمه واندفاعه عن تلك التي اتسم بها بحث الغرب عن بدائل لدى الثقافات الأخرى في حقب تاريخية سابقة. وهو بالطبع ما لا يزال يحدث لثقافات العالم غير الغربي. ففي الثقافات غير الغربية، ومنها الثقافة العربية، كان التدفق الثقافي بألوانه المختلفة قدرًا لا مفر منه، هيمنة واجتياحًا أكثر مما كان احتياجًا وسعيًا نحو الجديد المجدد.
يقول الفيلسوف الفرنسي إدغار موران حول العولمة: إنها «عملية قد بدأت منذ قرون مع غزو الأميركتين ثم غزو العالم على يد الغرب»، ثم يشير إلى التسعينيات بوصفها المرحلة التي شهدت «عولمة تقنية واقتصادية متسارعة» منتهيًا إلى أن ما يصفه هو «أزمة المجتمعات التقليدية الواقعة تحت وطأة التغريب»، لكنها أيضًا أزمة يعيشها الغرب نفسه، حسب موران، فهي «الأزمة التي يواجهها الغرب ذاته، فالغرب يقدم إلى بقية الكوكب ما يشكل مشكلة لديه!». فما المقصود بالأزمة إذًا؟ يقول موران: «يحمل مفهوم الأزمة داخله اختلال التوازن وغياب اليقين» وهي إلى جانب ذلك «تتمظهر في الإخفاق في ضبط نظام الكبح أو كبت الانحرافات… للحفاظ على الاستقرار…» («في مفهوم الأزمة»، لندن: دار الساقي، 2018م).
وجوه الأزمة
تمظهر الأزمة في غياب اليقين هو ما نطالعه أيضًا في كتاب مشترك للمفكرين البولندي زيغمونت باومان والإيطالي كارلو بوردوني في كتابهما «حالة تأزم» (كمبريدج، 2016م) الذي يتفحص وضع الحضارة الغربية في ثلاثة من وجوه التأزم: تأزم الدولة، تأزم الحداثة، وتأزم الديمقراطية. كل تلك الوجوه تعيش تأزمًا. يقول باومان معرفًا ذلك التأزم أو الأزمة: «عند الحديث عن الأزمة مهما كانت طبيعتها… نعبّر أولًا عن شعور بالحيرة، شعور بالجهل تجاه الوجهة التي توشك الأمور أن تسير باتجاهها- وثانيًا الرغبة في التدخل: اختيار الإجراءات الصحيحة وتقرير تطبيقها بشكل صحيح». المظاهر الثلاثة التي تتضح فيها الأزمة لدى باومان وبوردوني تغيب عنها الجوانب الفكرية والثقافية، تمامًا كما هو الحال عند المفكر الفرنسي موران. لكن باومان في مواضع أخرى من دراساته معني بجوانب من الثقافة تتضح فيها العولمة من حيث هي مصدر للتأزم، العولمة بوصفها سيولة وتدفق للأنماط السلوكية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، كالاستهلاك والممارسات الاجتماعية الأخلاقية إلى غير ذلك. لكن العولمة لا تشمل، سواء عند موران أو باومان، تحول ما لديهما ولدى غيرهما من المفكرين والعلماء من فلسفات ونظريات ومناهج ومفاهيم إلى قوالب فكرية ومناهج جاهزة للتحليل في ثقافات أخرى.
حقيقة الأمر هي أن عولمة أخرى، عولمة فكر وثقافة وعلوم، هي أيضًا جزء من التدفق المعرفي أو الحضاري الغربي، الأوربي الأميركي. تلك العولمة لا ينبغي أن نتوقع من موران أو باومان أو فوكو أو غيرهم من مفكري الغرب أن يتوقفوا عندها طويلًا، وإنما أن يتوقف عندها من تمس تلك العولمة ثقافتهم ونتاجهم الفكري والنقدي والأدبي مسًّا مباشرًا ومؤثرًا. النقد ما بعد الاستعماري، ابتداء من إدوارد سعيد وهومي بابا وغاياتري سبيفاك ونغوجي وا ثيونغو وآخرين، نهض على ذلك الأساس أو ما يشبهه.
يقول الناقد الهندي عامر مفتي في دراسة لمفهوم العالمية في الأدب والإشكالية المعرفية والثقافية التي تنشأ نتيجة لمفهوم الأدب العالمي: «المفاهيم والأنواع ذات الأصل الأوربي تقع في قلب الأدب بوصفها «فضاء» أو حقيقة…» («الاستشراق وآداب العالم»، هارفارد، 2016م)، وما يقصده مفتي هنا هو الأدب من حيث هو أدب بغض النظر عن المكان الذي نشأ فيه أو ينتمي إليه. الأدب، كل الأدب، بات من الصعب التفكير حوله، أي تناوله بالقراءة أو الدرس، دون معطيات مفاهيمية غربية تجعل غير الغربي يفكر كما لو أنه غربي، يرى العالم كما يراه الفرنسي أو الأميركي. تصير المفاهيم المستوردة مثل اليورو أو الدولار في الشيوع وفي السيطرة على الاقتصاد، ولتنشأ من ذلك فجوات دلالية لا حصر لها.
هامش:
(١) جزء من مشروع بحثي حول أزمة المفاهيم.

سعد البازعي - ناقد سعودي | سبتمبر 1, 2022 | مقالات
قصيدة الشاعر الأيرلندي وليام ييتس (1865-1939م) «حجر اللازورد» Lapis Lazuli ترسم رؤية لطبيعة الفن ودوره، ماهيته وأثره، ما الذي يكون به الفن فنًّا، سواء كان شعرًا أو مسرحًا أو نقشًا على حجر؟ وهذا لون من التأمل يشيع في الشعر الغربي الحديث، وهو في الوقت نفسه لون أثير لدى ييتس نفسه. نجده في قصائد كثيرة، لعل أشهرها قصيدته «الإبحار إلى بيزنطة»، حيث تمْثُل المدينة العتيقة، ممثلة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، أو القسطنطينية، بوصفها مدينة اتصفت بتعالق الفنون والثقافات، وتألقت بعمارتها وفنونها المختلفة. ذلك التعالق والتألق يتكرر في «حجر اللازورد». فالقصيدة، كما ذكر الشاعر الأيرلندي نفسه، استدعاها النظر في نقوش على حجر من اللازورد، وهو حجر كريم، أهدي إليه، وفي النقوش مشهد لحكماء صينيين يقفون على قمة جبل ويتأملون ما تحتهم.
جوهر الفن في واقع متغير
لكن قصيدة ييتس كتبت في ظل ظروف تاريخية مأساوية هي الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من عنف ودمار. كان السؤال الملح حينها: ما دور الفن في ظروف كتلك؟ الفن متهم باللاجدوى واللامعنى وعدم الاكتراث في وقت تساقط فيه القنابل ويموت الناس. ذلك ما يراه، حسب ييتس، من لا يدرك معنى الفن فينظر إليه من زاوية عملية أو شديدة الواقعية، أي الزاوية التي تنتظر من الفن والفنان أن يكونا عمليين بحيث يتحولان إلى انعكاس مباشر لما يحدث فيعلقان عليه ويتدخلان في مجرياته.
ينسب ييتس تلك الرؤية لمجموعة من «النساء الهستيريات»، في موقف سيراه بعض منا اليوم موقفًا ذكوريًّا متحيزًا ضد المرأة. لكن بغض النظر عن ذلك الموقف وما يستدعي من قراءة مختلفة، سيتضح لنا أن القصيدة مرافعة متصلة عن أهمية الفن في حياة الإنسان وحياة الحضارة أيضًا. فلكي يكون الفن فنًّا، حسب الشاعر، عليه أن يخلص لهويته، لطبيعته، لكونه فنًّا، فلا يتماهى مع متغيرات الحياة والأحداث. لكن ذلك لا يعني عدم الاكتراث، وإنما العكس، فالفن ينهض على الوعي بالمأساة مثلما ينهض على الوعي بنقيضها، الملهاة، فهو واعٍ بالدمار وباحتمالاته، لكنه مضطر لكي يكون ذاته، لكي يحقق جوهره، أن يتجاهل المتغير، فتستمر المسرحية الشكسبيرية:
كلهم يقومون بدورهم المأساوي، /هناك يتبختر هاملت، وهنا لير،/ وتلك أوفيليا، وتلك كورديليا؛
ومع ذلك، فحين يأتي المشهد الأخير،/ وتكون الستارة في المسرح الكبير على وشك الإغلاق،/
إذا كانوا جديرين بأدوارهم البارزة في المسرحية،/ فإنهم لا يقطعون نصوصهم ليبكوا./ يعرفون أن هاملت ولير مبتهجان؛/ البهجة تغير كل ذلك الرعب.
البهجة هي جوهر الفن، وهي لا تعني ابتهاجًا بما يحدث وإنما مقابلة ما يحدث بثقة بأن الفن يتجاوز كل ذلك، يخلد على الرغم من كل المآسي. والأمثلة كثيرة في تاريخ الحضارات وفنونها. وينسحب ذلك على ما يراه الشاعر محفورًا على حجر اللازورد، فالصينيون المرسومون عليه ناجون من دمار محتمل، مع أن من حفر أشكالهم فني في الدمار. فناء الفنان لم يحل دون ممارسته لإبداعه بابتهاج الفنان وقبوله لمصيره المحتوم. لكن ييتس لا ينسى أن يضم نفسه إلى المشهد الفني المبتهج، فهو يختتم القصيدة بتخيل ما يشاهده على حجر اللازورد، ممارسًا بذلك عملية إبداعية تذكر القارئ بأنه هو الآخر فنان مبدع يحتفي بالفن ببهجة لا تكدرها احتمالات الدمار القائمة نتيجة للحرب:
ويبهجني/ أن أتخيلهم جالسين هناك؛/ هناك، على الجبل والسماء،/ على كل المشهد المأساوي الذي يحدقون فيه.
إنه يواجه تلك الاحتمالات لكن لا كما تواجهها «النساء الهستيريات» أو غيرهن بهستيريا مماثلة، وإنما ببهجة هي روح الفن وأسباب بقائه. التلقي المبدع والمبتهج للفن هو فن آخر أيضًا.
حجر اللازورد – وليام ييتس
سمعت أن النساء الهستيريات يقلن/ إنهن قد مللن من لوح الألوان وقوس الكمان،/ من الشعراء المبتهجين باستمرار،/ لأن الجميع يعلمون أو يجب أن يعلموا/ أنه إن لم يُفعل شيء حاسم/ فإن الطائرات والمناطيد ستأتي،/ تلقي بقنابل الملك وليم/ حتى تترك المدينة كلها مسوّاة بالأرض./
كلهم يقومون بدورهم المأساوي،/ هناك يتبختر هاملت، وهنا لير،/ وتلك أوفيليا، وتلك كورديليا؛/
ومع ذلك، فحين يأتي المشهد الأخير،/ وتكون الستارة في المسرح الكبير على وشك الإغلاق،/
إذا كانوا جديرين بأدوارهم البارزة في المسرحية،/ فإنهم لا يقطعون نصوصهم ليبكوا./ يعرفون أن هاملت ولير مبتهجان؛/ البهجة تغير كل ذلك الرعب./ كل الناس سعوا، كسبوا وخسروا؛/ انطفاء المشهد؛ تبرق السماء على الرؤوس:
تصل المأساة إلى أقصاها./ مع أن هاملت يتمتم ولير يزبد،/ وكل المشاهد النهائية تنتهي مرة/ واحدة/ على مئات الآلاف من المسارح،/ فإنها لا تزداد إنشًا ولا أونصة./ جاؤوا على أقدامهم، على السفن،/ على ظهور الجمال، ظهور الخيل، ظهور الحمير، وظهور البغال،/ حضارات تحاربت./ عندئذٍ اندثرت واندثرت حكمتها:
لم يبق عمل يدوي واحد من كاليماخوس/ الذي عالج الرخام كما لو كان برونزًا،/ صنع ستائر بدت كما لو أنها ترتفع/ حين تهب ريح البحر على الزاوية./ مداخن ضوئه الطويلة التي شكلها مثل جذع/ نخلة نحيلة، عاشت يومًا واحدًا فقط:
كل الأشياء تسقط وتبنى ثانية/ والذين يبنونها ثانية مبتهجون./ صينيان، خلفهما ثالث،/ منحوتان على حجر اللازورد،/ فوقهما يطير طائر طويل الساقين/ رمز لطول العمر؛/ والثالث، خادم دون شك،/ يحمل آلة موسيقية./ كل خدش على الحجر،/ كل حفر أو كدمة/ تبدو مجرى لماء أو انهيارًا لثلج،/ أو منحدرًا عاليًا حيث الثلج ما زال يسقط/ مع أن غصن كرز أو برقوق ما زال دون شك/
يحلّي البيت الصغير عند منتصف المسافة/ الذي يصعد الصينيون نحوه، ويبهجني/ أن أتخيلهم جالسين هناك؛ / هناك، على الجبل والسماء،/ على كل المشهد المأساوي الذي يحدقون فيه./
يطلب المرء أغاني حزينة؛/ تبدأ أصابع مرهفة بالعزف./ أعينهم بين التجاعيد الكثيرة، أعينهم،/
أعينهم الشائخة، اللماعة، مبتهجة.

سعد البازعي - ناقد سعودي | يوليو 1, 2022 | مقالات
مراجعة: ويل دن – محرر في مجلة نيو ستيتسمان
كتب إسحاق نيوتن لزميله العالم روبرت هوك عام 1675م يقول: «إن كنتُ رأيتُ أبعد مما رأيتَ فلقد كان ذلك لأنني وقفت على أكتاف عمالقة». هذه العبارة التي ينظر إليها على أنها أعظم عبارة علمية نملكها، فقد تكون نكتة ساخرة: كان هوك، المنافس الذي ادعى أن الفضل يعود إليه في اكتشافات نيوتن والذي كرهه نيوتن كراهية عميقة، رجلًا قصيرًا.
لكن كان من الصحيح أيضًا أن نيوتن استعان بأناس ظلوا متوارين. ويصدق ذلك أيضًا على التمويل الذي حصل عليه: كان نيوتن مستثمرًا في تجارة الرقيق. اشترى الآلاف من الأسهم في شركة البحار الجنوبية، التي كان مشروعها الرئيس نقل الناس من إفريقيا إلى أميركا. استثمر نيوتن في هذه التجارة على مدى يزيد على العقد من السنين وحصل على فوائد كبيرة (فوائد ما لبث أن فقدها في انهيار عام 1720م).
ليس بوسع الفن أن يوجد من دون مبدعه، بغض النظر عما فكر به أو فعله ذلك المبدع. غير أن المعرفة –ولا سيما القوانين الطبيعية في الفيزياء والرياضيات– تُكتشف اكتشافًا. لِمَ إذًا توسم بحياة ومعتقدات الأفراد الذين اكتشفوها؟ يقول المؤرخ جيسم بوسكِت Poskett في كتابه «آفاق»، الذي يروي قصة الجذور العالمية للعلم الحديث: إن هناك أسبابًا عدة مقنعة وراء ذلك. الدعوة إلى «إلغاء الاستعمار» عمن وقع عليهم بالاعتراف بسياقاتهم الثقافية يراها بعضهم دعوة مسيسة ولا حاجة إليها، لكن بوسكت يجادل في أن العلم كان مسيسًا أصلًا.
يقول: إن القول بأن الثورات العلمية محصورة في عبقرية الأوربيين الذكور –نيوتن، دارون، كوبرنيكس، غاليليو، آينشتاين– هو مشروع سياسي هدفه فرض فكرة أن الناس الذي يدعمون نظامًا محددًا من الحكم، أو يعيشون على جانب معين من الحدود، هم أشد حبًّا في الاستطلاع، وأكثر إبداعًا وقدرة من الآخرين.
لم تحدث الثورات العلمية على مدى القرون الأربعة الماضية فقط بصورة متزامنة مع الصراعات السياسية والدينية، وأعمال الغزو والاستعباد، وإنما كانت بسبب تلك الأحداث. فَهْمُ نيوتن للميكانيكا الفلكية لم يقفز إلى ذهنه عند سقوط تفاحة، وإنما صار فهمًا ممكنًا نتيجة لتوسع عالم الإمبراطورية. رحالة مثل الفلكي الفرنسي جان ريشير حملته سفن تتبع لشركات تجارة الرقيق إلى أراضٍ «جديدة»، وهناك استكشفوا السماء وحركة البندولات التي اعتمد عليها نيوتن –الذي لم يغادر إنجلترا– في بناء نظرياته. ويصدق ذلك على الارتقاء، وهو نظرية لم تكن مجرد نظرية توصل إليها تشارلز دارون، وإنما تشكلت عبر عقود على أيدي علماء في أنحاء مختلفة من العالم، يربطها بوسكت بتقلبات موازين القوى العالمية، مثل انحدار الإمبراطورية الإسبانية في أميركا الجنوبية، وتوسع الإمبراطورية الروسية في وسط أوربا.
مثلما اعترف نيوتن بأن «العالم كله يعلم أنني لا أتوصل إلى أية آراء بنفسي» –اعترف دارون أنه يستخلص النتائج بناءً على عمل أنجز في أنحاء مختلفة من العالم. في كتابه «أصل الأنواع» (1859م) كتب دارون يقول: «أجد مبدأ الانتقاء بصورة واضحة في موسوعة صينية قديمة». وكذلك كوبرنيكس الذي استشهد بفلكيين مسلمين كانت أعمالهم تأسيسية للنموذج الشمسي المركز للكون الذي وصفه في كتاب «حول دورات المدارات السماوية» (1543م). إن العبقري المستقل اختراع حديث.
أي هدف تحققه هذه الأسطورة؟ لقد كان العلم دائمًا أداة للقوة –كما يقول بوسكت، قد تكون للقدرة على صناعة تقويم أو فهم التكوين الصيدلاني لنبتة آثار بعيدة المدى. في القرن العشرين اتضحت قوة العلم بصورة متزايدة، وذلك بتزايد قدرة المعرفة التقنية على صناعة المزيد من الأسلحة الفتاكة. بمجيء الحرب الباردة صار من الضروري التظاهر بأن هناك شيئًا اسمه العلم السوفييتي، أو أن العلم الإسلامي ينتمي إلى «عصر ذهبي» قديم، أو أن أوربا هي المكان الوحيد الذي حدثت فيه نهضة للمعرفة في القرن السابع عشر (حدثت تلك النهضة في كل مكان من تمبكتو إلى التبت، ولم يطلق مسمى «النهضة» إلا بعد مضي 200 عام على وفاة كل من كانت له علاقة به). إن الحقيقة أكثر تركيبية بكثير، وأكثر عالمية وتعددية، لكن الأسطورة أسهل على الفهم. قصة شجرة التفاح أسهل على الشرح من قانون المربع المقلوب.
لكن إذا كان العلم مقيدًا بتبجيل الماضي، فإن تلك ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. في العصور الوسطى كانت دراسة العلم أو الطب تعني قراءة نصوص الأقدمين باللاتينية واليونانية؛ كان كسر تلك التقاليد هو ما مكن من ظهور عصر اكتشافات جديد؛ لذا لا يكتسب حوار صادق حول تاريخ العلم أهمية أخلاقية فحسب، بل هو ما يجعل الاكتشاف ممكنًا.
المصدر : https://www.newstatesman.com/culture/books/book-of-the-day/2022/05/horizons-global-history-science-james-poskett-review

سعد البازعي - ناقد سعودي | مايو 1, 2022 | مقالات
عرفت اللغة العربية طوال تاريخها حركة تبادل كثيفة مع لغات أخرى في مجال المفاهيم أو المصطلحات المتعلقة بالأدب إبداعًا ودراسة. أعطت العربية للآخر كثيرًا، وأخذت منه كثيرًا أيضًا. غير أن المهم ليس أن نقول ذلك فهو معروف متداول في التاريخ الأدبي الذي كتب عنه الكثير. ما هو مهم أيضًا ولكنه ليس كثير التداول هو الجوانب الإشكالية أو المتأزمة من حركة التبادل تلك. في تلك الجوانب نقف على حقيقة أن العلاقات الثقافية بين اللغات والآداب لا تتسم دائمًا بالسهولة أو القبول، وأنها معرضة، تمامًا كالعلاقات السياسية والتجارية وغيرها من ألوان العلاقات، لضروب من التوتر، من القبول والرفض، ومن درجات من الوعي والاستيعاب تتفاوت بين الثقافات مثلما تتفاوت بين الجماعات والأفراد. المفاهيم، أو المفردات التي تكتسب بعدًا اصطلاحيًّا أو قدرًا من التركيب يجعلها حمولات ثقافية أشبه بالكبسولات الدلالية، تحمل تاريخًا من التداول الذي كثيرًا ما يعتريه الاضطراب والتوتر سواء شعر به من يتداوله أو لم يشعر، لكن الحري بالتحليل الثقافي أو التأريخ للغات والثقافات أن يقف عليه ويبرزه بغية فهم أفضل ووعي أكثر صحة ومسؤولية تجاه العلاقة بين تلك اللغات والثقافات.

جاك دريدا
في سبعينيات القرن الثامن عشر نشر المستشرق الإنجليزي وليم جونز، الذي يعد رائدًا للاستشراق الإنجليزي، مجموعة من القصائد المترجمة عما أسماه «اللغات الآسيوية» منها العربية والفارسية والهندية وقدمها من حيث هي أنموذج ثقافي وأدبي مغاير لما ألفته أوربا في تراثها اليوناني اللاتيني. كتب جونز قائلًا: «إن حقلًا جديدًا ووافرًا سينفتح للتأمل؛ ستكون لدينا رؤية معمقة لتاريخ العقل البشري، ستتكون لدينا مجموعة من الصور والتشبيهات، وعدد من النصوص الرائعة، التي قد يشرحها الباحثون ويحاكيها الشعراء مستقبلًا». «حول شعر الشعوب الشرقية» (1772م). وكان جونز في حماسته تلك يدرك أن ما يدعو إليه لن يلاقي القبول السهل أو الترحيب الواسع. ولم تكن هيمنة التراث اليوناني واللاتيني هي العقبة الوحيدة التي رآها مستشرق تبنى آداب الشرق. لقد كتب وفي ذهنه موقف أوربي تطغى عليه الاستعلائية تجاه الآخر أو في أفضل الحالات الجهل بقيمة ما لدى الشعوب والثقافات الأخرى.
فمقارنته لقصائد حافظ الشيرازي بسونيتات شكسبير أو «كتاب الملوك» للفردوسي بالإلياذة، أو ثناؤه على شعراء المعلقات العرب الكبار، كما رآهم هو، كان يواجه موقفًا متعاليًا كموقف فولتير تجاه ما أسماه الكاتب الفرنسي «الذائقة السيئة لدى الآسيويين»، أو كموقف المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون الذي وصف في كتابه الشهير «انحدار وسقوط الدولة الرومانية» حماسة جونز بحماسة الشباب وأنه بعد نضجه سيخفف من تلك الحماسة. ولم يكن فولتير وجيبون وحدهما بالطبع مَنِ اتخذا مواقف كتلك، بل إن موقفهما هو الشائع لدى العديد من مفكري وكتاب وشعراء أوربيين في أزمنة مختلفة تنتظم الشاعر الإيطالي بترارك في القرن الثالث عشر والإنجليزي فيتزجيرالد في القرن التاسع عشر. كما أن تلك المواقف لم تصدر دائمًا عن ترفع بالطريقة الفاقعة التي عبر بها فولتير تحديدًا. كان بعض تلك يصدر عن شعور بالاختلاف العميق وقناعة باستحالة تجسير الهوة بين الثقافات واللغات. وبين هذه وتلك كانت ثمة مواقف ترى العلاقات الثقافية من زاوية الصعوبة وليس الاستحالة وأن انتقال المفاهيم أو المصطلحات والنظريات وما يشبهها يحتاج إلى جهد من التبيئة المتضمنة تعديلًا وإعادة صياغة لكي يلائم الوافد ما هو محلي وقائم.
احتدام الجدل
في القرن العاشر الميلادي احتدم الجدال بين المشتغلين في حقل الترجمة وعلماء النحو العرب حول القبول بالمنطق كما تجلى ذلك في المناظرة الشهيرة التي رواها أبو حيان التوحيدي بين أبي سعيد السيرافي ومتى بن يونس، بين الأول رافضًا للعنصر الأجنبي والثاني متخذًا موقفًا يشبه موقف وليم جونز في أهمية القبول بما يتضمنه ذلك العنصر. قال السيرافي:
«ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم
عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها، من أين يلزم الترك، والهند،
والفرس، والعرب أن ينظروا فيه، ويتخذوه حكمًا لهم أو عليهم، وقاضيًا بينهم،
ما شهد له قبلوه، وما أنكره رفضوه؟».
لكن متى بن يونس نفسه حين ترجم كتاب «فن الشعر» لأرسطو وجد أن ثمة صعوبة فعلًا في نقل بعض المصطلحات اليونانية الأساسية مثل ما أسماه «المديح» و «الهجاء» اللذين اختارهما لترجمة «تراجيديا» و«كوميديا» على أساس أن الأدب العربي يخلو من ذلكما الفنين وأن الأقرب هو ما اختاره مقابلًا لهما. هذه المحاولة لتبيئة المفهوم المختلف هي ما استمر ويستمر في اللغة العربية وغيرها من اللغات، فالاختلاف قائم والمسعى قائم أيضًا بعيدًا من الرفض المتعنت أو القبول السهل. غير أن اللغات تتفاوت في جانبي الإرسال والاستقبال، بين لغات ترسل أكثر مما تستقبل وأخرى تستقبل أكثر مما ترسل، بل إن منها ما لا يكاد يرسل شيئًا يذكر. ولو نظرنا إلى الترجمة في عصرنا هذا لوجدنا فيها مرآة للتفاوت الكبير في تلك الحركة الدائبة، وأن ذلك ينعكس على مقدرة بعض اللغات، ومنها اللغة العربية، على استيعاب ما يتدفق عليها من مصطلحات ومفاهيم ومفردات في مختلف مجالات الحياة.
ما تعنيه الترجمة هو بالتأكيد توسيع المساحات الإدراكية والمعرفية في اللغة المترجم إليها؛ لأنها تخلق دلالات جديدة تضطر اللغات إلى استيعابها بكيفية وقدر ما. غير أن هذا الجانب البناء الذي يطغى عند الحديث عن أثر الترجمة يجاوره جانب آخر يتضمن تحديات يؤدي بعضها إلى مآزق أو إشكاليات وانشطارات في المرجعية الدلالية لبعض ما يتدفق ولا سيما على مستوى المصطلحات والمفاهيم. الجانب البناء يتضح في مفاهيم جديدة على اللغة والثقافة بمعناها الواسع. مفردات أو مفاهيم في مجال الأدب مثل «الرومانسية» و«السوريالية» و«الرمزية» التي كانت من بين المفردات/ المفاهيم التي دخلت العربية مع حركة الترجمة والتعرف إلى الآداب الأوربية في النصف الأول من القرن العشرين ولم يكن لأي منها مقابل دقيق في اللغة العربية أو في الإنتاج الأدبي بطبيعة الحال.
ولكن لو نظرنا إلى تلك المفاهيم لوجدنا أن اثنتين منها أجنبيتان لفظًا ومعنى هما الرومانسية والسوريالية، في حين أن الرمزية مفردة عربية في لفظها وإن لم يكن في دلالتها المفهومية أو المصطلحية. ومع أن مفردة رومانسية شديدة التركيب حتى في اللغات الأوربية فإن وجود جذر لغوي هو «رومانس» يعني أن لها أصلًا تنتمي إليه ويمكن تخفيف صعوبتها بالإحالة إلى ذلك الأصل. يقول الناقد العراقي عبدالواحد لؤلؤة الذي ترجم مقالة حول الرومانسية مشيرًا إلى مختلف المصطلحات التي ترجم ما يعرّف بها:
«ولأن هذه المصطلحات النقدية تحمل مفهومات أوربية ترجع إلى حضارة
الإغريق والرومان وما نشأ من آداب أوربية منذ عصر النهضة فإن ترجمتها
إلى العربية لا يمكن أن تتخذ صيغة نهائية تقف عندها، كما وقفت في الغالب
الصيغ الأوربية المشتقة عن الإغريقية واللاتينية. لذلك لا مفر من الاشتقاق
والنحت والتعريب إلى جانب الترجمة…».
كل هذه الأساليب لم تؤدّ بطبيعة الحال إلى وضع مقابل مختلف تمامًا مثل الذي اختاره متى بن يونس في القرن العاشر لمفردتي كوميديا وتراجيديا. لكن هذه المعالجات المتعددة والمرهقة بالتأكيد (الاشتقاق، النحت، التعريب، الترجمة) تؤكد الصعوبة التي واجهها المترجم. وهي الصعوبة التي توقف أمامها الناقد المصري عبدالقادر القط حين اقترح في أواخر السبعينيات من القرن الماضي مصطلح «الاتجاه الوجداني» بوصفه بديلًا للرومانسية أكثر تناسبًا مع طبيعة الأدب العربي الموصوف بالرومانسية. فمع أن المجتمع العربي، كما يقول القط، مر بتغير حضاري يذكّر بالتغير الذي مرت به المجتمعات الأوربية ونتجت عنه الرومانسية، فإن التغير الأوربي كان شاملًا وعميقًا في حين أن «التغير الذي طرأ على المجتمع العربي لم يكن –برغم جسامته– على هذا النحو من الحسم والشمول».
ما يواجهه الباحث العربي حين يوظف هذه المصطلحات أو المفاهيم هو انشطار الدلالة بين مرجعيتين، أوربية وعربية. فحتى مع استعمال مصطلح بديل للرومانسية، وهو استعمال لم يَشِعْ، تظل الدلالة الأوربية الأصلية قائمة لأدب يعبّر عن علاقة وجودية ذات طابع حلولي أحيانًا بين الإنسان والطبيعة، علاقة غائبة إلى حد بعيد عن أدب عربي لا تكاد الطبيعة تحضر فيه بكثافتها أو نوعها في البيئات الأوربية وتغيب عنه الجذور الفلسفية الممتدة عبر النزعة الإنسانوية وفلسفة سبينوزا ثم كانط وهيغل وغيرهم. ويصدق مثل ذلك على السوريالية التي نشأت استجابة لأوضاع الحرب العالمية الأولى وبمؤثرات فرويدية سعيًا إلى حقيقة كامنة في اللاوعي بعيدًا من العقلانية التي واجهت خيبتها في النصف الأول من القرن العشرين. القادمون إلى السوريالية عربيًّا لم يأتوها في الغالب سوى من حيث هي تكنيك فني أو إبداعي، ومن هنا ينشأ انشطار الدلالة بين خلفية أوربية كامنة وواقع عربي لغوي ظاهر ومختلف.
تأزم دلالي

محمود درويش
غياب التجانس أو ضعفه هو ما يجب توقعه في غياب المؤثرات أو الظروف التي ولدت المفردات المفاهيمية في سياقها وما ينتج عن ذلك هو تأزم دلالي لمن يدرك ذلك الغياب أو الضعف، لمن يرى أن مفردة «أود» Ode التي اقترحها السير وليم جونز في القرن الثامن عشر لترجمة «معلقة» لا تؤدي الغرض لأن لكل من المفردتين سياقًا ثقافيًّا هو جزء أساس من تاريخهما، الأود بجذورها اليونانية الرومانية التي تجعلها شبيهة بمفردة «رومانسية» والمعلقة بجذورها العربية العائدة إلى ما قبل الإسلام. ويشبه ذلك ما يحدث حين يتبنى شاعر عربي معاصر مثل محمود درويش أو غيره شكل «السوناتة» أو «السونيت» أو «السونيتو» متكئًا على عدد أسطرها الأربعة عشر حتى نظامها في التقفية لتكتسب القصيدة نسبها إلى ذلك الشكل الأوربي العريق (وإن قيل إن له جذورًا تمتزج فيها المؤثرات الأوربية/ الإيطالية بالعربية). السوناتة بصلاتها الموسيقية الواضحة في إيحاءاتها اللفظية واشتقاقها من الصوت (Son) تظل منشطرة الدلالة عربيًّا بغياب تلك الجذور والصلات.
لكن إذا وقعت هذه المفردات المفاهيمية أو المصطلحية في حيز الأدب وتماست مع حرية الإبداع والتلقي ضمن دوائر الشعر أو السرد أو المسرح، فإن ثمة مفردات أخرى أكثر شيوعًا وأساسية يتبين منها، مثلما يتبين من مفردات الأدب، أن ذات الانشطار يتكرر فيها أيضًا وربما بتجذر أعمق وأثر أبعد. إنها مفردات مثل مفردة «نص» التي تشيع اليوم في العربية للدلالة على الكتابة الإبداعية. الدلالة العربية للمفردة، كما تتضح من المعاجم، دلالة دينية أساسًا ولا تزال تحمل تلك الدلالة حين نقول: «إن الكتاب ينص على كذا» أي يحدد دلالة ما. النص هو التحديد والإبانة عن معنى واضح: بنص القرآن أو نص الحديث. لكن هذا التحديد هو بالضبط عكس ما يراد من المفردة الأجنبية التي ترجمت إلى العربية على أنها «نص» وهي «تكست» Text التي تحمل في جذورها دلالة النسيج والتي جاءت منها مفردة textile (أنسجة/ ملبوسات). حين نقرأ رولان بارت أو جاك دريدا مثلًا نجدهما يؤسسان نظرياتهما حول النص بالاتكاء على الجذر الدلالي للنسيج بخيوطه القابلة لإعادة التركيب أو الفك ومن ثم تهلهل الدلالة وتشظيها.
مفردة «نص» العربية، حين تستعمل للقصيدة أو القطعة الأدبية لا يراد منها المعنى الديني لأنه سيكون قاتلًا لانفتاح الدلالة أدبيًّا: لن نقول «بنص القصيدة» أو إن القصيدة تنص على كذا. سنقول: إنها نص بالمعنى القادم من الدلالة الأوربية ناسين أو متناسين أو مهمشين للجذر الدلالي لمفردة نص العربية. لقد توافقت مفردة «تكست» الأوربية مع نظريات نقدية غربية ما بعد بنيوية حول انفتاح الدلالة وقابليتها للتشتت على نحو يصعب على كلمة «نص» العربية بدلالتها الدينية أن تتوافق معه، ومن هنا جاء التحيز الثقافي في كلتا المفردتين، أي تحيز كل منهما لسياقها الثقافي التاريخي.
إننا في كل هذا أمام حالات انشطار دلالية ناشئة بطبيعة الحال عن التماس الثقافي المثري حينًا والمؤزم حينًا آخر، لكنه الحتمي دائمًا والمطالب أيضًا برؤى ومعالجات نقدية تتسع للاختلاف وتنطلق من الوعي به.

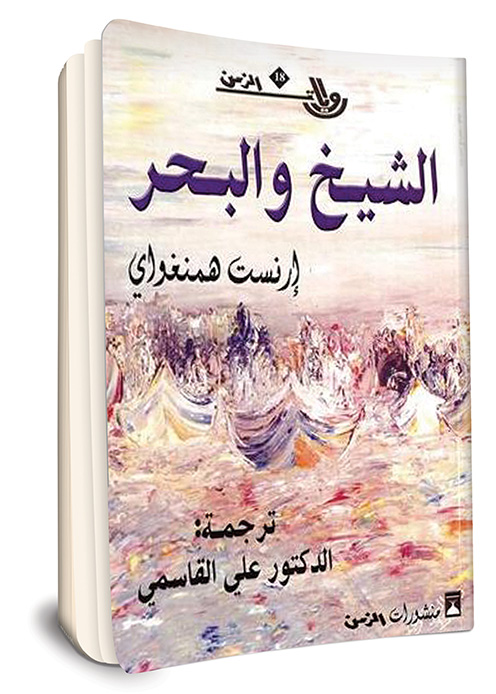 لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.
لكن القراءة حين تكون لنص أدبي، حين تكون نقدًا أي قراءة محكومة بمنهج ومعرفة أو خبرة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا. إنها تتحول إلى عملية تفسير مكثف تبعًا لكثافة النص. فلكي يكون النص الأدبي أدبيًّا، لا بد له من أن يكون على قدر من الكثافة. وبالكثافة أقصد تحول المفردات والعبارات من دلالاتها المباشرة إلى دلالات مجازية ندرك حين نطالعها أننا لسنا أمام كلام عادي، كلام تقريري. النص الأدبي، كما أدرك النقاد طوال العصور، صعود باللغة إلى مستويات من الدلالة لا تلبي احتياجنا اليومي للتواصل، أي لا نحتاجها لكي نتواصل، لكنها تشبع احتياجنا الجمالي، حاجتنا لمتعة القول. هي متعة مترفة إلى حد ما، متعة من لا يريد من الطعام مجرد الشبع وإمداد الجسم بالطاقة، وإنما أيضًا متعة المذاق وإرضاء احتياج آخر، هو الاحتياج الجمالي، وهذا احتياج مترف دون شك، لكنه مهم؛ ذلك أن الاحتياج إلى الجميل والممتع احتياج إنساني تتحقق به إنسانيتنا أو تصعد به إلى مراتب أعلى.






