
محمد الحجيري - كاتب لبناني | مارس 1, 2023 | بورتريه
لا بدّ للذين يواظبون على زيارة شارع الحمرا في بيروت، أن يحفظوا وجه الشاعر والناقد المسرحي اللبناني، بول شاوول وسيجاره التوسكاني وجريدته وملفه الشخصي الذي يتأبطه وهو يمشي أو يجلس في المقاهي سواء التي أقفلتْ، من «هورس شو» إلى «الإكسبرس» و«ويمبي» و«مودكا» و«سيتي كافيه» وكافيه دي باري، أو الجديدة «ليناس» و Godfather…
بول شاوول، أحد أبرز الوجوه الثقافية في لبنان، أتى في أواخر السبعينيات إلى منطقة رأس بيروت «منشقًّا» عن طائفته وعائلته، إذا جاز التعبير، وبقي فرديًّا وحرًّا وخارج الجماعات والأسراب، وحيويًّا في علاقته بشارع الحمرا، الذي يعدّه شرفته اليومية وملاذ عمله وحريته، لكن الشارع التعدّدي والكوزموبوليتي الذي كان يحوي معظم الصروح الثقافية والتعليمية والسينمائية والمدنية والطبية حتى السياسية، تغيّر في السنوات الأخيرة، وتحوّل سوقًا شعبيًّا، مثل مناطق أخرى كما يقول بول شاوول.
وصاحب «بوصلة الدم» الذي عمل في وقت سابق في صحف «السفير» و«النهار» ثمّ «المستقبل» (الصحيفة وقبلها المجلّة الباريسية) حتى إغلاقها في عام 2019م، وكان فيها مسؤولًا عن الصفحة الثقافية وناقدًا أدبيًّا ومترجمًا وكاتبًا سياسيًّا، خاض معارك مع سياسيين وفنانين ومثقفين من الجنرال ميشال عون إلى الفنان زياد الرحباني وما بينهما النائب جميل السيد. لكنه الآن، يعيش جانبًا من القلق والتوجّس والحيرة، وإن كان يرفض أن يضع نفسه في خانة «التشاؤم».
ولا يخفي بول شاوول في حديث لـ«الفيصل» أنه يقضي وقته من دون عمل منذ ثلاث سنوات، فالمنبر الذي كان يعمل فيه، انضم إلى قافلة المؤسسات الإعلامية اللبنانية المنهارة بفعل التحولات السياسية والاقتصادية حتى الإعلامية. وفوق ذلك، جاءت الأزمة النقدية والاقتصادية التي عصفت بالمصارف اللبنانية، وأطاحت بالقيمة الشرائية للعملة الوطنية، وجرى الاستيلاء على حسابات المودعين. يقول بول شاوول: إن ما جناه طوال خمسين عامًا، بات عالقًا في المصرف، وعليه أن ينتظر من شهر إلى شهر، ليُسمح له بسحب مبلغ زهيد يذهب نصفه إلى مولّد الاشتراك، في ظل انقطاع كهرباء الدولة… وكل هذه المسائل والقضايا لها تداعياتها على نمط حياة، كان يعيشه صاحب «كشهر طويل من العشق»، فهو الذي اعتاد أن يقرأ الكتب الفرنسية، خصوصًا الشعرية، بات عليه أن يفكّر ألف مرة قبل الدخول إلى المكتبة لمواكبة جديدها، على أن هذا الواقع المزري لم يمنعه من الاهتمام بالشعر وكتابته، بل إن القلق نفسه جعله يكتب، ويكتب، بعد مدة انقطاع…
القصيدة المتوحشة
الجلسة مع بول شاوول فيها كثير من التشعبات والمواقف والآراء حول السياسة والشعر والشعراء، والترجمة والحياة اليومية، والحرب والحب، والذاكرة والحداثة، وبيروت بعد انفجار مينائها وتحطمها وتصدّع دورها.. يقول بول شاوول: إنه كتب قصائد عديدة تتعلق براهن المدينة وانفجار المرفأ، أبقاها جانبًا، وقد يعيد قراءتها أو كتابتها في مرحلة لاحقة، في وقت هادئ، إما أن ينشرها أو يرميها. فالبعد من القصيدة يدفع الشاعر إلى قراءتها بعين نقدية خارج إطار العاطفة ولحظة الحدث والاندفاع؛ ذلك لأن الشعر لبول شاوول مرهون بما يحمل من جديد، ويشكّل نوعًا من اللعب على اللغة، والقصيدة منحوتة لا تحتمل الزوائد، عدا كتابة القصيدة خارج أوانها ونضجها هو أشبه بعملية اغتصاب. ويرفض بول شاوول أن يكتب القصيدة ويترك الرأي العام يقرر أهميتها؛ ذلك أن هناك قلّةً يقرؤون الشعر، وهو لا يكتب الشعر لإرضاء الصورة المسبقة لدى الناس أو الجمهور. ويرى أن عظمة الشعر في جديده، وكتابته لا يمكن أن تكون بالاستناد إلى قراءة الشعر وحده، فالشاعر عليه قراءة الروايات والفلسفة والتراث النثري والشعر والبلاغة ومتابعة الفن التشكيلي والفوتوغراف والسينما، فهذه الروافد الثقافية في اللاوعي كلها تصبّ في الكتابة الشعرية…
طوال مدة انقطاعه عن الكتابة، كان بول شاوول يقرأ ويترجم ويتابع وينتظر اللحظة التي تنضج وتجعله يكتب القصيدة وينشرها؛ ذلك أن كتابة الشعر في رأيه هي «فعل وجودي»: «أنا أكتب الشعر إذًا أنا موجود». والشعر أيضًا هو «النبل» و«ملح الثقافة»، و«فن الحذف»، في مكان آخر يقول: «كل تحديد للشعر باطل. وكل مدرسة شعرية ببيانات هي باطلة». ويرى أن هناك نوعين من الشعراء؛ منهم من يكتب القصيدة في الليل وتخرج دفعة واحدة وينشرها في الصباح في كتاب وهو ليس ضده، ومنهم من تكون القصيدة بالنسبة لهم مشروع».
في هذه المرحلة القلقة، سيصدر كتابان شعريان لبول شاوول: «ذلك الجسد»، و«القصيدة المتوحشة» (عن دار المتوسط في إيطاليا). الكتاب الأول ذاتي، كتبه الشاعر بعد إجرائه عملية قلب مفتوح قبل مدّة، ويتناول القلب وأعضاء الجسد بلغة نثرية، يومية، سهلة، ممتنعة، بطريقة تجريبية مختلفة عن تجاربه السابقة، وخارج الأسلوبية. أما «القصيدة المتوحشة» فهي في رأيه من أصعب المغامرات في حياته، في سياقها التجريبي اللغوي الاشتقاقي، فيها شيء من «جنون اللغة»، وصفها أحد الأصدقاء بقصيدة العصر. يقول بول شاوول: إنه انتقى فيها كلمات غير رائجة من التراث، وأعاد استخدامها في سياق جديد. وهو يرى أن الكلمات تموت أو تحيا على يد الشاعر سواء في الجاهلية أو الآن… يتفادى بول شوول أن يصف قصيدته قبل صدورها، لكن في الملمح العام يقول: إنها قصيدة عن انهيار العالم اليوم وتحولاته وتفككه، بكل خيوطه ورجوعه إلى الماضي وبلغة الماضي؛ إذ ثمّة من يريد عودة العثمانيين، وثمّة من يريد عودة القياصرة، وثمة من يريد عودة الفرس.

إعدام الكتب والقصائد
يرفض بول شاوول التكرار في الشعر، بمعنى إذا نجح ديوان لشاعر يقوم بكتابة ديوان شبيه به؛ لأن هذا يؤدي إلى «طريق مسدود»، ويجعل الشاعر صدى وببغاء نفسه. بول شاوول من المؤمنين بالتجريب الذي هو «الحرية المطلقة»، بينما التقليد هو «موت الشاعر»، ويفضِّل أن يقلِّد الآخرين على أن يقلّد نفسه، لهذا لم يتردّد في إعدام كتاب جاهز للنشر في لحظة من اللحظات. يعترف بأن الشاعر عبده وازن أنقذ له ديوانين… في المرة الأولى كتب ديوانه «أوراق الغائب» في أثناء وجوده في قبرص في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهو أخذ كثيرًا من الجهد وإعادة الكتابة والحذف، وبعد الانتهاء بدا حائرًا ماذا يفعل به، وكان على حافَة أن يعدمه. بعد الاتصال بالشاعر عبده وازن قال له: إن لديه هذا الكتاب ولا يعرف ماذا يفعل به، فكان أن بادر، وأخذ نسخة، وحصل أن نُشر عن دار الجديد. وقبل أكثر من عشر سنوات كتب بول شاوول ديوانين وأرسلهما لدار النهضة العربية في بيروت ولم يُنشرا في حينه لأسباب شخصية، ومنذ مدة علم الشاعر عبده وازن بهما، وبعد وقت قصير جاء له بالكتابين مطبوعين على ورق، بعد أن كانا على قرص مدمج، وهما «حديقة الأمس» الذي صدر قبل مدة و«حجرة مليئة بالصمت».
يقول بول شاوول: إنه عندما قرأ «حديقة الأمس» لم يعجبه لكن أبقاه جانبًا، عبده وازن قال له: «إن هذا الكتاب تحفة»، أما «حجرة مليئة بالصمت» فعندما قرأه رماه في سلة المهملات، قال هذا الكتاب أقلّد نفسي فيه، ولم يسمع كلام عبده وازن والروائية علوية صبح اللذين حاولا منعه من «إعدامه». «حديقة الأمس» كان عنوانه «حديقة المنفى العالي» لكنه غيّره عند نشره لأن الحديقة في البيت، وهي موضوع الكتاب، يبست، والديوان عبارة عن مجازات ومونولوغات يحكي مع الوردة والشجرة، في مزيج بين الميتافيزيقي والواقعي، بين المجازي والملموس، بين اليومي والملحمي.
يقرّ بول شاوول بحذف 80% من القصائد التي يكتبها، ويخاف إعادة قراءة دواوينه التي طبعها، حتى لا يضطر إلى إعادة النظر فيها ورميها، فلديه دائمًا نقد ذاتي وقسوة تجاه ما يكتبه، عدا ذلك أضاع مخطوطة مسرحية في متاهة مكتبته الكبيرة وبين أوراقه الكثيرة، وعندما كان يفتش ذات مرة وجد ديوانًا مكتوبًا إلى امرأة أحبّها في السبعينيات من القرن الماضي، ونشر منه بعض المقاطع في ملحق جريدة «النهار»، وهو لا يريد نشره الآن؛ لأنه شيء شخصي وتحوّل للذكرى، ومجرد تذكار، أما المرأة التي كتب عنها فقد أصبحت في العالم الآخر.
وغالبًا ما يرى بول شاوول الشعرَ فنًّا أقلّويًّا، أو جنسًا أدبيًّا يهتم به عدد محدود من الأشخاص. هناك استثناءات قليلة من الشعراء لديهم جمهور عريض، مثل: نزار قباني الذي تقلّص جمهوره بعد رحيله، وكذلك محمود درويش… وعدا ذلك أبرز الشعراء في العالم، يبيعون من الديوان نسخًا قليلة، سواء الشاعر الفرنسي آرثر رمبو، أو ملارميه… ويرفض بول شاوول رفضًا باتًّا حفلات التواقيع التي تعتمدها دور النشر؛ في رأيه هي تقوم على مصالح وعلاقات عامة يهدف منها الناشر إلى المزيد من المبيع لأناس يجاملون، هم من عائلات أو الموظفين أو الأصدقاء، ومعظمهم لا يقرؤون، وحين طُلب من بول شاوول توقيع كتاب رفض، واشترى نسخًا من كتابه وزعها على أناس هو يختارهم ويعرف أنهم من قراء الشعر، ولا يتطفلون عليه.
ترجمة الشعر الشبابي
يتحدث بول شاوول عن تجربته المهنية، فيقول: إنه تابع مئات المسرحيات في العالم العربي (لبنان، وتونس، وسوريا، ومصر، والأردن وغيرها)، وترجم آلاف القصائد من العالم، وهو صاحب مقولة «وراء كل شاعر عربي شاعر أجنبي». صدر له أخيرًا ثلاث ترجمات شعرية، «كتاب الشعر الفرنسي الحديث (1900- 1985م)». يقول في تقديم الكتاب: «لم أختر الشعراء الذين أحب أو أميل إليهم فحسب، كما أني لم آخذ منهم الرموز التي تجسّد التيارات والمدارس أو الاتجاهات فحسب، إنما إلى جانب ذلك حاولتُ أن أوفق بين الاختيار البانورامي والعلامات الأساسية في الشعر الفرنسي. ولهذا لم أجد بُدًّا من اختيار شعراء، يشكلون؛ إما استمرارًا ضمن توجهات شعرية عامة، أو امتدادًا منوعًا لشعراء أساسيين. ومن هاجس إبراز مجمل النشاطات الشعرية، المهمة منها والعابثة، الراسخة والعابرة، العميقة والطافية، وكي يكون القارئ العربي على اطلاع على مجمل هذه النشاطات، لم أهمل أية محاولة شعرية لامعة في هذا الإطار».
والجزء الثاني أصدره بعنوان: «ملحمة الشعر الفرنسي الجديد 1960- 2016م»، يقول في تقديمه: «طبيعة الشعر أن يكون جديدًا؛ يعني أن حركته في الوصول إلى سواه، أو أبعد منه، بطيئة. كل جديد بطيء الوصول، وكل جديد يتنكب المحمولات التاريخية، لكن بتحويلها هنا وتحطيمها، وتجاوزها، وهنا بالذات تكمن مشكلة الشعر، الذي يحمل هذه المواصفات، مع الآخر، أو مع الجمهور المستهلك السريع، أي المستهلك كل ما هو متجذر في عاداته وأنماطه، وأحاسيسه وأفكاره الجاهزة».
يقول بول شاوول لـ«الفيصل»: إن ثمة أسماء كبيرة في الشعر، تخطى ترجمتها سواء لويس أراغون أو بول إيلوار أو غيرهما، والآن يميل لترجمة الشعراء الشبان في العالم ليتعرّف إلى تجاربهم. وأصدر طبعة ثانية من كتاب «بابلو نيرودا/ مختارات شعرية من مجمل أعماله» (عن دار الجمل). يقول شاوول في المقدمة التي وضعها للكتاب: «ما زال شعر بابلو نيرودا يحتفظ بقوته ونضارته بعد زوال مختلف الظروف التي ساهمت في تغذيته وشحنه، فإنه يبدو الآن أكثر حضورًا مما كان في تلك المرحلة؛ ذلك أن الهالات السياسية التي كانت تغلف هذا الشعر وتحجب طاقاته الهائلة وتقننه وتوجهه توجهًا «أحاديًّا» أي توجهًا أيديولوجيًّا بالدرجة الأولى عبر الأحزاب والتنظيمات السياسية… قد تبددت لتترك الشعر وحيدًا بحياته الخاصة». ويضيف شاوول أنه خلال العمل على شعر نيرودا: «شعرت أولًا بأنني اكتشفت حجم نيرودا الشعري… ثانيًا شعرت بأن الأحزاب اليسارية العربية أساءت إلى هذا الرجل عندما قدمته في صورته الطاغية (كمناضل سياسي) وأغفلت ما تناءى من شعره عن سياساتها…».
حتى في علاقته بالشاعر محمود درويش، يميز شاوول بين نضالية الشاعر الفلسطيني التي لا يحبها، وذاتيتها التي جعلته يكتب قصيدة مختلفة. وذات مرة أجرت معه صحيفة إماراتية حديثًا، ووضعت عنوانًا: «بول شاوول.. الآن بدأ محمود درويش يكتب القصيدة»، يومها كان درويش أصدر ديوانه «سرير الغريبة»، ووصل كلام لدرويش يقول: إن بول شاوول يشتمه، وحين التقاه في إحدى المناسبات الثقافية في الأردن، جادله خلال جلسة، وقال له بما معناه: إن معظم الشعراء العرب يبدؤون بديوان جيد ثم يتراجعون، أنسي الحاج في «لن»، سعيد عقل في «قدموس»، أحمد عبدالمعطي حجازي في «مدينة بلا قلب»، الماغوط في «حزن في ضوء القمر»؛ أما محمود درويش فبدأ بقصائد تلبي ما يريده الجمهور، وفي أعماله الأخيرة عمل على تطوير نفسه والتجديد، وعاد إلى الشعر الذاتي على عكس معظم الشعراء العرب، ومنذ تلك الجلسة أصبحت علاقة بول شاوول بمحمود درويش على أحسن ما يرام… وفي المقابل بقيت متوترة مع الشاعر أدونيس منذ زمن.
صورة الشاعر وشعره
على عكس صورة بول شاوول الملازمة لشارع الحمرا ومقاهيه، فهو في الشعر يُكوّن تجارب متعدّدة، وكل قصيدة بالنسبة إليه تجربة جديدة. يميل إلى الاختبار والتجديد والاختلاف لا التكرار، والقراءات في شعره، تقول عن تعدّديته، ومصادر إلهامه، الفرنسية أو التراثية بشكل أقل. يقول الشاعر اللبناني أنطون أبو زيد في كتابه «مدخل إلى قراءة قصيدة النثر» (دار النهضة): «كان بول شاوول أحد شعراء السبعينيات الذين تنامت نبرتهم الشعرية وتعالتْ وسط الهامش الثقافي غير الرسمي، وعنيت به هامش الانفتاح والتحرّر الذي أتاحته بيروت، مثلما أتاحت للكثيرين من الشعراء اللبنانيين والعرب، المجايلين للشاعر». والحال أن بول شاوول جرّب أشكالًا كثيرة، والتجريب في رأيه حلّ محل النظرية و«المدرسة» والنمطية؛ لأن النظرية الجاهزة تضعف التجريب، وهذا هو السبب الكامن وراء انهيار المدارس الشعرية كالسوريالية والدادئية، التي أرادت قتل الأب فقتلتْ نفسها. فهي تضع قالبًا وتقول: اكتب. وبول شاوول يرفض قتل الأب ويرى أنه شعريًّا ولد من آباء كثر. ففي عام 1974م، عشية الحرب الأهلية أصدر مجموعته الأولى «أيها الطاعن في الموت»، كتب الشاعر والمسرحي الراحل عصام محفوظ في مقدمة الديوان: «إنه صوت جيل بأكمله»، ولد في تلك المرحلة الجيل الثاني من شعراء الحداثة، سركون بولص، أنور الغساني، عباس بيضون، وديع سعادة وغيرهم.
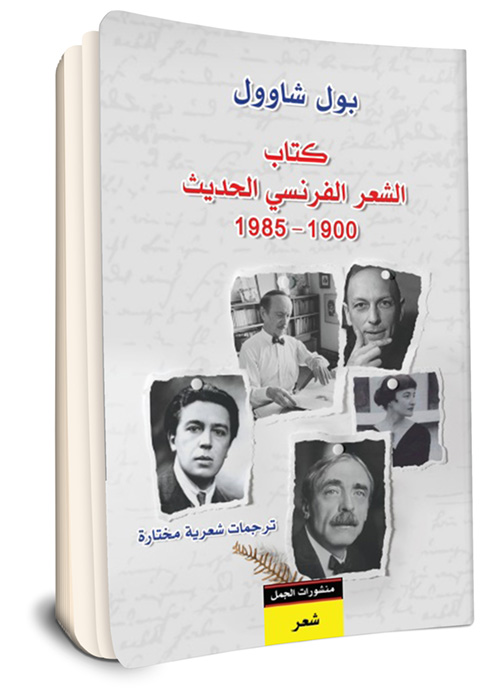 وفي عام 1977م أصدر مجموعته «بوصلة الدم» وهي قائمة على عبثية المعنى، وأقرب إلى قصيدة سياسية غير منبرية وغير خطابية، أتت مباشرة بعد موجات العنف في لبنان… وفي ديوانه «وجه يسقط ولا يصل» (1981م)، القائم على كثافة الصورة، كتب ما سُمِّي آنذاك «قصيدة البياض»، أي القصيدة المفتوحة المكثّفة المختزلة والمقطّرة التي تترك كثيرًا من الظلال فيما يسمّيه بول شاوول «المعنى الناقص» أو «الإيحاء الناقص»، و«ليس البياض زخرفًا ولكن باعتباره جزءًا مضمرًا من اللغة، نصف القصيدة كلام ونصفها الآخر صمت». يقول شاوول: والقصيدة «تتخذ من البياض حيزها السينوغرافي، تمامًا كما في المسرح، حيث يلعب الفضاء السينوغرافي دورًا مكملا للكلمة». تقول الكاتبة مليكة مبارك (مجلة نقد): و«الفراغ في كل مجموعاته يبدو ماثلًا، ناظمًا المدى النصي في كل قصيدة على النحو الذي ينسجم مع فلسفته الشعرية العدمية».
وفي عام 1977م أصدر مجموعته «بوصلة الدم» وهي قائمة على عبثية المعنى، وأقرب إلى قصيدة سياسية غير منبرية وغير خطابية، أتت مباشرة بعد موجات العنف في لبنان… وفي ديوانه «وجه يسقط ولا يصل» (1981م)، القائم على كثافة الصورة، كتب ما سُمِّي آنذاك «قصيدة البياض»، أي القصيدة المفتوحة المكثّفة المختزلة والمقطّرة التي تترك كثيرًا من الظلال فيما يسمّيه بول شاوول «المعنى الناقص» أو «الإيحاء الناقص»، و«ليس البياض زخرفًا ولكن باعتباره جزءًا مضمرًا من اللغة، نصف القصيدة كلام ونصفها الآخر صمت». يقول شاوول: والقصيدة «تتخذ من البياض حيزها السينوغرافي، تمامًا كما في المسرح، حيث يلعب الفضاء السينوغرافي دورًا مكملا للكلمة». تقول الكاتبة مليكة مبارك (مجلة نقد): و«الفراغ في كل مجموعاته يبدو ماثلًا، ناظمًا المدى النصي في كل قصيدة على النحو الذي ينسجم مع فلسفته الشعرية العدمية».
وفي ديوانه «الهواء الشاغر» (1985م) حاول بول شاوول «إيصال القصيدة إلى أقصاها، حيث إن الكلام التبس مع فراغ الصفحة، فصار كلٌّ منهما امتدادًا للآخر؛ أي أن البياض لم يكن تزيينيًّا ولا تجميليًّا، بل كان «جزءًا عضويًّا من بنية القصيدة»، هذه الصيغة الجديدة استدعت نوعًا من الالتباس مع كثير من الشعراء، ولا سيما شعراء الستينيات منهم. بعضهم قال: ماذا يكتب بول شاوول؟ أيجعل من كلمتين قصيدة؟ ولماذا هذا التدمير البنيوي لجسم القصيدة وتواصل عناصرها الظاهرية؟
بول شاوول النرسيسي كما يصفه بعضٌ، من المعنيين باكرًا بالحداثة الشعرية والنقدية، في اللغتين العربية والفرنسية معًا. من خلال نتاجه الشعري والنقدي وترجماته المعروفة أصدر في عام 1990م «موت نرسيس»، الذي يتضمن غنائية صاخبة متدفقة. وفي عام 1992م أصدر «أوراق الغائب»، وهو محطة بارزة في حياته، عاد للجمع بين مختلف الكتابات السابقة في قصيدة طويلة مبنية على المقاطع والتوازنات، لتتصل في جَوَّانِيّتها وتشكِّل المناخ العام… ويرى شاوول هذه القصيدة «تتويجًا غير مباشر لكل ما اشتغله»، «هي لحظة التقاء لمجمل إرثه الشعري» (يوسف بزي – مجلة الناقد)… إذ لعب «لعبة التدفق الملجوم، والغنائية المحجبة، ولعبة البياض الإيحائي، كأن هذه التجربة قد اختزلت ربع قرن من الشعر».
فكما لعب في «موت نرسيس» اللعبة المضادة لـ«الهواء الشاغر»، قال: عليه -ليتخلص من «أوراق الغائب»- أن يلعب اللعبة المضادة، أي محاولة كتابة نص ناثر ملموس، شهواني، مشهدي، تكون اللغة فيه آتية من مكان آخر. وتجلت التجربة في «كشهر طويل من العشق» (2001م)، الذي وصف بـ«الملحمة الشعرية العاطفية» كتب أول مقطع بعنوان «نساء» بـ«لغة ملموسة تستنفر التراث القديم من دون أن تقع في متحفيَّته». واتّهم بالعودة فيها إلى التراث وإن كان هذا ليست تهمة بالنسبة إليه؛ لأنه اشتغل تجريبيًّا على المادة القديمة، ووضع تراكيب قديمة في سياق جديد، لتفقد هذه التراكيب القديمة هويتها الأصلية، وفي الوقت نفسه، ثمة من الشعراء من عمل على محاكاة قصيدة «نساء» في الديوان. وهو في هذا الكتاب «شاعر معنى وشاعر لغة وشاعر اشتقاق لغوي»، وحاول «الكشف عن الذات الشعرية المتوحشة في أعماقه والذات الشبقية الأخرى، من خلال كتابته لنص مختلف، نص يأتي بكل حرياته وفوضاه، يفرض رؤى الشاعر البصرية على القارئ النموذجي المتفاعل» كما كتب
فاضل سلطاني.
وبالتزامن مع «كشهر طويل من العشق»، كتب بول شاوول «نفاد الأحوال» (2001م) بلغة شفوية ودرامية. يتوقف عند تفصيل عبثي يفتتح من خلاله مرثاته النثرية-الشعرية، فيتكلَّم على «شعرة تسقط أحيانًا من رأسك ويسقط معها من الأمور ما لم يُعَدّ وما لم تلحظه على مرِّ الوقت والأحداث بخفة الهواء، وبحدَّة ما في المآسي والذكرى»… وفي «بلا أثر يذكر»، قراءة لحالات الكائن الذي يراقب حياة تجري من حوله. يبدأ الكتاب بداية لافتة: «ينتظر، يوميًّا، ذلك الرجل الذي يجلس وحده في المقهى، إلى الطاولة نفسها، وفي الميعاد نفسه، وبالملابس نفسها، وبالسيجارة نفسها». وينتهي الكتاب بالقول: «لقطة بانورامية على متاعه الأخير: علبة سجائر، المنفضة. القلم الجريدة. النظارات، ثم أخيرًا أصابعه على الطاولة وحدها بلا مثيل ولا قرين. ولا شيء يذكر».

دفتر سيجارة
ولئن اشتهر بول شاوول بالسيجار التوسكاني، فهو في جلساته، لا بد من أن يتطرق إلى السيجارة ونجومها وطقوسها. يقول: هناك حضارة ما قبل السيجارة وحضارة ما بعدها، وهي لها وقع خاص، في الحياة اليومية، في المقهى وفي السينما ولدى العُمّال. ويصف شاوول كتابه «دفتر سيجارة» بأنه من أجمل كتبه؛ من أصعبها ومن أسهلها في الوقت نفسه. فالشفوية والهشاشة في الكتاب تشبهان الدخان المتصاعد من السيجارة وورقتها ورمادها. الكتاب عن علاقة الشاعر بالسيجارة التي لم تكن تفارق فمه، ويحاول تصوير حالاتها المختلفة. يتذكر المدينة ومقاهيها وناسها، الذين مضوا أو لنقل الذين اندثروا وذابوا مثلما تذوي السيجارة بعد الاشتعال. لاقى الديوان قبولًا خاصًّا من المدخنين. وانتشر بشكل جيد. يقول شاوول: «أسعدني أنه أثار الاهتمام. حتى في المقهى الذي أداوم على الحضور إليه، طلب بعض الرواد نسخة منه ليس بسبب الشعر، بل لأنهم مدخنون مزمنون»… وحاولت جماعة الإخوان في مصر مصادرته إبان حكم الرئيس محمد مرسي لأسباب واهية وساذجة.
ثمة كتب لبول شاوول هي مزيج من قصص قصيرة جدًّا ونصوص شعرية ونثرية من «ميتة تذكارية» إلى «منديل عطيل»، و«عندما كانت الأرض صلبة». وأعادت دار «راية» في حيفا إصدار قصيدته «هؤلاء الذين يموتون خلف أعمارهم»، يهديها الشاعر إلى أطفال غزة، وهو كان نشرها في جريدة «المستقبل»، وأصدرها في كراس صغير في بيروت، ووزعها على من يحب قراءة الشعر. والقصيدة خطها شاوول في ليلة 31 ديسمبر 2008م وفجر 2009م، أي في واحد من أول أيام الحرب على قطاع غزة، وتختزل العديد من الإشارات…
بول شاوول المسرحي له مؤلفات مسرحية عدّة؛ منها: «المتمرّدة»، و«الحلبة»، و«قناص يا قناص»، و«الزائر». وترجم صموئيل بيكيت وغيره، وكتب للسينما حوار فِلْم «بيروت يا بيروت» لمارون بغدادي، وسيناريو المسلسل التلفزيوني «الخيانة» (إخراج سمير نصري)، كما اقتبس للمسرح «مذكرات مجنون» لغوغول. لكن يبدو أن الشعر في حياته طغى على ما عداه.
ذاكرة
لا تنتهي الدردشة مع بول شاوول من دون التطرّق إلى شيء من الذاكرة؛ ذلك أن حياة صاحب «أوراق الغائب» في شارع الحمرا، لا ترتبط بمجرّد مكان للسكن، فهو اختاره لأنه المكان التعدّدي والمنفتح واللاطائفي، وهو يرفض العيش والسكن في الأماكن الطائفية والأحادية ذات اللون الواحد. ففي 1978م كان يسكن في منطقة شرق بيروت، ذات الأغلبية المسيحية، هدَّدَته الميليشيات اليمينية بحرق بيته إذا لم يغادر؛ ذلك لأنه كتب ضد الميليشيات وما فعلته في مخيم تل الزعتر خلال الحرب، وتعرض للخيانة والوشاية من أقرب المقرّبين إليه، هاجمه حزب الكتائب بتهمة أنه شيوعي، غادر المكان ولم يكن حينها يملك سوى خمسين ليرة لبنانية، وكان بلا عمل، سكن في شقة مفروشة في شارع الحمرا، وهي من الشقق التي لم تكن صالحة للسكن، ثم انتقل إلى الشقة التي ما زال يسكن فيها منذ عام 1979م… في بيروت لاقى احتضانًا من القوى اليسارية والوطنية، وكان لديه أصدقاء من معظم القوى… وخلال الحرب حُرِمَ رؤيةَ أهلِه مدةَ 12 عامًا.
لم يكن بول شاوول شيوعيًّا، بل كان ناشطًا وقياديًّا في حركة «الوعي» التي يصفها بأنها استمدت أفكارها واتجاهاتها من طبيعة التناقضات اللبنانية والعربية، وكانت تضم الروائي والشاعر أنطوان الدويهي والشاعر عقل العويط والمؤرخ عصام خليفة وغيرهم. ونجحت هذه الحركة في استقطاب العديد من طلاب الجامعات وبعض الثانويات حتى صارت واحدة من أهم القوى في الجامعة اللبنانية. وقد انتهت وتفرق شملها عندما بدأت الحرب وصارت القوى السياسية تطلق النار على بعضها. وعلى الرغم من الأحداث الأليمة التي عصفت بالعاصمة اللبنانية، فقد بقي بول شاوول، المولود في بلد سن الفيل، صامدًا في منطقة رأس بيروت، فخلال الحرب بين ميشال عون والجيش السوري في لبنان أواخر الثمانينيات، سقطت قذيفة على منزله أتلفت 500 كتاب من مكتبته، وتهجّر مدة إلى قبرص، وعمل في وكالة الصحافة الفرنسية. وإبان غزوة حزب الله لبيروت في 7 مايو/ أيار 2008م تهجّر لنحو ثلاثة أشهر من الشارع الذي أحبّه، والذي احتلته الميليشيا.

محمد الحجيري - كاتب لبناني | مارس 1, 2022 | تحقيقات
شواهد القبور التي يُنقش عليها أسماء الموتى وتواريخ حياتهم، تقليد تمارسه بعض الشعوب والمجتمعات على اختلاف ثقافاتها منذ العصور الأولى. وبحسب الباحث الأنثروبولوجي المصري أحمد أبو زيد، تتبدى شواهد القبور كإحدى المصادر التسجيلية، للمظاهر الإثنية والدينية واللغوية للتاريخ العام، ولحيوات الأفراد… و«تعد النقوش الكتابية القديمة من المصادر التاريخية المهمة التي تنقل لنا صورة موثقة للحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات القديمة، فهي وعاء لحمل الثقافات والحضارات»(١).
عندما ننظر إلى مضامين الكتابات المسجّلة على شواهد القبور، وتلك المعروضة في بعض المتاحف في عدد من الدول، نجدها قد تميّزتْ بالتنوع في النصوص التي سجلتْ عليها. وهي إما: البسملة أو آيات أو سور كاملة من القرآن الكريم، أو حديث نبوي، أو شهادة التوحيد، أو الأدعية، وتميزت بالخطوط (الفارسية والكوفية والعثمانية) والنقوش.
سياحة أدبية وروحية
يشرح المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه كيف أن الفن انبثقَ من القبر؛ فأول جامع تحف فنية كان القبر، وأول لوحة فنية كانت الكفن، وما ذلك إلا لإحياء الذِّكر. ويسأل: ألا تُحوَّل الورود التي تبعثر على قبر المغني جيم موريسون (1943-1971م)، زاوية من مقبرة Père-lachaise، إلى هيكل (…)؟(٢) ففي الذكرى الخمسين لرحيل موريسون، لا يزال ضريحه، مقصدًا للمعجبين. وذكرى رحيله موعد سنوي لعشاقه، لوضع الورد وإضاءة الشموع على قبره، وزيارة عدد من الأماكن التي قصدها خلال الأشهر الأخيرة من حياته. وإلى جانب موريسون، يرقد في المقبرة الشهيرة الواقعة في الطرف الشرقي للعاصمة الفرنسية باريس، عدد من أعلام الأدب والفن، من بينهم موليير، وأوسكار وايلد، وإديث بياف، ومارسيل بروست، وفريدريك شوبان.
وليس قبر موريسون وحده من «أساطير الحياة اليومية» كما شاء أن يسميها الناقد الفرنسي رولان بارت، فقد خاضت الأوساط الثقافية والأكاديمية في فرنسا معركة حول قبر الشاعر آرتور رامبو حيث وجّه عدد كبير من المثقفين الفرنسيين عريضة تدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن ينقل جثمانه إلى مقبرة العظماء «البانثيون» إلى جوار عظماء فرنسا أمثال روسو وفولتير وزولا وهوغو… وهذا الأمر أثار حفيظة عشاق رامبو الذين عدّوا هذا الطلب مخالفًا لتجربة وحياة رامبو، الذي كان متمردًا ضد المؤسسات الرسمية.
كتب الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين(٣) «أسلم رامبو الروح في 10/11/1891م، ثمّ حُمِلَتْ جثة (التاجر جان آرتور رامبو) من المستشفى في 11/11/1891م، ودفنت في مدافن العائلة في شارلفيل مسقط رأسه… والشاهدة التي وضعت على قبره، تشير إلى «قبر التاجر جان آرتور رامبو». أما الشاعر آرتور رامبو، فقد انتظرت شاهدة قبره سبعًا وخمسين سنة بعد موته، لكي تحل محلّ الأولى، فقد وضعت اللوحة النحاسيّة التالية، في الساحة الرئيسة التي تضمّ قبره في شارلفيل: «هنا/ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1891/ عند رجوعه من عدن/ الشاعر/ جان آرتور رامبو/ واجَهَ نهاية مغامرته الدنيويّة».
وقد نصبتْ هذه اللوحةَ «جماعةُ مرسيليا الأدبيّة» في 10/10/1946م.
 كُثر هم الذين زاروا قبر رامبو ووضعوا الورد عليه، وكتبوا عن «السياحة الأدبية». ربما أبلغ تعبير عن الزيارات ما كتبه الشاعر البيروفي خوسيه لويس أيالا «لا شيء في مقبرة شارلفيل،/ ولا الريح حتى/ أهو فصل آخر في الجحيم؟/ أنظّم شاهدة القبر،/ والحارس العربيّ العجوز يخبرني/ لا أحد يزوره/ غير اليمام والمطر»(٤).
كُثر هم الذين زاروا قبر رامبو ووضعوا الورد عليه، وكتبوا عن «السياحة الأدبية». ربما أبلغ تعبير عن الزيارات ما كتبه الشاعر البيروفي خوسيه لويس أيالا «لا شيء في مقبرة شارلفيل،/ ولا الريح حتى/ أهو فصل آخر في الجحيم؟/ أنظّم شاهدة القبر،/ والحارس العربيّ العجوز يخبرني/ لا أحد يزوره/ غير اليمام والمطر»(٤).
وبشكل من الأشكال، تتحول قبور المشهورين، ومنهم الأدباء والشعراء والفلاسفة، إلى معالم سياحية وأدبية يقصدها الزوار والسائحون، سواء قبر كافكا في براغ، أو قبر ابن عربي في دمشق، أو قبر محمود درويش في رام الله فلسطين، أو كارل ماركس في لندن، ومحمد إقبال في لاهور. وثمة قبور لأدباء يختلط فيها الأدبي بالديني… فقبر ومزار جلال الدين الرومي في مدينة قونية التركية، يعد منذ مئات السنين مهوى أفئدة أهل التصوّف في الشرق والغرب، يزور ضريحه عشرات الآلاف سنويًّا يتقاطرون عليه من كل جهات الأرض سواء من المسلمين أو غيرهم، وبخاصة الغربيون.
وما يُميّز ضريح الرومي، إلى جانب مئذنته ذات الطابع المعماري العثماني، قبّته الخضراء المزخرفة بخزف فيروزي. بعد سقوط السلطنة العثمانية وإلغاء مصطفى كمال الخلافة عام 1923م، عمد أيضًا إلى إلغاء كل الزوايا والتكايا وحوّلها إلى متاحف، فتحول ضريح الرومي عام 1926م إلى «متحف العصور القديمة لقونية»، قبل أن يأخذ عام 1954م اسمه الحالي «متحف مولانا». وكتب على قبره: «لا تبحث عن مرقدنا بعد الوفاة، إنما مقامنا في صدور العارفين من الأنام». وثمة قبور لشعراء في إيران، تأخذ منحى بين الديني والشعري؛ نجد أن قبر أهم شاعر فارسي على الإطلاق، وهو سعدي الشيرازي، يعدّ في الوقت نفسه «مزارًا دينيًّا». وكذلك نجد مزارات دينية/ شعرية فارسية أخرى عند قبر الشاعر حافظ الشيرازي وقبر الشاعر الفردوسي في مدينة طوس الإيرانية. ويحظى ضريح الشاعر والفلكي الإيراني عمر الخيّام، في مدينة نيسابور، بإقبال كبير من عشّاق الأدب والشعر، الإيرانيين والأجانب. أُنشِئ الضريح عام 1963م بأمر من الشاه الإيراني رضا بهلوي، حيث صمم طرازه المعماري على شكل خيمة، نسبة للقبه «الخيّام». وزيّنت جوانب الضريح برباعيات الخيام التي اشتهر بها أكثر من مؤلفاته الأخرى.
قبور مزعومة
أحيانًا تتحوّل القبور إلى نوع من هوس، فهي لها وقعها الاجتماعي والثقافي، ولكنها مزعومة أو افتراضية أو تعبّر عن متخيّل جماعة من الجماعات… فمع أن كثرًا يقصدون قبر أبي الطيب المتنبي الكائن على بعد 2 كم شمال قضاء النعمانية في محافظة واسط العراقية، لكن يعتقد أنه ليس قبره، إنما قبر شخص آخر يدعى أبا سورة ولا يعرف عنه الكثير. هناك «دراسات بهذا الخصوص، منها واحدة للمؤرخ عماد عبدالسلام رؤوف، بعنوان: «دير العاقول»، مبينًا أن تلك «الدراسة وغيرها رجحت أن يكون قبر المتنبي إما بالقرب من بغداد في المنطقة التي تعرف باسم جرجرايا، أو في منطقة تقع غرب قضاء النعمانية تدعى بالصافية، على الرغم من أن الغموض يكتنف الموضوع… فإن الروايات والحكايات تقول: إن جثة المتنبي وجدت عائمة على ضفاف دجلة قرب قبره الحالي، و«تسميته أبا سورة جاءت بالنظر لقذف نهر دجلة جثته على إحدى جوانبه بفعل تيار مائي قوي يدور حول نفسه». و«دوران الماء حول نفسه يدعى سورة ومنه أطلقت التسمية على قبر المتنبي، فبات يعرف بأنه أبو سورة».
أما ما كتب على قبر المتنبي، فمنه:
«ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثان يرى لبكر الزمان/ كان من نفسه العظيمة في جيش وفي كبرياء ذي سلطان». وكذلك الكتابة الآتية: «مالئ الدنيا وشاغل الناس أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي المتنبي، شاعر العربية الأكبر ولد في محلة كندة بالكوفة سنة 303 هجرية، وتوفي مقتولًا عام 354 هجرية وهو القائل: وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرًا أصبح الدهر منشدا/ فدع كل صوت غير صوت فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى».
وكذلك:
«أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي مـن بـــه صمم
الخيل والليل والبيداء تعرفني
والسيف والرمح والقرطاس والقلم».

قبر المتنبي، يبدو ضائعًا أو مزعومًا، وقبر امرئ القيس يبدو متعددًا أو بـ«منازل كثيرة»… عام 2007م صدر كتاب عن بلدية إسطنبول، أكد وجود قبر امرئ القيس في تلة هيديرليك، التي كانت تعرف أيضًا باسم تلة تيمورلنك. أعدتْ تركيا مشروعًا لإعادة ترميم الضريح أملًا في جذب السياح العرب وغيرهم من المهتمين بالتراث العربي والشعر الجاهلي. تقول معلومات نشرها موقع «دار الوراق»: إن صاحب قصيدة «قفا نبك» ذهب إلى القسطنطينية، بناءً على نصيحة الغساسنة؛ لطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي ضد خصومه في الجزيرة العربية، بعد مقتل والده أسد، وما كان من الإمبراطور، بسبب وشايات، إلا أن سمّمه عبر تلبيسه عباءة مسمومة ما لبثت أن قتلته في منطقة أنقرة حيث دُفن.
الشاعر والناقد الفلسطيني عز الدين المناصرة أصدر كتابًا، بعنوان: «امرؤ القيس.. ليس امرأ القيس: قصة امرئ القيس الكندي- شاعر العربية الأول»، يتضمن خلاصة عامة وهي أن امرأ القيس (الشاعر)، لم يزر قيصر الروم (جستنيان) في القسطنطينية، وأن الذي زار قيصر الروم، هو امرؤ القيس- (ملك فلسطين الثالثة، جنوب فلسطين، والبتراء، وأيلة، وتيران)؛ لأن هناك 28 شخصًا تاريخيًّا، يسمون امرأ القيس…

تضاربت الأبحاث والمعلومات حول قبر صاحب «قفا نبكِ»؛ بسبب كثرة الأسماء والحكايات التي راوَحَت بين مصادر شفهية وانتحال، وأخرى تستند إلى الآثار هنا وهناك. في المقابل تحول قبر الشاعر الإسباني الغرناطي غارثيا لوركا حكاية وقضية بسبب كثرة القتلى والمجازر خلال الحرب الأهلية الإسبانية. بحسب المتابعين لهذا الملف، تعدّ لحظات إعدام لوركا من أكثر اللحظات الحزينة في التاريخ الإسباني والإنساني، حيث أوقفه جنود نظام الجنرال فرانكو أمام جدار، وصوبوا نحوه بندقيتين أطلقتا الرصاص على جسده بينما كان يردد: «ما هو الإنسان يا مريانا/ من دون حرية/ كيف أستطيع أن أحبك/ إذا لم أكن حرًّا/ كيف أستطيع إهداءك قلبي/ إذا لم يكن ملكي».
سرت أخبار كثيرة حول مكان قبر لوركا، أمضى المؤرخ الإسباني ميغيل كابايرو بيريز ثلاث سنوات في دراسة أرشيفات الشرطة والجيش لربط أحداث الساعات الثلاث عشرة الأخيرة في حياة مؤلف «عرس الدم». يقول المؤرخ كابايرو: إنه تعرّف إلى هويات الشرطة والمتطوّعين الستة الذين شكلوا فرقة الإعدام وثلاثة سجناء. ونشر نتائج بحثه في كتاب بالإسبانية عنوانه: «آخر 13 ساعة في حياة غارثيا لوركا»، موضحًا أنه قرّر درس الأرشيفات بدلًا من جمع مزيد من الشهادات الشفهية؛ لأن سبب البلبلة والتشويش في هذه القضية، هو هذه الأقوال التي يتفوّه بها شهود مفترضون يولفون الروايات. وأشار كابايرو إلى أن نيّته في البداية كانت التأكّد من معلومات جمعها في ستينيات القرن الماضي الصحافي الإسباني إدواردو مولينا فاخاردو، الذي كان عضوًا في حزب الكتائب المناصر لفرانكو. وإن هذا الصحافي بسبب انتمائه كان يستطيع الوصول إلى أشخاص مستعدّين لقول الحقيقة. والأرشيفات تؤكد أغلب ما نقله مولينا فاخاردو، ويُفترض أنه كان مصيبًا بشأن المكان الذي دُفن فيه لوركا أيضًا. والمكان خندق حفره شخص يبحث عن الماء في منطقة ريفية قرب مزرعة تقع بين قريتَي فيثنار والفاكار. وتبعد المنطقة 500 متر فقط من قطعة الأرض التي حدّدها المؤرخ الإيرلندي أيان غيبسون عام 1971م، لكن أعمال الحفر التي أُجريت فيها عام 2009م لم تعثر على أي رفات أو عظام.
وثمة إشكال حول قبر الشاعر الإيرلندي، وليام باتلر ييتس، الذي توفي في 28 كانون الثاني (يناير) 1939م في فندق «إدييال سيجور» في روكبرون- كاب- مارتان الواقعة في مقاطعة ألب- ماريتيم الفرنسية على البحر المتوسط قرب الحدود مع إيطاليا. وقد دفن في مقبرة جماعية ونبش رفاته في عام 1946م ووضع في صندوق لحفظ العظام. ولم ينقل النعش الذي يفترض أن يكون ضم رفاته إلى إيرلندا إلا في عام 1948م بسبب مشكلات قانونية واندلاع الحرب العالمية الثانية. وُورِيَ الرفات في الثرى في باحة كنيسة في درامكليف في شمال غرب إيرلندا. وتحوّلت مقبرته- التي حفر عليها أحد أبياته الشعرية «ألقِ نظرة باردة على الحياة وعلى الموت أيها الفارس وامضِ في طريقك»- إلى محج يستقطب آلاف الأشخاص سنويًّا. إلا أن رفات ييتس قد يكون لا يزال في روكبرون- كاب- مارتان.

عادت التساؤلات حول مثواه الأخير إلى الواجهة مع اكتشاف دانييل باري، نجل دبلوماسي فرنسي كبير، وثائق في صندوق في قصر تملكه العائلة. وتنبه باري إلى وجود إشارات إلى اسم الشاعر في الوثائق فقرر تسليمها إلى سفارة إيرلندا في فرنسا. ومن بين هذه المخطوطات تقرير عن التحقيق الذي أجراه موظف في وزارة الخارجية الفرنسية في عام 1948م للتحقق من جدوى نقل رفات ييتس. وتشير هذه الوثيقة إلى أن رفات الشاعر الموجودة في صندوق العظام «مخلوطة بشكل عشوائي مع عظام أخرى»، وتؤكد أنه «يستحيل إعادة البقايا الكاملة والأصلية لييتس».
لا فضيلة للجسد
ثمّة من يسعى إلى جعل قبره للآخرين مزارًا يقصده الزوار، في المقابل هناك بعض المثقفين والكتاب والشعراء الذين لجؤوا إلى التوصية بحرق جثامينهم. ثمّة من يقول إن هذه التوصيات تأتي في إطار «الانشقاق» عن التقاليد الدينية الموروثة والتوجه العلماني والحداثوي الغربي، ولكن لا أحد ينتبه إلى أن فعل الحرق يلتقي مع الطقوس الهندوسية في الهند. حين رحل المخرج السينمائي الفلسطيني ناصر حجاج في فيينا، أوصى بحرق جثمانه، كتبتْ زوجته عبير حيدر في الفايسبوك: «نزولًا عند رغبته، سوف يتم حرق جثمانه ونثر جزء من رماده لاحقًا في مخيم عين الحلوة وعند قبر والدته فاطمة في صيدا، وجزء آخر في قريته الناعمة شمال فلسطين المحتلة، وجزء في سوريا التي تضامن مع شعبها المظلوم حتى آخر نفس، وجزء فوق تراب تونس حيث عاش سنين طويلة من عمره فيها»، قبل حجاج ركزت بعض وسائل الإعلام بقوة على وصية المعماري العراقي، رفعة الجادرجي، التي قال فيها: «كتبت وصيتي وهي في إنجلترا، أريد أن أحرق، لا أدفن، كي لا أدنّس الأرض»، وهو سبق وقال «أنا وزوجتي قررنا ألا ننجب أطفالًا لأن البشر يخرّبون الأرض». ولم يكتب عن كيفية التصرف برماد الجثمان.
المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد، أوصى بحرق جثته ونثر رماده في لبنان، وهو ما تم في 30 أكتوبر 2003م، فنقل رماده إلى مقبرة برمّانا الإنجيلية في ضهور الشوير (جبل لبنان)، وكتبت تفسيرات كثيرة متناقضة حول الحرق والدفن والمعنى والمغزى والسبب، وبعضهم أدخل المسألة في بوابة التأويلات الأسطورية والخرافية، وبدأ يفسر النار والرماد فكريًّا وأدبيًّا، وقال الروائي إلياس خوري: إن «إدوارد سعيد كان يرغب في أن يدفن بأرض عربية وقد اختار لبنان».
أيضًا، أوصى الروائي الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز، بحرق جثته لتتحول ذرات من الرماد المتناثر على أرض كولومبيا والمكسيك. وكان ماركيز في كتابه «قصص ضائعة»، قد كتب مقالًا بعنوان «أبهة الموت»، عن الروتين، ومأساة البيروقراطية في وكالة لدفن الموتى. بفعل الاعتياد والتعامل اليومي مع الموت، يفقد الموت هيبته، ويُعامل الموظفون الموتى وذويهم معاملة آلية باهتة. يذهب ماركيز ليشهد مراسم حرق جثة صديقه، فيجد التوابيت المشتراة من عائلات الموتى لتضم جثامين أحبتهم، وقد صارت بلا جدوى بعد انتهاء مراسم الدفن، فتعمد الوكالة إلى بيعها من جديد لعائلات موتى آخرين.
وأوصت الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو بحرق جثمانها؛ كي تتخلص من الجسد الذي آلمها كثيرًا، ونُثر رماده وحُفظ المتبقي منه في جرة داخل «البيت الأزرق» الذي تحول فيما بعد إلى متحف يضم لوحاتها ليحكي قصة المواجع التي لم تنته. أيضًا أوصى دييغو ريفيرا بحرق جثمانه ومزج رماده مع رماد كاهلو.
وصايا أخيرة
عدا قصص قبور الشعراء وأشكالها ورمزيتها، هناك الكتابات والتعابير التي تخطّ على الشاهدة. كثر من الأدباء والشعراء والفلاسفة، على مر العصور، أوصوا بكتابة أبيات شعرية أو أقوال على شواهد قبورهم، وكانت تنتقى بعناية لتحدد وجهة نظر الشاعر في الحياة نفسها. هل يمكن عدّ ما هو مكتوب على شاهدة قبر شاعر أو فيلسوف أن تلك الشاهدة هي آخر نصوصه؟ بعض الكتّاب اختاروا أن يوردوا نصًّا أثيرًا لديهم سبق أن كتبوه، آخرون هيؤوا جملة خاصة لموتهم ادخروها لتكون منقوشة على بيتهم الأخير، كأن هؤلاء حين يكتبون في وصاياهم عما ينبغي أن يكتب على قبورهم، يطبقون قول الشاعر اللبناني سعيد عقل: «أقول الحياةُ العزمُ، حتى إذا أنا انتهيتُ تَوَلّى القَبرُ عزمي من بَعدي»… في المقابل يقول الروائي الجزائري واسيني الأعرج: «القبور أيضًا تموت بالنسيان». وهناك مئات الأقوال أوصى بها الكتّاب لتدوّن على شواهد قبورهم، فقد أوصى أبو العلاء المعري أن ينقش البيت التالي على شاهدة قبره: «هذا ما جناه أبي علَيّ وما جنيت على أحد!».
كتب صبحي الياسيني، قائمقام معرة النعمان في مجلة «الرسالة» (عدد 588) أن هذا البيت ليس له وجود على قبره ذي الكتابة الكوفية المشجرة، ولا يوجد على شاهد الضريح سوى الكلمات الآتية: «هذا قبر أبي العلاء بن عبدالله بن سليمان». وقد محا الزمان كلمات: «هذا قبر أبي»، وكتب على ظهر الشاهد: رحمة الله عليه. وقد وجد بجوار ضريحه حجر مستطيل الشكل بقياس 50*30 مسطّر عليه هذان البيتان بخط ثلث حديث:

«قد كان صاحب هذا القبر جوهرة… نفيسة صاغها الرحمن من نطف/ عزّت فلم تعرف الأيام قيمتها… فردَّها غيرة منه إلى الصدف». وقد علمت من ثقة في المعرة أن هذا الحجر حديث، جدد عام 1903م بذيل آخر مكتوب بالخط الكوفي أتى عليه الزمان فجدده أهل الفضل. وكان أمر بناء الضريح تكتنفه الصعوبات لعوامل شتى منها تبدل الحكومات المتعاقبة على البلاد السورية، فكأن رغبة أبي العلاء التي أبداها في ترك قبره وعدم الاحتفاظ به قد تحققت بقوة خفية لا يمكن التغلب عليها؛ إذ يقول: «لا تكرموا جسدي إذا ما حل بي… ريب المنون فلا فضيلة للجسد».
وقال: «إن التوابيت أجداث مكررة… فجنب القوم سجنًا في التوابيت».
وأوصى أحمد شوقي أن يكتب على قبره من قصيدته «نهج البردة»: «إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل… في الله يجعلني في خير معتصم». وكتبت أبيات على قبر الشاعر السوري بدوي الجبل من قصيدته «الشهيد» يقول فيها: «أطلّ على الدنيا عزيزًا: أضمّني إليه ظلام السجن أم ضمّني القصر/ وما حاجتي للنّور النّور كامن بنفسي لا ظلّ عليه ولا ستر/ وما حاجتي للكائنات بأسرها وفي نفسي الدنيا وفي نفسي الدهر».
الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري طلب أن يُكتب على شاهد قبره بيت من مطلع قصيدته الشهيرة «دجلة»: «يا دجلة الخير حييتُ سفحكِ عن بعدٍ فحييني، يا دجلة الخير، يا أمّ البساتين».
الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أبى إلا أن يبقى شاهد قبره في ذاته دعوة للحياة «على هذه الأرض ما يستحقُّ الحياة»… وكتب الشاعر السوري محمد الماغوط، على ضريح زوجته: «هنا ترقد آخر طفلة في التاريخ الشاعرة الغالية سنية صالح».

الشاعر الإنجليزي جون كيتس، كان خياليًّا في عباراته المكتوبة على قبره، الموسومة بـ«هنا يرقد من كان اسمه منقوشًا على الماء». وكتب على قبر الفيلسوف إيمانويل كانط عبارة وردت في نهاية كتابه «نقد العقل العملي»: شيئان يملآن عقلي بإعجاب ورهبة لا انتهاء لهما ولا أمد وهو شعور لا يفارقني كلما أمعنتُ التفكير بهما: السماء المطرّزة بالنجوم من فوق رأسي والقانون الأخلاقي في داخلي. أما مُنظّر الشيوعية كارل ماركس فكُتِب على قبره: «يا عمال العالم اتحدوا، لقد فسر الفلاسفة العالم بطرق متعددة، لكن الهدف هو تغييره». وقد خُرّب قبر ماركس مرتين: في المرة الأولى رسم الصليب النازي على القبر وسكب الدهان عليه، وفي المرة الثانية كتب على القبر عبارة «شريعة الكراهية» و«مهندس الإبادة» باللون الأحمر.
وكُتب اسم كونراد على شاهدة بطريقة لا هي بولندية ولا إنجليزية (جوزيف تيودور كوجينوفسكي= اسمه الحقيقي)، كما نقش على الشاهدة عبارة «النوم بعد التعب، الميناء بعد البحار العاصفة، الراحة بعد الحرب، الموت بعد الحياة، كلها تبعث الكثير من السرور»، وهذان البيتان من قصيدة «الملكة الجنية» للشاعر البريطاني إدموند سبنسر.
وأوصت الروائية فرجينيا وولف (التي ماتت منتحرة) أن يكتب على قبرها: «أيها الموت! برُغمَ إرادتك سأُلقي بنفسي، لا مهزومة ولا مُنحنية». وكتب على شاهدة قبر الشاعر روبرت فروست: «كنت في شجار عاشق مع العالم». الشاعرة سيلفيا بلاث (التي ماتت منتحرة أيضًا) آثرت أن يكتب على شاهدتها هذه الجملة: «حتى وسط ألسنة اللهب المضطرمة يُمكنُ غرس زهرة اللوتس الذهبية». واختار الروائيّ اليوناني نيكوس كازانتزاكي عبارة مغرقة في الزهد والتصوّف: «لا آملُ شيئًا، لا أخافُ شيئًا، أنا حر».
وكُتِب على شاهدة قبر الشاعر والروائي الأميركي تشارلز بوكوفسكي كلمة «لا تحاول»، مرفقة برسم أشبه ما يكون لملاكم في معركة الحياة. وكانت حياته بحسب الكاتب مارك مانسون(٥) مثالًا على حياة إنسان انتقل من التسكع والتشرد والفقر إلى الشهرة والنجاح ليس بفضل قناعته بأنه إنسان فريد واستثنائي، بل بسبب عدم مبالاته وقناعته التامة بأن هذه الحياة لا تستحق المحاولة.
هوامش:
(١) أحمد أبو زيد، مقالة نشرت في مجلة «الكلمة».
(٢) حوار مع ريجيس دوبريه: ماذا تبقى من المقدس؟ ترجمة: سعيد بوخليط.
(٣) 150 عامًا على مولد رامبو هنا يرقد التاجر. الشاعر – مجلة «العربي» الكويتية.
(٤) ترجمة وليد السويركي.
(٥) مارك مانسون «فن اللامبالاة»، ترجمة الحارث النبهان.

محمد الحجيري - كاتب لبناني | مايو 1, 2021 | تحقيقات
على الرغم من أن بيروت تعد واحة التعددية والثقافة والحداثة والشعر والأفكار الجديدة والنيّرة والصحافة «الحرة»، فإن لبنان -رغم كل ذلك- شهد منذ الاستقلال عام 1943م أبشع أنواع الاغتيالات السياسية التي طالت أكثر من عشرين صحافيًّا وكاتبًا وأديبًا بارزًا، واستعملت في الاغتيالات العبوات الناسفة والرصاص أو كاتم الصوت، وصولًا إلى الضرب بالفؤوس على الطريقة الداعشية.
ولم ينجُ بعض الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال من التمثيل بجثثهم (سليم اللوزي وسهيل الطويلة، نموذجان)، وبدا أن لبنان بلد هشًّا يسهل فيه فعل أي شيء، خصوصًا في مرحلة الحرب الأهلية (1975- 1990م)، ومرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005م، فلبنان بلدٌ مستباح.
تقول الباحثة منى فياض في محاضرة لها: «إن كثافة عمليات الاغتيال أو محاولات القيام بها تجعلنا نعتبرُ أن الاغتيال في لبنان بعد الاستقلال تحوّل إلى لغة تخاطب أداة عمل سهلة التنفيذ»، وتضيف «يبدو لي أنّ أحد أسباب هذه السهولة في اللجوء إلى الاغتيالات كسلاح لفرض واقع سياسي».
وغالبًا لا يتعرض القتلة للمحاسبة، بل هم «معلومون مجهلون»، نسمع كثيرًا عنهم في الإعلام، لكنهم لا يَمثُلون أمام القضاء، ربما هم «أقوى» من القضاء وفوقه. وبحسب الباحث خليل أحمد خليل «شكّل الإعدام أو الاغتيال السياسي ظاهرة في مندرجات المسألة اللبنانية، تنمّ عن انعطاف في مجرى العلاقة التناقضية بين العدالة والسياسة».
وقاطرة الأسماء التي تعرضت للاغتيال متعددة الانتماءات والأسباب والقراءات، فقد شكل اغتيال الصحافي نسيب المتني، نقيب المحررين السابق، صاحب جريدة التلغراف المعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس اللبناني كميل شمعون الخارجية، فاتحة الاغتيالات السياسية لصحافيي ما بعد الاستقلال، دفع المتني ثمنًا لموقفه السياسي بسبب معارضته لسياسات الرئيس؛ إذ وقف ضد التجديد لرئيس الجمهورية، عادًّا التمديد جريمة. يقول المفكر كريم مروة: «كنت أعرف المتني جيدًا، وهو صحافي ولديه جريدة واسعة الانتشار، وكان عضوًا في الحزب التقدمي الاشتراكي وكان شعبويًّا. تمّ اختياره (اغتياله)، ليعمل مشكلة في البلد، وكان البلد عمليًّا يتحضر لهذا المشكل…» شكل اغتياله الشرارة التي أطلقت موجة عنف في اليوم التالي للاغتيال، فدعت المعارضة إلى الإضراب العام، وفي يوم التشييع انطلقت تظاهرات عارمة في مختلف المناطق اللبنانية، عبّرت عن الغضب والاستنكار ضد الأحلاف العسكرية الأجنبية، وطالبت باستقالة شمعون، وسرعان ما بدأت المواجهة وأدت إلى حوادث 1958م، وهي الحرب الصغرى التي ستكون المقدمة للحرب الكبرى 1975م…
وإذا كانت عملية اغتيال المتني، جاءت داخلية مع كثير من السيناريوهات والتخمينات، فعملية اغتيال الصحافي كامل مروة (16 مايو 1966م) كان لها أبعاد إقليمية معروفة… تكمن أهمية كامل مروة في مساهمته الفاعلة في تطوير الصحافة اللبنانية، إخراجًا وإنتاجًا وتحريرًا، إلى ابتكاره الافتتاحية القصيرة… فالصحافي ابن بلدة الزرارية الجنوبية، مؤسس «الديلي ستار»، و«الحياة» و«بيروت ماتان»، اغتيل بسبب مواقفه السياسية ومعارضته الناصرية، ففي ربيع عام 1966م، أدلى الرئيس جمال عبدالناصر بخطاب قال فيه: إن القوة الجوية المصرية صارت تسيطر على سماء العالم العربي، من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، وإن هذه القوة المصرية قادرة على محو إسرائيل.
علق مروة على خطاب عبدالناصر في افتتاحية في «الحياة»، قائلًا: إنه «إذا كان عبدالناصر قويًّا بما فيه الكفاية للقضاء على إسرائيل، فماذا ينتظر؟» وهذا الموقف كان جزءًا من مواقف كثيرة أطلقها صاحب «الحياة»، فبينما كان عبدالناصر يرى الانقلابات العربية كثورات تحرر، كان مروة ينظر إليها كحركات عسكرية فجّة هدفها التسلط على الحكم، ليس إلا.
وكانت الخاتمة المريرة اغتيال مروة في مكتبه، تقول الروايات: إن الضابط السوري عبدالحميد السرّاج، كلف إبراهيم قليلات رئيس ميليشيا «المرابطون» بعملية اغتيال مروة، وقليلات بدوره جنّد عدنان سلطاني، وأمّن له المسدس بكاتم للصوت، ودرّبه على استخدامه، وفي أثناء المحاكمة قال سلطاني: «ليس بيني وبين المغدور عداء شخصي، وقتلته بسبب تأييده للأحلاف». انتهت المحاكمة التي دامت سنتين إلى المعمعة، فقضت بالإعدام للقاتل عدنان سلطاني، وبالسجن للمشاركين الفارين محمود الأروادي وأحمد «سنجر» المقدم، وبرّأت «المحرض» إبراهيم قليلات. وورد في كتاب «ثلاث مدن شرقية» للكاتب فيليب مانسيل، أنه «وفي منطقة قليلات استُقبلت براءته في عام 1966م من اغتيال صحافي معادٍ لعبدالناصر يدعى كامل مروة بوابل من النيران وذُبح كثير من الخراف».

شعارات تطعن في مروة وترفع من شأن قتلته
ثم تبع ذلك عفو رئاسي خفّض عقوبة الإعدام الصادرة بحق القاتل إلى السجن 20 عامًا، وكان سلطاني سجينًا مرفهًا بأي مقياس. فرعاية المخابرات المصرية له لم تتوقف بعد إدانته. وزيارات موظفي السفارة المصرية في بيروت، وبينهم الملحق الأمني عبدالحميد المازني، كانت متكررة. كما لم يتعقب أحد الأروادي والمقدم، وبقيا حرّين طليقين. وعدا نَحْرِ الخراف تزامنًا مع إعلان «براءة» قليلات، وُزِّعت منشورات في بعض المناطق اللبنانية، «تطعن في كامل مروة، وترفع من شأن المتهمين. وألصقت صور إبراهيم قليلات في عدد من جدران بيروت والضواحي والأرياف، ووصفته بـ«البطل وابن بيروت البار».
وحين توكل محسن سليم (النائب الراحل، والد لقمان سليم الضحية الجديدة للاغتيال السياسي) عن الجهة المدعية ندّد الصحافي سليم اللوزي، صاحب مجلة «الحوادث» بمحسن سليم وقارن بينه وبين إبراهيم قليلات ناسبًا إلى المحامي الوكيل «العمالة». وأغدق اللوزي في الدفاع عن قليلات قائلًا: «عند إبراهيم قليلات، كانت الحقيقة أثمن من الحياة، فغامر بحياته من أجل أن تظهر الحقيقة». وبرر اللوزي دفاعه عن قليلات لأنه يحب «خطه السياسي الذي هو خطنا». ولم يُكمل سلطاني عقوبته؛ إذ نجح في الإفلات من سجنه إبان الحرب الأهلية عام 1976م، أي بعد مرور 10 سنوات على جريمته. وجيء بسلطاني إلى العاصمة المصرية بعد فراره من سجنه في رومية في ذلك العام.
وكان مطار بيروت مقفلًا، فجرى تهريبه بالبحر عبر مرفأ صيدا إلى مصر لمقابلة الرجل الذي أمر، أو ربما أُمر، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال. كانت القاهرة يومئذ قد دخلت عهدًا جديدًا مع تبوُّؤ الرئيس أنور السادات الحكم بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر عام 1970م. أما السراج، فكان نجمه قد أفل بغياب الأخير، ولم يعد له أي شأن، وكان أحد مسببي الفوضى والقتل في لبنان والمسؤول عن اغتيال فرج الله الحلو، الأمين العام للحزب الشيوعي، وتذويبه بالأسيد في دمشق.
عدا انزعاج الناصرية من الأقلام المعارضة، هناك الانزعاج الإسرائيلي من الأقلام المقاومة؛ إذ لجأ الموساد الإسرائيلي إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات ضد شخصيات ثقافية فلسطينية في لبنان، بدءًا بالروائي غسان كنفاني عام 1972م في الحازمية (شرق بيروت)، مرورًا بالشاعر كمال ناصر ورفاقه عام 1973م في فردان.. دائمًا إسرائيل كانت ترى الشعر والثقافة أخطر من المدافع.
القتل جزءًا من يوميات اللبنانيين
مع بدءِ الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975م، صار القتل جزءًا من يوميات اللبنانيين وعناوين صحفهم، ففي الثاني من إبريل 1976م، اغتيل المنظّر كمال الحاج بضربة فأس في رأسه. وكان انتقل مع عائلته إلى قريته الشبانية (جبل لبنان) حيث أسهم في إبعادِ شبح الفتنة عن منطقة يتعايش فيها المسيحيون والدروز، لكنه ما انفك يتلقى تهديدات بالقتل… كان الحاج من دعاة القومية اللبنانية، ومحبًّا للغة العربية، ويرفض العروبة الدينية، نحت كلمة نصلامية للتدليل إلى أن «القومية اللبنانية» هي زواج حضاري بين النصرانية والإسلامية، ونظّر بطريقة شوفينية للقومية اللبنانية في مواجهة القومية الناصرية، وأصدر مجموعة من المؤلفات منها: «فلسفة اللغة» و«رينيه ديكارت»، ويبدو أن شعاراته القومية لم تَرُقْ خصومَه في زمن الفرز المذهبي والقومجي، فحصل الاغتيال البربري الرهيب…
ومع دخول الجيش السوري إلى لبنان في إطار قوات الردع العربية، بدا واضحًا أن لبنان، وهو خاصرة سوريا الرخوة، سيعيش على وقع موجة جديدة من النزاعات والاغتيالات والتصفيات والأحقاد… فعدا الاغتيال الكبير الذي طال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط عام 1977م، كان اغتيال سليم اللوزي، وهو صحافي وُلد في طرابلس، وبدأ مشواره في كتابة القصص. سافر إلى القاهرة للدراسة الجامعية وعمل في روز اليوسف من عام 1945م إلى 1950م، وطُرد من مصر بسبب مقال، وعاد ليعمل في مجلة «الصياد» اللبنانية. وفي عام 1956م اشترى مجلة «الحوادث» ليصدرها أسبوعيًّا، وتطورت بسرعة حتى أصبحت في طليعة المجلات العربية.
كان اللوزي ناصريًّا في زمانه، ودافع في مجلته عن إبراهيم قليلات المتهم والمحرّض على قتل كامل مروة، وكان رافضًا للوجود السوري في لبنان، وكتب مقالات كثيرة في نقده، ويعدّ بعض مريدي الأسد في لبنان أن اللوزي كتب عن الطوائفية في سوريا ولم ينتبه للتحولات الجديدة، وما اقترفه إصداره «الحوادث» في أسبوعين متلاحقين بغلافين مثيرين و«استفزازيين»؛ الأول هو «عقدة العقيد» والثاني «عندما يكذب النظام»، وهو إذ كان يشعر بالأمان في لندن وعاد منها ليومين للمشاركة في جنازة والدته، وخلال عودته من طرابلس ليستقل الطائرة من بيروت، اختفى على طريق المطار، وقُتِل في 4 مارس 1980م، وعثر على جثته أحد الرعاة في أحراج عرمون (جنوب بيروت)… وقد عذب بأبشع الطرق قبل قتله حتى إن أصابعه التي كان يكتب بها أحرقت بالأسيد… كان انتقامًا رهيبًا من رجل كان يختلف سياسيًّا مع النظام الحاكم في سوريا.
وفي 23 يوليو من عام 1980م، اغتال خليل عباس الموسوي وعبدالإله محمد الموسوي نقيب الصحافة رياض طه لأسباب قيل إنها «ثأرية» بعدما نصبوا له كمينًا في منطقة الروشّة– بيروت، مطلقين ما يفوق الأربعين رصاصة، استقرت ستٌّ منها في جسده. وأصدر المجلس العدلي اللبناني حينها، حكمه الغيابي في القضية بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفاعلين (خليل وعبدالإله). والقضية لم تكن عشائرية بالمعنى العميق للكلمة، فكل التحقيقات تؤكد ذلك، وتقول: «إن هناك من دخل على الخط واستغل الخلاف العشائري، وعمل على التحريض ضد رياض طه لتصفية الحسابات السياسية معه، وبخاصة اتهامه يومًا بأنه يتعاطف مع حزب البعث العراقي في زمن تشظي العلاقات العربية- العربية، وانعكاس ذلك على الداخل اللبناني».
وسبق أن تعرض طه لمحاولة اغتيال في عام 1947م؛ بسبب مقالاته في جريدة «أخبار العالم» ضد الإقطاعية والإجرام وبيع الوظائف والسمسرة والإثراء غير المشروع، فكان قد نشر مقالًا بعنوان «خصمي وحاكمي» الذي كان كافيًا لأنْ يَصدر قرارٌ من مجلس الوزراء بتعطيل الصحيفة إلى أجل غير مسمى. كما جرت محاولة فاشلة أخرى لاغتياله في عام 1952م، وقد تبنَّت نقابة الصحافة المقال الذي سبب الاعتداء.
أعنف موجات الاغتيال الثقافي والسياسي
وشهدت مرحلة الثمانينيات أعنف موجات الاغتيال الثقافي والسياسي، طالت عددًا من المفكرين متنوعي التوجهات؛ منهم: الشيخ الدكتور صبحي الصالح في 7 أكتوبر 1986م بمسدس كاتم للصوت في حي ساقية الجنزير (بيروت)، والصالح حاصل على دكتوراه في الفلسفة والدراسات الإسلامية من جامعة السوربون، وكان يشغل رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي الذي كانت تقوم مهمته، على الخصوص، في تفسير الفقه الإسلامي. وعُرف عن الشيخ أنه مؤيد بقناعة للتعايش الإسلامي المسيحي (أتت موجة اغتيال الصالح في إطار حملة طالت مجموعة من الشخصيات السُّنِّيّة؛ منهم: مفتي الجمهورية حسن خالد، والنائب ناظم القادري، والصحافي محمد شقير، وخليل عكاوي…).
وطالت الاغتيالات أيضًا الصحافي الشيوعي سهيل طويلة بعدما خُطف من بيته الذي يقع في المبنى نفسه حيث تقع المستشارية الإيرانية (سفارة إيران) على برج أبي حيدر، إثر اشتباك بين الشيوعيين و«حزب الله». ووُجد سهيل طويلة بعد 24 ساعة من خطفه مقتولًا بست رصاصات في رأسه، مشوهًا ومقتلعة عيناه، ومرميًّا على مكب النورماندي في عين المريسة، وكانت العملية نوعًا من «ثأر» من شقيق أحد القتلة.
 واغتيل المفكر حسين مروة في 17 فبراير 1987م برصاصة واحدة من مسدس كاتم للصوت في غرفة نومه، ومروة تعلم العلوم الإسلامية في النجف، وهناك تَعرَّف إلى بعض الشيوعيين، وترك العمامة، والتحق بالفكر الماركسي، وصار من أبرز مُنظّريه في لبنان، وأصدر مؤلفات مثل: «النزعات المادية»، ورأس تحرير مجلة «الطريق» على مدى سنوات، وكان طريح الفراش حين اغتيل. يروي نجله أحمد سيرته فيسلط الضوء بغزارة في كتابهِ «كما أرادها أن تكتب، سيرة حسين مروة» على أدق تفاصيل حياته الإنسانية الدافئة، ويرمم مسارات الذاكرة لصيرورة حسين مُروّة، ولكن عندما تصل رواية السيرة إلى مرحلة النهاية أي إلى تاريخ حادثة الاغتيال، يقول نبيل مروة (نجل الكاتب وحفيد القتيل): «يُصبح الإيجاز الشديد وعدم البوح، السمتين الطاغيين على صفحات ثلاث فقط لا غير، تسرد الخبر بصيغة حيادية باردة غير مُهتمّة بإعادة بناء مسرح الجريمة من زوايا الصراعات المتعددة وقتذاك وفي مستوياته السياسية والأمنية والعقائدية». ويسأل نبيل والده عن سبب هذا الإحجام في الخوض في موضوع حادثة الاغتيال والاكتفاء بذكر التصريحات العمومية لقيادة الحزب الشيوعي اللبناني التي تارة كانت تتهم «الظلاميين والتكفيريين» بتنفيذ الاغتيالات، وطورًا تتهم «إسرائيل وعملاءها في الداخل». أجاب أحمد مروة: «يا ابني، هل تريد أن يعودوا لأذيتنا؟… أنا لست مهتمًّا لأعرف القاتل وأخبّر عنه، فردًا كان أم حزبًا، ومن أجل ماذا؟ الانتقام أو العقاب! الحقيقة قد تُكتشف عبر هذا الكتاب…! هذا كان واجب الحزب الشيوعي في ذلك الزمن، ولم يستطع عمل أي شيء!».
واغتيل المفكر حسين مروة في 17 فبراير 1987م برصاصة واحدة من مسدس كاتم للصوت في غرفة نومه، ومروة تعلم العلوم الإسلامية في النجف، وهناك تَعرَّف إلى بعض الشيوعيين، وترك العمامة، والتحق بالفكر الماركسي، وصار من أبرز مُنظّريه في لبنان، وأصدر مؤلفات مثل: «النزعات المادية»، ورأس تحرير مجلة «الطريق» على مدى سنوات، وكان طريح الفراش حين اغتيل. يروي نجله أحمد سيرته فيسلط الضوء بغزارة في كتابهِ «كما أرادها أن تكتب، سيرة حسين مروة» على أدق تفاصيل حياته الإنسانية الدافئة، ويرمم مسارات الذاكرة لصيرورة حسين مُروّة، ولكن عندما تصل رواية السيرة إلى مرحلة النهاية أي إلى تاريخ حادثة الاغتيال، يقول نبيل مروة (نجل الكاتب وحفيد القتيل): «يُصبح الإيجاز الشديد وعدم البوح، السمتين الطاغيين على صفحات ثلاث فقط لا غير، تسرد الخبر بصيغة حيادية باردة غير مُهتمّة بإعادة بناء مسرح الجريمة من زوايا الصراعات المتعددة وقتذاك وفي مستوياته السياسية والأمنية والعقائدية». ويسأل نبيل والده عن سبب هذا الإحجام في الخوض في موضوع حادثة الاغتيال والاكتفاء بذكر التصريحات العمومية لقيادة الحزب الشيوعي اللبناني التي تارة كانت تتهم «الظلاميين والتكفيريين» بتنفيذ الاغتيالات، وطورًا تتهم «إسرائيل وعملاءها في الداخل». أجاب أحمد مروة: «يا ابني، هل تريد أن يعودوا لأذيتنا؟… أنا لست مهتمًّا لأعرف القاتل وأخبّر عنه، فردًا كان أم حزبًا، ومن أجل ماذا؟ الانتقام أو العقاب! الحقيقة قد تُكتشف عبر هذا الكتاب…! هذا كان واجب الحزب الشيوعي في ذلك الزمن، ولم يستطع عمل أي شيء!».
وأتى اغتيال حسين مروة في إطار حملة لتصفية الشيوعيين في لبنان، طالت أبرز قادته الفكريين، ومنهم مهدي عامل (اسمه الحقيقي حسن حمدان)، صاحب كتاب «مقدمات نظرية»، وهو اغتيل في مايو 1987م بعد دخول القوات السورية إلى بيروت، واتهمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي «يد العمالة والخيانة»… ويكتمل مشهد الاغتيال برفض مراجع شيعية إقامة صلاة الجنازة على الراحل لأنه شيوعي، يومها قال «اليسار العربي» و«الثقافي»: «الرجعية والفكر الظلامي قتلوا مهدي عامل».
ولاحقًا كتب أحمد برقاوي، الأستاذ في جامعة دمشق، أنه «بعد اغتيال حسين مروة برصاص «حزب الله»، بأيام، اجتمعنا في بيت الدكتور طيب تيزيني، على شرف حضور الفيلسوف والشاعر الماركسي المحبوب، مهدي عامل، وسئل مهدي: كيف ستكون العلاقة بينكم وبين حزب الله وأمل بعد اغتيال حسين مروة؟ فأجاب: لا بد من التحالف معهما، نحن في معركة صعبة. فقلت: من قتل حسين مروة سيقتل مهدي عامل، أخاف عليك. فتبسم مهدي بسمته الطفولية وأجابني: لا تخف علي. ولم يمض على اغتيال حسين مروة أشهر حتى اغتيل مهدي».
مع اتفاق الطائف خفّت الاغتيالات
خفّت عمليات الاغتيال السياسي بعد اتفاق الطائف نهاية الحرب، باستثناء اغتيال الكاتب مصطفى جحا الذي كان وجّه انتقادات قاسية للتدخل الفلسطيني في لبنان، وفي عام 1980م؛ أصدر كتاب «الخميني يغتال زرادشت» انتقد فيه ترك الشيعة للبنانيتهم، وانتقد في الكتاب نفسه مواقف الخميني، وهو ما أثار غضب رجال الدين الإيرانيين. وقد أصدرت المحكمة الشرعية الجعفرية، عام 1983م، فتوى شرعية تقول: إنّ «مصطفى جحا مرتد وكافر!». اغتيل جحا، يوم 15 يناير 1992م، بعد انتهاء الحرب اللبنانية، في منطقة السبتيّة (شرق بيروت)، وقد أُهمل ملف اغتياله بطريقة مريبة. حكى مصطفى جحا (الابن) كيف عايش عندما كان في الثامنة عملية اغتيال والده بداية التسعينيات في بيروت. وبعد أن قرر فتح ملف الاغتيال وإعادة نشر كتب والده أصبح عرضة للتهديد وحاول مجهولون اغتياله.
وبعد عام 2004م عادت موجة الاغتيالات السياسية، ففي 2 يونيو 2005م اغتيل الكاتب والصحافي في جريدة النهار، سمير قصير بعبوة ناسفة تحت سيارته في الأشرفية (شرق بيروت)، وأشارت البي بي سي في اليوم التالي لاغتياله إلى أن الأيادي الملطخة بالدماء امتدت للبنان ثانية لتهاجم واحدًا من أبرز صحافييه، ومن أشجع العناصر في انتقاداتها للنظام السوري.
وسمير قصير صاحب كتاب «تاريخ بيروت»، وأكثر من استعمل عبارة «عسكر ع مين»، من منظري التظاهرات عام 2005م، خلال تحريره مقالات عدة ينتقد فيها النظام الأمني ومدير الأمن العام تحديدًا جميل السيد. وبحسب جزيل خوري، زوجة قصير، فإنه أخبرها قبيل اغتياله بأن السيد اتصل به هاتفيًّا وأبلغه استياءه الشديد منه، وتوعد بقتله شخصيًّا على خلفية مقالاته التي تعرض فيها للجهات الأمنية اللبنانية الموالية لسوريا. غير أن السيد أنكر في تصريحاته للبرنامج أنه توعد قصيرًا بالقتل، وقال: إنه توعد بملاحقة ملفه، والتحقيق في كيفية حصوله على الجنسية اللبنانية، وهو الذي وُلد لأب فلسطيني وأم سورية.
واغتيل الصحافي والسياسي جبران تويني، نجل غسان تويني وحفيد جبران تويني، الذي يمثل الجيل الثالث في جريدة النهار، وكان أعلن في نهاية أغسطس 2005م أنه تلقى معلومات دقيقة من لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بأن اسمه على لائحة الاغتيال، وقرر بعد ذلك السفر وقضاء معظم وقته في باريس، وهو الذي عُرِف بمواقفه «الحادة» تجاه «حزب الله» وسلاحه وولائه، وكان يقول آراءه بلا مواربة، ويفتقد إلى ما يسمى الدبلوماسية… تحدّى تويني نصائح الكثيرين له بالبقاء في باريس، وقرر العودة إلى بيروت، وكانت السيارة المفخخة في انتظاره على طريق منزله في 12 ديسمبر 2005م، في اليوم الثاني لوصوله إلى لبنان. وشكل اغتياله ضربة قاسية لجريدة «النهار»، وأتى بعد محاولة اغتيال خاله النائب مروان حمادة واغتيال زميله سمير قصير، وكان قبل يومين زار في المستشفى بباريس زميلته مي شدياق التي كانت تعرضت لمحاولة اغتيال، وبُترت ساقها ويدها.
ولم تهدأ الاغتيالات السياسية إلا بعد حصول «تسويات» سياسية هشّة، وانحسار الخطاب المضاد للسلاح غير الشرعي في لبنان… ولكن بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019م، بدا أن ثمة تحولات وقعت؛ إذ تصدّعت الأحزاب المسيطرة على السلطة، وتنامى خطاب الشارع الرافض لكل الأحزاب القديمة، ومنهم «حزب الله» الذي طالما عَدَّ نفسه مترفعًا ومنزهًا عن الآخرين؛ بسبب أنه يرفع راية «المقاومة».
حملات إعلامية ضد لقمان سليم
وسرعان ما شُنت حملات إعلامية على «الناشط السياسي» والكاتب والناشر لقمان سليم، وغيره من الناشطين بتهمة العمالة والتبعية للسفارات، وهذا المرة أتت الحملة مصحوبة بشعارات ألصقت على جدران منزله في ضاحية بيروت، أبرزها «المجد لكاتم الصوت». وحصل انفجار مرفأ بيروت وأتت بعده معمعة وبلبلة حول الجهة المسؤولة عن تخزين الأمونيوم فيما سمي العنبر رقم 6 في المرفأ، ولم تمرّ أشهر حتى عادت الاغتيالات بطريقة أكثر غموضًا؛ إذ قتل ضابط متقاعد في غرفته بضربة في الرأس، واغتيل المصور جو بجاني بكاتم للصوت أمام منزله، وقيل: إنه كان من مصوري المرفأ.
ولم تمر أسابيع حتى اغتيل لقمان سليم في 4 فبراير الماضي في جنوب لبنان… والنافل أن لقمان أنشأ في سنوات ما بعد الحرب اللبنانية، مركز «أمم للتوثيق والأبحاث» الذي يؤمن بحسب تعريفه بـ«أن التعامل مع أعمال العنف في تاريخ لبنان، هو أمر أساسي للقضاء على شبح تجدد الصراع الذي لا يزال يتردد على البلاد حتى اليوم». وتفرع عن «أمم للتوثيق» موقع «ديوان الذاكرة اللبنانية». ومَن يتأمل بيانات الموقع، يحسب أن لقمان كان يكتب عن نفسه، أو أنه، بمعنى ما يقرأ في قدره… ويضع لقمان لائحة بالاغتيالات التي حصلت في لبنان منذ عام 1975م يوم اغتيل معروف سعد في صيدا، إلى اغتيال جو بجاني، وكأن قدره أن يكون بينهم. عدا ذلك عُرف لقمان بتصويره بعض الأفلام السينمائية الجريئة، عن مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982م، وعن سجن تدمر في سوريا، وأصدر سلسلة من الملفات تتناول قضايا حساسة مثل ملف المفقودين في لبنان…

محمد الحجيري - كاتب لبناني | يناير 1, 2021 | كتب
يمكن القول: إن القسوة هي القاسم المشترك في كل ما كتبه المعماري والكاتب كنعان مكية عن العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، سواء كتابه «جمهورية الخوف»، أو «القسوة والصمت»، أو «النصب التذكارية» حتى روايته «الفتنة»… ويقرّ مكية بأنه لم يكنْ واعيًا بذلك في البدء، ولكن تجربته الشخصية إثر انتفاضة 1991م ضد نظام صدام حسين، كانت نقطة التحوّل إلى درجة دفع المصطلح إلى الصدارة في ذهنه «منذ ذلك الحين، تحولتْ حرفة الكتابة إلى تجارب تأمل في القسوة، تهيمن عليها المشاعر التي انبثقت تلك السنة».

كنعان مكية
كنعان مكية الذي يبدو كتابه الجديد أشبه بمجموعة كتب متداخلة في كتاب واحد (عن التسامح والمظلومية والذاكرة والمواطنة…)، يقول: «إذا كانت تجربتي في الكتابة عن القسوة قد علّمتني شيئًا، فهو أن القسوة ظاهرة إنسانية تمامًا، فضلًا عن أنها من القضايا التي يصعب مناقشتها بوصفها ظاهرة». فـ«القسوة الجسدية على وجه الخصوص، تتجاوز حدود العقل، ولعل هذا هو السبب الكامن في أن الفلسفة والعلوم الاجتماعية ليس لديها الكثير لتقوله في هذا الموضوع. عالم الكتابة والتفكير المجرّد وبحوث علم الاجتماع تجتنب القسوة، لكن العكس يحدث في عالم الفن… هناك أعمال لبعض الفنانين تدعو حقًّا إلى التفاؤل، فهم ليسوا غرباء عن القسوة، ومن خلال أعمالهم نستطيع الوصول إلى جوهر هذه الظاهرة. فمن دانتي والتقاليد السائدة في تمثيل مشهد الصلب المُخلّص وشغف المسيح في الرسم الإيطالي، إلى غويا الإسباني وهوغارث الإنجليزي، وروايات دوستويفسكي وديكنز، على سبيل المثل لا الحصر، نرى أن الفنانين كانوا أبرز من نجح في إلقاء الضوء على الفظائع التي نقوم بها نحن البشر، بعضنا ضد بعض».
وكنعان مكية الذي أهداه والده قطعة مستنسخة من جدارية لأسد آشور يصارع الموت، وفي ذكرى وفاة والده الأولى قرر أن يزور المتحف البريطاني حيث العمل الأشوري الأصل الذي كان هذا الأسد أحد تفاصيله، ويقرأ في حيثياته وطقوس القديمة، وهو إذ لم يعطه الاهتمام الذي يستحق من قبل، فـ«قد تحول فجأة إلى إحساس غامض وغريب ومذهل»، يضيف «هدفي هنا، بعد ما حدث لي وأنا أقف أمام صيد الأسود، إضافة فنان حرفي آشوري مجهول إلى قائمة الأسماء اللامعة أعلاه؛ ذلك الفنان (القديم) بحسب الرسام العراقي جواد سليم «كان دائمًا حرًّا في التعبير عن نفسه، حتى في خضم الدولة في آشور، يتكلم الفنان الحقيقي من خلال دراما الحيوان الجريح».
شرعنة القسوة
لا يركز كنعان مكية على ممارسات القسوة بل يميل إلى بيان أسس شرعنتها عبر التاريخ في الأفكار، والثقافة، والدين، والمشاعر المتداولة، وأساليب إضفاء الشرعية فضلًا عن تاريخ المرحلة التي نحن فيها. وينتقي مكية أنماط المعاناة التي يمكن عدّها قسوة حسب تعريف كتابات كثيرة، وأعمق ما كتب في الموضوع على أيدي أناس اختبروا ما يكتبون عنه هم: بريمو ليفي في كتابيه «البقاء في أوشفيتز»، و«إذا كان هذا رجلًا»، ألكسندر سولجينتسين وكتاباه «أرخبيل الغولاك» و«يوم في حياة إيفان دينيسوفيتش»، وفاسيلي كروسمان عبر كتابيه «كل شيء يمضي» و«الحياة والقدر»، وهي رواية تقارن برواية «الحرب والسلام» لتولستوي ولكنها تغطي معركة ستالينغراد التي غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية.
يركز مكية على الكاتب ميشيل دي مونتين الذي ذكر القسوة إلى الدرجة التي لم يكن يطيق «النظر إلى دجاجة وهي تذبح» كما كتب؟ لأن صراخها وتفاصيل وجهها وحركاتها الهستيرية كانت توحي له بمقدار ألمها، ومن بين كتاباته الغزيرة، هناك جملة واحد من آلاف الجمل ألحَّت رقابة الكنيسة الكاثوليكية على حذفها، عندما كان مونتين مقيمًا في روما بين العامين 1580م و1581م، رفض الكاتب حذفها وأصرّ على تكرارها مرتين في الطبعة الثانية من كتابه: «يبدو لي أن كل أذى يتعدّى الموت بأبسط أشكاله هو قسوة نقية، أي صافية من كل شوائب».
ويسأل مكية لماذا خشيت رقابة الكنيسة الكاثوليكية في روما هذه الجملة؟ ويجيب لأنها تصف بالكلمات ما كان ينحته الفنان الأشوري المجهول قبل ثلاثة آلاف عام. إنها عملية معقدة أن تتعدى الموت، أي أن يكون هدفك وحساباتك تمديد المدة الزمنية التي يهاجم فيها الألم الجسد قبل الوصول إلى الموت. علينا أن نتذكر أن التعذيب الذي نشمئز منه اليوم، لم يكن منبوذًا على مدى التاريخ، بالعكس، كان التعذيب مستخدمًا ومقبولًا اجتماعيًّا في الحضارة اليونانية والرومانية العتيقة، عملية التعذيب حسب ظن تلك الحضارات، تمسح الفروق بين البشر.
الألم الجسدي
لا يهدف مكية إلى الكلام عن القسوة العقلية، بل الألم الجسدي الذي يرعبنا جميعًا ويمثل صنفًا خاصًّا قائمًا برأسه، وهو مختلف نوعًا ما عن سائر أصناف المعاناة. ويدعو إلى عدم الخلط بين مفاهيم العنف والقسوة، فالقسوة التي يقصدها هي الإفناء من العالم من دون موت. القسوة والتعذيب لا يعنيان القتل بل العكس؛ إذ يغدو الموت وحدة مقارنة بأهوال التعذيب مثل «لعب الأطفال».
القسوة هي المسافة الفاصلة بين الحياة والموت. «العنف ظاهرة أعم من القسوة»، وقد كانت موجودة في الطبيعة بين الحيوانات قبل دخول الإنسان على الخط. القسوة باختصار، هي ابتكار جنسنا البشري بعد انفصاله البيولوجي عن عالم الحيوانات. «العنف في صميمه أداتي وحياتي، فيما تمارس القسوة لإفناء ذات الإنسان» كما كتب الفيلسوف النمساوي جان أمري الذي ذاق العذاب على يد الغستابو الألماني، انتحر بعد الحرب العالمية الثانية، لكن خلف كتابًا مهمًّا عن تجاربه ومشاعره تحت التعذيب. «لا يمكن أن نقف محايدين أمام القسوة، فحتى عندما يدافع الإنسان عن ضرورة استخدامها، فهو يشمئز منها»، يقول مكية: منذ فويرباح ونيتشه وفرويد في العصر الحديث، حل الخوف في الفناء عن الوجود وعذاب جهنم محلّ قوى الطبيعة الفتاكة، التي أصبحنا نسيطر عليها بفعل التقدم التكنولوجي… والحيوانات مثل أسود آشور، التي يفتتح مكية الكتاب بسردية عنها، تعرف العنف والألم الذي هو جزء من الطبيعة لا خيار فيه، لكنها لا تعرف القسوة التي ابتكرها الجنس البشري، وفي ضوء كتاب الأنثروبولوجي إرنست بيكر «إنكار الموت»، يبدو أن الجنس البشري استخدم فكرة التضحية غالبًا، وسيلة لدرء مخاوفه من الموت.
وإن لإدراكنا الخوف من الموت هو الدافع الرئيسي الكامن خلف كل الحضارات والإنجازات الإنسانية. وبات واضحًا أن أي بحث في تاريخ الوعي متعلق بظاهرة القسوة، عليه أن يبدأ بتجارب القارة الأوربية؛ منها يظهر على الفور أن للقسوة المبرمجة على يد السلطة تاريخًا طويلًا وخاصًّا بها، لقد بدأ التصدي للممارسات البشعة مع القرن السابع عشر في فرنسا وبريطانيا على يد مجموعة من المفكرين والنشطاء في الساحة العامة والأفكار، أصبحوا فيما بعد رموز عصر الأنوار، من نحو مونتين الذي يعدّه كنعان مكية الأب الروحي لكتابه، ولوك ومونتسكيو، المنظر الأبرز لمبدأ فصل السلطات، وفولتير الذي تزعَّم حركة احتجاج واسعة في فرنسا ضد عقوبات الكنيسة الكاثوليكية.
ولم يكن دور الفنانين في تناول القسوة أقل أهمية من سواهم من المثقفين، فالفنان الإنجليزي وليم هوغارث رسم «مراحل القسوة» في أربع لوحات وُزّعت كالمناشير بين الناس. الرسام الإسباني غويا الذي كان شاهدًا على رعب «الحرب النابليونية»، ركز في أعماله على الإساءة إلى الأسرى وجرائم الحرب، في سلسلة من الصور المسماة «كوارث الحرب».
انتهاك حرمة الجسد
طوال المدة التي عملت فيها الرموز الثقافية من أمثال غويا وتصدرت للقسوة في مجتمعاتها الأوربية، انصبّ القسم الأكبر من نقدها على انتهاك حرمة الجسد. ودور الرواية لا يقل أهمية من الفنون التشكيلية وتفشي الأفكار الجديدة التسامحية. الرواية الحديثة الأولى كما يؤكد أكثر من ناقد ومؤرخ، تعود إلى سرفانتس الذي نشر الجزء الأول من روايته «دون كيخوته» عام 1615م. عاش سرفانتس حياة قاسية جدًّا بمقاييس عصره؛ إذ جرح في معركة ليبانتو، وهو ما أدى إلى فقدانه كفه اليسرى، وألقى القراصنةُ القبضَ عليه عام 1575م، ليُستعبَد في الجزائر خمس سنوات، وعمل جاسوسًا لإسبانيا بعد الإفراج عنه في البرتغال والجزائر.
لأسباب غامضة، بدأ كتابة «دون كيخوته» وهو في السجن. أهمية قسوة الحياة التي عاشها تأتي في الطريقة الفذة التي جسدها في روايته… في عالمنا العربي هناك الكثير من التجارب المشابهة في التصدي لظاهرة القسوة، منها إميل حبيبي الذي نقل قسوة الحياة الفلسطينية موضوعًا لروايته «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل»، يقول مكية: «إن الرواية، ولا سيما تلك التي تعتمد الضحك، هي العدو اللدود للقسوة أينما رفعت رأسها».
في المقابل اليوناني أفلاطون لا يخاف بعض فناني الضحك والسخرية؛ لأنهم قد يشكلون معارضة لجمهوريته المثالية فحسب، إن مشكلته مع الضحك والسخرية أعمق من هذا، إنه يخشى الضحك نفسه، يخشى المهن المرتبطة بإخراج وتسويق الضحك، ولا سيما عندما يمارس على أيدي المتفوقين فيه، يفهم أفلاطون أيضًا أن هذه المهن لا تنبثق من شيطان أو إبليس خارج الإنسان بل داخله. وأصول القلق الأفلاطوني من فنون الضحك تكمن في أنها تمثل هروبًا من العقل باتجاه المشاعر والغرائز، وتنطوي على نوع من الإنفلات النفسي.
يرى مكية أن الحبّ المفرط للنفس، أو للذات العربية أو الإسلامية، الذي بات في وضع يتجه من سيئ إلى أسوأ، قد أبعدَنا من التأمل في ظواهر تخلفنا، مثل قسوة مجتمعاتنا وفقرنا وقمعنا المتفاقم للأقليات…، وكل شيء ينتج تداعيات لا تنتهي، فإذا كان من الطبيعي التضامن والتعاطف مع ضحايا القسوة كرد فعل على الظلم، فلقد انطلقت كل حركات التحرر، بشكل أو بآخر، من غريزة التضامن تلك.
هذا التعاطف يكون جديرًا بالتصديق ما دام المرء يدرك أنه ليس «أنا» الذي يعاني الظلم، بل «الآخر». لكن الإغراء الأخطر هو أن نذهب أبعد من هذا التضامن، لننسب المثالية للمظلوم وكأنها موجودة ومتأصّلة في حالة المظلومية نفسها، أي أن نجعل المظلوم في مخيلتنا قدوة أو مصدر إعجاب، بل مَثَلًا أعلى في الحياة…
ويقرّ مكية بأن رفض القسوة من دون تحفظ وفي المطلق يُعَدّ إنجازًا مهمًّا للإنسانية؛ إذ مهد الطريق للفردانية بوصفها الحجر الأساس للمواطنة الحديثة. أصبح رفض القسوة هو السبيل والشرط الأساسي للمواطنة لا العكس، ولكن في الوقت نفسه كان بداية لشق الطريق إلى الحداثة، «القسوة هي حالة قصوى من الوجود كالفقر المدقع. القاسم المشترك بين تغلغل القسوة والفقر هو الدرجة التي يختزلان فيها خصوصيات الإنسان؛ هويته وثقافته ودينه وانتماءه الطائفي… الفقر والقسوة سوية»… الإنسان تحت التعذيب أقرب إلى الفقير الذي يبحث عن لقمة العيش…

محمد الحجيري - كاتب لبناني | مارس 1, 2020 | تحقيقات
منذ بدء الاحتجاجات في لبنان (سميت انتفاضة وثورة وحراكًا)، طرح السؤال عن علاقة المثقفين والكتّاب بالتحركات والتظاهرات ودورهم فيها، خصوصًا أنها أتت من خارج الأحزاب التقليدية. تظاهرات بدأت عفوية وسرعان ما أصبحت كثيرة التشعبات في أكثر من مدينة وبلدة ودسكرة، واستعملت فيها شتى أنواع الطقوس والتعابير، من الهتافات النابية (طالت معظم زعماء الأحزاب اللبنانية الذين يقدسون أنفسهم) إلى الضرب على الطناجر (الأواني المطبخية) وصولًا إلى الكتابة على الجدران (الغرافيتي والإستنسل)، وشغلت الرأي العام بوجوهها وشبانها ونسائها. بدا الناس فيها كأنهم في «هايد بارك» بلا سقف، يعبرون بمواقفهم مباشرة على شاشات التلفزة بكل حرية، يريدون محاسبة كل شيء، يصفّون حساباتهم مع الماضي والحاضر والمستقبل، كأنهم على صفحات الفيسبوك، أو كأن عالم الفيسبوك وتعليقاته نزلوا إلى المجال الافتراضي إلى الشارع الواقعي، فحتى الطالب المختلف مع أستاذه في المدرسة أو الجامعة نزل ليحاسبه.
على أن المثقفين اللبنانيين في علاقتهم بالمظاهرات هم مثل الشعب اللبناني، منقسمون بين علمانيين ومدنيين و«ممانعين» مناهضين لثقافة الغرب حتى طائفيين… في الأيام الأولى لم يشاركوا في التظاهرات، وسرعان ما تفاعلوا مع التحركات اليومية في مختلف المدن والساحات، وبخاصة ساحتا البرج ورياض الصلح (وسط بيروت) حيث كانوا ينزلون يلتقطون الصور أمام تمثال الشهداء وبين خيام المعتصمين أو في سينما البيضة التي اتخذتها بعض المجموعات المنتفضة مقرًّا لنشاطاتها الثقافية وموئلًا لإطلاق شتى رسوم الغرافيتي. ومن الذين نشروا صورهم وهم في وسط بيروت: الروائيون جبور الدويهي، ومحمد أبي سمرا ورشا الأمير وبسمة الخطيب… الباحث أحمد بيضون والباحثتان عزة شرارة، ودلال البزري. المعلق السياسي حازم صاغية. الشعراء شوقي بزيع، يوسف بزي، يحيى جابر، وبعض الفنانين التشكيليين مثل جميل ملاعب وريم الجندي والبريطاني طوم يونغ…
في الجانب الفني، غاب المؤلف الموسيقي زياد الرحباني بشكل كليّ عن الساحات واقتصر حضور اسمه على الشائعات والتسريبات، ومقابلة تلفزيونية واحدة، في حين كان الفنان مارسيل خليفة الأكثر اندفاعًا في حفز الناس على المشاركة في التحركات المطلبية، انطلق من مدينة طرابلس (شمال لبنان) ولم يوفر النبطية وصور وبعلبك (حيث يسيطر حزب الله) إلى جانب صيدا ومناطق أخرى، وهو يغني أغنيته الشهيرة «شدوا الهمى»… ولا يختلف الأمر مع الفنان أحمد قعبور الذي غنى «أناديكم» في بلدة الفاكهة (شرق البقاع)، وفي النبطية جنوب لبنان ومناطق أخرى… وكان لافتًا مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين في عرض الاستقلال المدني وهم ينشدون ويغنون ومنهم فادي أبي سمرا، عبدو شاهين، حنين أبو شقرا، بديع أبو شقرا، حنان الحاج علي، إلى جانب الفرق الشبابية التي تعزف في ملهى المترو (أبرز معلم ثقافي ترفيهي في شارع الحمرا بيروت)…
في التفسير والتوصيف
حضور المثقفين في التظاهرات اللبنانية كان له أوجه مختلفة، بين المشاركة الميدانية من جهة، ومن جهة أخرى المشاركة الميديائية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التعليقات والمواقف المؤيدة للمحتجين، أو التي تشخّص الواقع، وتوصّف الفئات المنتفضة في الشارع من هي؟ ومن أين أتت؟ وماذا تريد؟ قال الباحث وضاح شرارة صاحب كتاب «دولة حزب الله» عن المتظاهرين إنهم «أيتام الريوع»، بمعنى أنهم كانوا من المستفيدين من السلطة وأركانها في مرحلة، قبل أن تجف السيولة فيلجؤون إلى الشارع، وهم علامة من علامات الانهيار الاقتصادي. وفي مقال آخر، اعتبر أن «علاج السلطة الفاسدة، والغالبة، سلطة أخرى في مقابلتها، وليس الخبرة «المحايدة» التي يصح فيها قول أحدهم في المثالية الأخلاقية: هذه المثالية نظيفة اليدين إلا أنها تفتقر إلى يدين». (يقصد أن المتظاهرين في الشارع بلا قوة).
وكتب الباحث والمؤرخ اللغوي أحمد بيضون مقالًا بعنوان «المُناهَبةُ أو البنْيةُ السياسيّةُ لمَسارِ الدولةِ اللبنانيّة نحو الإفلاس»، مفندًا مكامن الفساد في الجمهورية اللبنانية منذ اتفاق الطائف وتأسيس الجمهورية الثانية في بداية التسعينيات. وفي تعليق فيسبوكي بدا بيضون سعيدًا بالاحتجاجات في صورتها الجديدة، عاقدًا الأمل على مسارها وعلاقتها ببيروت قال: «لم أكُنْ أجِدُ بيروت جميلةً. أقيمُ فيها من سنِّ الثامنةَ عشرةَ وأنا اليومَ على عتبةِ السابعةِ والسبعين ولم أكن أراها جميلة. كنتُ أقارِنُها بما أعرِفُ من مدُنٍ في أصقاعِ الأرضِ المُخْتَلِفةِ فلا أراها جميلة. مع ذلك، كانَ يكفيني سلْمُها العاديّ لأسْتَمْتِعَ بالحياةِ فيها كثيرًا ولكن لم أكُنْ من أهلِ التغزُّل بها، في أيّ حال. (…) هي تنفِّذُ الآنَ انقلابًا خطرًا. انقلابًا خطيرًا جدًّا، ولكنّهُ انقِلابٌ على مواطنِ الخطرِ في بواطِنِ تاريخِها المعاصِر. وهي تنفّذُه ومعها غيرُها من مدن لبنان ونواحيه فلا تستأثِرُ بانقلابِها على نَفْسِها. لذا هي جميلةٌ الآن»…
وقدم بعض المثقفين انطباعات مختلفة ومتنوعة في تفسير التظاهرات وقراءة توجهاتها وتأثيراتها. قالت الباحثة السيكولوجية منى فياض: «اللبنانيون الذين أوكلوا، قبل أكثر من خمسة عقود، مهمة قهرهم إلى جلاديهم من الطغاة وسماسرة السياسة وأمراء الطوائف، يتلون الآن فعل الندامة، ويتولون بأنفسهم صناعة التاريخ». المفكر اليساري كريم مروة الذي وُصف «بالفتى التسعيني» (في التسعين من العمر) لأنه حضر في تظاهرات طرابلس وصور وشارك في الدبكة مع المحتجين في النبطية متحدثًا ومشجعًا قائلًا للشبان: «إن ما فعلتموه لم نستطع فعله نحن في السابق»، وكذلك شارك الشاعر شوقي بزيع في الاعتصامات لكن من دون رفاقه الشعراء الذين يجلس معهم في مقاهي بيروت، كأنه وحده من يؤيد الاحتجاجات، وقال في حوار صحفي: «أنا من الذين يعيشون هذا الفرح الاستثنائي الذي سبّبته انتفاضة اللبنانيين التي قد تأخذ طريقها لتصبح ثورة متكاملة؛ لأنها تحتاج إلى رؤية متكاملة ولأن تفرز قياداتها. هذه الثورة عجيبة لأنه ليس لها ملهمون بالمعنى الفردي وليست لها قيادات، وولدت من شرطين هما سفالة هذه الطبقة السياسية وفسادها المستشري وتعاملها مع الناس بوصفهم قطعانًا أو بلوكات عمياء ملحقة بهذا الزعيم الطائفي أو ذاك»…
وفي وسط بيروت كان يحضر الشاعر عقل العويط بشكل يومي، ومن خلال مقالاته في جريدة «النهار» وفي آخر صرخاته «لن أسمح لكم بتجويعي». أما الروائي إلياس خوري فكان على رأس مظاهرة المثقفين إلى جانب المخرجين ربيع مروة وروجيه عساف. أكد خوري «أن الثورة انتصرت وأن الشباب والصبايا قد أنهوا الحرب الأهلية في اللحظة الأولى التي نزلوا فيها في 17 تشرين الأول، قائلًا: إن الطبقة السياسية انهارت كليًّا ولم يعد يوجد قداسة لأي زعيم». وأشار إلى أنّ المنتفضين أوجدوا لغة جديدة، لا يمكن تجاهلها، والثورة رجّعت المعنى للكلام. ويجب أن يكون هناك أفق لعمل اجتماعي ثقافي فكري جديد. وتابع خوري تأكيده «أننا بحاجة لنبني وطنًا لأننا ورثنا مشكلة وليس وطنًا، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب، وخصوصًا الطلاب يعلموننا كيف نبني وطنًا، بعد أن عملت الطبقات السياسية المتعاقبة على نهبه وتدميره».
خطر العنف
المعلق السياسي حازم صاغية عاد إلى الفيسبوك بعدما غادره لمدة «هاربًا» من الجدل الذي أحدثه بعدما أعلن رأيه بوضوح في الفنانة فيروز لم يستسغه كثيرون من عشاق الفنانة اللبنانية… هدف عودة صاغية إلى الفيسبوك ليس ترفًا ولا حب التسلية، بل مواكبة التحركات الاحتجاجية، التي اعتبرها «لحظة تأسيسية في لبنان»، ولكنه في المدة الأخيرة بدا متوجسًا من لجوء بعض المحتجين إلى العنف، مفرقًا بين العنف كردة فعل احتجاجية و«العنف الممجّد» والأيديولوجي الذي له مخاطره؛ إذ ظهرت إلى الواجهة شعارات تمجّد علي شعيب، أحد الذين اقتحموا مصرف «بنك أوف أميركا» في وسط بيروت في السبعينيات من القرن الماضي وقتلته القوى الأمنية مع اثنين من مجموعته، وتأتي هذه الشعارات بعد تحريض حزب الله أكثر من مرة ضد المصارف، وبعد الإجراءات المصرفية من خلال منع المواطنين من سحب ودائعهم… واللافت أن من بين المؤيدين رمزية علي شعيب بعض الشعراء مثل يحيى جابر والسينمائي أحمد غصين وكثير من الناشطين وبخاصة الشيوعيون واليساريون… وتوجس من مشهد العنف مجموعة من المثقفين اللبنانيين، بينهم الصحافي جهاد الزين الذي كتب «العنف لعبة أكبر من الطبقة الوسطى الثائرة، حذار»… ونشرت منى فياض بعد الهجوم على مصارف شارع الحمرا صورة شجرة اقتلعها المتظاهرون الذين يمارسون التكسير وكتبتْ متهكمة «اقتلعوها… يبدو أنها من عصابة «حكم المصرف»، وقال الروائي محمد أبي سمرا: إن التظاهرات اللبنانية تجمع شبانًا من علي شعيب (أي المؤيدين للعنف) إلى شباب ما بعد الحداثة، وتعرض إلى انتقاد حاد من اليساريين لأنه مس ما يعتبرونه أيقونة (علي شعيب) في ذاكرتهم… الباحث أحمد بيضون أيضًا عارض العنف قائلًا: «أعارِضُ لجوءَ الحركةِ الشعبيّةِ إلى العُنْفِ. عارضتُهُ أمْسِ وأعارِضهُ اليومَ وغدًا. لا أعارضِهُ حرصًا على الأملاكِ العامّةِ والخاصّةِ ولا على سلامةِ قوى القمعِ ولا على راحةِ بالِ المصارف. أعارِضُهُ خوفًا منه على الحركةِ الشعبيّةِ نفسِها: خوفًا من زَجِّ جمهورِ الحركةِ الأعرضِ في البيوتِ مسمّرًا أمام الشاشاتِ بَعْدَ أن خرجَ من الساحاتِ، وخوفًا من تحوّلِ الحركةِ إلى حركةِ مجموعاتٍ ضئيلةِ الأعدادِ «متفرّغةٍ» للنضال».
التخوين
لم تخل موجات التظاهر في لبنان من حملات التخوين والبلبلة، اتُهم الصحافي بيار أبي صعب بأنه المحرض من خلال تغريداته ضد «خيمة الملتقى» في وسط بيروت حيث كان من المقرر إقامة ندوة ثقافية عن سياسة «حياد لبنان» للباحث عصام خليفة، وسرعان ما ألغيت بعد محاولة إحراق الخيمة من جانب محتجين مقربين من حزب الله، وهم يهتفون «صهيوني صهيوني» ضد الناشط لقمان سليم، لمجرد أنه قال في مداخلته «دولة إسرائيل» وليس الكيان الصهيوني فاتهم بالتطبيع، وجرى التحريض عليه؛ إذ وزعت على باب منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت عبارات «المجد لكاتم الصوت». أيضًا اتهم «أبي صعب» بالتحريض على ندوة كان من المقرر أن يقدمها المثقف الماركسي اللبناني المقيم في بريطانيا جلبير الأشقر. غرد أبي صعب داعيًا إلى حضور الندوة بكثافة، فهم قرّاء التغريدة أنها دعوة مبطّنة إلى الهجوم على الندوة، وكما كتب الصحافي الفلسطيني راشد عيسى: «مفهوم تمامًا ماذا يعني أن يدعو أحد أبرز الناطقين باسم «حزب الله» للنزول بكثافة إلى فعالية كهذه، في عزّ موجة حرق خيام الثوار بحجة نقاشها بأمور التطبيع مع إسرائيل، وإلصاق تهديدات تمجّد كاتم الصوت». قال جلبير الأشقر كانت النتيجة الطبيعية أن خشي المسؤولون عن المنتدى الذي كانت ندوتي سوف تُقام فيه من أن يؤدي الأمر إلى تخريبه، فطلبوا إلغاءها…
بعض الإعلاميين الممانعين المؤيدين لحزب الله الاحتجاجات في نظرهم هي للزعران وقطاع الطرق، وبعض المؤيدين للرئيس اللبناني ميشال عون يقولون «ثورة سرقها الزعران»، لمجرد أنها شتمت جبران باسيل.


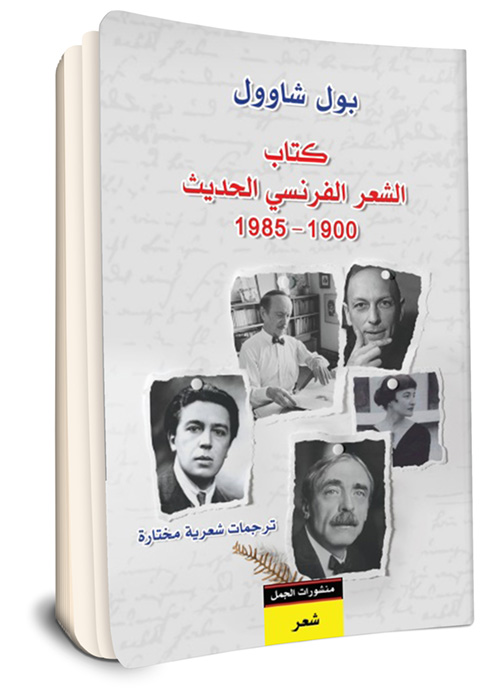 وفي عام 1977م أصدر مجموعته «بوصلة الدم» وهي قائمة على عبثية المعنى، وأقرب إلى قصيدة سياسية غير منبرية وغير خطابية، أتت مباشرة بعد موجات العنف في لبنان… وفي ديوانه «وجه يسقط ولا يصل» (1981م)، القائم على كثافة الصورة، كتب ما سُمِّي آنذاك «قصيدة البياض»، أي القصيدة المفتوحة المكثّفة المختزلة والمقطّرة التي تترك كثيرًا من الظلال فيما يسمّيه بول شاوول «المعنى الناقص» أو «الإيحاء الناقص»، و«ليس البياض زخرفًا ولكن باعتباره جزءًا مضمرًا من اللغة، نصف القصيدة كلام ونصفها الآخر صمت». يقول شاوول: والقصيدة «تتخذ من البياض حيزها السينوغرافي، تمامًا كما في المسرح، حيث يلعب الفضاء السينوغرافي دورًا مكملا للكلمة». تقول الكاتبة مليكة مبارك (مجلة نقد): و«الفراغ في كل مجموعاته يبدو ماثلًا، ناظمًا المدى النصي في كل قصيدة على النحو الذي ينسجم مع فلسفته الشعرية العدمية».
وفي عام 1977م أصدر مجموعته «بوصلة الدم» وهي قائمة على عبثية المعنى، وأقرب إلى قصيدة سياسية غير منبرية وغير خطابية، أتت مباشرة بعد موجات العنف في لبنان… وفي ديوانه «وجه يسقط ولا يصل» (1981م)، القائم على كثافة الصورة، كتب ما سُمِّي آنذاك «قصيدة البياض»، أي القصيدة المفتوحة المكثّفة المختزلة والمقطّرة التي تترك كثيرًا من الظلال فيما يسمّيه بول شاوول «المعنى الناقص» أو «الإيحاء الناقص»، و«ليس البياض زخرفًا ولكن باعتباره جزءًا مضمرًا من اللغة، نصف القصيدة كلام ونصفها الآخر صمت». يقول شاوول: والقصيدة «تتخذ من البياض حيزها السينوغرافي، تمامًا كما في المسرح، حيث يلعب الفضاء السينوغرافي دورًا مكملا للكلمة». تقول الكاتبة مليكة مبارك (مجلة نقد): و«الفراغ في كل مجموعاته يبدو ماثلًا، ناظمًا المدى النصي في كل قصيدة على النحو الذي ينسجم مع فلسفته الشعرية العدمية».

 كُثر هم الذين زاروا قبر رامبو ووضعوا الورد عليه، وكتبوا عن «السياحة الأدبية». ربما أبلغ تعبير عن الزيارات ما كتبه الشاعر البيروفي خوسيه لويس أيالا «لا شيء في مقبرة شارلفيل،/ ولا الريح حتى/ أهو فصل آخر في الجحيم؟/ أنظّم شاهدة القبر،/ والحارس العربيّ العجوز يخبرني/ لا أحد يزوره/ غير اليمام والمطر»
كُثر هم الذين زاروا قبر رامبو ووضعوا الورد عليه، وكتبوا عن «السياحة الأدبية». ربما أبلغ تعبير عن الزيارات ما كتبه الشاعر البيروفي خوسيه لويس أيالا «لا شيء في مقبرة شارلفيل،/ ولا الريح حتى/ أهو فصل آخر في الجحيم؟/ أنظّم شاهدة القبر،/ والحارس العربيّ العجوز يخبرني/ لا أحد يزوره/ غير اليمام والمطر»






 واغتيل المفكر حسين مروة في 17 فبراير 1987م برصاصة واحدة من مسدس كاتم للصوت في غرفة نومه، ومروة تعلم العلوم الإسلامية في النجف، وهناك تَعرَّف إلى بعض الشيوعيين، وترك العمامة، والتحق بالفكر الماركسي، وصار من أبرز مُنظّريه في لبنان، وأصدر مؤلفات مثل: «النزعات المادية»، ورأس تحرير مجلة «الطريق» على مدى سنوات، وكان طريح الفراش حين اغتيل. يروي نجله أحمد سيرته فيسلط الضوء بغزارة في كتابهِ «كما أرادها أن تكتب، سيرة حسين مروة» على أدق تفاصيل حياته الإنسانية الدافئة، ويرمم مسارات الذاكرة لصيرورة حسين مُروّة، ولكن عندما تصل رواية السيرة إلى مرحلة النهاية أي إلى تاريخ حادثة الاغتيال، يقول نبيل مروة (نجل الكاتب وحفيد القتيل): «يُصبح الإيجاز الشديد وعدم البوح، السمتين الطاغيين على صفحات ثلاث فقط لا غير، تسرد الخبر بصيغة حيادية باردة غير مُهتمّة بإعادة بناء مسرح الجريمة من زوايا الصراعات المتعددة وقتذاك وفي مستوياته السياسية والأمنية والعقائدية». ويسأل نبيل والده عن سبب هذا الإحجام في الخوض في موضوع حادثة الاغتيال والاكتفاء بذكر التصريحات العمومية لقيادة الحزب الشيوعي اللبناني التي تارة كانت تتهم «الظلاميين والتكفيريين» بتنفيذ الاغتيالات، وطورًا تتهم «إسرائيل وعملاءها في الداخل». أجاب أحمد مروة: «يا ابني، هل تريد أن يعودوا لأذيتنا؟… أنا لست مهتمًّا لأعرف القاتل وأخبّر عنه، فردًا كان أم حزبًا، ومن أجل ماذا؟ الانتقام أو العقاب! الحقيقة قد تُكتشف عبر هذا الكتاب…! هذا كان واجب الحزب الشيوعي في ذلك الزمن، ولم يستطع عمل أي شيء!».
واغتيل المفكر حسين مروة في 17 فبراير 1987م برصاصة واحدة من مسدس كاتم للصوت في غرفة نومه، ومروة تعلم العلوم الإسلامية في النجف، وهناك تَعرَّف إلى بعض الشيوعيين، وترك العمامة، والتحق بالفكر الماركسي، وصار من أبرز مُنظّريه في لبنان، وأصدر مؤلفات مثل: «النزعات المادية»، ورأس تحرير مجلة «الطريق» على مدى سنوات، وكان طريح الفراش حين اغتيل. يروي نجله أحمد سيرته فيسلط الضوء بغزارة في كتابهِ «كما أرادها أن تكتب، سيرة حسين مروة» على أدق تفاصيل حياته الإنسانية الدافئة، ويرمم مسارات الذاكرة لصيرورة حسين مُروّة، ولكن عندما تصل رواية السيرة إلى مرحلة النهاية أي إلى تاريخ حادثة الاغتيال، يقول نبيل مروة (نجل الكاتب وحفيد القتيل): «يُصبح الإيجاز الشديد وعدم البوح، السمتين الطاغيين على صفحات ثلاث فقط لا غير، تسرد الخبر بصيغة حيادية باردة غير مُهتمّة بإعادة بناء مسرح الجريمة من زوايا الصراعات المتعددة وقتذاك وفي مستوياته السياسية والأمنية والعقائدية». ويسأل نبيل والده عن سبب هذا الإحجام في الخوض في موضوع حادثة الاغتيال والاكتفاء بذكر التصريحات العمومية لقيادة الحزب الشيوعي اللبناني التي تارة كانت تتهم «الظلاميين والتكفيريين» بتنفيذ الاغتيالات، وطورًا تتهم «إسرائيل وعملاءها في الداخل». أجاب أحمد مروة: «يا ابني، هل تريد أن يعودوا لأذيتنا؟… أنا لست مهتمًّا لأعرف القاتل وأخبّر عنه، فردًا كان أم حزبًا، ومن أجل ماذا؟ الانتقام أو العقاب! الحقيقة قد تُكتشف عبر هذا الكتاب…! هذا كان واجب الحزب الشيوعي في ذلك الزمن، ولم يستطع عمل أي شيء!».


