
سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | يناير 1, 2020 | إعلام
تحتل الشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي سلطة الخبر الموثوق، وبذلك تؤثر في شريحة واسعة من الجمهور من خلال عملية التلقي في وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا أن انتشارها يكون على نطاق واسع، وفي وقت قياسي. أمام هذا الاكتساح الذي يشبه النار في الهشيم، تقف الجهات الرسمية عاجزة في كثير من الأحيان عن الحد من بث الإشاعات ودحض مزاعمها المزيفة. سألنا عددًا من المثقفين العرب عن تأثير الإشاعة في الرأي العام ودورها في تزييف الحقيقة واقتراح السبل لمواجهتها والحد من تأثيرها: كيف يروَّج للشائعة في وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار غير الموثوقة؟ كيف يمكن أن تؤثر في شكل واسع من خلال عملية التلقي في نطاق واسع؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ وأين الدور الرسمي للحد من تأثيرها؟
هاشم الجحدلي: مصدر خطير لزلزلة الرأي العام
في كتابه الشهير «الشائعات.. الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم»، يكشف جان- نويل كابفيرير عن مدى خطورة الشائعات ودورها المؤثر في المجتمعات اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا. ومن خلال الجهد الكبير الذي بذله الباحث في تقصي ظهور هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمعات القديمة يمكن لنا أن نؤصل لحالتها الراهنة التي أصبحت حالة أكبر من حدود الظاهرة، حالة توازي الواقع الحقيقي، بعد أن وجدت حاملًا قويًّا وجبارًا وذائع الصيت يتمثل في منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الشائعة والأخبار المزيفة والملفقة تحولت الآن إلى مصدر خطير لزلزلة الرأي العام، وتشوية سمعة أشخاص ومنتجات، من خلال توظيف المعلومة الكاذبة أو الصورة المفبركة، أو استغلال الفوتوشوب في حذف أو إضافة شيء مفبرك للصورة الأصلية. بل يتعدى الوضع أحيانًا هذه الصور إلى تغيير معلومة أو اختلاق معلومة زائفة عن شيء لا وجود له. ويمثل تنامي هذه الحالة السوداء إلى الإضرار بكيانات كبرى يمكن لخبر مختلق أو كاذب أن يزلزل من وضعها في السوق ومن سمعة منتجاتها عند المستهلكين. وكذلك الإضرار بسمعة شخصيات سياسية أو شهيرة في مقتل. ولذلك دأبت الدول على وضع التشريعات الصارمة ضد هذه الظاهرة، وتصدت مواقع بعينها لكشف كل حالة بعينها وفضحها للناس من خلال وضع الخبر الحقيقي في مواجهة الخبر المختلق نصًّا وصورة. ولكن هذه التشريعات والمبادرات لا تكفي وحدها لأنها تأتي أحيانًا بعد أن تكون الشائعة قد أدت المهمة القذرة التي اختُلِقَتْ من أجلها، أو كما قال الروائي الأميركي مارك توين: «يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض في انتظار أن تلبس الحقيقة حذاءها»، ولذلك لا بد من صناعة وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان.
نائب رئيس تحرير جريدة عكاظ.
طالب الرفاعي: لا توجد جهة رسمية قادرة على الوقوف في وجه الإشاعة
العالم يعيش اليوم عصرًا قوامه، بشكل أو بآخر، مواقع الإنترنت، ومحركات البحث، وأكثر من ذلك شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كانت محركات البحث تشير إلى أن المعلومات المبثوثة حيال أمرٍ ما أو شخص ما قد تكون غير صحيحة، فإن الحسابات الشخصية، تقدم نفسها بوصفها ناقلًا صادقًا للخبر، بما في ذلك الإشاعة؛ لذا فإن تناقل الإشاعة عبر حسابات كثيرة، سواء كانت حقيقية أو مزوَّرة، يجعل البعض يتعامل معها وكأنها واقع حقيقي، وهنا تكمن الخطورة. نعم، تؤثر الإشاعات في أعداد كبيرة من الناس وتأخذ مكانها في تفكيرهم وتنعكس على سلوكهم، وذلك لاعتقادهم بصدقها دون التحقق منها. ويصعب جدًّا الحديث عن طريقة تحدُّ من انتشار وتأثير الإشاعة. لكن ما يمكن الإشارة إليه، هو أن يتابع المتلقي حسابات حقيقية بأسماء معروفة ولها صدقيتها الفكرية والاجتماعية. كما يمكن إخضاع أي معلومة لشيء من التبصر والمراجعة وبما يتيح للمتلقي الوقوف على مدى صدقها من كذبها. لا أظن أن جهة رسمية، سواء كانت عربية أو عالمية، قادرة على الوقوف في وجه الإشاعة والحدّ منها بالمعنى الحرفي. لكن الدور الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الإشاعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة الصحيحة وفي أسرع وقت. فحين تنتشر إشاعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويُبطل مفعولها بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية كانت أو أهلية، يفنّد تلك الإشاعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا تتبخر الإشاعة وتنطفئ. مواقع الإنترنت، والحسابات الشخصية، غدت صاحبة التأثير الأكبر في نفوس البشر، وليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو إشاعة إلا بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى. فالإشاعة كانت وستبقى جزءًا من المسلك البشري، وكانت ولا تزال تؤثر في مجموعة من الناس. لكن التاريخ البشري يظهر دائمًا أن البقاء للصدق، وأن أي مجتمع قادر، ولو بعد حين، على الوقوف على صدق الأمور وبالتالي نبذ الإشاعة ومعايشة الواقع.
روائي.
إدريس كثير: تصفية حسابات
الشائعة خبر مغرض، وهي سريعة التداول والانتشار. غالبًا ما تكون خبرًا مثيرًا للفضول. هناك فرق فيما يبدو بين الإشاعة والشائعة. الأولى تضخّم الأخبار الصغيرة الموجودة، والثانية هي أخبار زائفة أغراضها خبيثة. قيل في الشائعات: إنها حقيقة تتنزّه ككذب من الآذان إلى الأفواه لا تحثّ الناس على التفكير والتروّي، تمرُّ كزفير فوق رؤوس الرياح. وهي كالدخان بالنسبة للجلبة والضجيج. لإطفاء شائعة ليس هناك أفضل من شائعة أخرى، والشائعة كذب يولد لقيطًا في الشارع ويموت على عتبة الحقيقة… هناك أنواع عدة من الشائعات. فيها ما يبدو كقتل رمزي للآخر، تُصفَّى فيه حسابات ثقافية أو سياسية، وهي أيضا سلاح حربي يمارس السياسة بأدوات أخرى أكثر خبثًا وفتكًا، وهي أداة للدعاية والإشهار أو للتشهير والفضح، وهي تقتير للأخبار بطريقة شبه رسمية لتوجيه الناس وحثهم على اختيارات وميولات معينة، وهناك الشائعات الاقتصادية، وإشاعات المرض، وصناعة الأدوية وترويجها، ويشاع أن هناك صناعة مخابراتية تخصُّصُها صنعُ الإشاعات وترويجها.
والأمثلة على هذه الأضرب من الإشاعات كثيرة : كإشاعة امتلاك العراق للأسلحة النووية لتبرير الحرب ضده، وإشاعة أورليانس (فرنسا 1969م) المتعلقة باختفاء النساء في أماكن قياس الألبسة لدى التجار اليهود التي أذكتها الصحافة آنذاك، ودفعت الفيلسوف إدغار موران إلى تشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة هذه الإشاعة؛ البحث الذي جمعه في مؤلف تحت عنوان: «إشاعة أورليانس» حكمته يمكن تلخيصها في: «كيف يمكن خلق هلع أخلاقي عفوي. كانت الإشاعة تنقل من الفم إلى الأذن، وكان الناس يتهامسون بها، أو تنقل عبر ما يسميه الأوربيون «الهاتف العربي» بنوع من الإشاعة المغرضة. أما الآن فقد أصبحت الإشاعة عالمية عبر وسائل الاتصال الكونية، كل المحركات الإلكترونية هي الآن في خدمة الإشاعة. لقد وصف أمبرتو إيكو العظيم هؤلاء الفرسان الجدد للإشاعة المعولمة بمجموعة من المعتوهين الذين نقلوا دردشاتهم من الحانات الرخيصة إلى الفضاء الأزرق.
لكن دومًا وراء الإشاعة ما وراءها. هذا هو الدرس الذي يفصح عنه الفيلسوف جان لوك إفار في مؤلفه «بحث في الإشاعة». وهو الأمر نفسه الذي نعثر عليه في مؤلف آخر لدونيس كامبوشنير«ديكارت لم يقل» مشيرًا إلى أن الكثير ممّا يردده محبّي الفلسفة عن ديكارت ما هو إلا إشاعات ومغالطات. وأن أخت نيتشه إليزابيث فورستير نضَّدت كتاب «إرادة القوة» بعد موته وأطنبته بالعديد من الإشاعات حتى يتلاءم والنزعة النازية، وهناك ما دفع بعض الفلاسفة إلى الحديث عن «الكتب السوداء» فيما ترك هايدغر لتقريبها من روح الدرس الافتتاحي لسنة 1940م وتمجيد الفكر النازي… من الفلاسفة الذين تعرضوا للإشاعة القاتلة برنار هنري ليفي. أشاعوا موته على التويتر، وانطلق الخبر كالنار في الهشيم، ولمّا ألف مسرحيته «فندق أوربا» أشاعوا أن الإقبال عليها ضعيف بل منعدم، وأن الشريط المقتبس منها «الأميرة أوربا» منحت له ميزانية خارقة للعادة، واضطرت زوجته أريـال دومباسل أن تنفي على حسابها في التويتر إشاعة طلاقهما الوشيك و…ربما خلفية الإشاعة حقيقية مهما كانت مغرضة.
مترجم مغربي.
سعاد العنزي: هشاشة المجتمع ترحب بتداول الإشاعة
كلما انتشرت الشائعات في مجتمع ما زاد معدل الجهل والسطحية في المجتمع. في الماضي، كان الإعلام الرسمي يقنن نشر المعلومات، والأقاويل والإشاعات، في حين اليوم يسهل بث الإشاعة من خلال تويتر والفيس بوك والسناب شات. وهذا، في رأيي، ناتج من عدم القدرة على متابعة الأخبار ورغبة الأفراد في ممارسة أدوار لا تمثل هوياتهم واهتماماتهم الحقيقة، مثل الخوض في القضايا السياسية والاجتماعية بوصفهم أهل دراية ومتابعة، وهم ليسوا كذلك. واحدة أيضًا من هذه الإشكاليات هي استخدام بعض الكتاب والفاعلين للمبالغات في تقديم القصص والأخبار؛ كي يحصلوا على أكبر عدد من القراء والمتابعين. في عصر الثورة الرقمية، أصبح كل فرد يبث ما يبث وفقًا لقناعاته ورؤيته من دون التحقق من المصادر الرسمية للمعلومة. ولا يخفى على القارئ اليوم أن مثل هذا الدور، يقوم به فرد غير مرتكز على أساس جيد من الرصانة المعرفية، إضافة إلى أن الفراغ الفكري الذي يعيشه البعض، والابتعاد من الرؤية الأخلاقية، تجعل من نشر الشائعة وتلقيها أمرًا ترفيهيًّا مثيرًا للتسلية كما أنه مدعاة لإكمالها، وتعديلها وحذف أجزاء وإضافة أجزاء أخرى حسب شهية المتلقي.
 عندما يكون المجتمع هشًّا وسطحيًّا، فإنه يرحِّب بتداول الإشاعات على نطاق واسع. ولكن الأخطر من بعض الإشاعات ذات الطابع الفكاهي، هي تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية الشائكة والناتجة من حركات وتيارات تخريبية وهو ما يؤثر على إحساس الفرد بالأمان والاسقرار؛ لذلك، تقوم الدولة بالمراقبة وسنِّ بعض القوانين للحد من الإشاعات، ويكون هذا الدور الرقابي كبيرًا عندما تكون الشائعات تتعرض لأداء المؤسسات الرسمية، أو الشخصيات السياسية البارزة، إضافة إلى حق المتضرر في رفع قضية. كما يجب أن أنوِّه بدور المكونات الاجتماعية الحاد جدًّا في التعامل مع الإشاعات التي تخص فئة بعينها، وهو ما يزيد من نسبة المراقبة الذاتية عند مَنْ يحاول ترويجها. حقيقة، أرى أن الشائعات وجه من أوجه الثقافة الشعبية في المجتمعات العربية، وتعكس فكر وثقافة وتطلعات المجتمع، وتحتاج إلى مراقبة من المؤسسات الرسمية والمدنية؛ كي لا تتحول من إطار الفكاهة والتندر إلى مصدر تفكيك المجتمع وتدميره.
عندما يكون المجتمع هشًّا وسطحيًّا، فإنه يرحِّب بتداول الإشاعات على نطاق واسع. ولكن الأخطر من بعض الإشاعات ذات الطابع الفكاهي، هي تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية الشائكة والناتجة من حركات وتيارات تخريبية وهو ما يؤثر على إحساس الفرد بالأمان والاسقرار؛ لذلك، تقوم الدولة بالمراقبة وسنِّ بعض القوانين للحد من الإشاعات، ويكون هذا الدور الرقابي كبيرًا عندما تكون الشائعات تتعرض لأداء المؤسسات الرسمية، أو الشخصيات السياسية البارزة، إضافة إلى حق المتضرر في رفع قضية. كما يجب أن أنوِّه بدور المكونات الاجتماعية الحاد جدًّا في التعامل مع الإشاعات التي تخص فئة بعينها، وهو ما يزيد من نسبة المراقبة الذاتية عند مَنْ يحاول ترويجها. حقيقة، أرى أن الشائعات وجه من أوجه الثقافة الشعبية في المجتمعات العربية، وتعكس فكر وثقافة وتطلعات المجتمع، وتحتاج إلى مراقبة من المؤسسات الرسمية والمدنية؛ كي لا تتحول من إطار الفكاهة والتندر إلى مصدر تفكيك المجتمع وتدميره.
أكاديمية وناقدة.
عبيد بوملحة: كيانات متخصصة لمواجهة الشائعات
الشائعة موضوع كبير ومتشعب يجب تناوله من زوايا عدة؛ أهمها المصدر والسبب والنتيجة، وهناك مثلث تعتمد عليه الشائعات وأول زواياه هو: التوقيت. فقد يكون مفاجئًا أو متوقعًا، والزاوية الثانية هي التهديد بالإضرار بأحد الأطراف سواء كان كيانًا مؤسسيًّا حكوميًّا أو خاصًّا أو فردًا أو مجموعة من الأفراد، والأضرار قد تكون للمصالح والقيم والأهداف، وقد ينتج منها خسائر مختلفة مادية أو معنوية، قد تستغل من الجهات الداخلية أو الخارجية لتحقيق مطالب وأهداف وضغوطات لصالحها وأكبر قدر من الأرباح. والزاوية الثالثة هي نقص وغموض المعلومات، التي ما تساعد على انتشار الشائعة في ظل الفراغ، وقد تؤثر في الأفراد والمؤسسات الحكومية على حد سواء، وفي اتخاذ القرار الرشيد للتعامل مع الشائعة أو نتائجها أو لمواجهتها والحد من آثارها السلبية، فعند انتشار الشائعة خصوصًا في ظل التطور التقني في وسائل التواصل الاجتماعي يعاني متخذُ القرار كثرةَ المعلوماتِ الواردة وتدفقها بصورة سريعة ومتتالية، قد تُلْهِيهِ، وتضيعه، وتجعله يهتم بمواضيع فرعية غير مهمة ويهمل الموضوع الأساسي.
فالمطلوب المعلومات المهمة التي تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة دقيقة ذات تأثير كبير. وقد يكون الكثير من المعلومات خاطئة أو غير دقيقة أو قد تصل متأخرة في غير الوقت المناسب، ومن ثم يكون القرار المتخذ متأخرًا، ولا يواكب سرعة تداعي الأحداث وانتشار الشائعة. ولمواجهة الشائعات يجب على الدول أن تنشئ كيانات متخصصة، ويكون ذلك الكيان على تواصل مع بقية مؤسسات الدولة بطريقة شبكية متوازنة ومتوازية تضمن سرعة ودقة تدفق المعلومات وتشكيل فرق متخصصة نوعية بحسب كل مشكلة، وأن تكون هناك سيناريوهات لإدارة الشائعات وتشكيل الفرق ووضع الخطط المستقبلية لمواجهتها في ظل الطفرة الإلكترونية الهائلة وتطور نظم الاتصال وسرعة تداعي الأحداث، وأن تبرز أهمية دور التنبؤ، ليكون لها القدرة على التعامل مع أي شائعة وتوفير أكبر قدر من المعلومات المطلوبة وتكون دقيقة ومؤمنة ومدروسة وفي الوقت المناسب، ومحللة ومفهرسة، لمواجهة غزارة المعلومات في ظل ضيق الوقت الذي لا يسمح لدراستها أو تفنيدها، فهذه الكيانات لها القدرة على دعم اتخاذ القرار ومساندة متخذ القرار في اتخاذ القرار الأمثل.
روائي.
سعيد سهمي: الشائعات تُحوِّل التافه إلى عبقري
الوسائط الرقمية ساهمت في خلق ثورة حقيقية في مجال الإعلام والاتصال؛ حيث أصبحت المعلومات متوافرة للعموم، وأصبح الوصول إلى الأخبار يتم بشكل مباشر وسريع، وهو ما أدى إلى نوع من الشفافية في عالمنا المعاصر، ونوع من الديمقراطية في مجال الحصول على المعلومة ونشرها. هذه الوفرة في المعلومات والمرونة في نشرها عبر الوسائل الإلكترونية خلقتا نوعًا من الفوضى لدى المتلقي العادي في الوصول إلى الحقائق، ومن أبرز تجلياتها نشر الشائعات التي خلقت نوعًا من الوعي الزائف لدى المتلقي، ولا سيما أن جُلَّ ما يُنشَر من شائعات يكون مقصودًا ومُمَأسسًا، بشكل يصعب معه التمييز بين الحقيقة والإشاعة. هكذا غزت مواقع التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك، وتويتر، وتطبيقات التواصل الفوري مثل الواتساب، ومواقع التسجيلات المرئية مثل يوتيوب، عالَمَنا، وأصبحت بديلًا للوسائط التقليدية، حيث تشير وكالة الأنباء البريطانية رويترز إلى أن 51% من الأشخاص يعتمدون في تلقي المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، و12% منهم يعتمدون هذه المواقع المصدر الوحيد للمعلومات.
ومن الآثار الخطيرة للشائعات أنها صَنَعَت من شخصيات تافهة شخصياتٍ عبقرية في السياسة والثقافة والفن، فلم تعد العبقرية تحتاج إلى أن يكون للمرء باع كبير في الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني، وإنما في حاجة فقط إلى دعم إلكتروني قد تساهم فيه الرسائل الإلكترونية. كما أن لنشر الشائعات آثارًا اجتماعية كبيرة، حيث تسهم في تشويش العلاقات الاجتماعية وفي تفكيك أواصر الأسر، عبر نشر الأكاذيب والأضاليل؛ للحط من كرامة الأشخاص، وهو ما يعدُّ مسًّا واضحًا بحقوق الإنسان وبكرامته. ويتطلب التصدي للشائعات أولًا حكامة إلكترونية تراقب ما ينشر على المواقع الإلكترونية لمواجهته قانونيًّا، وهو ما يدعو إلى إنشاء محكمة إلكترونية عالمية، على شاكلة المنظمات والهيئات الحقوقية والقانونية العالمية للتعامل مع الشائعات التي تمس حقوق الإنسان، والتي تنشر عبر المواقع الإلكترونية، وعلى المستوى المحلي لا بد من تفعيل المحاكم الإلكترونية؛ لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتصدي للشائعات.
لا بد أيضًا من التكوين الكافي في مجال المعلوميات والإنترنت؛ لخلق مناعة لدى الأشخاص في تعاملهم مع الإنترنت ومع الشائعات، وهو ما يُمَكِّن من تعامل ذكي وحَذِرٍ مع الصور والفيديوهات المفبركة ومع الأخبار غير الموثوق في مصدرها وسياقها. إن الإشاعة أو الخرافة الحضرية، كما يسميها جان برونو رينارد، هي تعبير عن المخاوف والتطلعات، ومن ثمة فهي تعويض عن النقص الحاصل لدى البعض، في تحقيق تطلعاتهم على أرض الواقع، وبذلك فإن التصدي لها لا بد أن يكون من هذا الباب، أي عبر خلق مناعة نفسية واجتماعية لدى الأفراد، ولا يمكن تحقيق هذا إلا عبر تضافر الجهود بين المؤسسات، يساهم فيها التعليم، والقانون، والأخلاق والإعلام.
أكاديمي.

سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | مارس 3, 2019 | فوتوغرافيا
«أعتقد أن الفوتوغرافيا يجب أن تكون استفزازية وألا تخبرك بما تعرفه بالفعل. لا يتطلب الأمر قوة كبيرة أو سحرًا لإعادة إنتاج وجه شخص بواسطة صورة فوتوغرافية. السحر يكمن في رؤية الناس بطرق جديدة».
الفوتوغرافي الأميركي: دوين مايكل
في عام 1966م، أصبح دوين مايكل، المصور العصامي، معروفًا بمتتالياته الصغيرة باللونين الأسود والأبيض التي تتميز بأسلوب مبتكر يبدأ بفكرة وسيناريو لينتقل إلى تنفيذ صور فوتوغرافية متعاقبة الموضوع والدلالة. وهكذا بعدد قليل من الصور (صور صغيرة ومنسقة)، مصحوبة بنص مكتوب بخط اليد (العنوان، والترقيم، والتعليقات، والأسئلة فوق الصور وأسفلها)، يصبح الفوتوغرافي ساردًا لقصة قصيرة، ولنوع من الحكاية الفوتوغرافية التي تبدأ بالطقوس اليومية، وتنزاح إلى الشعري والخيالي. الفنان لا يمارس اللقطة الفورية، بل يخترع سيناريو يضعه في المشهد، حيث يُظهِر الأشياء والأشخاص. غالبًا ما ينتقل أبطال قصصه من مكان إلى آخر، أو يضاعفون أو يندمجون، أو يكشفون أو يخلقون الوهم، أو يكشفون اللامرئي أو يتحولون إلى (ملائكة، أو أشباح، أو أرواح).
يتلاعب في صوره بالضوء سواء كان طبيعيًّا، أو اصطناعيًّا مستفيدًا من ظلال المكان المتاحة، والإضاءة الخلفية، والتراكب الطباعي، والتأثيرات الضبابية والانعكاسية. يركز على إطار معين قد يكون نافذة أو مرآة، ويستحضر في الوقت نفسه قصة أدبية من خلال السرد والرسم والتصوير السوريالي المترعة بمؤثرات بسيطة. كثير من حكاياته الفوتوغرافية المتسلسلة مشوبة بالفانتازيا، والتصوف، والفكاهة والرغبة، متلاعبة بموضوعات الواقع والخيال، والنوم والحلم، والرغبة والموت.

تجدر الإشارة إلى أن دوين مايكل، وبصرف النظر عن هذه المتتاليات الفوتوغرافية، قد كرس جزءًا من تجربته الفنية، بشكل خاص لتصوير الفنانين صانعي الأفلام والفنانين التشكيليين والأدباء والمغنين، مثل ماغريت، ووارهول… والأدباء الفرنسيين، والمغنين الأميركيين. كانت كلها بالأبيض والأسود. لم يشرع تقريبًا في التصوير بالألوان إلا مع بداية الألفية الثالثة.
أعاد ابتكار نفسه
بعض الفنانين يبحثون عن التقنية، أو النوع، أو الموضوع أو الأسلوب، وبمجرد أن يكتشفوه، يكرسونه ويستقرون عليه. وبوصفهم فنانين «ناضجين»، يسعدهم أن ينتجوا اختلافات دقيقة حول الموضوع نفسه، مرارًا وتكرارًا، وربما طوال حياتهم المهنية. لكن دوين مايكل هو، من دون شك، ليس واحدًا من هؤلاء الفنانين. خلال الخمس والخمسين سنة التي قضاها في الإبداع الفوتوغرافي، أعاد مايكل ابتكار نفسه واختراعها باستمرار، ولم يقتنع قط بما حققه؛ لأنه كان يسعى صوب ما لم يحققه. لهذا لم يطمئن قط إلى صورِهِ الفوتوغرافية، فأعاد رسمها والتلاعب بها، وقام ببناء حكايات متخيَّلة وعلق عليها، طارحًا فلسفته البصرية كالتالي: «صوري هي الأسئلة، وليست الأجوبة»، وهذا ربما يلخص بحثه الجامح، وبلا هوادة، نحو اقتراف أشكال تعبيرية جديدة.
مع النظر إلى أرشيف مايكل البصري، ندرك أنه عمل شاقّ لكنه على العموم يرتبط بشكل وثيق بالرغبة في سرد حكايات بصرية مثيرة، لهذا يمكن القول: إن مايكل قاص الواقعية السحرية لكن في جُبَّة مصوِّر فوتوغرافي. حكاياته هي مزيج متنوع بشكل مثير للدهشة، ولكن منظم بشكل مثير للإعجاب. وفي هذا المجال فهو رائد التصوير الفوتوغرافي السردي وعميده اليوم فهو ما زال حاضرًا بيننا رغم بلوغه ستة وثمانين عامًا.
تتجلى هذه الريادة في الإمكانات السردية الهائلة لتجربته الفوتوغرافية ذات الأبعاد التعبيرية الشخصية والخرافية عن الذات والرغبة والموت وأشياء أخرى. ويمكن قراءة متتالية الطفل والجد والموت، أو متتالية «اليَبَاب» وغيرها من المتتاليات المدهشة. كرغبات طفولية لاكتشاف أغوار النفس البشرية والأسئلة التي تقف كحواجز منيعة بلا أجوبة.
في مواجهة هذا التحدي المتمثل في التكثيف المتواصل في أعمال دوين مايكل عند تلقيها من طرف الجمهور، يحضر بقوة تنسيق اللحظات وعرضها بتسلسل زمني وتعاقب الأحداث. تُراوِح موضوعات المتتاليات بين «قصص الأطفال» و«الرغبة»، إضافة إلى «النوع الفني»، وهو ما يسلط الضوء على مدى نهم الفوتوغرافي إلى التجديد في التصوير.
الأشياء غريبة
ولع دوين مايكل باجتراح التحفة الفوتوغرافية جعله في مقدمة الفنانين الذين يحاكون كثيرًا، فقد أثّر بشكل لافت في عدد من التجارب الفوتوغرافية، ويمكن أن نرى علامات تأثيره الثوري في نخبة من الفنانين الفوتوغرافيين الصاعدين بقوة، مثل: ماث ليبس، وبرندان فولر، وأنّا أوستويا، وأليك سوت، وبول غراهام وغيرهم. وتعدّ سلسلة «الأشياء غريبة» (1973م) من بين أشهر صور دوين مايكل الفوتوغرافية، وهي سلسلة من تسع صور تجسد اللامعنى والتفاهة، وهي عبارة عن زوايا مختلفة لمحتويات «حمام منزلي». صور تعكس متاهة الزمان والمكان. تميزت هذه التجربة بالسوريالية، وانسياب شعريّ.

وُلد دوين مايكل عام (1932م) في بنسلفانيا، ابن لعامل متواضع وحياة قاسية. تكون في دنفر ونيويورك؛ كي يصبح مصمم رسوم بيانية، واكتشف لديه اهتمامًا بالغًا بالتصوير الفوتوغرافي بعد رحلة إلى الاتحاد السوفييتي عام (1958م). بعد ذلك أصبح مصورًا للمجلات الشهيرة مثل: «فوغ»، و«لايف» وفي هذه المرحلة بدأ بعرض أعماله. في البداية اشتغل مصورًا مراسلًا، في أوائل الستينيات، وهي طريقة جديدة لاستكشاف أسرار التصوير الفوتوغرافي. تأثر دوين بالرسامين ماغريت أو بالثوس، فبدأ يرى في التصوير وسيلة أخرى للتعبير ومعالجة الموضوعات الفلسفية أو الأدبية. ومن هنا أخذ يجمع بين الصورة الفوتوغرافية والكتابة المرافقة لها، لاستحضار الموضوعات التي تستحوذ عليه مثل الموت، وأسرار الوجود. يمكننا القول: إن دوين طوَّر فكرة «السرد البصري التعاقبي» الذي تتدرج فيه الفوتوغرافيا من مشاهد عدة مصحوب كل واحد بنص قصير. في عام 1970م، نشر مجموعته المتسلسلة الشهيرة التي لاقت نجاحًا باهرًا. سمحت له مكانته الفنية الجديدة وساعدته بقوة على الاستقرار في نيويورك، والتقاء الفنانين الذين يعجبونه وتصويرهم؛ مثل: باسوليني، وتروفو، ووارهول، ودوشا، وبالطبع ماغريت. في عام 1965م، ذهب إلى بروكسل لتصويره في المنزل مع زوجته. بعد ذلك نشر هذه السلسلة المطبوعة بالعوالم السوريالية للرسام، مستخدمًا تقنية الشفافية والتراكبات،؛ للإشادة بأعمال هذا الرسام العظيم. هذه اللقطات المتقطعة تخرق تقنية التصوير الفوتوغرافي الوثائقي التي تسعى لفهم اللحظة العابرة سواء كانت حاسمةً أم لا؛ لأن دوين على العكس من ذلك، يقترف متتاليات تعطي انطباعًا بتمديد الزمن إلى اللانهائي، ويمكن ملاحظة ذلك في سلسلة الطفل والجد والموت.

ورغم النجاح الذي حققه بهذه التقنية، يواصل بحثه واستكشافه لطرق أخرى لإبداع الصور: فهو لا يتردد في استخدام الفرشاة وتحويل الصور (مثل ألبوم فرقة الشرطة في 1983م) أو في بعض الأحيان يستخدم كليشيهات قديمة مثل سلسلته الأخيرة حول الكتّاب الفرنسيين.
تتسم تجربته أيضًا بالعاطفة لإنشاء الحميمية والكثافة؛ عاطفة تطمح إلى اكتشاف الجوهر والتعبير عن «تجربة كاملة» عميقة في العمل والحياة. يدافع مايكل، عن تجربته الفريدة قائلًا: «يجب إعادة تعريف التصوير؛ لأنه من الضروري أن نعيد تعريف الحياة وفقًا لاحتياجات كل فرد. الكلمة المفتاح هي التعبير وليس التصوير ولا الرسم ولا الكتابة»، لأكثر من نصف قرن، سمح لنا هذا الفوتوغرافي العبقري باكتشاف العديد من الطرق لطمس الحدود بين التصوير والفن، بين الخيال والواقع، بين الشخصية الأيقونة والشخصية العادية، وبين الفن والفنان، ولكن الأهم من ذلك، أنه أعاد تعريف هذه الحدود باستمرار وفقًا لحياته واحتياجاته، بل تخطَّى هذه الحدود، مستكشفًا مناطق بصرية مجهولة، بشكل متكرر وبإصرار على اللقطة/ التحفة لعشرات المرات وربما إلى أبعد من ذلك، وبعيدًا من قواعد التصوير وشروط المؤسسات، والأهم من كل ذلك فقد علَّمَنا هذا الفنانُ أنه يمكننا ويجب علينا أن نعلِّم أنفسَنا بأنفسنا لاجتراح التجربة الفنية الفارقة والثورية.
يعد اليوم، دوين مايكل شخصية فنية عظيمة في التصوير الفوتوغرافي تنظر إلى عالم الفوتوغرافيا المعاصر نظرة نقدية وساخرة؛ لأنها تحولت إلى سوق تجاري مثخن بالانحرافات. حاليًّا يقوم دوين بجولات أكاديمية في الجامعات العالمية، رغم تقدمه في السن، يستعرض فيها تجربته الفنية الطويلة، ويحكي قصصه الفوتوغرافية المثيرة والمتجددة والساخرة.

سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | سبتمبر 1, 2018 | كتب
كان البحر دائمًا مصدر إلهام لكثير من الكُتَّاب. وعلى خطى هؤلاء حاول الفيلسوف والأديب «سيمون ليس» المولود في بلجيكا عام 1934م اقتفاءَ أثر البحر في الأدب الفرنسي. نتحدث هنا عن مجلدين ضخمين في نحو 1376 صفحة: الجزء الأول خصصه الكاتب للبحث في موضوع البحر وتجلياته: «من فرانسوا رابليه إلى ألكسندر دوما»، أما الجزء الثاني فأبحر فيه «من فيكتور هوغو إلى بيير لوتي». عند قراءة هذا العمل المثير للإعجاب، ندرك أن البحر قد أنجب نصوصًا مدهشة لا يمكن أن يطويها النسيان. يحب سيمون البحر ويعرفه جيدًا، وقد أثبت لنا ذلك في كتابه «غرقى باتافيا».
يبدأ المجلد الأول مع «فرانسوا رابليه» وما كتبه في «دوار بحر بانورجي». ثم تلي «رابليه» قصص: جان مارتيله، ودوغواي – تروين، يوجين سو مع كتابه «لا سالاماندر». ونقف أيضًا منبهرين أمام كتاب «ميشلي والبحر»، لكن الكاتب المفضل عند «سيمون» ليس سوى «فيكتور هوغو» الذي خَصَّص له وحده قُرابة 300 صفحة. ويمكن القول: إن «سيمون ليس» كتب بعشق وعمق عن كاتبه المفضل أعذبَ الصفحات وأجملها على الإطلاق. يقول: «البحر حاضر بقوة في أعمال فيكتور هوغو الأدبية وفي تجاربه التشكيلية. تتساوق قوة المحيطات مع إبداعه العبقري؛ لهذا نجد أن البحر هو إحدى القوى الدافعة لإلهامه، وبخاصة خلال الفترة التي قضاها في المنفى؛ فهو يحتل مكانةً متميزةً في حياة هوغو، بدءًا بإقامته الجبرية عام 1855م بجزر جيرزي النورماندية- الإنجليزية؛ حيث قضى عشرين عامًا تقريبًا. وأثناء إقامته هناك سيواجه نفسه، كما سيواجه البحر المتلاطم أمامه، وسيختلط بالصيَّادين والبحَّارة… وسيتحرر خياله؛ ليكتب لنا تحفه الخالدة ويشيد أسطورة القرون الأدبية، من «البؤساء» مرورًا بـ«عمال البحر» و«الرجل الذي يضحك»، إلى مئات القصائد المتلألئة بالبحر ومن أجل البحر، الداكنة بالبحر وبحزن البحر…».
قد يدعي بعض أن الكتاب تغلب عليه النزعة الذاتية في اختيار النصوص، ولكن هذه هي الطريقة التي ينهجها هذا العمل التجميعي العظيم، الذي تغلب عليه، قبل كل شيء، ذائقةُ سيمون ليس التي تميل إلى اختيار نصوص بعينها، لا تتحدَّث إلا عن المغامرات البحرية واستراحة البحَّارة في الموانئ، يوردها على شكل مقتطفات مصحوبة بتعليقاته الشديدة الحميمية والنباهة الأدبية، ثم يدرجها كملاحظات ومعلومات مرفقة بالمقتطفات، مع انطباعاته عن المؤلفين الذين استشهد بنصوصهم، ويواكب تحريره أيضًا بفيض من الإعجاب بالتفاصيل والدقة التاريخية التي يحرص الأدباء فيما مضى على تدوينها والتأكيد عليها. مع «سيمون ليس» يتحوَّل الأدب إلى وثائق شاهدة على وقائعَ طواها النسيان. كتاب غني مليء بالنصوص الكلاسيكية المشهورة أو الأقل شهرة، التي نكتشفها معه لأول مرة، كما أنه يشكل فرصة استثنائية للقراءة، وبخاصة إذا كان القارئ مولعًا بالبحر وما كُتب عنه من الحكايات والملاحظات والمعلومات التي تمتع وتفيد القارئ، وبخاصة أن «سيمون ليس» حرص على إرفاق المقتطفات، بانطباعاته الشخصية عن الأدباء، وأحاسيسهم نحو التفاصيل الدقيقة والمعطيات التاريخية.

سيمون ليس
تكمن فرادة كتاب «سيمون ليس» وأصالته في إبراز كيف ألهم البحر الكُتَّاب الفرنسيين الأكثر تنوعًا ومن جميع العصور والأساليب الأدبية؛ بدءًا بمونتين، وباسكال، ولافونتين، أو كورني، إلى لابرويير، وروسو، وشاتوبريان، وفولتير، وفلوبير، أو ميشلي. ومن بين الكُتَّاب المعاصرين نجد: أبولينير، وبلوي، وموباسان، ونيرفال، رامبو، دونَ نسيان «جول فيرن» ومغامراته الخيالية في أعماق البحار.
جمع سيمون في كتابه تحفًا أدبية مخصصة، ليس فقط لأدب البحر وحكاياته وقصائده وشهاداته واستكشافاته الملاحية، بل أساسًا للبحث عن دور البحر في تشكيل نصٍّ أدبي. يركز سيمون في اختياره لكتابات الكتاب والشعراء أو الروائيين على المكانة التي يحتلُّها البحر في التراث الأدبي الفرنسي، وكيف كان البحر وسيبقى لكثير من الكتاب العظماء، ليس في فرنسا فحسب، بل في العالم كله، موضوعًا خصبًا لا ينضب مَعينه ولا تفنى كنوزه من الخلق والإلهام والإبداع، سواء في الأدب أم الرسم أم الموسيقا.
تتضمن هذه النصوص أحلام يقظة عن الماء، وهذا يوافق وصية «شارل بودلير» للرجل الحر بأنْ يحب البحر، فهو مرآة له. ولا شك أن الصفحات الأكثر جمالًا في هذا المجلد هي تلك التي، على عكس المشروع، تعلن استحالة تحقيق أدب بحري خالص. وقد كان «تيوفيل غوتييه» الذي اعترف في مقالة عام 1836م، بأنه يجهل الأشياء المائية، وأنه لا يستطيع الجَلَد أمام أعمال «يوجين سو» عن البحر؛ لأنه غير قادر على التمييز بين مقدمة السفينة ومؤخرتها، رافضًا حفظ القاموس البحري وبالتالي الأدب البحري. وبمجرد أن يتخلَّص القارئ من هذه الحالة المزاجية السيئة لتيوفيل، يجد نفسه أمام حتمية أن يأخذ في الحسبان حالة الأدباء الذين يعانون دوار البحر، مثل «مونتسكيو» الذي يصف معاناته المنفرة التي تنتقل عدواها إلى القارئ فيحسُّ بالدوار وآلام الأمعاء نفسها، لكن فجأة نُجزى الجزاء الحسن بصبرنا على أهوال الإبحار، لنجد أنفسنا أمام تحف «فيكتور هوغو» الذي يجعل من دوار البحر حالة باعثة على الانتشاء والفرح.
هوغو الذي يعترف بأنه تلقَّى في الحياة هبتَيْن هما: باريس، والمحيط؛ حيث وجد «هاوية الشعر». لا يتردد الكاتب في استدعاء عباقرة القرون الماضية «رجال المحيطات» لتأمُّل تجاربهم البحرية العميقة قدر أعماق البحر وعنفه وملوحته وتهديداته الدافعة إلى الانبعاث أو العدم.
إن هذه الأنطولوجيا الأدبية التي صمَّمها «سيمون ليس» بذكاء خارق لرحالة في جغرافية البحر والأدب، ليس كتابًا عن أدب البحر، ولكن عن البحر في الأدب. يشير الكاتب إلى أن «لكل قطر قصصه، وحكاياته عن البحر؛ مثل: هوميروس، وألف ليلة وليلة، اللذين تركا لنا العديد من تقاليده المخيفة، والمهلكة والعاصفة، والهادئة والقاتلة. يميتون فيها المرء بين مياه لا نهائية عطشًا، أو يضطر الإنسان التائه فيها إلى التهام أخيه جنونًا. وحيث تخرج فجأة وحوش مخيفة، وثعابين البحر العظيمة… إلخ». ولا يُخفي «سيمون ليس» افتتانه بـ«جزيرة الموتى» للأديب بوكلين؛ حيث يبدو الماء والظلام كأنهما قد التحما لحضور حفل زفاف مروّع، مؤكدًا دور البحر في تشكيل نصوص أدبية باذخة.
في الختام يمكن الحديث عن نجاح «سيمون ليس» في سنواته الأخيرة في إنجاز عمل أدبي فريد من المختارات الثرية بالمعرفة البحرية، والسخية بالعطاء الأدبي اللامحدود؛ فهو الكاتب الموسوعي الذي غادر بلجيكا ذات يوم من عمره المبكر إلى الشرق الأقصى، فالتحم بالثقافة الصينية وكتب عنها كتبًا مذهلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى أستراليا، مانحًا القراء هناك مدونةً فكرية وأدبية هائلة وغزيرة ومتنوعة، نالت عددًا مهمًّا من الجوائز الأدبية وبوَّأت الكاتب «سيمون ليس» مكانة مرموقة. وقبل وفاته عام 2014م أوصى بأن يُنثر رماده في البحر. وهذا دليل آخر على عشق هذا الرحالة الأدب والأفكار والأسفار ودلالته الفيزيقية والوجودية.

سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | أغسطس 31, 2017 | ثقافات

 تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
أعمال هذا الكاتب الكبير المترجمة إلى العربية، للأسف قليلة. لا تقدم الكاتب بصورة واضحة وشاملة للقارئ العربي، ولا أعلم سبب تهرب المترجمين من أعماله على الرغم من أنها أكثر أدبيةً وعالميةً من أعمال غيره من الروائيين اليابانيين، خصوصًا الشباب. من رواياته التي ترجمت إلى العربية: «علمنا أن نتجاوز جنوننا» (دار الآداب) بترجمة كامل يوسف حسين، و«مسألة شخصية» (مؤسسة الأبحاث العربية) ترجمة وديع سعادة، و«الصرخة الصامتة» (دار المدى) ترجمة سعدي يوسف.
وفي أحد أيام هذا الصيف القائظ تلقى كنزابورو أوي وهو محاط بزوجته يوكاري وابنه هيكاري، عشرات الكتب والصفحات المسودة وضعت فوق طاولة منخفضة وسط بهو منزله. كانت تلك الأوراق تجسد تاريخًا من الفكر النشيط والكلمة اليقظة المتنقلة بين الأدب والالتزام الاجتماعي. تأملها النوبلي كنزابورو أوي مبهورًا، فقد بلغ عدد الصفحات أكثر من 1300 صفحة قامت بترجمتها دار غاليمار الفرنسية عن أعماله. منها القصة القصيرة والرواية والمقالات الأدبية. كبداية لخطة نشر أعماله الكاملة في حلة تليق بهذا الكاتب الفريد.
يبلغ اليوم كنزابورو أوي 82 عامًا، ولا يزال آخر عمالقة الرواية في اليابان يعيد النظر بصبر وعمق في طفولته وحياته الفريدة ككاتب وأب لطفل معاق ومثقف ملتزم بقضايا مصيرية تهم بلاده ومستقبل العالم. على هامش هذا الحدث الأدبي المهم أجرى مراسل صحيفة ليبراسيون الفرنسية في اليابان الكاتب والصحافي أرنو فولران مؤخرًا حوارًا مهمًّا مع كنزابورو أوي، هنا ترجمة له من الفرنسية.
الرواية بضمير المتكلم
■ كنزابورو أوي: فوجئت كثيرًا عندما قيل لي: إن 1300 صفحة من أعمالي نُشرت في دار غاليمار، وما زلت متأثرًا بذلك. ولعل هذه هي أعظم هدية في حياتي، خصوصًا ضمن سلسلة «كوارتو»؛ لأنها تضم أعمالًا كلاسيكية. أشعر حقًّا أن الأمر يتعلق بكتاب وبصورة كاتب، لكن كنت أعتقد أنها تمثل أيضًا حياتي. إنه شيء خاصّ جدًّا بي. أنت تعلم أن في اليابان، نحن نتحدث «الوتاكوتشي شوسيتسو»، «الرواية بضمير المتكلم» لكن هذا لا يعكس حياة الفرد. هذه الرواية، التي تكتب بضمير المتكلم وشخصيتها الأساسية هي تخص الكاتب الذي يعيش عادة في طوكيو، ليست سيرة ذاتية. في هذا النوع من الرواية اليابانية، تروى بالأحرى تفاصيل الحياة
● أرنو فولران: لكنك لا تنتمي إلى هذه المدرسة.
■ كنزابورو أوي: لم أكن أنوي أن أكتب رواية بضمير المتكلم؛ لأن عملي يستند إلى نقد هذا النوع من الرواية. على سبيل المثال، ناويا شيغا [1883-1971م] أصبح معروفًا ونال التقدير لأنه كتب بضمير المتكلم. عندما نقرأ رواياته، نكتشف أخيرًا الصورة الشخصية الحقيقية للكاتب. إن الذين اشتغلوا على هذا النوع من الرواية يعطوننا انطباعًا بأنهم يقومون بالتقاط صور عن حياتهم وتحويلها إلى كلمات. لكن في وقت ما بعد الحرب حاول الكُتاب أن يجدوا ويحللوا الإنسان الذي يكتب للتمعن في أين يمكن أن نذهب بالتفكير في كيفية حياته وموته، وهذا ما حاولت أن أقوم به. انطلاقًا من قراءتي للأدب الأوربي، بدا من المهم تطوير الكتابة للنظر إلى العالم بطريقة أكثر شمولية واتساعًا. لقد بدأت بكتابة قصص قصيرة حول موضوعات أصيلة. ثم ولد هيكاري بإعاقة [ولد الطفل الأول لكنزابورو أوي في 1963م بإعاقة ذهنية] فغيرت تمامًا مشروعي. فقلت في نفسي: «ستكون حياتي معه هي موضوع كتابتي». هذا الوضع الأصيل الذي بحثت عنه في قصصي وجدته في حياتي الخاصة. وهذا ما سمح لي حقيقة بأن أكتب عندما قررت صحبة زوجتي القبول والعيش رفقة هذا الطفل. وهكذا قُبِلتُ ككاتب وسرَّني كذلك أن المختارات من أعمالي اتخذت سمة التأريخ للكتاب والإنسان.
● أرنو فولران: لكن، على كل حال، هل أنت سعيد؟
■ كنزابورو أوي: لو قيل لي: إن هذا المصير جيد لي، سأرغب دائمًا في أن أقول: لا. أشعر ببعض الأشياء. الآن عمر هيكاري 53 عامًا (يعمل مؤلفًا للموسيقا، وقد عُزفت سيمفونيته في ألمانيا منذ شهور – المترجم)، منذ ثلاث سنوات، وأنا أشعر أنه أصبح أكثر قتامة. من قبل كان يتحدث طوال اليوم كطائر. وكان مثل الطفل يستمتع بأسرار اليقظة، وأعتقد أنه في يوم من الأيام سيموت مبكرًا أو عجوزًا، لكنه سيموت بروح طفل. وأظن إلى جانب هذه الحياة السعيدة رغم كل شيء، عشت حياتي مع تجارب صعبة، لحظات مفجعة؛ لذلك بدأت الكتابة عن هذه الحياة في رواياتي، فمن الواضح أني أقدم تجارب حياة ليست دائمًا مرحة. هناك دائمًا في معظم رواياتي شكل من أشكال الفكاهة وهي تأتي من هيكاري، ومن علاقتنا. لقد عشت وأنا لا أفعل شيئًا غير الكتابة، فتمكنت من أن أذهب إلى الجامعات، وتقديم المحاضرات. عشت حياة أخرى غير حياة المدرِّس. من خلال كل ذلك، تحدثت أيضًا عن قريتي وطفولتي. أعتقد أن هذا هو أيضًا السبب في أن بعض القراء يُبدون اهتمامًا بكتاباتي.

 ● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
■ كنزابورو أوي: لا. كنت أقرأ كثيرًا من الروايات، كنت قادمًا من القرية أشبه شابًّا بين الأطفال. تُوفي والدي مبكرًا جدًّا [في عام 1944م، وربما بسبب نوبة قلبية]، لكني لم أكن على علاقة بكبار القري
ة، كما لم أشعر بأني أنتمي إلى دائرة الأطفال. كنت أقرأ فقط. ثم جئت للدراسة في طوكيو، التقيت كازو واتانابي، وهو مدرس، خبير ومترجم رصين لرابليه. إذا كنا نتحدث عن الالتزام تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، فمن شأن العمل بالكتابة أن يدفعك بالضرورة إلى التساؤل عن اليابان، والتساؤل أيضًا عما إذا كنت عارضًا، عوضًا عن أن أكون ملتزمًا، ثم شعرت أن الأدب الذي كنت أكتبه لا يمكن أن يكون محدودًا، وأنه يجب أن ينفتح على اليابان وآسيا.
● أرنو فولران: في هذه المختارات نجد المجموعة القصصة «سبعة عشر» التي لم يسبق نشرها في فرنسا، تحكي قصة مراهق ممزق بين دوافعه الغريزية
والسياسية والوجودية. كانت هذه المجموعة القصصية التي تتكون من 90 صفحة مثيرة للجدل في الستينيات؛ ما مكانتها بين منجزك؟
■ كنزابورو أوي: إنها عمل مهم لي؛ لأن الأمر يتعلق بشاب يعيش في المجتمع المدني الياباني. احتلت هذه الشخصية العادية التي قامت بعمل إرهابي مكانة مهمة في تفكيري. بكتابة هذهالقصة، بدأ شيء ما يتغير بداخلي، إنها نقطة البداية.
أب وحياته مع ابنه في طوكيو

كنزابورو مع ابنه سنة 1935م
● أرنو فولران: في «نشيد الذكرى» القصيدة الجميلة، تكتب «ما زلت لا أعرف ماذا سأقول للشاب الذي كنته» نشعر بكثير من الفشل في هذه الجملة.
■ كنزابورو أوي: تحدثت للتو عن الانفتاح على العالم، لكن كتابتي لا تزال في إطار محدود، عن أب وحياته مع ابنه في طوكيو. لا أكتب وفي ذهني تصور كي أكون موضع تقدير أو فهم في الخارج. إنه لمن دواعي سروري أن أُقرأ وأُترجم، لكن هذا لن يملأ حياة أو يجعلني أفكر في أني سأموت مرتاح البال. أعتقد أني سأعيش خمس سنوات أخرى ولمدة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى سيكون نشاطي الفكري طبيعي إلى حد ما. من يومين أدركت أنني لم أمارس رياضة الجري منذ عام. لهذا ارتديت بذلة رياضية وركضت لمدة عشر دقائق. عندما نركض، هناك لحظة نرتفع فيها، وأنا أحب هذه اللحظة القصيرة جدًّا التي نرتفع فيها عن سطح الأرض. لقد أدركت أنه حتى في سن متقدمة، يمكن أن نركض. وهذا منحني شعورًا بالفرح والوضوح في حياتي. الإنسان هو ذلك الشخص الذي يسمو عن سطح الأرض. وبهذه الطريقة عدت مرة أخرى بشريًّا.
● أرنو فولران: أنت معارض للنظام الإمبراطوري منذ وقت طويل. ومع ذلك، عبرت عن رضاك من دعوة السلام المعروضة من الإمبراطور أكيهيتو، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية؟
■ كنزابورو أوي: عندما كنت طفلًا، كل صباح في المدرسة، كنا نسجد في الهيكل للإله الإمبراطور. هل كنت أومن بذلك؟ لا أعرف. على كل حال، كان لديّ انطباع أني أعرف، أن هناك شخصًا مقدسًا فوق الجميع. لم نفكر قط في أن نعطي قيمة لما يقوله الإمبراطور، أو النظر فيما إذا كان جيدًا أم لا. الإمبراطور الإله صاحب السلطة المطلقة تركناه خلفنا جميعًا، لقد انتهى في عام 1945م. وتوفي، ولم يعد إلهًا. عشت على عدم الاهتمام بما يمكن أن يفكر فيه الإمبراطور. وأيًّا كان النظام الإمبراطوري، لا بد من إزالته من الدستور. أنا أنتقد بشدة حكومة شينزو آبي الذي ينوي تغيير الدستور، وألا يبقى البلد مسالمًا لا يستخدم الحرب كأداة ضد بلدان أجنبية.
● أرنو فولران: هل ستصبح اليابان «دولة طبيعية» وفقًا للرغبة التي عبّر عنها شينزو آبي؟
■ كنزابورو أوي: بالفعل تملك اليابان جيشًا يسمى قوات الدفاع الذاتي، وهناك جيش أميركي لديه قنبلة نووية مزروعة في اليابان. ويبدو هذان الأمران مخالفين للدستور. إذا آبي، أو رئيس الوزراء المقبل، تمكَّن من تعديل الدستور بموافقة الشعب، سيكون من السهل جدًّا تحويل جيش قوات الدفاع الذاتي الحقيقي وأن يصبح لليابان سلاح نووي على الفور. في كوريا، هناك نقاش حول هذا الموضوع، وبطبيعة الحال، أنا أعارض. يمكن أن تصبح المنطقة قريبًا مكانًا لحرب نووية. إذا تغير الدستور، لن نكون في عالم يمكن أن نحقق فيه السلام. ستكون هذه هي نهاية اليابان إذا كان هناك استفتاء، وقرر الشعب الياباني دعم مواقف «آبي». وأنا على استعداد للنزول كل يوم إلى الشوارع لمعارضة ذلك.
سعيد بوكرامي – كاتب ومترجم مغربي
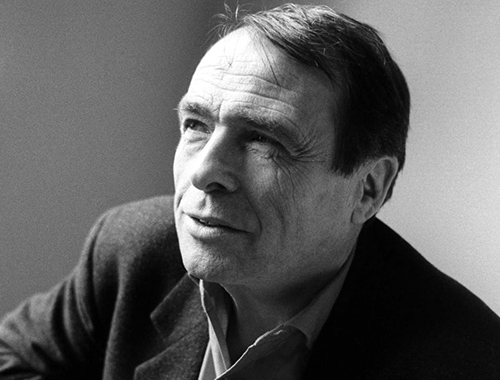
سعيد بوكرامي - كاتب و مترجم مغربي | نوفمبر 6, 2016 | ثقافات

سعيد بوكرامي
لا ينتمي كتاب «بيير بورديو: بنيوية بطولية» للسوسيولوجي الفرنسي «جان لويس فابياني» إلى كتب السيرة الفكرية المتعارف عليها، التي تنحاز غالبًا إلى التوثيق والتأريخ وهذا ما يعلي من قيمة هذا الكتاب فكريًّا ويضعه في صدارة المراجع التي كتبت عن «بيير بورديو» المفكر والإنسان (1930 – 2002م).
جاء الكتاب نتيجةَ مرافقةٍ لبورديو دامت سنوات طويلة، ووفق إنصات عميق لمعنى علاقة حميمة جمعت الباحث بالمفكر وبفكر أشهر عالم اجتماع معاصر. كما يشكل خلاصة تعلق أكاديمي بعالم وإنسان لم يكن يبخل على مريديه بالفكرة الراجحة، والموضوع الناجح والمعرفة الثقافية والاجتماعية، التي تتجاوز المجتمع الفرنسي إلى مجتمعات أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قدم لنا «فابياني» نتائج مراقبته لكيفية كتابة «بورديو» لعلم اجتماع متجدد ومبتكر، ولصيرورة تشكُّل فكري وثقافي وسياسي غيرت مفهومنا عن العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يشكل الكتاب الصادر حديثًا عن دار سوي الفرنسية إضافة نوعية وفارقة إلى مجموعة غزيرة من الأبحاث البارزة التي أنجزت حول «بيير بورديو»؛ لأنه يقترح إعادة قراءة المفاهيم المركزية لعلم الاجتماع «البورديوي» على ضوء الممارسات الممكنة عمليًّا ونظريًّا، ثم لأن المؤلف يستخدم الشبكات الفكرية وطرائق التحليل التي حددها «بورديو» تدريجيًّا، أضف إلى ذلك الوضع الشخصي والأكاديمي لفابياني الذي كان يتوافر على الشروط الذاتية والموضوعية للنجاح في مقاربته الفكرية.
مثقف بطل من نوع جديد
يواجهنا في الصفحات الأولى من الكتاب سؤال محوري ومنهجي: «هل يمكننا اليوم الحديث بهدوء عن بورديو؟». هذا هو السؤال العام الذي يسعى «جان لويس فابياني» للإجابة عنه، باستخدام منهجية تستهدف تحليل المفاهيم الأساسية لنظرية علم الاجتماع. وقسم الباحث كتابه إلى ثلاثة أقسام: يهدف القسم الأول إلى تحليل الحقل المفاهيمي، والهابيتوس: «المظاهر الاجتماعية» ورأس المال الثقافي والرمزي. وهذه مفاهيم مركزية في البناء النظري لبيير بورديو، التي- كما يذكرنا «جان لويس فابياني»- صُممت أصلًا للعمل بشكل شمولي. أما القسم الثاني فيتناول التصميم المنهجي والسردي الموظف من عالم الاجتماع. وأما في القسم الثالث فيهتم على نطاق واسع بصورة «بيير بورديو» من خلال مفاهيمه السياسية، ثم يتحدث عن معاناة «بورديو» وشغفه بموضوعات بحثه. وأخيرًا يرسم الملامح النهائية لـ«بطل مثقف من نوع جديد».
 حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
وهكذا، فيما يتعلق بالحقل الاجتماعي الموصوف لدى «بورديو» بـ«النظرية المستحيلة»، يوضح «فابياني» أن «بورديو لا يتردد في اللجوء إلى مفهوم الغموض عندما يفتقر إلى المصادر التحليلية». وخلال تحليل الهابيتوس يشير «بيير بورديو» إلى أنه: «مثل كل نظريات التنشئة الاجتماعية يمكث على نطاق واسع صندوقًا أسودَ»، بمعنى من المعاني فعلم الاجتماع لديه لا يملك أجوبة حاسمة إنما تعترضه ثغرات وصعوبات يستحيل ترميمها أو حلها. وأبسط هذه الأمور حضور ذات المفكر السوسيولوجي وشروط اشتغاله العلمي، ونجد هذه التوضيحات في كتابه «الإنسان الأكاديمي» حينما تحدّث عن تأثير التاريخ الشخصي لعالم الاجتماع في عمله الأكاديمي؛ إذ تتدخل الذات المفكرة في ممارسته العلمية وتُبلبل رؤيته للمجتمع، وفي غالب الأحيان دون وعي منه.
وأخيرًا: يتناول المؤلف بالتحليل مفهوم «رأس المال الرمزي»، الصنف الأبرز من جميع أشكال رأس المال الذي أبدعه ونظر له «بورديو». ويشير الكاتب إلى أنه: «لا يمكن أن نمنع أنفسنا من التفكير في المفهوم الرمزي، الذي يحتفظ بنصيب من الغموض، حتى عندما نعيد القراءة بعناية دقيقة للمفاهيم، التي صاغها «بورديو» وجمعها مبكرًا خلال مسيرته العلمية». ويضرب مثالًا بمفهوم رأس المال الرمزي الذي يُحَدد من سمات الفرد المشكّلة من مظاهره الاجتماعية التي تختلف من فرد إلى فرد ومن مجتمع إلى مجتمع، لكنها تتوحد في سمات مشتركة مثل الشرف والهيبة والسلوك الحسن والسمعة وغيرها.
في القسم الثاني: يستمر هذا البحث «التاريخاني»، مع التركيز هذه المرة ليس على المفاهيم ولكن على المسالك المنهجية والسردية التي وظفها «بيير بورديو». وفيما يتعلق بالأولى فإن «جان لويس فابياني» يهتم بتفاصيل علاقة «بورديو» بالإحصاءات والأدب والتاريخ، موضحًا أن التحليل الهندسي كان ثمرة تعاون مع الإحصائيين، بدأه «بورديو» في الفترة الجزائرية، ويبدو أنه حمله معه خلال دراساته الاجتماعية للحفاظ على تماسكٍ بنيوي، مراعيًا بصرامة التغيير الاجتماعي.

جان لوي فابياني
تنوع أنظمة الكتابة
وفيما يتعلق بالمسالك السردية فإن الحجة الرئيسة للمؤلف التي واجهت المهتمين بدراسة أعمال «بورديو»، هي تنوع «أنظمة الكتابة» لديه؛ إذ لاحظ المؤلف أن أعماله يختلط فيها العلمي بالفلسفي، والنفسي بالأدبي؛ فهناك تحول مذهل في الأساليب والتخصصات لكنها تكون دائمًا تحت سماء علم الاجتماع بشروطه العلمية.
وفي القسم الأخير: يعرض «فابياني» بطريقة شاملة صورةَ عالم الاجتماع واقفًا ضد التصورات المقولبة التي وضعت مرارًا وتكرارًا صورةً عن «بورديو» الخجول سياسيًّا والملتزم ثوريًّا في الجزء الأخير من حياته. بينما هو في الواقع يدافع بشكل جدلي عن صورة المثقف والمفكر المنتقد والمندد، والمجدد لأنماط التفكير الثقافي والسياسي والسلوك الاجتماعي، جنبًا إلى جنب مع صديقه المفكر الفرنسي «بيار فيدال- ناكي». ومن ثَمَّ يرى الباحث أهمية ما مارسه «بورديو» من تأثير في الحياة الاجتماعية، الذي أشار إليه «بورديو» نفسه خلال ممارسته وإنتاجه.
هذا الاهتمام هو في الواقع، حسب المؤلف، موجود في أشكال عدة هي: أولوية الجسد في العلاقة العملية بالعالم التي بُلورت في الأعمال الأنثروبولوجية في موضوعات تتجسد في موضوعَي: المعاناة، والشغف.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، نلاحظ أن تحليل «فابياني» يبدو كأنه وصل بشأن هذه المفاهيم إلى طريق مسدود: «العلاقة بالتحليل النفسي هي إحدى النقاط الأصعب في البنيوية التوليدية، وبورديو لم يساعد القراء ولم يمهّد الطريق للتفسير».
في الفصل الأخير: سنصل إلى المقاصد السامية للكتاب التي تتجلى في إضاءة منهج «بورديو» انطلاقًا من سيرة حياته الذاتية والفكرية، وأيضًا في إبراز أهم المشاكل التي اعترضت ممارسته العلمية على نطاق أوسع. ومن هنا تبدو أطروحة الكتاب واضحة: إن عالم الاجتماع اتبع نمطًا مميزًا من الحياة اتسم في مجمله بـ«البطولة» التي كانت وقودًا فعالًا في مساره الاجتماعي، ودفعه إلى مضاعفة مجهوداته وزيادة إنجازاته العلمية. وبناء عليه يحدد «فابياني» الطابع الاستثنائي لهذا البطل المتمثل في قدرته الانعكاسية على نقد ذاته وتجاوز عثراته والإصرار على مواقفه الثقافية والسياسية مهما كلفه ذلك من تضحيات. والنتيجة: أن «بورديو» تمكن في سنوات حياته الأخيرة من تأسيس نظام سوسيولوجي نظري وتطبيقي شمولي كان قد سهر على تشييد صرحه بجهد ذاتي وفكري استثنائي.
استعادة مفاهيم «بورديو» وتعقيداتها
تكمن القوة الحقيقية للكتاب -كما أعتقد- في الثراء المعرفي ودقة المفاهيم في قراءة منجز «بورديو»، وقد شكل هذا الاستعراض التحليلي فرصة للتعرف إلى مهارة باحث وُفِّق في استعادة مفاهيم «بورديو» وتعقيداتها، لكن أيضًا هشاشة التوضيحات النظرية لدى «بورديو». وبهذا المعنى يبدو أن المؤلف يقف حقًّا على أسس عمل تجريبي مهم سمح بالانفلات من «المواجهة العقيمة» التي عاناها «بورديو» وصنفته تصنيفات مُجْحِفة.
لكن الباحث، للأسف، لم يطور هذه النقاط إلا قليلًا، مشيرًا في سياقات متعددة إلى أنه يسعى إلى «تطبيق النظام المفاهيمي الخاص ببورديو، على بورديو نفسه» وهذا يبدو إشكاليًّا؛ لأن «فابياني» حاول خلال تحليله أن يبين التناقضات ومختلف الاستخدامات التي قام بها «بورديو». ويمكن الشعور بهذه الفجوة في البناء الكلي للكتاب؛ إذ لا تتوافر فصول الكتاب على أقسام فرعية أو تنصيص من متون أخرى للاستدلال والمقارنة، إنما كُتبت الفصول دفعة واحدة. كما يصعب أحيانًا فهم الترابط الداخلي على نحو سلس ومنطقي؛ ما يفقد بعض الفقرات تماسكها. كما تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن العمل الذي اقترحه «فابياني» هو في رأينا مصدر قيم للغاية؛ لأنه يمكننا من شحن التفكير النقدي وتجريب منهجية اجتماعية وفرها لنا «بيير بورديو» من خلال أعماله الغنية والجدلية.
حاول «فابياني» إذن أن يجد معنًى لعمل «بيير بورديو» الشاق بأنْ منحه صفة «البطولة»، منبها إلى أن «بورديو» عاش اجتماعيًّا وعلميًّا بهذه الروح الشغوفة بالتحدي والرغبة في التغيير إلى ما هو أفضل محليًّا ودوليًّا. وتجلى ذلك في اختلافه الدائم مع أنماط التفكير السائدة التي تستغل الإنسان وتجرده من قيمه الثقافية والإنسانية؛ لهذا يجب على المثقف أن يكون مناضلًا ليجعل المؤسسات المهيمنة في وضع غير مريح. إن «بورديو» -كما يقول «فابياني»-: «هو أول ثوري رمزي قادم من الشعب»، لكن «فابياني» لا يخفي خيبة أمله؛ إذ يعتقد أن «بورديو» استسلم في نهاية المطاف لغطرسة المؤسسات المهيمنة، التي حاربها طوال حياته. وهذا لا ينتقص من عظمة المساهمة العلمية التي قدمها «بورديو»، التي تظهر من خلال مؤلفاته ومواقفه الشجاعة.

 عندما يكون المجتمع هشًّا وسطحيًّا، فإنه يرحِّب بتداول الإشاعات على نطاق واسع. ولكن الأخطر من بعض الإشاعات ذات الطابع الفكاهي، هي تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية الشائكة والناتجة من حركات وتيارات تخريبية وهو ما يؤثر على إحساس الفرد بالأمان والاسقرار؛ لذلك، تقوم الدولة بالمراقبة وسنِّ بعض القوانين للحد من الإشاعات، ويكون هذا الدور الرقابي كبيرًا عندما تكون الشائعات تتعرض لأداء المؤسسات الرسمية، أو الشخصيات السياسية البارزة، إضافة إلى حق المتضرر في رفع قضية. كما يجب أن أنوِّه بدور المكونات الاجتماعية الحاد جدًّا في التعامل مع الإشاعات التي تخص فئة بعينها، وهو ما يزيد من نسبة المراقبة الذاتية عند مَنْ يحاول ترويجها. حقيقة، أرى أن الشائعات وجه من أوجه الثقافة الشعبية في المجتمعات العربية، وتعكس فكر وثقافة وتطلعات المجتمع، وتحتاج إلى مراقبة من المؤسسات الرسمية والمدنية؛ كي لا تتحول من إطار الفكاهة والتندر إلى مصدر تفكيك المجتمع وتدميره.
عندما يكون المجتمع هشًّا وسطحيًّا، فإنه يرحِّب بتداول الإشاعات على نطاق واسع. ولكن الأخطر من بعض الإشاعات ذات الطابع الفكاهي، هي تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية الشائكة والناتجة من حركات وتيارات تخريبية وهو ما يؤثر على إحساس الفرد بالأمان والاسقرار؛ لذلك، تقوم الدولة بالمراقبة وسنِّ بعض القوانين للحد من الإشاعات، ويكون هذا الدور الرقابي كبيرًا عندما تكون الشائعات تتعرض لأداء المؤسسات الرسمية، أو الشخصيات السياسية البارزة، إضافة إلى حق المتضرر في رفع قضية. كما يجب أن أنوِّه بدور المكونات الاجتماعية الحاد جدًّا في التعامل مع الإشاعات التي تخص فئة بعينها، وهو ما يزيد من نسبة المراقبة الذاتية عند مَنْ يحاول ترويجها. حقيقة، أرى أن الشائعات وجه من أوجه الثقافة الشعبية في المجتمعات العربية، وتعكس فكر وثقافة وتطلعات المجتمع، وتحتاج إلى مراقبة من المؤسسات الرسمية والمدنية؛ كي لا تتحول من إطار الفكاهة والتندر إلى مصدر تفكيك المجتمع وتدميره.







 تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
تقدم الأعمال المترجمة للروائي الياباني كنزابورو أوي من اليابانية إلى اللغة الفرنسية الصادرة مؤخرًا خدمة أدبية جليلة للقارئ عمومًا. فترجماتها رصينة وانتقاؤها دقيق، ترصد حياته وأدبه على مدار عقود عدة. ولا ينحصر اهتمام دور النشر العالمية بنشر أعماله فحسب، بل يأتي الاهتمام أيضًا من كونه شخصية ثقافية مثيرة للجدل في اليابان. فهو يحتل اليوم واجهة الإعلام الياباني بحكم معارضته الشرسة للاستخدامات النووية العسكرية والمدنية. ولد كنزابورو أوي في عام 1935م في قرية شيكوكو من مقاطعة إيهايم باليابان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وهو واحد من الشخصيات الأكثر نشاطًا ثقافيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا. ألف كتابًا مؤلمًا عن هيروشيما، نشر في عام 1965م (أعيد إصداره مؤخرًا ضمن سلسلة كتاب الجيب)، وقد منحته الكارثة البيئية والإنسانية في فوكوشيما الفرصة لتوسيع نطاق هذا الالتزام برفض الطاقة النووية المدنية من دون التخلي عن إنعاش الذاكرة الجماعية، منبِّهًا إلى نتائج مأساة هيروشيما وناغازاكي، وفي هذا الصدد كتب كثيرًا من المقالات وأجرى عددًا من المقابلات، كما التمس من رئيس الوزراء التخلي عن الطاقة النووية وجمع أكثر من سبعة ملايين توقيع تؤيد موقفه.
 ● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
● أرنو فولران: كنت في الثانية والعشرين عندما نشرت عملًا غريبًا؛ هل كنت تشعر أنك كاتب؟
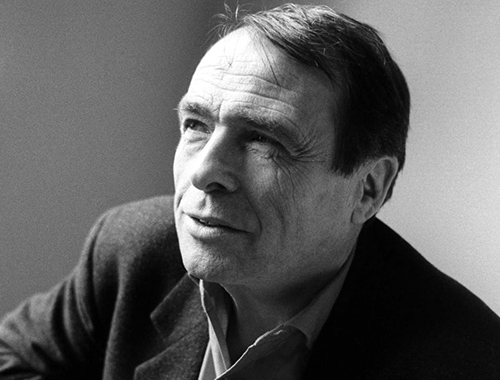

 حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم.
حاول الباحثُ- (استنادًا إلى قراءة قريبة جدًّا من أعمال «بورديو» جنبًا إلى جنب مع أدبيات «بورديو» السوسيولوجية الوفيرة، مع العلم أن رصيد بيير بورديو ثلاثون كتابًا ومئات الدراسات والمقالات) تحليلَ «تاريخانية» التطورات المتلاحقة التي عرفتها المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع. وهذا مكّن «جان لويس فابياني» من تسليط الضوء على التطور التدريجي لها عند «بورديو» منذ عام 1960م، إضافة إلى بعض التناقضات المتنامية الميّالة إلى التعميم، كما مكّن هذا التحليل المفصل للمفاهيم الثلاثة المؤلفَ بدرجة أكثر أو أقل من التوصل إلى تفكيك أهم المفاهيم. 
