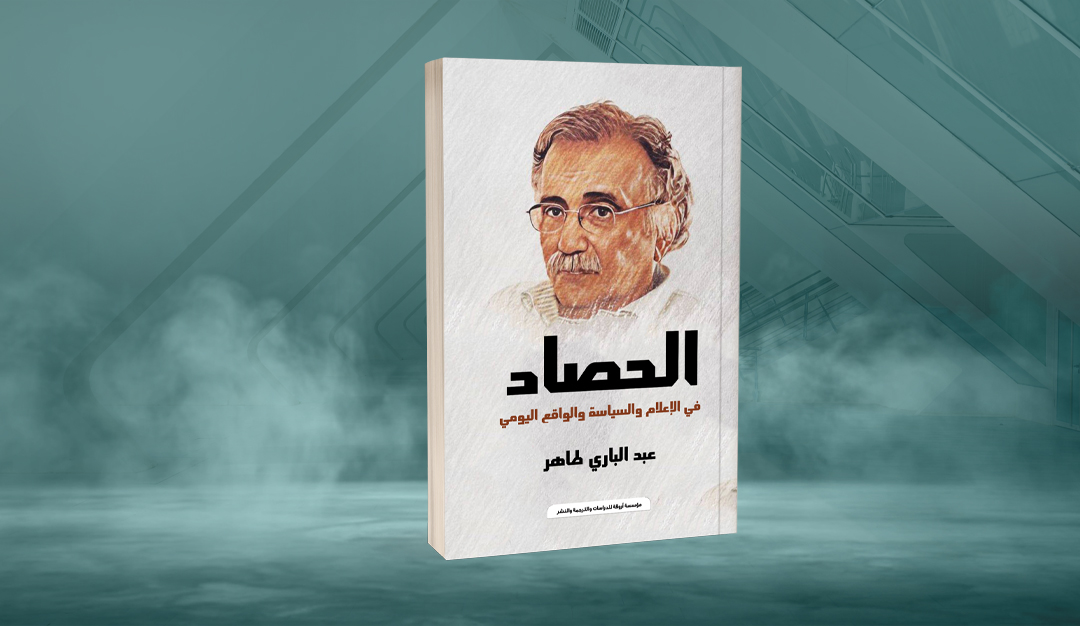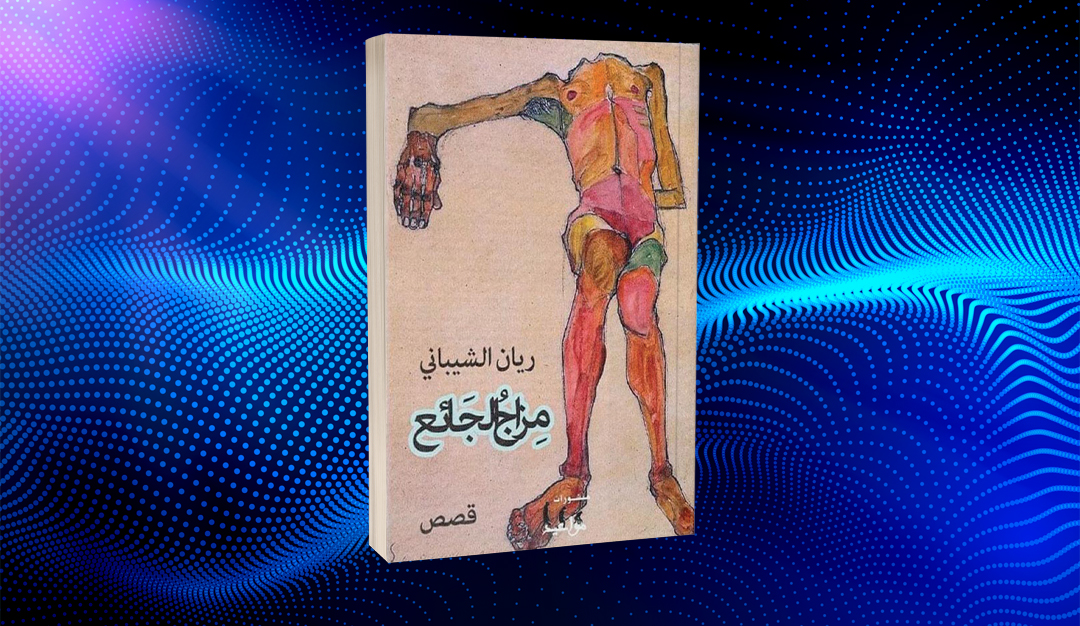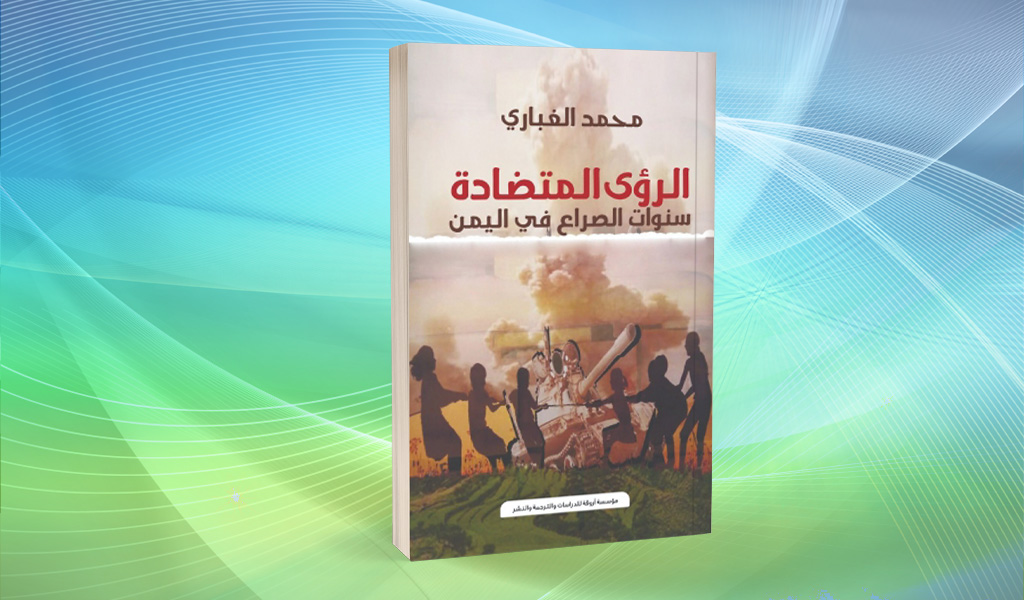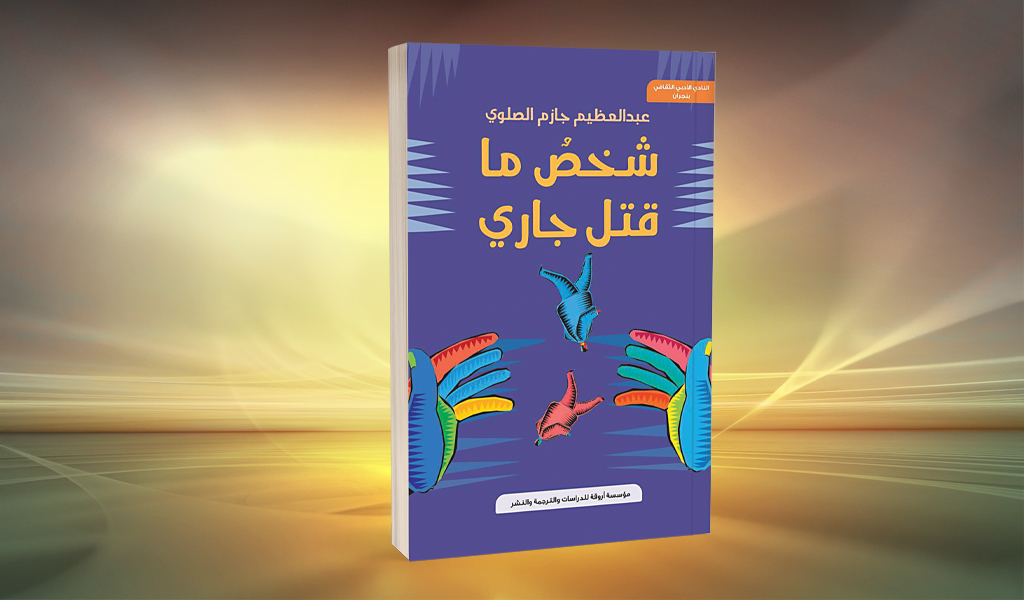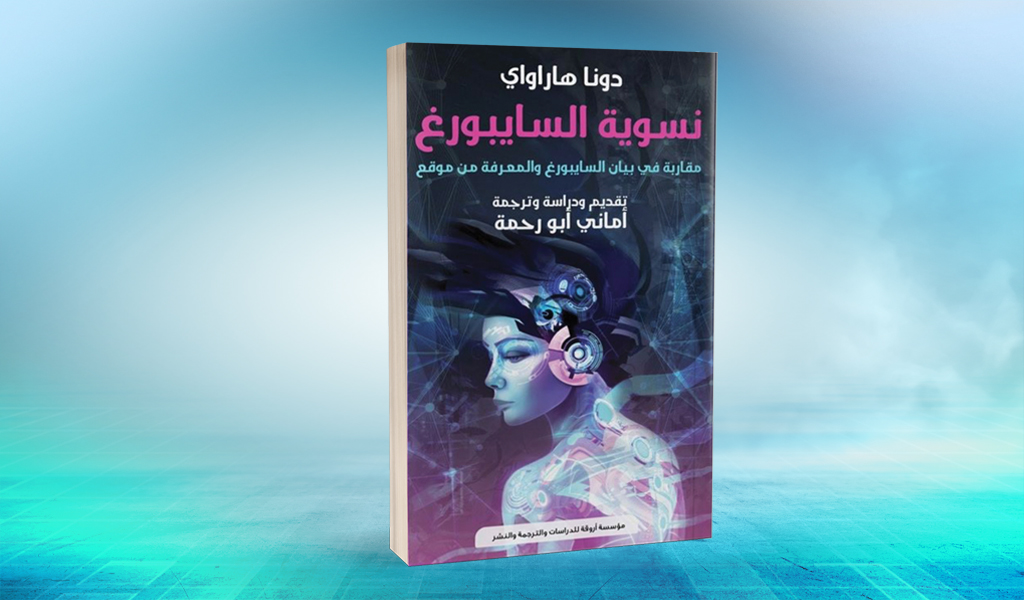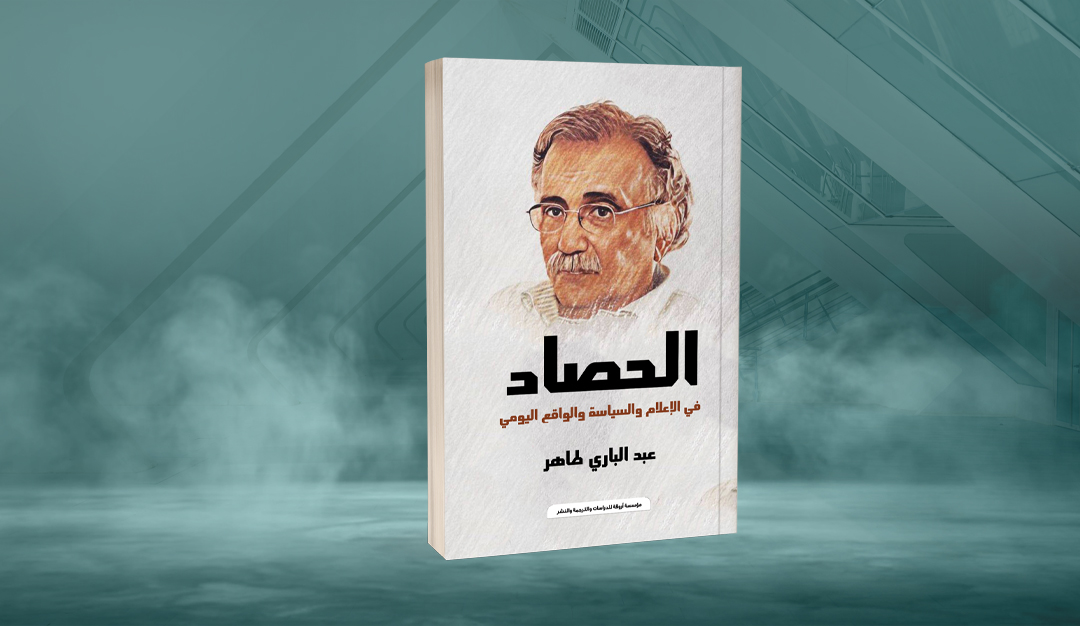
محمد جازم - كاتب يمني | مارس 1, 2025 | كتب
نادرون جدًّا الكتاب الذين يشبهون المبدع الكبير عبدالباري طاهر، فهو من ذلك النوع الذي تتسق أفعالهم ومواقفهم المبدئية مع ما يقولون ويكتبون، يحمل في «قميصه المنتف» على حد تعبير شاعرنا الكبير عبدالله البردوني كل تعقيدات الذات اليمنية وبساطتها، تتناهشه حراب حساده وأصدقائه وأعدائه وهو صامد مثل جبل النبي شعيب، وإن به صفة توارثها من طباع القبائل العربية تلك التي لا تترك مظلومًا حتى تنتصر لمظلوميته، وهو كذلك لمن يتابع مشروعه في الصحافة اليمنية والعربية، فقد أخذ على عاتقه الانتصار لقضايا البسطاء أينما كانوا، مدافعًا عنهم حتى يصلون إلى ما يريدون، إنه لا يترك مشكلة أو قضية إلا وقال رأيه فيها بكل صدق وأمانة، وبكل التزام أخلاقي وفلسفي ووطني، متخذًا من منهجه الجدلي طريقًا ودربًا لمعالجة القضايا المتعلقة بحرية الإنسان وكرامته.
ولد عبدالباري طاهر في سهول تهامة عام 1941م، وبدأ الكتابة في صحيفة الجمهورية عام 1967م، انتُخب لرئاسة نقابة الصحفيين عند تأسيسها في سبعينيات القرن المنصرم، وفي عام 1979م انتُخب نائبًا للأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ترأس تحرير صحيفة الثورة الرسمية في 1973م، وترأس مجلة الحكمة الصادرة عن اتحاد الكتاب اليمنيين وصحيفة الثوري الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي اليمني، كما ترأس الهيئة العامة للكتاب؛ وهذا سيبدو جليًّا في كتابه «الحصاد في الإعلام والسياسة والواقع اليومي» (صدر عام 2025م عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر) جاء الكتاب الضخم، أكثر من 400 صفحة، تعبيرًا عما يؤمن به صاحبه. يحكي بما فيه، أنه صورة لآرائه الصارمة وتصوراته العميقة وشغفه العلمي بالمعرفة والمحبة السخية لمن يكتب من أجلهم ويدافع عنهم. ينقسم كتاب الحصاد إلى ثلاثة فصول: الأول بعنوان صحافة، والثاني بعنوان قضايا وطنية، والثالث بعنوان: قراءات.
جاءت المقدمة في هيئة مقال استهلالي يتحدث عن يوم الصحافة اليمني 9 يونيو، وهو يوم يرتبط بالذهنية الوطنية لدى الصحفيين، وعبدالباري الذي أسس في شمال الوطن مع رفاقه أول مؤتمر لنقابة الصحفيين اليمنيين منتصف السبعينيات، وفي 1990م دُمجت النقابتان الشمالية والجنوبية بعد الوحدة اليمنية ببضعة أسابيع ليرأسها هو أيضًا.
دستور صحفي

عبدالباري طاهر
هذا الكتاب المعجون بعرقه ودمه وتراب الوطن يصح أن نقول فيه، إنه يصلح لأن يكون دستورًا صحفيًّا ومادة علمية مدرسية، يتعلم منها الأجيال في الوطن العربي، كيفية الإخلاص والالتزام. في المقال الاستهلالي بدا شديد اللهجة، مدافعًا عن مواطنيه حتى ليبدو كما لو أنه يقدم نصائح للصحفيين، وفي المقابل يدين القامعين ويوبخهم، يقول: «كل الأطراف المتقاتلة تتنافس وتتسابق على قمع الصحفيين ومصادرة الحريات العامة والديمقراطية، وبالأخص حرية الرأي والتعبير. لدى كل الأطراف بما في ذلك الجنوب «المحرر» وتعز المحاصرة، قمع شائن للحريات الصحفية. ويقينًا فإن الصحفيين الشهود على جرائم الحرب والمحتربين، هم أكثر ضحايا هذه الحرب الإجرامية. ويجدر بنا أن نشير إلى أن الفرضية التي بُني عليها الكتاب تتحدث عن السياسة القمعية وحرية الصحافة في الإعلام والمسكوت عنه، في الوقائع اليومية لحياة الناس وأحلامهم وآمالهم. وأهم ما ركز عليه الكتاب نهج الحرب والاقتتال الداخلي منذ عام 1994م وانعكاسات ذلك على التنمية، يقول: «حروب قبلية ومناطقية هنا وهناك – تغطي مسار اليمن الحديث لأكثر من نصف قرن، هذه الحروب سبب رئيس في تغييب التنمية والبناء والتحديث والاستقرار». وقد دعم ذلك بتساؤلات ضمنية عن كيفية الحد من التنكيل بالصحفيين؟ وأهمية الحرية لإرساء قيم وتقاليد صحفية قوية، إضافة إلى فهم وإدراك أهمية الهامش الديمقراطي، وعدم استغلاله للتضييق على حرياتهم في الحصول على المعلومة.
قدم الكاتب الكثير مما يتعلق بتاريخ الصحافة اليمنية في الخارج، مستندًا إلى صحيفة السلام التي أصدرها في كارديف الشهيد الكبير عبدالله علي الحكيمي، والتي ذكر أنها أول صحيفة عربية تصدر في بريطانيا، «اهتمت الصحيفة منذ الأعداد الأولى بالدعوة للحرية والحوار والدفاع عن ضحايا 1948م وفلسطين والجامعة اليمنية، واستقلال البلاد العربية». ويتنقل كتاب عبدالباري طاهر من التنظير إلى التطبيق، متبنيًا لائحة بالمطالب الصحفية، مشيرًا إلى أنها وضعت لبنات استحقاقها بنضالات رموزها: أنور الركن، وأمجد محمد عبدالرحمن، وأحمد عبدالرحمن وغيرهم.
قضايا
ويناقش الكتاب عددًا من المواضيع والقضايا التي تنوعت: «بين قضايا تخص اليمن، وقضايا تتعلق بالوطن العربي». تناولت قضايا اليمن ما يخص الهموم الكبيرة التي تشغل بال الكثيرين، ومنها الحرب في اليمن وخطابها موضحًا أن تلك الحرب التي انتشرت بسرعة البرق -في سبتمبر 2014م لتجتاح صنعاء وتعز وعدن وحضرموت- بأنها غرائبية لانعدام العمل السياسي فيها واعتمادها على ميليشيات مسلحة تتقاتل مع بعضها في ظل غياب أو ضعف التوجه السياسي. فالحرب اليمنية كما وصفها المؤلف «لعبة مقيتة» وخطابها هو الأكثر زيفًا ومراوغة والتباسًا خاصة أنها جاءت في وقت لم يعد فيه «المجتمع الدولي مهتمًّا بالحرب كما كان، فالعالم مشغول بالقضايا الأكثر سخونة وخطورة على مصالحه وقضاياه الكبرى، لم يعد الاهتمام باليمن إلا في الجوانب الإنسانية». وخلص المؤلف إلى أن اليمن شهدت ثلاثة مسارات: مسار اقتسام الحكم، ومسار تشكيل لجنة الحوار الوطني، ومسار استمرار الحرب بين
جيش وميليشيات.
أما القضايا التي تتعلق بالأمة العربية فقد تطرق عبدالباري طاهر إلى فلسطين وكيف أن الاستعمار الذي توارى كوجود عسكري ظل حاضرا سياسيًّا واقتصاديًّا، وهو ما أدى إلى التفكك العربي الذي أشار له بـ«سردية أندرسون»، وهو عبارة عن تحقيق بعنوان: «كيف تفكك العالم العربي؟».
قراءات لعشرات الكتب
ولمن تابع مسيرة عبدالباري طاهر منذ أكثر من ستين عامًا، سيجد أن هذا الكتاب الذي يعده الحصاد، هو في جانب منه مقدمة لعشرات الكتب التي صدرت خلال سنوات طويلة، ولعله أقام الفصل الأخير من هذا العمل على مخزونه الأخير وحنكته الدؤوبة في تلمس المشهد الثقافي اليمني، ومن الواضح أن قراءاته تنقلت بين تناول الروايات والقصص إلى المذكرات والكتب السياسية والفكرية والمعجمية، وهو على قلة الكتب التي تصله شغوف بالتواصل ومجد في معرفة الجديد، فقد ذكر أن اليمن في تسع السنوات الأخيرة أصدرت كُتبًا كثيرة جدًّا، وهي على كثرتها تمتاز بالجودة والثراء الأدبي والمعرفي الهائل، وكأنها على حد تعبيره رسالة للحرب الكارثية بأن إرادة الحياة أقوى.
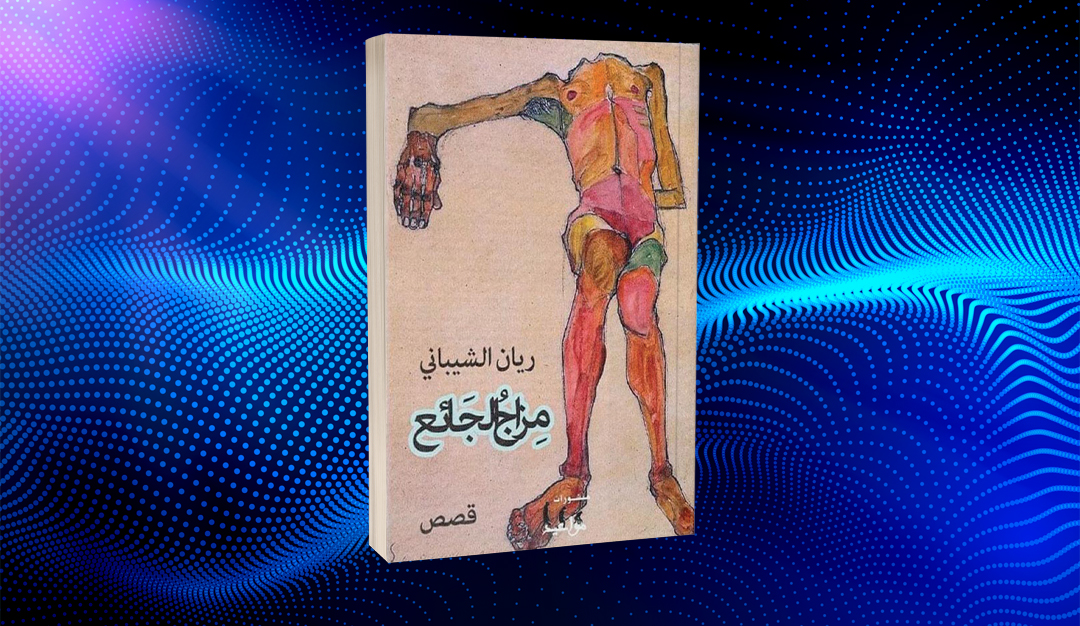
محمد جازم - كاتب يمني | نوفمبر 1, 2023 | كتب
صدرت عن دار مواعيد– صنعاء، مجموعة قصصية بعنوان «مزاج الجائع» للقاص والروائي الفنان ريان الشيباني، تقع المجموعة في 133 صفحة. وكان الكاتب قد أصدر قبل ذلك روايتين مهمتين في المشهد السردي اليمني؛ إحداهما بعنوان «الكلب» عن دار أروقة في القاهرة، والثانية بعنوان «الحقل المحترق» عن دار خطوط وظلال الأردنية. ومن يعرف الكاتب سيتذكر أنه دشن حياته الإبداعية بإقامة معارض تشكيلية لافتة في مدينة تعز – بداية، وكانت لوحاته التشكيلية وما زالت مثار إعجاب المهتمين، وقد رأينا أنه سار على الدرب، درب الرسم، ولكن هذه المرة بالكلمات.
قرأت قصصًا كثيرة لريان هنا وهناك، وشاهدت لوحات كثيرة لريان الفنان التشكيلي، ولا أستطيع إلا أن أقول: إن ريانَ حملَ معه مزاج اللوحة وهو يدلف من بوابة السرد، ومع صدور هذه المجموعة القصصية فهو ذكرنا بتلك اللوحات البديعة والمثيرة للإعجاب، هذا ما تؤكده مجموعته القصصية التي تحتوي على 21 لوحة/ قصة، استطاع أن يوشحها بخطوط إيقاعية لونية، مركزًا على موسيقا داخلية غير منظورة، ومحددًا مرتكزات وعلامات ودلالات، يجمع فيها الفنان بين الرسم السردي والأسلوب الفني. وإذا كان هناك من يعرف القصة بأنها تصوير مقطع من الحياة، فإنها لدى ريان تصوير مكثف من حياة اللون، ولا ينسى وهو يرسم قصصه أن يلتقط بورتريهات لشخصياته. فالفضاء البصري الذي اعتاده كاتبنا سار معه من فضاء اللوحة إلى أرض الواقع والحياة اليومية.
ولعلنا إذا تأملنا في العنوان «مزاج الجائع»، سندرك أن قصص ريان تتتبع أناسًا هامشيين منذ الغلاف الذي يحتمل كثيرًا من القراءات والاجتهادات، وإن كانت القراءة المفترضة للعنوان تشير إلى مزاج من نوع آخر. وسوف نلمس اصطفاف ريان، كما أننا سوف نتعرف إلى همه الذاتي وحزنه الخاص، وتوظيفه الساحر لفلسفة الجوع. فشخصياته جميعها لديها فلسفتها الخاصة وقدرتها المكثفة على الرد، لهذا فإن إضافة مفردة مزاج إلى مفردة الجائع لا تعني سوى أن المعركة معركة وجود. أنا جائع ولكن لدي مزاجي الخاص، حتى لو اقتضى الأمر أن أنشر جواربي في مطار دولي، وأمام وجه البرجوازية العفنة.
تقنية رسم الشخصية
من يقرأ هذا العمل الإبداعي سوف يكتشف أن ريان نقل تقنية رسم الشخصية من اللوحة، وأصبحت في أعماله تقنيات يشكلها حسب أحلام وأفكار شخصياته. اللوحة الأولى: البائع، خمسيني «يلبس بدلة سفاري رمادية… وجهه أسمر متورد، وشفة سفلية متهدلة، يحفها شارب كث» ص11، عن صديق أبيه، مقاول غربت شمسه أو هكذا يدعي. في قصة «المميزون الغرقى» لقطتان، من فوق الطائرة؛ إحداهما لركاب درجة أولى، والأخرى لركاب الدرجة الثانية وهما في لحظة الذروة، على وشك السقوط في بحيرة تانا. ثمة بورتريه دقيق لعجوز سبعينية في مطار رفيق الحريري ببيروت، تتأفف من وجود شخص ما كان له أن يوجد هنا.

ريان الشيباني
لوحة «يا لوجهك القاتل اللعين! ما الذي يدور ببالك» يتجلى فيها بوصف الدكتاتور «يوسف زباطة» فهي لوحة تهكمية ساخرة، تشبه إلى حد ما لوحات الفنان الشهير «بهجاتوس». إنها لوحة فنية لا تمتد إليها يد الإنسان العادي، يظهر فيها زباطة وقد أمر مناصريه بإحداث شغب من أجل إسقاط الحكومة الجديدة التي أسقطته بعد حكم امتدّ لأكثر من ثلاثين عامًا، وهنا تتكثف اللقطة بثبات على ابتسامة مصطنعة «خرجت من شفتين مستعارتين لم تتعافيا بعد من آخر محاولة اغتيال» ص35. ألم أقل لكم: إن ريان «يشكل» بالكلمات. فلو تحولت هذه اللقطة إلى لوحة سنرى شفتين سوداويتين تتطاير جوارهما الأوسمة الصفراء والدخان والعيون الحمراء الملتهبة، و«نظارة ابن أخيه المعتمة داخل سحابة سوداء معتمة» ص36.
قصة الملياردير محمود هي أيضًا تنتقد رجلًا فقد تجارته، ولكنه يمتلك في قريته أرضًا تُقدّر بمساحة البحرين، وهذا ما جعله علكة في فم أهل القرية أصحاب الحق الأصليين، الذين من حقهم أن يشاركوا الرباصي هذه المساحة. فقد ذهبت إليه عبر حيله الخاصة وعلى حين غفلة مثل: «نحتاج جدارًا يقي نساءنا نظرات الغرباء» ص43. وهو المكان الذي سيبني فيه قصرًا على شكل دبابة، مبددًا كل أمواله على حلم عبثي لا طائل منه.
يستلطف الراوي «متسول عصري» فهو أيضًا لديه مزاج ولا يحب أن يبوح بأسراره إلا عن طريق اللغة الإنجليزية، ليس لأنه يبتكر طريقة جديدة للتسول ولكن حتى لا يفقد هيبته، فهو دكتور ينحدر من أصول هندية تقطعت به السبل، فلم يستطع العودة إلى بلد المنشأ، والخلاصة أنه يفتقر إلى المال ويريد أن يقنع محدثه أنه في حكم الضيف لكي يحفظ ماء وجهه، ولكنه حين أخذ ما بالجيب نسي لغته المفترضة وعاد لفصاحته العربية.
لن أنسى التوضيح أن قصص ريان ليست بورتريهات فقط، ولكنها ذات فضاءات وخلفيات مكانية وزمانية وفضاءاتها ليست مغلقة، وإنما عامة ومفتوحة ومؤثثة بما يشير إلى أنها قصص الناس العاديين. فالقصة التي أخذت العنوان «مزاج الجائع» تدور أحداثها داخل مطعم مفتوح لمن أراد ارتياده، وشخوصه متجددون كما لو أنهم ماء نهري يعبرون في مكان محدد، ثم يذهبون إلى فضاءات المطعم، هي أيضًا مفتوحة على شخوص عدة؛ المسؤول الأول، والمسؤول الثاني، والندل، والزبائن، إضافة إلى الأدوات وما يتبعها، والمكان المؤثث بملحقات جمة.
أنقاض الحرب
أما قصته «لحظة كاوية» فإنها منحوتة من بين أنقاض الحرب، وبطلاها سليم المربوش وماجد المكمّل، وكلاهما يخضع لدهر الحرب اليمنية التي كما يبرزها السارد تسيطر على المجتمع، فبالقدر الذي يجسد فيه القاص ملامح سليم المربوش يذهب إلى ماجد فيرسمه بدقة لأنه يمثل المرحلة: «يحتزم حافظة متروسة بالرصاص، ويحمل في يده اليمنى بندقية كلاشنكوف، وعلى خاصرته اليسرى مسدس ميكاروف» ص57. قدم ماجد كنافة، وصفها الجد المرتاب، الذي يعد من المحاربين القدامى، باللغم؛ ليلتها توفي الجد وهو يصرخ بأن الرجل الذي زارهم، من الأعداء، وهو الأمر الذي شكك فيه سليم؛ فظل طوال عمره يشك في أنه يحمل جسدًا ممتلئًا بالسم. استعار الراوي من الفضاء العام صورة جد سليم وصفه بين الشخصيتين، ثم جاء بوجوه خلفية اصطفت هي أيضًا خلف الوجوه الرئيسة؛ مثل: زوجة سليم منى، وصديق مشترك، وسائق السيارة التي أقلته إلى المطعم. وفي المجمل تصور القصة كاوية الحرب وهي لا تحرق المشهد البصري فقط، وإنما تمتد إلى الداخل. غير أن ما نود التنويه إليه، هو أننا لمحنا خيطًا رفيعًا يتتبع «مزاج الجائع» داخل مجموعة اللوحات؛ في القصة الأولى شاهدنا رجلًا لديه حسه الخاص في عرض مدخراته لطالب معدم هو الآخر. الشاب في مطار بيروت يواجه بجواربه المتسخة وجه امرأة برجوازية تتقزز من وجوده، لكنه بعزيمة الإنسان المقهور يوجد. الشاب نيبور في قصته لا يستطيع دفع ثمن الفتاة، التي ذهب لخطبتها كما لو أنها «بقرة»، وهو ما يعني أن القاص يمضي محافظًا على أمزجة شخوصه الجوعى. «المميزون الغرقى» ليسوا سوى ركاب طائرة، وفيها يشير الكاتب إلى خيط غير المميزين، من حيث إنهم يحملون عنوان العمل القصصي نفسه، فالجميع سيغرق.
أخيرًا، تعد «مزاج الجائع» إضافة حقيقية للمشهد الإبداعي اليمني؛ لما تمتلكه من أسلوب خاص وقاموس لغوي ممتع وسرد شائق، استطاع أن يختط له مكانًا فارهًا في المشهد الإبداعي اليمني.
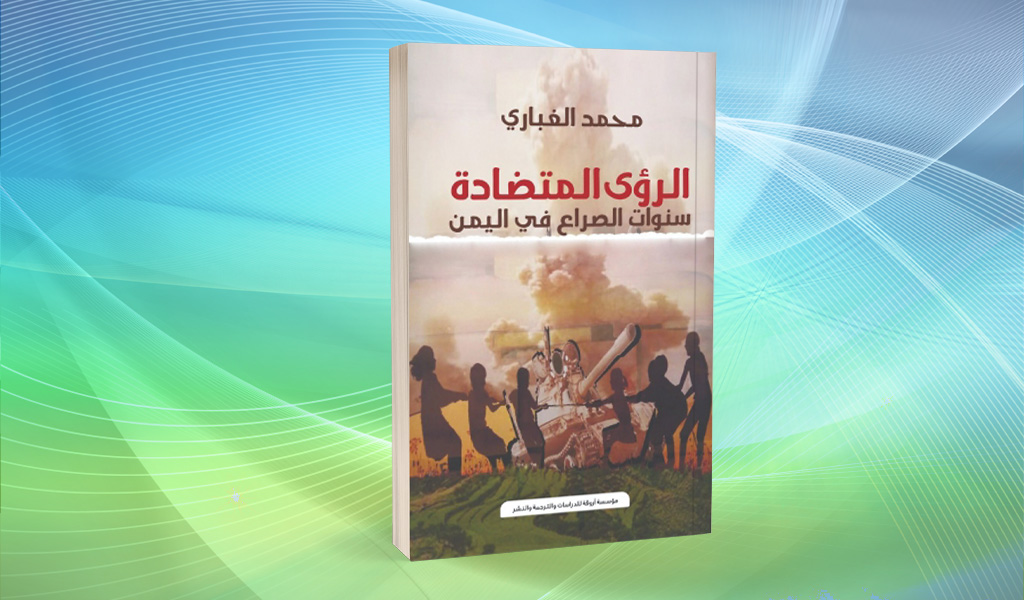
محمد جازم - كاتب يمني | سبتمبر 1, 2021 | كتب
قارئ كتاب «الرؤى المتضادة: سنوات الصراع في اليمن» للصحافي محمد الغباري (دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر– في القاهرة) سيتساءل وهو ينهي قراءته: هل هي حرب داحس والغبراء تتناسل منذ العصر الذي سبق الإسلام في اليمن؛ أم إن الصراع طبيعة متأصلة في الإنسان؟ المشهد السياسي اليمني يبدو على درجة كبيرة من التعقيد، وهو تعقيد تتحكم فيه البيئة ذات التباينات الجغرافية والبشرية الموغلة في الانقسام، لكن الصحافي المعروف محمد الغباري تجشم رحلة التوثيق لهذا الصراع الطويل، وبحنكة الباحث استطاع تسليط الضوء على كثير من المناطق الرمادية والمعتمة في هذا المشهد، ولعل أهم ما نبّه إليه في مقدمته، على طريق هذا المسار، هو أن الحركات السياسية لم توثق لأنشطتها، فيما المراكز البحثية والأكاديمية كانت محكومة بسياسات السلطات المتعاقبة، وأن ما أُنجِزَ لا يفي بالغرض لأن هناك كثيرًا من التفاصيل تتساقط مع مرور الزمن.

محمد الغباري
ومن هذا المنطلق وضع الكاتب نصب عينيه إزالة الغموض والملابسات التي تكتنف المشهد، فهو انتقد الكتابات والمذكرات المحدودة التي صدرت؛ لأنها «لم تسلط الضوء على تجاربها الداخلية وصراعها مع المختلف». تقوم منهجية الكتاب على الحوار التحليلي الذي يركن إلى الشفافية والوضوح، واعتماد مبدأ الاقتراب من الحقيقة في ممكنات وثوقها. وعلى الرغم من أن الكتاب عمل على إزالة الاشتباك بين تجربتين للحكم؛ واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب، فإن التداخل بين التجربتين لا يمكن فضه بسهولة، إنما يمكن، في المعنى العام، القول: إن الكتاب حاول تقويم التجربتين بوضع أسئلة مفتوحة، وكان على رأس الشخصيات المحاورة المفكرُ والصحافي الكبير عبدالباري طاهر والسياسي المعروف عبدالله سلام الحكيمي وطه سيف نعمان الذي تحدث عن تجربته في حزب البعث والصراع بين بغداد ودمشق، وكذلك رئيس الحكومة السابق محمد سالم باسندوة، متحدثًا عن الصراع المميت بين الجبهتين القومية والتحرير في الجنوب، ومحمد الأكوع الذي وضع رؤية أخرى عن الانقلاب على الرئيس السلال في صنعاء؛ ثم عبدالله الراعي والانقلاب على الرئيس الإرياني.
مقدمة الكتاب جاءت بعنوان: «محاولة للإنصاف»، تحدث فيها الغباري عما كان يتوقعه المهتمون بالشعب اليمني، من جاهزية اندثار قوى اليسار بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، غير أن ذلك لم يحدث، وإنما حافظ على وجوده رغم الحرب القوية التي شنّت ضده في صيف 1994م والتي على إثرها سُرِّحَ جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأُخلِيَ عن سكان المحافظات الجنوبية وما رافق ذلك من إغلاق للمصانع والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، ومن ثم توزيعها على حلفاء الحرب.
قطب محرك
الحوار الذي أُجري مع المفكر اليمني البارز عبدالباري طاهر، رئيس نقابة الصحافيين السابق، أثرى الكتاب كثيرًا لأن طاهرًا لم يكن سياسيًّا مخضرمًا فقط، وإنما أحد الأقطاب المحرِّكة للعمل الوطني في اليمن، وكان ولا يزال من أهم الذين وثقوا للمراحل والتحولات التي حدثت منذ مطلع 1962م. أسئلة مفصلية تحدث فيها طاهر عن مخاضات تأسيس الأحزاب السياسية في اليمن بعد الثورة اليمنية، تلك التي انطلقت منذ عام 1964م، من رابطة الطلاب في القاهرة حيث نشأ عن هذه الرابطة اتجاهان: الإخوان المسلمون والاتجاه الماركسي. ومن أجل توضيح المشهد أبان طاهر بداية التململ السياسي ضد حكم الأئمة وعلاقته بالدستوريين والضباط الأحرار في 1948م، و1955م، و1962م، ووضح كيف شُكِّلَت الاتحادات مثل اتحاد الشعب الذي أسسه عبدالله باذيب. وفي ميدان الانشقاقات السياسية تطرق لكثير من الالتباسات حول تشكل الجبهة القومية.
تصاعد الحوار إلى أن أصبح شبيهًا بالسيرة التنظيمية لطاهر وعلاقته بتشكيل الأحزاب اليسارية، وصحيفة الثورة التي رأس تحريرها في أواسط السبعينيات، ثم كيف حدثت الانشقاقات السياسية والاعتقالات في أثناء حكم السلال، وكيف وصل الحكم إلى الرئيس إبراهيم الحمدي. ثم ذهب الحديث إلى كيفية الإطاحة بالرئيس قحطان الشعبي، ورأي عبدالفتاح إسماعيل في تشكيل حزب واحد يضم اليسار في الشمال والجنوب تحت اسم الحزب الاشتراكي اليمني. وخلص طاهر من خلال رؤاه الفكرية إلى أن الصراع في الجنوب أضعف المسار الأيديولوجي للحياة السياسية في اليمن.
أما عبدالله سلام الحكيمي فقد تحدث عن تنظيم الناصريين والرئيس الحمدي والانقلاب على صالح؛ وإذا أمعنا النظر إلى ما أورده الحكيمي سنجد أن الناصريين تواصلوا مع الحمدي وهو رئيس للبلد؛ بعد حركة 13 يونيو التصحيحية -تحديدًا- التي قادها، حيث توافرت لديهم معلومات ناتجة عن متابعة وتحليل ليتضح أن شخصية الحمدي قيادية من الطراز الأول، وأنه يتمتع بكثير من الذكاء الوطني؛ لأنه كان حريصًا على التواصل مع المثقفين والقوى السياسية وبخاصة الحزب الديمقراطي الثوري، وبقية أحزاب اليسار وشخصيات عسكرية وآخرين تأثروا بالفكر الناصري.
ومن الحوارات المهمة التي تضمنها الكتاب الحوار الذي أجري مع طه سيف نعمان، والحقيقة أن كل شخصية من الشخصيات المكونة للكتاب تميزت بتجربة خاصة؛ إذ بلغ السرد ذروته في تجربة طه سيف نعمان الذي تمحور الحديث معه حول تجربة السجن، وهي تجربة نقل من خلالها واقع السجون اليمنية في السبعينيات والثمانينيات، وكيف كان الاعتقال والتعذيب؛ فقد نقل صورة مؤلمة للتعذيب الذي تلقاه أبو بكر السقاف، وكذلك عبدالمجيد الخليدي، وعبدالكريم الشرجبي وعبدالله الواسعي.
محمد سالم باسندوة أحد أقطاب جبهة التحرير، تحدث عن دور جبهة التحرير وعملية النضال السلمي ضد الاستعمار، ثم نزوحه إلى مدينة تعز بسبب الصراع مع الجبهة القومية. وتطرق إلى تجربته في صنعاء، حيث عُيِّنَ في عدد من المناصب الدبلوماسية والوزارية منذ عام 1974م، حتى ما بعد قيام ثورة 11 فبراير التي عين فيها رئيسًا للوزراء. أما محمد علي الأكوع فقدَّم رؤية مختلفة للانقلاب على السلال، كما أنه يحتفظ برؤية أخرى عن انقلاب 1955م على الإمام أحمد. الحوار مع عبدالله بركات عبارة عن شهادة حول أحداث أغسطس 1968م. كما تحدَّث عبدالله الراعي عن تجربته في حزب البعث. وتبعه شهادة مغايرة أخرى من محمد عبدالله القردعي، حول المواجهات بين الحراكيين والقوى التقليدية.
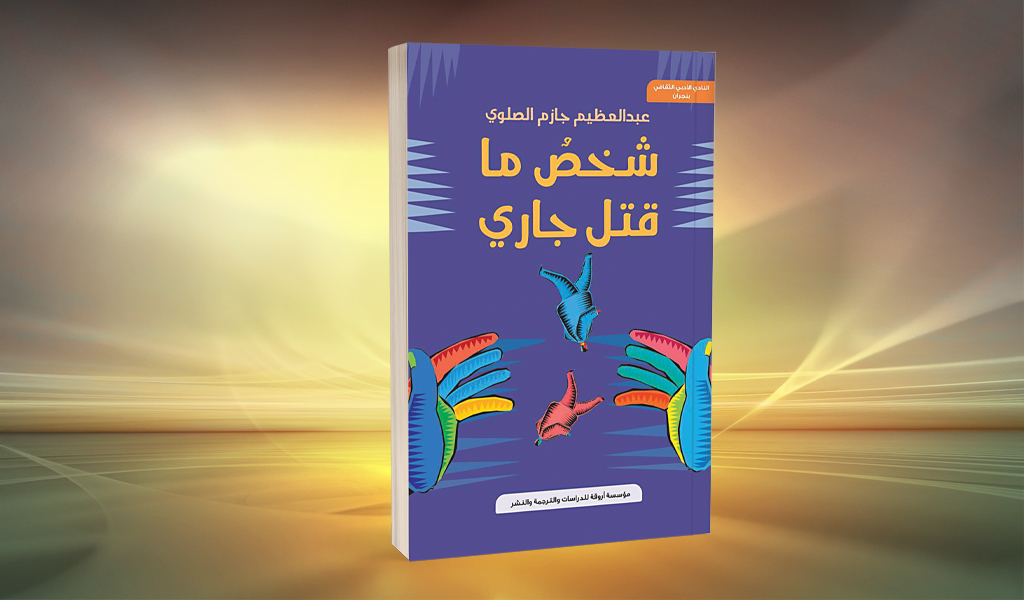
محمد جازم - كاتب يمني | يناير 1, 2021 | كتب
«شخصٌ ما قتل جاري» للقاص عبدالعظيم الصلوي، صدر حديثًا عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر. قبلها بعامين كان عبدالعظيم قد أصدر مجموعة «أفكار معكوسة» التي نالت استحسان الكثيرين. أن يكون الشعر والسرد على تماسّ فهذه لعبة غير مأمونة الجوانب لكنها تنصاع لمن يمتلك موهبة ثاقبة، وهنا في هذه المجموعة يعيش السارد لحظات كشف صوفية، فجميع القصص تتوحد مع نفسها ومع لحظتها المشتعلة في إطلالة وامضة يختطفها الكاتب من ثباته في ملاحقة المطلق والشارد من الثيمات.
قد يتساءل القارئ عن الجار الذي قُتل، ومن قتله؟ ولماذا؟ أسئلة تفتح أفقًا جديدًا سيتلقى السائل عنها إجابة مغمَّسة بالدهشة.. هذا هو الشيء الذي تروم المفارقة أن تحدثه.. إنه الدهشة. قد يصاب القارئ بخيبة أمل حين لا يجد قاتلًا ولا مقتولًا، إنما صياغة تهكمية جاءت في سياق القصة نفسها حاملة معها دلالة الومضة إضافة إلى رمزيتها العفوية. القصة بعنوان «تنهيدة» تقول: «ليس من السهل أن تنتظر شخصًا ما ثم يفاجئك بشلة من تكرههم.. تتنهد قائلًا وليمة وعزاء بشكل موسع يرد أحدهم: ماذا تقصد؟»
– شخصٌ ما قتل جاري! ص57، وهكذا سيكتشف القارئ أن قصة القاتل والجار لم تكن سوى لعبة فنية.. لعبة أدارها الكاتب بمرونة مطلقة؛ بل أراد أن يلعبها مع متلقيه الذين سيشاركونه دهشة الإحالة وكأن بطل القصة أراد أيضًا أن يقول: إن ما قمتم به أيها الأشرار فعلًا يساوي قتلكم لشخص ما هذا الشخص هو جاري. ويهمني القناع الذي لبسه السارد هنا هو قناع التهكم ممن تنتظره على أحر من الجمر فيأتي وهو لا يدري كم تعذبت وتشرنقت في مرحلة الانتظار هناك!
غلاف المجموعة يوحي بأن هناك أيادي عابثة تنطلق من فضاء مجهول، وكأنه عالم فضائي يحدث قرب سماء ثانية. الإهداء ينسجم مع هذا العلو الذي تعكسه اللغة المواربة حيث يهدي الكاتب المجموعة إلى والده وإلى أمه المتوفاة وهو ما ينسجم مع فضاء الزرقة في الغلاف. إيحائية العنوان تعني صفاء النفس وسخرية مبطنة من فعل القتل.. الانفتاح في اختيار مفاتيح للدخول إلى المجموعة تترك إحالات عميقة متواشجة مع النص، يقول في المفتتح الذي كتبه كاتب هذه الأسطر: «في الأفق دائمًا هنالك طيف.. دائمًا هناك شفق.. دائمًا هناك أمل» ص7، المفتتح الآخر اختيار للمنفلوطي: «الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس» ص9، قدم المجموعة الشاعر الأديب علوان الجيلاني بلغة أنيقة تفوح من حروفها قوة الدفع بالجيل الجديد من الكتاب يقول: «بعيدًا عن الادعاءات والحذلقة اللفظية يكتب عبدالعظيم الصلوي نفسه ويفجر هواجسه ومكنوناته التي تشكِّل انعكاس العالم فيه، العالم بوصفه واقعًا وأحداث حياة» ص11.
لعل أهم ما يلفت القارئ في هذه المجموعة هو سحر اللغة الشعرية وقدرتها على إحداث المفارقة والدهشة.. قبل الدخول إلى القصة الأولى «أرواح على عاتق الموت»، يقول: «من المعتقد أن تستحضر ثلاثية الحرب العقيدة الحياة كل غباء العالم ليكون نموذجًا ثم تموت قبل أن تبدأ بأحدهم» ص17، أن تعيش السعادة فهذا أمر تخلقه البيئة التي تعيش فيها، وكذلك إذا كنت حزينًا وشقيًّا فأنت تمضي ضد فطرتك التي جبلت عليها لأن الأفكار السعيدة والكئيبة أنت انتزعتها من التجربة والمعايشة، وعليه تكون تجربتك الاستيهامية.. فالصدق في التجربة يولِّد دهشة عميقة لدى المتلقي الذي يتحرك من حالة سكونية إلى حالة مساءلة وتأمل.
تبحث قصص المجموعة عن أحلام مدفونة في خبايا النفس البشرية وهي زاوية لا يذهب إليها إلا كاتب تتحرك مشاعره تجاه كسر المألوف والبحث عما هو أسمى. تقول القصص: إن الإنسان يبحث دائمًا في الظلام الدامس عن نفسه، هو يبحث عما يشعره بأن هذا العالم موجود، وأن الإنسان العاقل هو الذي يمضي مكشوف الرأس ليبحث عن الحقيقة، وهكذا يمضي القاص بوصفه مخبريًّا للبحث في مختبره عن الكرة الأرضية التي تتحرك داخله: «الأشياء التي نرفض أن نتعلمها بتمهل نتعلمها بأقسى ألم» ص19.
أهم ما قرأته حول القصة الومضة أنها جنس أدبي شائق؛ ولكنه صعب المراس ويصعب تأليفه، على حد تعبير هارفي ستابرو؛ لذا فإن ما يبدو عليه قاصُّنا هو أنه يلاحق الومضات عبر مجهر التأمل والكتابة، كأنه يقضي وقتًا طويلًا في انتظار الومضة، وحين تسفر يقبض عليها، فتتخلق بين جنبات ذهنه المتقدة حاملة مفارقتها الدلالية. مستوى قصص الومضة وهي القصص التي يمكن تحديد حجمها بسطر؛ أو سطرين وعددها ١٩ قصة وامضة. ثمة خاصية واحدة تجمع هذه القصص وهي الإيحاء الوامض.
قد تأتي قصة الومضة على شكل حلم، وهذا حدث في القصة الكابوسية «أرواح على عاتق الموت» البطل يرخي زمامه للنوم، لكن الكابوس يستيقظ، تتخطفه الأرواح الشريرة. في قصة «حضور وغياب» يدخل القاص إلى المختبر الجوّاني للنفس حيث نجد أن القاص يُراوِح في المكان التجريبي نفسه، وكما اعتاد باحث المختبر، فإنه يبدأ في تفكيك شخصية البطل من الداخل وليس رسمها كما درج القصاصون من الخارج. يتوهم البطل محمد أن لديه حبيبة؛ فيترك ضمير المتكلم من أجلها، ولكنه حين يبلغ به الجهد أَوْجَه لا يَجِدها فيعود إلى صاحبه. نجح وميض المعادلة الفنية التي قوامها المفارقة في إرسال حساسيته، ومن ثَمّ التغلب على مثل هذه الشخصيات المتقلبة التي تثرثر؛ فتمدح نفسها وفي الأخير لا تجد سوى الهزيمة، وفي أتم الأحوال الاعتراف بالذنب كنتيجة للمعادلة.
الومضة في القصة القصيرة جدًّا واردة؛ ففي حدود فهمنا لجماليات القصة القصيرة جدًّا أنها تنحو باتجاه المحافظة على التكثيف في اللغة والحدث الشاعري والإبهار والدهشة والحذف والمفارقة وعبر بناء قصة «انتزاع» نجد تلك الشروط جلية حين ارتمى البطل على الأرض أخذت الريح المعطف بعيدًا لكنها أعادته متّسخًا، وهنا تظهر الحبيبة لتقول: «حتى الريح تحاول انتزاعك مني»، المفارقة هنا هي الحامل المثير للدهشة في كل انعطافات العمل النصي هنا. كما أنها بميلها إلى التعبير الومضي الذي يجنح إلى جمل وتراكيب تقوِّض التعابير الانفعالية السائدة. في قصة «لمّ» يلملم البطل أوراقه ويمضي لكنها تتساءل: الأوراق أهم من أن تأخذني؟ تتحقق الفاعلية القصصية هنا باتحاد الأرض مع الشغف في الوجود، فحين خرج السارد ارتسمت هي على أوراق الغبار، يستثمر القاص تفاعلات الحياة ليعلن عن مدى اهتمامه بقضايا التجريب.. قوة التخييل هي أيضًا- سمة بارزة في أعمال عبدالعظيم وهذا نجده في قصة «غفلة» حين نظن أن البحر هادئ وهو في الحقيقة ليس كذلك، هكذا تقول المتصلة بهاتف البطل: اذهب من جوار البحر.
من الملاحظ أن مستويات القص في المجموعة أتاح لها القاص أن تذوب في بعضها لتشكِّل عملًا متجانسًا كائناته الوضوح والمفارقة الوامضة والتضاد العميق. إن قصة الومضة على الرغم من قصرها فنجدها تغطي المكان والزمان والمستقبل عبر إيحاءاتها، كما أنها تكشف عن أسرار تعجز عن الوصول إليها المقاطع الطويلة.
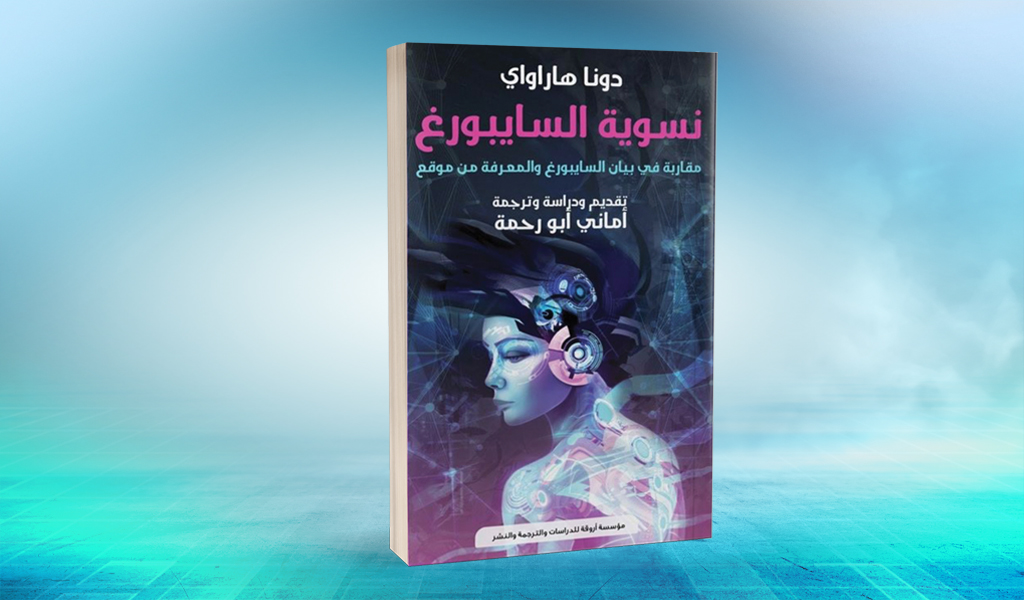
محمد جازم - كاتب يمني | مايو 1, 2020 | كتب
في كتابها «نسوية السايبورغ» الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر 2020م، تستعرض الباحثة والمترجمة أماني أبو رحمة التحدي النسوي حول إزالة الفوارق بين الشروط التي ميزت الذكورة عن الأنوثة وموقع ذلك من الطبيعة، والتكنولوجيا والعقل والعاطفة وفق السايبورغ الذي يعني رفض الحدود الصلبة التي تفصل بين الأجناس البشرية؛ فالسايبووغ كائن سايبرنيتيكي «معرفي» هجين بمعنى أنه يجمع بين الآلة والكائن الحي…
ينقسم الكتاب إلى جزأين؛ الأول عبارة عن مقدمة عميقة تشرح فيها المؤلفة فكرة الكتاب عبر سلسلة من المحطات، والجزء الثاني يترجم كتاب «بيان السايبورغ» لـ«دونا هارواي» وعلاقة ذلك بالعلم والتكنولوجيا والنسوية الاشتراكية في أواخر القرن العشرين، وقد رأت أبو رحمة في مقدمة الكتاب أن الرقمية القائمة على الدماغ بدلًا من العضلات وعلى شكل الشبكات بدلًا من التسلسل الهرمي تبشر بعلاقة جديدة بين النساء والآلات لكنها في كل ذلك تستند إلى ما كتبته هارواي، التي وضعت عام 1985م «بيان السايبورغ»، ثم عادت ونشرته كما أفادت الباحثة مزيدًا ومنقحًا عام 1991م؛ من أجل انتقاد المفاهيم التقليدية النسوية، خصوصًا تركيزها القوي على الهوية، بدلًًا من التقارب.
تعد هارواي صاحبة كتاب «بيان السايبورغ» من «النسويات» الفاعلات، فضلًا عن أنها قد وصفت بالماركسية الجديدة وبما بعد الحداثية. درّست هارواي مادتي «الدراسات النسوية» و«تاريخ العلوم» في جامعة هاواي وجامعة جونز هوبكنز. وفي سبتمبر 2000م؛ مُنِحتْ أعلى تكريم تمنحه جمعية الدراسات الاجتماعية للعلوم: جائزة برنال عن مجمل مساهماتها العلمية وأبحاثها. وتعود مفردة السايبورغ «cyborg» (الكائن الحي السيبراني) في الأصل إلى عام 1960م. وضعها المهندسان: مانفريد كلاينز وناثان كلاين اللذان يعملان لصالح الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) تتعلق رؤية كلاينز وكلاين عن السايبورغ بهجين من الآلة والبشر يقوم بتعديل البشر من أجل الفضاء، بدلًا من إنشاء بيئات صديقة للإنسان خارج كوكب الأرض. لذلك، يعد السايبورغ آلية تحررية من البيئات البشرية من خلال «نظام الإنسان/ الآلة ذاتي التنظيم». نظرًا لكونه أكثر مرونة من الكائنات البشرية.
السايبورغ بالنسبة لهارواي ليس مجرد مجاز يتحدث عن البيولوجيا والتكنولوجيا، ولكنه يجمع بين الهويات المتكسرة والمناطق الحدودية لأنواع كثيرة مادية وخيالية؛ لأن السايبورغ يعمل على تفتيت الحدود القائمة بين جسم الإنسان والكائنات الحية الأخرى في أبهى تصوره.
تقول أبو رحمة: إن هارواي لا تنكر الجسد كخريطة «للسلطة والهوية»، إلا أنها ترى في السايبورغ فرصة لتجاوز حدود الصورة النمطية؛ حتى داخل الدراسات النسوية للجسد الأنثوي: جسد السايبورغ ليس بريئًا؛ لم يولد في جنة، لا يسعى إلى الهوية الوحدوية، ويولِّد ازدواجيات متضادة إلى ما لا نهاية، أو حتى ينتهي العالم، ومن ثَمَّ يأخذ السايبورغ المفارقة. لكن السؤال الذي سيظل يرافقنا كيف نشأت مفردة السايبورغ؟ وما جذورها في الواقع؟
ومن منظور إصلاح الجندر وضعت النساء أفكارًا جديدة عن المساواة بين الرجل والمرأة، جاءت هذه الأفكار وفق تطور استعرضت فيه الباحثة محاور عدة ومن ذلك النسوية والماركسية والاشتراكية؛ فالنسويات الماركسيات اللواتي ينتقدن العائلة لأنها تضطهد المرأة، هن من قمن بوضع ربات البيوت في بنية الرأسمالية؛ أي العمل الاقتصادي الصناعي. وفي معرض التحليل احتوى الكتاب على تعريف النسوية التي عرفناها بأنها توجه نظري يتضمن مجموعة واسعة من المواقف ووجهات النظر.
في الجزء الخاص بالنسوية الراديكالية ترى مجموعة من النسوة الباحثات أن البطريركية هي الكلمة المفتاحية للراديكالية النسوية، أو القمع الكاسح للنساء من الرجال واستغلالهن؛ وتؤمن النسوية الراديكالية بأن النظام البطريركي غير مقدور عليه لأن جذوره الاعتقاد بأن النساء مختلفات وأدنى درجة، وهو ما يعني أن ذلك جزء لا يتجزأ من وعي معظم الرجال. وهناك -أيضًا- النسوية الإيكولوجية أو الفكر الإيكولوجي الذي ظهر في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالبيئة والتنمية عام 1992م، الذي ضغطت فيه المنظمات البيئية النسوية من أجل مراعاة حقوق المرأة والبيئة بالترادف. اتفق هذا المؤتمر، ومؤتمر المرأة الرابع في عام 1995م في بكين، لأول مرة على أنه لا يمكن الفصل بين حقوق المرأة وحقوق البيئة.
وفيما يخص نسوية ما بعد الحداثة فإنها تنتقد النسويات السياسيات القائمة على أساس فئة عالمية، المرأة، ويقدمن بدلًا من ذلك رؤية أكثر تخريبية تقوض صلابة النظام الاجتماعي المبني على مفاهيم: جنسيْنِ، وجنسانيتيْنِ، وجندريْنِ. ويقلن: إن المساواة ستأتي عندما نعترف بأجناس وجنسانيات وجندرات متعددة بحيث لا تقف في الساحة فئتان فقط تتواجهان إلى الأبد.
ترى هارواي في البيان أن السايبورغ يمكن أن يفكك الجوهرية الجندرية، وأن يسهم في الأجندة النسوية اليوتوبية التي تتخيل العالم بلا جندر، أو عالم ما بعد الجندر، وتزعم أن كل السايبورغات هن «نساء ملونات». وفي جانب آخر تتحدث عن النسويات الملونات (التشيكانا: السكان الأصليون) في الولايات المتحدة: إنهن لم يكن -ولا السوداوات بطبيعة الحال- يتماهين مع النسويات البيض في الولايات المتحدة في كثير من الأحيان؛ لم يكن قادرات على قبول أيديولوجية نسوية مهيمنة واحدة تستند إلى تجارب النساء البيض كحلٍّ لقهرهن.
موضوعات الكتاب المترجم «بيان السايبورغ» الذي حللته وشرحته أبو رحمة، تتضمن: التكنولوجيا والنسوية الاشتراكية في أواخر القرن العشرين، والحلم الساخر بلغة مشتركة للنساء في الدائرة المتكاملة، وهويات العلم ممزقة، والمعلوماتية للهيمنة، واقتصاد العمل المنزلي خارج المنزل، وسايبوغارت: خرافة الهوية السياسية.
يورد الكتاب مصطلحًا مهمًّا برز في السنوات الأخيرة وهو مصطلح الهويات المتقاطعة، وهو عن: كيف تتفاعل أنواع مختلفة من الاضطهاد وتؤثر في حياة الناس. تستنتج هارواي أن المصطلح «يشير إلى تكامل المصنع والمنزل والسوق بطرق جديدة وحاسمة؛ لأن التغيرات الاقتصادية تترك أثرًا في بناء الأسرة، وهو الأمر الذي تنشده هارواي وتستطيع تصوره: أسرة ما بعد الحداثة..أسرة تديرها وترأسها أمرأة».
تنتقد النسويات ما بعد الحداثيات السياسات القائمة على أساس فئة عالمية، المرأة، ويقدمن بدلًا من ذلك رؤية أكثر تخريبية تقوض صلابة النظام الاجتماعي المبني على مفاهيم: جنسيْنِ، وجنسانيتيْنِ، وجندريْنِ. ويقلن: إن المساواة ستأتي عندما نعترف بأجناس وجنسانيات وجندرات متعددة بحيث لا تقف في الساحة فئتان فقط تتواجهان إلى الأبد. تدرس النظرية النسوية ما بعد الحداثية الطرائق التي تبرر بها المجتمعات المعتقدات حول الجندر في أي وقت (الآن وفي الماضي) مع «الخطابات» الأيديولوجية المتضمنة في التمثيلات الثقافية أو «النصوص». ليس فقط الفن والأدب ووسائل الإعلام، ولكن أي شيء أنتجته مجموعة اجتماعية، بما في ذلك الصحف، والإعلانات السياسية، والطقوس الدينية، هو «نص». إن «خطاب» النص هو ما يقوله، وما لا يقوله، وما يلمح إليه (يسمى أحيانًا «نصًّا فرعيًّا»). يصبح السياق التاريخي والاجتماعي والظروف المادية التي يصدر فيها النص جزءًا من خطاب النص..