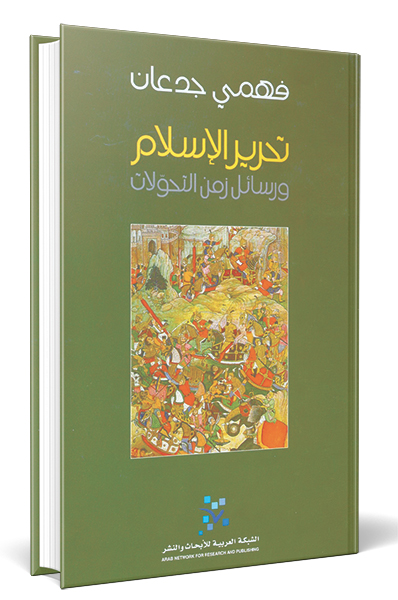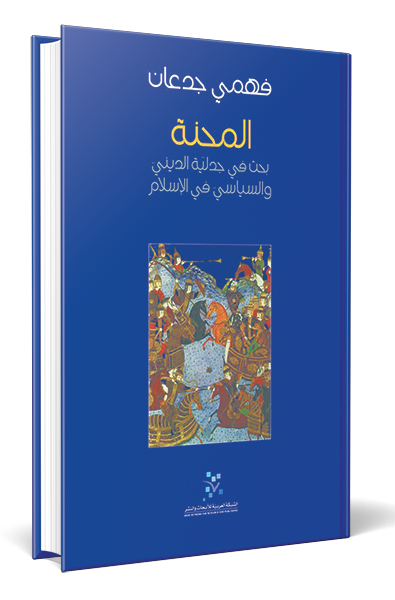موسي برهومة - كاتب و أكاديمي أردني - الجامعة الأمريكية في دبي | مارس 3, 2019 | حوار
يوازي المفكر العراقي الدكتور عبدالجبّار الرفاعي بين البروتستانتية المسيحية وما يطلق عليه «البروتستانتية الإسلامية» ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين، وهو تعبير يستعيره من المفكر الإيراني علي شريعتي. وما يجمع بين البروتستانتيتيْنِ هو التشديدُ على الدنيا، وهو ما تنشده جماعاتُ الإسلام السياسي التي تفتقر، كما قال، في حواره مع «الفيصل»، للتربية الروحية والأخلاقية والجمالية؛ لأنها تنشغل بالتفكير والعمل للاستيلاء على السلطة السياسية. ويميّز المفكر العراقي بين المفهومين، من حيث إنّ البروتستانتية في المسيحية أنجزت تحريرَ الدنيا والمعارف والعلوم من سطوة الكنيسة، وأطاحت بالبابوية والكهنوت بوصفهما المؤسسةَ المسؤولة عن التفسير الرسمي للدين. إلّا أنّ ما أفضت إليه الجماعاتُ الإسلامية هو توسيعُ حدود الدين، وتمديدُها لتستوعب الدنيا بتمامها، فقد أزاحت هذه البروتستانتيةُ الدينَ خارج مجاله، واغتصبت به كلَّ ما هو دنيوي، كما عملت على ترحيل الدين من حقله الطبيعي ووظيفته الأنطولوجية العميقة في إشباعِ الحاجة للمقدّس، وتحويلِه إلى أيديولوجيا.
ويرى الرفاعي أنّ أيديولوجيا جماعات الإسلام السياسي أقحمت الدين في مواجهة شاملة مع الدولة، والمجتمع، والعلوم والمعارف، والفنون والآداب. وهو ما تمثّله المساعي الحثيثةُ المتواصلة للجماعات الإسلامية، وجهودُها المضنية في محاولاتِ بناءِ دولة دينية، وتأسيسِ علوم ومعارف وفنون وآداب دينية، وهو ما تبلور في لافتات: البنوك الإسلامية، وأسلمة المعرفة، وأسلمة الفن، وأسلمة الأدب.
تطرق الحوار مع الرفاعي إلى رؤيته كيفية تحديث الفكر الديني وتجذير مسيرة التنمية والبناء، حيث لا يتم ذلك إلا بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين، يبعث الأبعاد التنزيهية العميقة في جوهره، ويعمّم صورته الإنسانية، تلك الصورة المغايرة لما تريده الجماعات التي تعمل على تقديم صورة متوحشة زائفة للدين.
يذكر أنّ الدكتور عبدالجبّار الرفاعي من مواليد ذي قار بالعراق، سنة 1954م، وهو حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وأصدر مجلة «قضايا إسلامية معاصرة» سنة 1997م، ويرأس تحريرها منذ ذلك الحين، كما أنه يدير مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد. من مؤلفات الرفاعي:
محاضرات في أصول الفقه (مجلدان)، 2000م. مبادئ الفلسفة الإسلامية (مجلدان)، 2001م. جدل التراث والعصر، 2001م. نحن والغرب: جدل الصراع والتعايش، 2002م. مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، 2005م. تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية، 2010م. إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين، 2012م. الدين والظمأ الأنطولوجي، 2015م. الدين والاغتراب الميتافيزيقي، 2018م. هنا نص الحوار:
● تَستخدمُ مصطلحَ «البروتستانتية الإسلامية» وتَرى أنّ نشأته ترافقت مع انبثاق حركة الإخوان المسلمين. الأولى في المسيحية كانت بمثابة حركة إصلاح ديني في الكاثوليكية من خلال مارتن لوثر، فهل جرى الأمر نفسه مع حركة الإخوان، في اعتقادك؟
■ أظن أنّ أولَ من تداول مصطلح «البروتستانتية الإسلامية» في أدبيات الإسلام الحديث هو علي شريعتي، الذي كان يسعى لبناء رؤية دنيوية للدين، اصطلح عليها (البروتستانتية الإسلامية)، محاكيًا البروتستانتية المسيحية، من خلال تحويل كلّ ما هو دنيوي إلى ديني، وكلّ ما هو ديني إلى دنيوي. يقول شريعتي: «منطلق مهمّة المستنير ومسؤوليته في إحياء وخلاص مجتمعه تتمثّل في تأسيس بروتستانتية إسلامية». البروتستانتية هي (حركة الإصلاح الديني في الكاثوليكية)، التي قادها مارتن لوثر (1483 – 1546م). (البروتستانتية الإسلامية) هي (حركة أدلجة الدين والتراث في الإسلام الحديث والمعاصر)، التي يمكن أن نؤرّخ لها بولادة الإخوان المسلمين. البروتستانتية المسيحية والإسلامية كلتاهما تشتركان في إنهاكِ الدين، وإفقارِه ميتافيزيقيًّا، وخفضِ طاقته الروحية، وإهمالِ قيمه المعنوية والأخلاقية، والتشديدِ على مضمونه الدنيوي الأرضي، لكن البروتستانتية الإسلامية مختلفةٌ عن المسيحية، فالبروتستانتية المسيحية حرّرت الدولةَ من الدين، والبروتستانتية الإسلامية أفشلت الدولةَ بالدين، وأفشلت الدينَ بالدولة.
ما تنشده البروتستانتيةُ في المسيحية هو التشديدُ على الدنيا، كذلك تنشد جماعاتُ الإسلام السياسي في بروتستانتيتها الدنيا أيضًا، لكن في المسيحية أنجزت البروتستانتيةُ تحريرَ الدنيا والمعارف والعلوم من سطوة الكنيسة، وأطاحتْ بالبابوية والكهنوت بوصفهما المؤسسةَ المسؤولة عن التفسير الرسمي للدين. إلّا أنّ ما أفضت إليه الجماعاتُ الإسلامية التي تمثّل أدبياتُها البروتستانتيةَ الإسلامية هو توسيعُ حدود الدين، وتمديدُها لتستوعب الدنيا بتمامها، فقد أزاحت هذه البروتستانتيةُ الدينَ خارج مجاله، واغتصبت به كلَّ ما هو دنيوي، كما عملت على ترحيل الدين من حقله الطبيعي ووظيفته الأنطولوجية العميقة في إشباعِ الحاجة للمقدّس، وتحويلِه إلى أيديولوجيا، تغدو هذه الأيديولوجيا وقودًا لعجلة السلطة، وإقحامه في مواجهة شاملة مع: الدولة، والمجتمع، والعلوم والمعارف، والفنون والآداب. وهو ما تمثّله المساعي الحثيثةُ المتواصلة للجماعات الإسلامية، وجهودها المضنية في محاولاتِ بناءِ دولة دينية، وتأسيسِ علوم ومعارف وفنون وآداب دينية. وهو ما تبلور في لافتات: البنوك الإسلامية، وأسلمة المعرفة، وأسلمة الفن، وأسلمة الأدب. وكأن أسلمةَ المعرفة وغيرها تمثِّل عمليةَ تعويضٍ نفسي للمسلِم في العالم المعاصر، الذي لم يسهم في مكتشفاته واختراعاته ومكاسبه العلمية والمعرفية، فيتوهّم بذلك أنّه ممن أنجزوا العلمَ الحديث، وأسهموا في إنتاج المعارف والتكنولوجيا اليوم.

● في ضوء هذا الإفقار المتواصل للدين من ينابيعه الروحية، توسيع حدوده، وتمديدها لتستوعب الدنيا بتمامها؛ هل جنت جماعات الإسلام السياسي على الدين والدنيا في آنٍ واحد؟
■ الدينُ بمعناه الروحي والأخلاقي والجمالي مشروعٌ ينشد تكريسَ إنسانية الإنسان، ولا يمكن له تحقيقُ ذلك من دون الإعلاء من الكرامة البشرية وحمايتها. الدين يرى الكرامةَ بوصفها أحدَ مكونات الهوية الوجودية للكائن البشري، أي أنّ الكرامةَ قيمةٌ أنطولوجية أصيلة، لا إنسانيةَ للإنسان من دونها. تفتقر الأدبياتُ التي يتربى عليها شبابُ جماعات الإسلام السياسي للتربية الروحية والأخلاقية والجمالية؛ لأنها تنشغل بالتفكير والعمل للاستيلاء على السلطة السياسية. لذلك نجد معظمَ الشباب المنخرطين في جماعات الإسلام السياسي، أرواحَهم منطفئة، لم يُضِئْها الإيمان، وأفئدتَهم جائعة لم تُشبع بالمعنى، وقلوبَهم ظامئة لم ترتوِ بحب الله والإنسان والعالم، وسلوكَهم لا يخلو من مفارقات وازدواجية، تنتهك الأخلاقَ في السر، وإن كانت تتظاهر بها في العلن، ذلك أنهم يفتقرون لمثال بشري روحي أخلاقي مجسّد في محيطهم، سلوكُه مرآة للخُلق النبيل، وروحُه تفيض بالإيمان، وتضيء قلبَه سُبلُ الأسفار إلى الحق. لا نعثر في هذه الجماعات على نموذج حياتُه مشبعةٌ بالمعنى، يمتلك كيمياءَ روحية، تمنح هؤلاء الشباب القدرةَ على استعادة هويتهم الشخصية المفتقدة، وتشبع حاجتَهم للاختلاف والتميز، وتسهم في تعزيز قدرتهم على إثراء حياتهم أنطولوجيًّا، وتساعدهم على أن تكون حياتُهم أجمل، في عالم يتشيّأ فيه كلُّ شيء، ويتنمّط فيه كلُّ شيء، ويكاد يتشابه فيه كلُّ شيء، ويتكرّر فيه كلُّ شيء مكانيًّا وزمانيًّا.
● ولكنّ أدبياتهم تزعم احتكار اليقين الديني والنطق بلسان السماء!
■ أدبيات جماعات الإسلام السياسي تفتقر إلى ما يقودهم للسماء، ولا تكفّ عن وضعهم في مواجهة كلِّ الناس، وزجّهم للخوض في صراعات السلطة والهيمنة والمال في المجتمع. وبدلًا من أن يكون النصُّ الديني في أدبياتهم: منتِجًا للإيمان، ومنبعًا لتكريس الحياة الروحية، ومنهلًا لإثراء الحياة الأخلاقية، يجري توظيفُه كغطاء للهيمنة على السلطة والقوة والمال.
وعادة ما تتلفع هذه الأدبياتُ بغطاء، يُصاغ عبر شعارات استنهاض واستغاثة، تثير المشاعر، وتوقد العواطف، وتحرّض على الانخراط في حروب باسم الله، ومواجهة العالم كلّه، بذريعة الغيرة على الله! من دون أن يعلموا أنّ الشفقةَ على الإنسان، والرحمةَ بخلق الله هي المضمون العميق للغيرة على الله.
التديّنُ المفرغُ من المعنوية أنهك أرواحَنا، واستنزف قلوبَنا. أتمنى أن يتخلّص دعاةُ الأديان والمبشّرون من الولع برسم صورة مفزعة لله؛ كي يحرروا حياتَنا من الغرق في القنوط والقلق والخوف، وكأننا في معركة مزمنة مع الله. وأن ينشغلوا في التبشير بالمهمة العميقة للأديان، التي تتلخص في: خلع معنى على حياتنا، وعلى كلّ ما لا معنى له في عالمنا، وتشييد مرتكزات الأمل، وإيقاظ منابع التفاؤل، ومنح أحلامنا صورها الأجمل، وإذابة المرارات، وإطفاء حرائق الروح، وتسكين مواجع القلب.
وليست المهمةُ الأصيلة للأديان رسمَ صورة مرعبة لرب العالَمِينَ، وتحويلَ صورة العالَمين -الدنيا والآخرة- إلى سجون أبدية، ووضعَ الكائن البشري في قلق متواصل، وزرعَ الخوف في قلب الإنسان، مما سيفضي إليه مصيره، في القبر وعذابه، وجحيم العالم الآخر.
الإنسان الخائف يتمزق، ويصاب بالشلل، ويعجز عن مقاومة أيّة قوة تسعى لاستعباده. ففي كلّ مجتمع خائف ينبت ويتوالد الاستبدادُ على الدوام. الخوفُ منبعُ الاستبداد، هناك علاقةٌ جدلية مزمنة بين الخوف والاستبداد. حيثما يوجد الخوفُ يولد الاستبداد، حيثما يوجد الاستبدادُ يولد الخوف. حين تختنق الحياةُ بالخوف، ينسحق الكائنُ البشري، ويمسي مستعدًّا للرضوخ والانصياع لأيّ شخص يمتلك أداةَ سطوة وعنف.

الشخص الخائف لا يمتلك القدرةَ على إبداء أيّ رأي لا يتطابق مع ما يفرضه خطابُ العنف، بل لا يستطيع الذهنُ الخائف أن يفكر بما هو خارج ما تفرضه أداةُ العنف. المحيط المشبع بمختلف أنماط العنف الجسدي والرمزي ينتج شخصيةً مستلَبة. المجتمع الذي يسكنه الخوفُ يسكنه الاستبداد.
● أمِنْ أجل هذا تدعو إلى تحرير الدين من الأيديولوجيا وإعادته إلى وظيفته الأنطولوجية الأولى؟ ولكن ألم تشتمل النصوص التأسيسية الأولى على أيديولوجيا، لجهة إدارة الاجتماع البشري، وتفصيل الفرائض والعبادات، وتظهير صور الآخرين في مرآة المسلم؟
■ إنّ الدينَ في مفهومي حاجةٌ وجوديةٌ لكينونة الإنسان بوصفه إنسانًا، ولا يصنع الإنسانُ حاجتَه للدين، بل يصنعُ أنماطَ تديُّنهِ وتعبيراتِه وتمثُّلاتِه المتنوعة والمختلفة للدين، على وفق اختلاف أحوال البشر وبيئاتهم وثقافاتهم. ولا تختفي هذه الحاجةُ العميقةُ مع تطور الوعي البشري، وما ينجزه الإنسانُ من مكاسب كبيرة في المعارف والعلوم والتكنولوجيا، حتى لو غاب أكثرُ أشكال تعبيراتها في المجتمعات الحديثة فإنها لا تغيب كلّيًّا، بل تعلن عن حضورها أحيانًا على شكل ظواهر لا عقلانية وممارسات غرائبية تنبعث بصورة لا واعية في معتقدات بعض الناس وسلوكهم، ويمكننا أن نعثر على محاولات تعويضٍ عن الدين بخرافات وشعوذات هذيانية يعتنقها أفرادٌ في مجتمع متحضر.
حاجتُه للدين يفرضها وجودُه من حيث هو كائنٌ بشري ينماز عن غيره من الكائنات في الأرض بهذه الحاجة؛ لأنّ الحيوانات مثلًا تشترك مع الإنسان في عدد من حاجاته المادية وغير المادية، لكن الهويةَ الوجوديةَ للإنسان هي التي تنفرد بالحاجة الأنطولوجية الملازمة لكينونتها، وهي الحاجة إلى الدين.
هذا هو منشأ الحاجة إلى الدين، أما المناشئ الأخرى، التي تحدّث عنها علماءُ ومفكرون كبار، كالخوف والجهل والفقر… وغيرها، فهي لا توجِد أصلَ الحاجة للدين، بل يظهر أثرُها بوضوح في بناء المعرفة الدينية، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا في تشكيل أنماط التدين.
وتظل الفلسفةُ تتفاعل مع الدين وتتغذّى من مائدته في كل العصور؛ لأن الأسئلةَ الميتافيزيقية الكبرى في الفلسفة هي أسئلة تتوالد من رحمِ الدين، والبحثِ عن عالمٍ وراء هذا العالم، وحياةٍ وراء هذه الحياة، وروحٍ كلية تتفوق على كلّ الأرواح، وحقيقةٍ أزلية، تظل كلُّ حقيقة نسبيةً بالقياس إليها.
الظمأ الأنطولوجي للمقدّس
● لكنك ترى أنّ الدين هو المنهل لإرواء الظمأ الأنطولوجي، وأنه حين يرتوي الشخص البشري، تخمد نزعة الشر المتأصلة في ذاته، ويكفّ عن العدوان وكراهية الآخر. لكنّ الدين الذي بحثت في تجلياته صار مرتهنًا للأيديولوجيا ومسجونًا بين قضبانها. ألا يعني ذلك استمرار الظمأ، وتفشي الروح التدميرية العدمية لدى الكائن؟
■ أعني بالظمأ الأنطولوجي الظمأَ للمقدّس، أو الحنينَ للوجود الحق، إنه ظمأ الكينونة البشرية، بوصف وجود الإنسان وجودًا محتاجًا إلى ما يثريه، وهو كائنٌ متعطشٌ على الدوام إلى ما يرتوي به. حيثما كان في الأرض بشرٌ لم يفارقه ذلك الظمأ، وحيثما كان الظمأ للمقدّس لا بد أن يحضر الدين.
ولو استعرنا لغةَ الحكماء والمتصوفة والعرفاء، فإنّ الإنسانَ لا ينفكّ عن نقص في كينونته، وهو في توقٍ وشغفٍ أبدي يطلب كَمَالَه الوجوديّ. وليس الإنسانُ فقط هو ما يعتريه النقصُ في عالم الإمكان، بل النقصُ حقيقةُ هذا العالم الوجودية؛ إذ لا كامِلَ إلا الواجب.
الشرُّ ليس طارئًا في هذا العالم، الشرُّ في معناه الوجودي هو النقصُ في عالم الإمكان، أما الشرُّ في معناه المجتمعي فيتمثّل في كلّ شكلٍ لإهدار كرامة الإنسان من حيث هو إنسان، وهو ما يحدثه التضادُّ في إدارة شبكات المصالح، والصراع على وسائل إشباع الحاجات واحتكارها، والسعي للاستحواذ على مختلف أنواع السلطة والثروة. الشرُّ واقعٌ يفرضه الصراعُ بين الأفراد والطبقات الذي تنتجه صيرورةُ المجتمع وتحولاتُه التاريخية.

ما دامت هناك نزاعاتٌ عنيفة لا يمكن أن يختفي الشرُّ في العالم. ولا يمكن الخلاصُ من العنف إلا بإدارة النزاعات سلميًّا، وتُشكِّلُ الحياةُ الروحية ومنظومةُ القيم الأخلاقية والجمالية عناصرَ أساسية في بناء عالم ينخفض فيه حضورُ مختلف أشكال العنف المادي والرمزي.
● تستدعي كثيرًا الصوفيةَ وابنَ عربي وجلال الدين الرومي؛ أليست الصوفية أقرب إلى الآداب والشطحات الفلسفية، والهروب من المواجهة المباشرة مع الواقع. بمعنى أنها لا تصلح لإدارة العيش المشترك والاجتماع البشري، فكيف لها أن تروي قلب المؤمن بالعقيدة والمحبة؟
■ أنا ناقدٌ لتراث المتصوّفة كما أنقد غيرَه من حقول التراث، وقد أعلنتُ موقفي بصراحة أكثر من مرة في سلوك المتصوّفة، وشرحتُ رأيي في قيمةِ آثارِهم، وشدّدتُ على أنها تعبّرُ عن اجتهادات بشرية وليست نصوصًا مقدّسة، لكن يمكننا الإفادةُ مما هو حيّ ويتطلبه زمانُنا منها.
وأشير هنا بإيجاز إلى أنني ضدّ كلّ أشكال توثين المعتقدات، والأفكار، والأشخاص مهما كانوا، سواء فعلَ ذلك التوثينَ المتصوّفةُ أو غيرُهم، فأيةُ فكرة تستمدُّ قيمتَها من تعبيرها عن الحقيقة، وأيةُ شخصية تستمدُّ مكانتَها من تمسّكِها بالحق وانحيازِها للإنسان ودفاعِها عن كرامته وحقوقه وحرياته. إن المتصوّفةَ بشرٌ تورّطَ أكثرُهم في توثين شيوخهم وأقطابهم، وتمادى «المريدُ» منهم في سجن نفسه بعبوديةٍ طوعيةٍ لشيخه، وتعالت تعاليمُ الشيخ في وجدانهم فصارت مقدَّسةً يرضخُ لها الأتباعُ حدّ الاستعباد، بنحو تكبّلهم وتشلّ حركتَهم.
كما أنّ تراثَ المتصوّفة لا يمكن استئنافُه كما هو في عالمنا اليوم؛ لأنه كأيّ تراث آخر ينتمي للأفق التاريخي الذي وُلد فيه، وهو مرآةٌ للعصر الذي تكوّن فيه، إذ ترتسمُ في هذا التراث ملامحُ ذلك العصر ومختلفُ ملابساته. وهو تراثٌ يتضمن كثيرًا من المقولات المناهضة للعقل، والمفاهيم التي تعطّلُ إرادةَ الإنسان وتشلّ فاعليتَه، وتسلبه الحريةَ في العودة إلى عقله واستعمال تفكيره النقدي. وإنّ بعضَ أنماط التربية الروحية التي يعتمدها التصوّفُ العملي تُسرِفُ في ترويضِ الجسد وتتنكرُ للطبيعة البشرية، باعتمادِ أشكالٍ من الارتياض يكون الجسدُ فيها ضحيةَ الجوعِ والسهرِ والبكاءِ والعزلةِ والصمتِ؛ لأنّ هذه الأساليب من أهمّ أركان تربية السالك لديهم. ومثلُ هذا الارتياض العنيف غالبًا ما يفرضُ على المتصوّف الانسحابَ من المجتمع والانطواءَ على الذات، وقد يفضي أيضًا إلى أمراض نفسية وأخلاقية.
● ما دام الأمر على هذا النحو، فبِمَ تنفردُ كتابات المتصوّفة؟
■ تنفرد كتابات المتصوفة بأنها فتحت آفاقًا للتأويل تتخطى الفهمَ الحرفي المغلق للنصوص الدينية. بعد أن تغلّبت على القوالب الصارمة للمنطق الأرسطي، فكانت تفكر بحرية لا تسمح بها قواعدُ هذا المنطق ومقولاتُه ومحاججاتُه وأدواتُه؛ لذلك نجد نظريةَ المعرفة في التصوُّف الفلسفي تبتني على القول بنسبية المعرفة، وتقدّم فهمًا مختلفًا للتنوع والتعددية في الأديان، بوصفها تجلياتٍ مختلفةً للحقيقة الدينية وصورًا متنوعةً لوجوهها، وأساليبَ مختلفة للتعبير عنها. وعلى أساس مفهوم المعرفة الدينية هذا، خلص المتصوفةُ للقول بتنوع طرق الوصول إلى الله، وهذا هو معنى الاعتراف بحق الاختلاف والتعددية الدينية. لذلك لم يحتكروا النجاةَ ولم يختصّ الخلاصُ في رأيهم بديانة أو فرقة أو مذهب أو طائفة أو جماعة، وهذا ما نراه في آثارهم؛ إذ لا نقرأ في مدونةِ التصوّف الفلسفي مواقف وكلمات تنصّ على تكفير المختلف في العقيدة أو فتاوى تسوّغ قتله.

عبدالجبار الرفاعي
وتؤشر نظريةُ المعرفة في التصوف الفلسفي بما يؤكد أنّ للدين حقيقتَه الخاصة، ويقترب ذلك مما ذهبتْ إليه الهِرْمِنيوطيقا الفلسفية، فلم تعد «الحقيقة» فيها مختزَلةً في الحقيقة العلمية فقط، كما يشرح ذلك غادامير، بل إنها ترى للدين حقيقتَه الخاصّة به، أو هو تجربةٌ للحقيقة، وهكذا للفن حقيقتُه الخاصّة به، أو هو تجربةٌ للحقيقة، وللعلم حقيقتُه الخاصّة به. في ضوء ذلك تعود للحقيقة الدينية راهنيتُها، بعد أن أصبحت الهِرْمِنيوطيقا أفقًا جديدًا لتفسير الدين، بوصف الحقيقة تتجلى في كلٍّ من العلم والفن والدين، في كلّ واحد منها، على شاكلته. لذلك لم يعُدْ حضورُ الدين طارئًا في الحياة، أو يمثّل مرحلةً يعبرها الإنسانُ لحظة ينتقل إلى عصر العلم، بل يظلّ الدينُ تجربةً للحقيقة ما دام هناك إنسانٌ في هذا العالم.
أمَّا علم الكلام، فلمَّا كان منطقُ التفكير فيه يبتني على المنطق الأرسطي، لذلك ترفض نظريةُ المعرفة في علم الكلام القولَ بنسبية المعرفة، ولا ترى إلا وجهًا واحدًا للحقيقة الدينية ينحصر الوصولُ إليه بطريق خاص، وهذا الطريق هو ما ترسم إطارَه مقولاتُ المتكلم واجتهاداتُه في بناء هيكل معتقدات فرقته، التي هي فقط «الفرقة الناجية» دون سواها. لذلك أسرفَ متكلِّمو الفِرَقِ في الإسلام بتكفيرِ من لا يعتقدُ معتقدَهم، ولم تتخلصْ أيةُ فرقةٍ من تورُّط بعضِ متكلِّميها في تكفير المختلف، وإن كان ينتمي للفِرْقةِ ذاتها، إن اجتهدَ فتخطى الحدودَ المرسومةَ للاعتقاد، حتى المعتزلة، الذين اشتهروا بأنهم ممثلو العقلانية في الإسلام، تورّطَ بعضُ متكلميهم بالتكفير. يقول أبو حيان التوحيدي في كتابه «البصائر والذخائر»: «إن الجُبائيين المعتزليين، أبا علي (محمد بن عبدالوهاب الجُبائي)، أستاذ الإمام الأشعري، وابنه أبا هاشم، (عبد السلام) لم يكن أحدُهما يتورع عن قذف الآخر بالكفر. كما أنّ أختَ أبي هاشم، لم تكن، هي الأخرى، تتورّعُ عن إلصاق نفس التهمة بأخيها وأبيها معًا».
لغة المحبة والابتهاج بالوصال مع معشوق جميل
● كيف يتجلى أثر المعتزلة في التصوف؛ بمعنى هل للتصوف الفلسفي جذر عقلاني؟
■ لقد وجدتُ بعضَ آثارِ التصوّف الفلسفي تغتني بما هو شحيحٌ في آثار علم الكلام والفقه. فلم أجد الصلةَ بالله في هذه الآثار تبتني على الخوف؛ لأن التصوّفَ الفلسفي أعادَ بناءَ الصلة بالله فجعلها تتكلمُ لغةَ المحبة وتبتهجُ بالوصال مع معشوق جميل. وفاضتْ مدوَّنتُه بمعاني الرحمة والمحبة والشفقة والرفق والرأفة والعطف والتضامن مع البؤساء والمنكوبين، ويُعلي بعضُ المتصوّفةِ من هذه المعاني بالشكل الذي تصبح فيه مقصدًا محوريًّا للدين برأيهم. مضافًا إلى أنّ أعلامًا للتصوّف الفلسفي لا يرفضون العقل، بل يعتمدونه ويتمسّكون ببراهينه في بناءِ نظامهم المعرفي ورسمِ رؤيتهم للعالَم. وهذا ما نجده في أعمال محيي الدين بن عربي، وبعض العرفاء الذين يبتكرون طريقتَهم العقلية في الاستدلالِ على مقولاتهم ونقضِ حجج خصومهم.
كما يسودُ آثار بعضِ أعلامِ التصوّفِ كجلال الدين الرومي تبجيلٌ للعشق الإلهي، ونظرةٌ متفائلةٌ للحياة، واحتفاءٌ بالفن، وكشفٌ عن تجليات جمال الوجود، ودعوةٌ للفرح، وجعلُ المحبة مادةَ الدين، بحيث صار تطهيرُ القلب من الحقد مفتاحًا لطهارة الإنسان، كما ينصّ على ذلك جلالُ الدين الرومي بقوله: «توضَّأْ بالمحبة قبل الماء، فإنّ الصلاةَ بقلب حاقد لا تجوز». وتمكّن بعضُهم من صياغة سلسلة مفاهيم تعمل على تحريرِ الإنسان من اغترابه الوجوديّ، وإرشادِه لتعاليم تحثّه على التصالح مع العالَم الذي يعيش فيه.

ونعثر في آثارهم على فهمٍ للدين وتفسيرٍ لنصوصه يذهب للتعامل مع الآخر المختلف بوصفه إنسانًا بغضّ النظر عن معتقده. لذلك تخلو أكثرُ آثار المتصوّفة من الأحكام السلبية حيال المختلف في الدين التي نجدها في آثارٍ أخرى، ولا نجد لدى أعلامهم مفاهيمَ تغرسُ كراهيةَ الأديان الأخرى، وتحظر التعاملَ مع أتباعها، وترسّخ النفورَ منهم. وبعضُ أعلامهم ينفردون في مقولات تكسر احتكارَ الرحمة الإلهية وتوسّع دائرةَ الخلاص، وتصوغ فهمًا للنجاة في الآخرة لا يجعلها حقًّا حصريًّا لمن يعتنق معتقدًا خاصًّا.
● في كتاباتك الفكرية يمتزج الديني بالفلسفي بالروحاني الرومانسي أو ما تسميه «التدين الروحاني الأخلاقي». هل تعتقد أنّ هذه التركيبة من شأنها توفير الخلاص المنشود للكائن البشري، بحيث تكون بمنزلة «سِفر وجودي إلى الحق»؟
■ أنا إنسانٌ، وكلُّ إنسان واحدٌ في حين أنه متعددٌ، ومتعددٌ في حين أنه واحدٌ. الإنسانُ كائنٌ غريب، في كيانه تتوحدُ: متطلباتُ جسد بكل ما يُشبعُ حاجاته المادية، ومتطلباتُ عقل بكل ما ينشده من لذة المعرفة، وشغف باكتشاف ما حوله من ألغاز عالم مجسد لا يكف عن الامتداد والاتساع، وعالمٍ مجرد تظل الأسئلة حيال أسراره مفتوحة على الدوام، ومتطلباتُ نفس بكل ما تبوح به وتضمره من عواطف ومشاعر وأحاسيس وقلق، ومتطلباتُ روح بكل ما تبوح به وتضمره من ظمأ أنطولوجي وأشواق توَّاقة لصلة وجودية بالمطلق؛ لذلك تنوعت العلوم والمعارف والآداب والفنون بجوار الأديان والفلسفات، تبعًا لتنوع تلك المتطلبات. أنا كائن بشري تتفجر في كياني متطلبات متنوعة لا أستطيع كَبْحَها، لكن تظل متطلبات الروح هي الأشد؛ لذلك أكتب كأني كائن ميتافيزيقي عاجز عن إطفاء جذوة الروح المشتعلة في باطني، وهذا ما يجعل كتاباتي تتلون بأشواقها. يجد القُرَّاء الخبراء أنّ منابع الروح الخفية تلهمني فيما أكتب، وتثري كتاباتي تأملاتي في كتاب الله التكويني ومطالعتي لكتابه التدويني. لا أكتبُ للأكاديميين، أكتبُ أشواقَ روحي، وسيرةَ قلبي، وأسئلةَ عقلي. أنشد إحياءَ إيمان المحبة والرحمة والجمال والخير والإرادة والثقة والحرية والعدل والسلام. تتلخصُ مهمتي في بناء الحب إيمانًا والإيمان حبًّا، واكتشاف صورة الله الرحمن الرحيم، وتطهيرها مما تراكم عليها من ظلام وتوحش، فرحمةُ الله وطن حيث تُفتقَد الأوطان.
تداخلُ الأجناس في كتاباتي ينشأ من أنها «رسائل في الإيمان»، بمعنى أنها تأملات لإحياء الإيمان، وليست كتابات أكاديمية. الكتبُ من هذا النمط تخاطب الروحَ، والقلبَ، والنفسَ، عبر العقل. الكاتبُ الأصيلُ يكتبُ ذاتَه. أعمقُ تجلّ للكائن البشري العميق أن تكون كتابتُه هو، ويكون هو كتابتُه. الفكرةُ الباردة لا طاقة فيها على تحريك الإنسان. ميزة الكتابة الإيمانية أنها في الوقت الذي تكون قادرة على إيقاظ العقل، تكون أيضًا قادرة على إيقاد المشاعر، وملهمة لسكينة الروح.

موسي برهومة - كاتب و أكاديمي أردني - الجامعة الأمريكية في دبي | أغسطس 31, 2017 | الملف
يستعيد سؤال لماذا نجحت العلمانية في أوربا والعالم المتقدم، وأخفقت عربيًّا، أصداءَ السؤال الذي حاول الإجابة عنه المفكر الإصلاحي العروبي شكيب أرسلان في كتابه: «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟»؛ إذ يطرح أرسلان في كتابه الذي صدر عام 1939م مجموعة أسباب لتأخر المسلمين تتمثل في «الجهل، والعلم الناقص، وفساد الأخلاق، والجُبن، ونسيان ماضيهم المجيد»، وكذلك «اليأس والقنوط من التقدم والنهوض والانتصار».
ويتطرق أرسلان الملقب بـ«أمير البيان» إلى عدم تعارض البوذية مع نهضة اليابان، وعدم تناقض المسيحية مع تطور أوربا، لافتًا إلى أنّ المعضلة ليست في الأديان، إنما في «عقول الناس» مؤكدًا قدرة الإسلام على إنشاء «مدنيّة متطورة». وما بين سؤال أرسلان، الذي سبقه مفكرون كثيرون إلى معاينة أسباب تقهقر المسلمين، وبين اللحظة الراهنة الملتبسة التي اشتجر فيها الدين مع السياسة فتفجّرت التناقضات حتى تحولت إلى حروب مذهبية، ثمة أسئلة لا تزال تنهض ولو من تحت رماد الحرائق: هل هناك أفق لنهضة عربية إسلامية بشروط مدنيّة تحترم العقل، وتنهض على تأسيساته، وتعمل وفقًا لرهاناته؟ ويستتبع ذلك سؤالٌ آخر: هل العقل العربي مهيّأ لاستقبال التفكير العقلاني واحتضانه، أم أنّه، وحسب، عقل «بياني» و«عرفاني» بتعبير محمد عابد الجابري، وبالتالي غير قادر على إنتاج المعرفة العقلانية، كما يفعل العقل «البرهاني»، الذي يعمل في ضوء الديناميات الثقافية والفكرية، ويستمد معرفته من الاستدلال الاستنتاجي، وعالم المعرفة الفلسفية العلمية، حيث التعويل على طرائق التفكير، وليس على التفكير نفسه؟
ويُفضي هذا التشخيص لآليات عمل العقل العربي إلى مجموعة من الاستنتاجات التي قد تبدو، متعسّفة، للوهلة الأولى؛ لأنّ العقل لا يعترف، بالضرورة، بشروط الجغرافيا، ولا يمتثل لإكراهات العوامل الجينية. هذا على المستوى المنطقي يبدو متوافقًا مع شروط التحليل، لكن يتعين عدم إغفال ما يقترحه علم الاجتماع الذي يرى أنّ العملية المعرفية تنشأ بالتعلم لا بالوراثة، إذ إنّ للثقافة جانبين أحدهما مضمر؛ وهو المعتقدات والقيم والعادات التي تشكّل المضمون الجوهري للثقافة، والآخر هو الأشياء والرموز وأشكال التقانة التي تجسّد ذلك المضمون. وبصفتنا أعضاء في مجمع الثقافة العربية الإسلامية، ننهل من معينه، فإنّ ممارسة الاختلاف في التفكير لا تحظى بـ«مباركة» من السلطات السياسية والدينية والاجتماعية، ما أنتج في العموم جملة من اليقينيات التي تواطأ فيها العقل الجمعي مع تلك السلطات من أجل «التوافق» على رواية عامة لمختلف التصوّرات والأسئلة المتصلة بالحكم وإدارة الدولة والاقتصاد وحركية الأفراد، وكذلك ما له صلة بالميتافيزيقا من حيث محاولة الاقتراب من فكرة الإله وديناميات عمله.
كائنات دينية
 العلمانية انبثقت كخلاص في لحظة انسداد الآفاق، وفي غمرة هيمنة التصوّرات الدينية المتطرفة التي لا صلة لها بالإسلام الحقيقي، التي غمرت الأرجاء، وحوّلت الناس إلى «كائنات دينية»، في ظل تواطؤات مع السلطة السياسية التي منحت هيئة الفتوى صفة «المقدّس» فأغلقت باب التفكير النقدي. الانسداد وصل الآن إلى ذروته، وتضاءل الأمل بعد أن غمرت الأفكار السلفية المتطرفة كل شيء، وبعد أن أدركت السلطات السياسية العربية أنّ التصورات الدينية التي اعتمدتها بصفتها ملجأً وملاذًا قد ورّطتها في أزمات لا حصر لها، وأضحت أحد أكبر مصادر التهديد لكياناتها، وصار الانفكاك من تلك الهيمنة المستشرية هو المشتهى، ولكن كيف، وبأية أدوات؟
العلمانية انبثقت كخلاص في لحظة انسداد الآفاق، وفي غمرة هيمنة التصوّرات الدينية المتطرفة التي لا صلة لها بالإسلام الحقيقي، التي غمرت الأرجاء، وحوّلت الناس إلى «كائنات دينية»، في ظل تواطؤات مع السلطة السياسية التي منحت هيئة الفتوى صفة «المقدّس» فأغلقت باب التفكير النقدي. الانسداد وصل الآن إلى ذروته، وتضاءل الأمل بعد أن غمرت الأفكار السلفية المتطرفة كل شيء، وبعد أن أدركت السلطات السياسية العربية أنّ التصورات الدينية التي اعتمدتها بصفتها ملجأً وملاذًا قد ورّطتها في أزمات لا حصر لها، وأضحت أحد أكبر مصادر التهديد لكياناتها، وصار الانفكاك من تلك الهيمنة المستشرية هو المشتهى، ولكن كيف، وبأية أدوات؟
هل نذهب مع المتحمسين، ونقول: إنّ «العلمانية هي الحل» بعد سقوط خطاب الجماعات الدينية التي أفرزت الحلول الجهادية وقدمت المسلمين بوصفهم غزاة جددًا للحضارة والتمدن وللعلم والحداثة؟ وإذا كانت «العلمانية هي الحل» فأية علمانية ستكون، وكيف يمكن «تبْيئة» خطابها في تربة الأرض العربية التي لطالما جاهرت بالعداء لها، وقلبت لها ظهر المجنّ؟ ينبغي الإقرار بأنّ العلمانية لم تختبر عربيًّا في أيّ من الأقطار الممتدة من الماء إلى الصحراء. جرى اختبارها في بلدان إسلامية (تركيا، وإندونيسيا، وماليزيا) وشهدت نجاحات لافتة، وكانت علامة على نهضة سياسية واقتصادية، ولم تُرق أية قطرة دم في النزاع بين الدين والسياسة، وجرت المؤاخاة بينهما، ولم يُفصَل الأول عن فضاء الدولة وروحها، لكن جرى وضع ترسيمات لضمان عدم فيضان أحد الركنين على الآخر. ولعل الدرب إلى توطين العلمانية في بيئة النظام السياسي العربي ليس مهمة مستحيلة، لكنها تحتاج إلى تضحيات كبيرة، وإلى فهم سياسي متقدّم لدى السلطات العربية يقضي بتقديم «تنازلات» لمصلحة سريان أفكار العلمانية وشق الدروب والقنوات لسيلانها من دون أية عوائق، إذا كانت تلك السلطات ترتجي التمدّن الحقيقي والنهضة الحقيقية والاستقرار الحقيقي والاستقلال الحقيقي والمزاحمة الحقيقية في عالم السياسة والاقتصاد والرفاه الاجتماعي والتقدم العلمي.
فك الاشتباك مع المقدس
ولئن كانت التصورات القديمة تعطف العلمانية على الإلحاد والكفر والزندقة، وتراها بمنظار السوء وتهديم المجتمعات وشقائها وانحلالها الأخلاقي، فإنّ ذلك يستدعي كشف هزاله وتهافته، فالعلمانية الأوربية كانت محرك النهضة الأول، وقادح شعلة التمدن وانفجارات العقل في مختلف الميادين. والعلمانية، استطرادًا، ليست كلها «علمانية صلبة» تدعو إلى تحرير الفرد من أغلال الميتافيزيقا، وإلى إقصاء الدين، ومنعه من التدخل في الشؤون المدنية للدولة والأفراد، فثمة «علمانية مرنة» أو «علمانية مؤمنة» ترنو إلى فكّ الاشتباك مع إشكالية المقدّس، وترسم للدين والسياسة مسارات تحول من دون التداخل، وتحفظ لكل حقل ميدانه الحيوي، بما يضمن حياد الدولة إزاء الأديان. العلمانية، حتى تتنفس في مجال حيوي نقي ومريح، وكي تنمو وتزهر، تحتاج إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة وضمان الحريات العامة. وبجوار هذه المقومات يمكن الحديث عن استقلال المؤسسة السياسية عن المؤسسة الدينية، وبالتالي إضعاف (بالمعنى الإيجابي) هيمنة الدين على المجتمع، والإقرار بضرورة الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية، فما كان صالحًا قبل ألف عام لا يصلح الآن، وهذا ما سلّم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».
وثمة من يرى أنّ التشريعات المدنيّة تتعين أن تكون مستقاة من الشريعة، لأنّ هناك افتراضًا بأنّ الشريعة، أية شريعة، تشتمل على الكمالات الأخلاقية المطلقة، في حين يرى إسبينوزا، على سبيل المثال، أنّ قوانين العدل الطبيعية والإخاء والحرية هي وحدها مصدر التشريع. وقد تتوافق قوانين العدل هذه مع قوانين الشريعة، لكن لا يتعين القبول بأن تدار الدولة المدنية بمرجعيات دينية شمولية، بما يحولها إلى دولة «ثيوقراطية» يسيطر عليها الكهنوت. وتحفظ العلمانية حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم من دون تهديد أو فرض وصاية، وهذا القانون مشتمل في النص القرآني: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾؛ لأنّ التدخل في معتقدات الآخرين، وعدم إفساح المجال أمامهم لممارسة الحقوق السياسية والمدنية بعيدًا من تدخل الدولة، يسفر عن استبداد وطغيان وانهدام الحرية. لقد نشأت في أوربا حروب طائفية ومذهبية بين البروتستانت والكاثوليك، تشبه الحروب التي عصفت ولا تزال ببلداننا بين المسلمين والمسيحيين، والآن بين السنة والشيعة، وكل طرف يزعم أنه يملك الحقيقة الدينية المقدسة، ويريد فرضها بالقوة على المجتمع، بوصفه ممثل المطلق. وكما تعافت أوربا من هذا الوباء بعد آلام مبرّحة، فاختارت الحل العلماني ومضت عقودًا وهي تشيّد بنيانه، فإنّ المجال مفتوح أمام العرب والمسلمين كي يسلكوا الدرب ذاته، فيجربوا الوصفة المدنية في الحكم وإدارة الصراع، وجعل الدين هاديًا للروح، ومنقيًا للنفس من الدرن والفساد، وممارسة الشعائر المقدسة في أماكنها التي يحفظها القانون، ويؤمّن لكل المختلفين فضاءً للتعبير من دون إقصاء أو دعوات لاستئصال الآخر بوصفه مخالفًا أو مختلفًا.
لقد كانت الدعوات المستمرة لتمدين الدين، ودفعه نحو معركة بناء النموذج الحضاري للدولة، تلقى صدودًا من قبل أنصار خيار الحكم الحصري بما قالت به الشريعة، فإذا لم يتم التوافق على تمدين الدين، والحيلولة دون طغيان النزعات المحمومة لتديين المدينة، فإن التزمّت سيبقى سائدًا، وسيُحكَم البشر بعقلية القرون الوسطى. لا بد، إذًا، من خلق ثقافة علمانية تبني سفينة النجاة من أمواج الجماعات الإقصائية التي تسعى بحد السيف «المسلول» إلى أن تديّن المدينة، وتحجّبها، وتبرقعها، نزولًا على مقتضيات الأحكام السلطانية!

موسي برهومة - كاتب و أكاديمي أردني - الجامعة الأمريكية في دبي | ديسمبر 27, 2016 | حوار
يربط المفكر العربي الدكتور فهمي جدعان الأفكار والتمثّلات الفلسفيّة في مشاغله كافة بمعين الوجدان، ونهر الحياة، وقوة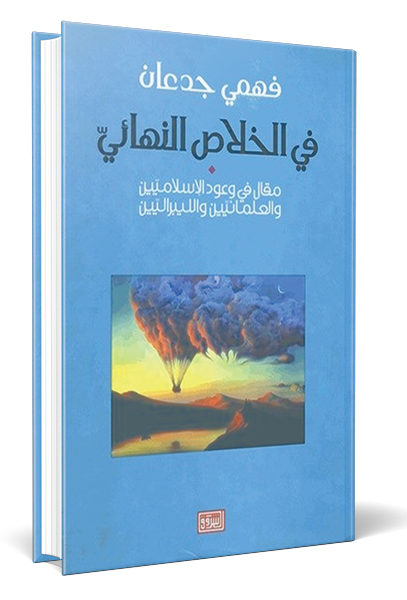 الأمل، فهذه في نظره من المحدّدات التي يعوّل عليها من أجل تعبيد السبيل أمام الأجيال القادمة، والحيلولة دون إنتاج المزيد من الآفاق المسدودة. ويعتقد جدعان أنّ المثقف يحتاج، كي يفهم الواقع ويحلّله ويوجهه، إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة؛ لأنّ التعويل يكون على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف. ويدافع جدعان، المولود في قرية عين غزال بفلسطين المحتلة، عن حتميّة البرمجة الوجدانيّة «الصحيّة»، النبيلة، النّزيهة لأبنائنا، اليوم وغدًا، ففي نظره أنّ غياب هذه القيم والمبادئ، التي ينبغي أن تقترن بها التربية الوجدانيّة المبكّرة، هو الذي يفسّر التدلّي والتخلف والعقم الذي يغلّف ويتلبّس هذه الأجيال المتأخرة من شعوبنا العربيّة.
الأمل، فهذه في نظره من المحدّدات التي يعوّل عليها من أجل تعبيد السبيل أمام الأجيال القادمة، والحيلولة دون إنتاج المزيد من الآفاق المسدودة. ويعتقد جدعان أنّ المثقف يحتاج، كي يفهم الواقع ويحلّله ويوجهه، إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة؛ لأنّ التعويل يكون على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف. ويدافع جدعان، المولود في قرية عين غزال بفلسطين المحتلة، عن حتميّة البرمجة الوجدانيّة «الصحيّة»، النبيلة، النّزيهة لأبنائنا، اليوم وغدًا، ففي نظره أنّ غياب هذه القيم والمبادئ، التي ينبغي أن تقترن بها التربية الوجدانيّة المبكّرة، هو الذي يفسّر التدلّي والتخلف والعقم الذي يغلّف ويتلبّس هذه الأجيال المتأخرة من شعوبنا العربيّة.
ويدعو في مجمل نتاجه الفكري، وبخاصة كتبه الأخيرة، إلى تحرير الإسلام من التصوّرات والتمثّلات والمواقف التي تفسد صورته وتجور عليها، وتيسّر إصابته والإساءة إليه، وربما أيضًا إقصاءه من لوح الوجود الحيّ. كما يحثّ أيضًا على إقرار مبدأ «التأويل» القرآني – بالمعنى العقلاني- بديلًا لمبدأ القراءة الظاهريّة للنصوص، وهو ما يأذن بالتحوّل من سياسة «العنف» إلى سياسة «السِّلم» و«العدل» القرآنية. ويعتقد صاحب «في الخلاص النهائي» أنّ الحركات الدينيّة – السياسيّة الحديثة تريد أن تجعل «زمن الصراع» التاريخيّ زمنًا أبديًّا، وأن تكون العلاقة بين الإسلام وبين المخالفين أو المختلفين علاقة «صراعيّة» دائمة، حتى بعد أن استقرّ دينُ الإسلام في العالم وبين البشر بما هو دين أخلاقيّ إنسانيّ حضاريّ.
وفي ضوء الشقاق والصراع والاختلاف في فهم وتمثّل القيم الدينيّة، يصبح الذهاب إلى نظريّة «إنسانيّة» كونيّة في الأخلاق أمرًا لا مفرّ منه، كما يقول جدعان الذي يشدّد في حواره مع «الفيصل» على أنّ الغائيّة الأساسيّة لدين الإسلام تكمن في مبدأ (العدالة)، وإنه «حيثما ظهرت أمارات العدل فثمّ شرعُ الله».
ودارت مشاغل جدعان، الذي حاز الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس، على تكريس هذه المفاهيم وتجذيرها منذ كتابة «أسس التقدّم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» الذي تبعه مؤلفات عدّة من بينها «نظرية التراث» و«المحنة» و«الطريق إلى المستقبل» و«الماضي في الحاضر» و«رياح العصر» و«في الخلاص النهائي» و«المقدّس والحرية» و«خارج السرب»، إضافة إلى كتابيه الأخيرين «تحرير الإسلام» و«مرافعة للمستقبلات العربية الممكنة» اللذيْن سألناه عن بعض القضايا المستبطنة فيهما.
هنا نصّ الحوار:
● ترى أنّ الحركات الإسلاميّة الثوريّة الراديكاليّة كـ«القاعدة» و«داعش» تنهل من مرجعيّة نصيّة دينيّة. هل يعني ذلك أنّ أفعالها «شرعيّة» أم أنّ في النص الدينيّ التأسيسيّ نزعاتٍ «عنفيّة». وما السبيل إلى الخروج من هذا المأزق؟
– قلت وأقول دومًا، وأكرر أنّ العقدة الأساسيّة؛ العقدة البنيويّة في مشكل الحركات الإسلاميّة السياسيّة، سواءٌ أكانت ثوريّة راديكاليّة، أم غير ذلك، تكمن في المنهج الإبيستيمولوجيّ الذي يحكم علاقة منظّري هذه الحركات بالنصّ الدينيّ، أعني في طريقة فهمهم للمعطيات الدينيّة أو للمعطيات التاريخيّة ذات العلاقة بأصول دينيّة.
يقوم هذا المنهج، عند هذه الحركات، على المسلّمات التالية: هي أولًا ذات نزعة «ذريّة»، بمعنى أنها تجتزئ بالنّصوص المفردة وبالوقائع الجزئية، وتقوم بعملية تجريد وتعميم يخترقان ويتجاوزان المكان والزمان والتاريخ، ولا تلتفت إلى الوجوه العلائقيّة التي تربط بين الجزئي وبين الكلي، أو بين «الذريّ» وبين «الهولستيّ» أو الشموليّ. وهي ثانيًا لا تأبه بتاريخية النّصوص التي تسيء بها على الأقل «أسباب النزول». وهي ثالثًا تتعلق براديكاليّة مسرفة في القراءة «الظاهريّة» للنصوص الدينيّة، ولا تعترف بأنّ في النصوص الدينيّة نصوصًا لا يمكن، ولا يجوز أن تُفهم على ظاهرها، وأنّ فهمها على الظاهر يُلحق إساءات بالغة بالاعتقاد الدينيّ الإسلاميّ، حتى عندما ترفض قراءة آية المحكم والمتشابه والظاهر والمؤوّل قراءة قائمة على مبدأ العطف، لا الاستئناف، أعني القراءة الاعتزاليّة والرشديّة التي تجعل «التأويل» لله وللراسخين في العلم. عطفًا على هذا أقول: إن في النّص الدينيّ التأسيسيّ نصوصًا في القتال والجهاد وفي التقابل «العنيف» الذي يشي كله، في ظاهر النّص وفي الواقع المشخص، بهذا الذي ينسب إلى «نزعات عنفيّة». لكنّ الحقيقة هي أننا لسنا بإزاء «نزعة» بقدر ما نحن بإزاء وقائع تفرض «العنف»، لكنه العنف المتبادل الذي يفرضه «الصراع»؛ لأنّ كلّ النصوص التي تشي بمظاهر العنف مقترنة بحالة «الصراع» التاريخي التي تبلورت غداة انبعاث الرسالة الإسلاميّة، وفي أعطاف «التناقض» الوجوديّ والتاريخيّ الذي نجم بسبب هذا التقابل بين «الأوضاع القائمة» وبين «الأوضاع المستجدة».
تريد الحركات الدينية – السياسية الحديثة أن تجعل «زمن الصراع» التاريخيّ زمنًا أبديًّا، وأن تكون العلاقة بين الإسلام وبين المخالفين أو المختلفين علاقة «صراعيّة» دائمة، حتى بعد أن استقرّ دينُ الإسلام في العالم وبين البشر بما هو دين أخلاقيّ إنسانيّ حضاريّ. هذا خِيار، لكنه خِيار بائس وكارثيّ. لذلك هو يتطلّب حلًّا تجاوزيًّا، وهذا الحل يكمن عندي في ثلاثة أمور:
الأول: الدفاع عن إستراتيجيّات معرفيّة تعزّز مبدأ «تاريخيّة» النصوص الدينيّة «الصراعيّة»، وما يقاربها من نصوص «مربكة» تتطلب الدراساتُ التاريخية والمفهومية المعمّقة توجيهَ فهمهما توجيهًا سديدًا.
الثاني: تعزيز الفهم المنهجيّ المستند إلى ردّ «الجزئيّ» أو «الذّريّ» إلى «الكليّ» أو «العام» أو «الهولستي» أي المقاصديّ.
الثالث: إقرار مبدأ «التأويل» القرآني – بالمعنى العقلاني- بديلًا لمبدأ القراءة الظاهريّة للنصوص. هذه المبادئ تأذن، بصراحة، بالتحوّل من سياسة «العنف» إلى سياسة «السِّلم» و«العدل» القرآنية.
● في ضوء ذلك، هل يحتاج الإنسان المسلم في هذه القنطرة الحضاريّة الملتبسة إلى نظرية أخلاق جديدة تنهل من الإنسانيّ أكثر مما تنهل من الدينيّ؟
– أنتَ تعلم أنني لست «داعية إسلاميًّا»، لذا فإنني لا أوحّد، بالضرورة، بين ما هو إنسانيّ وما هو دينيّ. ولا أعتقد أنّ المرء ينبغي أن يكون، بالضرورة، «متديّنًا» أو «ذا دين» محدّد لكي يكون «أخلاقيًّا». ثمة ثلة من القيم «المطلقة» التي يتبيّنها العقل الإنسانيّ وتطلبها الطبيعة الإنسانية «المكوَّنة» اجتماعيًّا وثقافيًّا. هذه القيم لا مفرّ منها لكلّ البشر: العدل، والحرية، والتواصل، والكرامة، والخير، والسعادة، والفضيلة، والنزاهة، والمحبّة… كلها ابتداءً ذات طبيعة «إنسانيّة» سابقة للدين. ثم يأتي الدين، تاريخيًّا، ليشير إلى سُلّمه الخاص في القيم. لكنّ قراءة الأفكار و«النّصوص» في الديانات المختلفة تتفاوت في شأن هذه القيم. وهي، في جملتها، تُزْهى بالأغلبيّ من هذه القيم، لكنّ بعضها، في قراءات متفاوتة، لا يسلّم بالأفهام نفسها لهذه القيمة أو تلك، فيحدث من ذلك التضاد والتقابل والاختلاف. ويصبح اللجوء إلى سُلّم «إنسانيّ» متوافَق عليه كونيًّا، أمرًا حتميًّا وضروريًّا. خذْ زمننا العربيّ الراهن، وما أحَلْتَ إليه من أمر «هذه القنطرة الحضارية الملتبسة».. هل تعتقد أنّ «الآمر الدينيّ» الذي تتمثّله الحركات الدينيّة – السياسيّة الإسلاميّة اليوم – وهو الآمر المستند إلى مبدأ «الثورة العنيفة» والاقتتال الذاتيّ والتقابل الذي لا يرحم- يصلح لأن يكون مبدأً لأخلاق «إنسانيّة» حقيقيّة سعيدة، فضلًا عن أن يكون مبدأً لأخلاق دينية «رحيمة» و«عادلة»؟!
في ضوء الشقاق والصراع والاختلاف في فهم وتمثّل القيم الدينيّة، يصبح الذهاب إلى نظريّة «إنسانيّة» كونيّة في الأخلاق أمرًا لا مفرّ منه. هذا لا يعني أننا نحن في الإسلام نضادّ، بالضرورة، مثل هذه النظريّة. أنا أعتقد، خلافًا لما تجري عليه التمثّلات المعاصرة المتصلّبة لدين الإسلام، أنّ هذا الدين الرحيم يحمل في «أصوله البذريّة» وفي معطياته المُحكمة، ما يوافق نظرية إنسانيّة كونيّة في الأخلاق. لكنّ هذه النظرية لا تستقيم إلا في حدود منهج تأويليّ للنّصوص الدينيّة «المتشابهة». وأنا أعتقد أنّ القيم الأخلاقيّة العليا التي ينطوي عليها (النّص الدينيّ) تُوافق القيم الإنسانية العليا، ولا تضادّها.
سقوط الأيديولوجيا بدعة
 ● لعل هذا الأمر يُحيلنا إلى النظر في الأيديولوجيا. فهل ما زال للأيديولوجيا مكان في العالم المعاصر. هل تفكّكت المنظومات الأيديولوجيّة، أم أنها أعادت تموضعها، وإنتاج مقولاتها بشكل عنيف. وهل العنف أيديولوجيا، أم هو محض شظايا لتطاير الأفكار على نحو فوضويّ عاصف؟
● لعل هذا الأمر يُحيلنا إلى النظر في الأيديولوجيا. فهل ما زال للأيديولوجيا مكان في العالم المعاصر. هل تفكّكت المنظومات الأيديولوجيّة، أم أنها أعادت تموضعها، وإنتاج مقولاتها بشكل عنيف. وهل العنف أيديولوجيا، أم هو محض شظايا لتطاير الأفكار على نحو فوضويّ عاصف؟
– الدعوى الزاعمة بسقوط الأيديولوجيا «بدعة» اخترعتها الرأسمالية الغربيّة الظافرة غداة انهيار الاتحاد السوفييتيّ وأيديولوجيته الماركسيّة؛ أي غداة انهيار الشيوعيّة. لكن كيف يقال: إن الأيديولوجيا قد انحسرت من العالم المعاصر، ونحن نشهد صعودًا وانتشارًا وتجذّرًا عميقًا لليبراليّة الجديدة (النيو- ليبراليّة)؟ أليست (الليبراليّة الجديدة) – وهي النقيض الجذريّ للشيوعيّة والماركسيّة- أيديولوجيا؟ والعلمانيّة الراديكاليّة أليست أيديولوجيا؟ و«الإسلام السياسيّ» أليس أيديولوجيا؟
الحقيقة أنّ ما تفكّك وتراجع، في حدود، هو ما يسميه فلاسفة (ما بعد الحداثة) «السرديّاتُ الكبرى» كالعقل، والعلم، واليقين. أما الأيديولوجيا، بما هي نظام شموليّ فكريّ- اجتماعيّ- سياسيّ- اقتصاديّ- أخلاقيّ، فإنها ما زالت حية ترتع، وبشدة وعنف لا يقلّان عن شدة الأيديولوجيّات الآفلة وعنفها. هل العنف أيديولوجيا؟ لا، العنف ليس أيديولوجيا؛ لأنه مجرّد «موقف» أو «ارتكاسة» من ارتكاسات الغضب والاحتجاج أو الرفض أو القهر أو الخلل في «البرمجة الوجدانيّة» للعنيف، وهو ليس «منظومة فكريّة» شمولية وجامعة لكل الأنشطة الإنسانية الموجّهة لرؤية شاملة للفرد والمجتمع والدولة.
● تحدثت عن مبدأ «التأويل» القرآني – بالمعنى العقلاني. فهل يحتاج المسلمون الآن إلى «مارتن لوثر» على غرار ما جرى في التجربة الأوربيّة. أم أنّ عوائق كأداء تحول دون ذلك؟
– (مارتن لوثر) و(جان كالفان) أحدثا انشقاقًا في المسيحية، و(حركة الإصلاح) هي عنوان هذا الانشقاق الذي جذّر «الاختلاف» في هذه الديانة. بتعبير آخر «حركة الإصلاح الدينيّ» لم تُصلح المسيحية بقدر ما أحدثت انشقاقًا فيها: بروتستانتيّة من طرف، وكاثوليكيّة من طرف آخر. هذا الانشقاق حاصل عندنا في الإسلام منذ زمن بعيد، وهو ماثل في التقابل السنّيّ – الشيعيّ. وهو تقابل يتعذّر إصلاحه على المدى المنظور، وبخاصة أنه بات يتخذ طابعًا سياسيًّا حادًّا، على الرغم من أنه أصلًا ذو بذور وعوارض سياسيّة. المشكل في الإسلام السنيّ على وجه الخصوص هو أنّ «النواة القاعديّة» العقدية فيه لم تستجب لجهود الإصلاح التي بدأت منذ محمد عبده، وأنّ «الرؤية الاتباعية» صلبة لا تتقبّل «الاجتهادات» الجديدة، ولا تطيق مقاربة «الرؤية الإسلاميّة» التقليدية مقاربة إبداعيّة. العوائق كأداء بكلّ تأكيد، ويجذّر من الصعوبات فيها أنّ الإنكار والرفض أصبحا مقترنيْن بالتكفير والعنف الأقصى. ثم إنني أعتقد أنّ اقتران الحداثة بالحركة الاستعماريّة الغربيّة قد قلّص فرص التأثيرات الإيجابيّة التي يمكن للحداثة أن تجريها في النزعات الاجتهاديّة الإسلاميّة. وهذه نقطة خطيرة لم يتنبّه إليها دارسو هذه النزعات.
● يثار بين الفينة والأخرى حديث عن الدولة المدنيّة. ثمة من يرى أنها لا تتحقق إلا في ظل نظام علمانيّ، وهناك من يذهب إلى أنّ الدين والدولة المدنيّة ليسا متعارضين. مَن مِن الطرفين في ظنك أقرب إلى الصواب ومعقوليّة التطبيق؟
– لا ينبغي أن نخدع أنفسنا. الدولة المدنيّة دولة تحتكم إلى الاجتهادات البشريّة، إلى العقل الإنسانيّ، إلى الخبرة الإنسانيّة، لا إلى «الشرائع الدينيّة» الوَحْيية على النحو الذي يتمثّله القائلون بالدولة الدينيّة، أو الدولة «ذات المرجعيّة الدينيّة» أو الإسلاميّة مثلًا، مثلما يقول الشيخ القرضاوي، دولة مدنيّة بمرجعية إسلامية!
بمعنى آخر، الدولة المدنيّة دولة تقال على الدولة المضادة للدولة الدينيّة، أعني الدولة التي تستقي قوانينها وشرائعها وسياساتها النظريّة والعمليّة من الدين نفسه، بما هو وحي. وبهذا المعنى ينبغي الاعتراف بأنّ «الدولة المدنيّة» الحديثة، أي الدولة الغربيّة، دولة لا تقبل بتطبيق أحكام الشريعة مثلما يريد دعاة مبدأ «الحاكميّة». لك أن تسميها دولة علمانية. هذه التسمية مطابقة تمام المطابقة حين يتعلق الأمر بالعلمانيّة الراديكاليّة، «علمانيّة الفصل» التي تُقصي الدين وأحكامه من المجال السياسيّ والقانونيّ. لكنّ الأمر يختلف بعض الاختلاف حين نتكلّم على «علمانيّة الحياد»، التي لا تضادّ الدين مثلما تفعل العلمانيّة الراديكاليّة، وتترك المجال مفتوحًا للحياة الدينيّة والأنشطة الدينيّة، أي أنها تحافظ أو تحفظ للمؤمنين حقوقهم الدينيّة، بل إنها تقدّم المساعدات الماديّة للمؤسسات الدينيّة، لكنّها تتمسّك بالاعتقاد بأنّ تشريعات الدولة ينبغي أن تكون «إنسانيّة». أيهما أقرب إلى الصواب؟ المسألة مسألة «اختيار» لا مسألة صواب وصدق وحقيقة. أعتقد أنّ الظروف التاريخية تتدخّل وتفرض صيغًا متفاوتة في قبالة هذا المشكل. وفيما يتعلق بنا نحن، وبدين الإسلام، اليوم، نلاحظ أنّ الدين، يُوجَّه إلى صيغة أيديولوجية سياسيّة راديكاليّة، تضاد التصوّر الذي أتمثّله أنا شخصيًّا لهذا الدين بما هو منظومة اعتقاديّة، أي إيمانيّة، ذات ماهيّة إنسانيّة، وأخلاقيّة، وحضاريّة، وجماليّة، تتوافق مع «علمانيّة الحياد» لا مع «علمانيّة الفصل». أي مع «دولة مدنيّة» تصون الدين من التعدّيات والإساءات، وتحفظ لأهله الحريّة والكرامة والعدل التي هي قيم مشتركة بين الدين وبين الدولة الإنسانيّة العادلة.
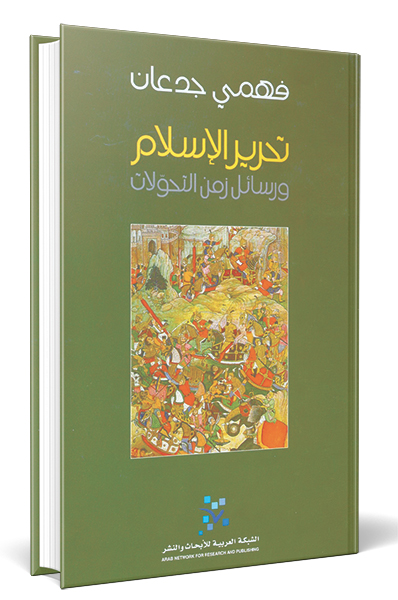 ● في سياق متصل، تقول في كتابك الأخير «مرافعة للمستقبلات العربيّة الممكنة»: إنّ «الدولة العربيّة الحديثة لا تستطيع أن تستمر في التشبّث بالقيم الدارسة في الحكم، أو أن تتجاهل على الدوام الحقائق الثاوية وراء تقدّم العالم الحديث وظفر الحداثة وأهلها» وتنبّه لاستمرار الارتهان إلى مبدأ السيّد والعبد في علاقته مع المواطنين، أليس هذا أمرًا دنيويًّا يستند إلى منظومة الأخلاق والقوانين أكثر من استناده إلى التصوّرات الدينيّة؟
● في سياق متصل، تقول في كتابك الأخير «مرافعة للمستقبلات العربيّة الممكنة»: إنّ «الدولة العربيّة الحديثة لا تستطيع أن تستمر في التشبّث بالقيم الدارسة في الحكم، أو أن تتجاهل على الدوام الحقائق الثاوية وراء تقدّم العالم الحديث وظفر الحداثة وأهلها» وتنبّه لاستمرار الارتهان إلى مبدأ السيّد والعبد في علاقته مع المواطنين، أليس هذا أمرًا دنيويًّا يستند إلى منظومة الأخلاق والقوانين أكثر من استناده إلى التصوّرات الدينيّة؟
– هذا التقدير صحيح. أعني أنّ منظومة القيم والمبادئ التي تحكم المجتمع والدولة ينبغي أن تكون ابتداءً مستقاة من مسلّمات العقل الإنسانيّ، ومن مقتضيات وضرورات الواقع الدنيويّ التاريخيّ، ومن الخبرة البشريّة التي تحتكم لمبادئ العدالة. لكن ليس معنى ذلك أنّ هذه المنظومة هي بالضرورة مضادة للمسلّمات الدينيّة البديهيّة، وبخاصة حين أقول، في أمر دين الإسلام بالذات: إنّ الغائيّة الأساسيّة لهذا الدين تكمن في مبدأ (العدالة)، وإنه «حيثما ظهرت أمارات العدل فثمّ شرعُ الله»، وأضيف أنّ القيم العليا الإنسانية كامنة في «الأصول البذريّة» والنصوص «المُحكَمة» لهذه القيم في (النصّ الدينيّ) الذي هو عندي ذو ماهيّة إنسانيّة أخلاقيّة أولًا وآخرًا، وأنّ فهم جميع النّصوص ينبغي أن يوجّه هذه الوجهة استنادًا إلى مبدأَيِ المُحكم والمؤوّل.
● سألتَ نفسك، في حوار سابق: إن كان الإسلام نفسه، بما هو رؤية أنطولوجيّة عقديّة تديُّنيّة حضاريّة، يتقبّل الديمقراطيّة التمثيليّة، والليبراليّة الاجتماعيّة، والعَلمانيّة الحياديّة الليبراليّة، لا علمانيّة الفصل الجذريّة. وسألت أيضًا: مَنْ هم المسلمون الذين يمكن أن «يتكيّفوا» أو «يتوافقوا» مع هذه المبادئ؟
– نعم، سألتُ هذا السؤال في (المرافعة..)، وسواه، في أكثر من حوار، على نحو إيجابيّ؛ لأنني أعتقد يقينًا أنّ الإسلام هو قبل كل شيء آخر «دين»، أي أنه منظومة من العقائد الأنطولوجيّة والميتافيزيقيّة الإلهيّة -أو اللاهوتيّة- المسيّجة بمنظومة من القيم الأخلاقية الرفيعة القمينة بأن تحوّل الإنسان من «حالة الطبيعة» إلى «حالة الثقافة»، في حدود نسق حضاريّ وإنسانيّ أخلاقي قائم على العدل والرحمة والمساواة والفضيلة والحرية. وقلت: إنّ «إسلام الأغلبيّة» إسلام «التيّار العام» أو الـ (main stream)- لا الإسلام السياسيّ الذي هو محض «أيديولوجيا» تمتح من الميكافيليّة والخداع ونشدان المنفعة الخالصة والسيطرة- يتقبّل الديمقراطيّة التمثيليّة؛ لأنها تعبير عن الإرادة العامة للشعب أو الأمة، وهذا يُوافق صريح النصوص الدينيّة. وأنّ (إسلام التيار العموميّ أو الأغلبيّ) يتقبّل الليبراليّة الاجتماعيّة؛ لأنّ هذه الليبراليّة تعني الحريّة لجميع أفراد المجتمع والعدالة والمساواة لكل المواطنين، وهذا أيضًا يُوافق صريح النّصوص الدينية، وأنّ (إسلام التيار العموميّ أو الأغلبيّ) يتقبّل العلمانيّة الحياديّة الليبراليّة؛ لأنه لا يطلب إلا ممارسة حياته الاعتقاديّة الدينيّة بدون قسر أو قهر، وأنّ هذه الصيغة من العلمانيّة الحياديّة تحرص على «حفظ الدين» ودعمه في الفضاء الاجتماعيّ.
صحيح أنها لا تقبل بمبدأ «الحاكميّة» الذي يميّز الحركات الدينيّة – السياسيّة الراديكاليّة، لكنّ المؤمن في حياته المجتمعيّة لا يطلب أكثر من أن تُصان له حريته ودينه ومعتقداته وشعائره، مما يدخل في وظيفة «الدولة العادلة». وأنا أعتقد أنّ عنصر الإشكال لا يكمن في المضمون، إنما في الذيول والأطياف السلبيّة التي تتلبّس مصطلح «العلمانيّة».
المشكل يكمن في المصطلح
 ● ألهذا تعتقد، وتحديدًا في كتابك «تحرير الإسلام ورسائل زمن التحولات»، أنه من الأجدى أن ندعو إلى «إسلام متصالح مع العلمانيّة، أو «علمانيّة موافقة للإسلام»، عوضًا عن «إسلام علمانيّ». وتأمل أن يفيض المستقبل بعصر آخر يتقبّل المفهوم ويهضمه. أهو «رهاب العلمانيّة»؟!
● ألهذا تعتقد، وتحديدًا في كتابك «تحرير الإسلام ورسائل زمن التحولات»، أنه من الأجدى أن ندعو إلى «إسلام متصالح مع العلمانيّة، أو «علمانيّة موافقة للإسلام»، عوضًا عن «إسلام علمانيّ». وتأمل أن يفيض المستقبل بعصر آخر يتقبّل المفهوم ويهضمه. أهو «رهاب العلمانيّة»؟!
– أكرّر ما قلته قبل قليل. المشكل يكمن في المصطلح، وفي تاريخه السلبيّ في العالم العربيّ المعاصر، إذ تمكّنت الحركات الدينيّة التقليديّة والأصوليّة من «شيطنة المصطلح». وأسهم كثير من العلمانيين في تعزيز هذه الشيطنة؛ لأنهم تمترسوا دومًا وراء المفهوم الفرنسي للعلمانيّة، أعني «علمانيّة الفصل» المناهضة لكل دعوى أو رؤية دينيّة، وذهب فريق منهم إلى تقديم هذا المصطلح بما هو قرينٌ للإلحاد، فولّد ذلك ما أسميتَه «رهاب العلمانية»! أنا لستُ «أيديولوجيًّا» على الرغم من جنوحي إلى هذه الصيغة أو تلك في مجال الأفكار والنظم الاجتماعية- السياسية. ولا أرغب في أن أكون «داعية» لهذه الصيغة أو تلك من العلمانيّة، وأتوق إلى تجاوز هذه المصطلحات التي باتت «صدئة». ما أطلبه اليوم وغدًا هو أن يحمل المستقبل لشعوبنا العربيّة ولأجيالنا القادمة، على وجه التحديد، «الدولة العادلة»، التي تكفل للمواطن العربيّ العدالة والحريّة والرفاهيّة والاستقلال والإرادة والنّزاهة والطمأنينة، وما أسماه أبو الحسن الماوردي قديمًا «الأمل الفسيح».
● تميل بعضُ التحليلات الاجتماعيّة والنفسيّة إلى تصوّر كيان تاريخيّ للأفراد، بمعنى أنهم امتداد تاريخيّ لثقافتهم، ونتاج لها. فالثقافة المؤسَّسة على العنف، وتسويغ الإذعان بوصفه طاعة، وقهر النساء بوصفه طريقًا إلى العفة، هي التي تُنجب أدبيّات دينيّة تمجّد العنف، وتدعو إلى إحراق المخالفين وسَوْمهم سوء العذاب. ولنا في تراثنا أدلّة كثيرة على ذلك. فلمَ العجب، إذًا، من شيوع «الداعشيّة» في الممارسة والسلوك، وهيمنتها على خيارات الفرد العربيّ في هذه اللحظة المرتبكة؟
– لا عجب أبدًا؛ لأنه لا شك على الإطلاق في أمرين: الأول التاريخيّة الثقافيّة للفرد، والثاني «البرمجة الوجدانيّة» المبكّرة. في الحالة الأولى تنتج الثقافة التاريخيّة أبناءها، ومن بين هؤلاء من يوجّهه «حظّه» أو «ظروفه» إلى الوقوع في براثن أفراد أو دعاة أو أحزاب أو جماعات أو أسرة «أبويّة» تمثّلت التجربة التاريخية بعيون العنف، فيذهب هؤلاء في هذه الطريق أو تلك. وفي الحالة الثانية تقوم «البرمجة الوجدانيّة» المبكّرة بتشكيل الشخصيّة وتوجيهها في هذه الطريق أو تلك. ليس ثمة أخطر من مرحلة الطفولة والفتوّة، أو الصبا. فيها تتشكّل الشخصيّة الفرديّة و(الأنا) العميقة، وفيها تتحدّد النزعات الانفعاليّة والعاطفيّة الأساسيّة التي تحكم المستقبل، لا الفرديّ فقط، إنما أيضًا الجمعيّ؛ لذا كانت «التربية المبكّرة» و«الثقافة القاعديّة» الصحيّة التداوليّة هي الضامن الأساس لنموّ سليم و«طبيعيّ»، «غير داعشيّ».
● هذا الأمر يقودنا إلى السّجال المندلع في غير ما مكان في العالم العربي حول تطوير المناهج المدرسيّة وتحديثها، وحقنها بالفكر العلميّ والعقلانيّ والتنويريّ. هل ترى أنّ ذلك ممكن في ظل «انسداد الآفاق»، لا سيما إذا علمنا أنّ تعديل المناهج لن يُثمر ما نتمناه ما دام أنّ ثمة «منهجًا خفيًّا» يتمثّل في المدرسين الذين ينتسبون، في جلّهم، إلى أيديولوجيا التزمُّت والخرافة؟
– أعلم جيدًا أنّ «الصعوبة» خارقة، وأنّ ما يشبه «الدور المنطقيّ» يتلبّس المشكل: نريد تحديث التربية بأدوات «غير حديثة»! كيف نستبدل ما هو خير بما هو أدنى؟ من أين نأتي بالمربّين والمعلّمين- العلميّين، العقلانيين، التنويريين، في مؤسسات تنضح بالتخلّف الفكريّ والعقليّ والخرافيّ؟ وأين «الدولة الحكيمة» التي تتبنى سياسات تتوافر فيها هذه الشروط في قبالة قوى ومؤسّسات رافضة؟ لن أتكلّم من جديد على «الآفاق المسدودة».. وبصراحة لا أكاد أرى من طريق للعبور والخروج إلا بمزيد من الدعوة والدفاع عن «مبادئ الحداثة»، من خلال الجهود المتضافرة التي يبذلها المثقفون المستنيرون، والمفكرون، ومنابر الرأي، والمؤسسات الثقافيّة الحديثة، والضغط المستمر على الدولة من أجل إحداث التطويرات الضروريّة. نحتاج إلى أزمنة ممتدّة لإدراك نتائج ملموسة. وعلى الرغم من أنّ «الثقافة الكونيّة» (global culture) المقترنة بـ(العولمة) تسهم في التغييرات الحداثيّة، فإنّ هذه الثقافة تحمل أيضًا عناصر مضادة للحداثة الحقيقيّة. وفي جميع الأحوال لا مفرّ من هذه التغييرات، لكنّ المشكل يكمن في قدرتنا على التحكّم فيها وضبطها والسيطرة عليها. في ظلّ الأوضاع الكارثيّة والفوضى الضاربة في كلّ مكان، ليس لديّ القدرة على «التكهّن» والتنبّؤ».
دائرة الإفتاء غير مغلقة
● ربما ينتسب إلى هذه الفوضى العارمة، ما نبّهتَ إليه في كتابك «تحرير الإسلام، ورسائل زمن التحولات» من هيمنة الأساطير والخرافات التي تشوّه صورة الإسلام، كما يتجلّى ذلك في فضائيّات ووسائل إعلام تُشيع أفكارًا تجعل الإسلام «دينًا خرافيًّا». ألا تعتقد أنّ بموازاة هذه الصورة المفزعة إسرافًا في إصدار الفتاوى التي تسجن الكائن في زنزانة الحرام والحلال، وتنزع عنه قدرته على التفكير بعقل مقاصديّ يُصدّع سلطة هؤلاء الفقهاء، ولا يقيم وزنًا لها؟
– بكل تأكيد. وبخاصة أنّ دائرة الإفتاء «غير مغلقة»، وأنّ الذين يتصدّون للإفتاء يأتون من كل حدب وصوب، تتوزّعهم المذاهب والأهواء والقيود، وتصدر عنهم آراء «خارقة»، فضلًا عن أنهم غرباء عن حركة العالَم وتطوّراته الجوهريّة، ويفتقرون إلى الرؤية الهولستيّة، الشموليّة، وإلى الإحاطة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الدقيقة. أعتقد أنّ قضية «الإفتاء» واحدة من القضايا المربكة والعويصة في النظام الديني الإسلامي، وأنها تتطلّب «رؤية راديكالية». أنا أنبّه فقط إلى عقابيلها ومخاطرها، لكنّ الخوض في شعابها وفي تقنيّاتها لا يدخل في مجال كفايتي واهتمامي.
● تدعو أيضًا في «تحرير الإسلام..» وأنت تتأمل في حال الإسلام اليوم، إلى التحوّل عن منهج قياس الغائب على الشاهد، والذهاب إلى معطيات الواقع المباشرة واشتقاق المبادئ منها. على من تقع هذه المهمة؛ على المفكرين الوَجلين المرتعدين خوفًا من سلطة «الإيمان الشعبي» وغلوائه، أم على «الفقهاء» المرتبطين بمصالح السلطات الحاكمة والناطقين باسمها؟ أليس هؤلاء هم الأولى بالتحرير.. والتطهير؟!
– التحرير يجب أن يطال الجميع. العيوب والتقصير ماثلان في كلّ حيّ ومجال. منهجيًّا قلتُ دومًا: إن نقطة الانطلاق ينبغي أن تكون هي المعطيات المباشرة للواقع المعيش. والمبادرات «النقديّة» ينبغي أن توجّه إلى كل القطاعات. وفي المجال الدينيّ الإسلاميّ نحن نعلم أنّ الفقهاء هم الذين شكّلوا «العقل الإسلامي» وأسهموا، بالتالي، في الفوضى العمليّة في الحياة الإسلامية المشخصة، وذلك بسبب اختلافاتهم التي لم تكن رحيمة دومًا، وبسبب ما صدر عنهم من أحكام ومن فتاوى وتقديرات يكشف التحليل و«التفكيك» الدقيقان عن مدى ما أصاب دين الإسلام من اجتهاداتهم الملتبسة أو المربكة. لا شك أيضًا في أنّ تناقضات «المتكلّمين» وافتراقهم فرقًا ومذاهب قد فاقمت من فوضى «الاعتقاد» في الإسلام. كما أنّ استبداد «السياسيّ» بـ«الدينيّ» قد أسهم في هذه الفوضى وفي «الجوْر» الذي لحق بدين الإسلام. فالتطهير والتحرير، إذًا، مطلوبان في جميع القطاعات المعرفيّة والعمليّة الدينيّة، وليس فقط في «عقل العامة» الغارقة في التعصّب والخرافة والجهل. المشكل عميق، وشامل، ويزداد اتساعًا وشدّة يومًا بعد يوم.

أحمد زويل
● تصف «الربيع العربي» ووعوده، بـ«الربيع الكاذب». لكنّك في أكثر كتبك وأبحاثك تراهن على انبعاث الإرادة العربيّة من رماد القهر والتخلّف والاستعباد. ألا يمكن أن نكون على موعد قادم مع «ربيع حقيقيّ» يفي بوعوده الجماليّة، ولا سيما أن مبرّرات ودواعي هذا الربيع «الانفجاريّ» لا تزال شاخصة؟
– لم يكن لسعادتي حدود حين انفجر الحدث الأول والثاني والثالث، وحين خرجت الجموع تصدح بالحرية وبالعدالة وبقهر الاستبداد وبالعيش الكريم. وقد عقدتُ آمالًا خارقة على المستقبل. واعتقدت أنّ تلك كانت فعلًا «أعراضًا ربيعيّة»، لكنّ «المرحلة الربيعيّة» لم تطلْ كثيرًا؛ إذ تمّت أقلَمة الظاهرة وتدويلها، ودخلت (داعش) و(القاعدة) على الخط، ولم يعد الربيع ربيعًا. وبعد أن قلت: إنّ للتاريخ حِيلَه، وإنّ الجدليّات الاجتماعيّة «ولّادة»، قلت ما قاله أرسطو وكرّره آخرون: «إنّ طائر سنونو واحدًا لا يصنع الربيع»! من المؤكد أنّ خللًا عظيمًا قد نجم -ولا داعي للإنكار- وأنّ الحدث قد فقد «براءته الأولى» ومجده العظيم، وأنّ التصوّرات الكارثيّة التي جرت وتجري ليست هي ما نطلبه من أجل الخروج من النفق. هل يتعارض هذا التقدير للأمور مع ما جريتُ عليه في جملة أعمالي؟ أبدًا. لأنني ما زلت وسأظل متعلّقًا بأنّ التاريخ «ولّاد»، وبأنّ له «حِيَله»، وأنّ علينا أن ننتظر ربيعًا قادمًا، حقيقيًّا، صادقًا، نزيهًا، جميلًا.. لسبب بيّن، بديهيّ، وهو كما تقول: إنّ مسوّغات ودواعي هذا «الربيع الانفجاريّ» لا تزال شاخصة تطلب حقوقها، وتطلب هذه الحقوق بقوة.
● تُميّز بين «المفكر» و«المثقف» فتُعلي من شأن الأول، لاعتقادك الصارم، كما تقول، بأن «الكلمة الوثقى هي لقول المفكر، لا لرغبة المثقف». ألا يكتنف هذه المراتبيّة استعلاءٌ من نوع ما؟
– هذا التمييز ضروريّ، وهو يخفى على الجميع. وليس المقصود منه اصطناع تراتبيّة أو طبقيّة، إنما المقصود التحديد «الوظيفيّ» لكل منهما. كان لي قول مفصّل في هذه المسألة، ذهبتُ فيه إلى أنّ «المفكّر» يتميّز بالمرجعيّة العقليّة، والفلسفيّة والعلميّة، والموضوعيّة -بقدر الإمكان- والنّزاهة، والتحرّر -بقدر الإمكان- من الذرائعيّة والنفعيّة والهوى أو «الرغبة»، وغائيته الأساسيّة التحليل والتنوير والنقد والاقتراح. أما المثقّف فإنه يطلب بالدرجة الأولى «تغيير الواقع»، ويلجأ في ذلك إلى «التدخّل المباشر المشخص» والجنوح الشديد إلى الأدلة «الخطابيّة» أو «الشعريّة» أو «الاحتماليّة» المقترنة بالرغبة التي تتجاوز ما هو يقينيّ «معقول» في كثير من الأحيان. لكنني أضفت أنّ المفكّر يمكن أن يكون أيضًا «مثقفًا» يطلب التغيير، ومثّلت لذلك بإدوارد سعيد. وفي جميع الأحوال، المثقف يحتاج حاجة ماسّة إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة. وفي أمر فهم الواقع وتحليله وتوجيهه ينبغي، في رأيي، التعويل على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف. و«القول» يُحيل إلى العقل والعلم، و«الرغبة» تُحيل إلى الظنّ والشهوة.
● سألتُ ناشرًا عربيًّا مرموقًا عما يرغب الناسُ من محبّي المعرفة في قراءته، فلفت انتباهي إلى أمر أدهشني يتمثل في إقبال عدد كبير من القراء على الفلسفة، ولا سيما إذا كانت كتبها معروضة بشكل مبسّط ومثير. هل يدهشك هذا الأمر. وإلامَ تحيله؟
– لا. لا يدهشني أبدًا. أستحضر قولًا لأرسطو في مطلع (ما بعد الطبيعة) هو أنّ كلّ الناس ينشدون بصورة طبيعيّة المعرفة، وبخاصة المعرفة المنزّهة عن المنفعة. الذي يحدث في الغالب الأعمّ هو أنّ الناس ينفرون من الفلسفة بسبب التجريد الذي يتلبّس أعمال الفلاسفة، لكن إذا قُدّمت الفلسفة لهم بلغة وأسلوب مبسّطين فإنهم سيُقبلون عليها؛ لأنهم يريدون مكافحة «الجهل» الذي يهاجمهم، ويريدون أن يفهموا العالم والعصر اللذيْن يزدادان حولهم غموضًا وتعقيدًا. ومع ذلك، فإنّ الذي يبدو لي هو أنّ «الفلسفة العمليّة» -أعني الفلسفة السياسيّة والفلسفة الأخلاقيّة- هي التي تثير اليوم الاهتمام الأكبر لدى الجمهرة من الناس.
أنا في وضع «سيزيف».. أتحمل وأطيق وأصبر وأقع وأقوم
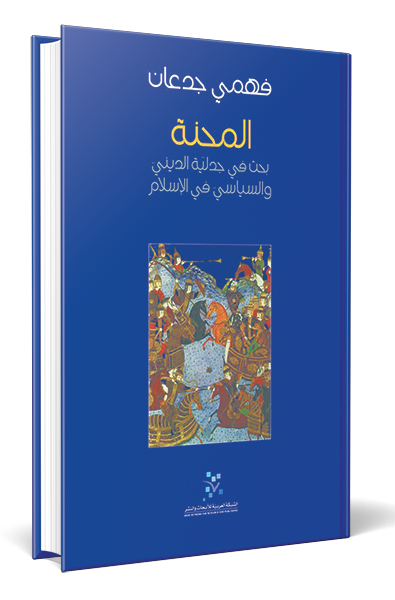 ● منذ «أُسس التقدّم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» حتى «مرافعة للمستقبلات العربيّة الممكنة» وأنت تتنكّب سُبل الأمل، وتعدّ اليأس خيانة، مع أنّ الواقع يخون والعقل يخون والإرادة تترنّح. هل تحمي، في رهاناتك المتفائلة هذه، صورة المفكّر من التساقط في هوة العدميّة، أم أنك تتمثل هيئة «سيزيف» الذي لا يكفّ عن رفع الصخرة إلى أعلى الجبل كلما تقهقرت إلى قاع الوادي السحيق؟!
● منذ «أُسس التقدّم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» حتى «مرافعة للمستقبلات العربيّة الممكنة» وأنت تتنكّب سُبل الأمل، وتعدّ اليأس خيانة، مع أنّ الواقع يخون والعقل يخون والإرادة تترنّح. هل تحمي، في رهاناتك المتفائلة هذه، صورة المفكّر من التساقط في هوة العدميّة، أم أنك تتمثل هيئة «سيزيف» الذي لا يكفّ عن رفع الصخرة إلى أعلى الجبل كلما تقهقرت إلى قاع الوادي السحيق؟!
«الوضع الوجودي الذي أتقلّب فيه منذ (الخروج) هو الوضع الرواقي. كان عليّ دومًا أن أتحمّل وأطيق وأصبر وأكافح.. أقع وأقوم، ككثيرين من أبناء جيلي ووطني. بهذا المعنى أنا في وضع «سيزيف». لكن من ناحية أخرى، مقترنة بالوضع نفسه، أنا لا أطيق العدميّة، ولا أطيق «الخيانة». وبين العدميّة من طرف، والأمل من طرف آخر، أختار الأمل.. لأنه ما الذي يتبقّى حين نفقد الأمل؟!
● تحدثت عن العقل الوجداني أو التربية الوجدانية أو إعادة البرمجة الوجدانيّة للإنسان. أنت تراهن كثيرًا على «الوجدان» وتراه رافعة أساسيّة لتحقيق النزاهة. ودعني أقول: إن «النزاهة» جزءٌ منك شخصًا ومفكرًا. ماذا جنيتَ من النزاهة. وهل جنت عليك؟!
كلام جميل! لكنّني اليوم، أكثر مما كنتُ في أيّ يوم مضى أشدّ اقتناعًا وأصلب عودًا في الدفاع عن حتميّة البرمجة الوجدانية «الصحيّة»، النبيلة، النزيهة لأبنائنا، اليوم وغدًا؛ لأنّ غياب هذه القيم والمبادئ التي ينبغي أن تقترن بها التربية الوجدانيّة المبكّرة هو الذي يفسّر التدلّي والتخلف والعقم الذي يغلّف ويتلبّس هذه الأجيال المتأخرة من شعوبنا العربيّة ومن إنساننا العربيّ الغارق اليوم فيما لا تقدر لغتي «المهذّبة» على وصفه. وأنا شخصيًّا سعيد جدًّا لأنك تنسبني إلى النّزاهة، وأنا سعيد جدًّا بهذه النزاهة إن كنتُ أتّصف بها حقًّا. تسألني: ما الذي جنيته من هذه النزاهة؟ وهل جنتْ عليّ؟ أنا أسألك! هل كنتَ ستعتقد أنني سأكون أفضل لو أنني استسلمتُ للإغراءات غير النبيلة التي عرضت لي؟ هل كنت سأكون نبيلًا لو أنني فعلتُ، مثلما يفعل كثير من المثقفين و«المفكرين» الأدعياء، وبعتُ نفسي للشيطان؟ هل سيكون ضميري مرتاحًا لو أنني تنازلتُ عن كرامتي، ورضيتُ أن أتحوّل إلى «مرافق ذليل» أو مستشار تافه لرجل دولة أو مال أو جاه؟!
هل كنتُ سأكون أسمى وأعظم وأخطر لو كنتُ وزيرًا أو رئيس جامعة، أو صاحب مُلك أو مال وضيع؟! صدّقني.. النزاهة لم تجنِ عليّ.. أنا الذي جنيتُ منها.. جنيت منها كثيرًا شخصًا ومفكرًا، كما تقول. وعلى الأقل هي منحتني الرضا الداخلي، والنبل، والثقة بالنفس، والاعتزاز بالذات، واحترام الآخرين لي، واحترامي لنفسي. ويكفيني أنك أنتَ ومن يقاربك في الفهم والتقدير تنسبونني إلى هذه القيمة النبيلة، في الوقت الذي تنسبون أكبر الأسماء ذيوعًا وانتشارًا وتأثيرًا إلى النذالة والخسّة والكذب والنفاق! لقد دافعتُ دومًا عن القيم، وجعلتها المبدأ الرئيس لكل إصلاح وتقدّم. لذا كان من الطبيعيّ أن أجنح إلى النّزاهة والنبل والاستقامة، وأن يُقال بعد مغادرتي هذا العالم: كان نبيلًا، نزيهًا، شريفًا، ولم يطلب ما يطلبه الآخرون الذين يرفلون بثياب العزّ والنذالة والذلّ.







 العلمانية انبثقت كخلاص في لحظة انسداد الآفاق، وفي غمرة هيمنة التصوّرات الدينية المتطرفة التي لا صلة لها بالإسلام الحقيقي، التي غمرت الأرجاء، وحوّلت الناس إلى «كائنات دينية»، في ظل تواطؤات مع السلطة السياسية التي منحت هيئة الفتوى صفة «المقدّس» فأغلقت باب التفكير النقدي. الانسداد وصل الآن إلى ذروته، وتضاءل الأمل بعد أن غمرت الأفكار السلفية المتطرفة كل شيء، وبعد أن أدركت السلطات السياسية العربية أنّ التصورات الدينية التي اعتمدتها بصفتها ملجأً وملاذًا قد ورّطتها في أزمات لا حصر لها، وأضحت أحد أكبر مصادر التهديد لكياناتها، وصار الانفكاك من تلك الهيمنة المستشرية هو المشتهى، ولكن كيف، وبأية أدوات؟
العلمانية انبثقت كخلاص في لحظة انسداد الآفاق، وفي غمرة هيمنة التصوّرات الدينية المتطرفة التي لا صلة لها بالإسلام الحقيقي، التي غمرت الأرجاء، وحوّلت الناس إلى «كائنات دينية»، في ظل تواطؤات مع السلطة السياسية التي منحت هيئة الفتوى صفة «المقدّس» فأغلقت باب التفكير النقدي. الانسداد وصل الآن إلى ذروته، وتضاءل الأمل بعد أن غمرت الأفكار السلفية المتطرفة كل شيء، وبعد أن أدركت السلطات السياسية العربية أنّ التصورات الدينية التي اعتمدتها بصفتها ملجأً وملاذًا قد ورّطتها في أزمات لا حصر لها، وأضحت أحد أكبر مصادر التهديد لكياناتها، وصار الانفكاك من تلك الهيمنة المستشرية هو المشتهى، ولكن كيف، وبأية أدوات؟
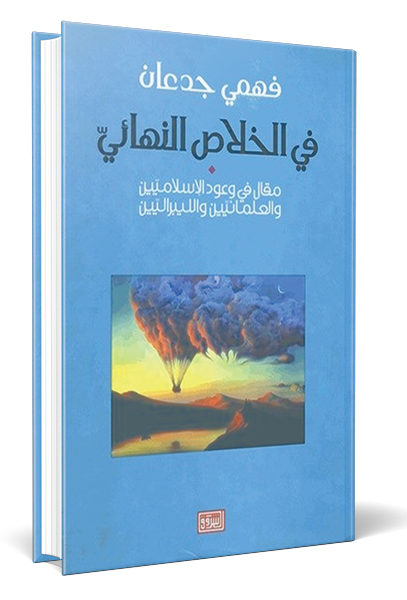 الأمل، فهذه في نظره من المحدّدات التي يعوّل عليها من أجل تعبيد السبيل أمام الأجيال القادمة، والحيلولة دون إنتاج المزيد من الآفاق المسدودة. ويعتقد جدعان أنّ المثقف يحتاج، كي يفهم الواقع ويحلّله ويوجهه، إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة؛ لأنّ التعويل يكون على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف. ويدافع جدعان، المولود في قرية عين غزال بفلسطين المحتلة، عن حتميّة البرمجة الوجدانيّة «الصحيّة»، النبيلة، النّزيهة لأبنائنا، اليوم وغدًا، ففي نظره أنّ غياب هذه القيم والمبادئ، التي ينبغي أن تقترن بها التربية الوجدانيّة المبكّرة، هو الذي يفسّر التدلّي والتخلف والعقم الذي يغلّف ويتلبّس هذه الأجيال المتأخرة من شعوبنا العربيّة.
الأمل، فهذه في نظره من المحدّدات التي يعوّل عليها من أجل تعبيد السبيل أمام الأجيال القادمة، والحيلولة دون إنتاج المزيد من الآفاق المسدودة. ويعتقد جدعان أنّ المثقف يحتاج، كي يفهم الواقع ويحلّله ويوجهه، إلى المفكر وأدواته العلميّة والفلسفيّة المنضبطة والضابطة؛ لأنّ التعويل يكون على «قول» المفكر، لا على «رغبة» المثقف. ويدافع جدعان، المولود في قرية عين غزال بفلسطين المحتلة، عن حتميّة البرمجة الوجدانيّة «الصحيّة»، النبيلة، النّزيهة لأبنائنا، اليوم وغدًا، ففي نظره أنّ غياب هذه القيم والمبادئ، التي ينبغي أن تقترن بها التربية الوجدانيّة المبكّرة، هو الذي يفسّر التدلّي والتخلف والعقم الذي يغلّف ويتلبّس هذه الأجيال المتأخرة من شعوبنا العربيّة.