
المهدي مستقيم - باحث مغربي | مايو 2, 2017 | ثقافات
إذا كانت القيم والمثُل التقليدية (الدينيّة، أو الوطنيّة، أو الثوريّة) قد عجزت عن استمرارية عملها بالمعاني التي تضفيها على حياتنا، فإن ما أنعته «ثورة الحب»، المتجذِّرة في العبور من الزواج العرفي إلى الزواج المؤسس على قيمة الحب، بوصفها أفقًا وغاية، أحدث تغييرًا كليًّا على حياتنا. وهذه الثورة الصامتة، والشديدة العمق في الآن نفسه، تمدُّنا بمبدأ جديد من حيث المعنى، أضفى قيمته على تلك الأبعاد الإنسانية، التي طالما كانت مهمشة، والمجسدة في الحب الذي نكنُّه لرفقائنا ورفيقاتنا، ولأصدقائنا وأطفالنا وأقربائنا.
بيد أن هذا الانقلاب لا يمكن حصره فيما هو خاص؛ إذ سرعان ما امتدّت عدوى التغيير الجذري الذي طال حياتنا الخاصة، لتشمل علاقاتنا الجماعية، ذلك أن الحرص على أن نحقِّق لمن نحبهم، ابتداء بأطفالنا، عالمًا يَسْهل العيش فيه، وتتوافر فيه سبل الازدهار، يضع الاهتمام بالأجيال القادمة في صميم رؤيتنا لما هو سياسي. لقد تبلورت أنسنة ثانية بإيقاعات موسعة، على أنقاض الأنسنة الأولى القائمة على فلسفة الأنوار وحقوق الإنسان، أنسنة جديدة تتسم بالأخوَّة والتعاطف، وتمتنع عن التضحية بالإنسان لفائدة الوطن أو الثورة أو حتى التقدم (وهي مُثُلٌ اشتهرت بأنها منفصلة عن الإنسانية ومتعالية عليها)، في حين أنها تشعر بحضور ذاتها في وجودنا المحايث، وفي مشاعرنا تجاه الآخرين منبعًا ليوتوبيا إيجابية، تنبثق من المشروع المتمثل في توريث من سيأتي من بعدنا عالمًا يوفر لكل واحد مسوغات «التحقق».
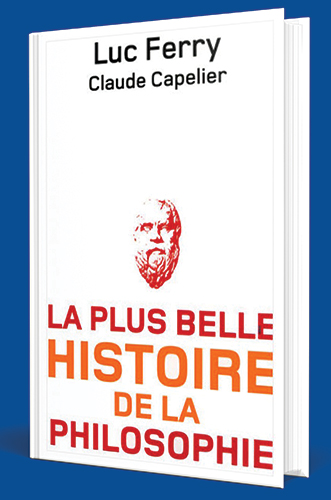 لقد تبين أن الأَنْسَنَةَ الأولى، أي أنسنة الأنوار والعلم المنتشي بنجاحات الانتصار، قد تعرضت في زمن التفكيك لأنواع حادة من النقد، نقد لم يكن حكرًا على الفلسفة العالِمة وحسب، بل طال السياسة أيضًا (إضافة إلى الإيكولوجيا) والحياة اليومية لدى الغربيين، ولكي نصير أكثر اقتناعًا بذلك، يكفي أن نراجع الحدود التي تغيرت فيها علاقتنا بالعلم منذ القرن الثامن عشر. حظي رد فعل ألمع المفكرين تجاه الزلزال الذي خرب لشبونة سنة 1755م، وأودى الموت بآلاف الأشخاص، بالإجماع والثقة، بيد أن ما أحرزته العلوم والتقنية من إنجازات وتقدم غير مسبوق، سيكون قادرًا مستقبلًا على تجنيب الإنسانية مثل هذه الكارثة.
لقد تبين أن الأَنْسَنَةَ الأولى، أي أنسنة الأنوار والعلم المنتشي بنجاحات الانتصار، قد تعرضت في زمن التفكيك لأنواع حادة من النقد، نقد لم يكن حكرًا على الفلسفة العالِمة وحسب، بل طال السياسة أيضًا (إضافة إلى الإيكولوجيا) والحياة اليومية لدى الغربيين، ولكي نصير أكثر اقتناعًا بذلك، يكفي أن نراجع الحدود التي تغيرت فيها علاقتنا بالعلم منذ القرن الثامن عشر. حظي رد فعل ألمع المفكرين تجاه الزلزال الذي خرب لشبونة سنة 1755م، وأودى الموت بآلاف الأشخاص، بالإجماع والثقة، بيد أن ما أحرزته العلوم والتقنية من إنجازات وتقدم غير مسبوق، سيكون قادرًا مستقبلًا على تجنيب الإنسانية مثل هذه الكارثة.
إذ بوسع الجيولوجيا والرياضيات والفيزياء أن تمكننا من ممارسة عمليات الاحتمال، ومن ثمة تفادي انعكاس المآسي الناتجة عن عبث الطبيعة القاسي على قدرات الكائنات البشرية. وباختصار، التفكير العلمي حسب رأي هؤلاء المفكرين اللامعين، هو الملاذ الوحيد الذي بإمكانه أن يجنبنا طاغوت المادة الخام. وقد شهد العصر تغيُّرًا جذريًّا، حتى لا نقول انتقالًا من براديغم إلى آخر جديد، إذ تبدو لنا الطبيعة اليوم نظريًّا أقل تهديدًا وأقل عدوانيّة، وأكثر رأفة من العلم الذي بات يشكل مصدر تهديد للبشرية، لا سيما أن كل ما يعرِّض وجودنا للخطر بات يبعث في أنفسنا الرعب. نحن نتظاهر بالاعتقاد أنه بإمكاننا تجنب قلق الموت، لكن سرعان ما يتحول هذا الاعتقاد إلى أصناف جديدة من الخوف: الخوف من الخمر، ومن التدخين، ومن السرعة، ومن ممارسة الجنس، ومن الذرة، ومن الهاتف النقال، ومن التعديل الوراثي، ومن الاحتباس الحراري، ومن الاستنساخ، ومن التكنولوجيا الحديثة، ومن ألف تحديث وتحديث شيطاني لا يزال يهدده بنا صناع العلم التقني العالمي.
لقد انتعشت أساطير فرانكشتاين وشخصية الساحر من جديد، حكى لنا التاريخ قصة كائن ممسوخ أو سحري ينفلت من خالقه، ويهدد بتخريب الأرض، هذا النوع من المجاز هو الذي ما لبث ينطبق في أيامنا على البحث العلمي، فبينما كان هذا الأخير في بداياته خاضعًا لسلطة بشرية روضته وتحكمت فيه بمشيئتها، فإنه اليوم أصبح ينذر ويهدد بالانفلات من قبضتها، إلى درجة لم يعد معها أحد يستطيع في النهاية أن يضمن بقاء النوع البشري وتوريثه للأجيال القادمة، ويكاد الأمر يتعلق بمجال ذهني لم يشهد له التاريخ البشري مثلًا.
فيما يخص علاقة العلم بالطبيعة، نحيل إلى الثورة الحقيقية التي شهدتها نهاية القرن العشرين، إذ منذ ذلك الحين لم نعد نميل إلى إرجاع الأخطار الجسيمة التي تحدق بنا إلى الطبيعة، إنما (للأسف) إلى البحث العلمي، حيث لم نعد نراهن على الهيمنة على الطبيعة، بقدر مراهنتنا على إحكام قبضتنا على البحث العلمي؛ ذلك أن العلم، ولأول مرة في تاريخه، أصبح ينتج للجنس البشري مسوغات دماره وأفوله، وهذا غير وارد بالنسبة للمجتمعات الحديثة التي باتت تعاني مخلفات الاستثمار الصناعي للتكنولوجيات الحديثة، بل يحصل أيضًا، عندما تُوظَّف هذه التكنولوجيا من جانب غيرنا. وإذا كنا اليوم نشعر بالتهديد أكثر من أي وقت مضى، فذلك يرجع لوعينا بأن الإرهاب بإمكانه أن يمتلك منذ اليوم –أو في وقت قريب- الأسلحة الكيماوية، بل حتى النووية المروّعة. لقد بات العلم الحديث بكل فروعه وتفعيلاته متملصًا منا، وقوَّته الماحقة صارت تبعث فينا الدهشة.
لم تقف سحابة تشيرنوبيل بفعل معجزة جمهورية، اخترقت حدود فرنسا. كما أن السيرورات التي تحكم النمو الاقتصادي أو الأسواق المالية لم تعد هي الأخرى تخضع لأوامر نواب الشعب، الذين توقفوا عن إخفاء عجزهم عن الالتزام بالوعود التي يودون تقديمها، أمام تزايد وتيرة هذا النمو. هنا بكل تأكيد يظهر سر نجاح أولئك الذين يريدون إقناعنا، شأن جمهوريينا الجدد، بأنه تمت إمكانيات للرجوع إلى الوراء، وأن التحالف القديم بين العلم والأمة والتقدم مسألة ينحصر تحققها في «المدنية» و«الإرادة السياسية» كم بودِّنا تصديق ذلك! خصوصًا أن شحنة لا بأس بها من التعاطف ترافق حتمًا أقوالهم المفعمة بالحنين.

المهدي مستقيم - باحث مغربي | نوفمبر 6, 2016 | كتب
يعد المفكر المغربي طه عبدالرحمن، أحد أكبر سدنة الدرس الفلسفي المنطقي في العالم العربي، وما يرتبط به من قضايا ذات صلة بفلسفة اللغة، وقد شرع في تطوير قضايا ومحاور هذا الدرس منذ وقت مبكر، إثر التحاقه سنة 1969م بالتدريس بشعبة الفلسفة بكلية محمد الخامس للآداب والعلوم الإنسانية، وخلف طه آثارًا عظيمة، تجلو عن أصالة المجهودات التي ما انفك يبذلها بكثير من الحنكة الأكاديمية والكفاءة العلمية، توجت بإصداره مجموعة من الدراسات المهمة، التي تعبر عن قناعاته وتوجهاته واختياراته وتمثلاته لنمط القول الفلسفي الذي يدعي أن بإمكانه أن يخدم إنماءنا واستدراك ما فاتنا.
استهل طه عبدالرحمن إصداراته بمصنفه الأول سنة 1979م تحت عنوان «اللغة والفلسفة»، ثم أعقبه بإصدار ثانٍ سنة 1983م بعنوان «المنطق والنحو الصوري»، وثالث بعنوان «فقه الفلسفة»، وهو عبارة عن مشروع في جزأين، صدر منه الجزء الأول سنة 1995م بعنوان فرعي: «الفلسفة والترجمة»، والثاني بعنوان «القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل»، وقد هدفت هذه الإصدارات التي شيد على أثرها طه مسيرته الفكرية، استنطاق أسس فلسفة اللغة والمنطق. ثم عرج بعد ذلك إلى التناول النقدي للأطروحات والتصورات السائدة في الفكر الفلسفي المغربي والعربي ككل، مفصحًا عن توجهه الفكري، المؤسس على تجربة روحية تنهل من المبادئ الأخلاقية التخلقية، وذلك في إصداراته الموسومة بـ «في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» (1987م)، و«العمل الديني وتجديد العقل» (1989م)، ثم «تجديد المنهج في تقديم التراث» (1994م). وتصنف بقية إصدارات طه ضمن مقولة «الائتمان»، وتدخل فيها مجموعة من الدراسات التي أصدرها طه تباعًا في هذا المجال.
نقد تيارات التقليد والحداثة
إن هذه المصنفات التي خطها طه عبد الرحمن بكثير من الحنكة والدقة، إنما تجلو عن مشروع فكري ضخم، يتغيا نقد تيارات التقليد والحداثة في الفكر المغربي والعربي، سعيًا منه إلى تحقيق نوع من الاستقلال الفلسفي المبدع، ينهل من تجربة روحية عقدية، تربط صفاء السريرة بالعقل العملي الصوفي، على أن هذا الأخير هو وحده من يستطيع أن يمنح للذات ما يهبها الرضا والقرب من طبيعة الإنسان ومعنى العالم وحقيقة الله. وهو مشروع سيكتشف المطلع عليه، أنه أمام جهد نظري كبير، جهد يعتني، كما قال المفكر كمال عبداللطيف، «بالكلمات والعبارات كما يعتني بالمفاهيم والتصورات، مستوعبًا خاصية الدقة والتدقيق باعتبارها لازمة أساسية في الكتابة الفلسفية، وذلك من أجل مقالة واضحة المعالم، وعبارة مسبوكة بكثير من العناية». (كمال عبداللطيف، أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، المركز الثقافي العربي).
يضعنا مشروع طه، أمام براديغم أو أنموذج إرشادي، يهدف إلى إعادة النظر في متخيلنا الاجتماعي، وفي القضايا التي يخوض فيها الفكر العربي المعاصر، ويعرف طه عبدالرحمن بهذا البراديغم أو الأنموذج في كتابه بؤس الدهرانية، إذ يقول: «نستعمل (الأنموذج) هاهنا بمعنى غير (النموذج)، ولو أنهما مشتقان من أصل لغوي واحد، فـ(النموذج) عبارة عن (المثال) بمعنى (الطراز)، ومقابله الإنجليزي هو Model أو Pattern، في حين نقصد بـ(الأنموذج)، على وجه الإجمال، منهجية متبعة ورؤية محددة للعالم، فمثلا نظرية نيوتن في الجاذبية أنموذج، ونظرية أينشتاين في النسبية أنموذج آخر، ومقابله الإنجليزي هو Paradigme (طه عبدالرحمن، بؤس الدهرانية: النقد الائتماني للفصل بين الأخلاق والدين، الشبكة العربية للأبحاث والنشر). إنه أنموذج مؤسس على قناعة ذاتية عميقة تخص تجربة طه الإيمانية، وقائم على ترسانة نظرية ومفاهيمية سميكة، تحاجج من أجل سلامة هذه التجربة، وتبرهن على نجاعتها وصدقها وإمكانيات تعميمها خدمة لتصور معين للعالم وللزمان.

الخيوط الكبرى الناظمة
يصعب على القارئ مسايرة المشروع «الطاهائي»، من دون إدراكه للخيوط الكبرى الناظمة للأنموذج الذي يتأسس عليه، ولعل ذلك ما حدا بالدكتور رضوان مرحوم إلى القول في التقديم الذي خصه لكتاب طه المعنون بـ(سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد): «ولما كان الحديث عن (أنموذج النظر) ينبني على منهجية غير مسبوقة، ويؤسس نمطًا معرفيًّا متميزًا – أي جملة من الصور والنظريات والمفاهيم والمسلمات والأحكام والأدلة التي تنبني عليها المعرفة الإنسانية في مدة معينة – لزم التطرق إلى (الأطر المفاهيمية) التي تلزم عن استعمال هذه المنهجية باعتبارها توجه النظر وترشده إلى تحصيل مطلوبه». ومن ثم فإن قارئ المشروع مطالب حسب رضوان مرحوم، بإدراك ترسانة كبيرة من المفاهيم المنهجية التي تشكل معجمًا اصطلاحيًّا خاصًّا بفكر طه عبدالرحمن، وهذه المفاهيم هي:
• «المنهجية التكاملية»: تقويم التراث الإسلامي العربي لا يصح إلا بفقه المنهاج التكاملي الخاص بهذا التراث، يرى طه أن تحقيق الإبداع الذي يوصلنا إلى التحرر الفكري لا يتم إلا بواسطة استخراج المنهجية التي نظّر لها من تقدّمنا من النظار المسلمين ممن حافظ على الخصوصية التداولية لثقافته الإسلامية الأصلية، وكرس في كتاباته استقلالية عقل المسلم، وهذه المنهجية المستنبطة من التراث ينبغي إعمالها عند تقويم عطاء المتقدمين في مختلف المجالات التي خاضوا فيها بنظرهم، وهو الأمر الذي يوجب الابتعاد عن الأحكام المتسرعة والدعاوى الأيديولوجية التي أطلقها بعض من خاض في تقويم التراث، لأن التمكن من وسائل النظر في التراث يتقدم طلب المعرفة بمضامين هذا التراث.
• «المنهجية التداولية»: تقويم العمل الفلسفي لا يتوصل إليه إلا بفقه آليات التداول الخاصة بالفيلسوف، إذا كان للتراث الإسلامي إبداعه الذي يميزه ويتفرد به عن باقي الإنتاجات الثقافية الأخرى، فإن للتراث الغربي (اليوناني والأوربي) إبداعه الخاص به، ومن منطلق الدعوة إلى التعارف التي تقتضي الانفتاح المعرفي والتلاقح الفكري بين الأمم، فإن استكشاف «المنهجية الفلسفية» التي اتبعتها ثقافة الغرب لإنتاج نموذجها الخاص في إبداع قولها الفلسفي يكون شرطًا ضروريًّا لاستئناف مسيرتنا الفلسفية الإبداعية بعد عصر الانحطاط، من هنا دعوة طه إلى النظر في الصنعة الفلسفية الغربية من منطلق علمي، لا فلسفي، حتى نتمكن من الدخول إلى مصنع الفيلسوف وهو يضع ترجمته لنصوص غيره من الفلاسفة، ويبدع مفهومه، ويضع تعريفه، ويبني دليله، ويسلك وفق مقتضيات قوله الفلسفي، لهذا، يتعين التعامل مع مشروع «فقه الفلسفة» بوصفه جهدًا نظريًّا ينبغي أن تضطلع به أجيال مجتمعة من الباحثين والمفكرين، من أجل استكشاف المنهجية التي صيغت بها الفلسفة عند العرب، وذلك بقصد استعمالها بما يتناسب مع مقتضياتنا التداولية في تحصيل أسباب الإبداع.
• «المنهجية الحجاجية»: التقويم المنطقي للتراث الإسلامي والخطاب الفلسفي لا يصح إلا بقانون المنطق الحجاجي، ذلك أن المنهجية التي تم استمدادها من التراث الإسلامي واستكشافها في الفلسفة الغربية لها أيضًا شرائط منطقية، ومقتضيات حجاجية، فيكون النهوض بإمكانياتنا الفكرية، واستئناف عطائنا الإبداعي محتاجًا، لكي يحيط بتمام عرضه، إلى تحصيل قوانين هذه المنهجية، واستعمالها عند صياغة نظرياتنا الفكرية. (طه عبدالرحمن، سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، المؤسسة العربية للفكر والإبداع).
أخيرًا، يركن المشروع الطاهائي إلى ممارسة نوع من النقد الصوفي للحداثة، ويلجأ من أجل ذلك في أحايين عديدة، إلى توظيف لغة دعوية تقليدية محافظة، ليبرز بذلك جاهلية وبهيمية ومادية الحضارة المعاصرة، حضارة الحداثة والتقنية، وهذا ما يبعد طه عبدالرحمن كما يقول كمال عبداللطيف، عن الطموح الذي أعلن عنه.

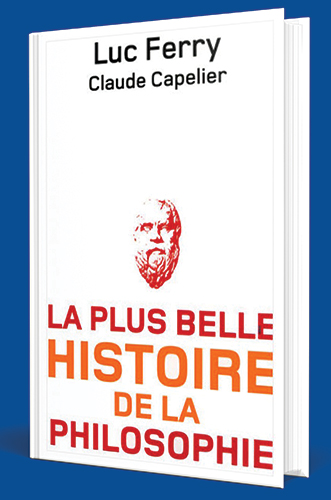 لقد تبين أن الأَنْسَنَةَ الأولى، أي أنسنة الأنوار والعلم المنتشي بنجاحات الانتصار، قد تعرضت في زمن التفكيك لأنواع حادة من النقد، نقد لم يكن حكرًا على الفلسفة العالِمة وحسب، بل طال السياسة أيضًا (إضافة إلى الإيكولوجيا) والحياة اليومية لدى الغربيين، ولكي نصير أكثر اقتناعًا بذلك، يكفي أن نراجع الحدود التي تغيرت فيها علاقتنا بالعلم منذ القرن الثامن عشر. حظي رد فعل ألمع المفكرين تجاه الزلزال الذي خرب لشبونة سنة 1755م، وأودى الموت بآلاف الأشخاص، بالإجماع والثقة، بيد أن ما أحرزته العلوم والتقنية من إنجازات وتقدم غير مسبوق، سيكون قادرًا مستقبلًا على تجنيب الإنسانية مثل هذه الكارثة.
لقد تبين أن الأَنْسَنَةَ الأولى، أي أنسنة الأنوار والعلم المنتشي بنجاحات الانتصار، قد تعرضت في زمن التفكيك لأنواع حادة من النقد، نقد لم يكن حكرًا على الفلسفة العالِمة وحسب، بل طال السياسة أيضًا (إضافة إلى الإيكولوجيا) والحياة اليومية لدى الغربيين، ولكي نصير أكثر اقتناعًا بذلك، يكفي أن نراجع الحدود التي تغيرت فيها علاقتنا بالعلم منذ القرن الثامن عشر. حظي رد فعل ألمع المفكرين تجاه الزلزال الذي خرب لشبونة سنة 1755م، وأودى الموت بآلاف الأشخاص، بالإجماع والثقة، بيد أن ما أحرزته العلوم والتقنية من إنجازات وتقدم غير مسبوق، سيكون قادرًا مستقبلًا على تجنيب الإنسانية مثل هذه الكارثة.

