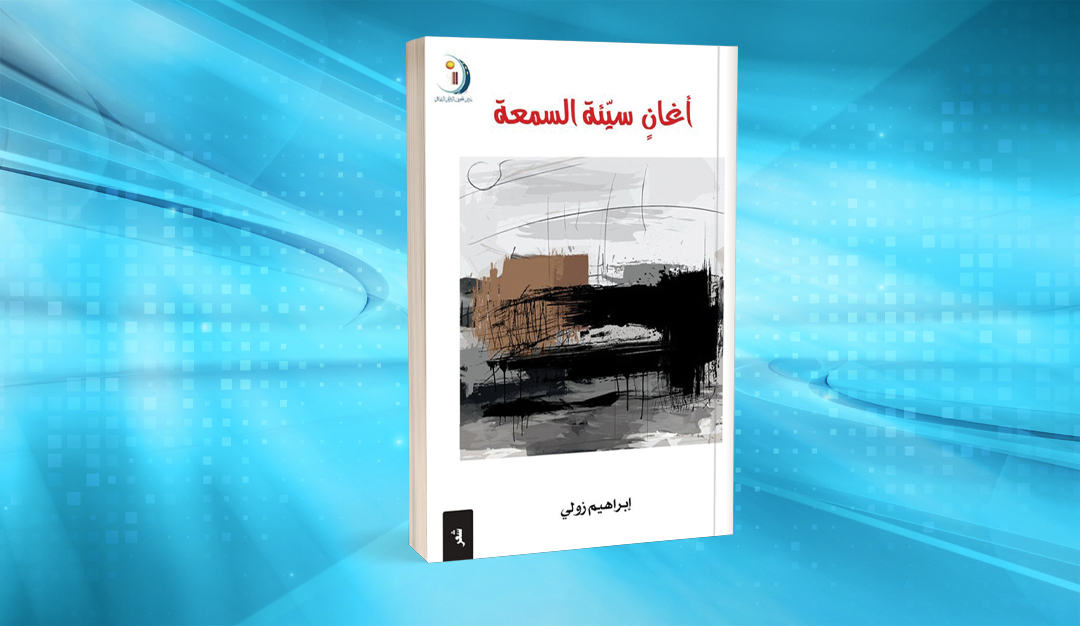
«أغانٍ سيئة السمعة» لإبراهيم زولي رفع الغطاء عن المضمر المحذوف
كتب ابن عربي في رسائله: «الحرفة حجاب على أعين الناظرين، وعلى عين المحترف، ولا يرتفع ذلك الحجاب حتى لا تتناول من كدك شيئًا». تذكرت ذلك في أثناء قراءاتي لمجموعة «أغانٍ سيئة السمعة» للشاعر السعودي إبراهيم زولي. فهذه المجموعة امتدادٌ مركز للاشتغال الفكري والذاتي على مركزية التجريب والتحديث في نصه الشعري، وهي كذلك ترسيخٌ مستديمٌ على الحفر الدؤوب وسبر ما وراء الملفوظات النصية، أو كما تقول المجموعة: «كعادتك في القراءة/ ترفع الغطاء عن المحذوف/ من الكلام، وتستحضر أنهار الأبدية/ لن تتأوّل أحاديث لزجة/ أو تلتقط إشارة كاذبة وتقفز مثل/ لاعب سيرك على السطور».
الوعي الفردي والفني
النصوص في المجموعة نتاجٌ ليقظات شعورية وعقلية تجاه الذات ومحيطها وعوالمها وواقعها. والنصوص قد تمرست عبر خبرات مسبقة وقدرات مكتسبة ومعايشات تجريبية على التفرد برؤيا مستندة على أساسات من الثقافة المتشعبة سواء الموروثة أو الآنية، وعلى قواعد واعية بالزمن الحاضر وبالعصر المحيط بالنص ومبدعه وبالظرف الوسطي المعيش. فالشاعر إبراهيم زولي تميز بالنص ذي الوعي الذاتي والمتفرد في رؤاه، وكذلك بقدر من الوعي بميزاته الشعرية، ولديه المعرفة التامة بحدود مقدراته الشعرية، ويدرك الفرص المتاحة للنص المرغوب، ويستبصر جميع العقبات التي تجابه النص الفردي الرؤيوي. وزولي مُلمٌّ بالفرص، وبالقوى النصية الفاعلة وبالمؤثرات المهيمنة في عصرنا الحاضر، بمعنى أن النصوص هنا مستشرفةٌ للمنحنيات والمنعطفات التي سوف تسلكها آنيًّا، أو قد طافت بها مسبقًا، وهذا ما تشي به المجموعات السابقة وختامها هذه. «ربما لن تخطئ هذه المرة، فالعالم/ ديوان خالٍ من الشعر، والمحبون/ يوقدون نيراهم على حياة رطبة/ لا تمنح الأيام فرصة لتتصدق عليك/ كن سريعًا كنعاس الشهداء». «أكتب عن جسد يكافح من أجل/ حقوقه المشروعة/ عن طير يلتقط قمحة بمتعة فخمة».

إبراهيم زولي
الوعي يُستحضر سواء في نموذجه الفني الجمعي الذي يُعنى بطرائق وعادات فنية في كتابة النص، أو في نموذجه الفردي الذاتي من خلال الرؤى الفنية الخاصة لإنتاج النص المبدع عبر التطلعات الذاتية الإبداعية. وهذا التفاوت بين الجمعي والفردي ومن خلال التضادات البينية المؤدية حتمًا إلى ابتداءات التجريب، وقطعًا سيؤدي التقابل بينهما إلى التطوير والتحديث الواعي والمنضبط ابتغاء الوصول إلى النص الفني المثال؛ إذ لو كان الوعي الفردي الذاتي متساويًا ومتماهيًا مع الوعي الفني الجمعي، فلن نجد في النصوص اهتزازات اللذة الفنية في التلقي، فلا كينونة عندئذٍ للنص الفني الكمال.
فالتطوير نابعٌ من فرادة الرؤيا في النصوص، والتجديد نتاج تباين التعاملات النصية مع الظواهر الآنية، وكل ما سبق من اختلاجات سيؤدي إلى انفراداتٍ مطلوبة تقصي النصوص عن أشباح الجمود وعن ظلام الثبات والسكون، وستجعل المجموعة في منأى من القولية الميكانيكية في حين أن عجلة الحاضر تتسارع باغية التحديث الموزون، والوعي الفردي بكل ما يمتلكه من أفكار ومفاهيم وصور ذهنية، فإنه يدرك الخصوصية الزمانية والمكانية في الحاضر. والوعي الذاتي للمجموعة مدرك تمام الإدراك للمتغيرات المعيشة والمتواصلة. فالظرف المحيط ليس كما قبل ثلاثين عامًا، وهذا يستدعي بالضرورة نصًّا واعيًا ملبيًا استجابات نصية فنية تتواءم مع المتغيرات الظرفية المتسارعة، ويستلزم وجوبًا نصًّا خبيرًا في تعامله لإدارة وتنظيم ردود أفعال تتواكب مع التحديات والعقبات، وعلى النص الشعري أن يكون في قمة عطائه تامًّا غير منقوص، ومتألقًا غير مشوش. «عليَّ أن أرقص مرة واحدة على الأقل/ أن أتتبع الهاوية، والذكريات/ الذكريات الماهرة في اغتصاب العزلة/ في فتح الشبابيك المحرمة». «أولئك الذين يعتقدون ما كتبناه حقيقة/ استطاعوا الإفاقة قبل سقوط الأمنيات/ التي صنعناها من رغوة الكلام/ قبل تهور الكاميرا في/ اصطياد شراسة الغيب/ لا حاجة لمراثٍ لا تشبه حتفي/ مراثٍ لا تنزل الطرقات/ العامة، ولا تستظل بأعمدة النحيب/ لا حاجة لأغانٍ/ لا تسترسل في الفتنة».
بصمات ذات خصوصية
وبما أن المجموعة أداء لفظي ابتداء، فإن الوعي الذاتي فيها سيستثمر طاقاته الصوتية من خلال المفردة المختارة بدقة، والتراكيب المنتقاة بعناية، والتناصات الدينية الحاضرة، والموظفة جميعها في لغة أنيقة وصياغة رائقة، ومن خلال التراكيب الجمالية للتعبير عن ثيمات مستقصاة ومسكوت عنها في الخفايا، مع إبقاء الباب مواربًا للتحرش بالمضمرات المختبئة بقدر الذكر والحذف والإطناب والإيجاز من الأساليب. وهي بذلك تتجاوز الخطاب الشعري الأحادي، وتتخطى فضاءات الذاكرة التي استأثر بها المسكون من الوعي الجمعي العام. والوعي الذاتي ظل بدوره منفتحًا على عوالم وآفاق للتعبير عن مقتربات تواصلية إنسانية في داخل النفس وخارجها، والملفوظات سعت في تراكيبها حاوية تاريخ كتابات نصية مسبقة؛ لأن لكل قصيدة أو كتابة تاريخًا نصيًّا سابقًا من إنتاجات المبدع ذاته، أو حتى عند غيره مما سبق. وبقدر الإزاحة وبمقدار الزحزحة عن السوابق تكون قوة النص الفردي بعد امتصاصه وهضمه لما كان، وعندئذ تحلُّ التجاوزات النصية المرتجاة، ويكون التخطي المبتغى. «لكل امرئ مقام يهرب البرق إليه/ نزفٌ يحرض الإثم الأُجاج/ يقينٌ تنزع الهداية أظلافه/ لليقين أفكار شاذة يضرب بعصاه/ الحكاية، فتنفجر اثنتا عشرة غربة».
تتجلى في النصوص الهيمنة اللغوية، ولا أقصد بها اللغوية التواصلية مع المتلقين وحسب، وإنما المقصود هو اتكاء النصوص على الاشتغال الجمالي في الأداء النصي. وهي الوظيفة التي أشار لها هابرماس، الوظيفة الدالة على الهويات سواء على المستوى الشخصي النصي، أو على مستوى الهوية المكانية. فنحن من خلال تقليب نصوص إبراهيم زولي نستطيع أن ندرك من خلال اللغة النصية المستخدمة، هوية صاحب النص، أو كما نقول الأسلوب دالٌّ على صاحبه. وإذا عملنا مقارنات بين نصوص المجموعة فيما بينها، أو شرعنا في مقاربات بين المجموعة والمجموعات الأخرى، نستطيع العثور على بصمات ذات خصوصية، مع تسليمنا بالضرورة أن النصوص الفنية لا تمثل مبدعها تمام الانطباق كثيمات، ولكن ستبقى الوظيفة الدالة على الهوية الشخصية أو النصية حاضرة ودامغة، فالمبدع يعيش خارج النص واقعيًّا، وليس قابعًا في كل حذافير النصوص بشخصيته الحقيقية والبيولوجية التي نعهدها في حياتنا الاجتماعية.
