
الفلسفة وتجربة الرؤية عند موريس ميرلوبونتي
ينتسب موريس ميرلوبونتي إلى قبيل فلسفي يرمي إلى تخلية الفلسفة من ألبستها الدغمائية التي تزدري الحس والجسد، وتحبس دفقة الحياة في نسخ عقلية وتمثلات تضع العالم في خطابات ساكنة. بخلاف هذا النزوع إلى تقييد العالم بقيود التجريد، تسعى فلسفة ميرلوبونتي إلى تحقيق المشروع الفينومينولوجي الهوسرلي الذي يقتضي توضيح التجربة، وتركها تعبر عن معناها الخاص بها، لا عن الأحكام المسبقة للمعرفة العلمية والفكر المثالي((Edmund Husserl, Premières Recherches logiques. Prolégomènes à la logique pure, tome 1, trad. par H. Elie, éd. PUF, Paris, 1990, 3ème édition, p.171)).
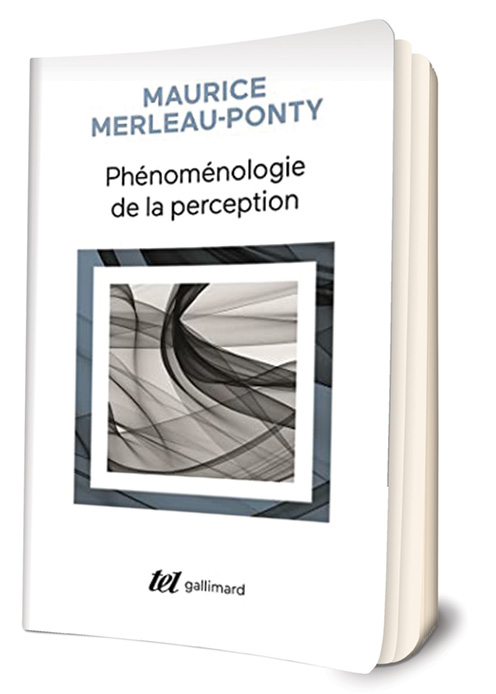 ولعل مأتى هذا السعي عائد إلى أن ميرلوبونتي يطمح إلى استبانة الشروط التي تمكن الإدراك والرؤية من النفاذ المباشر إلى عالم الأشياء والأحياء، كما يتقدم للإدراك في عريه الأول. والواقع أن فينومينولوجيا ميرلوبونتي قد بادرت- استنادًا إلى أعمال هوسرل- إلى التعبير عن هذا الطموح عبر حكمتها الشهيرة: العودة إلى الأشياء ذاتها؛ إذ انتهى الرجل في تنقيباته عن الصور الابتدائية للوعي القصدي إلى مطابقة الفلسفة بتجربة الرؤية، طالما أن الفلسفة، عنده، ما كانت إلا تجربة وقد طالها التوضيح، وأن «الفلسفة الحقة تدعونا إلى تعلم رؤية العالم وتجديدها»((Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, Coll. « Tel », Paris, 1945, p.21.)). بهذا المعنى، تنتقد فلسفة ميرلوبونتي تقليدًا فلسفيًّا يمتد بجذوره إلى أفلاطون، وهو تقليد يجد له صورًا حديثة (ديكارت وكانط بالخصوص) ومعاصرة (عند فلاسفة من طراز ألان وسارتر). إن ما يميز هذا التقليد هو مطابقته للفلسفة بفكر الرؤية، متناسيًا بذلك تجربة الرؤية التي يقوم عليها هذا الفكر.
ولعل مأتى هذا السعي عائد إلى أن ميرلوبونتي يطمح إلى استبانة الشروط التي تمكن الإدراك والرؤية من النفاذ المباشر إلى عالم الأشياء والأحياء، كما يتقدم للإدراك في عريه الأول. والواقع أن فينومينولوجيا ميرلوبونتي قد بادرت- استنادًا إلى أعمال هوسرل- إلى التعبير عن هذا الطموح عبر حكمتها الشهيرة: العودة إلى الأشياء ذاتها؛ إذ انتهى الرجل في تنقيباته عن الصور الابتدائية للوعي القصدي إلى مطابقة الفلسفة بتجربة الرؤية، طالما أن الفلسفة، عنده، ما كانت إلا تجربة وقد طالها التوضيح، وأن «الفلسفة الحقة تدعونا إلى تعلم رؤية العالم وتجديدها»((Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, Coll. « Tel », Paris, 1945, p.21.)). بهذا المعنى، تنتقد فلسفة ميرلوبونتي تقليدًا فلسفيًّا يمتد بجذوره إلى أفلاطون، وهو تقليد يجد له صورًا حديثة (ديكارت وكانط بالخصوص) ومعاصرة (عند فلاسفة من طراز ألان وسارتر). إن ما يميز هذا التقليد هو مطابقته للفلسفة بفكر الرؤية، متناسيًا بذلك تجربة الرؤية التي يقوم عليها هذا الفكر.
لذا نتساءل، إذا نهضت الفلسفة، حسب ميرلوبونتي، على تجربة للرؤية محلها الإدراك، فبأي معنى تكون هذه الفلسفة نقدًا لفكر الرؤية الذي يرى العالم بمنظور الفكر؟ وما أوجه الاختلاف بين «فكر الرؤية» و«تجربة الرؤية»؟ وإذا كان فكر الرؤية يذهب بنا نحو عالم الشيء في ذاته، فكيف تلتقي تجربة الرؤية بعالم العيش بما هو عالم الأشياء ذاتها؟
بين الفلسفة والرؤية
طغى على تاريخ الفلسفة- منذ أفلاطون- تصورٌ رأى فيها حوارًا داخليًّا بين النفس وذاتها((Platon, Théétète, tr. Émile Chambry, éd. Flammarion, Paris, 1967, p. 136.))، إذ عوض أن يدفع هذا التعريف الضيق بالفلسفة إلى النظر في عالم الأشياء والأحياء، اتجه بها عكس ذلك إلى ترسيخ القطيعة مع علائقنا الطبيعية بالعالم الحسي من جهة كونه عالم الظلال والضلال((Platon, La république, tr. Georges Leroux, éd. Flammarion, Paris, 2002, p. 350.)). فإذا كانت الفلسفة تعلمًا للموت، كما جرى تعريفها عادة، فإنها لن تكون سوى حوار للنفس مع ذاتها، وبالتالي يغدو الجسد والحس عائقين يتعين على الفيلسوف أن يتخلص منهما.
يقول أفلاطون: «يفصل الفيلسوف نفسه، ما أمكن، عن كل ارتباط بالجسد، وبكيفية تميزه عن الناس كافة»((Platon, Phédon, tr. Émile Chambry, éd. Flammarion, Paris, 1965, p. 113.)). يبدو أن ثمة تعارضًا بين الفلسفة والموقف الطبيعي من حيث كونه موقفًا أعمى، لا موقع له إلا في الكهف الأفلاطوني حيث لا يرى المرء من العالم سوى مظاهر مستمدة من الحواس التي ما تلبث تخدعنا، فتعوق وصولنا إلى رؤية الوجود الفعلي للأشياء. أكثر من ذلك، توشك أولية الرؤية (العقلية في الأغلب) أن تكون مسلمة في تاريخ الميتافيزيقا، بحيث يكون العقل في العرف الفلسفي الحديث نورًا طبيعيًّا، في مقابل النور الخارق للطبيعة (الوحي مثلًا). وبالنتيجة تكون العين وسيلة هذا العقل من أجل بلوغ أفكار واضحة ومتميزة((وفي اجتهاد متميز عملت الباحثة شانتال جاكي على إعادة الاعتبار للحواس، لا سيما حاسة الشم، وتبين الدور الأساسي لهذه الحاسة في عمليات الذاكرة وبناء الهوية، ولقد استفادت الباحثة في عملها من اجتهادات تيار فلسفي حيوي انطلق من أمبادوقليس وديموقريطس إلى نيتشه، وهو التيار الذي خلصت معه الباحثة إلى القول إن التفلسف معناه أن نمتلك أنوفا تميز بين رائحة الحقيقة والكذب. ينظر: Chantal Jaquet, Philosophie de l’odorat, éd. PUF, coll. « Hors collection », 2010.)).
 يبدو أن ثمة علاقة وشيجة بين الفلسفة والرؤية، ولربما هذا ما تنبه إليه كثرٌ من فلاسفة العصر الحديث، وعلى رأسهم ديكارت الذي لم يتردد في ربط الرؤية بفعل التفلسف ذاته. يقول ديكارت في رسالته إلى مترجم «مبادئ الفلسفة»: «أن نعيش بلا فلسفة، أشبه بإغماض العينين دون الإقدام على فتحهما أبدًا»((René Descartes, Principes de la philosophie, préface :« Lettre au traducteur », éd. Félix Alcan, Paris, 1886, p. 32.)). لكن، ماذا نقصد هنا بالعين؟ هل نقصد بذلك أن الفلسفة تتأسس على رؤية حسية فلا يكون ثمة من مبرر للتمييز بين فكر الرؤية وتجربة الرؤية؟
يبدو أن ثمة علاقة وشيجة بين الفلسفة والرؤية، ولربما هذا ما تنبه إليه كثرٌ من فلاسفة العصر الحديث، وعلى رأسهم ديكارت الذي لم يتردد في ربط الرؤية بفعل التفلسف ذاته. يقول ديكارت في رسالته إلى مترجم «مبادئ الفلسفة»: «أن نعيش بلا فلسفة، أشبه بإغماض العينين دون الإقدام على فتحهما أبدًا»((René Descartes, Principes de la philosophie, préface :« Lettre au traducteur », éd. Félix Alcan, Paris, 1886, p. 32.)). لكن، ماذا نقصد هنا بالعين؟ هل نقصد بذلك أن الفلسفة تتأسس على رؤية حسية فلا يكون ثمة من مبرر للتمييز بين فكر الرؤية وتجربة الرؤية؟
بالعودة إلى الحركة التأملية التي يعبر عنها كتاب «تأملات ميتافيزيقية»، نستطيع أن نجيب بالنفي؛ لأننا نكون أمام ذاتية تنفلت من انغراسها الابتدائي فيما يسميه ديكارت بـ «تجربة الحياة»(( ذكرته جونيفييف روديس لويس، ينظر: Geneviève Rodis-Lewis, Descartes. Textes et débats, Paris, Librairie Générale Française, pp. 365-367.))، لكي تحدد وجودها بالفكر، إذ من الصحيح أن تأملات ديكارت تنهض على أساس «تجربة الحياة» من جهة كونها الوضعية الواقعية للكائن، إلا أنها ما تفتأ تحلق بعيدًا من التجربة صوب عالم النسق والتمثل والخطاب. هكذا، تنتقل «التأملات الميتافيزيقية»، بحركة صاعدة من المعيش إلى الفكر، من صمت التجربة إلى كلام الفكر، من الواقعة إلى البداهة، لتنتهي إلى أولية لا تصح إلا في نظام التجريد والفكر، وهي أولية الكوجيتو بما هي أولية فكر الرؤية على تجربة الرؤية((Emmanuel de Saint Aubert, Le scénario cartésien. Recherche sur la formation et la cohérence de l’intention philosophique de Merleau-Ponty, éd. Vrin, Paris, 2005, p. 28.)).
عودة إلى العالم المعيش
يرفض ميرلوبونتي تحديد الفلسفة بفكر الرؤية، ويرى أن مركز الفلسفة لا يمكن أن يكون ذاتية متعالية، مستقلة، تحتل كل مكان ولا مكان، على شاكلة رؤية الإله((Eric Matthews, The Philosophy of Merleau-Ponty, edited by McGill-Queen’s University Press, Montreal, 2002, p-p. 23-24))، بل إن مركزها لا يكون إلا في «البداية الدائمة» للتأمل، أي في رؤية وحركة وتوجه الجسد الذي يشكل النقطة التي تشرع فيها كل حياة فردية في التأمل في ذاتها((Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p-p. 89-90.)). باختصار، لا تمتلك الفلسفة بوصفها تجربة للرؤية بداية ثابتة، على شاكلة يقين ذاتي أو بداهة عقلية صلبة (الكوجيتو)، بل إنها بداية متجددة، وذلك بمقتضى وجودنا في العالم، أي وجودنا الإدراكي الذي يحيل إلى انفتاح دائم للذات على العالم.
وبالنتيجة، يتعين على الفعل الفلسفي أن يكون عودة إلى العالم المعيش الذي يرد إلى الأشياء هيئتها الملموسة، وإلى الذات تجذرها التاريخي، ويسعف باكتشاف الظواهر، وإبراز طبقة التجربة الحية((Ibid, p. 83.))، حيث يكون بوسعنا أن نفهم كيف تتم الرؤية دون أن تنغلق في زاوية نظرها، ودون أن تكون مجرد إغلاق للمشهد الطبيعي من أجل النظر إليه بحسبانه موضوعًا((Ibid, p. 95.)).
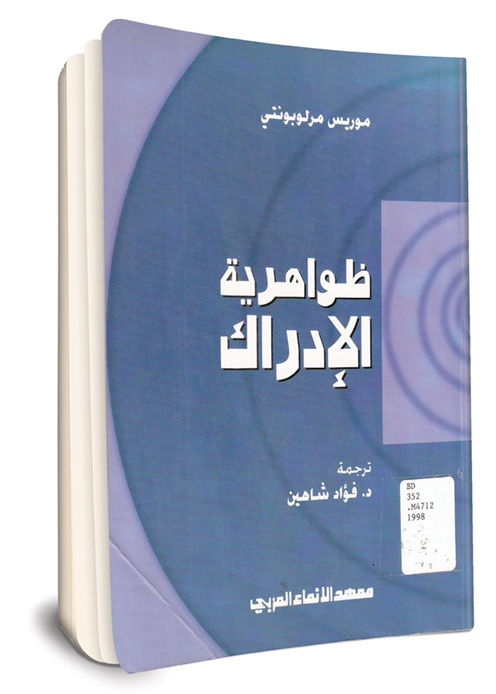 إن الفلسفة هنا طريقة في الرؤية، تشق أسلوبًا للنفاذ إلى العالم، يتخطى النظر الشفاف والمفتقد للآفاق، نحو رؤية ما تلبث تتوسع وتتجاوز آفاق المكان والزمان، فالنظر العادي أو العلمي لا يتجاوز حد التقاط موضوعه على الهامش أو تثبيته، إنه يفتقد للآفاق التي يحيل إليها الشيء في التجربة المعيشة؛ إنه نظر يجتث الأشياء من انغراسها الطبيعي، فيهمل إحالاتها الصارخة إلى تعالقات ابتدائية تكون شرطًا لبناء أي معرفة حول الأشياء في واقعها وتعقيداتها. على النقيض من ذلك، تكون الرؤية الملموسة الملقى بها في محيطها، أكثر وفاء لواقعها بوصفها رؤية منظورية، وللأشياء في رحابة ظهورها سواء على مستوى البعد المكاني أو البعد الزماني، لأنها رؤية مفتوحة على حضور عطاء لا يمكن استنفاد خزائنه اللامرئية. إن المعرفة هنا ليست تفسيرًا أو برهنة بقدر ما هي رؤية تتوسع باستمرار، فما تنفك تبتدئ وتستأنف نفسها.
إن الفلسفة هنا طريقة في الرؤية، تشق أسلوبًا للنفاذ إلى العالم، يتخطى النظر الشفاف والمفتقد للآفاق، نحو رؤية ما تلبث تتوسع وتتجاوز آفاق المكان والزمان، فالنظر العادي أو العلمي لا يتجاوز حد التقاط موضوعه على الهامش أو تثبيته، إنه يفتقد للآفاق التي يحيل إليها الشيء في التجربة المعيشة؛ إنه نظر يجتث الأشياء من انغراسها الطبيعي، فيهمل إحالاتها الصارخة إلى تعالقات ابتدائية تكون شرطًا لبناء أي معرفة حول الأشياء في واقعها وتعقيداتها. على النقيض من ذلك، تكون الرؤية الملموسة الملقى بها في محيطها، أكثر وفاء لواقعها بوصفها رؤية منظورية، وللأشياء في رحابة ظهورها سواء على مستوى البعد المكاني أو البعد الزماني، لأنها رؤية مفتوحة على حضور عطاء لا يمكن استنفاد خزائنه اللامرئية. إن المعرفة هنا ليست تفسيرًا أو برهنة بقدر ما هي رؤية تتوسع باستمرار، فما تنفك تبتدئ وتستأنف نفسها.
يبدو أن ميرلوبونتي يقطع مع اعتبار الفلسفة نظرًا تجريديًّا في العالم، لأنها تصير هنا تعلمًا ورؤية ملتزمة توجد سلفًا في خضم محيطٍ ليس عليها أن تؤسسه بقدر ما عليها أن تصفه، وتحكي عن تعالقاتها الابتدائية معه. لكن، يبدو أن تقليدًا فلسفيًّا بالكامل قد أخفق في تحقيق هذا المطلب المنهجي المتمثل في الوصف، وذلك حينما ذهب هذا التقليد إلى القول إن حقيقة العالم لا توجد إلا فيما زرعه العقل، أو إنها توجد في صورة متمثلة عن عالم ناجز ومكتمل، حيث ركن هذا التقليد إلى الاستعانة بإستراتيجيات ميتافيزيقية من قبيل الحديث عن التوازي بين النفسي والفيزيائي أو عن التناغم القبلي (لايبنتز)، أو مذهب المناسبة (مالبرانش) حيث لا نكون سوى فرص لتحقيق الإرادة الإلهية((Pascal Dupond, La réflexion charnelle :La question de la subjectivité chez Merleau-Ponty, éd. Ousia, 2004, p.15.)).
المتعالي والأرضي
لا توجد الحقيقة، في نظر ميرلوبونتي، إلا في العالم الذي يفتح عليه الإدراك، ويميط عنه اللثام النظر المتسائل. وبما أن الرؤية لا تسائل سوى الإدراك، فالحقيقة تولد، إن جاز التعبير، في مهد الحسي، فما على الفيلسوف إلا أن يولدها أو أن يرصد تفتحها آنَ تحققها، قبل أي قسمة معرفية بين الذاتي والموضوعي، أي في لحمة العالم ونسيجه. إن توليد الحقيقة بهذا المعنى لا يكون إلا عن طريق مساءلة الرؤية وتوسيعها، بكيفية مستمرة ودائمة. هكذا، ينبه ميرلوبونتي إلى أن الطريق الذي سلكته الفلسفة، ممثلة في المثالية، أي طريق التطابق بين العقل والشيء، والذات والموضوع، هي طريق غير أرضية، وإنما هي سبيل التحليق والمفارقة والتعالي، سبيل التحليق الذي لا يبالي برؤية الأشياء في وقائعيتها. خلافًا لهذه الطريق، يصرح ميرلوبونتي بأنه لا يمكن أن ننظر إلى الشيء والعقل في انفصال عن بعضهما بعض، ثم نبحث فيما بعد عن حل متعالٍ لاهوتي أو مفارقٍ، بغرض البرهنة ميتافيزيقيا على تطابقهما، بل إنه لا يمكن للعقل والشيء، للذات والموضوع، أن يكونا منفصلين تمام الانفصال((Ibid. p.16.))، لأنهما ينتميان ابتداءً إلى النسيج نفسه المكون للعالم، واللحم نفسه.((Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, éd. Gallimard, coll. « Tel », 1979, p.309.))
 هكذا، وإن بدا أن الفلسفة بوصفها رؤية تلتقي مع تاريخ الميتافيزيقا الذي يعلي من قيمة فعل الرؤية؛ فإن الأمر خلاف ذلك، وهذا من وجوهٍ عدة: أولها، أن الفاعل في الرؤية، في نطاق الفلسفات الثنائية (الميتافيزيقية)، هو النفس وليس الجسد؛ وثانيها أن فلسفة ميرلوبونتي لا تنحبس في مدار «فكر الرؤية» فقط، وإنما هي تساؤل جذريٌّ بشأن «تجربة الرؤية» عينها؛ وثالثها أن تجربة الرؤية متقدمة على المعرفة، لأن التعلم هو الذي يسمح، في نظرها، بتراكم المعرفة والفعل؛ ورابعها أن هذه الرؤية تتم في عالم العيش، أي في «العالم الذي يسبق المعرفة»، وليس في عالم الذات الإبستيمولوجية. لم تعد الرؤية مع ميرلوبونتي محمولة على النفس، بل صارت رؤية إدراكية جسدية، إنها رؤية ذات جسدية تعيش في عالم طبيعي واجتماعي يضمها ابتداءً، بالتالي، فالرؤية بوصفها تجربة إدراكية جسدية تتم في عالم قبل موضوعي، بل إنه لممكنٌ اعتبار «الوجود في العالم» مقولة رديفة لعبارة: «الرؤية قبل الموضوعية»، في حين يرادف «فكر الرؤية» عبارة «الرؤية الموضوعية المعرفية».
هكذا، وإن بدا أن الفلسفة بوصفها رؤية تلتقي مع تاريخ الميتافيزيقا الذي يعلي من قيمة فعل الرؤية؛ فإن الأمر خلاف ذلك، وهذا من وجوهٍ عدة: أولها، أن الفاعل في الرؤية، في نطاق الفلسفات الثنائية (الميتافيزيقية)، هو النفس وليس الجسد؛ وثانيها أن فلسفة ميرلوبونتي لا تنحبس في مدار «فكر الرؤية» فقط، وإنما هي تساؤل جذريٌّ بشأن «تجربة الرؤية» عينها؛ وثالثها أن تجربة الرؤية متقدمة على المعرفة، لأن التعلم هو الذي يسمح، في نظرها، بتراكم المعرفة والفعل؛ ورابعها أن هذه الرؤية تتم في عالم العيش، أي في «العالم الذي يسبق المعرفة»، وليس في عالم الذات الإبستيمولوجية. لم تعد الرؤية مع ميرلوبونتي محمولة على النفس، بل صارت رؤية إدراكية جسدية، إنها رؤية ذات جسدية تعيش في عالم طبيعي واجتماعي يضمها ابتداءً، بالتالي، فالرؤية بوصفها تجربة إدراكية جسدية تتم في عالم قبل موضوعي، بل إنه لممكنٌ اعتبار «الوجود في العالم» مقولة رديفة لعبارة: «الرؤية قبل الموضوعية»، في حين يرادف «فكر الرؤية» عبارة «الرؤية الموضوعية المعرفية».
