
سمية عزام - ناقدة لبنانية | يناير 1, 2025 | قراءات
الحياة لعبة سرد، مثلما أرادت نساء «أغنيات للعتمة» لإيمان حميدان، والسرد أول الزمان. فالحياة إذًا، لَعِب زمني؛ هكذا تكون المعادلة. والإطالة في الحكي، كما علمتنا أمنا شهرزاد، مد في خيط النجاة. وأول المكان في الرواية رسالة -علبة الذاكرة- تفتح غطاءها لتستهل بها الحكي قبل البدء. الرسالة، العتبة، ليست مخطوطة سرية مزعومة عثرت عليها الراوية لتعيد تأليف عالمها التخييلي استنادًا إليها، على غرار روايات الفروسية، بل هي كمقدمات الكتب القديمة تستبق السؤال بالإجابة عنه: لمَ تكتب؟ وعمن وعما ستكتب؟ والرسالة تجيب في ديباجتها عن سؤال: لمن ترسل ما تكتبه؟ وما زلنا في دائرة اللعب بين التقنيات التي توهم بالواقع، أو أنها تعيد تشكيله، باستعادة الصوت، وباستعارة لعبة «الماتريوشكا».
ماتريوشكا الحكايات والأنساب
الرسالة المستهَل بها «من أسمهان إلى وايدا»، التي تضع الحكي في إطاره التسويغي، ما هي إلا قصة الحكايات المسرودة، أو الأدق أن نقول: إنها سيرة مختصرة لسِيَر نساءِ أربع. السِّيَر الغيرية لنساء ينتمين لأجيال أربعة تكتبها أسمهان من الجيل الرابع وتوزعها على فصول، بغير أن تقصي سيرتها الذاتية في الفصل الأخير. مهما يكن من أمر هذه السِّيَر المستعادة، إن من الذاكرة وإن من خلال تسجيلات صوتية أو صور فوتوغرافية ورسومات ومذكرات ويوميات؛ فهي -أولًا- تضع تصورنا وجهًا لوجه أمام الدمية الروسية، «الماتريوشكا»؛ أي في مواجهة أرحام أربعة. فشهيرة الجدة العليا والدة ياسمين التي أنجبت ليلى، وهذه الأخيرة هي أم أسمهان الراوية ذاتية السرد. غير أنها سردت عن الجدتين والأم بصيغة الغائب، ولم تحسن سرد حكايتها إلا بصيغة المتكلمة. ولم تكن بدورها عاقرًا؛ فإلى جانب إخصاب الحكايات بالكتابة، فقد أنجبت تَوْءَمينِ، هما: كريم ولمى. ومع لمى الطفلة تبقى النهاية مفتوحة على ما لا يعد من مصاير وإمكانات.
 وإذا كانت الماتريوشكا لعبة أنثوية، فهي رمز متعدد الدلالات يذهب باتجاه الأمومة، والخصوبة، والتداخل، والتعدد في الواحد في حركتي التفكيك والجمع، وتعاقب الأجيال في اختلاف الأحجام، وليس انتهاءً بلعبة الظهور والإخفاء مع ما تتركه من إثارة للدهشة بعد كمون وانتظار. ولعبة السرد تسير باتجاهين في تفكيكها الحكايات، تمامًا كما تُفكَّك الدمية الروسية ويُعاد جمعها. تطالعنا شهيرة -الدمية الأم- في الظهور السردي الأول، لتتناسل الدمى -استعاريًّا- لكل من بناتها المتعاقبة: ياسمين وليلى وأسمهان. غير أن مَن جمع الحكايات كانت الصغرى، انطلاقًا من إرادتها في كتابة الذات، فاختارت تحري الماضي بفتح الدمى وإخراجها الواحدة تلو الأخرى. وإذ ذاك يطالعنا السؤال الآتي: هل كتابة الذات منفصلة عن كتابة الآخر، أم إننا لا نفهم ذاتنا إلا من طريق اكتشافنا الذوات الأخرى؟ الإجابة طي السؤال!
وإذا كانت الماتريوشكا لعبة أنثوية، فهي رمز متعدد الدلالات يذهب باتجاه الأمومة، والخصوبة، والتداخل، والتعدد في الواحد في حركتي التفكيك والجمع، وتعاقب الأجيال في اختلاف الأحجام، وليس انتهاءً بلعبة الظهور والإخفاء مع ما تتركه من إثارة للدهشة بعد كمون وانتظار. ولعبة السرد تسير باتجاهين في تفكيكها الحكايات، تمامًا كما تُفكَّك الدمية الروسية ويُعاد جمعها. تطالعنا شهيرة -الدمية الأم- في الظهور السردي الأول، لتتناسل الدمى -استعاريًّا- لكل من بناتها المتعاقبة: ياسمين وليلى وأسمهان. غير أن مَن جمع الحكايات كانت الصغرى، انطلاقًا من إرادتها في كتابة الذات، فاختارت تحري الماضي بفتح الدمى وإخراجها الواحدة تلو الأخرى. وإذ ذاك يطالعنا السؤال الآتي: هل كتابة الذات منفصلة عن كتابة الآخر، أم إننا لا نفهم ذاتنا إلا من طريق اكتشافنا الذوات الأخرى؟ الإجابة طي السؤال!
ويضعنا السرد -ثانيًا- أمام تاريخ نسوي يفكك النظام الأبوي في شجرة الأنساب؛ فالانتماء هنا إلى الأم، وشجرة آل الدالي زرعتها -مجازًا- أمّ وزكّتها ونمّت أغصانها نسوة، مع كل ما حملن من قهر وعنف وخوف وعزم. وحين نقرأ حكاياتهن نتساءل: لِمَ تكره النساء الحروب؟ وأيّ الحربين أقسى عليها: الحرب العسكرية-الأمنية أم الحرب الاجتماعية-النفسية؟ الحرب على الجسد أم الحرب على القلب؟ حرب الوجود أم حرب حضور الموجود؟ في الواقع، فإن كل من هذه الشخصيات المؤنثة وجدت معادلتها الخاصة للبقاء والاستمرار في العيش.
معادلة شهيرة: انحباس الدمع وإطلاق الصوت بالغناء
هي المرأة المؤسِّسة. شاءت الظروف أن تكون أمًّا لطفلين قبل أن تنجب أولادها. نمت «كنبتة برية»، وحين ابتعدت من قريتها وأهلها، لم تحمل معها من أمكنة الطفولة سوى الغناء وما تبقى في الذاكرة من طقوس الزرع والحصاد وأهازيجه. علمتها الحياة حكمة الاحتيال عليها وعلى الرجل. ما يميز هذه الشخصية إمكانية التعامل مع المواقف وتدوير الزوايا. «كانت تقاتل على جبهات عدة» في ترويض الرجل وترويض القدر. وقد نجح القول الروائي في التدليل على صلابتها بأن منحها القدرة على حبس دمعها؛ فشهيرة لا تظهر دمعها وإن انفطر قلبها حزنًا وألمًا. وهي على هذا النحو، تعمل وفق قاعدة: إن لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون؛ واعمل جهدك لتغييره وفق ما تطمح ليكون.
اقتضت معادلتها أن تستحضر الغائب والمشتهى من صور وأصوات وأهازيج وروائح في لحظات تثقل عليها بوجودِ ما أو من لا ترغب في حضوره، وهو واقع محتوم عليها تقبّله. هي معادلة العيش في الغياب وسط الواقع، وبغير نفيه أو نفي الذات منه. تجاوُب الصدى لهذه الشخصية جاء بتكرار نموذج يتخذ بعض ملامحها في الحفيدة ليلى. لكن الجدة لم تشأ تكرار الخسران بفقد الحلم بالتعلم الجامعي؛ فلا بأس بتقديم المعرفة على شؤون القلب والخيال، وإن كان حزن القلب ما زال جرحًا يحفر في ذاكرتها. تذكّر الحفيدة، باستمرار، بضرورة متابعة دروسها وترك ما عداها من روايات وأغانٍ جانبًا؛ فتقول الراوية: «في تلك اللحظات كانت شهيرة تبدو غريبة عن نفسها، بعيدة من صوتها وعن الغناء الذي أحبّت» (ص101).
لم تمنحها الحياة الحب الذي شاءته، ولا المصير الذي رغبت فيه؛ فلم تستطع أن تنقل الحب كما ينبغي إلى أحد؛ فأعادت إنتاج القهر على غيرها من الإناث. لم تتزوج بيَزيد الذي أحبته، وعرفت معه وحده لذة الحب، ولم تغدُ مدرّسة كوالدته التي تأثرت بها. رضخت لعرف اجتماعي بتزويج ابنتها ياسمين إلى ابن عمّها غسّان، بغير استشارة القلبين، واستمرت في النهج نفسه مع حفيدتها ليلى بالسير مع مصلحة العائلة بتزويجها من المغترب الميسور سالم. ومع شهيرة نتذكّر مقولة نفسية مفادها أن فاقد الشيء لا يعطيه. وربما أعطته على طريقتها، كما أحبت هي الحياة، فوجدت -ببراغماتيتها- أن القوة في العلم والمعرفة والعمل، لا في العاطفة والقلب؛ وهي التي خمنت أن الحب وهم، وأن «كل حب لا بد أن يلتهمه النسيان» (ص28). لم تبكِ ابنتها ياسمين حين ماتت، بل حامت حولها كما الفراشة في رقصها حول النار، وأطلقت صوتها بالغناء.. إلا أنها في أرذل العمر بكت لأول مرة، حين باتت الخسارة شاملة.
معادلة ياسمين: النجاة بالصمت
لم تجادل ياسمين القدر؛ لاذت بالصمت، بل بأكثر منه، بالقبول والتسليم. فهي مختلفة تمامًا عن والدتها شهيرة لجهة المثابرة والعناد والشجاعة وحسن التدبّر. حالما أنهت المرحلة الابتدائية من دراستها، وبفضل إصرار والدتها، تقزمت أحلامها إلى تأسيس عائلة. قتلتها أمومتها، كما تعبر الراوية، كاتبة السيرة. فحياتها القصيرة مع زواج مدبّر، لا يخلو من جو معذِّب لشخصية الزوج غسان الضعيفة في حسم القرارات واتخاذ المواقف، تمخضت عن ابنة جاءت سببًا لوفاتها إثر الولادة. القهر الذي عاشته ليس غريبًا عن البيئة الأبوية والهيكلية الذَّكرية للعائلات في المجتمع؛ حيث التحكم بقرارات الأبناء والأحفاد سائد من قبل الجيل الأول. وعليه عاشت في جو مسموم بالمشاحنات؛ فتسر إلى نفسها متسائلة: «هل الحلم بحياة أفضل صعب إلى هذا الحد؟» (ص70).
لم يمنح السرد ياسمين في معمارية الرواية سوى فصل واحد، لحياة مرسومة، شبه مهمشة وقصيرة. لكنّ للصمت معانيَ، وللغياب فاعلية حضور في فصول حياة كل من الابنة (ليلى) والحفيدة (أسمهان)، والأم (شهيرة) جميعًا. ففي صمتها إزاء العنف واللاتفاهم، إيجادُ صيغةٍ للعيش وسط جحيم عائلة ضيقت عليها رؤية أمها، لتعيش هي نفسها حياة يُتم في وجه ما. وفي صمتها النهائي -بموتها- بلاغة الخسران والفقد وشعور الابنة الدائم باليُتم: «ترعرعت في بيت يخيم عليه شبح الفقدان.. رسمت في خيالها صورًا متعدّدة لأمها حتى بات من الصعب معرفة الصورة الحقيقيّة لتلك الأم الغائبة. هناك حياة لم تعشها، فقدان لن يعوضه أي شيء» (ص94 و157). صمت ليلى نخالُه ينطق بلفظ واحد: «لو»، لو بقيت ياسمين حية! لاستتبعته الاحتمالات والممكنات السردية.

معادلة ليلى: احتقان الكلام وانعتاق الخيال
وإذ رغبت ياسمين في بنت تشبه أمها شهيرة، استجاب القدر لرغبتها. إنما تمرد الابنة -ليلى- اصطدم بواقع هشم حلمها في السفر ومتابعة دراساتها العليا، وبهجر حبيبها يوسف لها، ومن ثم بعنف زوجها سالم (الجسدي واللفظي) وبإلزامها به زوجًا لها، فلاذت بالصمت هي الأخرى. صمت المرأتين يختلف في الجوهر، وإن توحد في الغاية. فالأم صمتت قبولًا بالواقع، وهو ليس سوى رضى العاجز. والابنة رأت في الصمت «طاقية الاختفاء» من الواقع لتغييبه أو لمحو ذاتها فيه؛ فجاء صمتها باختيار، وبوصفه أحد إمكانات الحرية: «اعتادت الغياب منذ ولادتها. غياب الأم النهائي، غياب الحبيب، ثم ذلك الرجل الذي أصبح زوجها والذي يشبه غسان الأب الغائب هو أيضًا» (ص157).
لعل شخصية ليلى أكثر الشخصيات إشكالية. وبإمكاننا وصفها بأنها «وعي شقي»، تمامًا كما أسبغ جان واهل هذا الوصف على أب الوجوديين الفيلسوف سورين كييركيغارد. و«الوعي الشقي» يحدده هيغل بأنه ألم التمزق بين قطبين، مع إدراك هذا التمزق. فلم تعترف ليلى بالقدر ولا بالزمن. وإذ كان الواقع على غير ما تشتهي، اختارت العيش بين الكلمات، وفي عوالم الروايات تحديدًا. وربما تماهت مع من تقرأ: «كلما قرأت كتابًا تحلم، أو تحزن أو تذهب إلى النوم» (ص12)؛ فوقعت رهينة خلطها الواقع بالتخييل؛ لترتسم النتيجة مأساوية في مسار حتمي. في اختيار كهذا، عاشت مغتربة، مع ما يصاحب الشعور بالاغتراب من يأس وقلق، ومن حاجة، تاليًا، إلى الوجود الحق. هذا المآل من العزلة ونوبات الاكتئاب، ومن ثَمّ الاختفاء لم يكن إذًا، بمعزل عن أسباب تضافرت لتفضي إليه.
أسمهان ومعادلة الكتابة: تهريب الأمكنة والحيوات في حقيبة سفر
البدء بخطاب الذات -ذات أسمهان- حتم ذهابها في رحلة عودوية إلى الماضي، ماضي نساء عائلة الدالي. فالسيرة الذاتية -كما تحسب- لا تُكتب بمعزل عن تاريخها، فهي غير منبتّة الجذور. وحين تكتب الذات حاضرها لا بد لها أن توجه أسئلتها إلى الماضي كي تمعن في فهمها هذا الحاضر؛ ذلك في توثّب رؤاها نحو المستقبل، لا لتجمد الماضي في استرجاعه. وهذا ما تفصح عنه أسمهان بالقول: «توهمت أن سيرة حياتي ستكون منقطعة عن حيوات النساء قبلي.. خلت أن حريتي الفردية ليست وهمًا.. لكن اكتشفت أن الواقع لم يتغير» (ص 13). فأي واقع تتحدث عنه؟
هي المرأة التي تزوّجت زواجًا مختلطًا -وشاءت الظروف الأمنية ألا يكون مدنيًّا- من مناضل أحبته (مازن) كان يدعو إلى محو الطائفية عن بطاقة الهوية؛ إلا أنه طبق الشريعة حرفيًّا بزواجه من امرأة أخرى، ثم بتطليق أسمهان، وأخذ ابنها حالما أتم السابعة من عمره. فأمام المصالح الشخصية غُيّبت قيم العلمانية التي طالما تغنى بها. وهي المرأة التي ربيَت وسط عائلة لا سعادة فيها؛ إذ كانت تظنها موجودة خارج البيت وليس بداخله. وخُيّل إليها أن «هذه هي طبيعة العائلات: أب دائم الغياب وحين يحضر يصبح عنيفًا» (215). وغياب الأم -الحاضرة الغائبة- لم يكن أقل وطأة عليها: «أفتقدُ أمي ذاك الفقدان الذي لم يبدأ فقط منذ رحيلها، ولكن منذ وعيت على الدنيا واستحال عليّ الوصول إليها كأمّ. حين اختفت انتبهتُ إلى أنّنا لم نقُم بأيّ شيء معًا» (ص229).
وهي حفيدة امرأة ماتت بسبب أمومتها، فأورثت ابنتها الشعور الدائم بالفقد والخسران، وغيبت عنها نموذجًا متكررًا لبناء أسرة؛ فسرعان ما تتعبها أمومتها حالما تظهر. وهي تنتمي إلى الجدة العليا -شهيرة- التي تمتلك شخصيتين: «واحدة تقاوم كل شيء من أجل الحياة، وأخرى تعيد كل شيء إلى ما يجب أن يكون عليه وفق قيم المجتمع» (ص103). وقد تكون أسمهان الوحيدة، من بين نساء العائلة، مَن تزوجت بمن تحب، ومن وُلدت نتيجةَ حب، فهي ابنة يوسف لا سالمٍ. وعلى الرغم من حرية اختيارها تلك لم تمتلك مصيرها، وقد تكون مأساتها أعمق من أي منهن في خيبتها بالحب والحبيب.
التاريخ مكتوبًا من منظور نسوي
في المقدمات تجسدت أمام أعيننا الماتريوشكا برمزيتها في تثبيت نظام الأمومة في النسب، بتتبع القرابة في الخط الأنثوي، وفي تناسل الحكايات وإعادة إنتاج القهر، وإن اختلف في الشكل والدرجة من حالة إلى أخرى. غير أن الدمية الروسية هذه تختزن اليُتم -الفيزيقي والمعنوي- وتورثه أيضًا بإعادة إنتاج الفقد وانحباس عاطفة الأمومة. فأسئلة الحاضر التي توجه إلى الماضي لمساءلته، هي لتكرار ما ينبغي تكراره، وإقصاء ما ساهم في النيل من السعادة، السعادة الفردية والعائلية. فثمة فكرة نواة توجز سيرة نساء العائلة، ولعلها سيرة كثيرات من نساء بلادنا والعالم، مهما اختلفن في المصاير وطرق العيش؛ إذ ما يجمعهن ويلتقين عليه، هو «العطش إلى الحب».
حين وجدت أسمهان معادلتها بالهجرة وبالكتابة تاليًا، عِوض الجنون أو فقدان الذاكرة أو الانتحار أو السكر كبدائل لدى الشخصيات الأخرى، لتنجو من الحرب ومن حرمانها ابنتها على حد سواء، وضعت في حقيبتها ثلاث صور لأمّها، ودفاتر مذكرات هذه الأخيرة، وما دونته هي بنفسها من أحاديث مع نساء عائلتها، قائلة: «صارت حياتي هون بالشنطة» (ص249). فهرّبت بذلك الأمكنة والوجوه في حقيبة السفر لتبدأ بإعادة كتابة التاريخ. هو ليس تاريخ نساء العائلة، بل تاريخ القرية والمدينة، العاصمة والمناطق بتحولاتها وتناقضاتها وأحداثها السياسية ومفاصلها الأمنية في لبنان على مدار قرن من الزمان؛ بدءًا بالحرب العالمية الأولى واكتساح الجراد والمجاعة، وموجة الهجرة العظمى من الجبل وبيروت، مرورًا بالانتداب الفرنسي ثم خروجه واستقلال دولة لبنان الكبير، وبالحرب الكبرى، مع ما رافق تلك الحقبة من صعود أحزاب وتنازعات سياسية، وبروز الداهشية ومعتنقيها، وملاحقة أنصار الحزب القومي السوري الاجتماعي بعد إعدام زعيمه، فضلًا عن تداعيات إفلاس بنك «إنترا»، والحراك الشعبي لدى أيّ منقلب، وغضب الشارع مع عبدالناصر ولموته، وليس انتهاءً بدخول الدبابات الإسرائيلية بيروت، وبالحروب الأهلية المتواترة.
كتبت أسمهان لتقول لنا: إن المرأة مرآة الزمان ووجه المكان. وعليه، لنا أن نسأل: أوجدت الراوية ذاتية الحكي بعض سعادة بالكتابة؟ وهل حرّرت شخصياتها من الاختناق بصمتها حين أطلقتها من علبة الإخفاء؟ إن هذا التاريخ النسوي المتخيل يطرح إشكالية كتابة التاريخ الموازي؛ فماذا لو كتبت المرأة التاريخ الحقيقي، ومن منظورها الأنثوي؟

سمية عزام - ناقدة لبنانية | مارس 1, 2024 | قراءات
يكتب سهيل العطار في رواية «العرافة» للروائي اللبناني أحمد علي الزين، قائلًا: إن الحزن هو المطلق، وكل ما سواه نسبي. والعطار راوٍ ذاتي السرد، يضعنا في أجواء سيرتِه، وعكازُه الحنين. لكل كاتب قلقه ويقينه، وإذا كان وجود الرواية «وجودًا بالفعل»، بتعبير فلسفي، فإنها قبل هذا التحقق كانت سؤالًا في وجدان صاحبها، «وجودًا بالقوة». وفيما تخط للقارئ دروبًا لإجابات ممكنة، تتخذ ماهية «الوجود بالاختبار»، اختبار المعنى في وجوداتها الثلاثة. ويفصح العطار أن «العتبة هي مدخل المعنى». وعتبة النص هي صفة أطلقها على حبيبته نهلة الشهوب، أو ننسون. والحبيبة العرافة تنبئ بما سيأتي. وإذ تستبق الزمن، ترسم علاقته بخطوط اليد وبالقلب.
الزمن إذًا، هو عتبة المعنى، ومدخلنا للقراءة. وغالبًا ما تكون علاقاته مثلثة: ماضٍ حيث يسود التذكر، وحاضر يجلله الانتباه، ومستقبل فُطر الإنسان على التطلع إليه وترقبه وتوقعه. هذا تمامًا ما يقودنا؛ حيث البدايات تطوي النهايات، والوقت يسير القهقرى، في طرق ذكريات وحنين لا تفضي إلا إلى الذات، تؤثثها لازمة يكررها الراوي بتنويعاتها: «أنا هنا الآن في غرفتي»، معلنًا بذلك الإطار الزمكاني لوجوده، وانطلاقة بَوحه، من مستشفى «دار الفردوس».
بالحب يُبنى العالم، وبالفقد تُشيد عمارة الكتابة
تؤسس هذه الثنائية بنية الرواية: الحب بتجلياته الشخصية والعامة، والفقد مع ما يتبعه من حزن وحنين. بل الأدق قولنا: إنها ثنائية الإقامة والرحيل. من هنا، حيث يقيم سهيل في النهايات، تقيم الذاكرة في البدايات. للعطار، أستاذ الفلسفة القابع في المأوى منذ سبع سنوات، صديق فلسطيني، عادل الشوال، أستاذ التاريخ المنتسب لخسارتين: الأندلس وفلسطين. وما يجمع الأستاذين، وإنْ تُوُفِّيَ هذا الأخير، هو فائض الحنين والخيبات. فسهيل يعيش وحشتين: بفقدان سلمى زوجته القتيلة على خطوط التماس في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، وباختفاء حبيبته نهلة؛ إذ لا يكاد يميل القلب في منتصف العمر حتى تغادر.
 يقول عادل: إن حنينه سيقتله، ليجيب سهيل بالقول: إن حنينه لم يقتله بعدُ. غير أنه يرى الحياة سلسلة من الفقدان المولد للحزن. ومنذ الصفحة الأولى إرهاص بمصير الإنسان، حين يعبر سهيل -صغيرًا- عن رغبته لوالدته في أنه لا يريد أن يكبر. ويكرر أمنيته بعد حين: «وليتني لم أكبر». ويؤكد أن النهايات كلها مؤلمة؛ فليس من نهاية سعيدة إلا في الرغبات، وأن الهجر أقسى أنواع التعنيف للروح. نخاله يؤمن بلعبة الحياة التي تقود قصص الحب إلى الفراق في خواتيمها، أو أنه يسلم يقينًا بمصير مماثل حالما يقع، معللًا منطق الأشياء: «ما نبدؤه لتوه يؤسس لفقدانه».
يقول عادل: إن حنينه سيقتله، ليجيب سهيل بالقول: إن حنينه لم يقتله بعدُ. غير أنه يرى الحياة سلسلة من الفقدان المولد للحزن. ومنذ الصفحة الأولى إرهاص بمصير الإنسان، حين يعبر سهيل -صغيرًا- عن رغبته لوالدته في أنه لا يريد أن يكبر. ويكرر أمنيته بعد حين: «وليتني لم أكبر». ويؤكد أن النهايات كلها مؤلمة؛ فليس من نهاية سعيدة إلا في الرغبات، وأن الهجر أقسى أنواع التعنيف للروح. نخاله يؤمن بلعبة الحياة التي تقود قصص الحب إلى الفراق في خواتيمها، أو أنه يسلم يقينًا بمصير مماثل حالما يقع، معللًا منطق الأشياء: «ما نبدؤه لتوه يؤسس لفقدانه».
وعلى طريقة الراوي الذي يحب اللعب، ويلحّ على رؤية أي حدث كما لو أنه لعبة، يتلاعب بالمصاير إلاها الحب والحرب، إيريس وإيروس؛ والسر يكمن في حرف واحد زيادة أو نقصان، يُحيي أو يُدمر، وبه يُكتب التاريخ الشخصي والتاريخ العام. أمام إشكالية عمرها عمر الزمن الإنساني عندما خط أساطيره الأولى، تطرح الرواية سؤال خلاصية الفن واستشفائيته. وإذا كان جلجامش قد بحث عن عشبة الخلود حالما فقد صديقه أنكيدو، وإذ وجد سرابية بحثه، فكر في تشييد المدينة. وعلاوة على فن العمارة خُلدت مآثره في فن منقوش في ملحمة، هو الأبقى والرد الأجمل على هشاشته أمام الموت.
هكذا، أخذ سهيل بنصيحة أمه بأنه لا يُكتب كتاب إلا بعد الفقد. وعلى الرغم من اعتقاده بوهم الكتابة، فإنه يراه وهمًا جميلًا. ويعترف بأن اختفاء مَنْ أَحَبَّ هَدَّدَ رغبته في مزاولة العيش، لكن ما يكتبه من رسائل وأجزاء من سيرته، يعيد إليه الرغبة في العيش: «يبدو أننا نحتاج دائمًا لأحد نروي له حكاياتنا». يأخذ أيضًا بنصيحة والده عندما يقول له ذات مرة: «حين يرحل الأهل أو من تحب، يتصدع الجدار الفاصل بينك وبين الموت، تسقط الدفاعات الأخيرة. تابع المواجهة كي لا تهزم».
تصادي النوافذ ويقظة الحواس في مواجهة المحو
كيف واجه سهيل إذًا، هذا الطريق الممتد من الرحيل؟ هل بمزيد من الحنين؟ ويحق لنا أن نسأل عما إن كان الحنين يشفي في إنعاشه الذاكرة وتحريكه جسدًا في حالة موات، أم إنه لا يقود إلا إلى مزيد من الحزن! إذا ما تتبعنا حركة الحواس في جسد النص، عثرنا على بنية حسية، مشمومة ومرئية ومسموعة وملموسة فاعلة في حضورها. تعين سهيل العطار الثمانيني، وهو في كرسيه المُدَولب، على اقتفاء أثر من مروا في شريط الحياة واستقروا في البال. ونضيف إلى لازمته المكرورة عنصرًا مهمًّا، لتغدو على هذا النحو: أنا هنا الآن في غرفتي، أحس لأتذكر، وأستحضر الذكريات مجسدةً محسوسة.
لم يكن العطار في غرفة مغلقة، إنما مشرعة بنافذة على معهد الموسيقا قبالته، يسمع ويرى ويلوح بيده لبعض طالباته ويراسلهن. ونافذة أخرى مفتوحة على زملائه في قسم الاضطرابات النفسية، وهي نافذة مجازية. وثالثة تنفتح على أيامه وفق تعبيره. فالنوافذ الثلاث ما هي إلا منافذ للروح ومفاتيح للماضي المتدفق في الحاضر حيث يسير الوقت وئيدًا. يقول سهيل: «أتنقل بين ما أشاهده وأسمعه مباشرة في محيطي، وبين ما تحول إلى صورة في الذاكرة». أما بالنسبة للصوت والنغم الموسيقي على وجه الخصوص فمقامه رفيع في حياة هذا الرجل المتأثر بفراقيات جدته، وبعزف زوجته التي علقت لوحة فوق آلة البيانو خاصتها على جدار البيت، دُونت عليها العبارة الآتية: «عندما تسكت الموسيقا تتصدع جدران المدينة».
ويرى أن الصوت إطاره الكون كله، وله سرعة الضوء في قدرته على حمل الإنسان إلى الأمكنة النائية. إلا أن العطر أيضًا لا إطار له. ولعلاقة سهيل بالعطور امتداد تاريخي يعود إلى جده الذي أورثه اسم شهرته «العطار» وعطر السلالة. أما اللمس فقصته معه قصة يد ومنعرجات في الكف حين تلمسها يد الحبيبة ينتعش القلب: «عظيم هو اللمس، حاسة أقوى من النظر. يمكن أن ترى من خلال يدك». والأهم أن بصفعة من يد ابنه زرياب، وهو عازف، وصل إلى حيث يقيم. بملاحظة بدهية لهذا التكثيف الحسي/ الشعوري، أنه يماثل «صرة» (كزاد الراعي المربوط على عصاه) من أصداء وظلال ونسائم لحواس لا تترك آثارًا لخطوها إلا في الوجدان، وتواصل رحيلها.
تتبدى أبعاد ثلاثة للنوافذ في قصدية اختيار فني جدير بالانتباه. بُعد واقعي محايث لنافذة تطل على يافعات يرسمن مستقبلهن الموسيقي، تتغذى حواس العجوز عليها من سماع ومشاهدة، إذ يستعيد زمانه معهن. وبُعد نفسي في تواصله مع مَن كان من أصدقاء الماضي وبات في هذا المصح، على غرار الشاعر زمان، ورياض أستاذ العلوم، إضافة إلى قناص خطوط التماس التي شطرت بيروت إبان الحرب الأهلية، وقد يكون هو قاتل سلمى زوجة سهيل.
أما البعد الثالث للنافذة فهو استعاري، يتخذ دلالته من رمزية الانفتاح على الآخر داخل النص، وتجاوزًا له. التراسل مع رلى عازفة الفلوت وريتا عازفة الكمان في المعهد، مع ما يحمل رسائله من بوح ومرويات من سيرته يعيد إليه شغفه بالعيش وتقديره لوجوده. والبعد الانفتاحي الآخر نستعير لوصفه عبارة «التنافذ» لشاكر لعيبي. فنوافذ المستشفى والمعهد لا تبتعد كثيرًا من نوافذ الشاعر راينر ماريا ريلكه، عندما يفصح سهيل بالقول: «النوافذ هكذا تؤطر ما نراه ويصبح أبديًّا في الذاكرة، تشبه نافذة الشاعر ريلكه». وريلكه يعرف النوافذ بأنها وعاء الانتظار ومخبأ الودائع والموادعات، وبث الأحاديث للغائبين، الشرود وتمحص الوجود. ويرى أن الموسيقا تتجاوز الموت. ولا يتسع المقال لذكر نوافذ الراوي (الذات الثانية للروائي) على الآخرين من ابن عربي، إلى صموئيل بيكيت وغيرهما.

الخروج إلى المدينة: ماذا فعلنا؟ وما فعلت بنا الأيام؟
حين نتوغل في القراءة تنبثق أسئلة أخرى عن مآلات المبدعين ومن ساهم في تشكيل وجه المدينة. فهل من أحد يذكرهم؟ أو يكرمهم؟ وما الذي يجعلهم يخشون التقدم في السن؟ قد نلمح لدى سهيل إجابة ما تشبه اليقين بأن الأمكنة تحفظ ما يتمكن الزمان من محوه. في كتابة سيرته أو سردها على قارئ ضمني، يستحضر سير الآخرين، بل إن سيرته ما هي إلا جزء من سير أصدقائه، ومن تاريخ الأمكنة التي وضع معهم حجرًا في زاوية من زواياها. وإذ يترك بصمته قبيل مغادرته، تكون الأمكنة وناسها قد حفرت وشمًا في ذاكرته وآخر في نفسه. «كل صحبتي قتلوا بالحنين أو بالحزن أو بالرصاص… أتأمل في باطن كفي… صار الحفر عميقًا واضحًا… هكذا تصبح راحة اليد حين تتعب من الوقت ومن التلويح، ومن مهماتها النبيلة والسافلة».
المستشفى هو صورة مصغرة عن بيروت. عته الماضي وعنفه أفرزا هذه التشوهات، وجمعا الضحية والقاتل معًا، المجنون والعاقل، وجميعهم في العجز والهشاشة سواء. عن مجموعة المضطربين نفسيًّا في هذا الفردوس -بتسميته الساخرة- نجد صدى لقصة «عنبر 6» لأنطوان تشيخوف. تضعنا القصتان كلتاهما أمام مسألة تعريف الجنون إزاء العالم وأحداثه، وإزاء السلطة الاجتماعية. ولعل ممدوح عدوان، في دفاعه عن الجنون، خير معبر في هذا المقام عما تريد هذه السطور قوله: «في حياتنا شيء يجنن، وحين لا يُجن أحد فهذا يعني أن أحاسيسنا متبلدة، وأن فجائعنا لا تهزنا. فالجنون عند بعض منا دلالة صحية على شعب معافى لا يتحمل إهانة… اجعلوا الحياة من حولنا معقولة كي نظل بشرًا».
الحياة مسرح ونحن اللاعبون، حين نحضر تحضر اللعبة. هكذا تنبئنا الرواية حين تسدل الستارة. «وأسدلت الستارة في لعبة بيكيت على إله لم يصل. هذا هو العالم. كل واحد منا ينتظر إلهًا أو مخلصًا أو أحدًا يخرجنا من دائرة السكون». لكن ما حدث جاء أعلى من سقف توقعات سهيل. وسط هذا الموات للجسد وانكسار الروح، بقيت النوافذ مشرعة، والحواس ظلت حية في حركة لا تهدأ، ترسم «المكان الطريقي» (وفق تعبير جان بول سارتر)، إلى أن حان الوقت، وقت الخروج، منبئة باستعادة المدينة والقدرة على المشي معًا، المكان الطبيعي لهذه الذات التي سُلخت عن تاريخها الممتد لتنزوي في مساحة بحجم غرفة.
لم يكن للذاكرة وظيفة استشفائية فحسب، ولا للموسيقا والصوت والمرئيات والتداعي للمرويات، والتراسل، والروائح، وجميع ما ومن يسكن الذاكرة واستُدعي بفعل الخيبة والحنين، لم تكن جميعها عوامل بقاء على قيد الحياة ومقاومة لركود الزمن وضيق المكان فقط، بل كانت رحمًا يضطرم، ويؤسس في كمونه وانتظاره للخروج، للحركة وأفقِها: «أفسحوا الطريق، إني أسير». عاد إلى شوارع يتشربها نظره وتعبها روحه. فبانسلاخ سهيل عن أمكنة باتت جزءًا من كيانه انسلاخ عن الذات. وملاقاة الأمكنة ملاقاة الذات، على الرغم من نبرته التشاؤمية بقوله: «اللقاء الذي سيحدث هنا ليس لقاء حبيبين هو لقاء النهايات».
في حضور الأشياء والأشخاص في العوالم المعيشة وليس في الخيال هذه المرة، اختفاء لما أدى دورًا ما في هذا الاستحقاق. أدى وظيفته وتوارى خلف ستارة المسرح في لعبة الحياة كما يحلو لسهيل العطار أن يسميها، مستعيرًا من ستانيسلافسكي قوله: «إن كل ما يحدث هو لعبة ممثلين أفرطوا في الاندماج وبلغوا الحقيقة في أدائهم». فقد اختفى الحارس والشاعر زمان. والممرضة منى وبيتر عادا إلى المستشفى، ومعهما الكرسي، وقد رافقوه في رحلة خروجه من المستشفى. وبقي سهيل وحيدًا في المقهى بغير عكازيه أو كرسيه أو ممرضته. وكأننا به يقول: إن فائض الحنين نادى عرافته نهلة شهوب، فاستجابت للنداء الخفي، أقبلت إلى المقهى، وقالت له: قم. فقام، ومشى! هي طاقة الحب حين يصل إلى حدود الشوق وأبعد.

سمية عزام - ناقدة لبنانية | سبتمبر 1, 2023 | دراسات
في محبة بيروت كتب ربيع جابر خمس روايات بارزة. وقد يتبادر إلى ذهن القارئ في بادئ الأمر ثلاثيته «بيروت مدينة العالم» (الصادرة بأجزائها الثلاثة في الأعوام: 2003م و2005م و2007م). إنما لا يمكنه إغفال روايته «بيريتوس مدينة تحت الأرض» (2005م)، في أركيولوجيا المكان ودهاليز ذاكرة تضم من رحلوا، أو أن يتجاهل «تقرير ميليس» (2005م) في فزع سكان المدينة من التفجيرات المتلاحقة، وفي الهجرة يأسًا أو البقاء تشبثًا بوجود تاريخي لا يعوضه أي مكان آخر. وإن كان المكان مقومًا رئيسًا في السرد، فالزمان لا يقل عنه حضورًا في مشروع جابر السردي. وهو مشروع يحجز له موضعًا في الرواية اللبنانية التي اتخذت من الحروب المتلاحقة، في إرهاصاتها ومفرزاتها، خطابًا سرديًّا حفر عميقًا في الذاكرة والوجدان اللبنانيين.
بيروت في مرايا الذاكرة
الحروب اللبنانية المتكررة أيقظت في الروائي روح البحث عن البداية فوجدها في تاريخ لبنان السياسي والديني والثقافي؛ عله يعثر على منفذ للخلاص والتغيير. العنف صبغ تاريخ شخصياته، غير أن إيمانه بأن «الذاكرة التي تروى لا تموت»، وبأن «كل تعاسة مهما قست يمكننا أن نتحملها إن نحن رويناها كقصة» على ما يعبر الفيلسوف الفرنسي بول ريكور، دفعه في اتجاه اختيار طريق السرد. فمقاصد رؤيته تتبدى في تسريب القلق الوجودي إلى إدراك قرائه، لإيقاظهم وجعلهم يستشعرون وجودهم والماضي في خطوهم، وفي التحرر من طغيان الفكر الانغلاقي، وبلورة قيم مشتركة تتلاقى الجماعات الروحية عليها، في انفتاحها على الإنسانية. البداية إذن، غالبًا ما تكون في «إنسان المكان» وسط هذا المكان الحافل باصطخابه وتحولاته.

ربيع جابر
لبيروت حضور في جل روايات ربيع جابر، وستركز السطور التالية على بعض منها. في روايته «شاي أسود» (1995م)، تتحرك شخصية حسام المأزومة في شوارع بيروت، مع ذاكرة تهلوس في استعادتها الفقد والألم وأيام الملاجئ، في حركتين واضحتين بين شبكة مكانية بيروتية، وشريط زماني لذاكرة لا تهدأ. وكان للأكاديمية مهى جرجور قراءة فيها مقارنة مع رواية «الطيون» لأحمد علي الزين، في كتابها «الذاكرة والرغبة في الكتابة». وفي «البيت الأخير» (1996م)، وإن اتكأ في متخيله السردي على واقع مرجعي في رسم شخصية المخرج مارون بغدادي، فإن شخصية «ك» محكومة بذاكرة المدينة في مرايا متداخلة الوجوه والصور والشوارع والأبنية، تبحث عن توازن ما وسط عالم كل شيء فيه مؤقت وهش. والشخصيتان (ك وبغدادي) تمعنان في قراءة شخصية إسكندر المحورية في ثلاثية يوسف حبشي الأشقر، ولا سيما في الجزأين: «لا تنبت جذور في السماء»، و«الظل والصدى». ليس هذا فحسب، بل إن ذاكرة الراوي ذاتي السرد مسكونة بالشخصيتين المذكورتين.
بالمثل تطالعنا شخصية رالف رزق الله التي لقيت مصرعها أمام صخرة الروشة في بيروت، وهي شخصية ذات حضور مرجعي لأكاديمي وكاتب لبناني. يبحث الراوي ذاتي الحكاية في أسباب انتحارها ليس بعيدًا من ذاكرة بيروت المدماة بالمعارك، في عمله «رالف رزق الله في المرآة» (1997م). ولا ينسى القارئ بناية المبرومة التي ضمت في طبقاتها سبع عائلات نازحة ومهجرة من المناطق والضواحي بتفاصيل يومياتها في بدايات الحرب الأهلية (1975-1976م)، في رواية «طيور هوليداي إن» (2011م)، ولعله اختزل نصها في روايته اللاحقة المعنونة باسمها «المبرومة» (2014م).
متاهات العنف في «بيريتوس مدينة تحت الأرض»
بيريتوس اسم يحفر في التاريخ، وفي الحضارات الغابرة، فهو الاسم الإغريقي لمدينة بيروت. يصفها الراوي بأنها متاهة مدينة مطمورة تحت الأرض، موقعها كائن تحت بيروت الحالية. أما كيف دخلها الراوي ذاتي الحكاية واكتشفها، فذلك عبر حفرة انزلق فيها مطاردًا ياسمينة بثوبها الأبيض، متماهيًا مع شخصية بارزة من شخصيات لويس كارول، «أليس» التي طاردت أرنبًا أبيض في قصة «أليس في بلاد العجائب».
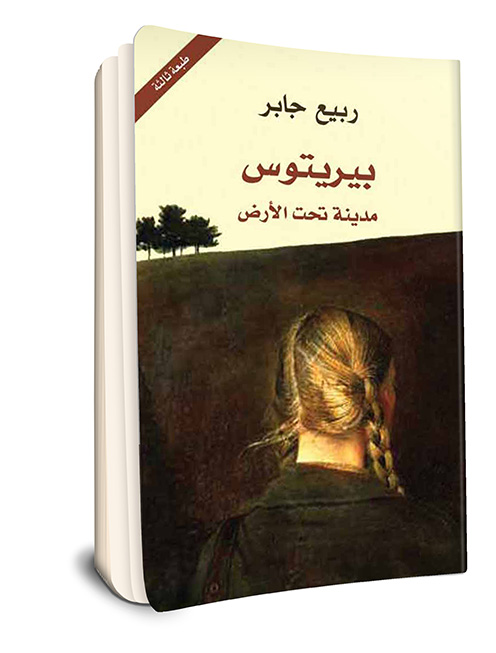 توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة.
توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة.
المتاهة هي شكل التيه لتقاطع طرق، بعضها مسدود بلا مخرج؛ فلا بد للتائه من البحث تاليًا عن مخرج. كان سبيل بطرس، طفلًا، للخروج مما تولده المعارك من ضيق هو الهروب إلى النوم، حيث يقول: «لماذا لا أذكر من الحرب كلها إلا نومي في الملجأ؟». يمني الراوي نفسه لو أن كل ما شاهده في بيريتوس منام لا حقيقة: «هذا كله منام طويل لن ألبث أن أستيقظ منه». ليس ذلك وحسب، بل يتصور أن الخروج من أنفاق الذاكرة الكابوسية قد يتأتى له في الكتابة، حين يحدث جليسه الروائي: «إذا أخبرتك القصة وكتبتها أنت في رواية صارت تبدو لي خيالية غير حقيقية، ولم تعد تفسد عليَّ نومي».
الشخصية الرئيسة الثانية هي شخصية ياسمينة، حبيبة بطرس، وقد استحالت رمزًا عندما شبهها بأوفيليا: «أراها تطفو مثل أوفيليا على وجه المياه. أنا الذي قرأت كل تلك الكتب لم تساعدني الكتب على احتمال الألم». وأوفيليا هي حبيبة هاملت، شخصيتان في مسرحية «هاملت» لشكسبير. أخفقت أوفيليا في إنقاذ هاملت من رغبته الجامحة في الانتقام، عن طريق الحب والغناء، لتسقط نفسها في البحيرة وترحل عن ذلك العالم المضطرب.
كانت ياسمينة أمل بطرس في الكهف البارد والمظلم في بيريتوس، مثلما هو أملها بالخلاص في الخروج من متاهة المدينة، حيث الزمن يتحجر. يرمز إليه بالساعة المتوقفة، والقنديل الذي لا يُضاء، المعلقان على الحائط الأبيض لبيت إسحاق، حيث قبع بطرس بعد سقوطه في الحفرة. الحائط نفسه استحال شاشة بيضاء تتلاحق عليها الصور، فيغدو سكان الكهف ظلال أشخاص في عالم من حركات خفِرة وأصوات هامسة ووميض أنوار خافتة، يدل ذلك كله على حياة تنضب وأرواح تتلاشى، بالتوازي مع اندثار مجد سينما سيتي بالاس. إشارة أخرى إلى سير الزمان وئيدًا، المكتبة الفقيرة بالكتب (عشرون كتابًا)، وقول إحدى الشخصيات: «الذي يتعلم هنا يصير شقيًّا… ما فائدة العلم؟». انحلال الحياة يرمز إليه أيضًا نضوب النهر الذي يغذي المدينة الجَوَّانِيّة، وشح الغذاء وفقدان كثير من المواد الغذائية، وهي إشارات استعارية تقرأ قراءة ثانية في خطاب بيئي ينجدل مع الخطاب السياسي-التاريخي.
أبواب الأمل موصدة، والحلم بالسماء مبتور، يقمعه الخوف من أمرين؛ أولهما: انطفاء الأعين إذا ما احترقت في الشمس، وثانيهما: عبور الأسوار لوجود «ناس الوحل» الذين لم يرهم أحد. ولفكرة ناس الوحل وإيهام الناس بوجودهم دلالة التسلط الاجتماعي الموروث، واستغباء السكان لاستبقائهم داخل الأسوار ومنعهم من ترك الجماعة والتفكير في الخروج. فرواية «بيريتوس» تزخر بالدلالات الرمزية، وتُحمل بمآزق زمكانية تستنطق الماضي. في عوالمها الغريبة يهرب الراوي مع شخصياته من ثقل الواقع ماضيًا وراهنًا، محذرًا من مستقبل بائس ومصير مشؤوم. فهي أمثولة الفكاهة المرة بالعودة إلى تاريخ تشكلها من سكان هاربين من حروب وقعت باسم الدين والعصبية الطائفية، فاختاروا العيش بغير دين، ومن دون علوم تفسد أفكارهم.
البينيات القاتلة في «تقرير ميليس»
عسى القارئ يستعيد أحداث هذه الرواية بُعيد تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020م؛ لأن محرك أحداثها تفجير «سان جورج» 2005م استهدافًا لموكب رئيس الحكومة رفيق الحريري؛ وقد وصفه الراوي أنه دائم المشي في شوارع مدينته، يتشرب بصره الأبنية، ويقول: «لا أحد أكبر من بلده». ولعله (القارئ) يستحضر عبارات جابر السردية الشهيرة: «ما هذه الحقيقة التي لا تُعرف أبدًا؟ لن يتحسن نومنا قبل أن يتكلم ميليس». وبات تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني ورفاقه) علامة على انتظار اللبنانيين لإشهار الحقيقة وإحقاق العدالة. والقاضي «أمام طريقين: يكشف الحقيقة أو لا يكشف الحقيقة.. المشكلة ليست فيما سيقوله التقرير، المشكلة ماذا سيحدث لنا بعد ذلك». تتعمق حالة الشخصيات البينية أكثر فأكثر بين رغبتها في كشف الحقيقة وعدم كشفها؛ «فقول الحقيقة يجر حروبًا عالمية». كل شيء مبهم وملتبس، يطرح أكثر من علامة استفهام تؤشر إلى مآزق متلاحقة: «فهل سيقول ميليس كل الحقيقة أم يختار منها ما يقتضيه التوازن الدولي؟».
المهندس سمعان يارد في الرواية، شاب ميسور عليل القلب، استحال رمز العبثية والعيش في اليوميات، حين ترك مشاريعه الأصيلة مترقبًا صدور التقرير. يشبه حاله حال سكان مدينته المسمرين على شاشات الفضائيات وأمام الجرائد. يصفه صوت أخته جوزفين في مناجاتها: «ما هذه الحياة الفارغة التي تعيشها؟ أنت معلق وحائر ومقسوم على نفسك». أو كما يخبر هو عن نفسه: «كأن إرادتي ليست لي. تحركت بليدًا كبزاقة أو سلحفاة. جسمي لم يعد لي». بات على مفترق طريقين؛ بين أن يبقى في مدينته على الرغم من القلق، أو أن يهاجر، ويلتحق بأختَيه في أميركا، كما فعل جل من يعرفهم.
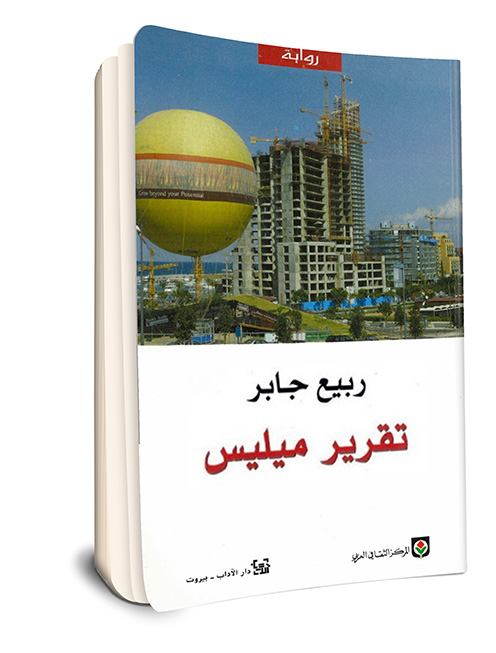 ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل».
ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل».
يتخذ الجرذ دلالة الفتنة الكامنة في إعلان إحدى الشخصيات أن «الجرذ الكبير إذا خرج من هذا العالم إلى عالم الأحياء قلب المدينة»، فخروجه ينبئ بالمآسي. يعضد هذه الدلالة رمزية الساعة الأثرية المعلقة في بيت سمعان للتكرار التاريخي والعَودوية: «تدق الساعة بحركة البندول منذ ستين سنة. لم تدخل محل تصليح ساعات. مرت كوارث وحروب عليها.. مالت واستندت إلى الدريسوار ولم تقع وتتهشم.. أثناء قصف الأشرفية صارت تؤخر، في حرب السنتين لم تتعطل، أثناء النصف الثاني من الثمانينات صارت تقدم.. يومًا بعد يوم تفاقمت أخطاؤها.. عام 1990م تم إصلاحها، وعام 1999م رجعت تؤخر لكنها لم تتعطل.. تدق دقاتها وتتكرر بصداها المعدني.. قديمة ساكتة تنظر ولا تنظر». فبحركة الساعة وسلامة دقاتها إحالة إلى سيرورة الحياة الفاعلة في المدينة، وبتأخيرها تقدم القهقرى. أما إذا تعطلت، وخشية سمعان أن تتعطل بفعل التفجيرات، فهو إيذان بوقوف الزمن وابتداء ساعة الصفر، ساعة حرب أهلية أخرى: «حين تتكرر الدقات المعدنية في بيت العائلة الفارغ، يشعر سمعان يارد أن الأشياء لم تتغير».
يطرح أحد سكان عالم الموتى سؤالين وجوديين: «كيف تعثر على قصة لحياتك، كيف تكتب قصة حياتك؟». فممنوع عليهم تمزيق الأوراق، كأن ما كُتب قد كُتب وانتهى الأمر، لا يُمحى ولا يزول. هوذا القدر! إذا كانت الورقة تمثل حياة الإنسان، في هشاشتها وسرعة تمزقها، فقد تكون البديل الهزيل عن الحقيقة. وفتح صفحة جديدة لتدوين قصة حياة أي من سكان عالم الموتى، يؤشر استعاريًّا إلى بدء عمل جديد ونسيان الماضي وضرب الصفح عنه. أما الظمأ المستديم إلى الماء فتناسبه الرغبة في الارتواء الروحي والفكري والإنساني. تقرير ميليس هو الحد الفاصل لاتخاذ القرارات، وكشف المصاير. عليه تتوقف الحياة أو به تتوقف: «الحقيقة ساكتة والناس يموتون». هي صرخة اعتصام بالعدالة والإنصاف إزاء القتل المعنوي في الترويع الممنهج، حيث تسود بَينية سالبة: لا حياة ولا موت، لا بقاء ولا رحيل، لا حقيقة ولا كذب، بل علامات استفهام تنتشر كالذباب على جبل النفايات في «برج حمود»، ومثل الجرذان التي تكاد تعبر من نهر جحيم عالم الموتى.
المدينة المسورة تغدو كوزموبوليتية
كانت بيروت مدينة مسورة، أو بلدة شبه مربعة؛ هذا ما يذكره الراوي في ثلاثية «بيروت مدينة العالم» كما يؤكده سمير قصير في كتابه «تاريخ بيروت»، (دار النهار، 2006م). في هذه الثلاثية يصور الروائي تحولات المدينة، بهدم سورها وتوسع مينائها وتجارتها، وتغير ديمغرافيتها بتوالي النازحين إليها، وفتح أبوابها الستة، وصعودها. يحكي بمحبة، فنخاله يحنو على المدينة، أو هذا ما يتسرب إلينا من خلال متابعة قصة درامية لحارة البارودي ومؤسسها عبدالجواد أحمد البارودي. وذلك طيلة قرن صاخب من الزمن، بدءًا بالربع الأول من القرن التاسع عشر مع وصول الشاب العشريني من دمشق إلى بيروت للاستقرار فيها، مرورًا بدخول العساكر المصرية، بقيادة إبراهيم باشا، واندحارها، وبالأوبئة والويلات التي حلت بقاطنيها، وانتهاءً بخروج العثمانيين. نجد لهدم سور المدينة على دفعات معادلًا في هدم سور الحارة، وانقراض سلالة عبدالجواد، فيخبر الراوي:
«حارة البارودي بسورها المستطيل.. هدمت على دفعات بين 1915م و1919م. أعمال الهدم لتوسيع دروب بيروت القديمة بدأها العثمانيون في مطلع الحرب العالمية الأولى، وأنهاها الإنجليز والفرنسيون بعد انتهاء الحرب بهزيمة الأتراك وخروجهم من بلادنا. أعمال الهدم أزالت من الوجود البيوت الأربعة التي بناها عبدالجواد، أزالت حارة القرميد التي رفعها ابنه الثاني عبدالرحيم».
فأي وجه للمدينة يريد الروائي؟ يؤكد إلحاح الروائي على موضوعات التدمير والحرائق نتيجة الحروب، وعلى قصور الرؤية السياسية، موقفَه النقدي، وقد عاين المخاطر المهددة هواء بلده ومياهه، وتربته، وجباله والمساحات الخضراء فيه. الأمر يتعدى الاعتداد بالسياحة الطبيعية في وطنه إلى الخوف على ناس المكان. وأكثر ما يُلمح هذا التوجس في روايتَي «بيريتوس» و«تقرير ميليس» اللتين كُتبتا في مرحلة متأخرة، أي خلال إعادة الإعمار وازدهار السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان. ولعل صرخته في متوالية أسئلة، خير معبر عن الأسى الذي يعتريه: «الأشجار قليلة في بيروت. كيف؟ لماذا قليلة؟ هناك شمس وسماء!».
حين بدأت مرحلة نهوض الدولة بعودة مؤسساتها وشرعيتها، تكشف عمق الأزمة فيما خلفته سنوات الحرب من تدمير متواتر لبيروت تحديدًا، بانت في الإمعان في التخريب من غير مراقبة ومحاسبة، ومن دون اشتراع خطط بيئية جادة. فمدينة بيريتوس تُحتضر، أتربة دائمة التساقط على رؤوس «الجَوَّانِيّين»، تطمر أحياءهم وتخنق بعضًا منهم، ومخلفات المصانع المتسربة إلى التربة ومجاري المياه الجوفية تسممهم. غارت مياه النهر وتلوثت بسلفات الحديد المتسرب من المعامل. وصار النهر أصغر من ساقية، واعتكر بالوحل وبمواد غريبة. ومن الأعراض التي ظهرت على السكان، تورم السيقان، وأورام في الحلق، وإسهال مميت، علاوة على معاناة العطش الدائم.
وفي أحياء بيروت (البَرَّانِيّة)، سببت المطامر والمكبات والمسالخ الأمراض للسكان المقيمين في محيطها. يذكر الراوي أسماءها في «تقرير ميليس»: «مكب العمروسية، وبرج حمود، والنورماندي، ومسلخ الكرنتينا»، ويعدد مفاعيلها؛ فهي تنشر الحشرات، وتسبب حساسية الربو، وأمراض العيون، وضيق التنفس لدى الأطفال والعجائز. كما أنها تبعث الغازات السامة والروائح الكريهة؛ فالمسلخ برميل غازات، والسكان لا يستطيعون النوم في الليل. الضرر إذن لم يصب هواء بيروت وشاطئها وبحرها وترابها فحسب، بل الطبقات الجَوَّانِيّة للأرض.
الخروج من المعتم إلى المضيء
ترهص الملفوظات السردية في رواية «يوسف الإنجليزي» بانعطافة تاريخية مهمة في المستويات: السياسي، والاجتماعي، والثقافي في الجبل اللبناني وبيروت، بمجيء الإرسالية الإنجيلية وتأسيسها المدارس في المناطق وبعض المدن، مثل دير القمر وعين عنوب وعيتات، وفي صيدا وبيروت. وإنشاء «الكلية الإنجيلية السورية» (الجامعة الأميركية اليوم)، والمرصد الفلكي (عام 1877م)، والمطبعة التي دُعيت بمطبعة الأميركان. كما أسست مدرسة البنات في «بيت الصوصة» في بيروت، تتعهّدها المسز شافرد، ويدرس مستر شافرد في مدرسة البنين. تزامن نشر الثقافتين العلمية والدينية مع صراع الولاءات إما للعثماني- الإنجليزي وإما للمصري- الفرنسي. وقد سطع اسم كارنيليوس فاندايك في نقل العهدين القديم والجديد إلى العربية في السنوات 1860م و1865م، وإنشاء المرصد الفلكي، واسم بطرس البستاني الذي عاون فاندايك في مشروع الترجمة، مثلما اشترك مع الدكتور عالي سميث في تأليف المعجم الإنجليزي- العربي. كانت نهضة علمية، وبداية التحول/ المنقلب الثقافي في ولاية بيروت ومتصرفية جبل لبنان.
 يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه.
يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه.
في «يوسف الإنجليزي»، سعى الضابط المصري محمود نامي، إلى تأسيس مدينة عصرية في الشرق تحاكي العاصمة الفرنسية باريس، فاختار بيروت. أنشأ دور بغاء تسهم في بعث الحياة الليلية، فاستقدم «العوالم» من خارج البلاد، وبخاصة بعد ازدياد عدد الجنود الأجانب، كما زاد عدد المشارب وبيوت الإفرنج. جُوبِهَ مشروعُه بالرفض من سكان بيروت الذين يرغبون في حياة هادئة كما ألفوها. يرون هذا التغيير في مدينتهم يتجه نحو الأسوأ لا الأفضل. فقدموا عريضة شكوى لإبراهيم باشا لإقفال سوق «العوالم». أما حين حضرت مشاريع الإنجيليين لتأسيس المدارس والمؤسسات العلمية، فرحبوا بها لإسهامها في نهضة المدينة والمناطق.
وفي «تقرير ميليس»، يبدو صوت الراوي مؤيدًا للحداثة، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، وعيه بصون ذاكرة المدينة. يخبر بأنه حين وُضعت المشاريع لإعادة إعمار بيروت، غُيبت خطة تقضي بالحفاظ على البيوت التراثية، وإعادة ترميمها، والإبقاء على مساحات خضراء فيها. اندثرت البيوت القديمة من حي «غندور السعد»، هدموها لترتفع مكانها أبراج الزجاج. أمست المدينة مريضة، وغابة من باطون مسلح، متشنجة في زحمة الحديد والزجاج والتنك، ومبانيها كما «علب السردين». يصف الأشرفية حين كانت غابة من شجر الجميز وجلول التوت والصبار والشوك. ويعرج على «حي السراسقة» التراثي، ومنزل سمعان يارد الكائن في حي «غندور السعد»، فهو ليس طارئًا على المدينة: «بيت عالي السقف، فسيح، فيه قطع أثاث قديمة وضخمة، كوة من زجاج ملون محجر مدورة، جنبات السقف فيها تخاريم- نقوش في الحجر. لا ضرورة لتشغيل المكيف، كان البيت يُغمر بنور الغروب.. أمامه سنديانة عمرها 85 سنة». فلا حداثة إذن لمدينة هجينة تتأسس على أنقاض ماضيها، وخواء ذاكرتها؛ لمدينة مبتورة الأصل.
يغدو الخوف شخصية محورية تستوطن الذاكرة في روايات ربيع جابر، ويحكم أفق الحاضر ليسطر ملحمة الذات الإنسانية. فللعنف وتنويعاته رائحة تتسرب وتنتشر في الكراهية والفساد والظلم والعبودية والدمار؛ هي رائحة واحدة، رائحة الرعب الكبير من أن تشيخ الذات وما زالت تحبو، ومن أن تعود الأمة المعتقة بالتاريخ إلى مرحلة الحَبو.
بيروت اليوم تشبه ساكنيها، لكنها لا تتماثل مع مراياها في وجدان من تسكنه. فأية قراءة لهذه المدينة، بما مر عليها، وبمن مر بها، لا تفصح. كتب ربيع جابر ما يشبه بيروت «المدينة» (بالألف واللام)، وحفر في طبقاتها المتعددة، ولملم مراياها الحضارية: مرآة في حب بيروت، تعكس وجوهًا بيروتية من داخل السور ومن خارجه. ومرايا حداثة «بيروتية» وانفتاحها، شرقيتها وغربيتها، كوابيسها وأزماتها، نهوضها وازدهارها، وأجيال الوافدين والنازحين الذين ضمتهم واستوعبتهم، فباتوا طبقة من طبقاتها. وليس بغير تبصر روائي أن يجعل صاحب «دروز بلغراد حكاية حنا يعقوب» (2011م)، وقد فازت بجائزة بوكر لعام 2012م، بنية روايته هذه -في مطلعها وختامها- من مرفأ بيروت منطلق الأحداث ونهايتها في تماهٍ مع رحلة أوليسيوس الهوميرية من حيث التجربة والمصاير والأسئلة حول ما يبدو عبثيًّا وموجعًا بعبثيته؛ ليستدل القارئ على معاني تلك التجارب.

 وإذا كانت الماتريوشكا لعبة أنثوية، فهي رمز متعدد الدلالات يذهب باتجاه الأمومة، والخصوبة، والتداخل، والتعدد في الواحد في حركتي التفكيك والجمع، وتعاقب الأجيال في اختلاف الأحجام، وليس انتهاءً بلعبة الظهور والإخفاء مع ما تتركه من إثارة للدهشة بعد كمون وانتظار. ولعبة السرد تسير باتجاهين في تفكيكها الحكايات، تمامًا كما تُفكَّك الدمية الروسية ويُعاد جمعها. تطالعنا شهيرة -الدمية الأم- في الظهور السردي الأول، لتتناسل الدمى -استعاريًّا- لكل من بناتها المتعاقبة: ياسمين وليلى وأسمهان. غير أن مَن جمع الحكايات كانت الصغرى، انطلاقًا من إرادتها في كتابة الذات، فاختارت تحري الماضي بفتح الدمى وإخراجها الواحدة تلو الأخرى. وإذ ذاك يطالعنا السؤال الآتي: هل كتابة الذات منفصلة عن كتابة الآخر، أم إننا لا نفهم ذاتنا إلا من طريق اكتشافنا الذوات الأخرى؟ الإجابة طي السؤال!
وإذا كانت الماتريوشكا لعبة أنثوية، فهي رمز متعدد الدلالات يذهب باتجاه الأمومة، والخصوبة، والتداخل، والتعدد في الواحد في حركتي التفكيك والجمع، وتعاقب الأجيال في اختلاف الأحجام، وليس انتهاءً بلعبة الظهور والإخفاء مع ما تتركه من إثارة للدهشة بعد كمون وانتظار. ولعبة السرد تسير باتجاهين في تفكيكها الحكايات، تمامًا كما تُفكَّك الدمية الروسية ويُعاد جمعها. تطالعنا شهيرة -الدمية الأم- في الظهور السردي الأول، لتتناسل الدمى -استعاريًّا- لكل من بناتها المتعاقبة: ياسمين وليلى وأسمهان. غير أن مَن جمع الحكايات كانت الصغرى، انطلاقًا من إرادتها في كتابة الذات، فاختارت تحري الماضي بفتح الدمى وإخراجها الواحدة تلو الأخرى. وإذ ذاك يطالعنا السؤال الآتي: هل كتابة الذات منفصلة عن كتابة الآخر، أم إننا لا نفهم ذاتنا إلا من طريق اكتشافنا الذوات الأخرى؟ الإجابة طي السؤال!

 يقول عادل: إن حنينه سيقتله، ليجيب سهيل بالقول: إن حنينه لم يقتله بعدُ. غير أنه يرى الحياة سلسلة من الفقدان المولد للحزن. ومنذ الصفحة الأولى إرهاص بمصير الإنسان، حين يعبر سهيل -صغيرًا- عن رغبته لوالدته في أنه لا يريد أن يكبر. ويكرر أمنيته بعد حين: «وليتني لم أكبر». ويؤكد أن النهايات كلها مؤلمة؛ فليس من نهاية سعيدة إلا في الرغبات، وأن الهجر أقسى أنواع التعنيف للروح. نخاله يؤمن بلعبة الحياة التي تقود قصص الحب إلى الفراق في خواتيمها، أو أنه يسلم يقينًا بمصير مماثل حالما يقع، معللًا منطق الأشياء: «ما نبدؤه لتوه يؤسس لفقدانه».
يقول عادل: إن حنينه سيقتله، ليجيب سهيل بالقول: إن حنينه لم يقتله بعدُ. غير أنه يرى الحياة سلسلة من الفقدان المولد للحزن. ومنذ الصفحة الأولى إرهاص بمصير الإنسان، حين يعبر سهيل -صغيرًا- عن رغبته لوالدته في أنه لا يريد أن يكبر. ويكرر أمنيته بعد حين: «وليتني لم أكبر». ويؤكد أن النهايات كلها مؤلمة؛ فليس من نهاية سعيدة إلا في الرغبات، وأن الهجر أقسى أنواع التعنيف للروح. نخاله يؤمن بلعبة الحياة التي تقود قصص الحب إلى الفراق في خواتيمها، أو أنه يسلم يقينًا بمصير مماثل حالما يقع، معللًا منطق الأشياء: «ما نبدؤه لتوه يؤسس لفقدانه».


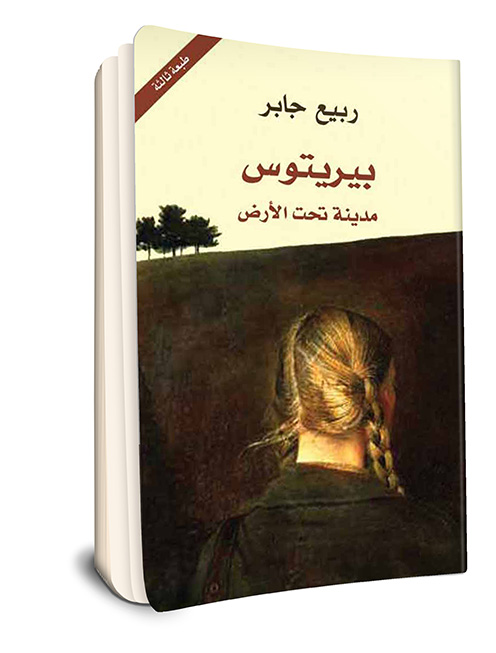 توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة.
توجد هذه الحفرة في خربة «سيتي بالاس»، الأثر الماثل من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، والكائنة على خط التماس الذي يقسم بيروت بين شرقية وغربية. لهذا المعلم رمزيته الدلالية التي تحيل إلى الذاكرة الكابوسية للحرب، ذاكرة طفولة بطرس الراوي المعذبة. يُخبر هذا الأخير عن أهل بيريتوس ومأزوميتهم ومأزقية المكان المهدد بالانهيار والتلوث. وما دهاليز المتاهة الأرضية وطبقاتها إلا طبقات الذاكرة وتلافيف الدماغ؛ حيث يصفها بأنها منخورة، مجازًا، بسوسة المنخوليا وهي «مرض الاكتئاب الشديد»: «إذا دخلت سوسة المنخوليا إنسانًا سكنت قلبه. إذا بلغت المخ صارت تأكل المادة الرمادية، وتقضم التلافيف الطرية التي تشبه الدهاليز، وتتغذى على الذكريات والأحلام والخيبات، وتنمو كالدودة». فناس بيريتوس ليسوا غير أطياف من خُطفوا وفقدوا، كما هي حال إبراهيم ابن خالة بطرس المخطوف، وقد عثر عليه في المتاهة. 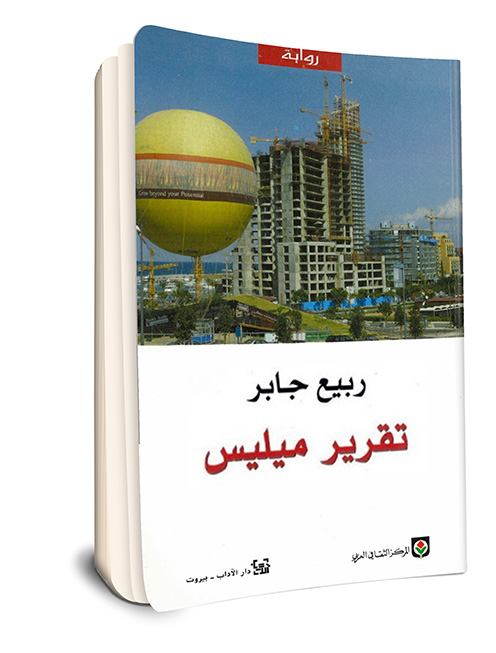 ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل».
ومن دلالات البينية انشطار الفضاء الروائي إلى عالمين: عالم الأحياء، وعالم الموتى. لتشتبك مآسي الماضي بآفاق الحاضر المرعبة. هذا الربط بين الحياة والموت أدت دلالته شخصية جوزفين القتيلة في زمن الحرب الأهلية، تناجي أخاها من عالمها الآخر محاولةً مهاتفته. فالهاتف بين عالمَي الأموات والأحياء يرنّ كثيرًا في منزل سمعان. آلة الاتصال هذه لها رمزية الخشية من الاستجابة للفتنة التي تعيد ذكرى مأساة الحروب السابقة؛ كأن الموتى يراقبون ويشهدون. أضحى الموت قريبًا جدًّا قربَ رفع السماعة للرد على المتصل. كيف إذا ما كان هذا المتصل ينتمي إلى عالم الموتى؟! ذلك، فضلًا عن وجود التلفزيون أحادي الوجهة في عالم الموتى، إذ بوساطته تتابع جوزفين أحداث عالم الأحياء. وهي بدورها عالقة بين عالمَي الأموات والأحياء؛ لأن الجرذ آكل الأرواح لم يرتشف ما تبقى من دم في عروقها. تتعذب لأن الحياة الباقية في جسمها كثيرة، وتطاردها صور الحياة: «لم أنسَ ذلك الجانب بعد». رمزية «العلوق» تتجسد في مكان مقتلها، خط التماس تحت الجسر الذي شبهته بنهر الجحيم في الأوديسة، فتقول: «قطعت النهر ولم أقطعه. لكل نهره. نهري خط التماس بين الشرقية والغربية، ومستنقع وحل». يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه.
يُطرح غير سؤال حول مفاهيم الأصالة، وحفظ ذاكرة المكان، والحداثة واتجاهاتها. فهل ثمة حداثة بغير عودة إلى ما كان، واختيار ما سيعود؟! تبدو هذه المفاهيم في حالة نزاع لوجود تعددية أصوات، يؤيد بعضها المظاهر العمرانية التراثية للمدينة، والمحافظة على الإرث الثقافي، ويرى بعضها الآخر ضرورة الانتقال إلى فضاء حداثوي، وإيجاد سبل المعاصرة لتأسيسه. 