
رسالة أخيرة إلى قارئ
في مطلع فصل الربيع، وبعد أشهر قلائل من بلوغه الثانية والثمانين شرع الكاتب الأسترالي الأشهر، المبشّر بنوبل من سنوات طويلة جيرالد مرنين (25 فبراير 1939م)، في كتابة مشروع أدبي جديد ينشد من خلاله أن يختتم به مسيرته المهنية كاتبًا. أما المشروع فهو قراءة جميع الكتب التي ألّفها وإعداد تقرير عن كل كتاب منها. كانت نية مرنين الأصلية إيداع التقارير في أرشيفه الشخصي الذي يوثّق حياته، ولكن مع تزايد عدد التقارير تراكمت النصوص حتى اتخذت شكل كتابٍ في نهاية المطاف. صدر الكتاب تحت عنوان: «رسالة أخيرة إلى قارئ». ويتناول فيه الأوضاع التي أسفرت عنها تأليف أعماله، مناقِشًا الصور والتأملات والذكريات المدموغة بطابع شخصي عميق، وفي المقال/ النص الأخير يقارب المؤلف -من وجهة نظر ثمانيني يدنو من الموت- مشاعر الابتهاج والغبطة المصاحبة لفعل الكتابة.
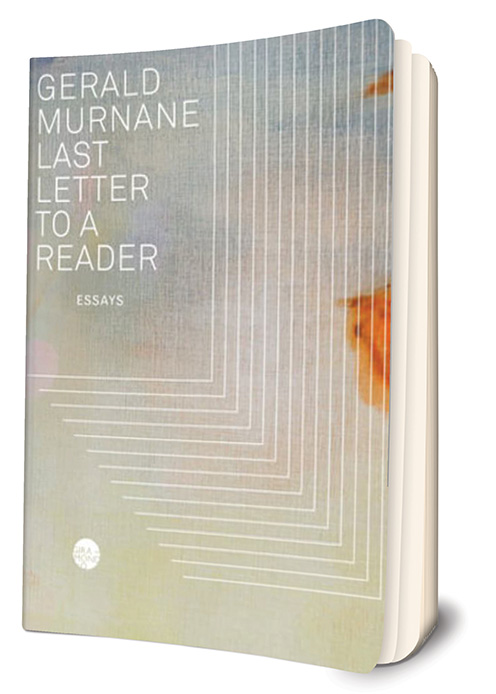 أشرقت فكرة الكتاب في ذهن مرنين في أثناء الإغلاق التام في بلدة جوروك الفيكتورية الصغيرة في سنة 2020م بسبب جائحة كورونا، عندما قرر قراءة كتبه «بترتيب نشرها». في المقال/ الفصل الأخير يبرز مرنين كلمتي «بهجة» و«ابتهاج» في وصف فعل الكتابة، مؤكدًا أنه لا يكتب لأجل السوق ولا لأجل التصفيق، ولكن لأجل ما يُطلق عليه «قارئه المثالي»، فيقول: «طَوال حياتي كنت أستمدُّ القوة والمعنى من الأساطير الخاصة بي، وهذا بكل تأكيد هو ما نأمل جميعًا في تحقيقه بالنسبة إلينا معشر الكُتاب».
أشرقت فكرة الكتاب في ذهن مرنين في أثناء الإغلاق التام في بلدة جوروك الفيكتورية الصغيرة في سنة 2020م بسبب جائحة كورونا، عندما قرر قراءة كتبه «بترتيب نشرها». في المقال/ الفصل الأخير يبرز مرنين كلمتي «بهجة» و«ابتهاج» في وصف فعل الكتابة، مؤكدًا أنه لا يكتب لأجل السوق ولا لأجل التصفيق، ولكن لأجل ما يُطلق عليه «قارئه المثالي»، فيقول: «طَوال حياتي كنت أستمدُّ القوة والمعنى من الأساطير الخاصة بي، وهذا بكل تأكيد هو ما نأمل جميعًا في تحقيقه بالنسبة إلينا معشر الكُتاب».
يعيد مرنين النظرَ في كل أعماله المنشورة طَوال مهنته كاتبًا لمدة امتدت لما يزيد على خمسة عقود. الجدير بالذكر أن الكاتب الذي يُعَدّ أهم كُتاب النثر الأحياء لم يُترجَم من أعماله إلى العربية سوى كتاب «مليون نافذة»، الذي نقله إلى العربية الكاتب والمترجم المصري محمد عبد النبي. الكتاب مؤلَّـف من خمسة عشر فصلًا أو مقالًا، يحمل كل فصل عنوان عمل من أعمال مرنين. والجدير بالذكر أن الكاتب الأسترالي المرموق قد كتبَ في مطلع سنة 2010م: «أتوسل إليك يا إلهي.. لا تدعني أنجذب إلى كتابة رواية أخرى». وكان مرنين قد أعلن اعتزال الكتابة قبل هذا التاريخ، وتحديدًا في سنة 1996م بعد أن وزّع كتابه «الزمرد الأزرق» ست مئة نسخة فقط، إلا أنه عاد إلى عالم الكتابة مجددًا في سنة 2009م مع رواية جديدة تبعها بمدة إنتاج متأخر وخِصب أسفرت عن سبعة كتب جديدة وجوائز أدبية كبرى وشائعات لا تتوقف عن تتويجه بجائزة نوبل.
المترجم
قبل بضعة أسابيع، وفي أحد الأيام الأولى من فصل الربيع في عامِي الثاني والثمانين في الحياة بدأت مشروعًا بدا أنه من المحتمل أن يُقَدِّم مسيرتي المهنية كاتبًا بصورة تقريبية أنيقة. شرعتُ في قراءة رواية «صف أشجار الطرفاء» (1974م)، أول أعمالي الروائية. كنت أخطط لقراءة الكتاب في وقت الفراغ، ثم أتابعه بقراءة كل عمل من أعمالي وَفْق الترتيب الزمني لنشره، وصولًا إلى كتاب «ظلال خُضر وقصائد أخرى» (2019م). اعتزمتُ أيضًا كتابة تقرير موجز عن تجربتي المتصلة بإعادة قراءة كل كتاب، على أن تُودَع نسخة من كل تقرير في الأرشيف الزمني الخاص بي، الذي رأيته نوعًا من توثيق حياتي كلها، ونسخة في أرشيفي الأدبي الذي يُعنى بكل أعمالي المنشورة. بدا المشروع برمّته، قبل الشروع فيه، باعثًا على الطمأنينة، بعيدًا من التكلّف. كنت أتطلّع على وجه الخصوص إلى التعرّف إلى الأشياء التي كان يجهلها ذلك الكاتب المبتدئ آنذاك، أو الأشياء التي نساها منذ ذلك الحين. في الوقت الحاضر يراودني شعورٌ بأنني أعرف عن تأليف الروايات أكثر مما كنتُ أعرفه في العقود السابقة. كيف سيحكم رجل اليوم على رجل الأمس؟ كانت هذه المشاعر وغيرها مبعث شعور لطيف بالترقّب في أثناء الأيام التي سبقت البدء في مشروعي.
قبل ذلك الحين لم أكن قرأتُ أيًّا من كتبي بعد طباعتها، كنت أتفحّص كل كتاب مرات عدة، ونصب عيني العثور على فقرة هنا أو هناك أستطيع الزهو بها لقراءتها وتلاوتها جهرًا. كنت قد قرأت جهرًا عددًا غير قليل من الفقرات المفضلة لديَّ في الأماكن العامة. كان آخرها الكلمات التي تلوتُها جهرًا عبارة من الفقرة الأخيرة الرنانة من كتابي «تاريخ الكتب» لكني لم أجلس قط «لأحاول» مواجهة أي من كتبي وجهًا لوجه كما لو كنتُ أراه للمرة الأولى. كلمة «لأحاول» هي الكلمة الفعّالة في الجُملة السابقة.
مواجهة ليست سهلة
لقد علمتُ بالتأكيد عندما فتحتُ كتاب «صفّ أشجار الطرفاء» في ذلك اليوم أن المحاولة هي أقصى ما يمكنني فعله. لقد اكتشفت في مرحلة مبكرةٍ من حياتي أن فعل القراءة أعقد بكثير مما يقرّ به معظم الناس. ومن ثم فمشروعي، كما أسميتُه، لن يكون أبدًا مواجهة بسيطة. وهكذا، كنتُ أمحّص مئات الألوف من ملايين الكلمات التي كتبتها بقلم حبرٍ منذ نصف قرن وأكثر، مثلما كنت أفعل بالضبط وأنا في حضرة كتابة نصّ: أتبع ما يمليه عليه ذهني.
إذا اخترت استخدام تعبير شائع فيمكنني أن أكتب في تقريري أن ذهني كان كثير التجوال منذ الوقت الذي أعيد فيه قراءة الصفحة الأولى من رواية «صف أشجار الطرفاء». على الرغم من ذلك فإن كلمة ذهني تدلُّ عندي خلاف ما تدلُّ عند غيري. لأكن أكثر دقّةً، وأقول: يمكنني بسهولة أن أضع في تقريري أن بعضًا أو جزءًا آخر من الوعي كان يتجول. سأحتفظ بكلمة ذهن للإشارة إلى المكان الذي حدث فيه الشرود. لقد كنتُ مشتّت الذهن، وأحيانًا تائهًا فيما يخصّ بمادة موضوع هذا العمل. باختصار سأظل أجاهد أفكاري دائمًا لأقرر كيف استطاع أيّ من كتبي أن يُحدِث أثرًا في القارئ. لكن هذه المجاهدة لن تمنعني من تقييم سلامة العبارات التي يتألّف منها النص أو من تقييم رشاقة السرد واتساقه.
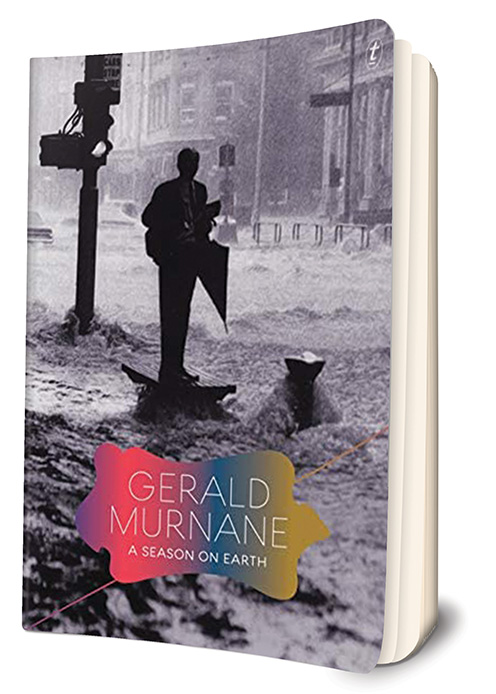 لقد تعلمت كثيرًا عن كتابة الجُمل وعن طرائق السرد الأدبي منذ أن بدأت في كتابة ما تحوّل في نهاية المطاف إلى رواية «صف أشجار الطرفاء». وعلى الرغم من أنني لم أفكر في التبرؤ قَطُّ من الرجل الذي أنفق أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمره في تأليف أول أعماله الروائية، فإنني توقعتُ أن تنبئني إعادة قراءتي أن كتابي الأول كان مليئًا بالعيوب. صحيح أنني كنتُ على علمٍ بأن الجُمَل لن تخيّب ظني -لأني كنتُ مهمومًا منذ صباي بتركيب الجُمل- لكني توقعتُ العثور على مَواطن عيب داخل النسيج السردي، ولم يفارق ذاكرتي يومًا التعليق اللاذع لمحرّر أيرلندي قال: إنني أقحمتُ تصورات رجل بالغ على إدراك طفل صغير.
لقد تعلمت كثيرًا عن كتابة الجُمل وعن طرائق السرد الأدبي منذ أن بدأت في كتابة ما تحوّل في نهاية المطاف إلى رواية «صف أشجار الطرفاء». وعلى الرغم من أنني لم أفكر في التبرؤ قَطُّ من الرجل الذي أنفق أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمره في تأليف أول أعماله الروائية، فإنني توقعتُ أن تنبئني إعادة قراءتي أن كتابي الأول كان مليئًا بالعيوب. صحيح أنني كنتُ على علمٍ بأن الجُمَل لن تخيّب ظني -لأني كنتُ مهمومًا منذ صباي بتركيب الجُمل- لكني توقعتُ العثور على مَواطن عيب داخل النسيج السردي، ولم يفارق ذاكرتي يومًا التعليق اللاذع لمحرّر أيرلندي قال: إنني أقحمتُ تصورات رجل بالغ على إدراك طفل صغير.
غنيٌّ عن البيان أنني وجدت فقرات كنتُ أودّ لو أنني كتبتُها اليوم على نحو مختلف، لكني كنتُ متفاجئًا في أغلب الأحيان. على الرغم من أن مؤلف الرواية قبل خمسين سنة لم يكن يفكر كثيرًا في نظريات السرد الأدبي أكثر مما أفكّر أنا اليوم، فإنَّ نوعًا من الشعور بصحة السرد كان إلى جانبه. لقد أمضيتُ عددًا لا يُحصى من الساعات في الستين عامًا الماضية في محاولة كتابة الروايات، لكني أمضيت كذلك ساعات طويلة جدًّا في محاولة شرح ما أفعله عندما كنت أكتب الرواية، ولماذا وجدتُ أشكالًا معينة من الكتابة السردية أكثر إشباعًا وإرضاءً من غيرها. لقد كنت مشغولًا بهاتين المسألتين لما يقرب من عشرين سنة قبل أن أجد الكلمات التي كنت أبحث عنها لمدة طويلة. في الحقيقة لقد وجدت مجموعتين من الكلمات المتكاملة بدقة. الخيال الحقيقي هو سرد لبعض محتويات عقل الراوي.
أن تعيد قراءة كتاب
عندي طريقتي الخاصة في تقييم أي كتاب، لا أقصد ما يُطلق عليه الكتاب الأدبي وحسب، بل أي نوع من الكتب، بل كل ما يتعلّق بـتقييم مقطوعة موسيقية، أو بعمل فني على وجه العموم. بعبارة أبسط يمكنني القول: إنني أحكم على قيمة الكتاب وَفْق المدة الزمنية التي يمكث فيها هذا الكتاب في ذهني، لكني بالطبع لن أدع هذه الفرصة تـمرُّ من دون أن أشرح كيف أن قراءة كتاب أو إعادة قراءته تختلف عندي عما تبدو عنها عند كثيرين غيري.
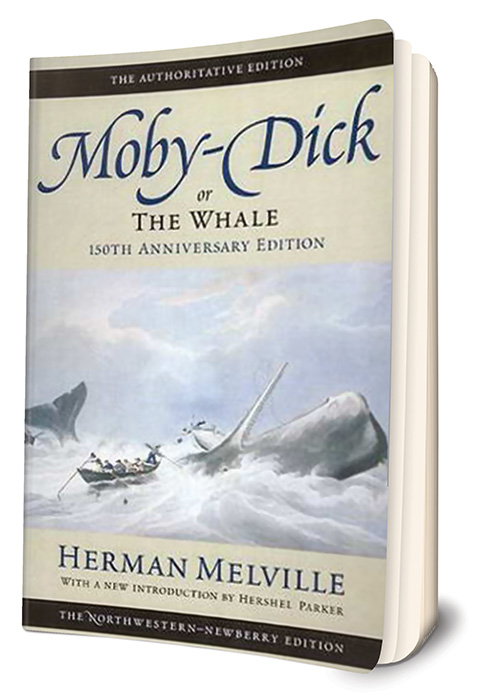 قرأتُ مرة أن جيمس جويس، كان يستشيط غضبًا عندما يسمع أحدًا يقول: إنه أو إنها قرأتْ كتابًا مثيرًا للإعجاب. ربما يبدأ الشخص المبهور بالكتاب في بيان مواطن إعجابه بالكتاب، لكن جويس لم يكن ليتسامح في ذلك أبدًا؛ إذ إنه كان يريد أن يعرف مِمَّ يتألّف الكتاب؟ وكان يريد من القارئ المتحمّس أن يستشهد ببعض الجُمل أو الفقرات التي حازت إعجابه. وبالطبع لم يكن يقدر على ذلك سوى قلة قليلة من القُرّاء المتحمسين. بل إنني شخصيًّا نادرًا ما أقدر على ذلك. ربما تمكث في ذاكرتي فقرة أو فقرتان لاحقًا.
قرأتُ مرة أن جيمس جويس، كان يستشيط غضبًا عندما يسمع أحدًا يقول: إنه أو إنها قرأتْ كتابًا مثيرًا للإعجاب. ربما يبدأ الشخص المبهور بالكتاب في بيان مواطن إعجابه بالكتاب، لكن جويس لم يكن ليتسامح في ذلك أبدًا؛ إذ إنه كان يريد أن يعرف مِمَّ يتألّف الكتاب؟ وكان يريد من القارئ المتحمّس أن يستشهد ببعض الجُمل أو الفقرات التي حازت إعجابه. وبالطبع لم يكن يقدر على ذلك سوى قلة قليلة من القُرّاء المتحمسين. بل إنني شخصيًّا نادرًا ما أقدر على ذلك. ربما تمكث في ذاكرتي فقرة أو فقرتان لاحقًا.
لم أعاود النظر إلى رواية «موبي ديك» لهيرمان ميلفل، لمدة ثلاث وخمسين سنة، لكني أستطيع تذكّر جُملة ما تبرح تزور ذاكرتي في بعض الأوقات وتمارس تأثيرها فيَّ؛ جُملة قصيرة وردت على لسان كابتن «أخاب» قبل مدة اصطياد الحوت الأبيض: «إنهم يصنعون القشّ في حقول جبال الأنديز، سيد ستارباك». وسأكون سعيدًا، لا خجِلًا لو أخبرني أحد أن هذه هي الكلمات الأصلية الواردة في النص، سأكون سعيدًا لأنني أعدتُ تنقيح نصّ سردي ملائم لجميع الأغراض، لإثراء الحياة الواقعية. إن الأعمال التي ألّفتُها طالما بدتْ إليَّ أكثر من كونها مجرد نصوص، في بعض الأحيان تبدو لي الكلمات المطبوعة مجرد حالات مِزاجية طويلة الأمد، حالات ذهنية عانت الاضطهاد أو تعبيرًا عن مراحل كاملة من حياتي، إلا أن بعض هذه الكلمات تظهر في صورتها المطبوعة أو تصدح في ذهني بصوتٍ عالٍ أو أنني أستدعيها إلى ذاكرتي، التماسًا للشجاعة أو المواساة. لا يمل القُرّاء أبدًا من سؤالي عن مدى اقتراب حيوات شخوصي الروائية ورواة أعمالي من حياتي الشخصية، ولا أملُّ أنا من الردّ بإجابات مراوغة. كلاهما كاذب، معترفًا أن فصل الذكريات الدقيقة عن نظائرها غير الدقيقة مهمة في غاية الصعوبة.
مكافأة الكتابة
على مدار أغلب حياتي في الكتابة لم تكن لديّ غرفة خاصة للكتابة، ولو حدث ونعِمَ المنزل بالهدوء في أثناء غياب زوجتي أو الأبناء كنتُ أفضّل الجلوس إلى كرسي البار في المطبخ ومواصلة الكتابة، وإن لم يتيسّر ذلك كنتُ آخذ طاولة الكيّ إلى غرفة نومنا أنا وزوجتي وأغلق الباب ورائي، متخذًا من طاولة الكي غير المتزنة المفروشة بالملابس طاولةً للكتابة، محتفظًا بمساحة فارغة من الجدار أمامي لو أردتُ النظر إلى الآلة الكاتبة. لكني كلما تذكرت مدة الكتابة الفعلية لما تحوّل اليوم لـرواية «السهول» أو تذكرت أوقات العطالة والخمول التي تخللتْ عملية الكتابة، فإني لا أذكر سوى المشهد العادي عبر نافذة المطبخ وأنا أجلس إلى كرسي البار. إن فعل الكتابة أو مجرد محاولة الشروع في الكتابة قد حبَتني أوقاتًا لا تُعَدّ ولا تحصى مما يُمكن أن أطلق عليه اليوم «التجليات». وكانت أكبر الأشياء قيمة من هذه المكافآت تصلني بعد مرور نصف ساعة من بدْء الكتابة الحقيقية أو الجهد للكتابة.
لقد خضعت رواية السهول لصنوفٍ شتى من الشرح والتأويل، وهو ما أعـدّه لونًا من ألوانًا الثناء لثراء وتعقيد عمل روائي يكاد يخلو من حبكة أو شخوص روائية، كما علّق أحدهم ذات مرة. وأنا سعيد لأن رواية السهول عمل في مقدوري الإشارة إليه بزهو حينما يُقال: إن روايتي قريبة الشبه جدًّا من سيرة ذاتية خيالية. إلا أن السؤال الحقيقي الذي يعنّ لي في كل مرة أؤلّف فيها كتابًا لم يكن «ما معنى ذلك؟»، وإنما «لِمَ أكتب هذا الكتاب؟»، أو بشكل أكثر دقة: «ما شكل المعنى الذي كشفه الكتاب في ذهني؟» وكانت الإجابة عن السؤال تأتيني وأنا في أثناء كتابة العمل نفسه، إلا أنني حتى قبل بضعة أيام خلَت وعلى مدار أربعين سنة تقريبًا لم تَشْفِ غليلي التفسيرات المختلفة عن مبرر وجود أشهر أعمالي على الإطلاق. لم يكن اهتمامي برواية «السهول» مردّه إلا اقترانها بأحداث في تاريخ حياتي الشخصية أو بتاريخي العقلي، لم تثر اهتمامي قط نباتات السفرجل بأوراقها الخضراء الباهتة».
