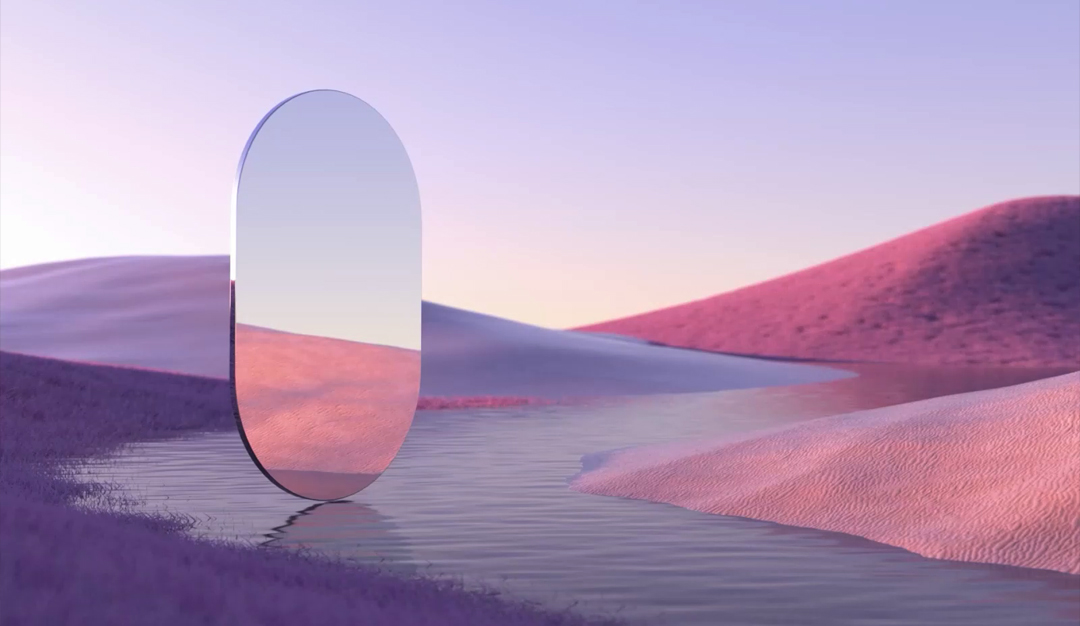
دعوةٌ لزراعة الشِّعر

أعترف أنني واحد من تلك الألوف التي تطالع هذا الشعار الأرجواني «عام الشعر العربي 2023» على شاشات المجمعات التجارية، والتلفزيونات، والشوارع. أطالعه بفرح واحتفاء خفي، وأحيانًا أتقمص دور المشاهد العادي لأقرأ ما عبر في ذهنه تلك اللحظة، هل تذكر قصيدة من أيام دراسته؟ هل نسي الشعر كله وفضّل، وهو يجول في المول، البحث عن ملابس لصغاره…! لكنني دائمًا أجهل ما هي خطوتي التالية.
هل يتوجب عليَّ أن أقرأ شعرًا أكثر أو أن أكتب أكثر، أم إني أعيش فرصة استشعار عظَمة الشعر القادمة من امرئ القيس والمتنبي والمعري وأبي تمام، وصولًا إلى القصيدة الممغنطة التي ينضّدها ويتلوها عليك برنامج «شات جي بي تي» دون رفّة عين، أو اضطراب قلب، أو تلعثم لغوي…! أم إن عليَّ أن أستقبل هذا العام ورمزيّته بشكل آخر.
لعل إحدى علامات التفاؤل أن الشعر العربي في كل عصوره قد شكل سيلًا دائم التجدد، وهو في كل عصر يصنع مناخاته ولغته ورموزه ونقّاده، وقد شكّل في الحقب الأولى تاريخًا لحياة الإنسان وتمزقاته وحروبه، فضلًا عن اشتباكه مع مفردات الطبيعة وتجلّياتها من حوله، بل إن القصائد كانت جزءًا من حطَب الهجاء بين القبائل، أو بين أسباب صلحهما. ولهذا عُرفت بعض حقب الحياة العربية بأسماء الشعراء أكثر مما عرفت بأسماء الحكام أو القادة أو شيوخ القبائل. كل هذا أبقى نسغًا بين حياة الشاعر وقصيدته، وبين أهله وعشيرته، وهذا التلاحم الفطري الذي ساد في زمن ما، هو ما أدى إلى انشقاق القبيلة عن شاعرها حين أمعن هو في البحث عن صوته الخاص، وتمرد عليها لغة وسلطة وامتثالًا اجتماعيًّا.
ولكيلا أبتعد من سؤال مجلة «الفيصل» فإن ساحة الشاعر تتراجع، خطابه الشعري غير مسموع أحيانًا، والأشكال الشعرية الأكثر حداثة، التي يخوضها ثلّة من الشعراء، تواجه صعوبة في اختراق ذائقة القارئ، وانتزاعه من الأرض الشعرية الكلاسيكية التي رآها مكرسة له منذ نعومة أظفاره حتى بلوغه ذروة دراساته الجامعية، لكن الشعر من جهة أخرى يتناسل في نسيج الفنون الأخرى المكتوبة والمرئية، وهذا ما يبقيه حيًّا. إذن، فإن مبادرة وزارة الثقافة بوسْم هذا العام، عامًا للشعر، مبادرة محمودة وعظيمة، ففي باطنها تذكيرٌ بأن الشعر كان مركبنا الأصيل الذي عبرْنا به الحقب، وسيبقي منه شذرات في أرواحنا وعقولنا ولغتنا، وفيما كانت الحضارات الأخرى تبقي آثارها المادية والعينية في خزائن الكتب، وعلى الأحجار، وفي النصب والتماثيل، والمتاحف ودُور العبادة، وفي القصور، فقد طوت الصحراء والعزلة المكانية هنا ما لا يحصى من العلامات والدلائل الثقافية في جغرافيتنا، وطمرتها تحت الرمال، ولم يبق أحيانًا سوى ما اختزنته وتناقلته بعض ذاكرات الأقدمين من أشعار وقصص ونوادر.
هل تفعل قصائدي شيئًا في هذا المعترك؟ أظنها تدّخر حياة أجمل وأنبل مما نتعارك معه في الواقع اليومي الطاحن. هناك مصطلح طبي أقتبسه في هذا الصدد وهو: «الرعاية التلطيفية»، وكثيرًا ما أرى الشعر سعْيًا تلطيفيًّا للحياة يعين الإنسان على السير في مناكب الأرض، لكن هذا المصطلح يعني النقيض تحت قباب المستشفيات..! إن كان لعام الشعر العربي هذا من خطط وبرامج، فإنني أضع هذين المقترحين ضمن تلك الخطط:
الأول: تحديد المواقع التي عاش فيها عشرة، على الأقل، من شعرائنا الأوائل في أرض الجزيرة، وحمايتها كمعالم ثقافية ومعرفية وسياحية تتيح لمواطني المملكة وزائريها من أفراد وهيئات أدبية وثقافية دولية زيارتها، وتسهيل الأعمال البحثية التي يمكن أن تقام حول تاريخ وحياة تلك الشخصيات.
والثاني: العمل على زرع النصوص الحداثية المحلية الجديدة شعرًا ونثرًا وفنونًا التي يبلغ عمرها نصف قرن في مناهجنا التعليمية، وفي المسارات البحثية الأكاديمية لجامعاتنا، وأن تخضع هذه المشروعات لمجالس أكاديمية علمية محكّمة قادرة على دمج أجمل ثمرات أدبنا المحلي الجديد في لغة وذاكرة النشء القادم.
هناك جهد أصيل لنقل أدبنا إلى العالم الآخر، لكننا نأمل أن يُوَطَّنَ داخل مجتمعنا وفي قلب حياتنا الثقافية واليومية. هذا الانشقاق ينبغي أن يتوقف، والأمل أن يكون هذا العام بشارة التغيير.
