
لين فان في - باحث صيني | مايو 1, 2025 | مقالات
بسبب «المركزية الغربية» التي أثرت في دراسات الأدب في الصين، عانت دراسة الأدب الشرقي التهميشَ من ناحية العدد والنوعية. فعلى الرغم من أن الصين كانت قد بدأت في القرن التاسع عشر، الترجمة من اللغة العربية إلى الصينية، فإن ذلك لم يتجاوز ترجمة بعض سور القرآن الكريم وقصيدة البردة للإمام البوصيري ولم تمتد أصابع المترجمين إلى الأعمال الأخرى.
حتى قبل تأسيس الصين الجديدة، في عام 1949م، لم يطبع في ذهن القراء الصينيين أي عمل أدبي عربي سوى كتاب «ألف ليلة وليلة» الذي تُرجم من اللغة الإنجليزية. وفيما بعد ذلك ترجم مو دون وبينغ شين بعض أعمال جبران خليل جبران. باختصار، لم يكن الأدب العربي لافتًا للنظر في الصين في أوائل وأواسط القرن الماضي. واستمرت هذه الحال في الصين حتى ثمانينيات القرن الماضي الذي يعد فاصلًا في تاريخ دراسات الأدب العربي في الصين. وخلال أربعة العقود الماضية على الدراسات والبحوث في الأدب العربي في الصين، شهدت هذه الدراسات تنوعًا وتغيرًا وتعمقًا مع التواصل بين الصين والدول العربية وبخاصة التواصل الثقافي.
تحليل اتجاهات دراسات الأدب العربي
مع دخول الصين إلى مرحلة النهضة، يمكننا أن نرى مثل هذه النهضة في دراسات الأدب العربي. ويمكن تقسيم اتجاهات دراسات الأدب العربي بعد عام 1949م إلى أربع مراحل حسبما شهدت الصين من التغيرات في مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع.
أولاً، من 1949 إلى 1979م: الترجمة الأدبية
بعد تأسيس الصين الجديدة عام 1949م وفي الخمسينيات، لم تكن هناك سوى جامعة واحدة في الصين تُعلِّم اللغة العربية، وهي جامعة بكين. وبحلول الستينيات، فتحت جامعة بكين للدراسات الأجنبية، وجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، على التوالي، تخصصات اللغة العربية. ومع ذلك، ركز التدريس خلال هذه المدة بشكل أساسي على اللغة، أما الأدب فلم يتلق اهتمامًا كافيًا.
 بدأ البحث الأدبي عمومًا بالترجمة الأدبية. بين عامي 1949 و1978م، كانت الأبحاث ذات صلة بالأدب العربي في مرحلة الترجمة والتقديم بشكل أساسي، ولم تُنشَر أية أبحاث أكاديمية ذات صلة.
بدأ البحث الأدبي عمومًا بالترجمة الأدبية. بين عامي 1949 و1978م، كانت الأبحاث ذات صلة بالأدب العربي في مرحلة الترجمة والتقديم بشكل أساسي، ولم تُنشَر أية أبحاث أكاديمية ذات صلة.
في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، تصاعدت حركات التحرر الوطني للشعوب العربية. ومن أجل التضامن مع الوضع السياسي في الشرق الأوسط في ذلك الوقت والتعبير عن الدعم لنضال الشعب العربي العادل، كانت هناك ذروة أولى في تعريف الأدب العربي إلى الصين، حيث تُرجمت ونُشرت بعض الأعمال الأدبية العربية، مثل «الأيام» و»الدار الكبيرة» وغيرهما. وفي هذه المرحلة تركز الأعمال المترجمة بشكل أساسي على المجموعات الشعرية ومجموعات القصص القصيرة. من عام 1966 إلى عام 1976م، حدثت «الثورة الثقافية الكبرى» في الصين، ولا يكاد هناك أي منشور عن الأعمال الأدبية الأجنبية؛ لذا لم تشهد دراسة الأدب العربي في الصين تقدمًا وتطورًا في هذه المدة.
ثانيًا، من 1980 إلى 1999م: ازدهار دراسات الأدب العربي
بعد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني، دخلت دراسة الأدب العربي في الصين مرحلة جديدة، إيذانًا ببدء ازدهار دراسات الأدب العربي في الصين. ومن أجل كسر «نظرية المركزية الغربية»، تزايد منذ أوائل الثمانينات عدد الجامعات التي تدرس اللغة العربية. إضافة إلى ذلك، فإن إنشاء جمعية أبحاث الأدب العربي عام 1987م ساهم بلا شك في تطوير البحث الأدبي العربي في الصين بشكل كبير. وتركزت الاتجاهات البحثية الرئيسة في هذه المدة على النقاط التالية:
الاهتمام بروائع الأدب: نجيب محفوظ: ركزت الأبحاث المبكرة حول الأدب العربي بشكل أساسي على الأدب القديم والتاريخ الأدبي. وبعد فوز محفوظ بجائزة نوبل للآداب عام 1988م، حولت الدوائر الأكاديمية الصينية اهتمامها تدريجيًّا من الأدب القديم إلى الأدب الحديث. وبطبيعة الحال، حظي محفوظ بكثير من الاهتمام وحظيت أعماله بكثير من الدراسات التي تهتم بالأفكار والتقنيات السردية في أعماله.
دراسات في الأدب المقارن: وكان من أكثر اتجاهات البحث التي جذبت الاهتمام في هذه المدة هو الأدب المقارن، وهو ما انعكس بشكل رئيس في الدراسة المقارنة بين الأدب العربي والأدب الغربي، مع التركيز على تأثير بعضه في بعض. يعود ازدهار الدراسات في الأدب المقارن إلى اتجاه عام للأدب في الصين؛ وذلك لأنه مع التبادل الثقافي بين الصين والدول الأجنبية، أصبحت النظريات الجديدة المختلفة والأساليب الجديدة ووجهات النظر الجديدة للأبحاث متعددة التخصصات والأبحاث عبر الثقافات المألوفة للدوائر الأكاديمية المحلية. فسعى الباحثون في الأدب العربي للتماشي مع الدراسات السائدة لإعادة حيوية دراسات الأدب العربي وقوته.

آسيا جبار
دراسات في أدب المرأة: حظيت أعمال الأدب النسائي العربي باهتمام أكاديمي لمدة طويلة، جرى التعريف ببعض الكاتبات بالعربية وتُرجمت بعض أعمالهن، على سبيل المثال، نُشرت أعمال الكاتبة الجزائرية آسيا جبار في السبعينيات وتُرجمت إلى اللغة الصينية، ولكن يبدو أن الأبحاث حول هذا النوع من الأدب لم تبدأ إلا في التسعينيات. وهذا لا ينفصل عن كون دراسة الأدب العربي بدأت متأخرة نسبيًّا، وأن أعمال النساء الأدبية المترجمة إلى الصين قليلة جدًّا. ولكن في الستينيات والسبعينيات، تدفقت الحركة النسوية إلى الصين، وهو ما أدى إلى ازدهار الإبداع الأدبي النسائي الصيني في التسعينيات. وفي الوقت نفسه، منذ أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات، شهد المجتمع في الصين تحولًا سريعًا، وظهر اقتصاد السوق، ولقي الأدب إقبالًا كبيرًا، كما نُشِر الأدب النسائي واحدًا تلو الآخر. في الوقت نفسه، ساهمت النظرية النقدية النسوية الغربية في تعزيز دراسات الأدب النسائي؛ ولذلك نرى أن الأعمال الأدبية النسائية مثل أعمال سعاد صباح وغادة السمان وحنان الشيخ ونوال السعداوي وغيرهن من الكاتبات حظيت باهتمام أكبر.
تأليف تاريخ الأدب العربي: فقط بعد عام 1990م، بدأ الباحثون الصينيون في تأليف كتاب حول تاريخ الأدب العربي، وأول كتاب كان «تاريخ موجز للأدب العربي» بقلم يي هونغ، ونشرته دار هاينان للنشر في عام 1993م. وكان الكتاب في الواقع كتابًا تقديميًّا للأدب الأجنبي ولم يكن مفصلًا. إن «تاريخ الأدب العربي» الذي كتبه تساي ويليانغ وتشو شونشيان في عام 1998م هو في الواقع أول تاريخ كامل للأدب العربي يجمعه الصينيون. وبحلول عام 2010م، جمع تشونغ جيكون كتاب «تاريخ عام للأدب العربي»، الذي يمثل أعلى مستوى حول تاريخ الأدب العربي.
ثالثًا: من 2000 إلى 2009م: ارتباط الدراسات بمختلف المجالات
دراسات الأدب العربي فيما بعد الاستعمار: كان لين فينغمين أول من طبق نظرية ما بعد الاستعمار على الأدب العربي. وفي عام 2004م، كتب «الاتجاهات الإبداعية لما بعد الاستعمار للكتاب العرب الحديثين والمعاصرين»، الذي تناول بالتفصيل ميزات ما بعد الاستعمار في الأدب العربي. ومنذ ذلك الحين، بدأ العديد من الباحثين في إعادة تفسير الأدب العربي من منظور ما بعد الاستعمار. حتى الآن، لا تزال دراسات ما بعد الاستعمار موضوعًا مثيرًا جدًّا.
الاهتمام بالسياسة عامة وبالقضية الفلسطينية خاصة: بالمقارنة مع الأدباء من البلدان الأخرى، يتمتع الكتاب العرب بإحساس أقوى بالتنوير والمطالب السياسية. يسعى الأدباء إلى أن يكون لأعمالهم وظائف اجتماعية وتنويرية، وشاركوا بنشاط في سياسة العصر. وفي هذه المدة، ظهرت تدريجيًّا النزعة السياسية للبحث الأدبي، وأصبح أكثر وضوحًا بعد عام 2011م.
رابعًا، من 2011م إلى الآن: تنويع دراسات الأدب العربي
مع دخول القرن الحادي والعشرين، ومع الإثراء المستمر للنظرية الأدبية والتقديم المستمر للأعمال الأدبية العربية، استمر رصيد البحوث الأدبية العربية في التزايد، وهو ما يثبت تنوع الأدب العربي، وتركز موضوعات البحث الرئيسة على النقاط التالية:
نظرية جديدة، رؤية جديدة: في هذه المدة، دخلت نظريات جديدة أيضًا في رؤية الباحثين الصينيين، مثل تناص النصوص، و«الصورة» وتيار الوعي، مما يزيد منظورات قراءة الأدب العربي. كما واصل الأدباء العرب تجربة تقنيات إبداعية جديدة في هذه المدة مثل السريالية وما بعد الحداثة، وهو ما أدى إلى توسيع دراسة أساليب السرديات في الروايات. على سبيل المثال، اجتذبت تقنية السرد العجائبي في رواية «فرانكشتاين في بغداد» وتقنية السرد متعدد الأصوات في رواية «سيدات القمر» اهتمام الباحثين المعنيين. إضافة إلى ذلك، بدأ العديد من الباحثين في التركيز على الفضاءات في الروايات، مثل الأزقة والمقاهي والمدن والحدائق وغيرها في محاولة لاستخدام نظرية الفضاء لتحليل دلالات الروايات.

نجيب محفوظ
الاهتمام بالروايات التاريخية: شهد الأدب العربي في السنوات الأخيرة اتجاهًا إلى «النظر إلى الوراء»، وظهرت العديد من الروايات التاريخية. في الواقع، منذ أربعينيات القرن العشرين حتى ستينياته، أطلقت الروايات التاريخية موجتها الأولى، مثل «الثلاثية التاريخية» لنجيب محفوظ، و«الزيني بركات» لجمال الغيطاني. في ذلك الوقت، شهدت الدول العربية موجة من التحرر الوطني، والغرض الرئيس من الكتابة التاريخية هو استخراج الثروة الروحية للأمة العربية من تراثها التقليدي وحَفْز الوعي القومي العربي.
في السنوات الأخيرة، وبعد تجربة المزاج المزدوج بين «التنوير» و«الثورة»، وصل المثقفون العرب إلى مفترق طرق، وكانوا حريصين على كسر الحصار الصارم الذي فرضه النظام السائد، وإيجاد طرائق جديدة للتنمية الوطنية. وفي الممارسة الإبداعية، ومن خلال التناص، نُقِل عدد كبير من الأحداث والقصص التاريخية لكسر حواجز الزمان والمكان، وفتح الحوار لمختلف اتجاهات الفكر بالتعايش والتصادم في النص نفسه، وهو ما يجعل الرواية مساحة ممتدة إلى ما لا نهاية ومليئة بالتوتر. لكن ما الهدف من كتابة التاريخ في السنوات الأخيرة؟ هذا أيضًا سؤال تناوله العديد من الباحثين. ومما لا شك فيه أن «النظر إلى الوراء» في السنوات الأخيرة يرتبط بشكل كبير بالتغيرات التي طرأت على الوضع في الشرق الأوسط منذ عام 2011م.
خاتمة
 يمكن أن نرى بعض الاتجاهات المهمة في دراسات الأدب العربي في الصين منذ تأسيس الصين الجديدة، ويسرنا كثيرًا أن نرى ازدهار وتقدم دراسات الأدب العربي في الصين. وفي الوقت نفسه، أطرح بعض الاقتراحات: أولًا، إن صفوف دراسات الأدب العربي آخذة في النمو، لكنها ليست قوية بعد. في الوقت الحالي، فإن الروايات المختارة عند دراسات الأدب العربي ليست كثيرة. وإذا أخذنا الأعمال الفائزة بجائزة البوكر العربية مثالًا، يمكن أن نرى أن الدراسات بشكل أساسي تركز على «ساق البامبو» لسعود السنعوسي، و«فرانكنشتاين في بغداد» لأحمد السعداوي، و«طوق الحمام» لرجاء عالم. ولكنْ هناك عدد قليل جدًّا من الدراسات حول الأعمال الأخرى الحائزة على جوائز مثل «القوس والفراشة»، و«الديوان الإسبرطي»، و«تغريبة القافر» وما إلى ذلك؛ لذا يجب على الباحثين الصينيين إيلاء مزيد من الاهتمام بالروايات العربية الممتازة وتوسيع آفاقهم في الدراسات من أجل زيادة تفاهم الشعوب بين الجانبين من خلال الأدب.
يمكن أن نرى بعض الاتجاهات المهمة في دراسات الأدب العربي في الصين منذ تأسيس الصين الجديدة، ويسرنا كثيرًا أن نرى ازدهار وتقدم دراسات الأدب العربي في الصين. وفي الوقت نفسه، أطرح بعض الاقتراحات: أولًا، إن صفوف دراسات الأدب العربي آخذة في النمو، لكنها ليست قوية بعد. في الوقت الحالي، فإن الروايات المختارة عند دراسات الأدب العربي ليست كثيرة. وإذا أخذنا الأعمال الفائزة بجائزة البوكر العربية مثالًا، يمكن أن نرى أن الدراسات بشكل أساسي تركز على «ساق البامبو» لسعود السنعوسي، و«فرانكنشتاين في بغداد» لأحمد السعداوي، و«طوق الحمام» لرجاء عالم. ولكنْ هناك عدد قليل جدًّا من الدراسات حول الأعمال الأخرى الحائزة على جوائز مثل «القوس والفراشة»، و«الديوان الإسبرطي»، و«تغريبة القافر» وما إلى ذلك؛ لذا يجب على الباحثين الصينيين إيلاء مزيد من الاهتمام بالروايات العربية الممتازة وتوسيع آفاقهم في الدراسات من أجل زيادة تفاهم الشعوب بين الجانبين من خلال الأدب.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن إنكار أن نظرية الأدب الغربية تُطبَّق تدريجيًّا على دراسات الأدب العربي، وقد تحقق العديد من النتائج البحثية المرضية. على سبيل المثال «تحول الأدب العربي المعاصر وتطوره» للباحثة الصينية يو يوبينغ التي استلهمت النظرية الغربية بشكل كبير وبحثت في الأدب العربي من المنظور المختلف. ومع ذلك، ما زلنا نحتاج إلى النقد البيئي، والنقد الماركسي، والنقد التاريخي الجديد لإعادة النظر في الأدب العربي من أجل استكشاف أسراره بشكل أفضل.

لين فان في - باحث صيني | مايو 1, 2023 | مقالات
صدر عدد غير قليل من الروايات العربية ذات النظرة الثاقبة والأفكار العميقة في هذه السنوات. وفي أثناء دراستي الروايات العربية المعاصرة، وجدت أن الحيوان عنصر لا يمكن الاستخفاف به. في ستينيات القرن الماضي، دفعت حركة حقوق الإنسان قضية الحيوان إلى «الموضع المركزي». في عام 1975م، صدر كتاب «تحرير الحيوان»، للعالم بيتر سينجر، رمز إلى الدراسات العامة والشاملة في الحيوان في الغرب. وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي، ظهر «اتجاه الحيوان» (Animal Turn) في مختلف المجالات. في عام 2007م، قدّر هذا الاتجاه في كتاب «معرفة الحيوان» تقديرًا عاليًّا، وصرح فيه أن العلوم الإنسانية والاجتماعية شهدت «اتجاه الحيوان» في السنوات العشرين الماضية وله أهمية فريدة(١).
أما في مجال الأدب، إذا أردنا فهم «اتجاه الحيوان»، فلا بد لنا من شرح ثلاثة مصطلحات رئيسة: «دراسات الحيوان» (Animal Studies)، و«سرد الحيوان» (Animal Narration)، و«نقد الحيوان» (Zoo criticism). بكل بساطة، اشتقت دراسات الحيوان من حركة حماية حقوق الحيوان وتركّزت على إعادة النظر في العلاقة بين الإنسان والحيوان وإعادة التفكير في جوهر الإنسان. أما سرد الحيوان فيعني «القصص عن الحيوان من خلال كتابة وصياغة صور الحيوان في الروايات لتعميق استكشاف المجتمع والثقافة والإنسانية»(٢)، ويرمز نقد الحيوان إلى ما يحمله سرد الحيوان في الأدب من الوظيفة الاقتصادية والمعاني الثقافية والسياسية والبيولوجية والتعليمية والعلمية من منظور عبر الثقافات؛ لذلك تعد العلاقة بين هذه المصطلحات متكاملةً ومتداخلةً ومتلازمةً، ويعد سرد الحيوان مقدّمةً مهمةً لنقد الحيوان، بينما اتّسعت دراسات الحيوان إلى مجال الأدب لبلورة نقد الحيوان، ويعد سرد الحيوان تجلياتٍ نصيةً لدراسات الحيوان في الأدب. فيمكن القول: إن نقد الحيوان في الوقت الراهن لم يقتصر على الدعوة إلى حماية حقوق الحيوان فحسب، بل يكسب أفقًا أوسع يحمل أوفر الرموز والاستعارات.
الحيوان والهوية
لفظ «هوية» في اللغة مشتق من الضمير هو، أما مصطلح «الهوية» فقد انبثق من «identias» في اللغة اللاتينية ومعناه الأصلي يعبّر عن «تماثل وتشابه» ويجيب عن: «من أنا؟» و «من أين أنا؟» و«إلى أين أنا؟» وغيرها من الأسئلة. في وجه العولمة والثورة التقنية والتحول الصناعي وغيرها من الموجات الاجتماعية، بدأ الكتّاب العرب المعاصرون في متابعة قضية الهوية في روائعهم. وهنا، يقترن الحيوان بالهوية في تحليل رواية «ناقة الله» (2015م)، للكاتب الليبي الطارقي إبراهيم الكوني، الصادرة عن دار سؤال اللبنانية، ومعها يمكن استكشاف طريق جديد لدراسات الأدب العربي المعاصر.
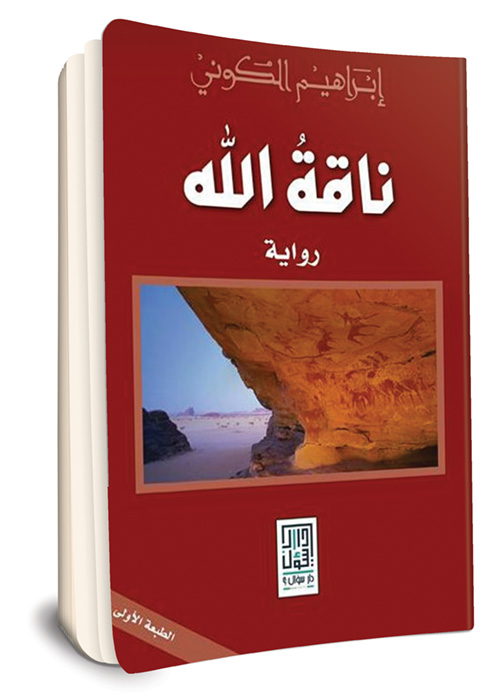 حكت الرواية عما حدث بين الراعي والناقة في ستينيات القرن الماضي حين قُسمَت الصحراء الكبرى بين الدول وهُجّر الطوارق من أوطانهم، وبدأت معاناتهم. تاقت الناقة «تاملالت» حنينًا ووجدًا إلى موطنها، وقاتلت على الرغم من كل القيود، وبغض النظر عن الأخطار. لكن راعيها خاف من موتها خلال مغامراتها، فبحث عنها كل مرة هربت فيها منه لبدء المغامرة الجديدة. انجلى موضوع الرواية بوضوح مع أخذ البحث عن الموطن خيلًا ربط الرواية بعضها ببعض. ومن الواضح أن هذه الرواية مبنية، حبكةً ومبنًى، على سرد الحيوان؛ إذ إن بطل هذه الرواية ليس إلا ناقة.
حكت الرواية عما حدث بين الراعي والناقة في ستينيات القرن الماضي حين قُسمَت الصحراء الكبرى بين الدول وهُجّر الطوارق من أوطانهم، وبدأت معاناتهم. تاقت الناقة «تاملالت» حنينًا ووجدًا إلى موطنها، وقاتلت على الرغم من كل القيود، وبغض النظر عن الأخطار. لكن راعيها خاف من موتها خلال مغامراتها، فبحث عنها كل مرة هربت فيها منه لبدء المغامرة الجديدة. انجلى موضوع الرواية بوضوح مع أخذ البحث عن الموطن خيلًا ربط الرواية بعضها ببعض. ومن الواضح أن هذه الرواية مبنية، حبكةً ومبنًى، على سرد الحيوان؛ إذ إن بطل هذه الرواية ليس إلا ناقة.
أراد الكوني لناقته أن تكون مثالًا للتعبير عن حب الأوطان. في هذه الرواية، يمكن ملاحظة أن عددًا من الجِمال مقتولة أو معذّبة. استعار الكوني هذه الصور لتوجيه الانتقادات إلى معاناة الطوارق تحت الاستعمار وسطو السلطة. ومن خلال وصف مغامرة الناقة بحياتها محاولةً الهروب إلى وطنها، أراد الكوني سرد توق الطوارق وجهودهم المبذولة لنيل هويتهم. في ظل فقدان الهوية في البلاد والتعرّض للتهميش، ماذا يجب أن يفعلوا؟ أين يجب أن يتجهوا؟ وما هويتهم؟ هذا ما تطرّق إليه الكوني في هذه الرواية، ويعد موضوعًا مركزيًّا فيها باستعارة سرد الحيوان للتعبير عن فكرته.
عاشت الأقليات في حالة حرجة في آواخر القرن الماضي في ليبيا، ومن الصعب عليهم الحصول على إثبات الهوية. والجدير بالذكر أن الكوني كرّر هذا الموضوع في روايات عدة كتب فيها عن هوية الطوارق، واستعرض ذكرياتهم من أجل بث صوتهم وإبلاغ معاناتهم للعالم لاستعادة هويتهم المشروعة، ولتعزيز وحدة ليبيا ودفع الانتماء للتوافق مع القومية والدولة. من هذا المنظور، استخدم الكوني سرد الحيوان لاستكشاف هوية الفرد وهوية القومية وهوية الدولة.
يمكن الملاحظة بوضوح، أن للجمل دورًا مهمًّا عند كتابة الهوية، وذلك لا ينفصل عن تقاليد وعادات الدول العربية. يُعتبر الجمل حيوانَ الصحراء ورمزَ الصمود وعمودَ البدو وله دور لا مثيلَ له في حياتهم اليومية. من ثم، يمكن النظر إليه على أنه رمز هوية العرب. من هذا المنطلق، من الممكن تعميق تحليل صور الحيوان في الروايات العربية لإماطة اللثام عمن يستخف بها. من خلال الحيوان، أطلق الكاتب حوارًا أوسعَ مع هذا المجتمع للتفكير في العلاقات بين الفرد والجماعة، الماضي والحاضر، الأمة والوطن، الدولة والعالم. والكُتاب بصفتهم «أصوات المجتمع»، من الطبيعي أن يتحملوا المسؤولية بقلمهم.
الحيوان والإيكولوجيا
الآن، يعد الإيكولوجيا من الموضوعات الأكثر تناولًا عند ذكر سرد الحيوان ونقد الحيوان ويهدف هذا الموضوع إلى تفكيك المركزية الإنسانية. عاد النفط بالنفع الهائل على الدول العربية بعد استكشافه واستخراجه، ولكنه في الوقت نفسه تسبب في التصحر وتلوث البحر في بعض الدول والجفاف. حسب التقرير الصادر في عام 2017م، انخفض عدد الحيوانات في الصحراء انخفاضًا حادًّا في العقود المنصرمة؛ بسبب الاصطياد المفرط والتصحر، بما في ذلك نوع من الظبي لم يكن عددُه قليلًا في الصحراء في بداية القرن الماضي، ولكنه أصبح من أندر الحيوانات في الأرض الآن. ألحقَ الإنسان الخسائر الهائلة بالحيوانات مما عرّضها للانقراض أو الانخفاض في العدد أو النوع. وقد أولى إبراهيم الكوني اهتمامًا بالغًا بالبيئة، كما قال في مقابلة: «إنني أعبّر عن عالم بيئي. عالم بيئي بالفطرة. عالم بيئي يقدس الطبيعة كأم حقيقية»(٣).
صدرت رواية «التبر» لإبراهيم الكوني، في عام 1990م وتحكي ما حدث بين أوخيّد والأبلق. أصيب الأبلق بداء الجرب بعد مغامراته مع الناقة، فجدّ أوخيّد معه في البحث عن الدواء من أجل إنقاذه من براثن الموت. وبعد شفائه، وقع في فخ دودو مما ألحقه بعار لا مثيل له في الصحراء. وفي نهاية الرواية، تعرّض أوخيّد والأبلق للقتل. دارت الرواية حول الاعتماد المتبادل بينهما لتكشف لنا عن المركزية الإنسانية وأضرارها على الحيوانات؛ إذ إن الإنسان اتخذ الحيوان أداةً لمصلحة نفسه وعذّبه عشوائيًّا لتوجيه الانتقادات إلى هذه العقلية من منظور توافق الذوات (Intersubjectivity) والحوار وضمير الغائب. الأثمن من ذلك، استعار الكاتب الحيوان كرمز لثقافة الطوارق؛ لإظهار التوافق بين الحيوان والإنسان منذ القدم، ويجد طريقًا رحبًا للإفلات من المركزية الإنسانية.
في الوقت نفسه، ثمة نقطة يجب علينا تعميق التفكير فيها. دعا بعض النقاد عند الدراسة إلى العودة التامة إلى الطبيعة بعد أن وجدوا ما تعرضت له بأفعال الإنسان. ولكن علينا أن نتذكر: هل العودة الكاملة إلى الطبيعة أمر محتمل في العصر الحديث؟ هل هي «المركزية الإيكولوجية»؟ ما نسعى إليه هو التنمية المشتركة الأكثر تواؤمًا وخضرةً، ليس الاهتمام بالجانب مع التعامي عن الجانب الآخر. قرن الناقد نيه تشن تشاو نقد الأخلاق بالنقد الإيكولوجي؛ ليطرح أن «الأزمة الإيكولوجية من الإنسان نفسه. ولكن لا بد من الاعتماد عليه لمعالجة هذه الأزمة. عليه أن يدرك مكانته كذات في الأرض ويتحمل المسؤولية المطلوبة. على الرغم من أنه لم يصبح مركزًا في العالم، لكن يمكنه أن يلعب دوره لاتخاذ الاختيارات الأخلاقية الصحيحة وإيجاد طريق الخروج من المأزق»(٤). من ثمّ، لا يمكننا إنكار الإنسان ككائن في الأرض عند اتهامه باتباع المركزية الإنسانية، أو بالأحرى، علينا إدراك توافق الذوات بين الإنسان والطبيعة والحيوان.
الحيوان والتصوف
من تجارب الكتابة الفريدة لشعراء وأدباء الأدب العربي الحديث والمعاصر التغذي بفلسفة التصوف. يعد التصوف من المذاهب الإسلامية ويتمتع بالخصائص العربية الفريدة. وقد تأثر الكتاب العرب مثل نجيب محفوظ وجمال الغيطاني ومحمد ديب تأثرًا ملحوظًا بالتصوف وأبدعوا أعمالًا فريدةً ذات سمات عربية. ذكر الغيطاني في مناسبات عدة أهمية التصوف واصفًا إياه بمنبع الإلهام وذي أهمية كبيرة.
استلهم الغيطاني من التراث المصري والعربي والتاريخ ليخلق عالمًا روائيًّا فريدًا يعد من تجارب الكتابة الناضجة، ويأمل من خلالها في رأب الشق الثقافي، وإعادة هيكلة ثقافة الأمة؛ لذلك ولدت رواية «هاتف المغيب» بقلمه، وتحكي عن رحلة البطل أحمد من القاهرة إلى الغرب بعد سماعه «ارحل» ومغامراته مع الشخصيات المختلفة، وتحوّل مكانته من العادي إلى الملك ليدرك في الأخير جوهر الحياة والوجود. إذا حلّلنا هذه الرواية من منظور نقد الحيوان، فسنجد صورةً مهمةً: الطير، وبخاصة قبل النداء الرابع، الذي أصبح ملك المملكة، واحتلت هذه المغامرة تقريبًا نصف حجم الرواية، أكسبها أهمية بالغة. أما المتصوفون، فالطير من الرموز الواضحة وقد ذُكر مرارًا في الأدب العربي. يرى المتصوف أن رحلة الطيور هي رحلة للتقرب من الله، كما جاء في «منطق الطير» الذي نظمه فريد الدين العطار وتألف من 4500 بيت، وموضوعه بحث الطيور عن السيمورغ (طائر خرافي)، والطيور هنا ترمز إلى أهل الصوفية، والسيمورغ يرمز إلى الله.
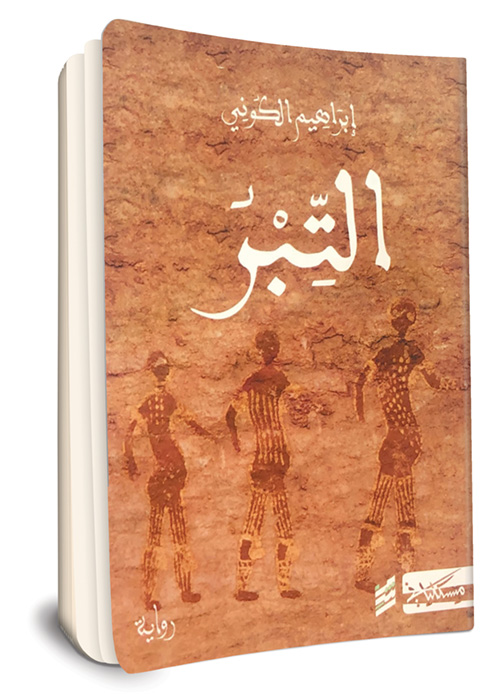 أبدع الغيطاني في تصوير الطير في النص للتعبير عن فكرته وفلسفته. في رحلة أحمد الأولى، حكى أحد الأشقاء الأربعة له عن أبيه الذي ألمّ بالطيور كل إلمام، وعرف أصواتها جميعًا. من الواضح أن الغيطاني رمز إلى أهل الصوفية بالطيور وشيخ الصوفية بأبيه. وفي الرحلة الثالثة، أي في المملكة، تصبح التلميحات أوضح، صورة الطيور ملصوقة في كل مكان والملابس مصنوعة من ريش الطيور. يمكننا أن نرى أن الكاتب تعمق في الكشف عن الأمراض الاجتماعية من خلال التناص أو الاستلهام من الثقافة العربية التقليدية أو التغذي بالثقافة الصوفية؛ لتحقيق أمله في نهضة الثقافة العربية وحرية الدين.
أبدع الغيطاني في تصوير الطير في النص للتعبير عن فكرته وفلسفته. في رحلة أحمد الأولى، حكى أحد الأشقاء الأربعة له عن أبيه الذي ألمّ بالطيور كل إلمام، وعرف أصواتها جميعًا. من الواضح أن الغيطاني رمز إلى أهل الصوفية بالطيور وشيخ الصوفية بأبيه. وفي الرحلة الثالثة، أي في المملكة، تصبح التلميحات أوضح، صورة الطيور ملصوقة في كل مكان والملابس مصنوعة من ريش الطيور. يمكننا أن نرى أن الكاتب تعمق في الكشف عن الأمراض الاجتماعية من خلال التناص أو الاستلهام من الثقافة العربية التقليدية أو التغذي بالثقافة الصوفية؛ لتحقيق أمله في نهضة الثقافة العربية وحرية الدين.
ومن خلال الاقتران بين نقد الحيوان والصوفية وعلى أساس التاريخ والمجتمع والسياسة في الدول العربية، يمكن للناقد الكشف عن معنى أعمق لهذه الروايات. بالإضافة إلى ذلك، المسخ في الثقافة الصوفية يمكن أن يُقترن بالنقد الإيكولوجي لزيادة أوجه الدراسات.
خاتمة
بالمقارنة مع أدباء الدول الأخرى، تحمّل أدباء الدول العربية الوعي السياسي، وهو الأمر الذي أكسب أعمالهم وظائف اجتماعية أكثر لإثارة وعي الجماهير بالدولة والعالم؛ لذلك، يمكن أن نقرن نقد الحيوان بتحرير المرأة وما بعد الاستعمار وتنمية الدولة، بالإضافة إلى الهوية والإيكولوجيا والتصوف عند تحليل الروايات العربية لاستكشاف أعمق معنى للنص. كما أنه مع ظهور كتاب الثمانينيات والتسعينيات في ساحة الأدب العربي، صدرت روايات أكثر عن الحيوان. في ذلك الوقت، إذا لم نطبّق النظرية الحديثة عند دراساتنا، قد لا نستطيع حل لغز النص بشكل كامل.
عند الدراسة، حاولتُ الاستلهام من منبع الثقافة العربية والأدب العربي بقدر الاستطاعة لأن يصبح نقد الحيوان أكثر «توطينًا» وأنسب لظروف الدول العربية. في الحقيقة، لم يخلُ الأدب العربي منذ القدم من وصف الحيوان مثل الجمل والطيور والنمل في «كليلة ودمنة» و«المعلقات». ونرى أن التشخيص أو الوصف البسيط للحيوان إما لإظهار الحب للحيوان أو لتقديم الوعظ للملك. وعلى الرغم من بساطته ما زال يستحقّ الدراسة العميقة والبحث الدقيق. وما زلتُ أعمل على تعميق الدراسة في هذا المجال مع الأمل في الكشف عن «الطعام العربي» في الروايات العربية.
هوامش:
(١) ابن رشد، أبو الوليد، «تلخيص أخلاق أرسطو»، ترجمه من العبرية أحمد شحلان، (الرباط، 2018م)، 229.
(٢) ابن رشد، أبو الوليد، «الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون»، نقله من العبرية إلى العربية أحمد شحلان، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998م).
(٣) ابن رشد، «تهافت التهافت»، تحقيق موريس بويج، (ط2، بيروت، دار المشرق، 1987م)، 584: 3-6.
(٤) ابن رشد، «تلخيص أخلاق أرسطو»، 225-226.
(٥) ابن رشد، «تهافت التهافت» 226: 6-10.

 بدأ البحث الأدبي عمومًا بالترجمة الأدبية. بين عامي 1949 و1978م، كانت الأبحاث ذات صلة بالأدب العربي في مرحلة الترجمة والتقديم بشكل أساسي، ولم تُنشَر أية أبحاث أكاديمية ذات صلة.
بدأ البحث الأدبي عمومًا بالترجمة الأدبية. بين عامي 1949 و1978م، كانت الأبحاث ذات صلة بالأدب العربي في مرحلة الترجمة والتقديم بشكل أساسي، ولم تُنشَر أية أبحاث أكاديمية ذات صلة.

 يمكن أن نرى بعض الاتجاهات المهمة في دراسات الأدب العربي في الصين منذ تأسيس الصين الجديدة، ويسرنا كثيرًا أن نرى ازدهار وتقدم دراسات الأدب العربي في الصين. وفي الوقت نفسه، أطرح بعض الاقتراحات: أولًا، إن صفوف دراسات الأدب العربي آخذة في النمو، لكنها ليست قوية بعد. في الوقت الحالي، فإن الروايات المختارة عند دراسات الأدب العربي ليست كثيرة. وإذا أخذنا الأعمال الفائزة بجائزة البوكر العربية مثالًا، يمكن أن نرى أن الدراسات بشكل أساسي تركز على «ساق البامبو» لسعود السنعوسي، و«فرانكنشتاين في بغداد» لأحمد السعداوي، و«طوق الحمام» لرجاء عالم. ولكنْ هناك عدد قليل جدًّا من الدراسات حول الأعمال الأخرى الحائزة على جوائز مثل «القوس والفراشة»، و«الديوان الإسبرطي»، و«تغريبة القافر» وما إلى ذلك؛ لذا يجب على الباحثين الصينيين إيلاء مزيد من الاهتمام بالروايات العربية الممتازة وتوسيع آفاقهم في الدراسات من أجل زيادة تفاهم الشعوب بين الجانبين من خلال الأدب.
يمكن أن نرى بعض الاتجاهات المهمة في دراسات الأدب العربي في الصين منذ تأسيس الصين الجديدة، ويسرنا كثيرًا أن نرى ازدهار وتقدم دراسات الأدب العربي في الصين. وفي الوقت نفسه، أطرح بعض الاقتراحات: أولًا، إن صفوف دراسات الأدب العربي آخذة في النمو، لكنها ليست قوية بعد. في الوقت الحالي، فإن الروايات المختارة عند دراسات الأدب العربي ليست كثيرة. وإذا أخذنا الأعمال الفائزة بجائزة البوكر العربية مثالًا، يمكن أن نرى أن الدراسات بشكل أساسي تركز على «ساق البامبو» لسعود السنعوسي، و«فرانكنشتاين في بغداد» لأحمد السعداوي، و«طوق الحمام» لرجاء عالم. ولكنْ هناك عدد قليل جدًّا من الدراسات حول الأعمال الأخرى الحائزة على جوائز مثل «القوس والفراشة»، و«الديوان الإسبرطي»، و«تغريبة القافر» وما إلى ذلك؛ لذا يجب على الباحثين الصينيين إيلاء مزيد من الاهتمام بالروايات العربية الممتازة وتوسيع آفاقهم في الدراسات من أجل زيادة تفاهم الشعوب بين الجانبين من خلال الأدب.
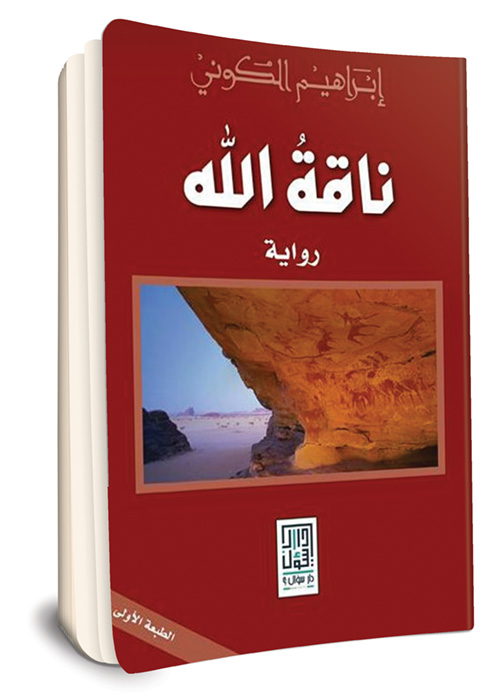 حكت الرواية عما حدث بين الراعي والناقة في ستينيات القرن الماضي حين قُسمَت الصحراء الكبرى بين الدول وهُجّر الطوارق من أوطانهم، وبدأت معاناتهم. تاقت الناقة «تاملالت» حنينًا ووجدًا إلى موطنها، وقاتلت على الرغم من كل القيود، وبغض النظر عن الأخطار. لكن راعيها خاف من موتها خلال مغامراتها، فبحث عنها كل مرة هربت فيها منه لبدء المغامرة الجديدة. انجلى موضوع الرواية بوضوح مع أخذ البحث عن الموطن خيلًا ربط الرواية بعضها ببعض. ومن الواضح أن هذه الرواية مبنية، حبكةً ومبنًى، على سرد الحيوان؛ إذ إن بطل هذه الرواية ليس إلا ناقة.
حكت الرواية عما حدث بين الراعي والناقة في ستينيات القرن الماضي حين قُسمَت الصحراء الكبرى بين الدول وهُجّر الطوارق من أوطانهم، وبدأت معاناتهم. تاقت الناقة «تاملالت» حنينًا ووجدًا إلى موطنها، وقاتلت على الرغم من كل القيود، وبغض النظر عن الأخطار. لكن راعيها خاف من موتها خلال مغامراتها، فبحث عنها كل مرة هربت فيها منه لبدء المغامرة الجديدة. انجلى موضوع الرواية بوضوح مع أخذ البحث عن الموطن خيلًا ربط الرواية بعضها ببعض. ومن الواضح أن هذه الرواية مبنية، حبكةً ومبنًى، على سرد الحيوان؛ إذ إن بطل هذه الرواية ليس إلا ناقة.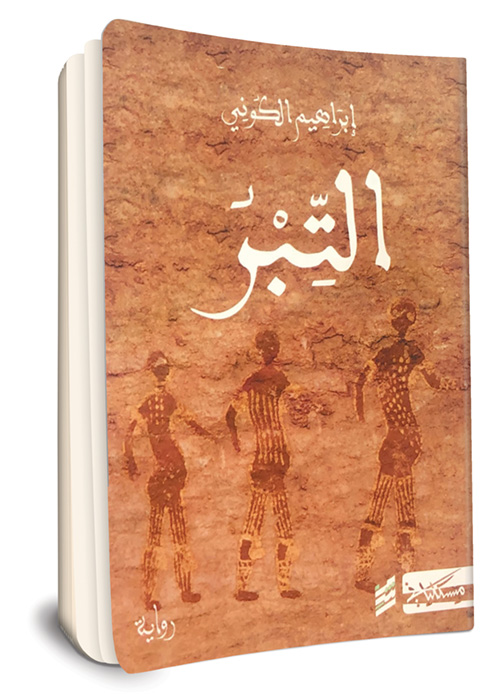 أبدع الغيطاني في تصوير الطير في النص للتعبير عن فكرته وفلسفته. في رحلة أحمد الأولى، حكى أحد الأشقاء الأربعة له عن أبيه الذي ألمّ بالطيور كل إلمام، وعرف أصواتها جميعًا. من الواضح أن الغيطاني رمز إلى أهل الصوفية بالطيور وشيخ الصوفية بأبيه. وفي الرحلة الثالثة، أي في المملكة، تصبح التلميحات أوضح، صورة الطيور ملصوقة في كل مكان والملابس مصنوعة من ريش الطيور. يمكننا أن نرى أن الكاتب تعمق في الكشف عن الأمراض الاجتماعية من خلال التناص أو الاستلهام من الثقافة العربية التقليدية أو التغذي بالثقافة الصوفية؛ لتحقيق أمله في نهضة الثقافة العربية وحرية الدين.
أبدع الغيطاني في تصوير الطير في النص للتعبير عن فكرته وفلسفته. في رحلة أحمد الأولى، حكى أحد الأشقاء الأربعة له عن أبيه الذي ألمّ بالطيور كل إلمام، وعرف أصواتها جميعًا. من الواضح أن الغيطاني رمز إلى أهل الصوفية بالطيور وشيخ الصوفية بأبيه. وفي الرحلة الثالثة، أي في المملكة، تصبح التلميحات أوضح، صورة الطيور ملصوقة في كل مكان والملابس مصنوعة من ريش الطيور. يمكننا أن نرى أن الكاتب تعمق في الكشف عن الأمراض الاجتماعية من خلال التناص أو الاستلهام من الثقافة العربية التقليدية أو التغذي بالثقافة الصوفية؛ لتحقيق أمله في نهضة الثقافة العربية وحرية الدين.