
سلمان زين الدين - ناقد لبناني | نوفمبر 1, 2024 | دراسات
منذ نحو قرن من الزمان، وبالتحديد في عام 1930م، صدرت الرواية السعودية الأولى «التوأمان» لعبدالقدوس الأنصاري. وفي عام 1947م، صدرت الرواية الثانية «فكرة» لأحمد السباعي. وفي عام 1948م، صدرت الرواية الثالثة «البعث» لمحمد علي مغربي. ثم كرت سبحة الإصدارات الروائية، بإيقاع بطيء حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبإيقاع سريع منذ ذلك التاريخ، في حركة روائية متسارعة، راحت تنمو، على الزمان، كمًّا ونوعًا، وتمخضت عن مئات الروايات التي صنعت للرواية السعودية موقعًا متقدمًا على خريطة الرواية العربية.
على أن الدارسين يجنحون إلى تجزئة هذه الحركة الطويلة إلى مراحل، لكل منها ميزاتها المختلفة عن الأخرى. وفي هذا السياق، يقسم الدارس السعودي حسن النعمي تاريخ الرواية السعودية إلى أربع مراحل تنتظم حركتها، هي: مرحلة النشأة (1930–1954م)، مرحلة التأسيس (1955–1979م)، مرحلة الانطلاق (1980–1990م)، ومرحلة التحولات الكبرى (1991– حتى تاريخه). ولكل من المراحل الأربع علاماتها الفارقة؛ ففي حين تتسم الأولى بالضعف الفني والرؤية المحافظة، وتتصف الثانية بقلة الإنتاج العددي وعدم الاختراق النوعي، وتشهد الثالثة الانفتاح الاجتماعي والتطور الاقتصادي والنمو التعليمي، تشكل الرابعة مرحلة التحولات الكبرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يتجرأ فيها الروائيون على الخوض في المسكوت عنه والحفر في الممنوع، مستفيدين من الهوامش التي أتاحتها التحولات المختلفة. (حسن النعمي، الرواية السعودية واقعها وتحولاتها). وإلى هذه المرحلة الرابعة والأخيرة، تنتمي الروايات التي تتناولها هذه الدراسة.

حسن النعمي
رواية التحولات الكبرى
تشغل التحولات الكبرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيزًا ملحوظًا في الروايات المدروسة؛ فعلى المستوى السياسي، تطرح رواية «ساق الغراب» ليحيى أمقاسم سؤال التحول من إطار العشيرة إلى إطار الإمارة، في مرحلة ما قبل توحيد المملكة، وهو ما يتوافق مع سنة التطور التي تقول بالانتقال من الأطر الصغرى إلى الأطر الكبرى، وينجم في الرواية عن اصطدام بين منظومتي قيم مختلفتين، تتمخض عنه سيطرة المنظومة الكبرى على الصغرى، على الرغم من الممانعة التي تبديها الأخيرة.
 على المستوى الاقتصادي، تطرح رواية «كائن مؤجل» لفهد العتيق سؤال المرحلة الانتقالية التي عاشها المجتمع السعودي، غداة الطفرة الاقتصادية الناجمة عن اكتشاف البترول، وهي مرحلة لا تزال ترخي بظلالها عليه، زمنيًّا ومكانيًّا وإنسانيًّا. فعلى المستوى الأول، ثمة انتقال من الماضي إلى الحاضر، وعلى المستوى الثاني، ثمة انتقال من بيوت الطين في الحارات القديمة إلى بيوت الخرسانة الجديدة والشقق السكنية، وعلى المستوى الثالث، ثمة انتقال من حياة الفقر والكفاف إلى حياة الاستهلاك. وفي هذه المرحلة الانتقالية، يبدو الكائن قيد التحقق؛ فانتقال خالد، بطل الرواية، من بيت طيني قديم إلى فيلا حديثة يجعل الأسرة تترجح نفسيًّا بين مكانين اثنين، تحن إلى الأول، على ضيقه، لعلوق رائحته بأجساد أفرادها. وتضيق بالثاني، على رحابته، لافتقاره إلى الروح. على أن هذا الانتقال المكاني يتزامن مع انتقال آخر، في الاتجاه المعاكس، على المستوى النفسي، حين تنتقل الأسرة من الطمأنينة والسكينة إلى الغربة والقلق والملل والفراغ وعدم الاستقرار. وهو ما تعكسه شخصية بطل الرواية، من خلال: تغييره الدائم للعمل، إحساسه برتابة الأيام، الخلل في علاقته مع الأب، الخوف من كل شيء، الخوض في وحول الحياة السفلية، وعدم تحقيق الأحلام. وبذلك، نكون إزاء منظور روائي سلبي للطفرة الاقتصادية المترتبة على اكتشاف البترول.
على المستوى الاقتصادي، تطرح رواية «كائن مؤجل» لفهد العتيق سؤال المرحلة الانتقالية التي عاشها المجتمع السعودي، غداة الطفرة الاقتصادية الناجمة عن اكتشاف البترول، وهي مرحلة لا تزال ترخي بظلالها عليه، زمنيًّا ومكانيًّا وإنسانيًّا. فعلى المستوى الأول، ثمة انتقال من الماضي إلى الحاضر، وعلى المستوى الثاني، ثمة انتقال من بيوت الطين في الحارات القديمة إلى بيوت الخرسانة الجديدة والشقق السكنية، وعلى المستوى الثالث، ثمة انتقال من حياة الفقر والكفاف إلى حياة الاستهلاك. وفي هذه المرحلة الانتقالية، يبدو الكائن قيد التحقق؛ فانتقال خالد، بطل الرواية، من بيت طيني قديم إلى فيلا حديثة يجعل الأسرة تترجح نفسيًّا بين مكانين اثنين، تحن إلى الأول، على ضيقه، لعلوق رائحته بأجساد أفرادها. وتضيق بالثاني، على رحابته، لافتقاره إلى الروح. على أن هذا الانتقال المكاني يتزامن مع انتقال آخر، في الاتجاه المعاكس، على المستوى النفسي، حين تنتقل الأسرة من الطمأنينة والسكينة إلى الغربة والقلق والملل والفراغ وعدم الاستقرار. وهو ما تعكسه شخصية بطل الرواية، من خلال: تغييره الدائم للعمل، إحساسه برتابة الأيام، الخلل في علاقته مع الأب، الخوف من كل شيء، الخوض في وحول الحياة السفلية، وعدم تحقيق الأحلام. وبذلك، نكون إزاء منظور روائي سلبي للطفرة الاقتصادية المترتبة على اكتشاف البترول.
على المستوى الاجتماعي، تطرح رواية «سقف القرية… قاع المدينة» لمحمد عبدالله الغامدي سؤال التحول، من خلال العلاقة بين الريف والمدينة، في عالم مرجعي تتراجع فيه منظومة القيم الريفية القائمة على المشاركة والتعاون والتضامن، لصالح أخرى وافدة من المدينة، تقوم على المصلحة والتشدد الديني والعلاقات المادية العابرة.
الفرد والجماعة
إذا كانت التحولات الكبرى غالبًا ما تصنعها الجماعات، فإن عائداتها تعود على الأفراد، وتبعاتها تقع عليهم. على أن الرواية قلما تهتم بالعائدات، وغالبًا ما تشتغل على التبعات، في محاولة منها لمساءلتها وتحويلها إلى عائدات، إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، وهو ما ينطبق على الرواية السعودية وغيرها؛ لذلك تشغل علاقة الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها حيزًا كبيرًا في الرواية السعودية، وحين تصطدم رغبات الفرد وميوله ونزعاته بقيم الجماعة، تترتب على ذلك الاصطدام ترددات كثيرة، تختلف من فرد إلى آخر. وهو ما نراه في عدد من الروايات المدروسة. في «الحَمَام لا يطير في بريدة» ليوسف المحيميد، تتمظهر ترددات الاصطدام في عدم التكيف والاغتراب وعدم الانتماء والقمع الفكري والكبت الجنسي، وهو ما يدفع الفرد إلى الرحيل عن المكان الذي تقيم فيه الجماعة. فهد السفيلاوي، بطل الرواية، يتذكر، خلال رحلة بالقطار من لندن إلى غريت يارموث في تموز 2007م، حياته الماضية، وما وقع عليه من تحرش جنسي وموت الوالدين وتسلط العم، ما حدا به إلى الرحيل وتلمس سبل الخلاص، عبر الرسم وصورة الأب والصداقة والحب والعلاقات العابرة، فيستعيد في الحاضر توازنًا أفقده إياه الماضي.
على أن الترددات الناجمة عن الاصطدام بين رغبات الفرد وقيم الجماعة قد تتعدد في الرواية الواحدة، وتتوزع على مجموعة من الشخوص الروائية، وهو ما نراه في رواية «العتمة» لسلام عبدالعزيز التي تتجاور فيها القَبَلية والطائفية والقمع الإداري والكبت والخيانة الزوجية والعقلية الذكورية، في آنٍ واحد. وتكون لها تمظهراتها في وقائع روائية مختلفة.
المرأة والرجل
وتغدو وطأة الترددات أثقل حين تقع على كاهل امرأة، ولا سيما أن المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمعات المحافظة، وتُلقى على عاتقها تبعات المحافظة. وهو ما يطرحه عدد من الروايات المدروسة، من زوايا مختلفة. في رواية «الشيطان يحب أحيانًا» لزينب حفني التي تتناول العلاقات غير المتكافئة بين الرجل المرأة في مجتمع ذكوري، تزدوج فيه المعايير، وتختل الموازين، تبدو المرأة خاضعة للرجل، مغلوبة على أمرها، تلوذ بالصمت ولا تجرؤ على المطالبة بأبسط حقوقها. ويبدو الرجل حاكمًا بأمره، يقوم بما تُسول له نفسه من الأعمال، وليس ثمة من يجرؤ على محاسبته. وهو ما نراه من خلال العلاقة بين الزوجين، مالك وعواطف؛ فالأول شخصية مدللة، غير مبالية، عابثة، متهتكة، منخرطة في حياة اللهو والمجون، على شيء من الخبث والدهاء، ولا يتورع عن ارتكاب شتى الموبقات دون أدنى تقدير للعواقب؛ لذلك، نراه يتزوج مرتين، ينخرط في علاقات عابرة، يخوض مغامرات غرامية، ويرتكب خيانات متعددة. والثانية شخصية ضعيفة، خانعة، تؤثر الصمت على المواجهة، وتتخذ موقفًا سلبيًّا من مسألة حيوية تتعلق بحقها الزوجي وكرامتها الشخصية؛ لذلك نراها تعجز عن الاحتجاج على ممارسات الزوج ووضع حد لخياناته المتكررة، وهو ما لا يتناسب مع نشأتها في أسرة داعمة لها، وامتلاكها حق اختيار الزوج، وممارستها رياضة ركوب الخيل، ودراستها اللغة الإنجليزية، ما يطرح مسالة بناء الشخصية على المحك. غير أن ما تعجز عواطف عن القيام به، من وضع حد لخيانات مالك، تتكفل به الأقدار بدلًا منها، فيُصاب بجلطة دماغية تؤدي إلى شلل جانبه الأيسر، وتعطيل وظائف جسده الحيوية، فيتردى في مهاوي الندم، ولات ساعة مندم.

وفي رواية «الأرجوحة» لبدرية البشر، تتعدد مصادر القمع الواقع على المرأة وأنواعه وردود الأفعال عليه؛ فتُراوِحُ مصادره بين الأب والأخ والزوج والحبيب. وتُراوِحُ أنواعه بين الضغط الزوجي والاستهتار الأبوي والتسلط الأخوي. وتختلف ردود الأفعال عليه من امرأة إلى أخرى باختلاف التربية والظروف. إن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات المحافظة كثيرًا ما تفتقر إلى التكافؤ بين طرفيها؛ فالرجل يمتلك القدرة على الهجر والطلاق والإغواء والتحرش والخيانة والإيقاع بالمرأة والتخلي عنها والتهرب من المسؤولية. والمرأة هي الضحية، ترزح تحت تلك الأفعال، وتدفع الثمن الغالي لرزوحها الذي قد يكون حياتها، في بعض الأحيان. هذا ما تطرحه مريم النويمي في «أنوثة شاغرة»، من خلال رصدها تحولات العلاقة بين وليد عمران، تقني المختبر المنتحل صفة دكتور، وفرائسه من النساء؛ ذلك أنه يحاصر الواحدة منهن باتصالاته وهداياه وعروضه، حتى إذا ما وقعت في شباكه ونال منها مأربًا، يتخلى عنها ويبحث عن فريسة جديدة. وهكذا، تسقط اثنتان من طرائده الثلاث في براثنه، وتؤولان إلى مصير قاتم، فتسقط هبة جثة هامدة، وتقف حنان على باب جمعية نسائية طالبة الإيواء مقابل أي عمل. بينما يتدخل القدر في مصلحة ندى قبل السقوط، فيعود زوجها من هجرته في الوقت المناسب.

والدليل على ما نقول أن المرأة في رواية «عبث» لإبراهيم محمد النملة هي التي تمتلك زمام المبادرة في علاقتها بالرجل؛ ففي وسط اجتماعي محافظ، تتعذر معه علنية العلاقة بين الرجل والمرأة، تجترح الأخيرة مسارب سرية محفوفة بالمخاطر والصعوبات لإقامة العلاقة. وعليه، تبادر القارئة اللعوب إلى استخدام الرسائل الإلكترونية والتواصل الهاتفي واللقاءات المباشرة للإيقاع بكاتب صحافي، زاعمةً أنها معجبة بمقالاته، حتى إذا ما نجحت في ذلك واعترف لها بحبه، تقلب له ظهر المجن، وتمتنع عن الإجابة على اتصالاته، وتغير مكان إقامتها، وهو ما يذكي أوار عاطفته المشبوبة، ويؤجج مشاعره نحوها، ويجعله يتردى في مهاوي الفقد والحزن والخيبة. وتكون الطامة الكبرى حين يكتشف أنه كان ضحية فتاة مغرورة، اتخذته وسيلة لإثبات ذاتها وإرضاء غرورها، في لحظة تحدٍّ لرفيقاتها، وهو ما يجعل الحب، من جهتها، نوعًا من العبث بمشاعر الآخرين. هنا أيضًا تُطرح مسألة بناء الشخصية على بساط البحث، فكيف لفتاة مغرورة أن تخدع كاتبًا صحافيًّا يُفترَض أنه أعلم منها ببواطن الأمور.
السياسة والدين والمجتمع
إضافة إلى ذلك، تشغل السلطة، على أنواعها، السياسية والدينية والاجتماعية، ثلاثًا من الروايات المدروسة، بوتيرة نوع واحد لكل منها؛ ففي «مملكة جبران»، يطرح إبراهيم الهطلاني، سؤال السلطة السياسية، من خلال آليات ممارستها في فضاء روائي متخيل، في القرن السابع عشر. وفي «الخطيب»، يطرح هاني نقشبندي سؤال السلطة الدينية، ويفكك ممارسات بعض القائمين بهذه السلطة الذين يتخذون الدين مطية لمآرب خاصة، ولا يتورعون عن ارتكاب الخطايا مستغلين سذاجة العامة وجهلهم وبلاهتهم. ويبين خطورة استخدام الشعائر الدينية في غير ما وُضعت له في الأصل ما يخرج بأماكن العبادة عن وظيفتها، ويجعل منها مقارَّ للتطرف والتكفير والحض على العنف والإرهاب بدلًا من أن تكون بيوت الله والصلاة والتسامح. هذا ما يفعله الروائي من خلال تفكيك ممارسات الخطيب والمؤذن في إحدى القرى، ورصد تأثير النشأة في أداء كل منهما؛ فالخطيب الذي ينشأ في أسرة مفككة، ويعاني قسوة الأب، ورحيل الأم، ما يؤدي إلى قتل الإنسان فيه وإصابته بخواء عاطفي، يهرب من واقعه إلى الدين، ويمارسه ترهيبًا وغضبًا وانتقامًا لا حبًّا. والمؤذن الذي يعاني موت الأب وزواج الأم، وينشأ في كنف الأخ الأكبر إلى أن تطرده زوجته، وتحول قلة تعلمه دون العثور على عمل يعتاش منه، تتقطع به السبل ويجد نفسه على عتبة المسجد، فيعثر عليه الإمام ويعينه مؤذنًا، تنعكس نشأته على أدائه.

يحيى أمقاسم
وفي «زرياب» التي يستوحي فيها مقبول العلوي سيرة المغني المشهور في العصر العباسي، يطرح سؤال السلطة الاجتماعية، المتداخلة مع السياسة، ويتناول حياة القصور في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وما يحاك فيها من دسائس ومؤامرات، وما تصنعه من مصاير ومسارات، وما تفاجئ به من تقلبات وانقلابات، ما يتكشف عن ازدواجية الطبيعة البشرية، وتقديم المصالح على المبادئ، والتناقض بين المظهر والمخبر، واتخاذ الدين مطية للتسلق واقتناص المناصب، واندلاع الصراعات على السلطة، وتنوع الخلفاء وتفاوت مستوياتهم، وطبيعة العلاقة بين السادة والعبيد، وهو ما نستخلصه من حياة زرياب التي امتدت سبعة عقود ونيف، جاب فيها الأصقاع المتباعدة، وخاض فيها تجارب عديدة، وتقلب بين الخلفاء والأمراء إلى أن استقرت به الحال لدى أمير الأندلس عبدالرحمن بن الحكم الذي احتفى به وقدره حق قدره، وفي كنفه تتحقق أحلامه، وينجح في إدخال حضارة بغداد إلى الأندلس.
الحرية والإرادة والقدر
وبعد، إذا كانت التحولات الكبرى، والعلاقات المتعددة الأطراف، والسلطات على أنواعها، هي الأسئلة التي تشغل العدد الأكبر من الروايات المدروسة، مما تناولناه آنفًا، فإن أسئلة أخرى تشغل العدد الأصغر من الروايات، كالحرية والإرادة والقدر، مما نفصله فيما يأتي. في هذا السياق، يطرح غازي القصيبي في «شقة الحرية» سؤال الحرية من زاوية أنها سلاح ذو حدين، فالحد منها يحول الفضاء العام إلى سجنٍ كبير، والإفراط فيها يحوله إلى برج بابل؛ لذلك لا بد من الحرية المسؤولة كي لا تخرج الحرية عن حدها، وتنقلب إلى ضدها. هذا ما يقوله القصيبي من خلال رصده حياة أربعة شبان بحرينيين، قصدوا القاهرة، أواخر خمسينيات القرن الماضي، في طلب العلم، وأفادوا من هامش الحرية الواسع فيها تعويضًا عن ضيق هذا الهامش في بلدهم الأصلي، ومارسوا نشاطهم في الدراسة الجامعية والعلاقات العابرة والعمل الحزبي، وانخرطوا في الحوارات السياسية والفكرية، وانغمسوا في مواقعة اللذات، وانحرفوا عن جادة الصواب، وأسرفوا على أنفسهم بداعي الحرية، وهو ما ترتب عليه نتائج وخيمة بالنسبة إلى كل منهم.
 وإذا كانت الحرية فعل إرادة بشرية بامتياز، فإن فعل الإرادة هو السؤال الذي تطرحه مها محمد الفيصل في «توبة وسليى»، من خلال مسارين سرديين متداخلين، واقعي/ أسطوري وأسطوري، يؤولان إلى مصيرين متشابهين، تنتصر الإرادة البشرية في كل منهما؛ ففي المسار الأول ينطلق فارس آل رضوان في رحلة سندبادية، يواجه فيها المخاطر والأهوال، وتقوده خطاه إلى مركب العطاء والقبطان مراد والجارية سليى التي تنسج سجادة تسجن فيها الأحياء، حتى إذا ما قام القراصنة بسرقة كتابها الأحمر، يضع فارس نصب عينيه استعادته، ويخوض دونه المغامرات الخطيرة، ويتمكن من تحقيق هدفه، في نهاية المطاف. وفي المسار الثاني ينطلق الراعي، في رحلة سندبادية، بحثًا عن دواء لحبيبته نوران، يلتقي خلالها فتاةَ الشوكِ التي تسببت في مرضها، وتبحث عمن يخلصها من ثوب الشوك الذي يلازمها عقابًا لها، وتقودهما الرحلة إلى البحيرة عاشقة القمر، حيث تنخطف هي بعد سقوط ورقة رائعة الجمال من الجنة في حجرها، ويعود هو بعبق القمر ونمير الأبصار دواءً يمسح به جبين حبيبته، فتشفى. وبذلك، تعلي الرواية قيمة الإرادة البشرية، وتقول بقدرة الإنسان على تحقيق أهدافه إذا ما أراد ذلك.
وإذا كانت الحرية فعل إرادة بشرية بامتياز، فإن فعل الإرادة هو السؤال الذي تطرحه مها محمد الفيصل في «توبة وسليى»، من خلال مسارين سرديين متداخلين، واقعي/ أسطوري وأسطوري، يؤولان إلى مصيرين متشابهين، تنتصر الإرادة البشرية في كل منهما؛ ففي المسار الأول ينطلق فارس آل رضوان في رحلة سندبادية، يواجه فيها المخاطر والأهوال، وتقوده خطاه إلى مركب العطاء والقبطان مراد والجارية سليى التي تنسج سجادة تسجن فيها الأحياء، حتى إذا ما قام القراصنة بسرقة كتابها الأحمر، يضع فارس نصب عينيه استعادته، ويخوض دونه المغامرات الخطيرة، ويتمكن من تحقيق هدفه، في نهاية المطاف. وفي المسار الثاني ينطلق الراعي، في رحلة سندبادية، بحثًا عن دواء لحبيبته نوران، يلتقي خلالها فتاةَ الشوكِ التي تسببت في مرضها، وتبحث عمن يخلصها من ثوب الشوك الذي يلازمها عقابًا لها، وتقودهما الرحلة إلى البحيرة عاشقة القمر، حيث تنخطف هي بعد سقوط ورقة رائعة الجمال من الجنة في حجرها، ويعود هو بعبق القمر ونمير الأبصار دواءً يمسح به جبين حبيبته، فتشفى. وبذلك، تعلي الرواية قيمة الإرادة البشرية، وتقول بقدرة الإنسان على تحقيق أهدافه إذا ما أراد ذلك.
على أن هذه الإرادة قد تنجح في رسم مسار الإنسان في حياته لكنها تخفق في تحديد مصيره النهائي، وهو ما يتولاه القدر بتدخله المفاجئ، حتى إذا ما حاولت الإرادة إعادة المياه إلى مجاريها، يكون الأمر قد تأخر. هذا ما يطرحه محمد حسن علوان في «طوق الطهارة»، من خلال رصد العلاقة بين بطلي الرواية، حسان وغالية، في تحولاتها المختلفة؛ ذلك أن القدر يتدخل، بطريقة سلبية، في حياة كل منهما؛ فحسان الذي يتعرض للاعتداء في طفولته، ويعيش الرتابة والفراغ في شبابه، ينغمس في علاقات نسائية عابرة، حتى إذا ما التقى غالية، رفيقة الصبا المطلقة عن ولد وحيد، وانخرطا في علاقة حب، وشارفا الزواج، يتدخل القدر بقيام الزوج السابق بخطف الولد وتخيير غالية بين حبيبها وابنها، فتختار الأخير، وتؤثر وحيدها على حبيبها، وهو ما يجهض العلاقة الوليدة.
أسئلة الواقع السعودي
وعَوْدٌ على بدءٍ، هذه الأسئلة وغيرها هي أسئلة الواقع السعودي، واستطرادًا العربي، في هذه اللحظة التاريخية، وهي تُراوِحُ بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني، وهي تُسائِلُ الواقع المحافظ من دون أن تتمرد عليه أو تكسر مزراب عينه، فالغاية الإصلاح والتطوير وليس الهدم والتثوير. ولعل هذه الأسئلة وطريقة طرحها هي التي تمنح الرواية السعودية موقعها المتقدم حاليًّا على خريطة الرواية العربية، إلى جانب أخواتها العربيات، فتتصادى معها وتتناغم وتتكامل في إطار المشهد الروائي العربي العام، من دون أن تفقد أي منهما خصوصيتها النابعة من خصوصية المكان/ الفضاء الذي ينتظم في علاقة تنوع ضمن وحدة الأمة العربية. وهذا ما يجعل قراءة الرواية السعودية من الأهمية بمكان، في لحظة تاريخية فارقة، مفتوحة على كثير من التحولات.

سلمان زين الدين - ناقد لبناني | مارس 1, 2024 | قراءات
تتعدد تقنيات التجريب وتتنوع في رواية «درب الحاجب 36» للروائي المغربي أحمد المديني، الصادرة مؤخرًا عن «المركز الثقافي العربي للكتاب»، في الدار البيضاء وبيروت. والرواية هي حلقة جديدة في مسيرة روائية طويلة، باشرها صاحبها منذ نحو نصف قرن، وشكلت روايته «زمن بين الولادة والحلم» الصادرة عام 1976م، حلقتها الأولى، وتمخضت عن سبع عشرة رواية حتى تاريخه، إضافة إلى عشرات الكتب في حقول معرفية مختلفة. وإذا كان التجريب مسألة تتعلق بالخطاب الروائي الذي يشكل الكيفية التي يُقدَّم بها ماهية الحكاية، فإنه من نافل الفعل أن نخوض في الماهية قبل الكيفية، وأن نلقي الضوء على الحكاية قبل الخطاب الذي يشكل التجريب لُحْمته وسَدَاه.
في الحكاية، يتخذ المديني من الدار البيضاء عالمًا مرجعيًّا لروايته الأخيرة، وهو ما فعله في روايته السابقة «رجال الدار البيضاء»، الصادرة منذ ثلاث سنوات. وعلى وحدة العالم المرجعي في الروايتين، فإن الأسئلة المطروحة فيهما تختلف من رواية إلى أخرى؛ ففي حين يطرح في السابقة أسئلة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها الدار البيضاء في سبعينيات القرن العشرين، يطرح في هذه الأخيرة سؤال العلاقة بين الحاكم والمحكوم ومتعلقاته، وهي علاقة تفتقر إلى التكافؤ بين طرفَيْها، عبر التاريخ، يستخدم فيها كلا الطرفَيْن أدواته، المشروعة وغير المشروعة، وتُدفَع فيها الأثمان الغالية، وتؤول إلى نتائج معينة، كثيرًا ما تكون في مصلحة الطرف الأقوى.
قرار المخزن
في هذا السياق، يشكل القرار الذي يتخذه المخزن (الاسم المرادف للحاكم في العالم المرجعي المختص، في بداية ثمانينيات القرن العشرين) بإزالة حي «درب الحاجب» في الدار البيضاء، (الاسم المرادف للمحكوم في الرواية)، نقطة تحول كبرى في مجرى الأحداث يكون لها ما بعدها؛ ذلك أن الدرب «الذي بناه الحاجب الملكي التهامي عبابو بعد أن أهداه السلطان مولاي يوسف قطعة الأرض، وباسمه تسمى وقطنه قسم من الوافدين، أغلبهم من أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، إما مجانًا أو بثمن زهيد، وعاشوا فيه منذ ذلك الوقت وتناسلوا وصارت لهم حياتهم الخاصة» (ص 202)، يشغل موقعًا إستراتيجيًّا في المدينة بمجاورته قصر الحاكم، ويمثل الملاذ الآمن لأهله الذين توارثوه أبًا عن جد، وعاشوا فيه بأمانٍ واستقرار. من هنا، يأتي القرار المفاجئ بإزالته وترحيل سكانه إلى حي آخر ليشكل زلزالًا تكون له تردداته وآثاره المتمادية على شخصيات الرواية وأحداثها، ويؤذن باندلاع معركة بين طرفين غير متكافئين، يستنفر فيها كل منهما أدواته، ويستخدم الأسلحة المتاحة له، وتنتهي بانتصار الطرف الأقوى فيها، وهو المخزن. ويدفع الطرف الأضعف فيها، وهو درب الحاجب، الأثمان الباهظة.
ولعل الرواية هي هذه المعركة الطويلة بين الطرفين، بأدواتها وأسلحتها ونتائجها وآثارها المتمادية. على أن المفارق في هذه الرواية/ المعركة أن المسافة بين الحقيقي والخيالي، بين الواقع والحلم، بين المعيش والمتخيل، بين الإطار والمحتوى، كثيرًا ما تتضاءل إلى حد الإلغاء، فلا نعلم أين ينتهي الحد الأول، في كل من هذه الثنائيات، وأين يبدأ الحد الثاني. وهو ما يتناسب مع العالم المرجعي الذي تُشكل الغيبيات والخوارق والأساطير جزءًا من معتقداته وحياته اليومية.
الحلقة الأضعف
يمثل أهل «درب الحاجب» الحلقة الأضعف في المعادلة أدواتٍ وأسلحة؛ فالشخصيات التي تنبري لقيادة الحركة الاعتراضية على القرار مصابة بأعطاب، جسدية أو نفسية، تختلف ثلاث منها، على الأقل، إلى المصحة النفسية 36، بفعل فاعل، وتتعرض للحقن وتجرع الأدوية المهدئة، وتسقط في الهذيان والتهيؤات. ولعل إصابتها بهذه الأعطاب ناجمة عن الضرب أو الاعتقال أو الوقوع تحت ضغط معين، مما تستخدمه أدوات الحاكم. ومع هذا لا تتخلى عن رفع الصوت للدفاع عن حق طبيعي أو الدفاع عن حق مكتسب.
وعليه، ينخرط في هذه العملية حميدو بو فارس المتحدر من عائلة فقيرة تخفي فقرها عن الآخرين لتتمكن من الاندماج معهم، ويعمل موظفًا في شركة تأمين، ويسهم في طريقة عملية في تنظيم الاعتراض على القرار الجائر بإخلاء الحي، ويحث أهله على الدفاع عن حقهم، حتى إذا ما تم الإخلاء في غفلة من المعترضين وجرى إسكان الناس في حي آخر، وفقد مستنداته الثبوتية، يُعاقَب على موقفه بأن يُحرم من مستند يعرف به وبأسرته، ما يجعله دون اسم، ويحول دون تمتعه بحق السكن. وينخرط في العملية نفسها فاتح السكوري الذي يسهم بدوره في الاعتراض، ويتطاول على ساكن القصر، وينضم إلى المعتصمين عند مدخله، ويصرخ في وجه مندوبه، حتى إذا ما اعتُقل في ظروف قاسية وأُفرج عنه، يتوهم أنه جنرال ويأخذ على عاتقه حماية الجيران والأصحاب، ويحرض الناس على القرار، ويخرج عليهم عاريًا في خطوة احتجاجية جريئة، ويسهم في تنظيم حركة الاعتراض. وحين يُزَج به في المصحة 36 يتحايل على العاملين فيها وعدم تناول الأدوية ويحرض المرضى على التمرد، وهو ما يجعل الطبيب المركزي يتركه في حال سبيله. على أن اعتراض هذه الشخصية يبلغ الذروة حين تقوم بترويج نصوص لابن خلدون تحذر من مغبة الظلم، ما يزعج المخزن، فيأمر بالقبض عليه. وينخرط في تنظيم عملية الاعتراض أيضًا عبيقة، «أكبر فتيان درب الحاجب وأصغر الرجال سنًّا فيه، وهو ملاذ هؤلاء جميعهم، وقبضتهم ومِديتهم، كلما مسهم ضيم» (ص 211)، وهو الذي يدافع عن الحي ويحمي بناته ويؤدب المتطاولين عليه من الأحياء المجاورة، ويتزعم تظاهرة للفتيان ترفض الرحيل عنه وتندد بالتابعين الأذلاء.
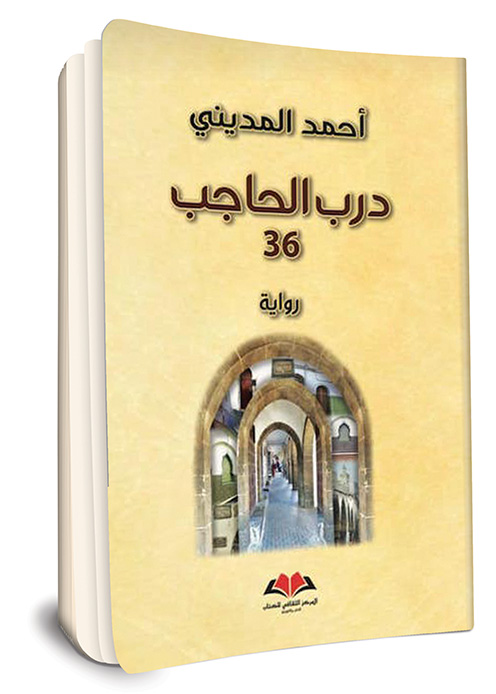 إلى ذلك ثمة من ينخرط في الاعتراض، في مكان آخر، ومن زاوية أخرى، فعبدالواحد المهبول، العامل في سبيطار برشيد، يتزعم مجموعة من نزلاء المصحة، وينظم تظاهرة لهم إلى ضريح القاضي الحاج صالح في برشيد ليشكو له سوء الحال، ويقود وفدًا منهم إلى مصلحة تقييد النفوس التي يديرها ابن خالته للمطالبة بمستندات تثبت وجودهم على قيد الحياة، بعد أن احترقت ملفاتهم. وإذ يُسقَط في يده، لا يتورع عن السخرية من قريبه، وعقد محاكمة متخيلة له، واتهامه بالتلاعب بالأسماء والعناوين. وهذه الشخصية بدورها تعاني عطبًا بنيويًّا، فتهذي وتهلوس كما الآخرين. وهكذا، يصبح مصير الإنسان في العالم المرجعي الذي تحيل عليه الأحداث مرهونًا بورقة من السلطة المعنية التي بيدها إيجاده أو محوه من الوجود.
إلى ذلك ثمة من ينخرط في الاعتراض، في مكان آخر، ومن زاوية أخرى، فعبدالواحد المهبول، العامل في سبيطار برشيد، يتزعم مجموعة من نزلاء المصحة، وينظم تظاهرة لهم إلى ضريح القاضي الحاج صالح في برشيد ليشكو له سوء الحال، ويقود وفدًا منهم إلى مصلحة تقييد النفوس التي يديرها ابن خالته للمطالبة بمستندات تثبت وجودهم على قيد الحياة، بعد أن احترقت ملفاتهم. وإذ يُسقَط في يده، لا يتورع عن السخرية من قريبه، وعقد محاكمة متخيلة له، واتهامه بالتلاعب بالأسماء والعناوين. وهذه الشخصية بدورها تعاني عطبًا بنيويًّا، فتهذي وتهلوس كما الآخرين. وهكذا، يصبح مصير الإنسان في العالم المرجعي الذي تحيل عليه الأحداث مرهونًا بورقة من السلطة المعنية التي بيدها إيجاده أو محوه من الوجود.
وإذا كانت أدوات الاعتراض على الظلم تتمثل في هذه الشخصيات المعطوبة وسواها من شخوص الرواية، فإن الأسلحة المستخدمة في العملية تتدرج صُعُدًا، بدءًا من الكتاب المفتوح، مرورًا بالمراجعة والاعتصام والتظاهر، وصولًا إلى نشر نصوص ابن خلدون بين ساكني الأحياء. أما الأثمان المدفوعة في هذه الحركة، فتُراوِح بين التهميش والانتظار الطويل على أبواب صاحب القرار والضرب والاعتقال والزج بالمعترض في مصحة نفسية وحقنه بالأدوية الضارة، والاقتلاع من الحي، في نهاية المطاف، وهو ما تنفذه السلطة، في غفلة من المعترضين، وبرغم أنوفهم.
الحلقة الأقوى
في المقابل، تتمظهر أدوات السلطة في مجموعة من الموظفين الإداريين والعسكريين، وبينهم مبعوث الحاكم والمقدم والخليفة والمخبر المحلي والطبيب والموظف في مصلحة تقييد النفوس وغيرهم، ولكل من هؤلاء دوره في تنفيذ القرار. على أن المفارق، في هذا السياق، أن أحمد المديني الذي يمنح حق الروي لتسع شخصيات من المهدورة حقوقهم، يكتفي بمنحه لثلاث شخصيات فقط ممن يدورون في فلك المخزن، هم: موظف تقييد النفوس حمدان لحريزي الذي يُسنِد إليه منفردًا روي 49 وحدة سردية، أي قرابة ثلث الوحدات التي تتألف منها الرواية، والمخبر المحلي ميلود العشاب الذي يُسنِد إليه روي 6 وحدات، والطبيب الكباص الذي يُسنِد إليه روي وحدتين سرديتين فقط، أي أن مجموع الوحدات التي ترويها جماعة المخزن يبلغ 55 وحدة سردية، ويبلغ مجموع الوحدات التي ترويها الشخصيات التسع من المهدورة حقوقهم 54 وحدة سردية. وبذلك، يتبين لنا أن انحياز المديني إلى أصحاب الحقوق، من حيث عدد الشخصيات الممنوحة حق الروي، سرعان ما يطيح به التوازن في توزيع الوحدات السردية على طرفي المعادلة، بحيث ينال أصحاب الحقوق 54 وحدة سردية في مقابل 55 وحدة لجماعة المخزن.
وبقراءة الشخصيات المخزنية الثلاث التي يُسنِد إليها مهمة الروي، يمثل حمدان لحريزي، العامل في مصلحة تقييد النفوس في عمالة الدار البيضاء، نموذج الموظف المخلص للجهة التي يعمل لديها، ينفذ الأوامر والتعليمات، يُدون أسماء الساكنة في المدينة وضواحيها وكل ما يتعلق بها من أخبار ملتوية ومشبوهة ويرفع التقارير إلى أهل الاختصاص، يتحول إلى مخبر للسلطة، يتخلق بأدبياتها في تعاطيه مع المكلفين، ولا يتورع عن ممارسة الحذف والإضافة والتلفيق والتزوير والتحوير وفقًا لمقتضى الحال. ويصدر عن نظرة عنصرية إلى القادمين من البوادي إلى المدينة، ويحول دون حصولهم على حقهم في المستندات الرسمية التي تثبت شخصياتهم. على أن هذه الممارسات تجعله يشعر بالذنب دون أن يبادر إلى التكفير عن ذنوبه؛ لذلك، كثيرًا ما يتحسس رأسه، ويشعر بالخوف من أن يصل الموسى إلى ذقنه، فممارسته دور الجلاد لا تجعله بمأمن من أن يكون هو الضحية التالية. ولعل تعرضه لحادث سير قد يكون مفتعلًا، بعد التقاعد، بهدف التخلص من المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته، يؤكد مخاوفه.
أما ميلود العشاب، صاحب الدكان ذي الموقع الإستراتيجي في الدرب، فيمثل دور المخبر المحلي الذي يراقب المارّة، ويُدون ما يرى ويسمع، ويرفع التقارير إلى خليفة المقاطعة. وهو لا يتورع عن الوشاية ببعض المحتجين ما يؤدي إلى اعتقالهم، ولا يخفي فرحه بالداء الذي يجتاح الدرب والأحياء المجاورة، وهو ما يجعل تجارته في الأعشاب تزدهر. على أنه رغم ما يُنسَب إليه من تواطؤ مع الجهة المهتمة بإزالة الدرب، فإنه لا يُعدَم أن يتعاطف مع الساكنة المتضررة من قرار الإزالة، وهو ما يشي بتضارب سلوكه مع مشاعره الدفينة بالانتماء إلى شريحة المهدورة حقوقهم.
إلى ذلك، يمثل الدكتور الكباص، العامل في المصحة، نموذج الطبيب الذي لا يحترم قَسَمَهُ الطبي، ويخفي عن المرضى حقيقة أمراضهم، ويجعل منهم فئران مختبر لتحقيق طموحات مَرَضية خاصة، وينصح بعضهم بالنسيان علاجًا لأمراضهم، ويصف لهم من الأدوية ما يفاقم حالاتهم المرضية، نزولًا على رغبات الجهة المقررة. وهكذا، يتبين لنا أن الأسلحة المستخدَمة من هذه الجماعة، في معركتها المفتوحة ضد أصحاب الحقوق، تُراوِح بين التبليغ والإحصاء والمسح والتنفيذ وإيصاد الأبواب والتهميش والاعتقال والتعنيف والحجر الصحي والتلاعب بالقيود وإخفاء المستندات وإصدار القرارات الجائرة وغيرها. ولعل القرار الأخير الذي تنتهي به الرواية والقاضي بمنح رقم لكل مواطن، يرافقه منذ ولادته حتى موته، وهو ما يجعل الناس مجرد أرقام في نظرها، يعكس طبيعة عمل الإدارة الحاكمة وزاوية نظرها إلى المحكومين.
تمظهرات التجريب
في الخطاب الروائي الذي تتمظهر فيه تقنيات التجريب، يضع المديني روايته في 151 وحدة سردية، ويعهد برويها إلى أربعة عشر راويًا بمن فيهم الراوي العليم، ويوزعها على خمسة أقسام، بوتيرة تُراوِح بين 20 وحدة سردية للقسم الواحد، في الحد الأدنى، و63 وحدة، في الحد الأقصى. على أن العلاقة بين الوحدات المتعاقبة ليست خطية، بل متكسرة إلى حد التشظي، وتوزع الواقعة الواحدة على وحدات سردية عدة. وهنا، ندخل إلى التجريب وتقنياته المستخدَمة في الرواية. وغني عن التعبير ما يستلزمه توزيع هذا العدد الكبير من الوحدات السردية على هذا العدد الكبير من الرواة من مهارة وخبرة وكفاءة، لا أظن أن المديني يفتقر إليها. أما التجريب الذي يقوم عليه الخطاب فيتمظهر في الوقوعات الآتية:
أولًا- استخدام الكاتب تقنية المرايا المتقابلة في السرد بتناول الواقعة الواحدة من منظورات متعددة، ويكون على المتلقي أن يتنكب أمر تركيب الوقائع المختلفة، واستطرادًا الحكاية. ولعل هذه التقنية تتيح تقديم صورة متكاملة للوقائع المختلفة.
ثانيًا- تنويع الأطر التي يُقَدَّم بها المحتوى الروائي، ومراوحتها بين الكابوس والحلم وحلم اليقظة والهذيان والهلوسة وغيرها، وهو ما نراه مع حمدان لحريزي وحميدو بو فارس وعبدالواحد المهبول بشكل أساسي. ولعل الكاتب يمارس من خلال هذه الأطر نوعًا من تقية روائية تحل صاحبها من المسؤولية عن المحتوى المروي، من جهة، وتجعل الواقع المرصود افتراضيًّا، من جهة ثانية.
ثالثًا- تدخل الروائي في توجيه القارئ من خلال ثلاثة نصوص تشكل ثلاث عتبات نصية لأقسام الرواية، يتناول فيها ظروف كتابة الرواية وطقوسها وآلياتها ومسالكها والمراحل المنجزة وتلك المتبقية منها.
رابعًا- احتكامه إلى القارئ في مسالك معينة، ومشاركته هواجسه في مسار الأحداث ومصيرها، وإعلامه بإستراتيجيته في الروي.
خامسًا- تدخله المباشر في أحداث الرواية، من خلال تحويل نفسه إلى شخصية روائية، تروي 10 وحدات سردية، يفصح فيها عن خططه، ويقتفي أثر شخصيات درب الحاجب لتدوين حكايته، ويقابل الشهود الذين ما زالوا على قيد الحياة.
سادسًا- تنازعه اتجاهات الروي مع سارده العليم، وتحويل هذا الأخير إلى شخصية روائية، ينخرط معها الكاتب/ الشخصية في جدال حول شراء الحكايات من أصحابها.
هذه التمظهرات وغيرها تعكس حرص أحمد المديني على ممارسة حريته في الكتابة إلى أبعد الحدود بمعزل عن الأنماط المكرسة والقوالب الجاهزة، ويثبت أن النوع الروائي عصي على التعليب، وأن ما يعلبه الواقع يحرره النص. وبهذا الواقع الافتراضي الذي يرصده بواسطة هذا النص التجريبي، يثبت أحمد المديني، مرةً أخرى، أنه قامة روائية عربية باسقة، كانت وتبقى وارفة الظلال.

سلمان زين الدين - ناقد لبناني | مايو 1, 2023 | كتب
تشغل الروائية أليف شافاك موقعًا مهمًّا على خريطة الرواية التركية. فهي «أفضل من كتب الروايات في تركيا في هذا العقد» بشهادة مواطنها الحائز على جائزة نوبل للآداب أورهان باموك. على أن شهرة شافاك الروائية لا تقتصر على تركيا وحدها بل تتعدّاها إلى مناطق أخرى من العالم، ولا سيما أن رواياتها قد ترجمت إلى العديد من اللغات، ومنها اللغة العربية بطبيعة الحال، فقد صدر لها عن دار الآداب اللبنانية وحدها عشر روايات حتى تاريخه.
وإذا كان اسم شافاك قد اقترن لدى القارئ العربي بروايتها «قواعد العشق الأربعون»، التي ترصد فيها تمظهرات العشق الروحي بين المتصوّفَيْن جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي، فإن لها روايات أخرى لا تقل شأنًا عن تلك الرواية، ومنها «جزيرة الأشجار المفقودة»، موضوع هذه القراءة. وإذا كانت «قواعد العشق الأربعون» تدور في فلك العشق الصوفي الإلهي، فإن «جزيرة الأشجار المفقودة» تدور في فلك الحب الإنساني/ الطبيعي الذي يتخطى الحب بالمعنى التقليدي، بما هو علاقة بين الرجل والمرأة، إلى الحب بالمعنى الشامل، بما هو شبكة علائقية بين سائر كائنات الطبيعة، البشرية والنباتية والحيوانية.
العتبات النصية
في العتبات النصية، تشتمل الرواية على ما يُنِيف على ثمانين عتبة نصية، رئيسة وفرعية، تتمحور في معظمها حول الأشجار ومتعلقاتها، والإنسان وأفعاله. وهذه العتبات تتوزع على: العنوان، والإهداء، والتصدير، وعناوين الأجزاء الستة، وعناوين الوحدات السردية.

أليف شافاك
أما العنوان فيجاور بين ثلاث مفردات تتعالق فيما بينها، على المستوى النحوي، بعلاقتي الإضافة والنعت، بحيث تُضاف «جزيرة» إلى «الأشجار»، وتُنعَت بـ«المفقودة». وتتعالق، على المستوى الدلالي، بعلاقة حسن جوار بين المكاني «جزيرة»، والنباتي «الأشجار»، والإنساني «المفقودة». ولعل وصف الجزيرة بالمفقودة يحيل إلى الفردوس المفقود، ويشي بفضاء روائي هو موضع فَقْدٍ ممن غادره، وموضع حنين ممن يتوق إلى العودة إليه. وهذا ما يتمظهر في المتن الروائي من خلال الوقائع المروية. وأما الإهداء فيجمع، بدوره، بين الإنساني «إلى المهاجرين والمنفيين في كل مكان…» والنباتي «إلى الأشجار التي تركناها وراءنا المتجذرة في ذكرياتنا»، وهو ما يتمظهر في المتن من خلال العلاقة الحميمة بين بطلي الرواية البشريين (كوستاس كازنتزاكس اليوناني وديفني التركية) وبطلتها النباتية (التينة). وأما التصدير المقتبس من بابلو نيرودا وشكسبير فلا يشذ عن هذا التلازم بين الإنساني والنباتي، فيشير الأول إلى انطلاق الشاعر من الغابة التشيلية للتحليق في فضاء العالم، ويشير الثاني إلى اشتراك الدم والأشجار في الحيز المكاني الواحد.
أما عناوين الأجزاء الستة التي تصور مراحل نمو الشجرة بين دفنها في الأرض واستخراجها منها، مرورًا بـ«الجذور» و«الجذع» و«الفروع» و«النظام البيئي»، فتتوازى مع نموّ الحوادث في هذه الأجزاء؛ ذلك أن التعاقب المرحلي بين العتبات النصية يوازيه نمو الحوادث في المتون السردية. وهنا أيضًا تتمظهر العلاقة الجدلية بين العتبات والمتون. أما العتبات النصية التي نقع عليها في عناوين الوحدات السردية الثماني والسبعين التي تشكل النسيج الروائي العام فتتوزع على: 34 عتبة تتّصل بالأشجار ومتعلقاتها، منها 27 عتبة بعنوان «التينة» و7 عتبات متعلقة بالأشجار، و30 عتبة تتصل بالإنسان ومتعلقاته، و7 عتبات ترتبط بالمكان، وعتبة واحدة زمانية. وبذلك، يطغى الإنساني والنباتي على ما عداهما في العتبات النصية، وهو ما نجد ترجمته في المتون التي ينتظم حوادثها سلكان سرديان اثنان، بشري ونباتي، ينخرطان في شبكة من علاقات التعاقب والتناوب والتقاطع والتوازي والتكامل، وهو ما يتمخض عنه النسيج الروائي العام.
المتون السردية
بالانتقال من العتبات النصية إلى المتون السردية، يتجادل عنوان الرواية مع المتن السردي منذ الصفحة الأولى في الرواية؛ فالعنوان «جزيرة الأشجار المفقودة» مكان روائي يُحيل إلى أسطورة الفردوس المفقود، والمتن يُؤسطر الجزيرة/ المكان، من خلال تحويلها إلى موضوع للحكاية في قديم الزمان، وموضع لهيام الرحالِينَ والحجاج والتجار وفرسان الحروب المقدسة: «كان يا ما كان، في سالف الذكرى، في الطرف القصي من البحر الأبيض المتوسط، جزيرة هام في حبها الرحالة والحجاج والتجار وفرسان الحروب المقدسة، فكانوا لفرط جمالها وزرقتها إما لا يطيقون فراقها، أو يحاولون أن يجروها معهم بحبال متينة إلى بلادهم» (ص 11).
مسار دائري
في السلك الأول، تُسند شافاك مهمة الروي إلى راوٍ عليم، يتولى سرد الحوادث التي تتمحور حول علاقة الحب بين عالم النبات اليوناني كوستاس كازنتزاكس وعالمة الآثار التركية ديفني، المختلفَيْن في القومية والدين، وهي علاقة تبدأ في قبرص عام 1974م، عشية الاجتياح التركي للجزيرة، وتنتهي في لندن أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وبين البداية والنهاية مياهٌ كثيرة تجري تحت جسر السرد، وتحولات كثيرة تطاول المكان الروائي والشخوص، ويكون لها نتائجها التي تتمظهر تباعًا في مجرى الرواية ونهايتها. على أن طرفي هذه العلاقة تُضطرهما الظروف إلى الانقطاع عن جذورهما القبرصية، واجتراح جذور جديدة لهما في لندن. وهنا، يتجادل المتن مع العتبات النصية الست التي جرت عنونة أجزاء الرواية الستة بها.
يبدأ السلك، على المستوى النصي، من مدرسة «بروك هل» في شمال لندن، أواخر العقد الثاني من القرن الجاري، بالكلام على آدا كازنتزاكس، ثمرة علاقة الحب بين كوستاس وديفني. يرصد السارد العليم وضعيتها، الجسدية والنفسية، في ضوء عدم شفائها من صدمة موت الأم منذ سنة. فنتعرف، بنتيجة الرصد، إلى فتاة منطوية على نفسها، تؤثر العزلة على الاختلاط، وتصدر عنها تصرفات غريبة تجعلها عرضة لتنمر رفاق الصف، وتجترع ألم فقد الأم وبرودة العلاقة بالأب، فتبدو لمن يشاهدها غريبة الأطوار.
بمعزل عن البداية النصّية لهذا السلك والمسار الدائري الذي تنتظم فيه الحكاية، فإننا حين نعيد تركيبها وفق المسار الخطّي التصاعدي، نخلص إلى أن علاقة الحب بين طرفيها المختلفين، قوميًّا وطائفيًّا ولغويًّا، تبدأ في نيقوسيا في عام 1974م، وتتمظهر في لقاءات ليلية خفيةً عن الأهل، يجري بعضها في «حانة التينة السعيدة» وسط تعاطف صاحبي الحانة، يورغوس اليوناني ويوسف التركي. ويأتي اكتشاف أم كوستاس العلاقة بين ابنها اليوناني وفتاته التركية، معطوفًا على التوتر الذي بدأ يذرّ قرنه بين القبارصة اليونانيين والأتراك، ليشكل نقطة تحول في مجرى الحوادث، فتضغط على ابنها كي يلتحق مؤقتًا بخاله المقيم في لندن، ويمتثل كوستاس مكرهًا لإرادة أمه، وإذا بالمؤقت يتحول إلى دائم، فتستمر إقامته اللندنية ربع قرن، ينقطع فيها عن حبيبته رغمًا عنه، وهو ما يترك تداعياته على العلاقة الوليدة بينهما.
غير أن القَدَر ما يلبث أن يبتسم لكوستاس وديفني، بعد ربع قرن، فيعود إلى قبرص، وتُرَمَّمُ العلاقة بينهما، ويصطحبها معه إلى لندن وفي رحمها الجنين الذي سيصبح آدا، ويصطحب معه أيضًا فسيلة من التينة الصديقة التي ترعرعت علاقة الحب في ظلها، فتشكل التينة المعادل النباتي للجنين البشري، وينموان معًا في بيئة غريبة. وهنا تتقاطع العتبات والمتون مرة أخرى.
قناع روائي
في السلك الثاني، تسند شافاك مهمة الروي إلى التينة، وتتخذ منها قناعًا روائيًّا لها، تقول من خلاله حقائق معينة عن هذا النوع النباتي وموقعيته في الأديان السماوية وما يحف به من معتقدات وطقوس شعبية عند مختلف الشعوب، من جهة، وتقول وقائع من تاريخ الجزيرة في اللحظة التاريخية المعنية في الرواية، من جهة ثانية. على أنه ثمة مفارقة بين الكم والنوع تتعلق بدور هذه الشخصية الروائية المحورية؛ فهي، على المستوى الكمي، تتنكب فعل الروي في سبع وعشرين وحدة سردية من وحدات الرواية الثماني والسبعين، لكنها، على المستوى النوعي، تقوم بدورها من موقع الشاهد على الحوادث والمتأثر بها أكثر من موقع المنخرط والمؤثر فيها.
واقعية وغرائبية
وإذا كان السلك الأول يوهم بواقعية الحوادث وإمكانية حصولها، فإن الثاني يتسم بالغرابة ويؤسطر الواقع. وفي هذه الأسطرة يتجادل المتن مع عتبة العنوان النصية. ولعل المقطع التالي الذي تتحدث فيه التينة عن العلاقة بين البشر والأشجار يشكل مثالًا ساطعًا على العلاقة الجدلية بين العتبات والمتون: «يمشي البشر من أمامنا كل يوم، يتفيّؤون ظلالنا جالسين أو نائمين، يدخنون ويقضون نزهاتهم، يقطفون أوراقنا، ويشبعون من ثمارنا، ويكسرون أغصاننا، يركبها الأطفال منهم أحصنة يلعبون بها، ثم حين يشتد عودهم وقسوتهم يستخدمونها لجلد الآخرين، […]. ومع ذلك كله، لا يروننا» (ص 73، 74). وغنيٌّ عن التعبير ما يعكسه هذا المقتبَس من وعيٍ عميق تدّخره التينة بعقوق الإنسان مقابل وفاء الأشجار. ولعل مثل هذا الوعي يشكل تعويضًا عن عدم تناسب نوع الدور مع كمّه.
وعلى الرغم من عدم التناسب بين الحيز الكمي الذي تشغله التينة في السرد والدور الذي تنهض به في الحوادث، فإن ما ترويه يشكل جزءًا أساسيًّا من النسيج النصي، ويؤثث الفضاء الروائي العام، ويُراوِح بين مستويات سردية ثلاثة: السرد السير- ذاتي، والسرد التاريخي، والسرد العلائقي؛ فعلى المستوى الأول، تروي محطات من سيرتها الذاتية، منذ ولادتها في نيقوسيا عام 1878م، مرورًا بانتقال فسيلة منها إلى لندن في العقد الأول من الألفية الثالثة، وصولًا إلى تحوّلها إلى شجرة أواخر العقد الثاني من الألفية نفسها، وتروي ما عاشته وشهدت عليه من وقائع وحوادث، خلال هذه المحطات وما بينها. وعلى المستوى الثاني، تروي التينة محطات من التاريخ القبرصي، بدءًا من الاحتلال البريطاني للجزيرة أواخر القرن التاسع عشر، مرورًا بالاجتياح التركي لها في العقد الثامن من القرن العشرين، وصولًا إلى أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وما تخلل هذه المحطات من غزو خارجي، وتقسيم داخلي، وحرب أهلية كانت لها مضاعفاتها المدرة على المكان والإنسان. أما المستوى السردي الثالث والأخير فيتمحور حول علاقات التينة، البشرية والنباتية والحيوانية، والدور الذي لعبته في ردم فجوات السلك السردي الأول، في إطار التكامل بين السلكين لرسم المشهد الروائي العام. وهنا أيضًا نقع على علاقة جدلية داخل المتون السردية، بين السلكين البشري والنباتي، وعلاقة جدلية خارجية بين المتون والعتبات النصية، سبقت الإشارة إلى بعض تمظهراتها.
وبعد، وعودٌ على بدء، يمكن القول: إن رواية «جزيرة الأشجار المفقودة» تشكل نموذجًا متقدّمًا للعلاقة الجدلية بين العتبات النصية والمتون السردية في النص الروائي، وذلك بما تشتمل عليه من عدد كبير من العتبات المتنوعة التي قلما تجتمع في رواية واحدة، وما تتخذه تلك العتبات من تمظهرات مختلفة في المتون السردية، وجميعها يحدُث تحت مظلّة أسطرة الواقع الذي يُجمله العنوان، ويفصله المناخ الغرائبي في المتن ولا سيما في سلكه الثاني. ولعل هذه العلاقة الجدلية هي ما يمنح الرواية روائيّتها، ويجعلها على قدم المساواة مع «قواعد العشق الأربعون»، فكلتاهما تستحق القراءة، وتشكل مصدرًا لـ«الإمتاع والمؤانسة»، على حد عنوان أبي حيان التوحيدي.


 على المستوى الاقتصادي، تطرح رواية «كائن مؤجل» لفهد العتيق سؤال المرحلة الانتقالية التي عاشها المجتمع السعودي، غداة الطفرة الاقتصادية الناجمة عن اكتشاف البترول، وهي مرحلة لا تزال ترخي بظلالها عليه، زمنيًّا ومكانيًّا وإنسانيًّا. فعلى المستوى الأول، ثمة انتقال من الماضي إلى الحاضر، وعلى المستوى الثاني، ثمة انتقال من بيوت الطين في الحارات القديمة إلى بيوت الخرسانة الجديدة والشقق السكنية، وعلى المستوى الثالث، ثمة انتقال من حياة الفقر والكفاف إلى حياة الاستهلاك. وفي هذه المرحلة الانتقالية، يبدو الكائن قيد التحقق؛ فانتقال خالد، بطل الرواية، من بيت طيني قديم إلى فيلا حديثة يجعل الأسرة تترجح نفسيًّا بين مكانين اثنين، تحن إلى الأول، على ضيقه، لعلوق رائحته بأجساد أفرادها. وتضيق بالثاني، على رحابته، لافتقاره إلى الروح. على أن هذا الانتقال المكاني يتزامن مع انتقال آخر، في الاتجاه المعاكس، على المستوى النفسي، حين تنتقل الأسرة من الطمأنينة والسكينة إلى الغربة والقلق والملل والفراغ وعدم الاستقرار. وهو ما تعكسه شخصية بطل الرواية، من خلال: تغييره الدائم للعمل، إحساسه برتابة الأيام، الخلل في علاقته مع الأب، الخوف من كل شيء، الخوض في وحول الحياة السفلية، وعدم تحقيق الأحلام. وبذلك، نكون إزاء منظور روائي سلبي للطفرة الاقتصادية المترتبة على اكتشاف البترول.
على المستوى الاقتصادي، تطرح رواية «كائن مؤجل» لفهد العتيق سؤال المرحلة الانتقالية التي عاشها المجتمع السعودي، غداة الطفرة الاقتصادية الناجمة عن اكتشاف البترول، وهي مرحلة لا تزال ترخي بظلالها عليه، زمنيًّا ومكانيًّا وإنسانيًّا. فعلى المستوى الأول، ثمة انتقال من الماضي إلى الحاضر، وعلى المستوى الثاني، ثمة انتقال من بيوت الطين في الحارات القديمة إلى بيوت الخرسانة الجديدة والشقق السكنية، وعلى المستوى الثالث، ثمة انتقال من حياة الفقر والكفاف إلى حياة الاستهلاك. وفي هذه المرحلة الانتقالية، يبدو الكائن قيد التحقق؛ فانتقال خالد، بطل الرواية، من بيت طيني قديم إلى فيلا حديثة يجعل الأسرة تترجح نفسيًّا بين مكانين اثنين، تحن إلى الأول، على ضيقه، لعلوق رائحته بأجساد أفرادها. وتضيق بالثاني، على رحابته، لافتقاره إلى الروح. على أن هذا الانتقال المكاني يتزامن مع انتقال آخر، في الاتجاه المعاكس، على المستوى النفسي، حين تنتقل الأسرة من الطمأنينة والسكينة إلى الغربة والقلق والملل والفراغ وعدم الاستقرار. وهو ما تعكسه شخصية بطل الرواية، من خلال: تغييره الدائم للعمل، إحساسه برتابة الأيام، الخلل في علاقته مع الأب، الخوف من كل شيء، الخوض في وحول الحياة السفلية، وعدم تحقيق الأحلام. وبذلك، نكون إزاء منظور روائي سلبي للطفرة الاقتصادية المترتبة على اكتشاف البترول.


 وإذا كانت الحرية فعل إرادة بشرية بامتياز، فإن فعل الإرادة هو السؤال الذي تطرحه مها محمد الفيصل في «توبة وسليى»، من خلال مسارين سرديين متداخلين، واقعي/ أسطوري وأسطوري، يؤولان إلى مصيرين متشابهين، تنتصر الإرادة البشرية في كل منهما؛ ففي المسار الأول ينطلق فارس آل رضوان في رحلة سندبادية، يواجه فيها المخاطر والأهوال، وتقوده خطاه إلى مركب العطاء والقبطان مراد والجارية سليى التي تنسج سجادة تسجن فيها الأحياء، حتى إذا ما قام القراصنة بسرقة كتابها الأحمر، يضع فارس نصب عينيه استعادته، ويخوض دونه المغامرات الخطيرة، ويتمكن من تحقيق هدفه، في نهاية المطاف. وفي المسار الثاني ينطلق الراعي، في رحلة سندبادية، بحثًا عن دواء لحبيبته نوران، يلتقي خلالها فتاةَ الشوكِ التي تسببت في مرضها، وتبحث عمن يخلصها من ثوب الشوك الذي يلازمها عقابًا لها، وتقودهما الرحلة إلى البحيرة عاشقة القمر، حيث تنخطف هي بعد سقوط ورقة رائعة الجمال من الجنة في حجرها، ويعود هو بعبق القمر ونمير الأبصار دواءً يمسح به جبين حبيبته، فتشفى. وبذلك، تعلي الرواية قيمة الإرادة البشرية، وتقول بقدرة الإنسان على تحقيق أهدافه إذا ما أراد ذلك.
وإذا كانت الحرية فعل إرادة بشرية بامتياز، فإن فعل الإرادة هو السؤال الذي تطرحه مها محمد الفيصل في «توبة وسليى»، من خلال مسارين سرديين متداخلين، واقعي/ أسطوري وأسطوري، يؤولان إلى مصيرين متشابهين، تنتصر الإرادة البشرية في كل منهما؛ ففي المسار الأول ينطلق فارس آل رضوان في رحلة سندبادية، يواجه فيها المخاطر والأهوال، وتقوده خطاه إلى مركب العطاء والقبطان مراد والجارية سليى التي تنسج سجادة تسجن فيها الأحياء، حتى إذا ما قام القراصنة بسرقة كتابها الأحمر، يضع فارس نصب عينيه استعادته، ويخوض دونه المغامرات الخطيرة، ويتمكن من تحقيق هدفه، في نهاية المطاف. وفي المسار الثاني ينطلق الراعي، في رحلة سندبادية، بحثًا عن دواء لحبيبته نوران، يلتقي خلالها فتاةَ الشوكِ التي تسببت في مرضها، وتبحث عمن يخلصها من ثوب الشوك الذي يلازمها عقابًا لها، وتقودهما الرحلة إلى البحيرة عاشقة القمر، حيث تنخطف هي بعد سقوط ورقة رائعة الجمال من الجنة في حجرها، ويعود هو بعبق القمر ونمير الأبصار دواءً يمسح به جبين حبيبته، فتشفى. وبذلك، تعلي الرواية قيمة الإرادة البشرية، وتقول بقدرة الإنسان على تحقيق أهدافه إذا ما أراد ذلك.
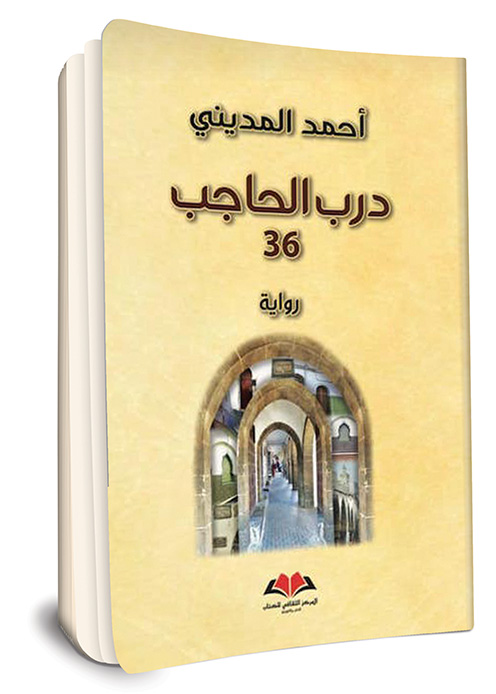 إلى ذلك ثمة من ينخرط في الاعتراض، في مكان آخر، ومن زاوية أخرى، فعبدالواحد المهبول، العامل في سبيطار برشيد، يتزعم مجموعة من نزلاء المصحة، وينظم تظاهرة لهم إلى ضريح القاضي الحاج صالح في برشيد ليشكو له سوء الحال، ويقود وفدًا منهم إلى مصلحة تقييد النفوس التي يديرها ابن خالته للمطالبة بمستندات تثبت وجودهم على قيد الحياة، بعد أن احترقت ملفاتهم. وإذ يُسقَط في يده، لا يتورع عن السخرية من قريبه، وعقد محاكمة متخيلة له، واتهامه بالتلاعب بالأسماء والعناوين. وهذه الشخصية بدورها تعاني عطبًا بنيويًّا، فتهذي وتهلوس كما الآخرين. وهكذا، يصبح مصير الإنسان في العالم المرجعي الذي تحيل عليه الأحداث مرهونًا بورقة من السلطة المعنية التي بيدها إيجاده أو محوه من الوجود.
إلى ذلك ثمة من ينخرط في الاعتراض، في مكان آخر، ومن زاوية أخرى، فعبدالواحد المهبول، العامل في سبيطار برشيد، يتزعم مجموعة من نزلاء المصحة، وينظم تظاهرة لهم إلى ضريح القاضي الحاج صالح في برشيد ليشكو له سوء الحال، ويقود وفدًا منهم إلى مصلحة تقييد النفوس التي يديرها ابن خالته للمطالبة بمستندات تثبت وجودهم على قيد الحياة، بعد أن احترقت ملفاتهم. وإذ يُسقَط في يده، لا يتورع عن السخرية من قريبه، وعقد محاكمة متخيلة له، واتهامه بالتلاعب بالأسماء والعناوين. وهذه الشخصية بدورها تعاني عطبًا بنيويًّا، فتهذي وتهلوس كما الآخرين. وهكذا، يصبح مصير الإنسان في العالم المرجعي الذي تحيل عليه الأحداث مرهونًا بورقة من السلطة المعنية التي بيدها إيجاده أو محوه من الوجود.

