
خلدون النبواني - كاتب سوري | مايو 1, 2025 | مقالات
فلسفيًّا، يؤرخ هيغل للحداثة منذ القرن السابع عشر أي بعد عصر النهضة الأوربية، واكتشاف أميركا، والإصلاح الديني اللوثري، حيث رسمت تلك المرحلة ملامح أفول العصور الوسطى وبزوغ فجر العصور الحديثة. منذ القرن السابع عشر (عصر العقل) شهدت أوربا سيرورة عقلنة شاملة علمية وتقنية وفنية وفكرية وأدبية قطعت مع الماضي القريب وتغيرت معها أشكال الحياة في المجتمعات الأوربية وشكل الدولة وأنظمة الحكم وأنماط الإنتاج. كما تحولت لغة الفلسفة من مصطلحات الجواهر الثابتة والغائية والإرادة الكلية للرب والعناية السماوية، التي طبعت مرحلة القرون الوسطى المسيحية إلى مفاهيم أكثر فيزيائية وميكانيكية تأثرًا بفيزياء غاليليو ونيوتن فظهرت فيها تصورات جديدة للكون ترى العالم بمفاهيم جديدة مثل الحركة والزمان والمكان والميكانيك والمادة حيث ستطغى الروح العلمية والتجريبية والوضعية وروح الشك والمراجعة على انشغالات الفلاسفة الحديثين.(1)
الإنسان في مركز الوجود
من رحم الحداثة أيضًا سيولد التنوير، في القرن الثامن عشر، بقيمه المثالية حول العقلانية والحرية والفردانية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتسامح والسلام وقد ساهمت الثورة الفرنسية بترجمة قيم التنوير الفلسفية إلى مؤسسات سياسية وبرامج عمل اجتماعي ومؤسساتي فصارت أفكار الفلاسفة في متناول الجميع (وهو ما يسميه كانط بالاستخدام العمومي للعقل) فظهرت آنذاك الفضاءات العامة والصالونات الأدبية والثقافية لمناقشة شؤون السياسة والمجتمع والفن، كما شُجِّع الاقتصاد الليبرالي والمَلكية الدستورية.
هكذا وبفضل الحداثة والتنوير ستحل نظريات العقد الاجتماعي مكان سلطة الكنائس واستغلال الإقطاعيات المَلَكية القروسطية المتحالفة مع الكنيسة حينًا والمتصارعة معها حينًا آخر. لكن لعل أهم مقولات التنوير تمثّلت في إعلان ولادة الإنسان الحديث، الحر، المفكر، صاحب الإرادة والواثق بعقله وبمستقبله وبنفسه بالنتيجة. مع تلك الوثوقية شبه المطلقة -التي لا تخلو من السذاجة، كما سيكشف بعد ذلك فلاسفة ما بعد الحداثة- بقدرات الإنسان وعقله التي أشاعها عصر التنوير نشهد على أول محاولة فلسفية (صامتة) تقول، دون أن تقول ذلك صراحةً، بنهاية التاريخ: فالعقل سيسيطر قريبًا على جميع مقدرات الطبيعة ويخضعها له، والتقدم سكة قطار ثابتة للإنسان الحديث لا يمكن له الخروج عنها بعد الآن، والسلام الدائم بين شعوب الأرض قادم لا محالة وإن كان كل ذلك لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل والوقت.
بوضعها الإنسان في مركز الوجود تكون الحداثة قد ترجمت عمليًّا مقولة السفسطائي الإغريقي بروتاغوراس الذي طالب بعَدّ الإنسان مقياس كل الأشياء فولدت الذاتية في الفلسفة الحديثة. ونحن لو أردنا وضع عنوان مختصر لمجمل الفلسفة الحديثة منذ ديكارت وصولًا إلى سارتر لقلنا: إنها فلسفة الذاتية، أو الفلسفة المتمركزة على الذات منذ «أنا» ديكارت المفَكِّرة وصولًا إلى فلسفة كانط المتمركزة على الذات في نقدياتها الثلاث مرورًا بفلاسفة التجريبية والعقلانية معًا.
وفي القرن التاسع عشر (عصر القوميات) تبلور الفكر السياسي الجدلي وفلسفة التاريخ مع هيغل وماركس، بحيث نُظر إلى التاريخ معهما كنسق خطي متواصل وتكاملي تصاعدي: دائمًا نحو الأعلى والأكثر تقدمًا. في الجدل الهيغلي الماركسي هناك نهاية تاريخ أيضًا وتخوم وحدود للحداثة.
وإذا كان هناك توافق بين الفلاسفة على أن الذاتية والعقلانية هما ابنتا الحداثة الأوربية وأن الحداثة، فلسفيًّا، قد ولدت على يد ديكارت (وربما هوبز أيضًا)، إلا أنها لم تتحول إلى إشكالية فلسفية، أي كموضع سؤال وتأمل فلسفيّ قبل هيغل، الذي جعل منها، بحسب هابرماس، «المشكلة الأساسية لفلسفته.»(2) في «فينومينولوجيا الروح» (1807م) لهيغل، ستُطرح إذن وللمرة الأولى إشكالية الأزمنة الحديثة فلسفيًّا حيث ستصبح الحداثة في قلب الجدل الفلسفي الحديث والمعاصر الألماني على وجه الخصوص إن لم يكن الحصر.
الحداثة عربيًّا بوصفها نهضة وتقدّمًا
إذا كانت الحداثة الأوربية قد قطعت أشواطًا بعيدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في تحديث مجتمعاتها التي أسّست فيها لأنظمة حكم ديمقراطية واقتصاديات ليبرالية ومؤسسات دول قوية وحققت قدرًا كبيرًا من الحريات لشعوبها، فإنها راحت توسِّع نفوذها آنذاك خارج حدودها القومية بعد أن نجحت، إلى حد كبير -منذ اتفاقية وستفاليا (1648م)- بوضع حدٍّ للحروب فيما بينها. وقد أدى توقف الحروب بين دول أوربا وفيها إلى تراكم فائض من القوة لديها وتحول الصراع فيما بينها إلى تسابق على أدوات السيطرة والهيمنة والثروة خارج الحدود الأوربية، فراحت تستعمر الدول وتبني المستعمرات في إفريقيا وآسيا بما فيها دول شمال إفريقيا، لكن أيضًا وعلى نحو خاص دول ما ستُطلق عليه (بنظرتها لنفسها على أنها مركز العالم) ﺑ«الشرق الأوسط».
وقد كان لحملة نابليون بونابرت (1798م) أثر الصدمة الحضارية التي تعرّف فيها العرب، في مصر أولًا، على حداثة الغرب وتقدمه ليدركوا بالمقارنة مع الجيش الفرنسي والحملة الفرنسية مدى تخلفهم التاريخي والحضاري. كان من النتائج غير المباشرة لتلك الحملة وصول محمد علي باشا إلى السُّلطة في مصر (1805- 1848م) الذي كان معجبًا بحضارة الغرب فطمح لتحويل مصر إلى دولة قوية «حديثة» بجيش منظّم حديث جيد التسليح. ومع أن تركيز محمد عليّ انصب على الجيش قبل كل شيء، إلا أن تحديث الجيش وبناءه كان يعني بالتبعية بناء مؤسسات الدولة والقيام بعمليات تحديث شاملة تقريبًا بما يتضمن ذلك بناء المدارس والجامعات الحديثة بدل الكتاتيب أو الاكتفاء بالأزهر.
هكذا ولد التعليم الحديث في مصر بفضل محمد عليّ مُستلهمًا التعليم الأوربي الحديث، فقد أرسل محمد عليّ الإرساليات العلمية التي مهد مبتعثوها -وعلى رأسهم رائد النهضة العربية رفاعة الطهطاوي- لولادة نهضة فكرية عربية من خلال التراجم عن الغرب والانفتاح الحضاري على أفكاره وحرياته المدنية ونظرياته الحديثة الاجتماعية والسياسية.(3) من الطهطاوي (1801-1873م) إلى طه حسين (1889-1973م) سيتداعى جيل من المفكرين العرب الساعين إلى تحديث بلادهم تأثرًا بما وجدوه عند الغرب من حداثة وتنوير وتقدم وعقلانية وحريات.
إذن مع نهايات القرن التاسع عشر بدأ تواصل العرب مع أفكار الحداثة الغربية، لكن وعلى خلاف الخصوصية الألمانية التي حوّلت، منذ هيغل، الحداثة إلى موضوعٍ للتأمل الفلسفي، استقبل مفكرو النهضة العرب أفكار الحداثة الأوربية الجاهزة دون الخوض الفلسفي المبكر بمفاهيمها. وبمعنى آخر لقد كانت النهضة العربية هي المحاولة العربية لتحقيق حداثة عربية مستلهمةً بمشروعها هذا مقولات الحداثة الأوربية في: العقلانية والحرية والأفكار القومية والتقدم والتفكير العلمي والعلمانية والاستقلال الفكري والدولة الحديثة والبرلمانات والانتخابات والدستور والنظام السياسي والمَلَكية الدستورية والجمهوريات والليبرالية، والاقتصاد الحر، إلخ. وبمعنى آخر، منذ الصدمة الحضارية التي خلّفتها حملة نابليون على مصر، اكتشف العرب -مفكرون وزعماء سياسيون- ضرورة تحديث مجتمعاتهم وأفكارهم ودولهم للنهوض من واقعهم المتخلف واللحاق بركب العالم الحديث المتطور الذي تجاوزهم بقرون.

الحداثة والتراث أو الأصالة والمعاصرة
يذكر المُفكِّر برهان غليون في كتابه «سؤال المصير» (2023م) كيف «فرض التحديث نفسه آنذاك على جميع النخب الحاكمة كخيار إجباري للحفاظ على البقاء، قبل أن يخضع لأي تأمل فكري أو مساءلة شرعية أو أخلاقية.»(4) قبل أن يضيف: «وفي سياق هذا الاحتفاء بالتقدم- الأوربي- ولد المثقف الحديث المتميز عن عالم الدين والفقيه والحامل لإرث الحداثة. والتقى في نهاية القرن التاسع عشر في القاهرة، عاصمة الحداثة العربية من دون منازع في تلك الحقبة، نخبة من رجال الأدب والفن والفكر من عموم العالم العربي. وازدهرت الصحافة ودور النشر والجامعات وظهرت الأنواع الفكرية والأدبية الجديدة من المقالة الفكرية والرواية التاريخية والقصة والمسرح وغيرها من الفنون التشكيلية والغنائية الحديثة. وانتشرت الثقافة الحديثة المتأثرة بالفكر الأوربي التنويري ونما، بموازاة ذلك، الشعور بالهوية العربية وإحياء الإرث التاريخي العربي.»(5)
لكن إن كانت «النهضة» هي محاولة العرب التحديثية، فإنها لم تنجح لأن تتحول إلى حداثة حقيقية فكرية ومجتمعية وقد يعود ذلك برأيي إلى سببين اثنين: الأول واقعي موضوعي، يتمثّل في انحصار مشروع محمد عليّ في بناء الدولة على الجيش، وهو ما جعل هذا المشروع هشًّا وضعيفًا على مستوى الروح، وقد تجلى ذلك بنجاح بريطانيا وفرنسا بوضع حد لطموحات محمد علي العسكرية حينما حاول التوسع نحو سوريا فقد خشيت القوى الأوربية آنذاك من ولادة دولة قوية ترث الإمبراطورية العثمانية وتهدد مصالحها الاستعمارية في المنطقة. أما السبب الثاني فهو في رأيي ذاتيّ يخص بنية فكر النهضة العربية ذاته الذي لم يكن جذريًّا كما كان عليه الفكر الغربي الحداثي الذي قطع بقوة مع الماضي المعوِّق وتخلص من باراديغم العصور الوسطى ليبني باراديغم الحداثة.
فقد ظل رواد الحداثة العربية الأولى، من وجهة نظري، يتأرجحون بين التوفيقية بين أفكار الحداثة الغربية والتمسك بتراث الماضي واضعين رِجْلًا في الحداثة ورِجْلًا في التراث، متقدمين خطوة في التحديث ومتراجعين خطوة ونصف خطوة معاكسة نحو الهويات المعوِّقة للحداثة وهذا ينطبق على الطهطاوي (وبخاصة بعد عودته إلى مصر) مرورًا بالأفغاني، ومحمد عبده، وخير الدين التونسي، ومحمد رشيد رضا، بل حتى طه حسين الأخير الذي غرق في التراثيات بعد أن كان جذريّ الفكر وحداثيّ المواقف. كانت النهضة العربية ممزقة إذن بين الماضي والحاضر بين ما سيعرف -ويعاد إنتاجه في الفكر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين على نحو تراجيدي- بإشكالية الحداثة والتراث أو الأصالة والمعاصرة.(6)
تشييء المفاهيمي
نقطة أخيرة أود التوقف عندها تتعلق بتشييء مقولات الحداثة الغربية مع استخدامها العربيّ أو ما سأدعوه ﺑ»متلازمة الملك ميداس»(7). فللمفاهيم حياة وهي تمر بمراحل من القوة إلى الضعف، وقد تتحول بعض المفاهيم التي كانت ثورية ومحرّرة في زمن ما وفي شروط معينة إلى عوائق وقيود معوِّقة إن تجاوزها الزمن أو لم يستجب لها الواقع. ففي السياق العربي اسْتُقْبِلَت مفاهيم الحداثة والتنوير جاهزة من الغرب. ومع أن هذه المفاهيم والمقولات قد أدت، في البداية، دورًا توعويًّا مهمًّا ومحركًا قويًّا لحركات التحرر الوطني وولادة الوعي بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان، وسيادة الشعب من خلال الديمقراطية، وحرّضت العرب على النهضة وفتحت وعيهم على العالم ودفعتهم للدخول في التاريخ الحديث ومحاولة اللحاق بركب الحضارات المعاصرة والاستقلال السياسي، إلخ، إلا أنها سرعان ما تحوّلت -وقبل أن تنضج ثمارها في حداثة عربية- إلى عوائق مفاهيمية معطِّلة للحداثة بعد أن صارت أصنامًا جامدة وشعارات مفرغة من محتواها في التلقي العربي لها. ولهذا أشبه التشيؤ المفاهيمي الذي لحق بمقولات الحداثة بأسطورة الملك ميداس.
ويعود السبب الأول في هذا التشيؤ المفاهيمي في رأيي إلى سرعة اختلاط هذه المفاهيم الحداثية التنويرية بالأيديولوجية السياسية الأداتية، كما حصل مثلًا في مأساة ترجمة مفاهيم القومية العربية والأمة الواحدة والتحرر من الاستعمار في أحزاب سياسية ارتبطت سريعًا بالعسكر كما كان حال حزب البعث في سوريا والعراق مثلًا. فقد أفرغ العسكر الفكر القومي العربي من كل طاقة تحررية قومية حضرت في طروحاته النظرية وكرّست الدولة القُطرية الأمنية مفاهيم التجزئة باسم الوحدة، والتخلف باسم التقدّم، والطغم الطفيلية باسم الاشتراكية، والاستبداد باسم الجمهورية، إلخ.
هكذا تكلّست المفاهيم وبدل أن تكون عجِلة التقدم صارت عصيًّا في تلك العجلة. وهكذا تحوّل الدفاع عن التنوير عند بعض المفكرين العرب إلى جملة مقولات مُقدسة تُرَدَّد كتمائم وتعاويذ بشكلٍ تكراري أُفرغ من محتواه فصارت العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والسلام، إلخ، مجموعة من العزائم والتمائم التي لا تعني شيئًا اللهم مجرد شهادة انتساب إلى نادي التنويريين العقلاء المُغلق. وبمعنى آخر تحولت الأفكار الثورية السائلة -التي حركت الغرب وأسست نظريًّا لحداثته وتقدمه وتحرره- إلى أصنام جامدة عديمة الفاعلية، هذا إن لم تكن قد شكلت سدودًا أمام التحديث والتقدم والتنوير.
لكل هذا قد يبدو تفكيك هذه المقولات من أجل فك الصدأ الأيديولوجي الصنميّ عنها مهمة تحديثية أولويّة. وبمعنى آخر قد تسمح أدوات ما بعد الحداثة «(التفكيك هنا) بتحرير محركات الحداثة من الصدأ الذي علق بها ومنع حركتها.
هوامش:
(1) انظر في ذلك: صادق جلال العظم، «دفاعًا عن المادية والتاريخ»، بيروت، دار الفكر الجديد، 1990م، ص43.
(2) Jürgen. Habermas, Le discours philosophique de la modernité, trad. Christian Bouchindhomme et Rainer Rochiltz, nrf, Gallimard, 1988, p. 19.
(3) لم يكن الطهطاوي أحد المبتعثين أو الطلاب الموفدين في البعثات التعليمية التي أرسلها محمد علي، وإنما إمام أول بعثة مصرية إلى فرنسا (1826م). ومع ذلك فقد درس الطهطاوي هناك وتعلم اللغة وقدم أبحاثًا في التراجم وكتب فيها «تلخيص الإبريز في تخليص باريز» وقد تولى بعد عودته إلى مصر مناصب كبيرة بعد أن افتتح في القاهرة مدرسة للترجمة وأشرف على مؤسسات التعليم.
(4) برهان غليون، «سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية»، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023م، ص، 23.
(5) المرجع نفسه، ص، 26.
(6) دار في فلك هذا التيار التوفيقي بين الحداثة والتراث أو الأصالة والمعاصرة نخبة من أهم المفكرين العرب المعاصرين: حسين مروة وطيب تيزيني وحسن حنفي ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري، حتى جورج طرابيشي، الذي كان قد وصف العودة إلى التراث بأنها «عصاب جماعي» في أحد كتبه التي حملت هذا العنوان قبل أن يلتحق بركب التراثيين. في رأيي أن جميع هؤلاء المفكرين بعودتهم إلى التراث بقصد تثويره وجعله متوافقًا مع الحداثة عبر قراءات إبستمولوجية أو علمية أو ماركسية أو بنيوية إلخ عادوا إلى الماضي بدل التوجه للحاضر الذي به تتأسس الحداثة فعلقوا في شباك الماضي ونصوصه، بل انتهى بعضهم إلى شبه فقهاء ومفسري نصوص أو مؤرخين في حين تميزت الحداثة الغربية بالقطيعة مع الماضي والانفتاح على الجديد أو، كانت «موقفًا من الحاضر» كما سيؤكد ميشال فوكو. بسفرهم إلى الماضي بقصد إنقاذ الحاضر يذكرني مفكرو التراث العرب بأورفيوس الذي ذهب لاستعادة يوريدس من مملكة الموت فعلق في عالم الموتى فلا هو أنقذ زوجته ولا استطاع الإفلات من عالم الأموات هو نفسه. لعل إشكالية التراث كانت مقتل النهضة العربية الذي منعها من أن تتحول لحداثة.
(7) في كتاب «التحولات» للشاعر أوفيد، نتعرف إلى أسطورة الملك ميداس الذي أكرم وفادة وأحسن معاملة الساتير سيلينوس، والد الإله زيوس بالتبني ومربيه بعد أن أسرف في الشراب فتاهت خطاه إلى أن قادته إلى أراضي ميداس. عرفانًا بالجميل لإنقاذ سيلينوس، أراد زيوس مكافأة الملك ميداس بأن يحقق له مباشرة أمنية وحيدة يختارها. فطلب الملك من رب الأرباب أن يتحول كل ما يلمسه إلى ذهب. وبالفعل حقق له زيوس أمنيته تلك فتحولت مباشرةً ملابسه التي كان يرتديها ذهبًا خالصًا وصار كل ما تلمسه يداه ينقلب ذهبًا، لكن المشكلة ابتدأت عندما أراد أن يأكل ويشرب إذ كان الماء يتحول إلى ذهب ما إنْ يلمس فمه وكذلك الطعام. عندها راح ميداس يتوسل زيوس ليخلصه من تلك الأمنية/اللعنة.

خلدون النبواني - كاتب سوري | يوليو 1, 2023 | مقالات
بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لصدور كُتيب كانط المعروف «مشروع للسلام الدائم» يكتب هابرماس نصًّا قصيرًا مستوحى من محتوى وعنوان كتاب كانط نفسه ويعنونه ﺑ«السلام الدائم- المئوية الثانية لفكرة كانطية» (1996م) يراجع فيه بشكل أساسي مفهوم المواطنة العالمية الكانطي. في مراجعته تلك يأخذ هابرماس في الحسبان المسافة الزمنية والتطور القانوني والتقني الذي يفصلنا عن نهايات القرن الثامن عشر التي كتب فيها كانط كُتيبه ذاك. يوضح هابرماس هذه النقطة بالقول: «بفضل المعرفة الإضافية التي استفادت منها الأجيال اللاحقة -دون أن يكون لها فضل خاص في ذلك- نعلم اليوم أن المشروع المقترح من قبل كانط يطرح مشكلات مفاهيمية فضلًا عن أنه لم يعد ممكنًا التوفيق بينه وبين المعرفة التاريخية التي نمتلكها نحن»(١).
يشير هابرماس إلى أن فكرة السلام عند كانط ظلت مرتبطة بفكرة الحرب التقليدية ومحدودة مثلها، فالحرب في التصور الذي كان يمكن لكانط أن يصوغه، وفقًا لمعطيات عصره التاريخية والتقنية، تنحصر في حرب محدودة في المكان والزمان بين مجموعة دول أو تحالفات ضيقة دون أن تسمح ظروف العصر والتطور التقني في القرن الثامن عشر بتصور حروب عالمية ولم يكن هناك بعد إرهاب يلجأ إلى القنابل(٢) ويستفيد من التقنية في عملياته، ولذلك كانت الأهداف السياسية للحروب محددة ومحدودة. وبما أن الظروف والمعطيات والمصالح والتطور التقني قد غيّر في مفهوم الحروب وأسبابها وبالتالي في فكرة السلام نفسها، فإن مشروع كانط حول السلام والمواطنة العالمية يحتاج إذن إلى مراجعة وتحديث كما يرى هابرماس.
نقد مشروع السلام الأبدي
بالعودة إلى قراءته لمشروع كانط، نجد أنه وفي مطالبته بمراجعة قانونية لفكرة المواطنة العالمية الكانطية، يُطالب هابرماس بضرورة تحديد الفرق، الذي اقترحه كانط، بين قانون للمواطنة العالمية والقانون الدولي الكلاسيكي. دون أن يقول ذلك بوضوح، لكن الفرق الذي يمكن استنتاجه من قراءة كانط بين القانون الدولي ومشروع المواطنة العالمية الذي يقترحه، يتمثّل في أن القانون الدولي يضع قوانين ويحدد شروط لإمكانية قيام الحروب كما أنه يعاقب على انتهاك هذه القوانين مثلما يحدث مثلًا فيما يصفه بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. في حين أن قانون المواطنة العالمية أو السلام الدائم يسعى إلى وضع حد نهائي للحروب. أي، خلافًا للقانون الدولي الذي يتصرف بشكل رجعي بعد وقوع الحروب ويضع عقوبات جزائية على تجاوزاتها (أي يعترف بها بالتالي ويسمح بها وفق شروط يحددها)، يقترح كانط فكرة «وقائية» للسلام الأبدي تضع شروطًا قَبْليِّة تلغي أسباب الحروب من أصلها أي قبل أن تبدأ حتى.

يورغن هابرماس
يرى هابرماس أن كانط مُطالب بتفسير كيف يمكن أن يضمن «ائتلاف شعوب العالم» ترسيخ السلام وإنهاء الحروب دون نظام تشريعي مُلزِم كالدستور وامتلاكه لسلطة تنفيذية قوية قادرة على تنفيذ القرارات الصادرة عنه وتجعلها محترمة ومُلزِمة. بالنسبة لهابرماس يظل المشروع الكانطي إذن غير فاعل؛ فدون: هذا العنصر الإلزامي، لن يحظى مجلس السلام لمجموع الدول بهيئة مجلس «دائم»، ولن تأخذ الجمعية الطوعية شكلًا مستمرًّا لجمعية «دائمة»، ولكنها سوف تظل مرتبطة بمجموعة مصالح غير مستقرة، ومن ثم تتفكك كما سيحصل لاحقًا لعصبة الأمم في جنيف(٣).
بهذا المنطق يدافع هابرماس عن الجانب القانوني في حقوق الإنسان التي لا تقتصر ويجب ألّا تقتصر في رأيه على جانب أخلاقي غير مُلزِم قانونيًّا. هنا أيضًا يريد هابرماس الانتقال بحقوق الإنسان من مستوى الإلزام الأخلاقي إلى مستوى قوة القانون؛ ليجعل منها إلزامية وعقابية لمن لا يحترمها، وليست مجرد معاهدات ومواثيق دولية أخلاقية غير إلزامية تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لانتهاك حقوق الإنسان دون وازعٍ أو رادع(٤).
هكذا يعود هابرماس إلى تفعيل فكرة كانط الأولى التي عبّر عنها في مقاله «حول المكان العام»، قبل أن يتراجع عنها، والتي تُطالب بمأسسة قانونية لفكرة دولة المواطنة العالمية. يرى هابرماس إذن أنه لا يمكن الاكتفاء، على الطريقة الكانطية، بالإلزام الأخلاقي وبالثقة بالمعيارية القطعية للواجب الأخلاقي لتكون مثل هذه الفيدرالية بين الدول ملزمة لجميع أعضائها.
نحو دولة مواطنة عالمية
من الصحيح أن كانط نفسه كان على وعي بعدم كفاية الإلزام الأخلاقي، وإنه سيحاول تعويض ذلك النقص بمطالبته بمنح العقل صفة «القانون العام» وأن يحظى الائتلاف الدوليّ «بدستور جيد»؛ ومن الصحيح أيضًا أن كانط قد حاول إضفاء الصفة القانونية للأخلاق بجعلها «مذهبًا قانونيًّا» كما يتجلى ذلك في كتابه «مذهب القانون»، لكنه لم يقدم في مشروعه حول السلام الدائم ودولة المواطنة العالمية سوى اقتراحات قانونية تحتاج قبلًا وأولًا إلى بنية سياسية متمثلة في دولة مواطنة عالمية، وهو ما تراجع عنه كانط كما رأينا لصالح ائتلاف شعوب يرتكز أكثر على الالتزامات الأخلاقية محاولًا بذلك المصالحة بين الأخلاق والسياسة.
لكن إذ يعترض هابرماس على الحل الأخلاقي الذي اضطر إليه كانط ليحتفظ بسيادة الدول القومية، متراجعًا عن الطرح القانوني المؤسساتي لدولة المواطنة العالمية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف سيحل هابرماس فكرة إنشاء مؤسسة قانونية عالمية مُلزمة لجميع الدول دون أن تستند إلى فكرة سوبر دولة عالمية تطيح بسيادة الدول القومية؟ وبمعنى آخر، بإصراره على إيجاد قانون ممأسس لدولة المواطنة العالمية سيجد هابرماس نفسه أمام الإشكاليتين ذاتهما التي وقف أمامهما كانط من قبل: سيادة الدولة-الأمة من جهة واستمرار الحروب العقابية المُهدِّدة للسلام باسم فرض السلام من جهة أُخرى.
لنتذكر هنا أن هابرماس ليس من أنصار الاكتفاء بسيادة الدولة القومية فهو من دعاة تجاوز الدولة-الأمة في تحالفات أوسع كخطوة أولى نحو دولة مواطنة عالمية تتطلب التنازل عن السيادة المطلقة للدول القومية. بفصله بين استقلال المواطن وسيادة دولته القومية(٥) يفتح هابرماس الباب أمام مفهوم للمواطنة العالمية الذي يستمد شرعيته من مواطني وشعوب العالم لا من الدول، وهو بهذا لا يخرج عن تنظيرات عصر التنوير عند روسو وكانط. لكنه يتجاوزهما حين يطالب بالجمع بين قانون المواطنة العالمي وقانون الأفراد. وبمعنى آخر يطالب هابرماس بالجمع بين القانون الدولي وقانون الأفراد ليتجاوزهما في الوقت نفسه بقانون مواطنة عالمي. دون أن يقول ذلك صراحة، لكن من الواضح جدًّا أن هابرماس أميل إلى تبني فكرة دولة المواطنة العالمية مكتملة السيادة التي تشترط على جماعة الشعوب «أن تكون قادرة على حمل أعضائها على احترام القانون تحت طائلة العقوبة»(٦).
على مسافة قرنين من كانط، يعرف هابرماس جيدًا أن التاريخ لم يستجب لمشروع كانط المعياري بخصوص دولة المواطنة العالمية، ولهذا سيطالب ببراغماتية واضحة وبمعيارية قائمة على ترسانة مفاهيمية حديثة بتحويل الإلزام الأخلاقي الكانطي إلى مؤسسة قانونية نافذة الأحكام وملزمة مثل الدستور كما أشرتُ آنفًا. في هذا الصدد يشرح هابرماس موقفه من فكرة كانط بالقول: «في الواقع، فإن تأسيس وضعية مواطنة عالمية يعني ألا تتم محاكمة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر ومكافحتها وفقًا لمعايير أخلاقية، بل متابعتها في إطار نظام قانوني دولاتي [من الدولة]، وفقًا لإجراءات قضائية ممأسسة، تمامًا مثلما هو شأن الأعمال الإجرامية»(٧).
ضرورة المراجعة
يعلم هابرماس أنه لا يُقدِّم جديدًا في هذا المطلب، فالتحول قد جرى أصلًا على الفكرة الكانطية. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية ثم سن قوانين وتشريعات عقابية وردعية معمول بها دوليًّا، كما ينص على ذلك مثلًا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُخول مجلس الأمن بموجبه -في حال تم تهديد السلام أو الاعتداء على سيادة إحدى الدول أو ارتكاب جرائم حرب- اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك التدخل العسكري. كل هذا صحيح، لكن هابرماس يعلم كذلك أن الأمم المتحدة على أهمية دورها ونبل مهمتها إلا أنها خاضعة للقوى الكبرى ولم تستطع على الرغم من توقفها على هيئة قانونية هي «الميثاق» وسلطة تنفيذية هي «مجلس الأمن» أن تحل السلام أو العدل ولا أن تجعل قراراتها محترمة أو إلزامية فعليًّا، اللهم إلا بما يتلاءم مع صراعات ومصالح الدول الكبرى. لهذا يطالب هابرماس، عن حق، بإعادة النظر في كل من القانون الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن لأن هذه الكيانات القانونية تحتاج هي نفسها إلى مراجعة ضرورية اليوم تطول إعادة النظر في دورها وبنيتها ومدى استقلال قراراتها.
مجلس الأمن مثلًا لا يمتلك جيشًا خاصًّا به، وهو يعتمد اعتمادًا كليًّا على المشاركة العسكرية الطوعية للدول الأعضاء في تنفيذ قراراته الجزائية والعقابية، مما يتركه فريسة لهيمنة القوى السياسية الكبرى، ولهذا فهو ليس سوى نمر من ورق أو فزّاعة لم تعد تخيف أحدًا في نظر هابرماس الذي يستنكر وضعية تلك المؤسسة الدولية بالقول: «لا يزال مجلس الأمن غير قادر على أن يفعل أكثر من تقديم ملاحظات مُنتقاة حول المبادئ المعلنة للمجموعة الدولية. لقد أظهرت مأساة سربرنيتسا أن فِرق الأمم المتحدة ليست في وضعية تمكِّنها من فرض الضمانات المطلوبة. إذا كان مجلس الأمن معوقًا عن تنفيذ قراراته، كما كانت حاله حيال مسألة صراع كوسوفو، وإذا قام مقامه تحالف إقليمي، مثل حلف الناتو، يتصرف من دون إيعاز من القوى العظمى، فإن ذلك سيُظهر الفارق الحاسم في القوة بين السلطة الشرعية، ولكن الضعيفة، والمتانة الحالية للدولة/الأمة القادرة على الفعل العسكري، لكنها لا تتبع في ذلك إلا مصالحها الخاصة»(٨).

إيمانويل كانط
يشير هابرماس كذلك إلى مشكلة أخرى تهيمن على مجلس الأمن تتمثل في الدول الدائمة العضوية فيه التي تستأثر بحق النقض الفيتو فتعطل عمليًّا مهمة مجلس الأمن، مؤكِّدًا: «نعلم أنه وخلال عقود قد شلّوا قرارات مجلس الأمن بشكل متبادل»(٩) كما أدت هيمنةُ تلك الدول على مجلس الأمن إلى استخدام تمييزي وتفضيلي انتقائي لقوة مجلس الأمن وتجاهل مبدأ المجلس القائم على المساواة في التعامل مع الأحداث وبين الدول. ما العمل إذن والحال كذلك؟
يرى هابرماس ضرورة تجاوز القانون الدولي الحالي في قانون مواطنة عالمية يرث القانون الدولي الذي يعاني كثيرًا الخللَ والثغراتِ التي تسمح للدول الدكتاتورية باستغلاله. فعلى سبيل المثال خلافًا للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة، تطرح هذه الأخيرة قانونًا آخر يحد منه، بل ويناقضه جزئيًّا، وهو بند يتمثل بإقرار حق كل دولة في الدفاع عن نفسها عسكريًّا مما يجعل سيادة الدولة محددة ومطلقة في آنٍ. لتحقيق ذلك الانتقال من القانون الدولي إلى قانون مواطنة عالمي يرى هابرماس أنه لا بد من توافر شرطين اثنين على الأقل: الأول، تجاوز مفهوم الدولة-الأمة، أي عقدة الهويات القومية من جهة، والثاني، إضعاف مفهوم السيادة المطلقة للدولة وإيجاز حق التدخل العادل في شؤون بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وقوانين المجتمع الدولي.
أفكار طوباوية
في تنظيره لإصلاح هيئة الأمم المتحدة، يدافع هابرماس عن فكرة «الكونية التواصلية» التي حفلت بها كتاباته منذ «نظرية الفعل التواصلي» (1981م)، داعيًا بذلك إلى الانتقال بالأمم المتحدة إلى نوعٍ من «ديمقراطية للمواطنة العالمية» التي تتحدد إصلاحاتها بثلاث نقاط: إنشاء برلمان عالمي، وتطوير العدالة الدولية، وإعادة تنظيم مجلس الأمن. يقترح هابرماس إذن لتجاوز ذلك التمثيل الحكومي المعمول به اليوم في الأمم المتحدة أن تتحول الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى شكلٍ من أشكال المجلس الفيدرالي للشعوب بحيث «لا تعود الشعوبُ مُمثَّلَةً بحكوماتها وإنما بوصفها كلية من مواطني العالم»(١٠). هكذا يؤسس هابرماس للانتقال من القانون الدولي إلى قانون المواطنة العالمية، لكنه بذلك يظل أسير طوباوية أفكار عصر التنوير.
من ناحية أخيرة يَعتبر هابرماس مفهوم السلام الدائم عند كانط مفهومًا سلبيًّا وهو في نقده له يبدو وكأنه يبرر وجود الحرب بالقول: كان كانط قادرًا على الاكتفاء بمفهوم سلبي عن السلام، لكن مثل هذا المفهوم غير كافٍ ليس فقط لأن القيام بالحرب قد تجاوز الحدود التقليدية، ولكن أيضًا وبشكلٍ خاص لأن للحروب أسبابًا اجتماعية(١١).
على خلاف كانط، لا يعني السلام الدائم عند هابرماس نهاية الحرب وإنما تشكيل قوة عسكرية ونظام قانوني عقابي يحاول منع اندلاع الحروب التي من شأنها تهديد السلام والأمن في العالم. هكذا يعيدنا هابرماس بطريق متعرج ومتشابك إلى تلك الأفكار السياسية المُلتبسة حول «الحروب العادلة» أو «الحروب من أجل إنهاء الحروب» المحكومة بدورها بنظرة المركزية الأوربية.
لا شك أن هابرماس أكثر واقعية من كانط في موضوع السلام الأبدي، لكنه لا يفعل في النهاية سوى أن يصادر حلم كانط الكوني ليسجنه في قفص مفاهيمي محولًا كونيته، إلى كونية مزعومة ليست في النهاية سوى نسخة معمَّمة وموسعة عن الدولة الأوربية الحديثة. مرة أخرى يحاول هابرماس التصالح مع اليوتوبيا لكنه بانتصاره للواقع ينتهي بتحويل اليوتوبيا إلى جثة معيارية لا حياة فيها ولا قدرة على التجديد.
هوامش:
(١) Jürgen Habermas, La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, trad. Rainer Rochlitz, Paris, Cerf, 2005, p. 9.
(٢) المرجع نفسه، ص، 13. كتب هابرماس كتابه هذا عام 1996م وكان تصوره للإرهاب محدودًا أيضًا ومتوقفًا على التفجيرات بالقنابل والعمليات الانتحارية الفردية. لم تكن تفجيرات برجي التجارة العالميين التي وقعت في سبتمبر 2001م ضمن تصور هابرماس للعمليات الإرهابية بوسائل جديدة كاستخدام طائرات مدنية تجارية أو هجمات كيمياوية أو سيبرانية.
(٣) Habermas, La Paix perpétuelle. op.cit., p. 20.
يشير هابرماس هنا إلى عصبة الأمم التي تشكِّل نموذجًا أقدم لهيئة الأمم المتحدة. تأسست عصبة الأمم، بعيد مؤتمر باريس للسلام وعلى إثر الحرب العالمية الأولى كهيئة دولية مهمتها حفظ السلام في العالم. لكن افتقارها لقوة عسكرية واعتمادها بشكل أساسي على الدبلوماسية، قد دفع الدول الطامعة في التوسع أو الساعية للحروب إلى عدم احترام قراراتها، بل والاستهزاء بها ولم تعد تحظى قبيل الحرب العالمية الثانية سوى باعتراف قانوني قبل أن تُحَلّ نهائيًّا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقبل أن يقترح مؤتمر طهران (1943م) إنشاء هيئة جديدة تحل محلها، لكن بصلاحيات أكبر واعتراف قانونيّ دولي ومجلس أمن كقوة عسكرية ملزمة لجميع الدول الأعضاء. ومع ذلك فإن الأمم المتحدة اليوم ليست سوى فزّاعة تتحكم بها القوى العظمى وتحتاج قوانينها بدورها إلى إعادة هيكلة وإصلاح، لكن هذا موضوع آخر.
(٤) Habermas, La Paix perpétuelle. op.cit., p. 122
(٥) المرجع نفسه، ص. 57
(٦) المرجع نفسه، ص، 51-52.
(٧) المرجع نفسه، ص.، 95-96.
٨) جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب- حوارات مع يورغن هابرماس وجاك دريدا، ترجمة وتقديم خلدون النبواني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2013م، ص، 87.
(٩) Habermas, La Paix perpétuelle. op.cit., p. 54.
(١٠) المرجع نفسه، ص، 77.
(١١) المرجع نفسه، ص،71

خلدون النبواني - كاتب سوري | يناير 1, 2023 | مقالات
فلسفيًّا، ارتبط مفهوم السلام بمفهوم الحرب، فالحرب تقدم النقيض الأبرز الذي يمنح السلم كل دلالاته، بل أهميته وضرورته. وعلى الرغم من أن الحروب، القديمة قدم التجمعات البشرية، قد تغيرت طرقها وقوانينها وإستراتيجياتها ووضوح أهدافها وأدواتها من الحجارة والعصا مرورًا بالسيوف والمدافع وصولًا إلى الحروب السيبرانية والثقافية والإرهاب، فإنها لم تتوقف فعليًّا بين البشر. والمفارقة اللافتة هي أن الحروب تزداد دمارًا ووحشيةً وقدرة على الإبادة والقتل باطرادٍ مع التقدم العلمي والتقني، وبشكلٍ متوازٍ مع كل ذلك التقدم الحاصل على مستوى الحقوق والقوانين والمنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية ومؤسسات السلام العالمي وجهود بعض المؤسسات الدينية الصادقة في الدعوة للسلم والتعايش.
وبسبب استمرار الحروب وازدياد انتشارها وقدراتها التدميرية للإنسان والكوكب بما تجره من فظاعات وانتهاكات قانونية وأخلاقية، فإن الدعوة إلى ضبطها ومحاولة منع وقوعها وترسيخ أسس مُلزمة أخلاقيًّا وقانونيًّا للسلام المحلي والإقليمي والعالمي تزداد إلحاحًا وحضورًا في الفلسفة والقانون والدين.
من الفكر الشرقي القديم مرورًا بفلاسفة الإغريق ثم الفكر الرواقي وفلسفة العصور الوسطى وصولًا إلى الفلاسفة الحديثين والمعاصرين مثل: برتراند راسل، وهابرماس، ودريدا، وبودريار مرورًا بكانط، وفيشته، وكارل شميت، إلخ، ظلت ثنائية السلم والحرب موضوعًا فلسفيًّا أصيلًا. وقد شُرعِنَت الحرب في بعض التنظيرات الفلسفية (العقلانية على كل)؛ إذ بُرِّرت بوصفها شرًّا لا بد منه لإقامة الخير والعدل، بل لتحقيق السلم بالعنف في حال عُدمت الوسائل السلمية. تحدث القديس أوغسطين مثلًا عن «الحرب العادلة» ونظّر غيره من الفلاسفة لضرورة قيام حروبٍ لتُنهي حروبًا أخرى وتحقق السلام. وبمعنى آخر، كثيرًا ما وجدت الفلسفة أنه ولتحقيق السلم لا بد من اندلاع الحرب، فأوكلت للعنف إنهاء العنف. هكذا ارتبطت، فلسفيًّا، الحرب بالسلم، والعكس بالعكس.
هل الحروب قدر الإنسان إذن؟ لا، ويجب ألّا تكون الحال كذلك، فالتاريخ هو من صنع الإرادات البشرية ويمكن أن يكون على نحو مختلف. ولكي يكون على نحو مختلف لا بد من تضافر الجهود، ومواصلة العمل على بناء السلام الأهلي والدولي الذي قد لا يكون أبديًّا (وهو لن يكون كذلك) ولكنه قد يكون طويلًا جدًّا. ولكي يدوم ويستمر أطول مدة ممكنة لا بد من تصوره أبديًّا إذن. هكذا على أية حال تلخصت رؤية كانط للسلام وهذا ما سنحاول إبرازه في الصفحات التالية.
كانط ومعيارية مشروع «السلام الدائم»
كان كانط عجوزًا قد تجاوز السبعين حين ألّف كُتيب «نحو السلام الدائم» Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf الذي ظهر عام 1795م، أي بعد مرحلة نقدياته الثلاث الشهيرة «نقد العقل المحض» (1781م، ط1، و 1787م ط2)، و«نقد العقل العملي» (1788م)، ثم نقد «ملَكة الحكم» (1790م). في تلك المدة عكف كانط أكثر على الفكر السياسي والقانوني الذي ظهرت نتائجه بشكل رئيس في كتيب «نحو السلام الدائم»، ثم «ميتافيريقا الأخلاق» (1797م) (التي ظلت وفقًا لطرحه جزءًا من مذهب القانون)، وأخيرًا نصه «صِراع الملَكات» (1798م). يقلل بعضٌ من أهمية تلك المرحلة العملية في فلسفة كانط، ويراها مرحلة الشيخوخة الآفلة قليلة الأهمية فلسفيًّا بعد أن استنفد كانط نفسه في النقديات، المشروع الأبرز لفلسفته، بحسب هؤلاء. لكن قراءة متأنية لهذه النصوص العملية الثلاثة تؤكد ليس فقط أهمية الطرح الكانطي النظري للفلسفة العملية وإنما أيضًا تأسيسه لمعيارية عقلية مضبوطة لمشروعات سياسة كبرى -مثل مشروعه لسلام دائم بين الدول- وهي مشروعات ظل ينظر إليها في السابق في إطار اليوتوبيا الساذجة وأحلام الفلاسفة الرومانسيين.
لكن قبل مناقشة أهم أفكار كانط حول السلام لنتذكر أولًا أن فكرة السلام الأبدي قد راودت كانط قبل سنتين من ظهور كتيبه الشهير «نحو السلام الدائم». ففي عام 1793 نشر كانط مقالًا اقترح فيه فكرة «دولة عالمية للشعوب تفرض قوانينها على كل الدول الخاصة». لكن هذا التصوُّر لدولة فائقة أو سوبر دولة ذات كيان سياسي تخضع له جميع الدول سيتراجع عنه كانط بعد سنتين ليقترح بدلًا منه ميثاقًا إنسانيًّا أو عقدًا اجتماعيًّا عالميًّا يقوم على التضامن بين الشعوب، وهو ما سيفصِّله في مشروعه حول السلام الدائم بين الأمم.
ما الذي جعل كانط يتراجع عن فكرة دولة عالمية فائقة تخضع لها كل الدول والأمم القومية وتذوب فيها؟ لهذا التراجع الكانطي السريع سببان في رأيي: الأول تاريخي موضوعي يتعلق بحالة القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية في عصر كانط التي تفترض وجود الدولة القومية وسيادتها كبديهية من بداهات السياسة. والسبب الثاني بنيوي يتعلق ببنية تفكير كانط، وبتحديد أكبر بصورية الأخلاق عنده التي تفترض الحرية الفردية والمسؤولية الشخصية حتى ولو كانت كونية كما تجلّى ذلك في تنظيره لفكرة الواجب الأخلاقي. وبمعنى آخر، تقوم الكونية الأخلاقية الكانطية أساسًا على ذوات فردية حرة تتصرف بمسؤولية بحيث تجعل من تصرفاتها قانونًا كونيًّا، وتلك الحرية والمسؤولية ستظل حاضرة على ما يبدو في ذهن كانط حين كتب عن دولة المواطنة العالمية، وهو ما سيجعله يتراجع عن فكرة دولة عالمية تبتلع بقية الدول وتخفي هوياتها القومية الخاصة. بحسب هذا التصور، فإن فهمهه للذوات الحرّة المسؤولة سينتقل لتصوره لفكرة الدول القومية التي ستتمثّل حريتها كلاسيكيًّا في سيادتها، وسيصبح العقد الاجتماعي للأفراد الأحرار (المستوحى من روسو أصلًا) ائتلافًا وميثاقًا بين الشعوب لا يقضي على حرية السيادة الخاصة بكل دولة.
كان كانط يتخوف أن ينتهي مشروع قيام دولة عالمية مؤلفة من مجموع دول العالم إلى دولة توتاليتارية هائلة على مستوى الكوكب أو، كما كان يتوجس، إلى «استبدادٍ أكثر رعبًا» من استبداد الدول القومية منفردة. كل هذا سيدفع كانط إذن للعزوف عن فكرة «دولة المواطنة العالمية» ليقترح بديلًا آخر يتمثل في مشروع ائتلاف عالمي لشعوب العالم وإلى التمييز بالتالي بين عقد أخلاقي (لكنه غير ملزم قانونيًّا) للمواطنة العالمية، والقانون الدولي الذي يضع تشريعات ملزمة تضبط العلاقات بين الدول. على الرغم من اختلاف هذين السببين اللذين أقدمهما هنا، فإنهما يلتقيان في النهاية في إشكالية واحدة: «سيادة الدولة-القومية» بشقيها السيادة الخارجية والسيادة الداخلية، وهي الإشكالية نفسها التي ستواجه من بعده كلًّا من كارل شميت وحنا أرندت وهابرماس ودريدا، حيث سينظِّر لها كل على طريقته.
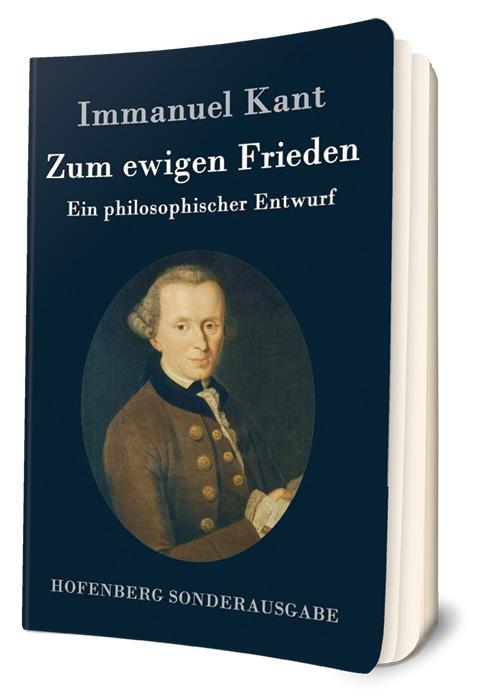 أحلام عصر التنوير
أحلام عصر التنوير
وبالعودة إلى مشروع كانط حول السلام يمكن لنا القول: إنه إذا كانت المدينة الفاضلة أو الجمهورية المثالية هي هاجس لاحق الفلسفة منذ تأسيسها، فإن هاجس تأسيس سلام أبدي بين الأمم قد برز فكريًّا بقوة في عصر التنوير الأوربي. وفي هذه النقطة تتقاطع الفلسفة مع الأديان التي سعت لإقامة «مدينة الله» على الأرض بحيث يتعايش جميع المؤمنين في سلام ومحبة وأمن. وعليه، ليس كانط إذن أول من طرح مشروعًا للسلام الدائم فكريًّا؛ إذ يبدو جليًّا أنه قد استلهم فكرته، بل عنوان كتيبه ذاك من نص للقس التنويري سان بيير والمعنون ﺑ«مشروع من أجل السلام الدائم في أوربا» (1713م) الذي يأتي كانط على ذكره والذي يبدو أنه تعرف إلى نصه حول السلام من خلال نقد روسو لكتابه ذاك.
لكن إذا ظل مشروع القس سان بيير مقتصرًا على إقامة السلام الدائم بين دول أوربا المسيحية، فإن مشروع كانط يريد التوسع ليشمل مساحة الكرة الأرضية كلها باختلاف دولها وشعوبها وألسنتها ودياناتها، إلخ. يريد كانط -وهو الفيلسوف المعياري- مشروع سلام دائم وأبدي للجميع، لكن هل يمكن تحقيق هذا المشروع عمليًّا أي سياسيًّا بإيجاد المعادل المؤسساتي الواقعي لهذا الطرح؟ تقدم لنا القراءة المتأنية لنص كانط ذاك جوابًا بالإيجاب ويمنحنا التاريخ السياسي/القانوني الحديث أملًا واقعيًّا إذ يكفي أن نتابع تطور المناقشات والقرارات حول القانون الدولي والمؤسسة الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها لنعرف أن مشروع كانط لم يكن محض حلم طوباوي من أحلام عصر التنوير.
يبدأ كانط كُتيبه حول السلام الدائم بالتمييز بين مهمة الفيلسوف ومهمة السياسي في التعامل مع المسائل السياسية. فالفيلسوف الذي يضع الأسس النظرية للعمل السياسي لا يُعجب السياسي الممارس لمهامه السلطوية الذي يرى في السياسة لعبة الممكنات الواقعية والبراغماتية التي قد تضحي بالأخلاق من أجل المصلحة. ولهذا يجد السياسي في الفيلسوف شخصًا جاهلًا بالممارسة السياسية حدًّا يثير السخرية. بل إن كانط يرى أن السياسي قد يجد في آراء الفيلسوف خطرًا يهدد الدولة نفسها فيقول: «لكننا نود أن نضع الشرط التالي: ما دام أصحاب السياسة العملية ينظرون إلى أصحاب السياسة النظرية بأنفة واستكبار، ويعدونهم حكماء لا خطر منهم على الدولة التي يجب أن تستمد مبادئها من التجربة، وما داموا ينظرون إليهم نظر لاعبين غير مدربين يستطاع التغلب عليهم بشيء من المهارة، فينبغي على السياسي الخبير أن يكون منطقيًّا مع نفسه حين تصدم آراؤه آراء الفيلسوف، فلا يستنكرها ولا يجد فيها على الدولة خطرًا».
 وصايا لتجنب الحرب
وصايا لتجنب الحرب
بعد سنة من صدور الطبعة الأولى لكتيب «نحو السلام الدائم» أي عام 1796م سيضيف كانط إليه ملحقين، يعود في الثاني منه إلى تباين التعاطي النظري والعملي مع السياسة، حيث سيؤكد هذه المرة التباين في تناول كل من الفيلسوف والمُشرِّع للشأن السياسي. فهذا الأخير يختلف -بحسب كانط- عن الفيلسوف فيما يتعلق بالنظرة الأخلاقية «لأن اختصاصه لا يعدو تطبيق القوانين القائمة، لا البحث فيما إذا كانت محتاجة إلى إصلاح أو تعديل…».
وبما أن كانط يتناول السلام كفيلسوف لا كسياسي ولا كمشرِّع فإنه يقصر همه هنا في الشأن النظري للفيلسوف الذي يؤسس معرفيًّا للسياسة، ويؤسس السلام الأبدي الذي لم يكن قبله سوى يوتوبيا مستحيلة، يوتوبيا على قاعدة معيارية عقلية تجعل هذا المشروع ممكنًا عمليًّا. يُجمل كانط رؤيته المعيارية العقلية للسلام الأبدي في ست مواد أولية يُكثِّفها على النحو الآتي:
أولًا- «إن معاهدة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا انطوت نية عاقديها على أمرٍ من شأنه إثارة حرب من جديد».
ثانيًا- «إن أي دولة مستقلة، صغيرة كانت أو كبيرة، لا يجوز أن تملكها دولة أخرى بطريق الميراث أو التبادل أو الشراء أو الهبة».
ثالثًا- «يجب أن تلغى الجيوش الدائمة على مر الزمان».
رابعًا- «يجب ألا تعقد قروض وطنية من أجل المنازعات الخارجية للدولة».
خامسًا- «يحظر على كل دولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو في حكومتها».
سادسًا- «لا يسمح لأي دولة في حرب مع دولة أخرى أن ترتكب أعمالًا عدائية -كالقتل والتسميم ونقض شروط التسليم والتحريض على الخيانة- قد يكون من شأنها، عند عودة السلم، امتناع الثقة المتبادلة بين الدولتين».
يميز كانط في هذه المواد بين «قوانين ناهية»، وهي برأيه قوانين مرنة واسعة مرتهن تطبيقها بالظروف وقابلة للتأجيل وهو يحصرها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، وقوانين أخرى مضبوطة أو «قوانين آمرة»، وهي عنده قوانين نافذة من فور صدورها من دون اعتبار الظروف، وملغية لما سبقها من قرارات وقوانين، ويحصرها في المواد الأولى والخامسة والسادسة. في مقابل هذه الأوامر والنواهي التي يضعها كانط وصايا لتجنب الحرب وتكرارها الدائم ولتثبيت شروط السلم الأبدي بين الشعوب، يصيغ مبادئ ثلاثة نهائية وضرورية لتحقيق السلام يجملها في التالي: «يجب أن يكون الدستور المدني لكل دولة دستورًا جمهوريًّا».
«يجب أن يقوم قانون الشعوب على التحالف بين دول حرة».
«حق النزيل الأجنبي، من حيث التشريع العالمي، مقصور على إكرام مثواه».
إذن وفق كانط «السلم الأبدي» بين دول العالم ليس مجرد طرح طوباوي، وإنما تأطير نظري فلسفي لإمكانية سياسية ممكنة لو توافرت الظروف والإرادات لوضع تلك الأفكار موضع تطبيق؛ إذ «لا يجوز لنا أن نستنتج من أن شيئًا لم ينجح حتى اليوم، أنه لن ينجح أبدًا». ولكن لكي يتحقق السلام بين دول العالم المتصارعة لا بد من تشكيل مؤسسة سياسية «حيادية» تسهر على قوانين السلام العالمي وتضعها موضع التطبيق وتحاسب منتهكيها، وتلك المؤسسة التي يسميها كانط مرة «حلف الشعوب» ومرة أخرى «حلف السلام» أو مرة ثالثة «جامعة أمم» ستكون نواة ما سيعرف لاحقًا بمنظمة الأمم المتحدة التي تأسست مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م والتي حلت مكان هيئة «عصبة الأمم» التي تأسست بدورها مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى، و«مؤتمر باريس للسلام» عام 1919م والتي كانت آراء كانط حول السلام حاضرة فيها كلها على نحو مباشر أو غير مباشر.
مَأْسَسة السلام وقَوْنَنَته
في كل مرة إذن كانت تقوم فيها حروب كبيرة «عالمية» يدرك الساسة ضرورة مأسسة السلام وقوننته في قوانين دولية، والعمل على فض النزاعات والحروب عبر الدول وهو ما سيتجلى في «مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة. لا شك أن هذه المؤسسات ليست مثالية، بل هي اليوم مجرد «وحوش من ورق» كما سماها هابرماس، وهي تخضع لسلطة وسيادة ومصالح الدول العظمى والقوى الكبرى التي تنتهك كغيرها من وقتٍ لآخر قرارات ومواثيق الأمم المتحدة، لكن هذا لا يمنع من أنها قامت وتقوم بدور تنظيمي للعلاقات الدولية، ولا بد اليوم من العمل على إصلاحها ابتداءً من التنظير الفلسفي الأخلاقي الذي يضع الشعوب وحقوق الإنسان فوق أي اعتبار للمصلحة والقوة.
من الصحيح إذن أن «السلام الأبدي» الكانطي ليس مجرد حلم طوباوي وإنما هو يندرج معياريًّا عنده ضمن مفهومه حول «الفكرة الموجِّهة» التي تظل ترانسندنتالية أي متعالية ومثالية، لكن مثاليتها شرط لتوجيه إرادات البشر نحو تحقيق أمثل للممكنات الواقعية في السياسة والأخلاق.
ومع أن كتيب كانط هذا يظل مرجعية نظرية لا غنى عنها للتأسيس الفلسفي لمفهومي الحرب والسلام، إلا أنه يظل محكومًا مع ذلك بواقع الحياة السياسية وتقلباتها وصراعاتها في أوربا في القرن الثامن عشر، ولكن بخاصة في فرنسا التي قامت فيها الثورة عام 1789م وتأثر بها كانط أعظم تأثير. من هنا يمكن أن نفهم اشتراطه أن يكون الدستور جمهوريًّا للدول لتحقيق السلام بين الشعوب كما يتجلى في المادة الأولى من المبادئ النهائية. كما أن رؤية كانط للسلم آنذاك تظل محكومة بحروب أوربا المستعرة يومها وحاجة الدول الأوربية المتصارعة آنذاك إلى التوصل إلى حلول سلمية تنهي المعاناة البشرية وتسمح لمبادئ التنوير بالتحقق.






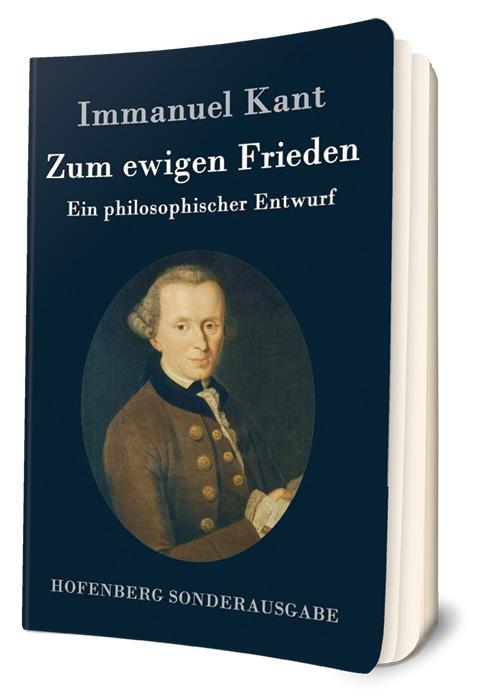 أحلام عصر التنوير
أحلام عصر التنوير وصايا لتجنب الحرب
وصايا لتجنب الحرب